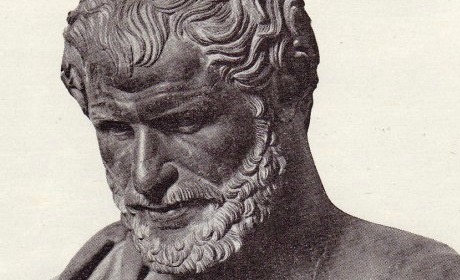يسوع يُنبئ ثانية بموته وقيامته – إنجيل لوقا 18 ج6 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
يسوع يُنبئ ثانية بموته وقيامته – إنجيل لوقا 18 ج6 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
يسوع يُنبئ ثانية بموته وقيامته – إنجيل لوقا 18 ج6 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد

(لوقا31:18ـ34): ” وَأَخَذَ الاِثْنَى عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ: هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَسَيَتِمُّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ بِالأَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ الإِنْسَانِ. لأنهُ يُسَلَّمُ إِلَى الأُمَمِ وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ وَيُشْتَمُ وَيُتْفَلُ عَلَيْهِ. وَيَجْلِدُونَهُ وَيَقْتُلُونَهُ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ. وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَكَانَ هَذَا الأَمْرُ مُخْفىً عَنْهُمْ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا قِيلَ “.
تكلّم النبي الطوباوي داود عن واحدة من تلك الأمور التي لها أهمية عظمى لمنفعتنا، خصوصًا وأنها تشير إلى ما يحدث دائمًا بالنسبة لأذهان الناس فيقول: ” تهيأت ولم أنزعج ” (مز 60:118 س). لأن كل ما يحدث على غير توقع، إذا ما كان متَسّمًا بالخطورة، فإنه يُعرِّض حتى أشجع الناس للاضطراب والانزعاج، وأحيانًا يصيبهم بمخاوف لا تحتمل. أما إذا كان قد ذُكِرَ قبل حدوثه، فإن وَقْعِه يسهّل تجنبه، وهذا هو على ما أظن معنى ” تهيأت ولم أنزعج”.
لأجل هذا السبب، فإن الكتاب الموحى به من الله، يقول ـ بشكل مناسب جدًّا ـ لأولئك الذين سوف يبلغون للمجد بسلوكهم طريق القداسة هكذا: ” يا بُني إذا تقدمت لخدمة الرب أعدد نفسك للتجربة، ووجه قلبك واحتمل” (ابن سيراخ 1:2 و2). إن الكتاب يتكلّم هكذا لكي يُعلّم الناس أنهم بممارسة الصبر والاحتمال فإنهم سوف يتغلّبون على التجارب التي تقابل كل من يعيشون بالتقوى، ويبرهنوا على تساميهم على كل ما يمكن أن يزعجهم. كذلك هنا أيضًا، فإن مخلّص الكل لكي يُعد مسبقًا أذهان التلاميذ فإنه يخبرهم بأنه سوف يعاني الآلام على الصليب والموت بالجسد بمجرد صعوده إلى أورشليم. وأضاف أيضًا أنه سوف يقوم ثانية، ويمسح الألم، ويزيل خزي الآلام بعظمة المعجزة، لأنه أمر مجيد ويليق بالله أن يكون قادرًا على كسر رباطات الموت والعودة بسرعة إلى الحياة. لأن القيامة من الأموات بحسب تعبير الحكيم بولس ـ تشهد له أنه الله وابن الله (رو 4:1).
لكن يلزمنا أن نشرح ما هي المنفعة التي نالها الرسل القديسون من معرفتهم باقتراب تلك الأمور التي كانت على وشك الحدوث. إنه بهذه الوسيلة قطع مسبقًا كل الأفكار غير اللائقة وكل فرص العثرة. سوف تسألون: كيف وبأي طريقة؟ وأنا أجيب: إن التلاميذ الطوباويين تبعوا المسيح مخلّصنا كلّنا في جولاته في اليهودية ورأوا أنه لم يوجد شيء، مهما كان فائقًا على الوصف، وجديرًا بالإعجاب لم يستطع أن يعمله. إنه دعا الموتى من قبورهم بعد أن أنتنوا، وأعاد البصر للعميان، وصنع أيضًا أعمالاً أخرى لائقة بالله ومجيدة، وسمعوه يقول: ” أليس عصفوران يباعان بفلس؟ وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم” (مت 29:10). والآن فَهُم الذين قد رأوا هذه الأشياء وتشدّدوا بكلماته (التي قادتهم) إلى الشجاعة، كانوا على وشك أن ينظروه يحتّمل سخرية اليهود، ويُصلب ويُستهزئ به ويُلطم من الخدام. لذلك كان ممكنًا أن يعثروا بهذه الأمور، ويفكروا في داخل أنفسهم ويقولون: ذلك الذي هو عظيم هكذا في قوته، وله مثل هذا السلطان الإلهي، والذي يجري المعجزات بإيماءته فقط، وكلمته مقتدرة حتى إنه يقيم الموتى من قبورهم، والذي قال أيضًا إن عناية أبيه تصل حتى إلى الطيور؛ والذي هو الابن الوحيد الجنس والبكر ـ كيف أنه لم يعرف ما كان مزمعًا أن يحدث؟ هل هو أيضًا أُخذ في شباك العدو وصار فريسة لأعدائه مع أنه وَعَدَ أنه سوف يخلّصنا؟ فهل أُهمِل وأُحتقر من ذلك الآب الذي بدون مشيئته لا يمكن أن يسقط ولا حتى عصفور صغير؟ ربما قال أو فكر الرسل القديسون في هذه الأشياء فيما بينهم وماذا كانت ستصير النتيجة؟ إنهم أيضًا مثل باقي جموع اليهود كانوا سوف يصيرون غير مؤمنين وجاهلين بالحق.
لذلك فإنه أخبرهم مقدمًا عما كان سوف يحدث، حتى يكونوا على دراية بأنه قد عرف بآلامه قبل أن تحدث، ومع أنه كان في استطاعته أن يهرب منها بسهولة، إلاّ أنه مع هذا تقدَّم لملاقاتها بإرادته. فبقوله: ” هانحن صاعدون إلى أورشليم”، فهو ـ إن جاز القول ـ شهد بقوة، وأمرهم أن يتذكّروا ما سبق أن أخبرهم به وأضاف أن كل هذه الأمور قد سبق أن تنبأ عنها الأنبياء القدّيسون. لأن إشعياء يتكلّم كما بلسان المسيح: ” بَذلَتُ ظهري للسياط وخدي للطم، وجهي لم أستر عن خزي البصاق” (إش 6:50 س). وأيضًا يقول عنه في موضعٍ آخر: ” مثل خروف يُساق إلى الذبح وهو صامت، وكنعجة أمام الذي يجزها” (إش 7:53 س). وأيضًا: ” كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب سلَّمه بسبب خطايانا” (إش 6:53 س). وكذلك يرسم لنا داود الطوباوي في المزمور الواحد والعشرون ـ كما لو كان صورة مسبقة للآلام على الصليب، ويضع يسوع أمامنا متكلّمًا كإنسان معلق على الخشبة (فيقول): ” أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يتكلمون بشفاههم ويهزون رؤوسهم قائلين اتكل على الرب فليخلصه” (مز 6:21ـ8 س). لأن بعضًا من اليهود كانوا يهزون رؤوسهم الأثيمة ويستهزئون به قائلين: ” إن كنت ابن الله انزل من على الصليب ونحن نؤمن بك” (مت 40:27 و43)، وأيضًا قال (داود): ” اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لُباسي ألقوا قرعة” (مز 18:21)، كما يقول في موضعٍ آخر عن أولئك الذين صلبوه: ” ويجعلون في طعامي علقمًا وفي عطشي يسقونني خلاً” (مز 21:68 س).
لذلك، فمِنْ كل ما كان مزمعًا أن يصيبه، لم يوجد شيء لم يسبق الإخبار به قبل حدوثه، والله بعنايته رتّب هذا لمنفعتنا حتى عندما يحين الوقت لحدوثه، لا يعثر أحد، لأنه كان في استطاعة من عَرِفَ مسبّقًا ما كان مزمعًا أن يحدث له، أن يرفض التألم كليّةً. إذن، لم يجبره أحد على ذلك بالقوة، ولا أيضًا كانت جموع اليهود أقوى من قدرته، لكنه خضع للتأّلم لأنه عرف أن آلامه سوف تكون لأجل خلاص العالم كله. إنه احتمل في الواقع موت الجسد، لكنه قام ثانية إذ داس على الفساد، وبقيامته من الأموات غَرَسَ في أجساد البشر الحياة النابعة منه، لأنه فيه تّم إعادة كل طبيعة البشر إلى عدم الفساد. وعن هذا شَهِدَ الحكيم بولس وقال: ” فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضًا قيامة الأموات” (1كو 21:15). وأيضًا: ” لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيُحيا الجميع” (1كو 22:15). لذلك فلا يحق لمن صلبوه أن يتمادوا في الكبرياء إذ أنه لم يبق بين الأموات، إذ نرى أنه كإله له قوة لا تُقاوم، بل بالأحرى عليهم أن يبكوا على أنفسهم بسبب كونهم مذنبين بجريمة قتل الرب، وهذا هو ما وجدنا المخلص يقوله للنسوة اللواتي كُنَّ يبكينَ لأجله: ” يا بنات أورشليم لا تبكينَ علىَّ بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن” (لو 28:23)، لأنه لم يكن من الصواب أن يَنُحنَ على من كان مزمعًا أن يقوم من بين الأموات محطمًا بذلك الفساد ومزعزعًا سلطان الموت، بل العكس كان يليق بالأكثر أن يَنُحنَ على مصائبهن.
سبق مخلّص الكل وأعلن هذه الأشياء للرسل الأطهار، لكن الكتاب يقول: ” أما هم فلم يفهموا من ذلك شيئًا، وكان هذا الأمر مُخفَى عنهم”، لأنهم لم يعرفوا بعد بالتدقيق ما سبق أن أعلن عنه الأنبياء القدّيسون، لأنه حتى الذي كان هو الأول بين الرسل لمّا سمع المخلِّص يقول مرّة إنه سيُصلب ويموت ويقوم، ولأنه لم يكن قد فهم بعد عمق السر، فإنه قاوم (الرب) قائلاً ” حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا ” (مت 22:16)، لكن الرب انتهره لأنه يتكلّم هكذا، لأنه لم يكن يعرف بعد معنى الكتاب الموحي به من الله فيما يختص به. لكن عندما قام المسيح من بين الأموات، فإنه فتح أعينهم كما كتب أحد الإنجيليين القديسين، لأنهم استناروا واغتنوا بالشركة الفيّاضة مع الروح، لأن الذين لم يفهموا قبلاً كلمات الأنبياء، حثوا فيما بعد الذين آمنوا بالمسيح أن يدرسوا كلام الأنبياء قائلين: ” وعندنا الكلمة النبوّية وهي أثبت، التي تفعلون حسنًا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضعٍ مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم” (2بط 19:1). وهذا أيضًا بلغ كماله، لأننا إنما قد استنرنا في المسيح الذي به ومعه لله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين.