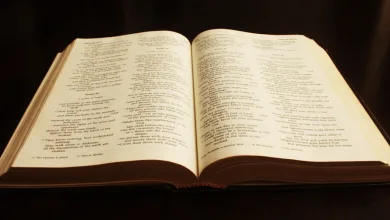المنهج فوق الطبيعي لتفسير الكتاب المقدس
المنهج فوق الطبيعي لتفسير الكتاب المقدس

المنهج فوق الطبيعي لتفسير الكتاب المقدس
كما رأينا، لقد وضع يسوع النموذج الذي اتبعه من كتبوا العهد الجديد، في التعامل مع الكتاب المقدس على أنه كتاب فوق طبيعي. فأمور مثل الحية النحاسية، وأحداث مثل الخروج من مصر، وكلمات مثل التنبؤ بأن إشعياء سيكون له ابن؛ وأشخاص مثل ملكي صادق – يتم فهمهم جميعاً على أنهم إشارات ليسوع المسيح.
بعض الشواهد تكون واضحة بما يكفي بحيث أن المفسرين اليهود للعهد القديم – قبل زمن المسيح – كانوا يرون باستمرار إشارات للمسيا. لكن العديد من الشواهد، مثل تلك التي أشرنا إليها أعلاه، لن ترد إلى ذهن الشخص الذي يبحث عن المعنى الذي كان يقصده المؤلف. فغير المؤمنين قد يقولون إن هناك معنى معين تم فرضه على النص.
أما المؤمنون فيقولون إن المعنى يظل مخفي إلى أن يكشفه المسيح أو رسله. ففي أي حدث، يتم رؤية الكتاب المقدس على أنه كتاب فوق طبيعي، هذا لأن الأحداث المستقبلية لا يمكن التنبؤ بها بدقة وتفصيل زمني، قبل حدوثها بسنوات كثيرة، بواسطة الحكمة البشرية وحدها.
المفسرون اليهود وآباء الكنيسة
لم تكن الطريقة التي فهم بها يسوع الكتب المقدسة وفسرها طريقة غريبة بالنسبة لسامعيه من اليهود. فعلى الرغم من أن بعض المفسرين اليهود تعاملوا مع العهد القديم على أنه وثيقة يتم فهمها بمعناها الواضح، إلا أن معظم المفسرين في زمن المسيح وضعوا على عاتقهم مسؤولية أن يكتشفوا المعاني والفروق الدقيقة والمخفية في الكتب المقدس.
كان المفهوم المحوري في تفسير أحبار اليهود، وربما في تفسير الفريسيين الأوائل كذلك، هو مفهوم “Midrash”، بمعنى أنه مفهوم يحدد “التفسير الذي إذ يتعمق فيما هو أبعد من مجرد المعنى الحرفي، يحاول أن يتغلغل في روح الكتب المقدسة، لكي يفحص النص من جميع الجهات، وبذلك يستخرج تفسيرات لا تكون واضحة مباشرة”[1].
توجد بعض التشابهات الموجودة بين فكرة المجاز اليهودية (التي تعتقد أنه بين طيات “الحرف”، أو المعنى الواضح، يوجد المعنى الحقيقي) وبين الطريقة التي تعامل بها من كتبوا العهد الجديد مع العهد القديم. لكن العهد الجديد لم يتعامل مع كل مقطع في العهد القديم بتلك الطريقة، كما رأينا. الأكثر من ذلك، لا توجد في العهد الجديد الاستنتاجات المتطرفة والخيالية، التي تعتبر نموذجاً لتفسيرات أحبار اليهود.
كان علماء الكتاب المقدس في حقبة الكنيسة ما بعد الرسولية يميلون لاتباع مثال اليهود، بل والمجازيين اليونانيين، أكثر من مثال من كتبوا العهد الجديد. وعلى الرغم من وجود مجموعة من العلماء في أنطاكية (كريزوستوم، وتيودور من موبسيويستيا، وتيودوريت) الذين سعوا لتحديد المعنى الحرفي الذي كان يقصده المؤلفون، إلا أن تلك المدرسة الفكرية لم تنتشر في الكنيسة.
كليمينت، وهو واحد من آباء الكنيسة الأولين العظام من شمال أفريقيا، وتلميذه أوريجن الاسكندري، وضعا نموذجاً لفهم الكتب المقدس منذ القرون الأولى للكنيسة وحتى الإصلاح.
كان أوريجن يعتقد أن المعنى الروحي لمجيء رفقة لاستقاء ماء لعبيد إبراهيم وجماله هو أننا يجب أن نأتي إلى ينابيع الكتب المقدسة لكي نلتقي مع يسوع. كما علم كليمنت أن الخمسة خبزات التي أطعم بها يسوع الجموع كانت تشير إلى التدريب الإعدادي لليونانيين واليهود الذي كان يسبق حصاد القمح. أما السمكتان فتشيران إلى الفلسفة الهلينية: منهج الدراسة، والفلسفة نفسها.
في قصة الدخول الانتصاري، كان الجحش يشير إلى حرف العهد القديم، وأن الأتان، الذي ركبه يسوع كان هو العهد الجديد. كما أن التلميذان اللذان أحضرا الحيوانين إلى يسوع يمثلان المعنى الأخلاقي والمعنى الروحي: لكن رغم أن كليمنت كان يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك معنى حرفي ومعنى روحي معاً في النص، إلا أن أوريجن كان يعتقد أن كل شيء في الكتاب المقدس له معنى مجازي رمزي.
هذا الاتجاه في التعامل مع الكتب المقدسة والذي يطلق عليه “the quadriga”، أو “الوسيلة الرباعية في التفسير”، تم تأسيسه بقوة منذ القرن الرابع وحتى القرن السادس عشر. قامت هذه الوسيلة بفحص كل نص من ناحية أربعة معان: حرفية، وأخلاقية، وباطنية (مجازية)، ونبوية. وقد تم تعليم ذلك المنهج بواسطة ترنيمة شهيرة:
الحرف يوضح لنا ما فعله الله وآباؤنا؛
المجاز يوضح لنا أين يكمن إيماننا؛
والمعنى الأخلاقي يعطينا قواعد للحياة اليومية؛
والمعنى النبوي يوضح لنا أين ينتهي جهادنا.
مثال على ذلك كلمة “أورشليم” حرفياً، تمثل أورشليم مدينة بذلك الاسم؛ ومجازياً، تعني أورشليم الكنيسة. أما نبوياً، فهي المدينة السماوية؛ وأدبياً، هي النفس البشرية.[2]
لقد اتخذ المصلحون موقفاً قوياً تجاه ذلك النوع من التفسير. فكان اهتمام لوثر، وكالفن، وزوينجلي هو أن يجدوا المعنى الذي قصده المؤلفون، وأن يجعلوا هذا المعنى هو السلطة للإيمان والأعمال. وقد اتحد هؤلاء المصلحون الثلاثة في رفض زعم الكنيسة في أن تكون هي المفسرة؛ وأكدوا على حرية وقدرة ومسؤولية الفرد في فهم معاني الكتب المقدسة. كما اتفق هؤلاء الثلاثة على سلطة كلمة الله باعتبار أنها فوق كل السلطات الأخرى.
واتفقوا على أن الكتاب المقدس بأكمله جدير بالثقة، وبالتالي، أن الكتب المقدسة يمكنها بل ويجب أن تفسر نفسها بنفسها. الأكثر من ذلك، لقد اتفقوا على أن استنارة الروح القدس هي أمر ضروري لفهم الكتب المقدسة، وأن الدراسة الجادة والقوية هي أمر مطلوب كذلك. لكنهم لم يتفقوا من جميع النواحي على كيفية تفسير الكتب المقدسة.
اختلف المصلحون في أن كالفن كان أكثر ثباتاً وتمسكاً في اتباعه لهذه المبادئ. فقد تمسك بشدة بالمعنى الواحد الواضح لنص الكتب المقدسة. أما لوثر فقد كان أقل تدقيقاً، وكان في بعض الأحيان يستخدم المعنى الرمزي لتفسير المقطع بطريقة تدعم لاهوته الخاص.
وكان تفسيره عقائدياً، يحكمه النظام اللاهوتي الذي كان منتمياً له – وهو الخلاص بالنعمة من خلال الإيمان وحده. أكثر من ذلك، كان تفسيره في بعض الأوقات على أسس ذاتية، أو يزعم أنه تلقاه عن طريق الاستنارة المباشرة بالروح القدس.[3]
لكن على الرغم من اختلاف المصلحين في تلك الطرق، إلا أنهم اتحدوا في التزامهم بالافتراضات المسبقة التي كان يعتنقها من كتبوا العهد الجديد:
1 – بأن الكتاب المقدس هو من الله، وأنه كتب بواسطة البشر.
2 – بأنه نقل مباشرة لمشيئة الله للبشر.
3 – أنه يمكن فهمه باللغة البشرية العادية.
لقد قدم المصلحون جسراً يعبر من المجهودات التفسيرية التي كانت في كثير من الأحيان خيالية ولا يمكن توقعها دائماً في القرون الأولى والمتوسطة للكنيسة، إلى الحقبة البروتستانتية، التي فيها أصبح المعنى الذي يقصده المؤلف هو موضوع البحث لمن يرغبون في فهم كلمة الله.
وإذ قام المصلحون بكسر قبصة التفسير المجازي الرمزي، كانت هناك نتيجة أخرى، وهي أن العقلانيين الآن قد أصبحوا أحراراً في التعبير عن وجهات نظرهم. وفي الحال، أصبح هناك من يرون الكتاب المقدس على أنه كتاب طبيعي صرف. في النهاية، أصبح المنهج الطبيعي سائداً في التفسير البروتستانتي للكتاب المقدس.
المُروحنون المعاصرون
(أي إعطاء روحانية للنص أكثر مما هي فيه)
بقولنا أن المصلحين قد جاهدوا لكي يقربوا الكنيسة أكثر إلى النظرة التي كان يعتنقها الكتاب المقدس نفسه، وأن المصلحين قد حرروا الكنيسة من أولئك الذين كانوا ينظرون للكتاب المقدس على أنه كتاب فوق طبيعي خالص أو حتى سحري، سيكون من الخطأ الكبير أن نفترض أن التفسير الرمزي قد توقف.
فالحقيقة أن هذا الاتجاه في تفسير الكتاب المقدس لا يزال سارياً ومزدهراً، خاصة في الدوائر الإنجيلية. فكر مثلاً في الاستخدام التالي للكتاب المقدس بواسطة أحد المفسرين المشهورين واسعي الانتشار:
ثالثاً، الصمت المطلوب من “الشعب” في هذه المناسبة قدم خطاً مهماً آخر في الصورة النموذجية التي أوردتها هذه الحادثة – رغم أنه خط لا يجذب بالتأكيد الكثيرين من المسيحيين في العصر الحاضر. إن احتلال إسرائيل لأريحا بلا شك سبق تصوير الانتصارات التي حققوها تحت قيادة الله، بواسطة الإنجيل. فالكهنة الذين كانوا ينفخون في الأبواق المصنوعة من قرون الكباش يصورون خدام الله وهم يبشرون بالكلمة.
إن منع “الشعب” من فتح أفواههم تكمن أهميته في أنه يصور أن الأفراد العاديين من المسيحيين لا يجب أن يكون لهم دور في التبشير الشفهي بالحق – فهم غير مؤهلين لذلك، وليسوا مدعوين لخدمة الكلمة. فلا يوجد في أي مكان في الرسائل حث واحد لهؤلاء القديسين على أن يشتركوا في التبشير العلني، وليس حتى على أن يقوموا “بالعمل الفردي” ويسعوا “لربح النفوس”.
كما أنه ليس مطلوب منهم أن “يشهدوا للمسيح” بسلوكهم اليومي في العمل وفي المنزل. بل عليهم فقط أن “يظهروا تسابيح الله”، أكثر من أن “يخبروا” بها. عليهم أن يدعوا نورهم يضيء. فشهادة الحياة هي أكثر تأثيراً من كلام الشفتين السطحي. فالأفعال صوتها أعلى من الكلمات.[4]
لن ينفع لتبرير تلك الطريقة في التعامل مع الكتاب المقدس أن نقول إن هناك معنى واحد فقط لكن تطبيقات كثيرة. صحيح أن المقطع يمكن أن يتم تطبيقه بعدة طرق بالنسبة للخلفيات المعاصرة، لكن أن نتعامل مع الكتاب المقدس بهذه الطريقة، ونستخرج منه رسالة تبعد كثيراً عما يقصده المؤلف، فهذا نموذج للتفسير الذي لا يتعامل مع المؤلف وقصده بمحمل الجد.
في مثل هذا المنهج، لا يكون للكتاب المقدس سلطته الخاصة، ولا يكون حراً في أن يذكر هدفه المعين ويطلب الطاعة لتعاليمه، بل بدلاً من ذلك، فإنه يُستخدم لهدف آخر يكون في ذهن المفسر من خلال عملية الروحنة – والعثور على معنى خفي في النص.
تكون براعة دارس الكتاب المقدس هي القيد الوحيد لتفسيراته المثيرة للكتاب المقدس في مثل هذا المنهج. فعندما يقوم واعظ بالتعامل مع حدث تاريخي مباشر على أن له مضامين خفية وحقائق روحية مثيرة، فلا عجب في أن الكثيرين من المسيحيين الإنجيليين يتعاملون مع الكتاب المقدس بنفس الطريقة في الاستخدام التعبدي وفي طلب المشورة.
كثيرون من المسيحيين المخلصين في قراءة الكتاب المقدس بطريقة تعبدية يشعرون “بالبركة” فقط عندما يجدون فكرة مدهشة مفاجئة يوحي بها النص، وتكون فكرة ليس لها علاقة بقصد وهدف المؤلف. فبالنسبة لهم، يبدو السعي لمعرفة مشيئة الله من خلال الدراسة المتأنية وفهم قصد المؤلف، عملاً جافاً ومملاً.
وبنفس الطريقة، يستخدم كثيرون من المسيحيين الكتاب المقدس بطريقة “سحرية” للحصول على إرشاد معين للقرارات التي يجب أن يتخذوها، مثل، إلى أين يذهبون، وماذا يشترون، وما الوظيفة التي يقبلونها – والتي يتم اكتشافها جميعاً من خلال مقاطع الكتاب المقدس التي، بالمصادفة العجيبة، يكون لها معنى مزدوج. لكن أولاً، هناك الرسالة التي يقصدها المؤلف، ثم هناك المصادفة غير المرتبطة بالموضوع الذي لا يتشابه مع خبرتهم الشخصية الحالية.
على سبيل المثال، قد يسعى زوجين شابين لطلب مشيئة الرب بشأن وظيفتهما الحالية في منطقة جبلية في الولايات المتحدة، ورغبتهما في أن يذهبا عبر البحار لخدمة إرسالية في إحدى الجزر. وأثناء قراءتهما في الكتاب المقدس يكتشفان الأمر القائل: “كفاكم دوران بهذا الجبل” (تثنية 2: 3).
ويلي ذلك اكتشافهما لنبوة كتابية أخرى تقول: “وتنظر الجزائر شريعته” (إشعيا 42: 4). فماذا يمكن أن يكون توجيهاً أوضح لحياتهما الشخصية من تلك الكلمات ذات السلطان من الكتاب المقدس؟ فلا يهم عندها إن كانت الرسالة التي تلقوها ليست لها أية علاقة بالرسالة التي كان يقصد الكاتب توصيلها.
إنني لا أقول إن الله لم يقدم إرشادات مطلقاً من خلال مثل هذه المصادفات الجيدة، فهو ربما يستخدمها، كما يحدث في ظروف الحياة، مثل لقاء شخص بطريق “المصادفة”، والذي يصبح جزءًا مكملاً لإرشاد الله. لكن الكتاب المقدس لم يُعط لأجل هذا الغرض، وعندما نستخدمه بهذه الطريقة، زاعمين السلطة الكتابية أو تصديق الله على قراراتنا الشخصية، فإننا بذلك نسيء استخدامه.
كما يمكن للمصادفة أن تحدث كذلك كترتيب من العناية الإلهية من خلال الصحف اليومية، مفترضة مساراً ما للسلوك للشخص الذي يسعى لمعرفة مشيئة الله. لكن لا يمكن للمرء أن يزعم، في كلتا الحالتين، إعلاناً معصوماً من الخطأ لمشيئة الله، كمثل ما يمكنه أن يزعم بالنسبة لتعاليم مقطع كتابي قصد المؤلف توصيلها.
بل أن الكتاب المقدس يساء استخدامه بصورة أكبر إذا كانت هذه “الرسالة” السرية من الله تم استخدامها لاستبعاد تعليم واضح للكتاب المقدس – أو مبدأ كتابي، على سبيل المثال، يحظر المسار المقترح للسلوك. لأن الروح القدس لن يقول مطلقاً شيئاً من خلال كاتبي الكتاب المقدس، ثم يقوم بمناقضته أو تغييره بالنسبة للقارئ.
بكلمات أخرى، لن يقوم الله بإرشاد المسيحي من خلال فهم أو تطبيق للكتاب المقدس يبتعد بأي حال من الأحوال عما هو مكتوب. فإن لو قام بذلك، لن تكون هناك طريقة لمعرفة إن كان تفسيرنا هذا من الروح القدس، أم من ميولنا الخاطئة، أم من الشيطان، أم من باعث نفسي أو مادي آخر.
يجب أن يكون واضحاً أن الانطباعات الذاتية لا يمكن أن تتناقض مع تعاليم الكتاب المقدس، إن كنا نريد أن يكون الكتاب المقدس هو السلطة الوظيفية لتفكيرنا وسلوكنا.
لكن الخطر الأساسي من الاعتماد على الانطباعات الذاتية التي يثيرها الكتاب المقدس ليس أن تتناقض مع الكتاب المقدس، بل أن تمضي لمعان أكثر مما يقصده الكتاب المقدس، فتجد معاني لم يقصدها المؤلف على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بالمشورة والإرشاد الشخصي، ثم استخدام هذه الانطباعات بسلطة إلهية كما لو كانت كلمة الله المعصومة من الخطأ.
بمعنى أن استخدام الكتاب المقدس كوسيلة عادية للإرشاد الشخصي يروج لوهم “الحق المعلن” الذي يكون مستوى سلطته أعلى من سلطة ظروف العناية الإلهية الأخرى في الحياة، لمجرد أن هذا “الإرشاد” موجود في الكتاب المقدس.
لكن الكتاب المقدس يجب أن يستخدم للإرشاد “بطرق صحيحة”. وهذه الطرق الصحيحة تتكون من مشيئة الله المعلنة للسلوك البشري، التي تتفق مع المعنى الذي كان يقصده المؤلف. فعندما يكون للنص علاقة عرضية بالظروف الشخصية الحالية والقرار المبني على مثل هذا “الإعلان”، يمكن عندها للشخص أن ينادي فقط بانطباعه الذاتي الخاص عن إرشاد الروح القدس من خلال ظروف غير معتادة، وليس بسلطة الإعلان الكتابي.
إن الخطأ الأساسي في كل المناهج الأربع الخاطئة في التعامل مع الكتاب المقدس هو صفة الذاتية. ففي خاصية الذاتية، يصبح المفسر هو السلطة المطلقة النهائية للتفسير. وقد رأينا أن المنهج الطبيعي لتفسير الكتاب المقدس هو ذاتي، لأن المفسر يقرر مسبقاً ما هو المقبول في الكتاب المقدس، بحسب افتراضاته الطبيعية المسبقة. على أن النوع الأقل ظهوراً للذاتية، خاصة بالنسبة للذين يتأثرون به، هو الروحنة الذاتية.
يعتبر الإنجيليون أكثر عرضة لهذا الخطأ، ربما لأنهم يتعاملون بجدية مع العلاقة بين الروح القدس وكلمة الله. لا يمكن الاستغناء عن عمل روح الله في التفسير الكتابي السليم. فقد ألهم الروح القدس الأشخاص الذين كتبوا الكتاب المقدس، وهو الذي ينير أذهان المسيحيين الذين يقرأون هذه الكلمات بعد ذلك بقرون.
فالوحي أو الإلهام يعني أن الله كان يراقب تدوين الكتاب المقدس حتى آخر كلمة فيه. والاستنارة تعني أن الروح القدس يعمل الآن في المسيحي لكي يساعده على فهم ما هو موجود بالفعل في الكلمة، ويساعده على تطبيق الكلمة بطريقة أصيلة وصحيحة.
أعطانا الوحي إعلاناً لمشيئة الله بدون خطأ، بحسب ما يقر الكتاب نفسه. ولكن الكتاب المقدس لا يقر بمثل هذا الوعد بالنسبة للإستنارة أو الفهم أو التطبيق الذي يساعد عليه الروح القدس. فكما يعمل الروح القدس فينا لكي يجعلنا قديسين، ولكننا لسنا قديسين بعد، هكذا يعمل فينا أيضاً لكي ينير أذهاننا من خلال الكتاب المقدس، لكن نتيجة هذه الاستنارة ليست فهماً كاملاً، لأنها لو كانت كذلك، لاتفق جميع المفسرين الأتقياء معاً في تفسيراتهم.
فعندما يتعامل المفسر مع الاستنارة كأمر معصوم من الخطأ، تماماً كما يتعامل مع نص الكتاب المقدس، يكون عندئذ قد سقط في الذاتية. لأنه عندما يدعى شخص ما مثل هذه السلطة في تفسيره لمعاني الكتاب المقدس يكون أمراً سيئاً بما يكفي، لكنه عندما يدعي مثل هذا المستوى من السلطة في انطباعه الذاتي بخصوص الإرشاد الشخصي، فإنه يخطئ أكثر، لأنه يتجاوز معنى النص الموحى به.
هل هذا يعني أن التفسير السليم و”البركة” الذاتية هما أمران متبادلان؟ بالتأكيد! لأن استخدام مبادئ التفسير لفهم وتطبيق الكتاب المقدس بصورة أصيلة، وإدراك المعنى الذي يقصده الله، سوف يسر الله بالتأكيد، ولكنه سيأتي أيضاً بالبركة الشخصية لحياتنا. فالكتاب المقدس يجب أن يكون له علاقة موضوعية بحياتنا، وإلا لن يتحقق هدفه في تغييرها. لكن التشبه بالمسيح لن يتحقق عندما نجعل الله وكلمته يتفقان معنا. لكن عندما نكون نحن أنفسنا متفقين مع الله ومع كلمته.
هل يوجد أكثر من معنى واحد؟
هل لكل مقطع كتابي معنى واحد، أم أن هناك معان خفية يجب استخراجها من خلال اتباع قواعد خاصة في التفسير، أم من خلال الحدس المباشر بالروح القدس؟ يقدم لنا الكتاب المقدس أمثلة لكلمات تم إعلانها لشخص، ومعنى هذه الكلمات تم إعلانها لشخص آخر. فعلى سبيل المثال، في اختبار كل من يوسف ودانيال، أعطيت الرسالة اللفظية أو الرؤية لشخص، بينما التفسير قد أعطي لشخص آخر (تكوين 41؛ دانيال 2).
فهل هذا هو ما حدث في حالة الكتاب الذين كتبوا العهد الجديد وبالنسبة ليسوع نفسه؟ هل كان لمؤلفي العهد القديم معنى واحد في ذهنهم، بينما كان المؤلف (الله) الذي هو خلف أولئك المؤلفين يقصد معنى آخر أو إضافياً، كشفه لشخص آخر في العهد الجديد؟
يوجد على الأقل رأيان في هذا المسألة. يعتقد البعض أنه يمكن أن يكون هناك معنى واحداً فقط للمقطع الكتابي إذا كانت اللغة يعتمد عليها وكان إيصالها للمعنى ممكن. هؤلاء الناس لا ينكرون احتمال أن يكون هناك عدة تطبيقات للمعنى الواحد. بل الأكثر من ذلك، فهم لا ينكرون احتمال أن يكون هناك معنا آخر أشمل محتوى داخل الإعلان الأصلي.
على سبيل المثال، في المشكلة الصعبة الخاصة باقتباس متى بشأن دعوة ابن الله من مصر (متى 2: 14-15)، يشير هذا الاقتباس بوضوح إلى خروج إسرائيل من مصر (هوشع 11: 1). فكيف إذاً يشير متى بذلك إلى إقامة مريم ويوسف والطفل يسوع في مصر؟ ألا يوجد هنا معنى مزدوج؟ لذلك فإن من يعتقدون بأن هناك معنى واحد فقط، وأن ذلك المعنى كان هو القصد الواعي للمؤلف، يفهمون المقطع على أنه تصريح عن قصد الله تجاه الرب يسوع منذ البداية.
وأثناء عملية الإعداد لهذا الأمر، وكرمز لحقيقة أن يسوع المسيح كان سيأتي من مصر، سمح الله لشعبه إسرائيل أن تكون لهم إقامة هم أيضاً في مصر. فالحقيقة أنه في البداية، دعا الله أول شخص اختاره، إبراهيم، من مكان اقامته في مصر. لذلك فإنه منذ البداية، كان هناك معنى واحد هو المقصود. لكن التحقيق التام لذلك المعنى انتظر حتى مجيء الشخص الذي حققه بالكامل.
هناك آخرون يجدون صعوبة في مثل هذا الاتجاه, إذ أنهم يؤمنون أن هناك مقاطع معينة في الكتاب المقدس لا يمكن تفسيرها على أن لها معنى واحد؛ فمثل هذه المقاطع يمكن أن يكون لها أكثر من معنى واحد مقصود. فالمعنى الثاني (الخفي أو الأقل ظهوراً) كان يمكن أن يكون في ذهن المؤلف أو ربما كان فقط في ذهن الروح القدس، الذي أوحى للمؤلف.
في كلتا الحالتين، فإنهم يعتقدون أن المعاني الإضافية موجودة هناك بواسطة القصد الإلهي. فالروح القدس قام بترميز الرسالة، ثم قام في وقت لاحق بإعلان المعنى الثاني لها من خلال متحدث آخر ملهم من الله. (معظم الكتب المقدسة التي يوجد جدل حاد بشأنها تتضمن نبوات). لكن سنقوم بالتعامل مع هذه المشكلة بتعمق أكثر في الفصل 18.
لكن لا بد من التسليم بأنه أمر مشروع بالنسبة لمؤلف أن يكون له معنى ثاني أو خفي. فإن كان أوليفر ويندل هولمز، مؤلف “The One-Hoss Shay”، قصد أن يكتب بيت شعري ليس فقط عن تحطم عربة تجرها الخيول، لكن لكي يسخر من النظام الكالفيني، فقد كان هذا حقه. وإن قصد كاتب فكاهي أن يخفي رسالة سياسية في مؤلفه الفكاهي، فإن له الحق الكامل في أن يقوم بذلك. فالحقيقة أن هذه تقنية أدبية شائعة.
لكن هناك قاعدة واحدة يجب مراعاتها، وهي أنه إذا تنصل المؤلف عن معنى خفي، لا يمكن لشخص آخر بمنتهى الثقة أو السلطة أن ينسب له هذا المعنى الخفي. بكلمات أخرى، أن المؤلف نفسه هو الوحيد الذي يستطيع بصورة شرعية أن يعرف ذلك المعنى الثانوي. هذه هي الحال مع الكتاب المقدس. إذا تم التسليم بأن هناك معنى ثانوي في مقاطع معينة. فالروح القدس هو الذي أوحى للمؤلف وهو الذي أوحى فيما بعد بالتفسير لذلك المؤلف.
إن مسألة ما إذا كان المؤلف لديه معنى مباشر ومعنى آخر أشمل في ذهنه هي أمر معقد وشديد الأهمية بالنسبة لغرضنا هنا من إقامة افتراض أساسي لفهم الكتاب المقدس، أعتقد أن هذه المسألة تحتاج أن يتم حسمها. لأنه حتى لو اعتقد المرء أن هناك معنى واحداً فقط في المقطع، وأن المؤلف كان على وعي بهذا المعنى في البداية وفي المضمون النهائي، إلا أنه يجب علينا أن نتفق أن ليس أي إنسان يمكنه أن يميز ذلك المضمون الأشمل أو النهائي.
ومن ناحية أخرى، إذا اعتقد الإنسان أن هناك مقاطع معينة في الكتاب المقدس تم ترميزها عن عمد بمعنى مزدوج – أحدهما واضح والآخر سيتم التعرف عليه في وقت لاحق – مرة أخرى، ليس أي شخص يمكنه أن “يفك الشفرة” أو يجد ذلك المعنى الخفي.
هذه نقطة مهمة، فمهما كان الوضع الذي لدى الشخص فيما يخص بمسألة المعنى الخفي أو الثانوي في النبوات، أو المعنى الأشمل المقصود منذ البداية، فإن يسوع المسيح أو كتاب الكتاب المقدس الموحى لهم هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم أن يحددوا ذلك المعنى الثانوي أو الأشمل. فعندما تحدث المسيح، كان له كل الحق في تفسير المؤلف. نفس هذا الأمر يمكن أن يقال عن أولئك الرسل الذين خول لهم أن يعلنوا عن مشيئة الله من خلال العهد الجديد.
فأن ينسب الشخص معان خفية للكتاب المقدس، فإنه بذلك يفترض لنفسه سلطة مساوية أو لاغية لسلطة ذلك المؤلف. فالمفسر، سواء كان فرداً أو كنيسة، يعني بذلك أنه سلطة تعلو فوق سلطة الكتاب المقدس. لكن الكتاب المقدس يجب أن يكون هو السلطة النهائية المستقلة لما يقوله الله لشعبه.
صحيح أن الإعلان هو فوق طبيعي في محتواه وفي الطريقة التي أعطي بها، وأن الكتاب المقدس له تأثيرات فوق طبيعة في حياة الذين يقرأونه ويسمعونه. لكن الأداة في توصيل تلك الرسالة فوق الطبيعة هي طبيعة، فهي اللغة البشرية التي توصل كلمات مفهومة لما هو في فكر الله.
فإن كان هناك معنى خفي، فإن المؤلف البشري أو الله نفسه هما الوحيدان اللذان لديهما السلطة لتأكيد ذلك. لذلك فإن أبناء الله الذين يرغبون في معرفة مشيئته وعملها يجب أن يدرسوا باجتهاد لك يتمكنوا من التعامل بطريقة سليمة مع كلمة الحق. فيجب عليهم أن يبذلوا كل اجتهاد لكي يتعرفوا على المعنى الواحد المقصود للمؤلف، وليس أن يبحثوا عن معان خفية.
وعندما يقوم الرب يسوع نفسه أو أحد مؤلفي الكتب المقدسة بإظهار معنى خفي في النص الكتابي، فإننا نفرح بذلك، ولا نندهش، لأن الكتاب المقدس هو كتاب فوق طبيعي، وهناك مؤلف واحد (الله) خلف كل هؤلاء المؤلفين له. لكننا يجب أن نترك مثل هذا النوع من التفسير لمؤلفي الأسفار المقدسة، إذ أننا غير مخولين من الله لأن نكون متحدثين باسمه معصومين من الخطأ بإعلان إضافي.
مراجع مختارة لمزيد من الدراسة
أكرويد، بي آر، وسي إفي إفانز، محرران. The Cambridge History of the Bible Cambridge: U. Press 1970.
فارار، فريدريك دبليو. History of Interpretation. 1886 reprint. Grand Rapids: Baker, 1961.
جرانت، روبرت إم. A Short History of the Interpretation of the Bible. مع ديفي تريسي طبعة ثانية منقحة Philadelphia: Fortress, 1984.
“History of the Interpretation of the Bible” The Interpreter’s Bible.
New York: Abingdon-Cokesbury, 1952. 1:106-41.
سمولي، بيريل. The Study of the Bible in the Middle Ages. Notre Dame: U. of Nortre Dame, 1964.
وود، جيمس دي. The Interpretation of the Bible: A Historical Introduction. London: Duckworth, 1958.
[1] إس هوروفيتز، Midrash, Jewish Encyclopedia، 12 مجلد (New York: Ktav, 1904)، 8: 548.
[2] جيمس دي وود، The Interpretation of the Bible: A Historical Introduction (London: Ducworht, 1958)، صفحة 72.
[3] نفس المرجع. صفحة 87. انظر أيضاً بيمارد رام، Protestant Biblical Interpretation (Grand Rapids: Baker, 1870)، صفحة 54.
[4] آرثر دبليو بينك، Gleanings in Joshua (Chicago: Moody, 1978)، صفحة 102.