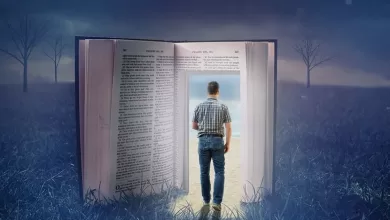نظرة لاهوتية وتاريخية عن الكتاب المقدس

ما هو الكتاب المقدس ؟ نظرة لاهوتية وتاريخية
المقدَّس والتاريخي
الكنيسة هي وحدة الحياة المواهبية، أمَّا مصدر هذه الوحدة فمحتجب في سرّ العشاء الربّاني وفي سرّ يوم الخمسيين الذي هو النزول الفريد لروح الحق إلى العالم. فالكنيسة إذن رسولية، لأنها خُلقت وخُتمت بالروح القدس في الاثني عشر. والتعاقب الرسولي هو خيط روحي سرِّي يصل الملء التاريخي لحياة الكنيسة باكتمال جامع. هنا نرى أيضاً وجهين: الوجه الموضوعي الذي هو التعاقب السرّي غير المنقطع والاستمرار الهيرارخي. فالروح القدس لا ينحدر على الأرض مرة تلو المرة، بل يقيم في الكنيسة التاريخية “المنظورة” وينفخ فيها ويرسل أشعته إليها. هذا هو ملء اليوم الخمسيني وجامعيَّته.
أمَّا الوجه الذاتي فهو الوفاء للتقليد الرسولي، أي العيش وفق هذا التقليد الذي هو عالم حيّ وحامل الحقيقة. هذا هو مطلب أساسي ومبدأ للفكر الأرثوذكسي، لأنه يفترض إنكار الانفصالية الفردية ويلحّ بقوة على الجامعيَّة. إن الطبيعة الجامعة للكنيسة تُرى بكل حيويَّة في كون خبرة الكنيسة تنتمي إلى كل العصور. ففي حياة الكنيسة ووجودها يتمّ تخطي الزمن والسيطرة عليه بشكل سرِّي، أو، إذا جاز التعبير، يبقى الزمن في توقف تام. وهذا لا يعود إلى قوة الذاكرة التاريخية أو إلى تخيُّل يقدر أن “يتجاوز حاجزي المكان والزمان”، بل إلى قوة النعمة التي تجمع في وحدة الحياة الجامعة ما فصلته الجدران التاريخية. فالوحدة في الروح تجمع بطريقة سرِّية قاهرة للزمن جميع المؤمنين في كل العصور.
وهي تظهر وتتجلَّى في خبرة الكنيسة وخاصة في خبرتها في سرّ الشكر، لأن الكنيسة هي الصورة الحيَّة للأبدية في الزمن. فالزمن لا يقدر أن يوقف خبرة الكنيسة وحياتها. والسبب ليس في استمرارية تدفُّق النعمة الذي يفوق الشخص فقط، بل في الدمج الكامل والجامع لكلّ ما كان موجوداً في الملء السرِّي للزمن الحاضر. لذلك لا يقدِّم تاريخ الكنيسة تغييراً متعاقباً فقط، بل وحدة وتماثلاً. بهذا المعنى الاشتراك مع القديسين هو “شركة القديسين” (communio sanctorum).
والكنيسة تعرف أنها وحدة العصور كلِّها وأنها تبني حياتها على هذه الشركة. فهي لا تفكر في الماضي وكأنه قد عبر وولَّى، بل على أنه أُنجز وتمَّ وهو موجود في الملء الجامع لجسد المسيح الواحد. والتقليد الكنسي يعكس هذا الانتصار على الزمن. إن التعليم من التقليد أو بالأحرى التعليم “في التقليد”، تعليم من ملء خبرة الكنيسة التي تقهر الزمن، والتي يقدر أن يتعرَّف إليها كلّ عضو في الكنيسة وأن يملكها وفقاً لقياس رجولته الروحية، ولنموِّه الجامع، أي أننا نتعلَّم من التاريخ مثلما نتعلَم من الإعلان. فولاؤنا للتقليد ليس ولاء لأزمنة ماضية ولسلطان خارجي، بل ارتباط حيّ بملء خبرة الكنيسة. إذن، العودة إلى التقليد لا تكون بحثاً تاريخياً، لأن التقليد لا يحصره علم آثار الكنيسة، ولأنه ليس شهادة خارجية يمكن أن يقبلها كل إنسان لا ينتمي إلى الكنيسة. الكنيسة وحدها هي الشاهد الحيّ للتقليد.
ونحن نقبله ونحسّ به كحقيقة لا تقبل الشك من داخل الكنيسة فقط، فهو شهادة للروح ولإعلانه غير المنقطع وبشارته. ما التقليد سلطة خارجية تاريخية لأعضاء الكنيسة الأحياء، بل هو صوت الله الأبدي المستمر، أي إنه صوت الأزلية لا صوت الماضي فقط. فالإيمان لا يجد أساسه في أمثولات الماضي ووصاياه فقط، بل في نعمة الروح القدس الذي يحمل الشهادة الآن وإلى أبد الآبدين.
يقول خومياكوف: “لا الأفراد ولا مجموعاتهم ضمن الكنيسة حفظوا التقليد أو كتبوا أسفار الكتاب المقدَّس، بل روح الله الذي يحيا في جسد الكنيسة كلَّه”. “موافقة الماضي” نتيجة لولائنا لهذا “الكل” وتعبير عن ثبات الخبرة الجامعة وسط أزمنة متغيِّرة. يجب أن نعيش في الكنيسة، وأن نعي حضور الرب الواهب نعمته فيها، وأن نحسّ بتنفس الروح القدس فيها حتى نقبل التقليد ونفهمه، لأن جسد الكنيسة جسده الذي لا ينفصل عنه.
ولذلك لا يكون الولاء للتقليد موافقة للماضي فقط، بل بمعنى من المعاني تحرُّر منه مثلما نتحرر من قياس خارجي شكلي. التقليد هو أولاً مبدأ تجدّد ونموّ، وليس فقط مبدأ للمحافظة على القديم والدفاع عنه، ولا مبدأ للنضال من أجل إعادة الماضي، بحيث يكون الماضي مقياساً للحاضر. هذا المفهوم يرفضه التاريخ نفسه ووعي الكنيسة أيضاً. التقليد سلطان للتعليم (potestas magisterii) وسلطان للشهادة للحق.
فالكنيسة لا تشهد للحق بالتذكّر أو بكلام الآخرين، بل بخبرتها الحيَّة المستمرَّ’ وبملئها الجامع… هذا هو “تقليد الحقيقة” (traditio veritatis) الذي تحدَّث عنه القديس ايريناوس (ضد الهراطقة 1، 10، 2). التقليد عنده يرتبط “بموهبة الحق الأصلية” (charisma veritatis certum) (ضد الهراطقة 4، 26، 2)، “وتعليم الرسل” ما كان مجرَّد مثل ثابت يجب أن نعيده ونقلِّده وكأنه ينبوع للحياة ووحي يبقى إلى الأبد من دون أن ينفد. فالتقليد سكنى الروح المستديمة لا تذكّر للكلام فقط. فهو مبدأ قائم على المواهب وليس مبدأ تاريخياً.
الخطأ هو أن نقيِّد “مصادر التعليم” بالكتاب والتقليد وأن نفصل الكتاب عن التقليد وكأن التقليد مجرَّد شهادة شفويّة أو تعليم الرسل. فكلاهما أُعطيا في الكنيسة وقُبلا بملء قيمتهما المقدَّسة ومعناهما، لأنهما يحويان حقيقة الإعلان الإلهي التي تعيش في الكنيسة. لكنَّ الكتاب والتقليد لا يستنفدان خبرة الكنيسة هذه، بل إنهما تنعكس فيهما فقط. ففي الكنيسة وحدها يحيا إذاً الكتاب ويُعلن من دون أن يجزَّأ ويصير نصوصاً متفرقة ووصايا وأمثالاً، أي إن الكتاب أُعطي في التقليد، لكنه لا يُفهم وفق أحكام التقليد فقط، وكأنه تدوين للتقليد التاريخي أو للتعليم الشهي، لأنه يحتاج إلى تفسير. فهو مُعلن في اللاهوت. وهذا يصبح ممكناً من خلال خبرة الكنيسة الحيّة فقط. لا نقدر أن نقول إن الكتاب المقدس يتمتع باكتفاء ذاتي، لا لأنه ناقص أو غير تام أو غير دقيق، بل لأنه في جوهره لا يدَّعي أنه هكذا. لكن نقدر أن نقول إن الكتاب نظام أوحى به الله أو أيقونة الحق وليس الحق نفسه.
والغريب أننا غالباً ما نضع حدّاً لحرية الكنيسة ككل من أجل توسيع حرية المسيحيين، أي إننا ننكر ونحدّ الحرية المسكونية والجامعة للكنيسة باسم الحرية الفردية، فتقيِّد حرية الكنيسة بمقياس كتابي ابتغاء تحرير الوعي الفردي من المتطلبات الروحية التي تفرضها خبرة الكنيسة. هذا رفض للجامعيَّة وتهديم للوعي الجامع. وهذا هو خطأ الإصلاح البروتستانتي. يقول دين اينج بدقة عن المصلحين البروتستانت: “وُصفت عقيدتهم بأنها رجوع إلى الإنجيل بروح القرآن. “عندما نعلن أن الكتاب مكتف بذاته نجعله عرضة لتفاسير غير موضوعية وكيفيَّة ونفصله عن مصدره المقدس.
فقد أُعطيِنَاه في التقليد، وهو مركزه الحيوي والمتبلور. إن الكنيسة التي هي جسد المسيح تتقدَّم الكتاب سرّياً، لأنها أكمل منه. وهذا الأمر لا يقلِّل من شأن الكتاب ولا يجعل صورته قاتمة، لكن المسيح لم يعلن الحقيقة في التاريخ فقط، لأنه ظهر وما زال يكشف عن نفسه لنا بثبات في الكنيسة التي هي جسده وليس في الكتاب فقط. في أيام المسيحيين الأوائل لم تكن الأناجيل المصدر الأوحد للمعرفة، لأنها كانت غير مدوَّنة بعد. لكنَّ الكنيسة عاشت وفق روح الإنجيل، بل إن الإنجيل نفسه برز إلى الوجود في الكنيسة عن طريق سرّ الشكر. فمن مسيح سرّ الشكر تعرَّف المسيحيون إلى مسيح الأناجيل. وهكذا صارت صورته حيَّة عندهم.
هذا لا يعني أننا نجعل الكتاب مصنَّفاً يناقض الخبرة، بل يعني أننا نجعلهما واحداً مثلما كانا منذ البدء. يجب ألا نفكر في أن كل ما قلناه ينكر التاريخ، لأننا نعترف بالتاريخ بكل واقعيته المقدَّسة. فنحن لا نقدِّم خبرة دينية ذاتية تناقض الشاهد التاريخي الخارجي، ولا وعياً سرياً فردياً، ولا خبرة لمؤمنين منعزلين، بل خبرة حيَّة كاملة للكنيسة الجامعة وللخبرة الجامعة وللحياة الكنسية. هذه الخبرة تشمل الذاكرة التاريخية أيضاً، فهي ممتلئة من التاريخ. وما هذه الخبرة تذكراً لأحداث قديمة فقط، بل رؤية لما تمَّ واكتمل ورؤية للانتصار السرِّي على الزمن ورؤية للجامعيَّة في كل زمان. الكنيسة تعرف عدميَّة النسيان. لذلك تصل خبرتها التي تهب النعمة إلى كمالها في ملئها الجامع.
هذه الخبرة لا يستنفدها الكتاب أو التقليد الشفوي أو التحديدات (الإيمانية)، ويجب ألاّ يستنفدها، ولا يمكن أن تستنفد، لأن الكلمات والصور يجب أن تتجدَّد في خبرتها، لا في “نفسانيات” (psychologisms) الشعور الذاتي، بل في خبرة الحياة الروحية. هذه الخبرة مصدر لتعليم الكنيسة. لكن لا تبدأ كلّ الأشياء في الكنيسة من أيام الرسل. وهذا لا يدلّ على أنه أُعلنت أمور “مجهولة” عند الرسل وأن كلّ ما هو متأخر يقل شأناً وإقناعاً. فكل شيء أعطاه الله وأعلنه منذ البدء. ففي يوم الخمسين اكتمل الإعلان ولذلك لن يقبل أي اكتمال آخر يوم الدينونة ويوم تحقيقه الأخير.
إن الإعلان الإلهي لم يتَّسع والمعرفة لم تزد. فالكنيسة اليوم لا تعرف المسيح أكثر مما كانت تعرفه في أيام الرسل. لكنها تشهد لأمور أكثر. وفي تحديداتها (الإيمانية) تصف الأمر نفسه من دون تغيير، لكن تبرز دائماً في الصورة التي لا تتغيَّر ملامح جديدة. لكن الكنيسة لا تعرف الحقيقة بصورة أقل أو بطريقة مختلفة عن معرفتها لها في الأيام القديمة. فوحدة الخبرة هي الولاء للتقليد. أمَّا الولاء للتقليد فلم يمنع آباء الكنيسة عن “خلق أسماء جديدة” (كما قال القديس غريغوريوس النزينزي) عندما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على الإيمان الذي لا يتبدَّل.
فكلّ ما قيل بعد ذلك كان من الملء الجامع، وهو مساوٍ في قيمته وقوته لكلّ ما نُطق به في البدء. وإلى يومنا هذا بقيت خبرة الكنيسة محفوظة ومثبَّتة في العقيدة دون أن تُستنفد. فهناك أمور كثيرة لا تثبِّتها الكنيسة في العقيدة، بل في الليتورجيا ورمزية الأسرار وفي التعابير الصورية التي تستعمل في الصلوات والاحتفالات والأعياد السنوية. إن الشهادة الليتورجية شرعية كالشهادة العقيدية. وأحياناً تكون ملموسية الرموز أكثر وضوحاً وحيوية من أي مفهوم منطقي، كما توحي صورة الحمل الرافع خطيئة العالم.
تخطئ النظرة اللاهوتية التي تدعو إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من الأشياء (minimalism) والتي تريد انتقاء التعاليم والخبرات الكنسية “الأكثر أهمية ووثوقاً وارتباطاً”. فهذا طريق خاطئ وطرح غير سليم للمسألة. طبعاً، لم تكن كلّ الأنظمة التاريخية في الكنيسة لها أهمية متساوية، ولم تكن كلّ أمورها التجريبية مقدّسة. فهناك أمور كثيرة تاريخية فقط. لكننا لا نملك مقياساً خارجياً لتمييزها، لأن مناهج النقد التاريخي الخارجي لا تكفي. فمن داخل الكنيسة فقط نقد أن نميِّز التاريخي وأن نميِّز المقدَّس. من داخلها نرى ما هو “جامع” وصالح لكلّ الأجيال وما هو مجرَّد “رأي لاهوتي” أو حتى حدث تاريخي عَرَضي. فالأهم في حيا الكنيسة هو كمالها وملء جامعيَّتها. وفي هذا الملء هناك حرية أكبر ممَّا في التحديدات الشكلية التي تقدِّمها النظرة التي تريد الاكتفاء بالحد الأدنى. ففي هذه النظرة نفقد أهمّ الأشياء أي الاستقامة والكمال والجامعيَّة.
أعطى مؤرخ كنسي روسي تحديداً ناجحاً جداً للصفة الفريدة التي تتحلّى بها خبرة الكنيسة فقال إن الكنيسة لا تعطينا منهجاً، بل مفتاحاً، لا تعطينا خارطة لمدينة الله، بل طريقة لدخولها. وقد يضلّ المرء بطريقه، لأنه لا يملك خارطة، لكنه يرى كلّ الأمور مباشرة وبواقعية وبلا وسيط. أمَّا مَنْ درس الخارطة فقط فجازف بالبقاء خارجاً من دون أن يجد شيئاً.
نقائص القانون الفكندياني
تبقى الصيغة الشهيرة التي قدَّمها فكنديوس الليرنسي (Vincent of Lerins) في وصفه طبيعة الجامعة لحياة الكنيسة غير دقيقة. فالصيغة تقول: “ما آمن به الجميع في كلّ مكان وزمان” (Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est). أولاً، إننا لا نعرف بوضوح إذا كان هذا المقياس تجريبياً أم لا. فإذا كان تجريبياً ثبت أنه خاطئ، لأنه عن أي “جميع” (omnes) يتحدَّث؟ وهل يجب أن نسال جميع المؤمنين عن إيمانهم، وحتى الذين لا يحسبون أنفسهم سوى مجرَّد مؤمنين؟ في جميع الأحوال يجب أن نقضي ضعفاء الإيمان والمشككين والثائرين على الإيمان. لكن هذا القانون لا يعطينا أي مقياس للتمييز والاختيار.
فالكثير من الخلافات تُثَار حول الإيمان، وأكثر منها حول العقيدة. فكيف نفهم عبارة “الجميع” (omnes)؟ ألا نكون متهوِّرين إذا ما عالجنا كلَّ الأمور المشكوك فيها وفق الصيغة التي نسبت خطأ إلى أوغسطين، أي إذا تركنا القرار “للحرية في الأمور المشكوك فيها” (in dubiis libertas). في الواقع، نحن لا نحتاج إلى أن نسأل جميع المؤمنين، لأن مقياس الحق تشهد له في أكثر الأحيان الأقلية. والكنيسة الجامعة قد تجد نفسها في يوم من الأيام “قطيعاً صغيراً” ولعلَّ اللاأرثوذكسيي الفكر سيكونون أكثر عدداً من الأرثوذكسيين. وقد ينتشر الهراطقة “في كل مكان” (ubique) وتنكفئ الكنيسة إلى خلفية التاريخ وتنسحب إلى الصحراء. وهذا ما حدث أكثر من مرة في التاريخ، ومازالت إمكانية حدوثه قائمة. ونقول بدقة إن في القانون الفكندياني نوعاً من الحشو والتكرار. فلفظة “الجميع” (omnes) يجب أن نفهمها وكأنها تشير إلى الأرثوذكسيين. في هذه الحالة يفقد هذا المقياس أهميته، إذ نكون قد عرَّفنا “الذات” (idem) “عن طريق الذات” (per idem).
وعن أية ديمومة وعن أي حضور كلِّي يتحدَّث هذا القانون؟ وبِمَ ترتبط لفظتا “المكان” (ubique)، و”الزمان” (semper)؟ هل ترتبطان بخبرة الإيمان أم بالتحديدات الإيمانية التي تشير إليها؟ في الحالة الأخيرة تكون هذه الصيغة خطيرة، لأنها تخفِّض الإيمان إلى حدّه الأدنى ولأن التحديدات العقيدية لا تفي بمقتضيات “المكان” (ubique)، و”الزمان” (semper) بدقة.
فهل يكون التقيُّد بحرف الكتابات الرسولية ضرورياً؟ يبدو أن هذا القانون فرضية للتبسيط التاريخي ولبدائية ضارّة، أي إنه يجب أن لا نبحث عن مقاييس خارجية وشكلية للجامعيَّة ولا نفسِّرها بموجب شمولية تجريبية. إن التقليد القائم على المواهب شامل لأنه يضمّ كل أنواع “المكان” و”الزمان” ويوحِّد “الجميع”، لكن قد لا يقبله الجميع عملياً. في جميع الأحوال يجب أن لا نبرهن حقيقة المسيحية عن طريق “قبول الجميع” (أو الإجماع) (per consensum omnium)، لأن “الإجماع” لا يُثبت عادةً الحقيقة. فتكون هذه العملية بمثابة حالة نفسية حادة تحتل مكاناً في الفلسفة أكثر من اللاهوت.
بل إن الحق نفسه هو المقياس الذي نقوِّم به أهمية “الرأي العام”. يقدر عدد قليل من الناس، ربما بعض المعترفين بالإيمان فقط، أن يعبِّروا عن الخبرة الجامعة، وهذا يكفي. ونقول بالتحديد إننا لا نحتاج إلى اجتماع عام ومسكوني، ولا إلى اقتراح أو تصويت، ولا حتى إلى “مجمع مسكوني” لكي نعبِّر عن الحقيقة الجامعة ونعترف بها. فالكرامة المقدّسة للمجمع لا تكون في عدد الأعضاء الذين يمثِّلون كنائسهم فيه. فقد يظهر مجمع “عام” كبير نفسه أنه مجمع لصوصي أو مجمعٌ مرتدّ عن الإيمان. وفي أكثر الأحيان يبطله “شتات الكنيسة” (ecclesia sparsa) بمعارضته الصامتة.
فعدد الأساقفة (numerus episcoporum) لا يحلّ المشكلة. إن الوسائل التاريخية والعلميَّة للاعتراف بتقليد مقدس وجامع قد تكون عديدة، ومنها دعوة المجامع المسكونية، إلى الانعقاد، ولكنَّها ليست الوسيلة الفريدة. هذا القول لا يشير إلى عدم ضرورة عقدة المجامع والمؤتمرات، فلعلّ الأقلية تحمل في كثير من الأحيان لواء الحق أثناء انعقاد المجمع، والأهم هو أن الحقّ يُعْلن في الكنيسة حتى من دون أن يلتئم أي مجمع.
وكثيراً ما تحمل آراء آباء الكنيسة ومعلِّمي المسكونة قيمة روحية أكبر من تحديدات بعض المجامع. فهذه الآراء لا تحتاج إلى إثبات أو إلى “إجماع” بل إنها المقياس وأداة البرهان. ولذلك تشهد الكنيسة لها بقبولها (receptio) الصامت. وأهميتها الكبرى هي في الجامعيَّة الداخليَّة، لا في شمولية تجريبية. نحن لا نقبل آراء الآباء كخضوع شكلي لسلطان خارجي، بل لأنها الدليل الداخلي على حقيقتها الجامعة. بل لأنها الدليل الداخلي على حقيقتها الجامعة. إن جسد الكنيسة كلّه له حقّ إثبات الأمور، بل له واجب الشهادة لصحتها. بهذا الروح كتب البطاركة الشرقيون منشور عام 1848 وقالوا إن “الشعب نفسه” (o laos)، أي جسد الكنيسة، هو “المدافع عن الدين” (hyperaspistis tis thriskias).
وقبل صدور هذا المنشور قال المتروبوليت فيلارت في كتابه عن التعليم المسيح، عندما أجاب عن هذا السؤال: “هل في التقليد المقدَّس كنز حقيقي؟” فقال: “إن الله يبني كلّ المؤمنين المتحدين جميعاً عبر الأجيال بواسطة تقليد الإيمان المقدس ليكونوا كنيسة واحدة. وهذه الكنيسة هي الكنز الحقيقي للتقليد المقدس أو عمود الحقيقة وقاعدته كما قال بولس الرسول” (1تيمو 3: 15).
إن قناعة الكنيسة الأرثوذكسية بأن الشعب بمجمله، أي جسد المسيح، هو “المدافع” عن التقليد والدين لا تقلِّل أبداً من قوة التعليم المعطاة للإكليروس. فهذه القوة المعطاة لهم هي وظيفة من وظائف الملء الجامع في الكنيسة. فهي قوّة تثبّت الإيمان وتوطّد التعبير عنه والنطق به وتقوّي خبرة الكنيسة التي حُفظت في الجسد كلّه. فالتعليم الذي يبشّر به الإكليروس هو فم الكنيسة: “إننا نركن إلى كلام المؤمنين، لأن روح الله ينفخ في كلّ واحد منهم”. لقد أُعطي لهم وحدهم أن يعلِّموا “بسلطان”، لأنهم لم ينالوا هذه القوة من جمهور المؤمنين، بل من رئيس الكهنة يسوع المسيح عندما وُضعت عليهم الأيدي. لكنَّ هذا التعليم تُعْرَف حدوده في تعبير الكنيسة كلّها. فالكنيسة مدعوة لأن تشهد لهذه الخبرة التي لا تُستنفد، لأنها رؤية روحية.
يجب على الأسقف في الكنيسة (episcopus in ecclesia) أن يكون معلِّماً، لأنه تسلَّم سلطان التكلُّم باسم القطيع. والقطيع تسلَّم حق التكلّم من خلال الأسقف. وعلى الأسقف أن يحتضن كنيسته وأن يظهر خبرتها وإيمانها، حتى يحقِّق هذا الأمر. وعليه أن لا يتكلَّم من عنده، بل باسم الكنيسة “وعبر إجماعها” (ex consensu ecclesiae). وهذا القول يناقض الصيغة الفاتيكانيَّة التي تقول: “من ذاته لا من إجماع الكنيسة” (exsese, non autem ex consensu ecclesiae).
إن الأسقف لا يتلَّقى قوة التعليم من رعيته، بل من المسيح عبر التعاقب الرسولي. لكن أُعطيت له قوة الشهادة للخبرة الجامعة التي لجسد الكنيسة. فهو يلتزمها، ولذلك يحتكم المؤمنون إلى تعليمه فيما يخص مسائل الإيمان. أمَّا واجب الطاعة فيزول عندما ينحرف الأسقف عن القاعدة الجامعة، فللشعب حقّ اتّهامه، وحتى حقّ خلعه.
حرية وسلطة
في الكنيسة الجامعة تزول الثنائية المؤلمة وينتفي التوتُّر القائم بين الحرية والسلطة، لأن السلطة الخارجية غير موجودة في الكنيسة. فالسلطة لا تقدر أن تكون مصدراً للحياة الروحية، لذلك تلجأ السلطة المسيحية إلى الحرية والإقناع عوضاً عن الإكراه، لأن الإكراه يبطل الوحدة الحقيقية في الفكر والقلب. لكنَّ هذا لا يدلُّ على أن كل ّ شخص قد تلقَّى حرية غير محدودة في التعبير عن رأيه الشخصي. “فالآراء الشخصية” يجب ألاَّ تكون موجودة في الكنيسة ولا يمكنها أن توجد فيها. وكلّ عضو في الكنيسة يواجه مشكلة مزدوجة.
أولاً، يجب أن يسود ذاته وأن يحرِّرها من حدوده النفسية وأن يرفع مستوى ووعيه إلى ملء القياس “الجامع”. ثانياً، يجب أن يفهم ويتحسَّس روحياً الاكتمال التاريخي لخبرة الكنيسة. إن المسيح لا يُعلن عن نفسه لأفراد منعزلٍ بعضهم عن بعض، ولا يقتصر عمله على توجيه مصيرهم الشخصي. فهو لم يأت إلى الخراف المبعثرة، بل إلى الجنس البشري بأجمعه. وهكذا يتمّ عمله في ملء التاريخ، أي في الكنيسة.
كلّ التاريخ مقدّس في معنى من معانيه، لكن تاريخ الكنيسة مأساوي أيضاً. فالجامعيَّة أُعطيت للكنيسة ولذلك كانت مهمتها الأولى أن تحقِّقها. الحقيقة لا تُدرك من دون ألم وجهاد، لأن تجاوز الذات والأخصّاء ليس أمراً سهلاً. والشرط الأول في البطولة المسيحية هو الانسحاق أمام الله وقبول إعلانه. وقد أعلن الله عن نفسه في الكنيسة. هذا هو الإعلان النهائي الذي لا يزول.
فالمسيح لا يُعلن نفسه لنا في عزلتنا، بل في علاقتنا الجامعة وفي اتحادنا. وهو يكشف عن نفسه ويُعلن أنه آدم الجديد ورأس الكنيسة ورأس الجسد. لذلك يجب أن ندخل حياة الكنيسة بتواضع وثقة وأن نحاول أن نكتشف أنفسنا فيها. ويجب أن نؤمن بأن ملء المسيح هو فيها وأن كل واحد منَّا أن يواجه صعوباته وشكوكه. لكننا نرجو ونؤمن بأن هذه الصعوبات ستنحلّ بجهد جامع موحَّد وبطولي وبعمل جريء. وكلّ عمل من أعمال الإلفة والوئام ممرّ نحو تحقيق الملء الجامع للكنيسة. وهذا يكون مرضياً في عيني الرب: “فأينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، كنت هناك بينهم” (متى 18: 20).