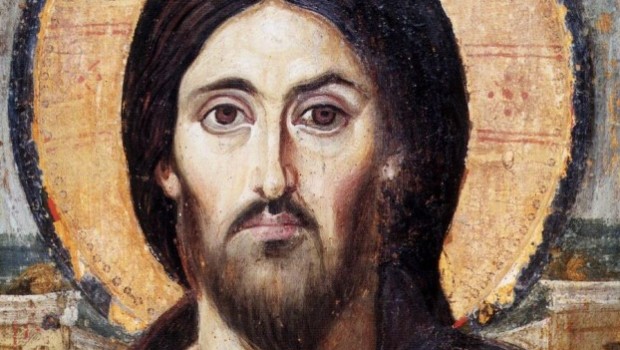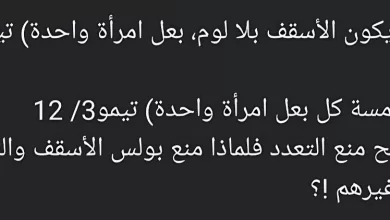حروب العهد القديم د. أوسم وصفي (صوت أونلاين)
حروب العهد القديم د. أوسم وصفي (صوت أونلاين)
حروب العهد القديم د. أوسم وصفي (صوت أونلاين)
حروب العهد القديم د. أوسم وصفي (صوت أونلاين)

لماذا نرى الله في العهد القديم في صورة رُبَّما تكون مختلفة عن التي نراها في العهد الجديد، فنراه في صورة “إله الحرب” و”رب الجنود” ونراه يأمر الشعب بالقتال، وتحريم بلاد بالكامل، أي إبادة كل حيّ فيها، وفي العهد الجديد نراه الإله الذي قد أَحَبّ العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد، والإله الذي يوصينا أن نُحِبّ أعداءنا ونبارك لاعنينا، ونصلي لأجل الذين يسيئون إلينا ويطردوننا.
ولتوضيح هذا الأمر سوف أتناوله تحت خمسة عناوين وهي:
- تخالف العدل والرحمة
- طبيعة العصر
- طبيعة المرحلة من تاريخ الفداء
- طبيعة الوحي
- السماح والمشيئة
تخالف العدل والرحمة
التخالف Paradox هو اجتماع أمران يبدوان متناقضين، لكنهما في واقع الأمر ليسا كذلك، بل بينهما جَدَلٌ يُحقِّق الاتزان، بحيث أنهما معاً يُنتجان الطاقة والحياة. التيار الكهربائي لا يسير سوى بقطبين سالب، وموجب، والحياة لا تستمر إلا بالجدل المستمر بين الذكورة والأنوثة. في شخصية الله هُناك جدلٌ مُستمرٌ بين الرحمة والعدل، ففي شخص الله، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما (مزمور 85: 10).
والله دائماً ما يُقَدِّم نحونا الرحمة لأننا خطاة ،فيقول المزمور التاسع والثمانون أيضاً مخاطباً الله: “الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك” أي أن الله يُبادر دائماً تجاهنا بالرحمة والأمانة، وطول الأناة والصبر، لكن في العدد السابق لذلك، يؤكد أن العدلَ والحق قاعدتيّ كرسيّ الله. فمن يأخذ من يد الله الرحمة والأمانة، ينجو، أما من يُصِرّ على التمرد والعصيان، فسوف يرتطم إن آجلاً أم عاجلاً بقاعدتي كُرسيّ الله: العدل والحق.
محبة الله وعلاقته بالبشر، مُتَّزنة جداً فيما يتعلق بالعدل والرحمة، أما نحن البشر الفاسدون الساقطون فلا نستطيع في أغلب الأوقات أن نحافظ على هذا الاتزان في مواقفنا وتعاملاتنا، فإما نجنَحُ إلى جانب الرحمة وننسى العدل، فتتحوَّل المحبة إلى تسيُّب تجاه جانب، وظلمٍ لجانب آخر، أو نجنح للعدل على حساب الرحمة فنقسو في العقاب ولا نُعطي فُرصة للتوبة والرجوع.
العهد القديم يؤكد دائماً أن ذلك الاتزان هو مفتاح شخصية الله وبه يتعامل الله مع كل البشر، سواء إسرائيل أو غيرها. وعندما أعلن الله عن نفسه وشخصيّته لموسى، ذكر ذلك الأمر بالتحديد، ففي سفر الخروج الأصحاح الرابع والثلاثين والأعداد السادس والسابع يقول: «الرَّبُّ إِلهٌ رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، بَطِيءُ الْغَضَبِ وَكَثِيرُ الإِحْسَانِ وَالْوَفَاءِ. حَافِظُ الإِحْسَانِ إِلَى أُلُوفٍ. غَافِرُ الإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْخَطِيَّةِ. وَلكِنَّهُ لَنْ يُبْرِئَ إِبْرَاءً. مُفْتَقِدٌ إِثْمَ الآبَاءِ فِي الأَبْنَاءِ، وَفِي أَبْنَاءِ الأَبْنَاءِ، فِي الْجِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابعِ من مُبغضيّ» مع أن الله طويل الروح وكثير الرحمة، لكنه لا يُبرئ إبراءًا يتغافل عن الحق، بل يفتقدُ ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع، من الذين يستمرون في بغضه والتمرد عليه. أي أنه ينتظر لأجيال قبل أن يُعاقِب.
أما بالنسبة للشعوب التي أمر الله شعب إسرائيل أن يحاربوهم، ويأخذوا أرضهم فقد كان ذلك عِقاباً عادلاً لشرٍّ مستمرٍ عاشته هذه الشعوب، وكان الرب قد صَبِرَ عليهم بالرحمة والأمانة قروناً طويلة وأجيالاً متعاقبة، لكنهم ظلوا على فسادهم وقسوتهم، حيث كانوا يقدمون أبناءهم وبناتهم ذبائحَ بشرية لآلهتهم، مثل مولوك وغيره.
لذلك كان القضاء على حياتهم الجسدية توقيفاً لهم من الاستمرار في غِيّهم الروحيّ جيلاً بعد جيل. وليس ذلك فقط، بل منعاً لهذا الشر من أن ينتشر، حيث كانت عبادات هذه الشعوب أيضاً تمتزج بممارسات جنسية، مثل عبادة عشتار ربة السماء، وغيرها من الممارسات التي رُبما كانت تُشَكِّل غوايةً للشعوب الأخرى المُحيطة ومنها شعب إسرائيل الذي كان يريد الله أن يُطَهِّره لنفسه شعباً خاصاً مُقَدَّساً ليُعلِن نفسه فيه لكل الأمم.
لم يعط الرب لبني إسرائيل أي تكليفٍ أو رُخصة لغزو العالم بالقوة،أو فتح البُلدان لنشر الإيمان بيهوه، وإنما كَلَّفَهم بمهمة معينة ومحدودة، يستخدمهم الله فيها كأداة لتحقيق عدالته، على سبيل المثال، في الأصحاح الرابع عشر من هذا السفر نقرأ في العدد التاسع: “إِنَّمَا لاَ تَتَمَرَّدُوا عَلَى الرَّبِّ، وَلاَ تَخَافُوا مِنْ شَعْبِ الأَرْضِ لأَنَّهُمْ خُبْزُنَا. قَدْ زَالَ عَنْهُمْ ظِلُّهُمْ، وَالرَّبُّ مَعَنَا. لاَ تَخَافُوهُمْ». قد زال عن هذا الشعب ظل الحماية التي يضعها الله على كل الشعوب، وذلك بسبب شَرِّهِم.
وكما أشرنا أيضاً إلى سفر التكوين في الأصحاح الخامس عشر، عندما قال الرب لأبرام أنه سوف يعطي نسله هذه الأرض، ولكن ليس الآن لأَنَّ ذَنْبَ الأَمُورِيِّينَ لَيْسَ إِلَى الآنَ كَامِلاً. لقد كان الله لا يزال يُعطي فرصة لهذا الشعب أن يتوب، مع معرفته السابقة، أن هذا الشعب لن يتوب بل يتقدَّم من سيءٍ إلى أسوأ.
والله في أمر العدالة لا يستثنى شعبه، فعندما تَلَوَّث شعبُ إسرائيل نفسه بأوثان الأُمم، استخدم الله شعوباً أخرى، بنفس الطريقة، مثل الآشوريين والبابليين لكي يطردوهم من الأرض ويسبونهم إلى آشور وبابل. صحيحٌ أن الله لم يأمر آشور وبابل بالقضاء على شعب إسرائيل تماماً، وذلك لأن الله لم يكن قد فقد الأمل فيهم تماماً، كما فقده في الآموريين وغيرهم من قبائل كنعان، الذين قال عنهم أن “ذنبهم قد اكتمل”، فالطبيب الحكيم يداوي ويُعالج، لكنه في وقتٍ ما عليه أن يبتر، حتى لا تتسبب القدم المُصابة بالغنغرينة في قتل الجسد البشريّ بأكمله.
طبيعة العصر
ليس من الإنصاف أو الموضوعية، أن نَحكُم على عصرٍ بمقاييس عصرٍ آخر. الحروب في تلك العصور القديمة، ونحن هنا نتكلم عن أكثر من ثلاثة آلاف سنة مَرّت، كانت في أغلب الأحوال حروب إبادة، خاصة وإن كان أحد أطرافها قبائل بدائية وليست ممالك مدنية مستقرّة تحترم العهود والمواثيق.
وكان نظام الغنائم والسبايا وغير ذلك، من القواعد المُتَّبَعة في الحروب، قبل تكوين جيوش نظامية مبنية على الوطنية وبها يتقاضى الجنود والضباط أجور وامتيازات غير متعلقة بالانتصار أو الهزيمة في الحروب. كما لم تكن هناك اتفاقية جنيف لتبادل أسرى، ولا الصليب الأحمر، ولا كُلّ هذه الأشياء، حيث لم تكن هناك تلك “القيمة” للإنسان التي صارت في البشرية، وخاصة بعد المسيحية[1]
ومن طبائع العصرِ أيضاً أنه كان يُنظَر للكيانات السياسية والدولية باعتبارها خليقة الآلهة وأدلةً حيةً على قوتها. بهذا يكون انتصار الرب “يهوه” على الكنعانيين شهادةً أمام العالم كله بأن إله شعب إسرائيل هو الإله الحقيقي الحي وصاحب الحق في المُطالبة بعرش الكون، كما أنه تحذيرٌ للأمم، بأن التقدم الحتمي لملكوت الله، سيطرد أخيراً جميع المقاومين له ويمنح الأرض لمن يعترفون بالرب، الإله الواحد ويعبدونه.[2]
بالطبع لم تكن هذه هي الطريقة الوحيدة لإظهار تَفَوُّق “يهوه” على هذه الأوثان، فبالأساس كان تَفَوُّقُ يهوه تَفَوُّقاً أخلاقياً، حيث أنه قد أعطى لشعبه شريعة أخلاقية ونظام راقٍ للعبادة وللعلاقات بين البشر، لكن في نفس الوقت كان ينبغي “مخاطبة هذه الشعوب” بلغتهم أيضاً التي لا تخلو من معايير القوة والسيادة.
طبيعة المرحلة من تاريخ الفداء
الكتاب المقدس ليس مُجَرَّد كتابٍ لإعلان حقائق أبدية مُطلقة، بقدر ما هو كتابٌ يحكي قصةَ تعامُل الله مع الإنسان ليأخذ بيده خطوة بخطوة في مسارٍ صاعدٍ من التطوُّر الروحي. وفي سفر التكوين نقرأ عن حقيقة محورية هامّة جدّاً لا يُمكن إغفالها ونحن نحاول أن نفهم أي شيء مُرتبط بالإنسان، أو أن نفهم طبيعة ما يُسمى بالتاريخ الفدائي، أو تاريخ فداء الله للإنسان. هذه الحقيقة هي حقيقة السقوط. فعصيان آدم وحواء في الجنة، لم يَكن مجرد “غلطة” أو هفوة، وإنما هو بداية حالة من السقوط وتغيير الطبيعة الصالحة التي خلق الله الإنسان عليها.
عندما عصي الإنسان أمر الله، انفصمت علاقة الطاعة والتواصل الحميم بين الله والإنسان، وتغيّرت بالتبعية طبيعة الإنسان. لكن رحمة الله، لم تسمح بإبادة الإنسان، وإنما بدأت معه سلسلةً من التعامل المُتدرِّج، بقصد افتداء الإنسان من هذه الطبيعة الخاطئة. وهذه السلسلة تَصِلُ في قِمّتها عند صليب المسيح، حيث يأخذ الله في نفسه هذه الطبيعة ويُميتها، لكي يفتح الباب للإنسان ليس فقط لاستعادة الطبيعة الصالحة التي خلقه الله عليها، وإنما أيضاً لإكسابه صورة أعلى وأقربً لطبيعة الله نفسه.
وكان، كما أشرنا مراراً من قبل، رمز الذبيحة، والعبادة بالذبيحة، مقصودٌ به، توصيل هذه الرسالة، وهي أن الطبيعة الإنسانية فاسدة، ولا يُمكن إصلاحها، وإنما سوف تتم إماتتها وإحياءها مرة جديدة.
ذبيحة المسيح، التي كان كل نظام الذبائح في العهد القديم يشير إليها، وقيامته بطبيعة إنسانية جديدة، صنعت فارقاً حاسماً في العمل الفدائي، فبذبيحة المسيح أُبطِلت الذبيحة الحيوانية الرمزية، وأصبح ممكناً لروح الله أن يسكن في الإنسان ويُغَيّره. لقد أصبح مُمكناً افتداء الإنسان وإصلاحه، من خلال الإيمان وسُكنى الروح القدس في المؤمن لتغييره من الداخل للخارج. أما في العهد القديم، عندما لم يكن هذا مُتاحاً، فيكون العلاج للعِصيان المُستمرّ، هو الاستئصال، لمنع انتشار الفساد في باقي الشعوب.
طبيعة الوحي
يجب أن نفهم طبيعة الوحي في الكتاب المقدس بشكل عام، فليس الكتابَ المُقَدَّسَ كلاماً “مُنَزَّلاً” من الله بصورة إملائية يكون الإنسان فيها مُتَلّقِّياً سلبياً (هذا باستثناء الوصايا العشر التي هي الكلام المُنَزَّل الوحيد المكتوب بإصبع الله) وإنما الكتاب المقدس هو سجلٌ لتعامل الله مع البشر عبر التاريخ الممتد لآلاف السنين. في هذا السجلّ، ليس كل ما هو مكتوبٌ أنه مشيئة الله، هو بالفعل مشيئة الله الحقيقية، بل كثيراً ما هو ما أدرك هؤلاء أنه مشيئة الله.
في رسالته الثانية لأهل كورننثوس، يُقدّم بولس الرسول مقارنة لإيضاح الفارق بين خدمة العهد القديم والعهد الجديد، فيما يتعلق بمدى وضوح رؤية الله، ومدى عُمق عمل روحه في الإنسان، فبالنسبة لوضوح رؤية الله، يتكلم عن “بُرقع موضوع على القلوب” يرى الإنسان من خلاله، رؤية بها قدرٌ من الحقيقة، لكنها ليست الحقيقة الكاملة. ثم يتكلم بعد ذلك عن “إشراق نورٍ من ظلمة” عندما يقول نَصاً في العدد السادس من الإصحاح الرابع: لأَنَّ اللهَ الَّذِي قَالَ:«أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ»، هُوَ الَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا، لإِنَارَةِ مَعْرِفَةِ مَجْدِ اللهِ فِي وَجْهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ.
الصورة الحقيقية لشخصية الله، هي في يسوع المسيح، وما نراه من صورة الله في العهد القديم، لا يُعَبِّر تماماً عن صورة الله، التي لا يُعَبِّرُ عنها بالتمام، إلا يسوع المسيح، وإنما تُعَبِّر عَمّا استطاع هؤلاء البشر أن يروه من الله في ذلك الوقت، من خلال بُرقع خطيتهم وصلابة رقابهم، وقد كان هذه الإعلان، في وقته، نقلة روحية هائلة، بالمقارنة بالحالة الروحية المُزرية التي كانت عليها الشعوب من حولهم. ربما نستطيعُ أن نقولَ مرة أخرى، أن الوحي الوحيد المباشر، المكتوب بإصبع الله والذي لم يمرّ من خلال طبيعة البشر، هو الوصايا العشر.
في نفس السياق، قال يسوع المسيح عن يوحنا أنه أعظم المولودين من النساء، لكنه أضاف أن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه، وذلك لأن يوحنا كان ينتمي إلى حقبة “أنبياء العهد القديم”، أما ملكوت الله الذي أسَّسَه المسيح بموته وقيامته وصعوده وحلول الروح القدس في المؤمنين، فهو “نقلة تطورية” روحية جديدة لا يُمكن مقارنتها بما سَبَقَها.
السماح والمشيئة
ليس كل ما يسمح الله به، يُسَرّ به. الحروب التي حدثت في العهد القديم، كانت حروب عادلة، وسمح الله بها، لأن هذه الشعوب كانت تُمارس، كما أشرنا، عبادةً وثنيةً شديدة الإيذاء للإنسانية. و في نفس الوقت عندما دخلت هذه العبادات لبني إسرائيل، سمح الله لبني إسرائيل بنفس العقوبة والسبي إلى آشور وبابل. عدالةُ الله قويّة، وحُكمه على الشرّ شديد، لكنه أبداً لا يكونُ سعيداً بذلك.
سمح الله في العهد القديم بالطلاق،على سبيل المثال، لكنه لم يكن سعيداً به، لذلك قال المسيح في العهد الجديد: بسبب قساوة قلوبكم، سمح لكم موسى أن تطلقوا نساءكم، لكن مُنذ البدء لم يكن هكذا (والبدء هنا هو في الجنة قبل السقوط والأكل من الشجرة المُحرمة)، فمنذ البدء كان الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسداً واحداً، فما جمعه الله لا يُفَرِّقُهُ إنسان.
عندما يُسمَح الآن بالطلاق، فذلك لأنه أحياناً يكون أفضل من علاقة زوجية مليئة بالشر والعنف، لكنه الله لا يُسر بالشر ولا بالعُنف، ولا بالطلاق الذي ربما يكون حلاً جزئياً له. الحلّ الذي يريده الله هو تغيير طبيعة الإنسان الروحية فيُحبّ، ليس فقط الزوج والزوجة، إن كانا مخطئين، بل حتى الأعداء. إن الله يريد للإنسان أن “يولد من جديد” في طبيعة تُحِبّ الآخر كالنفس، وعندما يُحِبّ الإنسان الآخر كالنفس، لن يكون هناك لا حربٌ، ولا طلاق. هذا يُمكن أن يحدث الآن فرديأً في أشخاص أتقياء، لكنه لن يكون عاماً في هذه الأرض.
ونفس الكلام عن الطلاق ينسحب على أمور كثيرة جداً في العهد القديم، سمح الله بها، لكنه لم يكن سعيداً بذلك. لم يكن سعيداً بالوثنية والشرّ، ولا بالحروب التي كانت عقاباً للوثنية والشرّ، لكنها كُلُها كانت، كما أشرنا سابقاً، “مرحلة” في التطوُر الروحي للبشرية.