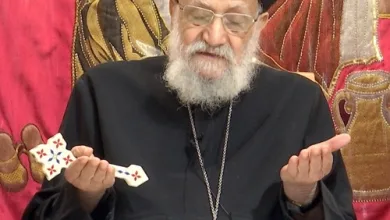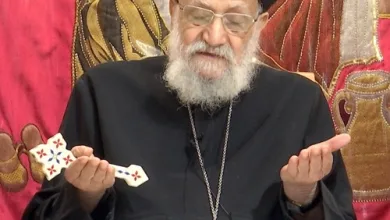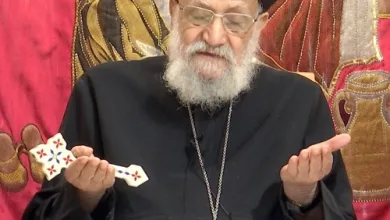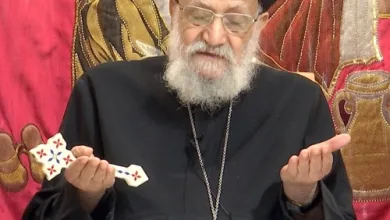تفسير العبرانيين 12 الأصحاح الثاني عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير العبرانيين 12 الأصحاح الثاني عشر - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير العبرانيين 12 الأصحاح الثاني عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير العبرانيين 12 الأصحاح الثاني عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
الجهاد
لما كان “كهنوت المسيح” هو الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة، حيث يقدم لنا الرسول السيد المسيح بكونه رئيس الكهنة الأعظم، جالسًا عن يمين الآب في السماء بكونها قدس الأقداس، يشفع فينا بدمه، ليدخل بنا إلى حضن أبيه، فقد ختم حديثه مؤكدًا أن هذه الشفاعة العجيبة لا توهب للمتكاسلين والمتراخين. لهذا بعد أن حدثنا عن الإيمان مقدمًا لنا أمثلة حية لرجال الإيمان، صار يحدثنا حديثًا مباشرًا عن التزامنا الحيّ، الذي بدونه لن ننعم بعمل السيد المسيح الكفاري.
- الجهاد وسحابة الشهود ١.
- الجهاد والتأمل في آلام المسيح ٢ – ٣.
- الجهاد حتى النهاية ٤.
- قبول التأديب الإلهي ٥ – ١١.
- مساندة الآخرين ٢ – ١٧.
- الناموس القديم والملكوت الجديد ١٨ – ٢٩.
- 1. الجهاد وسحابة الشهود
“لِذَلِكَ نَحْنُ أَيْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ مِنَ الشُّهُودِ مِقْدَارُ هَذِهِ مُحِيطَةٌ بِنَا،
لِنَطْرَحْ كُلَّ ثِقْلٍ وَالْخَطِيَّةَ الْمُحِيطَةَ بِنَا بِسُهُولَةٍ” [١].
إذ يحيط بنا الضعف فيمثل ثقلاً على النفس، تهاجمنا الخطية من كل جانب، لهذا يليق بنا أن نجاهد بغير انقطاع متطلعين إلى سحابة الشهود المحيطة بنا فنتمثل بهم في شهادتهم للحق. هذه السحابة هي “لنا” ليس فقط كمثالٍ نقتدي به لكنها “لنا” تسندنا بالصلاة لحسابنا.
يشبه الرسول القديسين بالسحابة لأنها مرتفعة إلى فوق، تتحول إلى مطرٍ لتروي الأرض. هكذا المؤمن الحقيقي يحيا في السماويات لكنه لا يتجاهل النفوس الضعيفة الملتصقة بالأرض والتي لها طبيعة التراب، إنما يصلي من أجلها لكي يستخدمه الله كمطر يروي الأرض بالبركات العلوية، فتأتي بثمر روحي كثير.
حينما يتحدث السيد المسيح عن مجيئه الأخير يؤكد أنه سيأتي على السحاب، وكأنه يأتي الرب جالسًا في قديسيه، السحاب الروحي المحيط به والحامل إياه. لنحيا كسحاب يطلب السماويات، دون تجاهل للأرض فنحمل ربنا يسوع فينا ونعلنه من يومٍ إلى يوم حتى يتجلى فينا بالكمال يوم مجيئه الأخير!
لكي تكون لنا شركة مع “السحابة من الشهود” التي لم يستطع الرسول أن يحدد قياسها، قائلاً: “مقدار هذه“، ولكي نصير نحن أنفسنا جزءًا لا يتجزأ من هذه السحابة الإلهية يلزمنا أن “ِنَطْرَحْ كُلَّ ثِقْلٍ وَالْخَطِيَّةَ الْمُحِيطَةَ بِنَا“، الأمور التي تفسد طبيعتنا وتحرمنا من التمتع بالخلقة الجديدة التي صارت لنا في المعمودية. ففي سفر إشعياء يتحدث النبي عن السيد المسيح القادم من مصر على سحابة خفيفة وسريعة (١٩: ١ – الترجمة السبعينية)، هذه التي تشير إلى السيدة العذراء عند هروبها إلى مصر حاملة السيد المسيح في حضنها، كما يقول القديس كيرلس الكبير، وفي نفس الوقت تشير إلى كل نفسٍ نقية وورعة تحمل يسوعها في داخلها وتسير به كسحابة سريعة خفيفة، لا يهدم ثقل الخطية طبيعتها ويعوق مسيرتها.
نشتهي أن نلتصق بالسحابة العظيمة من الشهود، الخفيفة والسريعة التي تحمل مخلصها مسرعة به، لا بالكلام والعاطفة فحسب، وإنما بالجهاد في الرب، إذ يكمل الرسول حديثه، قائلاً: “وَلْنُحَاضِرْ بِالصَّبْرِ فِي الْجِهَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا” [١]، أي لنسرع بالصبر إلى السباق الذي وُضع أمامنا لننال المكافأة. وكما يقول القديس أثناسيوس الرسولي: [مع وجود ضيقات مستمرة فإن “الضيق ينشئ صبرًا، والصبر تزكية، والتزكية رجاءً، والرجاء لا يخزي” (رو ٥: ٤). فإذ كان النبي إشعياء يتوقع مثل هذا الضيق صرخ بصوت عالِ وحثنا: “هلم يا شعبي ادخل مخادعك وأغلق أبوابك خلفك، اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب[1]” (إش ٢٦: ٣٠).]
يقول القديس چيروم: [في الوقت الحاضر نحن في وادي الدموع! هذا العالم هو موضع البكاء لا البهجة؛ يليق بنا ألاَّ نضحك. هذا هو العالم، إنه زمن الدموع، أما العالم العتيد فهو عالم الفرح… لقد دخل بنا الله كمصارعين في حلبة سباق حيث يكون نصيبنا على الدوام هو الصراع… إذن هذا الموضوع إنما هو وادي الدموع فلا نكون في أمانٍ (تراخٍ) بل كمن في حلبة صراع واحتمال للآلام[2].]
“َلْنُحَاضِرْ بِالصَّبْرِ فِي الْجِهَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا،
نَاظِرِينَ إِلَى رَئِيسِ الإِيمَانِ وَمُكَمِّلِهِ يَسُوعَ،
الَّذِي مِنْ أَجْلِ السُّرُورِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ
احْتَمَلَ الصَّلِيبَ مُسْتَهِينًا بِالْخِزْيِ،
فَجَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ اللهِ.
فَتَفَكَّرُوا فِي الَّذِي احْتَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنَفْسِهِ مِثْلَ هَذِهِ،
لِئَلاَّ تَكِلُّوا وَتَخُورُوا فِي نُفُوسِكُمْ” [١–٣].
إن كانت شهادة القديسين هي عون لنا في جهادنا، نمتثل بهم وننتفع بصلواتهم، مقاومين كمن في حلبة صراع لنلقي عنا كل ثقل أرضي وخطية محيطة بنا لنرتفع مع السحابة الإلهية إلى فوق، ويكون لنا شرف حمل الرب في داخلنا. فإن آلام السيد المسيح من أجلنا حتى الموت موت الصليب هي ينبوع نعم إلهية تسندنا في هذا الجهاد؛ أو كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [إن كانت آلام من هم قريبين منا تثيرنا للجهاد فأية غيرة لا يقدمها لنا سيدنا! أي عمل لا يحققه فينا!… حقًا إن آلام المسيح وآلام الرسل هي تعزية عظيمة حقيقية!… أيها الأحباء، الألم هو أمر عظيم يحقق أمرين عظيمين: يمسح خطايانا ويعطي قوة للرجال (الروحيين)[3].]
دعا الرسول السيد المسيح “رئيس الإيمان ومكمله“، فهو قائد المؤمنين في طريق الكمال الوعر، يدخل بهم إلى نفسه، لكي يعبر بهم من مجدٍ إلى مجد، فينعمون بالكمال أمام الآب خلال إتحادهم به.
آلام الصليب لا تُحتمل، وخزيه مرّ، لكنه في عيني السيد المسيح هو موضوع سرور وفرح، إذ يراه الطريق الذي به يحملنا إلى قيامته، ليجلسنا معه وفيه عن يمين العرش الإلهي. بالمسيح يسوع ربنا نفرح بالألم – بالرغم من مرارته القاسية – إذ نرى طريق الأقداس مفتوحًا أمامنا. احتمل السيد آلامه من أجلنا نحن الخطاة وليس من أجل نفسه، فكم بالحري يليق بنا أن نقبلها من أجل نفوسنا، خاصة وأننا نتقبلها في المسيح المتألم!
“لَمْ تُقَاوِمُوا بَعْدُ حَتَّى الدَّمِ مُجَاهِدِينَ ضِدَّ الْخَطِيَّةِ” [٤].
لم يقدم لنا الرسول هذه الوصية الخاصة بالجهاد الروحي حتى النهاية إلاَّ بعد أن قدم لنا أمثلة عملية وحية لمؤمنين مجاهدين من آباء بطاركة وأنبياء وقضاه وملوك، وأوضح لنا إمكانية الجهاد، إذ نحن محاطون بسحابة الشهود العاملين معنا، وفوق الكل أوضح عمل السيد المسيح المصلوب في حياتنا. لقد قبل الآلام بسرور مستهينًا بخزي الصليب، الأمر الذي يجعل جهادنا الروحي حتى الموت مقبولاً ومفرحًا. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [إلى الآن لم تحتملوا الموت، إنما امتدت خسارتكم عند المال والكرامة والطرد من موضع إلى آخر. على أي الأحوال، لقد بذل المسيح دمه من أجلنا، أما أنتم فلم تفعلوا هذا لأجل أنفسكم. لقد صارع من أجل الحق حتى الموت من أجلكم، أما أنتم فلم تدخلوا بعد في المخاطر التي تهدد بالموت[4].]
مادمنا أولاد الله، فإن الله يسمح لنا بالتجارب والضيقات أثناء الجهاد على الأرض، لا للانتقام ولا للدينونة وإنما لمساندتنا. فهو يعيننا لا بلطفه بنا فحسب خلال الترفق، وإنما أيضًا بتأديبنا لأجل نفعنا الروحي. فالضيقة بالنسبة للمؤمن الحقيقي المجاهد قانونيًا هي علامة حية لاهتمام الله به من أجل بنيانه.
“وَقَدْ نَسِيتُمُ الْوَعْظَ الَّذِي يُخَاطِبُكُمْ كَبَنِينَ:
يَا ابْنِي لاَ تَحْتَقِرْ تَأْدِيبَ الرَّبِّ،
وَلاَ تَخُزْ إِذَا وَبَّخَكَ.
لأَنَّ الَّذِي يُحِبُّهُ الرَّبُّ يُؤَدِّبُهُ، وَيَجْلِدُ كُلَّ ابْنٍ يَقْبَلُهُ” [٤-٦].
كثيرًا ما علق آباء الكنيسة على هذه العبارة الرسولية نقتطف منها:
- مغبوط هو الإنسان الذي يؤدَب في هذه الحياة، فإن الرب لا يعاقب عن الشيء مرتين (نا ١: ٩ – الترجمة السبعينية[5]).
القديس چيروم
- عندما يوبخ الله، وإنما لكي يصلح، ويصلح لكي يحفظنا (له) [6].
القديس كبريانوس
- لا ترجع النفس إلى الله إلاَّ إذا انتزعت عن العالم، وليس شيء ينتزعها عنه بحق إلاَّ التعب والألم؛ حين تكون النفس ملتحمة بملذات العالم التافهة الضارة والمهلكة… نتحول بسبب هذه التأديبات عن ضعفنا، إذ يليق بالإنسان أن يدرك أنه يتألم بسبب الخطية. ليته يرجع إلى نفسه ويقول: “أنا قلت في قلبي: ارحمني يا رب، اشفِ نفسي، فإني أخطأت إليك” (مز ٤١: ٤). بالضيق يا رب دربني، إذ تجلد كل ابن تقبله، ما عدا الابن الوحيد الذي وحده بلا خطية… أما أنا فأقول لك: “يا رب أخطأت[7]“.
القديس أغسطينوس
- الأب لا يهذب ابنه لو لم يحبه، والمعلم الصالح لا يصلح من شأن تلميذه ما لم يرَ فيه علامات نوال الوعد. عندما يرفع الطبيب عنايته عن مريض، يكون هذا علامة يأسه من شفائه.
- أيهما أفضل أن ندخل معركة (التأديب) إلى حين ونحمل أوتاد الحسكة (أسياخ من الخوازيق)، وتكون معنا أسلحة، ونرهق من حمل التروس الثقيلة، لكي نفرح بعد ذلك خلال الغلبة، أم نبقى عبيدًا إلى الأبد، لأننا لم نقدر أن نحتمل ساعة واحدة[8].
القديس چيروم
- لا تستطيع القول بأن إنسانًا بارًا يعيش بلا ضيق، حتى وإن لم يظهر عليه الضيق… إذ يلزم بالضرورة لكل بار أن يجتاز الطريق. هذا هو إعلان المسيح، أن الطريق الواسع العريض يؤدي إلى الهلاك، أما الضيق الكرب فيؤدي إلى الحياة (مت ٧: ١٣ – ١٤)… هل لأنك تعاني من أتعاب كثير تظن أن الله تركك، وأنه يبغضك؟! إن كنت لا تتألم يكون بحق قد تركك، لأنه إن كان الله يؤدب كل ابن يقبله، فمن لا يسقط تحت التأديب لا يكون ابنًا… ماذا نقول؟ ألا يسقط الأشرار تحت الضيق؟ حقًا يسقطون… هم ينالون عقاب شرهم ولا يؤدبون كأبناء[9].
القديس يوحنا الذهبي الفم
التأديب هو علامة البنوة، فالآب يهتم ببنيان ابنه الشرعي، ولا يبالي بالنغول: “وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِلاَ تَأْدِيبٍ، قَدْ صَارَ الْجَمِيعُ شُرَكَاءَ فِيهِ، فَأَنْتُمْ نُغُولٌ لاَ بَنُونَ” [٨]. وكما قال القديس يوحنا الذهبي الفم: [إن كان عدم التأديب علامة خاصة بالنغول، إذن يليق بنا أن نفرح بالتأديب كعلامة شرعية بنوتنا[10].]
يقارن الرسول بين التأديب الذي نخضع له من آبائنا في الجسد والتأديب الذي يقع علينا من أبينا السماوي موضحًا النقاط التالية:
أولاً: أن التأديب يُعطي للآباء الجسديين مهابتهم، فالطفل يهاب والده بكونه المربي الحازم؛ “ثُمَّ قَدْ كَانَ لَنَا آبَاءُ أَجْسَادِنَا مُؤَدِّبِينَ، وَكُنَّا نَهَابُهُمْ. أَفَلاَ نَخْضَعُ بِالأَوْلَى جِدًّا لأَبِي الأَرْوَاحِ، فَنَحْيَا؟” [٩]. هنا يؤكد الرسول عنصرًا هامًا وهو “المخافة الأبوية” فإننا وإن كنا أبناء الله، بذل الله أبونا ابنه الوحيد فدية عنا، وارتفع الابن عن يمينه ليشفع فينا، هذا يبعث فينا الدالة القوية لدى الله، فإن التأديب يهب الابن مخافة نحو أبيه تمتزج بالدالة، حتى لا تتحول الدالة إلى استهتار. لكن شتان بين المخافة التي تنطلق في قلب الابن والمخافة الممتزجة بالرعب في قلب الأجير أو العبد. الابن يخاف أباه لئلا يجرح مشاعره ويسيء إلى أبوته، أما الأجير فيخاف لئلا يُحرم من الأجرة، والعبد يخاف من العقاب.
ثانيًا: آباؤنا الجسديون يؤدبوننا أيامًا قليلة حسب استحسانهم [١٠]، مشتاقين أن يروننا ناجحين في هذا الزمان الحاضر، نحقق أمنياتهم الزمنية فينا، أما الله فيؤدب لهدف أعظم: لأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. هذه هي غاية تأديبه لنا، إذ يود أن يرانا شركاء في حياته المجيدة، نحمل سماته فينا، نتشبه به. هذه هي غاية الله من الإنسان، أن يراه كابن يحمل صورة أبيه.
ثالثًا: ” كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي الْحَاضِرِ لاَ يُرَى أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِ” [١١]. فالابن يئن تحت ألم التأديب، لكن متى بلغ النضوج أدرك أن التأديب هو سرّ نجاحه وبهجة قلبه الأكيدة. هكذا تأديب الله لنا يقدم لنا في البداية نوعًا من الحزن، لكنه في نفس الوقت يهب ثمر برّ السلام. به ندخل إلى برّ المسيح المجاني فيمتلئ قلبنا سلامًا فائقًا. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [الذين يتناولون الدواء المرّ يخضعون أولاً لشيء من الامتعاض لكنهم يشعرون بالراحة بعد ذلك… هذا أنتم تتألمون، هكذا هو التأديب في بدايته… فإنه كل تأديب يبدو للحزن مع أنه في حقيقته غير ذلك[11].]
أحد العناصر الهامة في الجهاد الروحي هو مساندة الأعضاء بعضها لبعض، فالحياة مع الله وإن كانت تمثل علاقة شخصية خفية بين الله والمؤمن لكن ليس في فردية منعزلة، إنما هي حياة شركة بين الله وكنيسته الواحدة. كل عضو يسند أخاه في الرب، لكي يتشدد الكل معًا كعروسٍ واحدة. يقول الرسول: “لِذَلِكَ قَّوِمُوا الأَيَادِيَ الْمُسْتَرْخِيَةَ وَالرُّكَبَ الْمُخَلَّعَةَ” [١٢]. ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم قائلاً: [ليس شيء يجعل البشر ينهزمون سريعًا في التجارب وينهارون مثل العزلة. اخبرني، بعثر فرقة في حرب، فإن العدو لا يقلق في سبيهم وأسرهم كفرادى[12].]
الآخرون بالنسبة لك كما يشبههم الرسول هم الأيدي والركب، فإنك لا تستطيع أن تقاوم العدو الشرير إبليس إن كان الأيدي مسترخية والركب مخلعة، فكل مساندة من جانبك لأخيك إنما هي مساندة لك أنت شخصيًا لأنه يمثل يديك وركبك! لهذا لا عجب إن ضعف الرسول بولس مع كل ضعيف، والتهب قلبه محترقًا مع عثرة كل إنسان، ويفرح ويتهلل مع توبة الغير!
تقويم الأيادي المسترخية والركب المخلعة لا يكون بمساندة الآخرين بالكلمات النظرية وإنما بالحياة العملية الداخلية والسلوك الروحي الحيّ، إذ يكمل الرسول قائلاً: “اِتْبَعُوا السَّلاَمَ مَعَ الْجَمِيعِ، وَالْقَدَاسَةَ الَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ الرَّبَّ. مُلاَحِظِينَ لِئَلاَّ يَخِيبَ أَحَدٌ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ. لِئَلاَّ يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ وَيَصْنَعَ انْزِعَاجًا، فَيَتَنَجَّسَ بِهِ كَثِيرُونَ” [١٤-١٥]. هنا يركز الرسول على سمتين هامتين في الجهاد، تسندان النفس وتعينا الآخرين، هما إتباع السلام مع الجميع والتمتع بالحياة المقدسة. فمن جهة إتباع السلام، فالمؤمن إذ يدرك مركزه كعضوِ في الجسد المقدس بل وفي البشرية كلها يعمل بروحٍ متناسقٍ مع الجميع خلال الرأس المدبر، يحتمل ضعف الآخرين من أجل بنيان الجماعة وسلامه الداخلي ولدفع الضعيف بالحب نحو التوبة. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [احتمال الشر هو أعظم سلاح في التجارب. به يجعل المسيح تلاميذه أقوياء، إذ يقول: “هذا أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات، وبسطاء كالحمام” (مت ١٠: ١٦)… فإنه ليس من شيء يُخجل من يصنع معنا شرًا مثل احتمالنا ما يجلبه علينا بلطف وعدم النقمة بكلمةٍ أو فعلٍ. هذا يجعل منا فلاسفة (حكماء)، ويجلب لنا مكافأة عظيمة، وفي نفس الوقت ينفع من صنع معنا شرًا[13].] أما من جهة الحياة المقدسة، فهي ترتبط بإتباع السلام وتلازمه. الحب الحقيقي الذي يعمل فينا لإتباع السلام هو بعينه يعمل فينا للتقديس بالرب يسوع القدوس. من يحب إخوته بصدقٍ في المسيح يسوع مشتهيًا خلاصه، لا يمكن أن يقبل الحياة الشريرة، بل يحب القداسة ويتفاعل معها. حبنا لإخوتنا أيضًا يفتح أبواب النعمة أمامنا لننهل منها شركة الحياة المقدسة في الرب.
ما هو إتباع السلام إلاَّ دخول في شركة عملية مع السيد المسيح محب البشر وملك السلام! هذه الشركة هي بعينها الحياة المقدسة. يقول القديس چيروم: [المسيح هو القداسة التي بدونها لا يقدر أحد أن يعاين وجه الله. المسيح هو خلاصنا، إذ هو المخلص والفدية في نفس الوقت. المسيح هو كل شيء بالنسبة لنا، فمن يترك شيئًا من أجله يجده مقابل ما قد تركه، فيستطيع في حرية أن يقول “نصيبي هو الرب” (مز ١٢٣: ٦)[14].]
أما علة السقوط في الحياة الروحية والعجز عن الجهاد فهو الاستباحة والاستهتار، فيكون مصير الإنسان هو مصير عيسو الذي طلب أن يرث البركة بدموع، لكن لم تجد التوبة لها مكانًا في قلبه الذي تدرب على الاستباحة، فقد تبلدت حواسه ولم يجد للندامة موضعًا فيه، يقول الرسول: “لِئَلاَّ يَكُونَ أَحَدٌ زَانِيًا أَوْ مُسْتَبِيحًا كَعِيسُو، الَّذِي لأَجْلِ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُورِيَّتَهُ. فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرِثَ الْبَرَكَةَ رُفِضَ، إِذْ لَمْ يَجِدْ لِلتَّوْبَةِ مَكَانًا، مَعَ أَنَّهُ طَلَبَهَا بِدُمُوعٍ” [١٦-١٧]. كما أن كل حب يوّلد حبًا وكل جهاد روحي يلهب القلب إلى جهاد أعظم في الرب، فإنه كل استباحة تود استباحة، وكل تهاون يخلق تهاونًا… حتى تفسد حياة المؤمن تمامًا وتفتر أحاسيسه الداخلية، ويشتهي الحياة المقدسة السابقة، لكن في تراخِ بلا توبة صادقة. هذه الخبرة حدثنا عنها الآباء فحذرونا من الثعالب الصغيرة والخطايا التي تبدو تافهة، فإن عدو الخير لا يحارب الإنسان المؤمن بخطايا واضحة إلاَّ بعد أن يتسلل إلى قلبه خلال التهاون في الصغائر، حتى متى أفسد القلب الداخلي يهاجمه بكل أنواع الخطايا، فيسقط فيما كان يظن أنه يستحيل ارتكابه. فداود النبي العظيم صاحب القلب النقي والمرتل لله على الدوام استهان قليلاً، فخرج على السطح عوض أن يشترك مع جيشه في الحرب بالصلاة والتذلل؛ هذا التهاون البسيط فتح المجال للنظر إلى امرأة أخيه في الرب وقائد جيشه، وهكذا انخرط من ضعفٍ إلى ضعف حتى سقط تمامًا في فخ إبليس… لكن الرب لم يتركه!
كما يتسلل العدو إلى قلبك خلال الصغائر، اسحب قلبك إلى الجهاد الروحي خلال الصغائر… فمن التداريب الجميلة الروحية حينما يشعر المؤمن بالتراخي أنه يقول في نفسه لأجاهد اليوم وأستريح غدًا، وإذ يقضي يومه يلتهب قلبه بالأكثر نحو الله، فيعود يكرر نفس القول وهكذا يسحب قلبه إلى الحياة السماوية العالية خلال جهاد بسيط في اللحظة الحاضرة، ولا يضع أمام نفسه خططًا لفترة طويلة، كما لا يؤجل للغد عمل الرب.
إذ أراد الرسول تأكيد فاعلية وصية العهد الجديد وبركات الملكوت الجديد قارن بين طريق استلام الناموس في العهد القديم على يديّ موسى النبي على جبل سيناء وتقبل الكلمة الإلهي ذاته في العهد الجديد.
أولاً: عندما تسلم موسى الناموس اضطرم الجبل الملموس بالنار بطريقة مادية واضحة وظلام وحدثت زوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، الأمر الذي جعل الشعب يستعفي من السماع لله مباشرة، ولم يكن ممكنًا حتى للحيوانات أن تقترب من الجبل وإلا رُجمت أو رُميت بالسهام دون أن يلمسها أحد! هكذا كانت العلاقة بين الله والإنسان مرعبة وغامضة، أما في العهد الجديد فلا نرى شيئًا من هذا إذ التحم كلمة الله بنا خلال تجسده فلم يعد هناك رعب ولا غموض.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على ذلك، قائلاً: [لم يُعط العهد الجديد ومعه هذه الأمور (النار والضباب والعاصف وأصوات البوق) وإنما قُدم إلينا حديثًا بسيطًا من قبل الله… كانت هذه الأمور مرعبة حتى لم يحتملوا سماعها، ولا تتجاسر حتى أية بهيمة أن تصعد؛ أما ما جاء بعد ذلك فلم يكن هكذا، لأنه ماذا تكون سيناء بالنسبة للسماء؟ والنار الملموسة بالنسبة لله الذي لا يُقترب إليه، إذ هو نار آكلة؟[15]]
هذه الأمور التي ظهرت مع استلام الناموس تكشف عن سماته؛ فالنار تشير إلى عقاب العصاة الرهيب، والضباب والظلام علامة الغموض وعدم الكشف عن الحق في كماله وإنما خلال الظل والرمز. وأصوات الأبواق تشير إلى طبيعته كإعداد لمجيء الملك السماوي كما في اليوم الأخير (١ كو ١٥: ٥٢). ويشير العاصف إلى الشعب المستكين المحتاج إلى عاصف ليوقظه من سباته الروحي وتراخيه.
في دراستنا لسفر الخروج تحدثنا في أكثر من تفصيل عن رموز هذه الأمور الروحية لحالة النفس الداخلية حين تتقبل كلمة الله فيها. تصير كالجبل الراسخ الملتهب بالنار الإلهية المتقدة، تحيط بها الأسرار الإلهية كضباب، ويُسمع فيها أصوات البوق معلنة الحق بحياتها الداخلية وسلوكها الَظاهر، تهب فيها عواصف الروح التي تحطم كل شرٍ تسلل إليها؛ هذا وكل بهيمة، أي كل فكر حيواني يقترب إليها يُرجم بحجارة الحق ويُضرب بسهم الصليب فلا يكون له موضع في داخلها.
ثانيًا: لم تقف حالة الرعب عند الشعب وإنما مست موسى النبي نفسه، إذ “قَالَ مُوسَى: أَنَا مُرْتَعِبٌ وَمُرْتَعِدٌ!” [٢١]. أما الآن فالكلمة قريبة منا، في داخل القلب، إذ دخل “الكلمة الإلهي” في حياتنا، وصار له مسكنًا فينا.
ثالثًا: عند استلام الشريعة الموسوية كان الشعب في البرية عند سفح الجبل، وكأن الناموس قد عجز عن أن يقدم للشعب الحياة السماوية المرتفعة، ويدخل بهم إلى أورشليم العليا، أرض الموعد. أما في العهد الجديد، فدخل بنا كلمة الله إلى السماوات عينها، وجعل منا محفل ملائكة: “بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَإِلَى مَدِينَةِ اللهِ الْحَيِّ: أُورُشَلِيمَ السَّمَاوِيَّةِ، وَإِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ مَحْفِلُ مَلاَئِكَةٍ، وَكَنِيسَةِ أَبْكَارٍ مَكْتُوبِينَ فِي السَّمَاوَاتِ، وَإِلَى اللهِ دَيَّانِ الْجَمِيعِ، وَإِلَى أَرْوَاحِ أَبْرَارٍ مُكَمَّلِينَ” [٢٢–24].
يرى العلامة أوريجينوس في السماء التي ننعم بها أربع رتب هي: جبل صهيون، مدينة الله أورشليم السمائية، ربوات هم محفل ملائكة، كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. أعلى هذه الدرجات هي العضوية في كنيسة الأبكار حيث ينعمون بالشركة مع المسيح البكر. إذ يقول: [اجتهد بكل قوتك أن تنمو وتتقدم في أعمالك وحياتك وعاداتك وإيمانك وطريقة تصرفاتك حتى تبلغ كنيسة الأبكار المكتوبين في السماوات، فإن لم تستطع فلتبلغ إلى درجة أقل… وإن كنت لا تقدر أن تقترب من الربوات الذين هم محفل ملائكة وتصعد إلى هذه الدرجة فعلى الأقل تبلغ مدينة الله الحيّ أورشليم السماوية، وإن كنت غير قادر على بلوغ هذه فحاول على الأقل أن تتجه نحو جبل صهيون لكي تخلص على الجبل (تك ١٩: ١٧). يكفي أنك لا تبقى على الأرض ولا تسكن الوديان ولا تبطئ في المناطق المطمورة[16].]
على أي الأحوال في العهد الجديد دخلنا إلى ملكوت الله المجيد، حيث يرتفع بنا إلى جبل صهيون الحق، وننعم بأورشليم العليا ونُحسب محفل ملائكة وأبكار للرب. وكما يقول القديس أثناسيوس الرسولي: [من لا يرغب في التمتع بالصحبة العلوية مع هؤلاء! من لا يرغب في تسجيل اسمه معهم، لكي يسمع معهم: “تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم” (مت ٢٥: ٣٤)[17].]
ويلاحظ أن الملكوت الذي بلغناه في المسيح يسوع يقدم لنا ثمانية أمور: جبل صهيون، مدينة الله، محفل ملائكة، كنيسة أبكار، الله ديان الجميع، أرواح أبرار مكملين، وسيط العهد الجديد يسوع، دم رش يتكلم أفضل من هابيل. نحن نعلم أن رقم ٨ يشير إلى ما وراء الزمن (٧ أيام الأسبوع)، أو إلى الحياة الانقضائية الأخروية، فالملكوت الجديد هو ملكوت سماوي يرفع الإنسان إلى الحياة الفائقة السماوية.
ركز كثير من الآباء على “كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات“، إذ صرنا في المسيح يسوع البكر أبكارًا. بكورية السيد المسيح ليست كالبكورية الجسدية، صاحبها يحرم الآخرين من التمتع بها، إنما بالعكس تهب الآخرين شركة فيها. هذه البكورية التي صارت لنا ليست جسدية، وكما يقول العلامة أوريجينوس: [الذين اعتبروا أبكارًا أمام الله ليس هم الأبكار حسب الميلاد الجسدي، إنما اختارهم الله بسبب حسب استعدادهم. هذا ما حدَث بالنسبة ليعقوب الرجل الثاني إذ حسبه الله بكرًا ونال بركة البكورية (تك ٢٧: ١١). بفضل إصابة أبيه بالعمى بسماح إلهي، وذلك لحسب استعداد قلبه الذي رآه الله فيه، إذ قيل: “وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرًا أو شرًا… مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو” (رو ٩: ١١، ١٢؛ ملا ١: ٢، ٣). هكذا لم يكن اللاويون أبكارًا حسب الجسد لكنهم ثبتوا كأبكار[18].]
مرة أخرى إذ أدرك الرسول كيف تمررت نفوس المسيحيين الذين هم من أصل عبراني لأنهم حُرموا من جبل صهيون ومدينة أورشليم والناموس المُسلَم بيد ملائكة، لهذا كشف لهم عن الملكوت الجديد الذي صار فيهم، بكونه مشبعًا لاحتياجاتهم ويعوضهم بأكثر مما فقدوا، فقد دعاه:
أ. جبل صهيون، فإن كانوا قد صاروا مضطهدين يُحرمون من السكنى في جبل صهيون الذي اعتز به اليهود، فإن رب المجد يرتفع بهم إلى جبل صهيون الحقيقي الداخلي، يرفع النفس إلى الجبل العالي لتنعم بالحياة السماوية.
ب. مدينة الله الحيّ أورشليم السماوية، عوض أورشليم الأرضية حيث الهيكل الذي يعتز به اليهود صارت النفس عينها مدينة الله، أورشليم الجديدة، لا يُقام فيها هيكل الله بل هي بعينها الهيكل المقدس، كقول الرسول بطرس: “الذي إذ تأتون إليه حجرًا حيًا مرفوضًا من الناس، ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضًا مبنيين كحجارة حية بيتًا روحيًا كهنوتًا مقدسًا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح” (١ بط ٢ : ٤، ٥).
ج. ربوات هم محفل ملائكة، إن كان اليهود قد فقدوا حرفية الناموس الذي سلم بيد ملائكة، فقد صاروا هم أنفسهم محفل ملائكة! وكما يقول القديس إكليمنضس السكندري إن المؤمنين الحقيقيين أصحاب المعرفة الروحية (الغنوسيين) ليس فقط يكونون في صحبة الملائكة، بل يصيرون هم أنفسهم كالملائكة. هذا أيضًا ما تحدث عنه كثير من الآباء بشيء من الإفاضة مثل العلامة أوريجينوس القديس يوحنا الذهبي الفم[19].
د. كنيسة أبكار، كان لليهود أبكارهم الروحيين أي سبط لاوي، يتقبلهم الله عن كل الجماعة المقدسة عوض الأبكار حسب الجسد. والآن صاروا كنيسة أبكار، خلال إتحادهم مع الابن البكر الحقيقي.
هـ. الله ديان الجميع، كان اليهود في حرفيتهم يتطلعون إلى الله كإله اليهود وحدهم، أما وقد قبلوا الإيمان بمخلص العالم فقد أدركوا الله كديان البشرية كلها.
و. إلى أرواح أبرار مكملين، صار لهم في المسيح أن يتبرروا ويصيروا كاملين في عيني الآب.
ز. وسيط العهد الجديد يسوع، إن كان رجال العهد القديم يطلبون المسيا وينتظرونه، فإن رجال العهد الجديد تمتعوا به، هذا الذي وهبهم “العهد الجديد” يدخل بهم إلى ملكوته السماوي.
ح. إلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل، هكذا يختم حديثه عن بركات العهد الجديد بمقارنته مع العهد القديم بالدم المرشوش في القلب، الذي يصرخ فينا شاهدًا للحق ومقدسًا إيانا… لا يمكن للزمن أن يخفته!
بعد المقارنة بين العهدين دخل إلى جانب عملي، وهو التزامنا لا بالافتخار بما نلناه، وإنما بالتجاوب معه عمليًا: “اُنْظُرُوا أَنْ لاَ تَسْتَعْفُوا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ. لأَنَّهُ إِنْ كَانَ أُولَئِكَ لَمْ يَنْجُوا إِذِ اسْتَعْفَوْا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى الأَرْضِ، فَبِالأَوْلَى جِدًّا لاَ نَنْجُو نَحْنُ الْمُرْتَدِّينَ عَنِ الَّذِي مِنَ السَّمَاءِ، الَّذِي صَوْتُهُ زَعْزَعَ الأَرْضَ حِينَئِذٍ، وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ وَعَدَ قَائِلاً: إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أُزَلْزِلُ لاَ الأَرْضَ فَقَطْ بَلِ السَّمَاءَ أَيْضًا. فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى تَغْيِيرِ الأَشْيَاءِ الْمُتَزَعْزِعَةِ كَمَصْنُوعَةٍ، لِكَيْ تَبْقَى الَّتِي لاَ تَتَزَعْزَعُ. لِذَلِكَ وَنَحْنُ قَابِلُونَ مَلَكُوتًا لاَ يَتَزَعْزَعُ، لِيَكُنْ عِنْدَنَا شُكْرٌ بِهِ نَخْدِمُ اللهَ خِدْمَةً مَرْضِيَّةً، بِخُشُوعٍ وَتَقْوَى. لأَنَّ إِلَهَنَا نَارٌ آكِلَةٌ” [٢٥–٢٩].
بمقدار ما تزداد العطية وتعظم تزداد المسئولية أيضًا. فإن كان الذين استهانوا بالناموس الذي عند تسلمه تزعزعت الأرض (إذ حدثت نار وأصوات رعود وزلزلة) لم ينجوا، فكيف ينجو من يستهين بالكلمة الإلهي السماوي، الذي قال أنه يزلزل الأرض والسماء أيضًا؟ في العهد القديم كانت الأرض تتزلزل إذ كان الناموس يمس الجسد الترابي، لكن العهد الجديد يمس الأرض والسماء، أي الجسد والروح معًا؛ لذا فعقوبة كاسر الناموس كانت بالأكثر تمس حياتنا الأرضية، لكن كاسر الوصية ومحتقر العهد الجديد فيسقط تحت العقوبة هنا على الأرض وفي الحياة الأخرى. من ناحية أخرى إن كنا قد قبلنا ملكوتًا لا يتزعزع يهب الجسد والنفس خلودًا، فلنشكر الرب ونخدمه بخشوعٍ وتقوى، مدركين أن إلهنا نار آكلة، قادر أن يلهب الجسد والنفس معًا بالروح الناري، فنصير بحق خدام الله الناريين! وكما يقول القديس أثناسيوس الرسولي: [لأنه يليق بخادم الرب أن يكون يقظًا وحريصًا، نعم بل وكلهيب نار، حتى أنه إذ بالروح الملتهب يبدد كل خطية جسدانية يقدر أن يقترب إلى الله الذي يُدعى نارًا آكلة كما يعبِّر القديسون[20].]
[1] Apol. De Fuga 21.
[2] On Ps. hom 16.
[3] In Hebr. hom 28 : 6, 7.
[4] In Hebr. hom. 29 : 1.
[5] On Ps. hom 51.
[6] Ep. 7 : 5.
[7] On Ps. 9 : 41.
[8] Ep. 118 : 1, 22 : 39.
[9] In Hebr. hom 29 : 2.
[10] In Hebr. hom 29 : 1.
[11] In Hebr. hom 30 : 1.
[12] In Hebr. hom 30 : 2.
[13] In Hebr. hom 30 : 2.
[14] Ep. 116 : 8.
[15] In Hebr. hom 32 : 1.
[16] In Num. hom 3.
[17] Fest Ep. 43.
[18] In Num. hom 3 : 1.
[19] آباء مدرسة الإسكندرية الأولون، ص ٧٨، ١٠٦، ٢٢٨.
القديس يوحنا الذهبي الفم، ١٩٨٠، ص ٢١١، ٢١٢.
[20] Fest. Ep. 3 : 3.