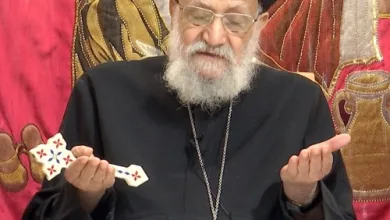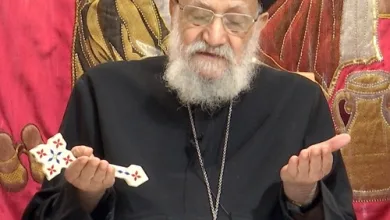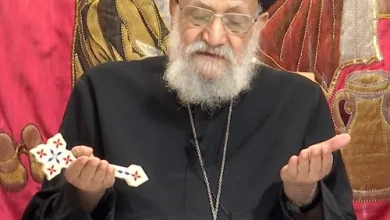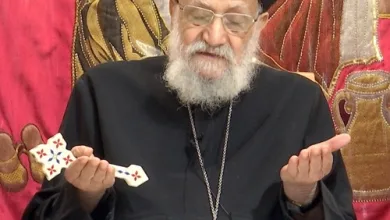تفسير رسالة رومية 13 الأصحاح الثالث عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 13 الأصحاح الثالث عشر - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 13 الأصحاح الثالث عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة رومية 13 الأصحاح الثالث عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثالث عشر
المؤمن والوطن
سبق فتحدّث الرسول عن المسيحي والحياة اليومية (ص 12) مظهرًا كيف يليق به أن يترجم إيمانه عمليًا في كل حياته، سواء في عبادته لله أو تقديس جسده بالروح القدس، أو في علاقته بالمؤمنين كأعضاء معه في الجسد الواحد ثم مع جميع الناس حتى مضطهديه، مقدّمًا بنعمة الله شهادة حيّة لمسيحه محب البشر. الآن يحدّثنا الرسول عن مركزه كمواطن حيّ يشعر بالتزاماته نحو وطنه بروح التواضع والاحترام. فإن كان المؤمن يدرك أن قلبه قد انطلق نحو السماء ليجد له فيها موطنًا أبديًا، فهذا يزيده التزامًا بالخضوع والحب ليشهد للوطن السماوي خلال سلوكه العملي.
- الخضوع للسلاطين 1-5.
- أمانته نحو الوطن 6-7.
- التزامه بحب القريب 8-10.
- استعدادنا للوطن السماوي 11-14.
1. الخضوع للسلاطين
“لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة،
لأنه ليس سلطان إلا من الله،
والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله،
حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله،
والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة” [1-2].
بلا شك كانت علاقة اليهود بالحكام غير الإسرائيليين تمثل مشكلة، إذ تمسكوا بحرفيّة الوصيّة الموسويّة: “إنك تجعل عليك ملكًا الذي يختاره الرب إلهك، من وسط إخوتك تجعل عليك ملكًا، لا يحل لك أن تجعل رجلاً أجنبيًا ليس هو أخاك“ (تث 17: 15). لقد أساء اليهود فهم هذه العبارة فكانوا يقاومون السلطات أينما وجدوا، وكانوا مثيري شغب في روما حتى اضطر الإمبراطور كلوديوس قيصر إلى طردهم من روما (أع 18: 2) حوالي عام 49م.
لقد ارتبطت العقيدة الدينية في ذهن اليهودي بالسياسة، فحسبوا أن المسيّا المخلص قادم لإنقاذهم من السلطة الرومانية وبسط نفوذهم على مستوى العالم، الأمر الذي دفعهم إلى صلب ربنا يسوع المسيح إذ لم يجدوا فيه سؤل قلبهم. أمّا المسيحي فكمؤمن حقيقي يدرك أن السماء هي دائرة اهتمامه الداخلي، كقول الرسول: “فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتمّوا بما فوق لا بما على الأرض“ (كو 3: 1-2). هكذا ينسحب قلبه إلى السماويات، مدركًا أن حياته كلها في يدي ّ الله ضابط الكل. ولا يطمع المسيحي كمؤمن في مراكز زمنية، ولا يرتبط إيمانه بالسياسة، إذ يرى في كنيسته ليست مؤسسة زمنية وإنما “حياة سماوية”، لا تدخل في السياسة، وإنما تقبل الكل بروح التواضع والخضوع والحب في الله.
كتب الرسول بولس: “لتخضع كل نفس للسلاطين، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله” [1]، ذلك في الوقت الذي كان فيه نيرون يضطهد الكنيسة بكل عنف. إذ كان يؤمن إن نيرون أيضًا ـ بالرغم من شرّه ـ قد أقيم بسماح إلهي لخير الكنيسة، وليس عمل الكنيسة أن تقاومه لا في الظاهر ولا بالقلب، إنما ترد مقاومته بالحب والخضوع في الأمور الزمنيّة مادامت لا تمس إيمانها بالله.
جاء في سفر الأمثال: “بي تملك الملوك، وتقضي العظماء عدلاً، بي تترأس الرؤساء والشرفاء، كل قضاة الأرض” (أم 8: 15-16)، “قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء أن يميله“ (أم 21: 1)، لهذا لا تكف الكنيسة عن أن تصلي من أجل الرئيس أو الملك ومشيريه ورجاله لكي يعطيهم الرب سلامًا وحكمة.
يحدّثنا القدّيس يوحنا الذهبي الفم عن خضوع الكنيسة للحكام، قائلاً: [إن كان يليق بنا أن نجازي الذين يضرّوننا بالخير فكم بالأحرى يليق بنا أن نطيع من هم نافعون لنا؟… لقد أظهر (الرسول) أن هذه التعليمات تشمل الكل كالكهنة والرهبان وليس فقط الذين يمارسون أعمالاً عالمية… إذ يقول: “لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة” [1]. فإن كنتَ رسولاً أو إنجيليًا أو نبيًا، أو أيّا كنت فلتعلم أن هذا ليس مدمّرًا للدين[1].]
يفسر لنا القدّيس يوحنا الذهبي الفم هذه العبارة موضحًا إننا نلتزم بالخضوع للرؤساء والحكام، لأن هذا التدبير هو من الله، لا بمعنى كل ملك أو مسئول أقيم من عند الله، وإنما التدبير ذاته هو من الله، إذ يقول: [ماذا تقول؟ هل كل حاكم اختاره الله؟ نجيب: لست أقول هذا، فإنني لا أتحدث عن أفراد وإنما عن المركز نفسه، إذ يجب أن يوجد حكام ومحكومين، حتى لا تسير كل الأمور في ارتباك، فيصير الناس كالأمواج يتخبطون من هنا وهناك، هذا ما أقول عنه إنه حكمة الله. لذلك لم يقل: “لأنه ليس حاكم إلا من الله” وإنما يقول: “ليس سلطان إلا من الله“. وذلك كما يقول الحكيم: “زواج الرجل بامرأة من عند الرب” (أم 19: 14 الترجمة السبعينية)، بمعنى أن الله أوجد الزواج لكن هذا لا يعني أنه هو الذي يأتي بكل رجل يتزوج بإمرأة. فإننا نرى كثيرين يتزوّجون للشرّ تحت شريعة الزواج، هذا لا ننسبه لله.]
يكمل القدّيس يوحنا الذهبي الفم مظهرًا أن الخضوع هنا ليس لأجل منفعة زمنية، وإنما من أجل الله نفسه. فالخضوع هنا لا يعني ضعفًا بل “طاعة في الرب”، لذا يليق بالمؤمن في خضوعه أن يخاف لا من الناس وإنما من الشرّ: “فإن الحكام ليس خوفًا للأعمال الصالحة بل الشرّيرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح، ولكن إن فعلت الشرّ فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثًا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشرّ. لذلك يلزم أن يُخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضًا بسبب الضمير” [3-5].
هكذا يرفعنا الرسول من الخضوع عن خوف أو للتملق إلى الخضوع عن ضمير داخلي حق، فيكون خضوعنا للسلاطين نابعًا عن أعماقنا الداخليّة، ممارسين الخير والصلاح وممتنعين عن الشرّ من أجل الضمير الداخلي. هكذا يلتقي خضوعنا للسلطان بتقديسنا الداخلي.
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على العبارة الرسولية السابقة، قائلاً: [انظروا كيف يجعل منهم أصدقاء للحاكم، مظهرًا أنه يمتدحهم من عرشه، فلا مجال للغضب… ليس الحاكم هو السبب في الخوف، وإنما شرّنا!]
2. أمانته نحو الوطن
في خضوعنا للسلطان نمارس وصية إنجيلية كجزءٍ لا يتجزأ من حياتنا الروحيّة. هذا الخضوع لا يكون بالفم أو اللسان، وإنما بالعمل الجاد، بإيفاء الوطن حقّه علينا، فبسرور نقدم الالتزامات، إذ يقول الرسول: “فإنكم لأجل هذا توفون الجزيّة أيضًا، إذ هم خدّام الله مواظبون على ذلك بعينه؛ فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزيّة لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام” [6-7].
يرى القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول قد حوّل ما يراه الكثيرون ثقلاً إلى راحة، فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذا لصالحه، لأن الحكام “هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه”، يسهرون مجاهدين من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة. فحياتهم مملوءة أتعابًا وسهر. بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام يُحرم منه الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام فحسب وإنما بالصلاة من أجلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة (1 تي 2: 1-2).
هذا وإن كلمة “أعطوا” هنا في الأصل اليوناني تعني “ردّوا”، فما نقدمه من جزية أو تكريم للحكام ليس هبة منّا، وإنما هو إيفاء لدين علينا، هم يسهرون ويجاهدون ليستريح الكل في طمأنينة.
سبق لنا الحديث بإفاضة عن الوصيّة الإلهية: “أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله” في تفسيرنا (مت 22: 21؛ 1 بط 2: 13، 17).
هذا والجزية هنا يقصد بها ما يأخذه الحاكم على النفوس والعقارات، أمّا الجباية فيأخذها على التجارة.
3. التزامه بحب القريب.
اِلتزامنا نحو الوطن لا يقف عند الخضوع للسلاطين ودفع التزاماتنا الماديّة كالضرائب وإنما يمتد أيضًا لحب كل إنسان، إذ يقول الرسول: “لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضًا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس” [8].
لا يستريح المؤمن مادام عليه دين، فيبذل كل الجهد أن يفي دين الآخرين عليه، ولعلّه يقصد هنا أنه يليق بالشعب أن يفوا الحكام الدين، لأن الآخرين يبذلون كل الجهد لأجل سلام الشعب.
على أي الأحوال يليق بنا أن نفي كل إنسان دينه، إنما نبقى نشعر بدين الحب نحو الكل من أجل الله الذي أحبّنا، فنعيش كل حياتنا نرد حب الله لنا بحبّنا للناس. وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم عن إيفاء دين الحب [يريدنا أن نبقي على الدوام نفي الدين، ولا ينتهي.] يسألنا القدّيس أغسطينوس أن نطلب من الله الحب حتى نقدر أن نفي الدين[2].
بهذا الفكر لا نمارس “الحب” وحده، إنما نكمل الناموس كله، “لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس” [8]. وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [مرة أخرى نناقش الأعمال الصالحة، المنتجة لكل فضيلة… إنك مدين لأخيك بالحب، لأننا أعضاء لبعضنا البعض؛ فإن تركنا الحب تمزّق الجسد إلى أشلاء. إذن فلتحب أخاك، فإن كنت بصداقتك له تقتني إتمام الناموس كله فأنت مدين له بالحب بكونك تنتفع به.]
يوضّح الرسول ذلك بقوله: “لأن لا تزن، لا تقتل، لا تشهد بالزور، لا تشته، وإن كان وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك” [9].
إذ يمتليء القلب حبًا حقيقيًا، إنما يمتلئ بالله نفسه الذي يشبع القلب والنفس والعواطف والأحاسيس، فلا يحتاج الإنسان إلى ملذات العالم وإغراءاته ولا شهوات الجسد ولا خداعات الخطيّة لتملأ حياته. الحب مشبع للكيان الإنساني، ومبهج للحياة!
بالحب أيضًا نلتقي مع السيد المسيح محب البشر، فتصير الوصايا الإنجيليّة هي ناموس حياتنا الداخليّة، عندئذ يكمل فينا الناموس بكونه وصايا سهلة وهينة.
يكمل الرسول حديثه، قائلاً: “المحبّة لا تصنع شرًا للقريب، فالمحبّة هي تكميل الناموس” [10].
المحبّة وهي أم كل فضيلة، ترفع الإنسان في أعماقه فوق كل شرّ، ليحيا بالروح مكملاً الناموس.
- حيث يوجد الحب ماذا نحتاج بعد؟… وحيث لا يوجد الحب فأي شيء يمكن أن يكون نافعا؟ فإن الشيطان يؤمن (يع 2: 19) لكنه لا يحب، لكن ليس أحد يحب ما لم يؤمن[3].
القدّيس أغسطينوس
- المحبّة هي تكميل الناموس، مثل المسيح (الذي أكمل الناموس)… بالحب تكمل الوصايا: لا تزن، لا تشته امرأة قريبك، تلك الخطايا التي مُنعت قبلا بالخوف[4].
القدّيس إكليمنضس السكندري
- الحب هو بداية الفضيلة ونهايتها، الحب هو جذورها وأساسها وقمّتها. إن كان الحب هو البداية والتكميل، فماذا يعادله؟[5]
القدّيس يوحنا الذهبي الفم
4. استعدادنا للوطن السماوي
إن كان يليق بنا أن نكون أمناء بالنسبة لوطننا الأرضي فنخضع للسلاطين، ونقدم لهم الكرامة عمليًا بالحياة الفاضلة، ونحب جميع إخوتنا كأنفسنا، فإن هذا الإلتزام ينبع عن أعماقنا الملتهبة بحب الوطن السماوي، وشوقنا الدائم للاستعداد للانطلاق إليه.
هذا وإنكم عارفون إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم،
فإن خلاصنا الآن أقرب ممّا كان حين آمنّا” [11].
لنكن أمناء ومحبّين للكل لأن أيّامنا على الأرض مقصّرة، هي مجرّد “ساعة“، وكأنها ساعة نوم نستيقظ لنجد أنفسنا مع الله وجهًا لوجه في ملكوته السماوي أبديًا.
يشعر الرسول أن كل يوم ينقضي إنما يدخل به إلى الأبدية مقتربًا من نهاية حياته الزمنيّة لينعم بشهوة قلبه. كأنه يترقب خروجه من العالم يومًا وراء يوم، وساعة بعد ساعة! هذه هي احساسات الكنيسة الأولى، إذ نسمع: “الوقت منذ الآن مقصّرً“ (1 كو 7: 29)؛ “نهاية كل شيء قد اقتربت“ (1 بط 4: 7)؛ “هي الساعة الأخيرة” (1 يو 2: 18).
- لقد اقتربت القيامة، اقتربت الدينونة الرهيبة، اقترب اليوم الذي يحرق كأتون. لذلك وجب علينا أن نتحرّر من تغافلنا… أنظر كيف يضع القيامة قريبة جدًا منهم، فالأيّام تتقدّم لينتهي زمان حياتنا الحاضرة، والحياة العتيدة تقترب… فإنه لا يليق أن يكونوا في بداية سعيهم غير ملتهبين غيرة وقد بلغ شوقهم كمال شدته، ليفتروا في غيرتهم مع مرور الزمن… إنما يجب أن يحدث العكس ألاَ يتراخوا بعامل الزمن، وإنما أن يزدادوا قوّة أكثر فأكثر. فكلما اقترب مجيء الملك يلزم بالأكثر أن يستعدّوا؛ كلما اقتربت المكافأة بالأكثر يصحون في صراعهم كما يحدث في المباريات حيث يزداد حماس المتسابقين كلما اقتربت نهاية المباراة[6].
القدّيس يوحنا الذهبي الفم
“قد تناهي الليل وتقارب النهار،
فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور،
لنسلك بلياقة كما في النهار،
لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر،
ولا بالخصام والحسد،
بل البسوا الرب يسوع،
ولا تصنعوا تدبيرًا للجسد لأجل الشهوات” [12-14].
يرى القدّيس بولس أن ليل الحياة الحاضرة يتناهى، لكي يقترب نهار الأبدية التي بلا ليل، لذا لاق بنا أن نتهيأ لهذا النهار فنحمل فينا السيد المسيح “شمس البرّ”، نلبسه فيحطِّم فينا كل أعمال الظلمة، مشرقًا علينا بأعماله المقدّسة كأسلحة نور.
يشبِّه البابا غريغوريوس (الكبير) الرسول بولس هنا بالديك الذي يعطي صوتًا جميلاً لنستيقظ عند انتهاء الظلمة، وحلول النهار في الفجر[7].
- لنمارس حياتنا هنا الآن بنفس الطريقة التي سنحياها في النهار، أي في العالم العتيد[8].
القدّيس جيروم
- إن كانت الظلمة قد رحلت عن صدرك، إن كان الليل قد تبدّد من هناك، إن كان الظلام قد طُرد، إن كان بهاء النهار قد أنار حواسك، إن كنت قد بدأت أن تكون إنسان النور، فلتمارس أعمال المسيح، لأن المسيح هو النور والنهار[9].
القدّيس كبريانوس
- يليق بنا أن نترك الأعمال نفسها تصرخ عاليًا، إذ تجعلنا نسير في النهار، إذ تضيء أعمالك (مت 5: 6) [10].
القدّيس إكليمنضس السكندري
- “بل البسوا الرب يسوع المسيح” [14].
نلبسه عندما نحب الفضيلة ونبغض الشرّ؛ عندما ندرّب أنفسنا على العفّة ونميت شهوتنا؛ عندما نحب البرّ لا الإثم؛ عندما نكرم القناعة ويكون العقل راسخًا؛ عندما لا ننسى الفقير بل نفتح أبوابنا لجميع البشر، عندما نقبل تواضع الفكر وننبذ الكبرياء[11].
القدّيس البابا أثناسيوس الرسولي
- “قد تناهي الليل وتقارب النهار” [12]
إذ أوشك هذا (الليل) على النهاية واقترب اليوم الأخير يلزمنا أن نمارس الأعمال التي تخص الأخير لا الأول…
إذ يرحل الليل تمامًا يسرع كل منّا نحو الآخر، قائلاً: لقد حلّ النهار، فنمارس أعمال النهار، كأن نلبس، تاركين أحلامنا ونومنا ليجدنا النهار مستعدين… هكذا فلنخلع عنّا تخيلاتنا، ولنترك أحلام هذه الحياة الحاضرة، ولننزع عنّا النوم العميق ونلتحف بثياب الفضيلة…
يقول: “فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور” [12]. نعم لأن النهار يدعونا أن نلبس الأسلحة ونحارب (روحيًا). لا تخف عند سماعك الأسلحة، لأن العدّة المنظورة ثقيلة وارتداءها مضني، أمّا الأسلحة هنا فمرغوب فيها، يستحق أن نصلي لنواله، لأنها أسلحة من نور! إنها تجعلك أكثر بهاءً من أشعة الشمس وتهبك بريقًا عظيمًا، وتقدّم لك أمانًا… إنها أسلحة النور!
“لنسلك بلياقة كما في النهار” [13]… لم يقل: “اسلكوا”، بل قال “لنسلك” ليجعل حثه بعيدًا عن التعقيد وتوبيخه لطيفًا!…
“بل البسوا الرب يسوع المسيح” [14]... لا يحدثهم عن أعمال معيّنة وإنما يثير فيهم أمورًا أعظم، لأنه حينما تحدّث عن الرذيلة أشار إلى أعمالها، أمّا وهو يتحدّث عن الفضيلة فلا يُشير إلى أعمالها بل إلى أسلحتها ليظهر أن الفضيلة تجعل صاحبها في آمان كامل وبهاء عظيم… أنه يقدّم الرب نفسه كثوب، الملك نفسه، من يلتحف به تكون له الفضيلة مطلقًا[12].
القدّيس يوحنا الذهبي الفم
[1] In Rom. hom 23.
[2] In Ioan. tr 57: 1.
[3] In Ioan. tr 83: 3.
[4] Strom. 4: 19.
[5] In Rom hom 23.
[6] In Rom hom 24.
[7] Pastoral Rule 3: 39.
[8] On Ps. hom 46.
[9] On Jealous y& Envy 10.
[10] Strom. 4: 26.
[11] Pasch. Ep. 4: 3.
[12] In Rom. hom 24.