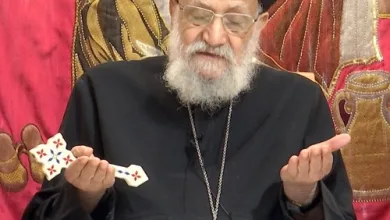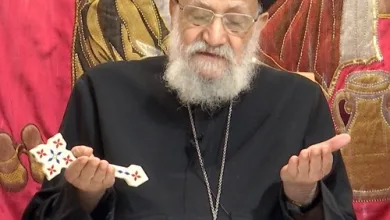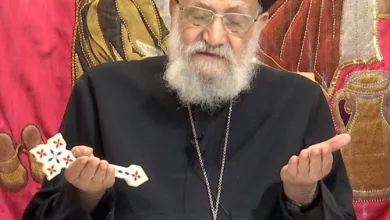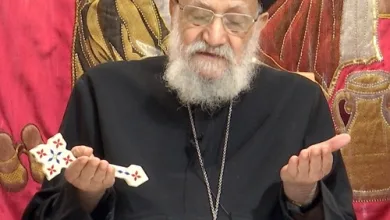تفسير رسالة رومية 10 الأصحاح العاشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 10 الأصحاح العاشر - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 10 الأصحاح العاشر – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة رومية 10 الأصحاح العاشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح العاشر
سرّ الجحود
إذ يعالج الرسول بولس مشكلة “اختيار شعب الله” التي أساء اليهود استخدامها، فعِوض شعورهم بحب الله الفائق لهم، والتزامهم بمسئولية الكرازة بين الأمم، تحجّرت قلوبهم بالجحود، وتعثروا في السيد المسيح “حجر الزاوية”، الذي صار لهم حجر صدمة وصخرة عثرة (9: 22-23). بينما قبله المؤمنون حجرًا كريمًا مختارًا (مز 118: 22؛ 1 بط 2: 6-7). الآن يكتب لنا عن “سرّ جحودهم” حتى لا نسقط نحن أيضًا فيما سقطوا فيه بطريق أو آخر.
- غيرة اليهود بلا معرفة 1-5.
أ. جهلهم برّ الله 3.
ب. جهلهم غاية الناموس 4-5.
- رفضهم بساطة الإيمان 6-11.
- رفضهم حب الله الشامل 12–13.
- رفضهم الالتزام بالكرازة 14–18.
- شهادة الأنبياء عن جحودهم 19-21.
- غيرة اليهود بلا معرفة
إذ يعالج الرسول موضوعًا شائكا للغاية، يمكن خلاله أن يُتهم بالخيانة لأمّته، يُعلن من حين إلى حين مدى حُبّه لإخوته حسب الجسد، وعن عدم تجاهله لما نالوه من امتياز دون سائر الأمم في عصري الآباء والأنبياء، وأيضًا عن غيرتهم الدينيّة، وإن كانت بلا إدراك روحي حقيقي، إذ يقول:
“أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص،
لأني أشهد أن لهم غيرة لله،
ولكن ليس حسب المعرفة” [1-2].
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة الرسولية موضحًا أن الرسول وهو يستعد لتوبيخهم بأكثر صرامة يودّ أن يقول لهم: لا تلتفتوا إلى الألفاظ، ولا إلى الاتهامات، كأني اتهمكم بروح عدائي، فإن “خلاصكم” هو موضوع سرور قلبي وصلاتي لله.
يا له من روح إنجيلي ملتهب بالحب، فمقاومة اليهود المستمرّة له لم تجرح مشاعر محبّته، إذ لا يجد ما يسرّ قلبه مثل خلاص الآخرين حتى المقاومين له. هم في قلبه، يشتهي خلاصهم، ولا يكفّ عن الطلبة من أجلهم. هذه الأبوّة الحانية نجدها في خدام الله الحقيقيّين، الذين من الأعماق يصرخون مع صموئيل النبي: “وأما أنا فحاشا لي أن أخطىء إلى الرب، فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم“ ( 1صم 12: 23).
علامة الحب الصراحة والوضوح، إذ يشهد لغيرتهم لله، لكنها غيرة ليست حسب المعرفة، سقط فيها هو من قبل، إذ كان في غيرته “ينفث تهددًا وقتلاً على تلاميذ الرب“ (أع 9: 1). يقول القدّيس أغسطينوس: [كانوا يظنّون أنهم يقدّمون خدمة لله بذبحهم خدّامه! يا له من خطأ مريع، عندما تودّ أن تسرّ الله بضربك محبوبيه حتى الأرض، وهدم مذبح الله الحيّ لتأتي به أرضًا كي لا يُهجر الهيكل الحجري، يا له من عمى لعين! هذا هو ما حدث مع إسرائيل من أجل ملىء الأمم، أقول أنه حدث جزئيّا وليس للكل، فلم تقطع كل الأغصان، وإنما بعضها، لكي تتطعّم أغصان الزيتونة البريّة (رو 11: 25، 17) [1].]
ما سقط فيه اليهود يمكن أن يسقط فيه بعض المسيحيين، إذ تكون “لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة“، كأن يسلك الإنسان بفكر متعصّب دون إدراك روحي للإيمان المستقيم أو اتساع قلب لمحبّة الغير؛ أو كأن يجاهد في طريق الفضيلة غير متكىء على صدر الله بل على ذراعه البشري وقدراته الخاصة ومعرفته الزمنيّة.
سر جحود اليهود جهلهم أمرين؛ أولاً: برّ الله، ثانيًا: غاية الناموس. يقوم الأول على جهلهم عمل الله في حياة المؤمن، فطلبوا برّ أنفسهم، لا برّ الله، فصار ذلك عائقًا عن خلاصهم، والثاني جهلهم غاية الناموس وأحكامه فتمسّكوا بالحرف القاتل دون الروح الذي يحيي.
أولاً: جهلهم برّ الله
“لأنهم إن كانوا يجهلون برّ الله،
ويطلبون أن يُثبتوا برّ أنفسهم،
لم يخضعوا لبرّ الله” [3].
يحاول أن يعطيهم عذرًا: “جهلهم برّ الله“، لكنه يحوّل العذر إلى اتهام ضدّهم يقوم على كبريائهم واعتداءهم بالذات: “برّ أنفسهم“. جهلهم لا يقوم على ظروف خارجية قهريّة، وإنما على فساد داخلي يدبّ في النفس.
حينما تتضخم “الأنا ego” تملأ القلب، فلا تطيق آخر في داخله، حتى إذ تديّنت تعمل لحساب ذاتها المغلقة، فتطلب تثبيت “برّ نفسها” عِوض اتساعها بالحب لتقبل نعمة الله واهبة البرّ بالإيمان. يحدّثنا إشعياء النبي عن هذا البرّ الذاتي، قائلاً: “قد صرنا كلنا كجنس، وكثوب عُدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريحٍ تحملنا“ (إش 64: 6).
- يقول الرسول بولس أن المسيح بالنسبة لنا برّ (1 كو 1: 30)؛ وبالتالي من يجوع إلى هذا الخبز إنما يجوع إلى البرّ النازل من السماء، الذي يهبه الله، وليس الذي يصنعه الإنسان لنفسه. فلو أن الإنسان لا يصنع لنفسه برًا لما قال الرسول نفسه لليهود: “إذ كانوا يجهلون برّ الله، ويطلبون أن يُثبتوا برّ أنفسهم، لم يخضعوا لبرّ الله” [3]… برّ الله لا يعني أن الله بارّ، وإنما يعني البرّ الذي يهبه الله للإنسان فيجعله بارًا بالله. مرة أخرى، ما هو برّ هؤلاء اليهود؟ البرّ الذي هو من عمل قوتهم والذي افترضوه، فحسبوا أنفسهم كما لو كانوا مكمِّلين للناموس بفضائلهم الذاتيّة[2].
القدّيس أغسطينوس
- الله وحده هو البارّ والذي يبرّر، يهب الإنسان البرّ.
إنهم يطلبون أن يُثبتوا برّ أنفسهم، بمعنى أنهم يظنّون بأن الصلاح هو من عندهم لا عطيّة إلهية. بهذا “لم يخضعوا لبرّ الله”، لأنهم متكبرون ويحسبون أنهم قادرون على إرضاء الله بذواتهم لا بما لله[3].
القدّيس أغسطينوس
- قال هذا عن اليهود الذين في اعتداءهم بذواتهم احتقروا النعمة، ولم يؤمنوا بالمسيح أنه يقول بأنهم أرادوا أن يُقيموا برّهم، هذا البرّ الذي من الناموس، لا أنهم ينفّذون الناموس، بل يقيمون برّهم في الناموس، عندما يحسبون في أنفسهم أنهم قادرون على تنفيذ الناموس بقوتهم، جاهلين برّ الله، لا البرّ الذي لله بل البرّ الذي يمنحه الله للإنسان[4].
القدّيس أغسطينوس
ثانيًا: جهلهم غاية الناموس
إن كانت “الأنا” قد حجبت عنهم الالتقاء مع الله بعمله فيهم، فصار برّهم الذاتي المزعوم عائقًا عن تمتّعهم ببرّ الله، فإن تمسكهم بحرفيّة الناموس وشكليّاته أفقدهم المتعة بغاية الناموس الحقيقية، ألا وهو الالتقاء بالمخلّص. يقول الرسول: “لأن غاية الناموس هي المسيح للبرّ، لكل من يؤمن، لأن موسى يكتب في البرّ الذي بالناموس، أن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها” [4-5].
اقتبس الرسول بولس من موسى العبارة: “تحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها إنسان يحيا بها” (لا 18: 5). وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم[5] أن الإنسان لا يمكن أن يحيا ولا أن يتبرّر ما لم يتمّم كل الفرائض وأحكام الناموس، الأمر الذي يعتبر مستحيلاً. لهذا فإذ أراد اليهود أن يتبرّروا بالناموس فالناموس عينه يُعلن عن العجز التام لكل إنسان أن يحقّق البرّ والحياة… بهذا يدفعنا إلى الإيمان بربنا يسوع المسيح الذي وحده غير كاسرٍ للناموس، بل وقادر على تبرير مؤمنيه. بهذا لم يترك الرسول بولس لليهود عذرًا يلتمسونه، فإن الناموس نفسه يُعلن عن المسيح بكونه وحده يتركّز فيه البرّ؛ من ينعم بالبرّ الذي قصده الناموس، ومن يرفضه إنما يرفض البرّ حتى وإن ظنّ في نفسه أنه بالناموس يتبرّر.
- المسيح هو غاية الناموس للبرّ، الذي أنبأنا عنه بالناموس لكل من يؤمن[6].
القدّيس إكليمنضس السكندري
- رفضهم بساطة الإيمان
ربّما يتساءل البعض: إن كان اليهود قد عجزوا عن تحقيق البرّ بالناموس بتنفيذ وصاياه، فماذا يكون حالنا أمام الوصايا الإنجيليّة وهي أصعب من وصايا الناموس؟ لذلك أسرع الرسول ليوضّح الإمكانيات الجديدة التي صارت لنا خلال السيد المسيح والتي يمكن تركيزها في نقطتين جوهريتين:
أ. أن الإيمان بالمسيح بسيط وقريب منّا للغاية [6-8ٍ].
ب. أن الأب أقام المسيح، ليهبنا قوّة القيامة عاملة فينا [9-11].
بهذا لم يحطم الرسول الأعذار اليهوديّة فحسب، وإنما فتح لنا باب الإيمان لنعيشه بكونه سهل المنال، خلال الحياة المُقامة لنا في المسيح ربنا.
أولاً: رفضهم الإيمان البسيط القريب
“وأما البرّ الذي بالإيمان فيقول هكذا:
لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحدر المسيح،
أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات،
ولكن ماذا يقول؟
الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك،
أي كلمة الإيمان التي نكرز بها” [6-8].
اقتبس الرسول عبارات لموسى النبي بعد أن أعطاها مسحة إنجيلية، إذ جاء في سفر التثنية: “أن هذه الوصيّة أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك، ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويُسمعنا إيّاها لنعمل بها؟ ولا هي في عبر البحر حتى تقول: من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويُسمعنا إيّاها لنعمل بها؟ بل الكلمة قريبة منك جدًا في فمك وفي قلبك لتعمل بها“ (تث 30: 11-14).
كان موسى يُحدّث شعبه عن الشريعة أو الوصيّة الإلهية أو الكلمة الإلهية، كيف صارت بين أيديهم ليست ببعيدة عنهم، ليست بالشريعة المرتفعة في السماء يصعب بلوغها والتعرف عليها، ولا هي في الأعماق ليس من ينزل إليها ليجلبها. إنما صارت في وسطهم تبكّتهم وتحثهم على الرجوع إلى الله. إن كان هذا ينطبق على كلمة الله المُعلنة خلال الحروف والمُسلمة بين يديّ موسى النبي لتُوضع في الهيكل وسط الشعب، فبالأحرى تنطبق على كلمة الله المتجسّد، الذي صار إنسانًا وحلّ بيننا كواحد منّا. فلم يعد غريبًا عنّا ولا ببعيدٍ عن حياتنا، بل هو قريب إلينا. يسكن فينا ويحلّ بروحه في داخلنا، لنحيا به في كلماتنا وتصرّفاتنا وكل مشاعرنا وأحاسيسنا.
في القديم كان اليهود يعتزون بأنهم شعب الله الذي تسلم الشريعة الإلهية بواسطة موسى بيد ملائكة (عب 2: 2)، أمّا الآن فقد جاءنا الكلمة نفسه متجسدًا، يهبنا ذاته، ويجعلنا فيه أبناء الآب في مياه المعموديّة بالروح القدس. يقول القدّيس أغسطينوس: [أرسل الناموس بواسطة خادم، أمّا النعمة فجاء بنفسه من أجلها[7].]
إن كان برّ الناموس صعبًا بل ومستحيلاً، فقد جاء السيد المسيح لا ليقدّم وصايا سهلة، ولا ليتهاون مع مؤمنيه، وإنما قدّم ذاته قريبًا من مؤمنيه، بل ساكنًا فيهم، لا ليتمّموا أعمال الناموس إنما به يزيد برّهم عن الكتبة والفرّيسيّين، كقوله: “إن لم يزد برّكم على الكتبة والفرّيسيّين لن تدخلوا ملكوت السماوات“ (مت 5: 20).
حدّثنا القدّيس أغسطينوس عن طريق لقائه مع الله قائلاً بأنه في غباوة كان يبحث عن الله في الطبيعة وكتب الفلاسفة، خرج خارجًا عن نفسه يطلبه، بينما كان الله في داخله عميقًا أعمق من نفسه وعاليًا أعلى من علوّه. إذن لنطلبه في داخلنا، فنجده يملك على القلب، ويُقيم عرسه فيه!
ثانيًا: التمتّع بقيامة المسيح فينا
“لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع،
وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت،
لأن القلب يؤمن به للبرّ،
والفم يعترف به للخلاص،
لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى” [9-11]
إن كان الإيمان ليس بالأمر الصعب، لكنه كما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم[8] يطلب نفسًا متيقظة ساهرة تقبل المسيح الذي قام من الأموات. فكما سبق فقال الرسول أن إبراهيم “على خلاف الرجاء آمن على الرجاء“ (رو 4: 18)، هكذا المسيحي يقبل على خلاف الرجاء الطبيعي الحياة المُقامة في المسيح. هذا هو مركز إيماننا!
يلاحظ في هذه العبارة الرسولية الآتي:
أ. اشتراك الفم مع القلب في الإيمان: “إن اعترفت بالرب يسوع، وآمنت بقلبك... خلصت” [9]. فإن كان القلب هنا يُشير إلى الإنسان الداخلي، فإن الفم يُشير إلى الحياة الظاهرة؛ إيماننا في جوهره لقاء النفس الداخليّة مع عريسها لكن دون تجاهل للجسد بكل أعضائه! بمعنى آخر إيماننا يمس أعماقنا الداخليّة وتصرفاتنا الظاهرة. بدون القلب يصير اعترافنا الظاهري لغوًا وتعصبًا وشكليّات، وبدون الحياة العاملة والاعتراف الظاهر لا ننعم بهذه المكافأة: “كل من يعترف بي قدام الناس اعترف أنا أيضًا به قدام أبي الذي في السماوات” (مت 10: 32).
- ينبع هذا الاعتراف عن جذور القلب. أحيانًا تسمع إنسانًا يعترف (بالمسيح) لكنك لا تدرك إن كان مؤمنًا أو غير مؤمن يجب ألا تدعو أحدًا أنه يعترف (بالمسيح) أن كان غير مؤمنٍ (بقلبه)، لأن من يعترف هكذا إنما ينطق بغير ما في قلبه[9].
القدّيس أغسطينوس
ليتنا نؤمن بربنا يسوع بكل قلبنا، فيملك كربٍ، ويخلص أعماقنا من كل ظلمة، متجاوبين مع مخلصنا بحياتنا المقدّسة فيه، فنعترف به بشفاهنا.
يرى القدّيس أمبروسيوس[10] الاعتراف بالفم يمثل إحدى القبلات التي يقدّمها المؤمن لعريسه السيد المسيح حين يناجيه، قائلاً: “ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر“ (نش 1: 2). فإن كان عريسنا لا يكف عن أن يقبّلنا بقبلات الحب العملي الباذل، يليق بنا أن نرد القبلات بالقبلات، والحب بالحب، لنوجد فيه محبوبين ومقدّسين.
ويرى القدّيس أمبروسيوس أيضًا في الاعتراف بالفم والإيمان بالقلب أشبه بالبوقين الذين من الفضة (عد 10: 2): [بهذين البوقين يبلغ الإنسان الأرض المقدّسة، أي نعمة القيامة. دعهما يصوتان لك كي تسمع صوت الله، فتحثك منطوقات الأنبياء والملائكة على الدوام وتسرع بك إلى العلويات[11]].
ب. الاعتراف بالفم بربنا يسوع المسيح لا يعني مجرّد شهادة الشفتين له، وإنما تعني إبراز الحياة المقدّسة لا لمجد الإنسان، وإنما لمجد الله نفسه، إذ يقول السيد المسيح: “فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات” (مت 5: 16). وكما يقول القدّيس أغسطينوس: [الذين يرغبون في إظهار أعمالهم الحسنة للناس ليمجدوا ذاك الذي أخذوا منه هذه الأعمال الظاهرة فيهم فيتمثلون بهم بالإيمان، بالحق يضيء نورهم أمام الناس، لأن منهم تنبعث أشعة نور المحبّة… لاحظوا الرسول أيضًا عندما يقول: “كما أنا أيضًا أرضي الجميع في كل شيء“ (1 كو 10: 33)، فإنه لم يقف عند هذا كما لو كان إرضاءه للناس هو هدفه النهائي، وإلا فباطلاً يقول: “لو كنت بعد أرضى الناس لم أكن عبدًا للمسيح“ (غل 1: 10)، بل أردف في الحال مظهرًا سبب إرضائه الناس، قائلاً: “غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا” (1 كو 10: 33). فهو لا يرضي الناس لنفعه الخاص وإلا فلا يكون عبدًا للمسيح، بل يرضي الناس لأجل خلاصهم حتى يكون رسولاً أمينًا للمسيح[12]].
ج. “لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى” [11]. اقتطف الرسول بولس ذلك عن سفر إشعياء (28: 16 الترجمة السبعينية)، ليؤكّد أمرين، الأول أنه بأعمال الناموس يمكن للإنسان أن يخزى، إذ يعجز عن التمتّع بالبرّ، أمّا بالإيمان الحيّ فلن يخزى. الأمر الثاني أنه لم يحدد فئة معيّنة بل قال: “كل من يؤمن به”، مؤكدًا عمومية الخلاص بلا تمييز بين يهودي وأممي.
- رفضهم حب الله الشامل
إذ سبق أن كشف الرسول عن سرّ جحود اليهود: رفضهم الإيمان البسيط القريب، جاء بعبارة نبوية مقتبسة من إشعياء النبي (28: 16) نعلن أن “كل” من يؤمن به لا يخزى. كما يقتبس من يوئيل العبارة “كل من يدعو باسم الرب يخلص“ (يوئيل 2: 28-29). العبارة التي اقتبسها الرسول بطرس في عظة يوم الخمسين (أع 2: 21).
هكذا لا يتوقف الرسول بولس عن تأكيد انفتاح باب الإيمان لجميع الأمم، “لأن الله، هو رب الكل” (أع10: 36) كما قال القدّيس بطرس في بيت كرنيليوس.
“لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني،
لأن ربًا واحدًا للجميع،
غنيًا لجميع الذين يدعون به،
لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص” [12-13].
- رفضهم الالتزام بالكرازة
يدخل القدّيس بولس الرسول بهم إلى اتهام جديد، ألا وهو تجاهلهم الدور الرئيسي الذي كان يجب أن يقوموا به كشعب الله المختار: الكرازة بالمسيّا الذي شهد له العهد القديم برموزه ونبوّاته. بمعنى آخر كان يليق بهم عِوض الدخول في مناقشات غبيّة بتشامخٍ وكبرياءٍ ضد الأمم أن يكونوا هم الكارزين لهم بالإيمان. هذا ما قصده الرسول بقوله: “فكيف يدعون بمن لا يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون أن لم يُرسلوا؟ كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات…” [14-15].
يقدّم لنا القدّيس يوحنا الذهبي الفم تحليلاً رائعًا لهذا النص الرسولي، إذ يقول[13] بأن الرسول يجرّدهم من كل عذر، فبعدما قال أن لهم غيرة لله لكن ليس حسب المعرفة، بدأ عن طريق الأسئلة يوضّح أنه كان يحب أن يكونوا أول المؤمنين بالسيد المسيح، لأنه قد أُرسل لهم الأنبياء ككارزين لهم به خلال النبوّات، لكنهم سدوا آذانهم ورفضوا الإيمان. فإن كان الخلاص يتطلب الدعوة باسمه كقول يوئيل النبي: “كل من يدعو باسم الرب يخلص“ (رو 10: 13؛ يوئيل 2: 28-29)، فالدعوة باسمه تستلزم الإيمان به، والإيمان يتطلب السماع عنه، والسماع لا يتحقّق إلا بالكارزين، والكارزون لا يبشِّروا ما لم يُرسلوا. وقد أُرسل لهم الكارزون فعلاً وكرزّوا قبل مجيئه بأجيال كثيرة كقول إشعياء الذي أعلن عن رسالة الكارزين المبشرين بالسلام (إش 52: 7)، ومع هذا فقد رفض اليهود الإيمان، فهم بلا عذر.
كان يليق باليهود أن يسبقوا الأمم في قبول الإيمان بالمسيّا المخلص ليقوموا بدور الكارزين، مكمِّلين رسالة أنبيائهم، عِوض مقاومتهم للإيمان. هكذا يظهر الرسول أن دينونتهم مضاعفة.
على أي الأحوال حتى هذا الرفض للإيمان تنبأ عنه إشعياء، إذ يقول الرسول: “لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن إشعياء يقول: يا رب من صدّق خبّرنا؟ إذًا الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله، لكنني أقول: ألعلّهم لم يسمعوا؟ بلى إلى جميع الأرض خرج صوتهم، وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم” [16-18].
لقد سبق فأنبأ إشعياء أنه ليس الجميع يطيعون الإنجيل، إذ يرفض كثير من اليهود خبر التبشير الذي سبق فأعلنه النبي نفسه (إش 53: 1). هو قدّم الخبر ليؤمنوا بالإنجيل، لكنهم لم يسمعوا، مع أن الأمم الذين في أقاصي المسكونة سمعوا وآمنوا، وهكذا صاروا شهودًا على اليهود.
اقتبس الرسول جزءًا من المزمور 19 حيث ينشد المرتّل: “السماوات تحدّث بمجد الله، والفَلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلامًا، وليل إلى ليل يبدي علمًا، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم“. يُعلن المرتّل في هذا المزمور أن الشهادة عن الله عامة والكرازة بأعماله مقدّمة لكل البشريّة خلال الطبيعة عينها (السماوات والفلك) وخلال كرازة الكارزين التي تبلغ أقصى المسكونة، وكأن المرتّل قد شاهد بروح النبوّة خدمة الرسل التي اتّسعت لتضم الشعوب والأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها.
- شهادة الأنبياء عن جحودهم
أعلن الرسول عن سرّ جحود اليهود برّ الله وعدم إدراكهم غاية الناموس، ورفضهم الإيمان البسيط القريب إليهم، وضيق قلبهم الذي لا يقبل حب الله الجامع لكل البشريّة، ونسيانهم رسالتهم ككارزين بالمسيّا المخلص للعالم. الآن يقدّم لهم الرسول شهادة أعظم تبيّن جحودهم، هما موسى وإشعياء:
“لكني أقول: ألعلّ إسرائيل لم يعلم؟
أولاً: موسى يقول أنا أُغيرَكم بما ليس أمة،
بأمّة غبيّة أغيظكم (تث 32: 21)؛
ثم إشعياء يتجاسر ويقول: “وُجدت من الذين لم يطلبوني،
وصرت ظاهرًا للذين لم يسألوا عني (إش 65: 1)؛
أما من جهة إسرائيل فيقول:
“طول النهار بسطت يديّ إلى شعب معاند ومقاوم” (إش 65: 2) [19-21].
يلاحظ في هذه العبارات الرسولية والمقتبسة من أقوال موسى وإشعياء النبيّين الآتي:
أولاً: يتساءل الرسول بولس: “ألعلّ إسرائيل لم يسمع؟” وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم أنه يقصد: هل سمع إسرائيل ولم يفهم؟ إن كان الأمم الوثنيّون سمعوا وأدركوا الإيمان، فكم بالأحرى كان يليق باليهود الذين [أعطاهم الله منذ القدم كل العلامات التي تستهدف نحو إزالة الغشاوة عن عيونهم[14].]
ثانيًا: اقتبس الرسول العبارة الموسويّة (تث 32: 21): “هم أغاروني بما ليس إلهًا، أغاظوني بأباطيلهم، فأنا أُغيرهم بما ليس شعبًا، بأمّة غبيّة أغيظهم”. وكأن الله قبل الأمم الوثنيّة كشعبٍ له خلال الإيمان ليُثير أيضًا مشاعر اليهود لعلهم يرجعون عن جحودهم ويتوبون إلى الله، وهكذا لم يغلق الرب الباب في وجه أحدٍ.
ثالثًا: يرى القدّيس يوحنا الذهبي الفم في العبارة “طول النهار بسطت يديّ إلى شعب معاند ومقاوم” إشارة إلى العهد القديم بأكمله حيث بسط الرب يديه خلال نداء الأنبياء المستمر، وإعلانه عن حُبّه لهم رغم عنادهم ومقاومتهم. إنه أب يبسط يديه نحو شعبه، كما نحو طفله الصغير الذي يرفض أحضان أبيه المتّسعة له بالحب. ويرى القدّيس يوستين في هذا القول النبوي (إش 65: 2) إشارة إلى الصليب حيث بسط الرب يديه عند موته ليحتضن الكل[15].
[1] In Ioan. tr. 93: 4.
[2] In Ioan. tr 26: 1.
[3] City of God 17: 4.
[4] Grace & Freewill, 24.
[5] In Rom. hom 17.
[6] Strom 2: 9.
[7] In Ioan. tr. 3: 2.
[8] In Rom. hom 17.
[9] In Ioan tr 26: 1.
[10] Ep. 41: 15.
[11] On Belief in Resurrection. 2: 112.
[12] Ser. On N. T. 4: 4.
[13] In Rom. hom 18.
[14] In Rom. hom 18.
[15] Dial. with Trypho 97.