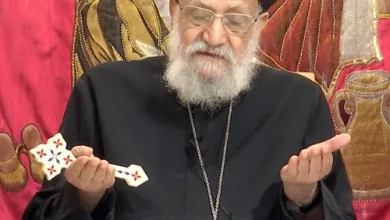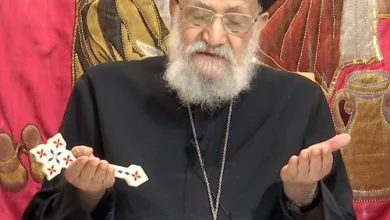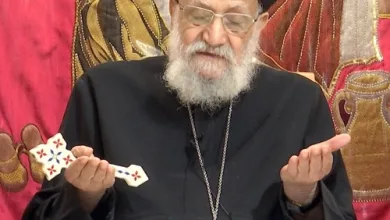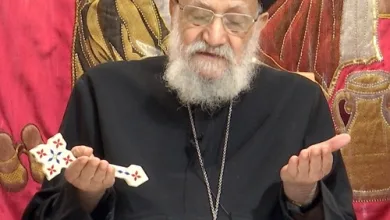تفسير رسالة رومية 8 الأصحاح الثامن – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 8 الأصحاح الثامن - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 8 الأصحاح الثامن – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة رومية 8 الأصحاح الثامن – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثامن
ناموس الروح وبرّ المسيح
أبرز الرسول في الأصحاح السابق دور الناموس كفاضحٍ للخطية دون معالجة لها، ثم قدّم لنا صورة قاتمة للغاية من جهة ناموس الخطيّة كمفسدٍ لحياتنا كلها، ومثير لشهوات الجسد ضد كل اشتياقٍ روحيٍ. والآن إذ ينتقل بنا إلى السيد المسيح الغالب وحده لهذا الناموس، يشرق علينا بالإمكانيات الإلهية التي تعمل في حياة المؤمن. لهذا إن كان بعض الدارسين يحسبون هذه الرسالة في كُلّيتها هي “كاتدرائية الإيمان المسيحي”، فيرى البعض في هذا الأصحاح “قُدس الأقداس” أو المذبح الروحي، عليه يقدّم المؤمن الحقيقي ذبيحة الحب والفرح والشكر وسط صراعه ضد الشرّ وضيقاته الزمنيّة.
قدّم لنا هذا السفر بقوّة إمكانيات الحياة المقدّسة في الرب، أو تمتّعنا ببرّ المسيح غالب ناموس الخطيّة، فاتحًا باب الرجاء في المجد الأبدي، ملهبًا القلب بمحبة المسيح الفائقة.
- المسيح وناموس الروح. 1-17.
- تجديد الخليقة وعمل الروح 18-27.
- المسيح المبرر 28-34.
- محبتنا للمسيح المبرر 35-39.
- المسيح وناموس الروح
سيطرت الخطيّة على الإنسان؛ سكنت فيه، وأخضعته لناموسها، فصار الإنسان جسديًا (7: 14)، يسلك بنفسه كما بجسده تحت مذلة شهوات الجسد وحُسب مبيعًا للخطية. فجاء السيد المسيح، لا لينتزع ناموس الخطيّة من أعماقنا فحسب، وإنما ليُقيم “ناموس روح الحياة” [2]، الذي يعطي للمؤمن إمكانية “السلوك ليس حسب الجسد، بل حسب الروح“. فيُحسب الإنسان في كُلّيته، بجسده ونفسه، إنسانًا روحانيًا أو روحيًا.
أزال السيد المسيح ناموس الخطيّة المستعبد للإنسان، ليُقيم فيه ناموس روح الحياة واهب الحرّية! أعطانا روحه القدوس ساكنًا فينا [11] يهب حياة للنفس والجسد معًا، حياة برّ عِوض موت الخطيّة، حياة البنوّة لله عِوض العبوديّة للخطية! حقًا أعطانا إمكانية الحياة وسط الآلام لكي ننعم بالروح على الميراث مع مسيحنا.
هذا هو موجز حديث الرسول بولس عن “المسيح وناموس الروح”، والآن، لنتبع كلماته الرسولية:
أولاً: الانعتاق من الدينونة: “إذًا لا شيء من الدينونة، الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح” [1].
إن كان ناموس الخطيّة يحطم نفسيتنا ويرعبنا، فإن نعمة المسيح ترفعنا لندرك أننا بالمسيح يسوع مُبرّرون، إن سلكنا حسب الروح لا حسب الجسد. لأن برّ المسيح لا يعمل في المتهاونين، الذين يستسلمون مرة أخري للحياة الجسدانيّة.
يقول الأب ثيوناس معلقًا علي هذه العبارة: [نعمة المسيح تحرّر جميع القدّيسين يومًا فيومًا من ناموس الخطيّة والموت، هذا الذي يخضعون له قسرًا، بالرغم من توسّلهم الدائم إلى أن يصفح الله عن تعدياتهم[1].]
يميز القدّيس يوحنا الذهبي الفم بين ثلاثة أنواع من النواميس: ناموس موسى، وهو روحي لكنه لا يهب الروح ولا يبرر؛ وناموس الخطية العامل في جسدنا وهو يدخل بنا إلى الموت الأبدي؛ وناموس المسيح أو ناموس الروح وهو يهب الروح ويقدم لنا الحياة الأبدية ببرّ المسيح، وبه لا نسلك فيتراخٍ حسب الجسد، بل في قوة الروح.
[كحقيقة واقعة، يسقط كثيرون في الخطيّة حتى بعد المعموديّة ممّا يسبّب صعوبة في الأمر، لذلك أسرع الرسول ليواجه هذا الأمر، لا بقوله “في المسيح يسوع” فحسب، وإنما يضيف “السالكين ليس حسب الجسد“، مظهرًا أن هؤلاء يتركون تراخينا.
الآن لنا القوّة للسلوك “ليس حسب الجسد“، بعد أن كان هذا عملاً صعبًا. وها هو يقدّم برهانه على كلامه هذا، بقوله: “لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني” [2]. فكما دعا الخطيّة “ناموس الخطيّة”، ها هو يدعو الروح “ناموس الروح”.
لقد وصف ناموس موسى بأنه روحي (7: 14) فما هو الفرق بينهما؟ الفرق عظيم وبلا حدود، فإن ذاك روحي، أمّا هذا فناموس الروح. ما هو التمييز بينهما؟ الأول مجرّد أُعطي بواسطة الروح، أمّا هذا فيهب الذين يتقبّلونه الروح بغير حدود. لذلك دعاه “ناموس الحياة” مقابل ناموس الخطيّة لا ناموس موسى. فعندما يقول أنه أعتقني من ناموس الخطيّة والموت لا يقصد ناموس موسى…
نعمة الروح القدس توقف الحرب الخطيرة بذبح الخطيّة، فيصير المُقاوم لنا سهلاً بالنسبة لنا، وتُتوِّجنا منذ البداية عينها، وتسحبنا للصراع بعد أن تمدّنا بعونٍ عظيمِ[2].]
إذًا ناموس المسيح، الذي هو ناموس الروح، هو تمتّع بعطيّة الروح، الذي يحطّم فينا عنف الخطيّة ويسندنا في صراعنا ضدها، واهبًا إيّانا روح الغلبة والنصرة، فنكلّل!
لاحظ القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول هو يتحدّث عن السيد المسيح واهب ناموس الروح يوضح أنهذا العمل هو عطيّة الثالوث القدوس محب البشر، الآب أرسل ابنه مبذولاً لأجلنا، والابن قدّم نفسه فِدْية ليدين خطايانا في جسده، والروح القدس يسكن فينا ليعمل بناموسه فينا. هذا هو عمل الثالوث القدوس الذي أعلنه الرسول في العبارة: “لأنه ما كان الناموس عاجزًا عنه في ما كان ضعيفًا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيّة، ولأجل الخطيّة دان الخطيّة في الجسد” [3].
يلاحظ هذا في النص الآتي:
أ. يرى القدّيس يوحنا ذهبي الفم أن الرسول لم يستخف بالناموس بقوله “لأنه ما كان الناموس عاجزًا عنه”، فإنه لم يقل أن الناموس شرّ، وإنما وهو متفق مع السيد المسيح يودّ صلاحنا، لكنه يعجز عن التحقيق. هذا العجز لا يقوم على عيبٍ فيه، وإنما على فسادنا نحن الذين صرنا جسدانيّين، إذ يقول: “كان ضعيفًا بالجسد”، هنا لا يقصد “الجسم الإنساني” إنما الحياة الجسدانيّة.
ويرى القدّيس جيروم أن سرّ العجز في الناموس هو عدم قدرتنا على تنفيذه، إذ يقول: [فقد عجز الناموس، لأنه لم يستطع أحد أن يتمّمه سوى الرب القائل: “ما جئت لأنقض (الناموس) بل لأكمل“ (مت 5: 17) [3].]
- كان الناموس يعمل ليجعل الناس أبرارًا، لكنه لم يستطع، فجاء (المسيح) وفتح طريق البرّ بالإيمان، وبهذا حقّق ما اشتهاه الناموس؛ ما لم يستطيع الناموس أن يحقّقه بالحرف حقّقه هو بالإيمان. لهذا السبب يقول: ما جئت لأنقض الناموس[4].
القدّيس يوحنا الذهبي الفم
ب. لم يقل “دان الجسد”، وإنما قال: “دان الخطيّة“، فصار الجسم مقدسًا مع النفس، يحمل برّ المسيح وقوة الروح، قادرًا على الغلبة ضد الخطيّة.
ج. يقول الرسول: “أرسل ابنه في شبه جسد الخطيّة”، وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم ليس لأنه لم يأخذ جسدًا مثلنا، وإنما لأنه أخذ جسدنا بدون الخطيّة.
- جاء في الجسد، أي في جسد شبه الخطيّة، لكن ليس في جسد خاطىء، إذ لم يخطئ قط، لذلك صار ذبيحة حقيقية عن الخطيّة إذ هو بلا خطيّة.
- أرسل الله ابنه لا في جسد خاطيء بل في شبه جسد الخطيّة، وأرسل الابن هؤلاء الذين وُلدوا بجسد خاطيء لكنهم تقدسوا به من دنس الخطيّة[5].
القدّيس أغسطينوس
- لم يقل “في شبه الجسد”، إذ أخذ المسيح جسدًا حقيقيًا، وليس شبه جسد، ولا قال “في شبه الخطيّة”. لأنه لم يخطيء، إنما صار خطية لأجلنا. جاء فى شبه جسد الخطية… قيل “في شبه” لأنه مكتوب: “هو إنسان من يعرفه؟” (إر 17: 9 الترجمة السبعينية). حسب الناسوت إنسان، في الجسد، حتى يمكن أن يُعرف، لكنه في القوّة هو فوق الإنسان لا يمكن أن يُدرك. أخذ جسدنا لكنه ليس له سقطات الجسد[6].
القدّيس أمبروسيوس
- جاء من هذا الجسد، لكنه ليس كسائر البشر، لأن العذراء لم تحبل به بالشهوة وإنما بالإيمان.
جاء في العذراء هذا الذي هو قبل العذراء.
اختارها الذي أوجدها، خلقها ذاك الذي سبق فاختارها.
وهبها الإثمار ولم ينزع عنها طهارتها التي لم تمس[7].
القدّيس أغسطينوس
د. جاء في تعليقات القدّيس أثناسيوس الرسولي وغيره من الآباء تأكيد علّة قبوله “شبه جسد الخطيّة”، ألا وهو اتحاده بطبيعتنا لننعم بالاتحاد معه، ونتمتع بعمله فينا بكوننا أعضاء جسده.
- صار إنسانًا ليؤلهنا فيه.
وُلد من امرأة، من عذراء، ليغير جيلنا الخاطي، فيصير جنسًا مقدسًا، شركاء في الطبيعة الإلهية، كما كتب الطوباوي بطرس (2 بط 1: 4).
- بسبب حسن مُسح الرب الذي بطبيعته غير المتغيّرة هو محب للبرّ ومبغض للإثم، وأُرسل دون أن يتغير حاملاً الجسد المتغير ليدين فيه الخطيّة، ويؤكّد له الحرّية والقدرة، محققًا برّ الناموس فيه، بهذا يمكننا أن نقول: لسنا في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنًا فينا (رو 8: 9)[8].
البابا أثناسيوس الرسولي
ثانيًا: التمتّع بالبرّ
لم يقف الأمر عند حدود العتق من الدينونة، وإنما نحمل البرّ الذي يشتاق الناموس أن نتمتع به لكنه يعجز عن تقديمه.
يقول الرسول: “لكي يتم برّ الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح” [4].
ماذا يعني أن يتحقّق برّ الناموس فينا؟ يري القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن “البرّ” هنا لا يعني مجرّد عدم وجود خطيّة، وإنما [البر بالنسبة لنا هو التمتّع بالنصرة[9]]، وأن البرّ لا يعني مجرّد الامتناع عن الخطيّة، وإنما التزيّن بالصلاح أيضًا، فلا يقف عند السلبيات، إنما يجب ممارسة الإيجابيات.
مرة أخرى يؤكّد القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن “البرّ” حياة ديناميكية مستمرّة، وعمل روحي غير متوقف، لذا يقول: [في هذه العبارة يظهر بولس أن المعموديّة لا تكفي لخلاصنا ما لم نمارس حياة لائقة بهذه العطيّة بعد نوالها[10].]
ثالثًا: الانشغال باهتمام الروح لا باهتمام الجسد
“فإن الذين هم حسب الجسد فيما للجسد يهتمون،
ولكن الذين حسب الروح فيما للروح،
لأن اهتمام الجسد هو موت،
ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام،
لأن اهتمام الجسد هو عداوة الله،
إذ ليس هو خاضعًا لناموس الله،
لأنه أيضًا لا يستطيع،
فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله،
وأمّا أنتم فلستم في الجسد بل في الروح،
أن كان روح الله ساكنًا فيكم…“ [5-9].
يلاحظ في حديث الرسول بولس عن اهتمام الروح واهتمام الجسد الآتي:
أ. لا يقارن الرسول هنا بين جوهر الجسد أي الجسم بأعضائه وبين الروح، وإنما بين اهتمام الجسد واهتمام الروح، فيقصد باهتمام الجسد شهوات الجسد واهتماماته واشتياقاته الجسدانيّة، ويقصد باهتمام الروح اشتياقات الروح واهتماماتها الروحيّة.
مرة أخرى نؤكد أن الإنسان بجسده وروحه يمثل وحدة واحدة، إن ترك لجسده العنان يتلذّذ بشهوات جسدانية، يتعدّى الجسد حدوده فيُحسب جسدانيًا، إذ يسلك الإنسان ككل بفكره ونفسه وجسده، بطريقة جسدانيّة، وكأنه قد صار جسدًا بلا روح. وعلي العكس إن سلّم حياته كلها تحت قيادة الروح القدس تتقدّس روحه الإنسانيّة، ويتقدّس جسده بكل أحاسيسه وعواطفه، فيسلك الإنسان ككل، كما لو كان روحًا بلا جسد، إذ يتصرف حتى الجسد بطريقة روحية.
خلال هذه النظرة يمكننا أن نعرف اهتمام الجسد، بمعنى ترك الإنسان الجسد على هواه ليتعدّى حدوده، فتخضع حتى النفس لتحقيق هوى الجسد، أمّا اهتمام الروح فيعني خضوع الإنسان لروح الله، فيسلك كإنسان روحي، يحقّق هوى الروح. الأول يثمر موتًا للنفس والجسد على مستوى أبدي، والثاني يهب حياة وسلاما أبديًا [6]. الأول يخلق عداوة لله [7] إذ يطلب الإنسان ملذاته على حساب صداقته مع الله، أمّا الثاني فيجد رضّا في عيني الله.
بهذا الفهم يفسّر القدّيس يوحنا ذهبي الفم العبارة: “فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله” [8]، قائلاً: هل نقطع جسدنا إربًا حتى نرضي الله، هاربين من طبيعتنا البشريّة؟ هذا التفسير الحرفي غير لائق، فهو لا يقصد الجسم الإنساني ولا جوهره، إنما يعني الحياة الحيوانيّة العالميّة المستهترة التي تجعل الإنسان جسدانيًا، حتى النفس تصير جسدانية، فتتغيّر طبيعتها ويتشوّه نبلها.
وأيضًا حين نسمع: “أمّا أنتم فلستم في الجسد بل في الروح“، لا نفهم بهذا أننا خلعنا الجسم الإنساني، لكنّنا ونحن في هذا الجسم قد تركنا تيّار الشهوات الجسدانيّة، فصرنا كمن هم بلا جسد من جهة الشهوات. استخدم السيد المسيح نفسه هذا التعبير حين قال لتلاميذه: “أنتم لستم من هذا العالم”، بمعنى أنهم لا يحملون فكر العالم الأرضي وشهواته الزمنيّة بالرغم من وجودهم في العالم.
بنفس المعنى يقول القدّيس إيريناؤس: [بهذه الكلمات لا يجحد مادة الجسم، وإنما يظهر ضرورة أن يكون الروح القدس منسكبًا فيه. فهو بهذا لا يمنعهم من الحياة وهم حاملون الجسد، إذ كان الرسول نفسه في الجسد حين كتب لهم هذا، إنما كان يقطع شهوات الجسد التي تجلب الموت للإنسان[11].] كما يقول: [لا يتحقّق هذا بطرد الجسد وإنما بشركة الروح، لأن من يكتب إليهم ليسوا بدون جسد، إنما تقبّلوا روح الله الذي به نصرخ: “أبا الآب” (8: 15)[12].]
ويرى القدّيس إكليمنضس السكندري أن التعبيرين “في الروح” و“ليسوا في الجسد” إنما يعني أن الغنوسيّين أي أصحاب المعرفة الروحيّة الحقّة يرتفعوا فوق أهواء الجسد: [إنهم اسمى من اللذّة، يرتفعون فوق الأهواء، يعرفون ماذا يفعلون. الغنوسيّيون أعظم من العالم[13].]
ب. إن اهتمام الروح ليس من عنديّاتنا، إنما هو ثمر سكنى السيد المسيح فينا، الذي بسكناه يُميت الحياة الجسدانيّة الطائشة، فيحيا الإنسان بكلّيّته، جسمًا ونفسًا، في انسجام كعضو في جسد المسيح، إذ يقول الرسول: “وإن كان المسيح فيكم، فالجسد ميّت بسبب الخطيّة، وأمّا الروح فحياة بسبب البرّ [10]
السالك بالروح القدس إنما ينعم بالمسيح أيضًا ساكنًا فيه، إذ يقول الرسول: “وإن كان المسيح فيكم…“ وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [ينطق (الرسول) بهذا لا ليؤكّد أن الروح هو نفسه المسيح، حاشا، وإنما ليُظهر أن من له روح المسيح، يكون له المسيح نفسه. فإنه لا يمكن إلا حيث يوجد الروح يوجد المسيح أيضًا، لأنه حيث يوجد أحد الأقانيم الثلاثة يكون الثالوث القدوس حالاً، لأن الثالوث غير منقسم على ذاته، بل له وحدة فائقة للغاية… الآن تأمّل عظمة البركات التي ننعم بها بنوالنا الروح: بكونه روح المسيح، يكون لنا المسيح نفسه، ونصير مناظرين للملائكة، وننعم بالحياة الخالدة، ونتمسّك بعربون القيامة، ونركض بسهولة في سباق الفضيلة[14].]
يكمل القدّيس الذهبي الفم تعليقه على العبارة الرسولية مظهرًا أن الجسد الذي لم يكن خاملاً فحسب بسبب الخطيّة بل كان ميتًا، ها هو بالمسيح الساكن فينا صار رشيقًا يركض بسهولة في ميدان الفضيلة لينال الجعالة… الجسد بذاته ميّت بالخطيّة لكن بالله الروح تمتّع بالحياة التي لا تنحلّ، وصار له برّ المسيح.
هكذا إذ يتحدّث عن سكنى المسيح فينا يُعلن عن “برّ المسيح” الذي لا يقف عند إماتة الحياة الشهوانيّة الجسدانيّة وإنما ينعم بتجلّي الحياة بحسب الروح [10]… يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول بولس يشجّع السامع معلنًا عن البرّ كمصدر للحياة، لأنه حيث لا توجد خطيّة لا يوجد الموت، وحيث لا موت تكون الحياة غير قابلة للانحلال.
رابعًا: التمتّع بالقيامة
إن كان ناموس الخطيّة قانونه الموت الأبدي، فإن ناموس الروح الذي يهبه لنا المسيح قانونه القيامة من الأموات، على مستوى أبدي. يهبنا السيد المسيح روحه القدوس ساكنًا فينا، الروح الذي أقام السيد المسيح من الأموات، إذ هو قادر أن يقيم طبيعتنا الساقطة، فينزع عنها ناموس الخطيّة أو الحياة الجسدانيّة الشهوانيّة ليهبنا الطبيعة الجديدة، الطبيعة المُقامة في المسيح يسوع، يسودها ناموس القيامة والحياة. هذا ما أعلنه الرسول بقوله: “وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنًا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات، سيُحيي أجسادكم المائتة أيضًا بروحه الساكن فيكم” [11].
يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم:
[مرة أخرى يمسّ (الرسول) نقطة القيامة بكونها أكثر الأمور تبعث الرجاء في السامع، وتهبه ضمانًا لما يُحدّث له في المسيح، فلا تخف إذن لأنك مثقّل بجسد مائت. ليكن لك الروح فستقوم ثانية لا محالة…
حقًا سيقوم الكل، لكن لا يقوم الكل ل لحياة، إنما يقوم البعض للعقاب والآخرون للحياة (يو 5: 29)…
أنه لا يعاقبك إن رأى روحه يشرق فيك، بل يوقف العقاب… ويدخل بك إلى حِجال العرس لتكون هناك مع العذارى (تك 25: 12).
ليتك إذن لا تسمح لجسدك (الحياة الجسدانيّة) أن يعيش في هذا العالم، لكي يعيش جسدك هناك.
ليمت كي لا يموت! فإن احتفظت به هنا حيًا لا يعيش، وإن مات يحيا.
هذا هو حال القيامة بوجه عام. إذ يجب أن يموت أولاً ويدفن، عندئذ يصير خالدًا.
ولكن هذا يُحدّث في جرن المعموديّة، حيث يتحقّق الصلب والدفن وعندئذ القيامة. هذا أيضًا ما حدث بالنسبة لجسد الرب، إذ صُلب ودفن وقام. ليحدث هذا أيضًا بالنسبة لنا، فتكون لنا الإماتة المستمدة عن أعمال الجسد. لا أقصد موت جوهر الإنسان، فإن هذا بعيد عن قصدي، إنما موت ميوله نحو الأمور الشرّيرة، فإن هذا هو الحياة أيضًا، بل ما هو هذا إلا حياة[15].]
يرى القدّيس أمبروسيوس[16] في هذه العبارة الرسولية: “سيحيّ أجسادكم المائته أيضًا بروحه الساكن فيكم” [11]، تأكيدًا لوحدة العمل بين الثالوث القدوس، فإن الآب يحيي من يشاء، وأيضًا الابن (يو 5: 21)، كذلك الروح القدس. وقد جاء في حزقيال: “هلم يا روح من الرياح الأربع وهبّ على هؤلاء القتلى ليَحيوا… فدخل فيهم الروح فحَيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدًا جدًا” (حز 37: 9-10).
خامسًا: الشعور بالدين للروح
“فإذن أيها الإخوة نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد،
لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون،
ولكن إن كنتم بالروح تُميتون أعمال الجسد فستحيون” [12-13].
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة هكذا:
[بعد أن أظهر عظم مكافأة الحياة الروحيّة إذ تجعل المسيح ساكنًا فينا، وتُحيي أجسادنا المائتة، وتهبها أجنحة لتطير بها إلى السماوات، وتجعل طريق الفضيلة سهلاً، بلياقة، يحثنا لتحقيق هذا الهدف. لم يقل: “يلزمنا ألا نعيش حسب الجسد”، وإنما قال هذا بطريقة أكثر إثارة وقوة هكذا: “نحن مدينون للروح”. هذا ما عناه بقوله. “نحن مدينون ليس للجسد”.
في كل موضع يؤكّد أن ما يقدّمه الله لنا ليس على سبيل الدين وإنما مجرّد نعمة (مجّانية). ولكن بعد هذا يوضّح أن ما نفعله نحن ليس بتقدمة اختياريّة، إنما هو دين (مقابل معاملات الله لنا)، إذ يقول: “قد اُشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدًا للناس” (1 كو 7: 23)، كما يكتب: “إنكم لستم لأنفسكم” (1 كو 6: 19)، وفي موضع آخر يثير ذات الفكر في أذهانهم بقوله: “وهو مات لأجل الجمع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم” (2 كو 5: 15). لقد أراد أن يثبت هذا بقوله: “نحن مدينون“… بقوله: “نحن مدينون ليس للجسد“، ولئلاّ تظن أنه يتحدّث عن طبيعة الجسد قال: “إن عشتم حسب الجسد”...
يقدّم لنا هنا تعليمًا… وهو أنه يلزمنا ألا نعيش حسب الجسد، بمعنى ألا نجعله سيِّد حياتنا، إنما ليكن الجسد هو التابع لا القائد، ليس هو الذي يدبِّر حياتنا، بل ناموس الروح هو الذي يدبرها. بإبرازه هذه النقطة، وتأكيده أننا مدينون بالروح، وإظهاره منافع هذا الدين الذي علينا للروح، لا يتحدّث عن الأمور الماضية بل عن الأمور المقبلة… فإن نفع الروح لا يقف عند هذا فقط، إنه حرّرنا من خطايانا السابقة، بل يهبنا حصانة ضد خطايانا المقبلة، ويحسبنا أهلاً للحياة الخالدة (ستحيون[17]).]
- وهبك المخلص الروح الذي به تميت أعمال الجسد[18].
القدّيس أغسطينوس
سادسًا: التمتّع بروح البنوّة
ركّز الرسول بولس في هذا الأصحاح وهو يتحدّث عن “ناموس الروح، وبرّ المسيح”، عن شعورنا أننا مدينون للروح القدس الذي يعتقنا من الدينونة مادمنا نسلك حسب الروح، ويهبنا روح الغلبة والنصرة فنواجه حرب الخطايا بقوّة، ونركض في ميدان الفضيلة، منطلقين نحو السماء كما بأجنحة الروح. أخيرًا، يكشف لنا الرسول عن عمل هذا الروح الإلهي فينا، لا بتقديم إمكانيات إلهية إلينا فحسب، وإنما بتجديد مركزنا بالنسبة لله، فيعتقنا من العبوديّة لنحتل مركز البنوّة الفائق الذي به نصرخ نحو الآب قائلين: “يا أبّا الآب”، نُحسب بالحق أولاد الله، لنا حق الميراث مع المسيح.
“لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله،
إذ لم تأخذوا روح العبوديّة أيضًا للخوف،
بل أخذتم روح التبنّي
الذي به نصرخ يا أبّا الآب؛
الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله” [14-16].
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على هذه العطيّة بقوله:
[الآن فإن هذه أيضًا أعظم كرامة من الأولى. ولهذا لم يقل “لأن كثيرين يعيشون بروح الله”، إنما يقول “لأن كثيرون ينقادون بروح الله”، مظهرًا أنه يستخدم سلطانًا على حياتهم (يقتادهم) كربانٍ يقود سفينة، أو سائق مركبة على زوج من الفرس، فهو لا يقود الجسد فقط وإنما النفس أيضًا، يملك عليهما… ولأنه يخشى بسبب الثقة في عطيّة جرن المعموديّة يهملون في رجوعهم بعد نوالهم العماد، لذا يود أن يقول لهم أنكم وإن نلتم المعموديّة ولا تنقادون للروح فإنكم تفقدون الكرامة التي نلتموها وسمو بنوّتكم[19].]
يرى ذات القدّيس أن قول الرسول: “لم تأخذوا روح العبوديّة” يُشير إلى العهد القديم حيث لم ينل اليهود روح البنوّة، إنما بنوالهم الناموس مجردًا عاشوا تحت تهديدات العقوبة في خوف كعبيدٍ، أمّا في العهد الجديد فلم تعد مكافأة الوصيّة أمورًا زمنية ولا عقابها زمنيًا، إنما قُدمت الوصيّة للبنين، ليكون الله نفسه هو مكافأتنا، ننعم به أبًا أبديًا، نناديه “أبًا”، وهي كلمة أرامية توجه لمناداة الأب.
يُعلّق القدّيس أغسطينوس على القول: “روح العبوديّة أيضًا للخوف“، قائلاً: [يوجد نوعان من الخوف ينتجان صنفين من الخائفين. هكذا يوجد نوعان من الخدمة يقدّمان نوعين من الخدام. يوجد خوف يطرده الحب الكامل خارجًا (1 يو 4: 18)، كما يوجد نوع آخر من الخوف هو طاهر ويبقى إلى الأبد (مز 19 : 9). يُشير الرسول هنا إلى الخوف الذي ليس للمحبّة… كما يُشير في موضع آخر إلى الخوف الطاهر، بقوله: “لا تستكبر، بل خف“ (رو 11: 20)[20].]
بهذا الروح نحمل لغة البنين في حديثنا مع الله كأب لنا، فنصرخ بالروح القدس الساكن فينا، واهب البنوة، لنقول: يا “أبًا”. هذا الصوت الذي نصرخ به كما يقول القدّيس جيروم: [لا يخرج من الشفاه بل من القلب، ففي الحقيقة يقول الله لموسى: “مالك تصرخ إليّ؟” (خر 14: 15)، وبالتأكيد لم ينطق موسى بكلمة[21].]
- بالحري يجدر بهم أن يفهموا أنهم إن كانوا أبناء الله، فبروح الله ينقادون ليفعلوا ما ينبغي فعله. وعندما يفعلون هذا يقدّمون الشكر لله الذي به فعلوا… وهذا لا يعني أنهم لم يفعلوا شيئًا (أي لا يحرمون من نسبة هذه الأعمال إليهم).
- إنه يعني عندما تميتون بالروح أعمال الجسد فتحيون [13] مجدوا الله، اشكروه، قدّموا له التشكرّات، ذاك الذي تنقادون بروحه، لكي تقدروا على السير في هذه الأمور لتظهروا كأبناء الله[22].
القدّيس أغسطينوس
يحدّثنا القدّيس كبريانوس عن التزاماتنا كأولاد الله، قائلاً: [إن كنّا أولادًا لله، إن كنّا بالفعل قد بدأنا أن نكون هياكله، إن كنّا نقبل روحه القدوس، يلزمنا أن نحيا بالقداسة والروحانيّة. إن كنّا نرفع أعيننا عن الأرض نحو السماء، إن كنّا نرفع قلوبنا، ونمتليء بالله (الآب) والمسيح بالعلويات والإلهيات، فليتنا لا نفعل إلا ما يليق بالله والمسيح، كما يحثّنا الرسول، قائلاً: “فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتمّوا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد مُتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أُظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تُظهرون أنتم أيضًا معه في المجد” (كو 3: 1-4). ليتنا نحن الذين في المعموديّة متنا ودفنا عن الخطايا الجسديّة التي للإنسان القديم وقمنا مع المسيح في التجديد السماوي نفكر في أمور المسيح ونمارسها[23].]
هذا ويروي القدّيس غريغوريوس أسقف نيصص[24] إن عطيّة البنوّة التي ننالها بالروح القدس هي عطيّة السيد المسيح نفسه، هذا الذي حمل مالنا ليهبنا ما له، فحمل موتنا ولعنتنا وخطايانا وعبوديتنا لينزع هذا كله عنّا، فلا نُحسب بعد عبيدًا بل أبناء وأحباء.
ويُعلّق القدّيس أغسطينوس[25] على تعبير “أبًا الآب”، قائلاً أن كلمة “أبا” تقابل في اللاتينية Pater وهي تعني أيضًا “الآب”، وكأن الكنيسة تكرر الكلمة، إذ تصرخ بلغة اليهود “أبًا” وبلغة الأمم “الآب”، فهي كنيسة واحدة تضم أعضاء من اليهود والأمم يشعر الكل بأبوة الله لهم بلا تمييز.
يشهد بهذه البنوّة الروح القدس نفسه الذي يسكن فينا واهبا إيّانا “كرامة البنوّة”، إذ يقول الرسول: “الروح نفسه أيضًا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله” [16].
سابعًا: التمتّع بالميراث
إذ ننال روح البنوة، نُحسب أبناء الله لنا حق الميراث الأبدي، وكما يقول الرسول: “فإن كنّا أولادًا فإننا ورثة أيضًا، ورثة الله، ووارثون مع المسيح” [17].
ظن اليهود أنهم كأصحاب للناموس هم ورثة المواعيد دون سواهم، لكن الرسول بلطفٍ يكشف لهم أن الأمم إذ نالوا روح البنوّة بالمعموديّة صاروا ورثة الله، وكما قال السيد المسيح نفسه: “أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديًا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين“ (مت 21: 41)، كما قال: “وأقول لكم أن كثيرون سيأتون من المشارق والمغارب ويتّكئون مع إبراهيم واسحق في ملكوت السماوات، وأمّا بنو الملكوت فيُطرحون إلى الظلمة الخارجية“ (مت 8: 11-12).
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [أضاف إلي قوله إننا ورثة الله “وارثون مع المسيح“. لاحظ طموحه، فإنه يريد أن يقترب بنا إلي السيد. فحيث أنه ليس كل الأبناء ورثة أظهر أننا أبناء وورثة أيضًا. ولما كان ليس كل الورثة ينالون ميراثا عظيمًا أبرز هذه النقطة بكوننا ورثة الله. مرة أخرى إذ يمكن أن نكون ورثة لله ولكن ليس ورثة مع الابن الوحيد أظهر أن لنا هذا أيضًا[26].]
ثامنا: الشركة مع المسيح المتألم والممجد
إن كان الروح القدس يهبنا الميراث كأبناء لله، نرث الله مع المسيح… فإن هذا الميراث هو عطية مجانية لا فضل لنا فيها، لكنها لا تُقدم للخاملين بل للجادين في الشركة مع المخلص، الذين لهم شركة في آلامه يتمتعون بشركة أمجاده ” إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه ” [17].
- تجديد الخليقة وعمل الروح
سبق فحدثنا عن “ناموس الروح” مبرزًا عمل الله فينا، أنه يعتقنا من الدينونة إن سلكنا بالروح القدس وليس حسب شهوات جسدنا، ويهبنا اهتمام الروح الذي هو الحياة والسلام، وننعم بسكنى السيد المسيح فينا فيهبنا برّه، وننعم بعربون القيامة عاملاً فينا، ونشعر بالدين نحو الروح الذي يهبنا البنوة لله والميراث مع المسيح والشركة معه. الآن يحدثنا عن عمل الروح فينا وأثره حتى على الخليقة غير العاقلة، مبرزًا ترقب العالم المخلوق من أجلنا لعودتنا إلي الأحضان الإلهية كأبناء لله بعد أن تركناه زمانًا فسببنا للأرض اللعنة وللخليقة فسادًا. هذا من جانب، ومن جانب آخر إذ نعود الآن لنختبر عربون الروح بقيامة نفوسنا من موت الخطية تتمتع أيضا أجسادنا بهذه القيامة مترقبة يوم الرب العظيم بصبرٍ ليعيش الإنسان بكليته، نفسًا وجسدًا، في كمال قوة القيامة أبديًا. ولئلا يستصعب المؤمن هذا أكدّ دور الروح القدس نفسه، واهتمامه بنا، لتحقيق هذا العمل فينا.
أولاً: بدأ الرسول حديثه بالقول: “فإني أحسب أن الآم الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا” [18].
وضع هذه العبارة كخاتمة للحديث السابق وافتتاحية للحديث الجديد، فإنه إذ كان يتحدث عن “برّ المسيح” وارتباطه بناموس الروح، كاشفًا عن عمل الروح فينا، خاصة البنوة لله والتمتع بالميراث أراد أن يوضح أن حياتنا مع الله ليست هروبًا من الضيق والألم الحاضر، وإنما هي ارتفاع على الآلام الحاضرة خلال انفتاح القلب علي المجد الأبدي. وكأن الرسول بعد أن عرّفنا علي عطايا الله غير المدركة إذا به يقودنا بثقة وسط آلام هذا الزمان وأخطاره، معلنًا أن اتحادنا مع الله بروحه القدوس في ابنه لا يغير الظروف المحيطة بنا بل يهبنا اتساعًا في القلب والفكر وقوة للنفس لتجتاز كل الظروف بنبلٍ من أجل الأمجاد الأبدية.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم علي هذه العبارة قائلاً: [لاحظ كيف يهدئ روح المصارعين ويرفعها في نفس الوقت، فإنه بعد ما أظهر أن المكافآت أعظم من الأتعاب، يحثهم لاحتمال متاعب أكثر دون أن يستكبروا، إذ لا يزالوا يغلبون لنوال الأكاليل كمكافأة لهم. في موضع آخر يقول: “لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجًد أبديًا”(2 كو 4: 17). هنا لم يقل إن الآلام خفيفة، لكنه يربط الآلام بالراحة خلال إعلان المكافأة بالصالحات العتيدة. “فإني أحسب أن الآلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا” [18]… لم يقل “المجد الذي سيكون لنا” وإنما “يُستعلن فينا”، كما لو كان المجد فينا فعلاً لكنه لم يستعلن بعد… هذا أوضحه أكثر في موضع آخر: “حياتنا مستترة مع المسيح في الله” (كو 3: 3)… هذه الآلام ـ أيًا كانت ـ مرتبطة بحياتنا الحاضرة، أما البركات القادمة فتبلغ عصورًا بلا حدود[27].]
هذا الحديث الرسولي عن المجد الأبدي الذي يُستعلن فينا خلال الآلام الزمنية المؤقتة ألهب قلب المؤمنين للانطلاق بالحب الإلهي على مستوى سماوي يرفع نفوسهم فوق كل ألم وضيق أو طلب خير زمني أو بركة مؤقتة:
- المحبة لا تجد شيئا ثقيلاً؛ الغيور لا يعرف عملا صعبًا. تأمل ما احتمله يعقوب من أجل راحيل المرأة التى وُعد بها، إذ يقول الكتاب المقدس: “فخدم يعقوب براحيل سبع سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها“ (تك 29: 20). لقد أخبرنا بنفسه بعد ذلك عما احتمله: “كنت في النهار يأكلني الحرّ في الليل الجليد“ (تك 31: 40). هكذا يليق بنا أن نحب المسيح ونطلب على الدوام قبلاته، وعندئذ يبدو كل صعب سهلاً لنا، وما هو طويل يصير قصيرًا.
لنُضرب بسهام حبه (مز 120: 5) فنقول في كل لحظة: “الويل لي فإن غربتي قد طالت عليّ” (مز 120: 5).
- إن تطلعت أن ترث خيرات العالم لا تقدر أن تكون شريكًا مع المسيح في الميراث.
- إنك طماع للغاية يا أخي، إذ تود أن تبتهج بالعالم هنا وتملك مع المسيح هناك[28].
القديس جيروم
- [إلى المُقدمين للاستشهاد في المناجم:]
إنكم تنتظرون كل يومٍ بفرحٍ يوم رحيلكم المنقذ.
ها أنتم قد تركتم العالم بالفعل، وتسرعون نحو مكافاءات الاستشهاد، نحو المنازل الإلهية، لكي تروا
بعد ظلمة العالم هذه النور اللائق، وتتقبلون مجدًا أعظم من كل الآلام والأحزان[29].
الشهيد كبريانوس
- “فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا” [18]. أنظر فإن النير هين والحمل خفيف (مت 11: 29). فإنه وإن كان عسيرًا علي القليلين الذين اختاروه، لكنه سهل بالنسبة للذين يحبونه. يقول المرتل: “علي حسب كلامك شفتيك لزمت طرقًا وعرة” (مز 26: 4)[30].
القديس أغسطينوس
ثانيًا: إذ يعلن الرسول أن الروح لا ينزع عن المؤمن الآلام والضيقات إنما يهبه مجدًا خفيًا في الداخل وسط الآلام الخارجية، يُستعلن هذا المجد في يوم الرب العظيم، ينتقل من حياة المؤمن الداخلية إلي الخليقة عينها، قائلا:“لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله” [19].
ماذا يقصد بالخليقة التي تترقب في شوقٍ إعلان بنوتنا لله؟
يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول يقصد بالخليقة هنا العالم كله بما فيه من جمادات. فإن كان الله قد خلق العالم كله من أجل الإنسان ليحيا سيدًا فيه يحمل صورته الإلهية ومثاله، فإن فساد الإنسان انعكست آثاره حتى علي الخليقة، فعندما سقط آدم جاء الحكم: “ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكًا وحسكًا تنبت لك” (تك 3: 17-18). قاوم الإنسان إلهه، فأثمرت مقاومته مقاومة الخليقة له، لكنها حتى في هذه المقاومة كأنها تترجى عودته إلى حضن الله كابن له فتعود هي متهللة من أجل الإنسان الذي خلقت لأجله.
صوّر الرسول بولس الخليقة كشخصٍ يئن ويتمخض معًا يترجى صلاح الحياة كلها. غير أن هذا لا يُفهم بصورة حرفية مادية وإلا توقعنا أن تعود البشرية كما مع آدم في الفردوس الأول الأرضي المادي ويبقى الفردوس خالدًا، الأمر الذي يتنافى مع فكر المسيح وروح الإنجيل، إنما أراد الرسول أن يبرز فاعلية عمل السيد المسيح في حياة الإنسان، حتى تكاد الخليقة غير العاقلة أن تنطق متهللة من أجل المصالحة مع الله وعودته إلى الأحضان الأبوية.
في أوضاع استثنائية سمح الله للطبيعة العنيفة أن تخضع للمؤمن، كملاطفة الحيوانات المفترسة الجائعة للشهداء في الساحات الرومانية، وعدم فاعلية السم علي بعضهم، وسكنى بعض المتوحدين والسواح مع الحيوانات البرية، وإعالة البعض في الصحراء بواسطة غربان الخ. هذا كله لم يكن قاعدة عامة إنما تحققت بفيض خاصة في عصور الضيق الشديد لمساندة الإيمان بطريقة ملموسة، ولتأكيد العطايا الإلهية الداخلية غير المنظورة والأمجاد السماوية المترقبة.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:
[يجعل (الرسول بولس) من العالم كله أشبه بشخصٍ، كما سبق ففعل الأنبياء عندما قدموا الأنهار تصفق بالأيادي (مز 98: 8)، والتلال تقفز، والجبال تتحرك، لا لنتخيل هذه الكائنات الجامدة أشخاصًا حية، فننسب لها قوة العقل، وإنما لكي ندرك عظمة البركات وكأنها قد أثارت الخليقة غير الحسية أيضًا. يستخدمون ذات الأسلوب أيضا في الظروف المؤلمة حيث يصورون الكرمة تنتحب والخمر يبكي والجبال وعوارض الهيكل تصرخ، لندرك مدي بشاعة الشر. هكذا امتثل الرسول بالأنبياء فجعل من الخليقة هنا أشبه بكائن حي يئن ويتمخض، لتظهر عظمة الأمور المقبلة…
ما معنى أن الخليقة أخضعت للباطل [20]؟ لماذا صارت فاسدة؟ وما هو السبب؟ بسببك أنت أيها الإنسان، فإنك إذ حملت جسدًا ميتًا قابلا للآلام تقبلت الأرض لعنة وأنبتت شوكا وحسكًا.
حتى السماء إذ تبلى مع الأرض ستتحول إلي حالة أفضل، اسمع ما ينطق به النبي: “من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك؛ هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير” (مز 102: 25ـ26). ويعلن إشعياء ذات الأمر، بقوله: “ارفعوا إلى السماوات عيونكم وانظروا إلى الأرض من تحت، فإن السماوات كالدخان يضمحل، والأرض كالثوب تبلى، وسكانها يموتون (مثلها)” (إش 51: 6).
ها أنت ترى بأي معنى سقطت الخليقة في عبودية الباطل، وكيف تتحرر من حالة الفساد؟…
لقد حاصرها الشر لأجلك وصار مفسدًا، مع أن (الخليقة) لم ترتكب خطأ من جانبها، ولأجلك أيضًا سيحدث عدم الفساد. هذا هو معنى “علي الرجاء” [20].
عندما يقول أنها أخضعت “ليس طوعًا” لا ليظهر أن ما قد حدث لها وإنما لكي نتعلم عناية المسيح للكل، فإن إصلاح الخليقة لا يكون من ذاتها[31].]
الآن، ما هو رجاء الخليقة؟
“لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلي حرية مجد أولاد الله” [21].
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:
[الآن، ما هي هذه الخليقة؟ إنها لا تعنيك أنت وحدك، وإنما معك أيضًا الخليقة الأدنى، التي لا تشترك معك في العقل أو الحس، هذه تشاركك بركاتك.
يقول “ستعتق من عبودية الفساد”، بمعنى أنها لا تعود تصير فاسدة، وإنما تتمشى جنبًا إلي جنب مع الجمال الذي يُوهب لجسدك. فكما أنه عندما صار جسدك فاسدًا فسدت هي أيضًا، هكذا الآن إذ صار جسدك غير فاسد تتبعه هي أيضًا. وإذ يعلن الرسول هذا يبلغ إلي النتيجة: “إلى حرية مجد أولاد الله”، فتتحقق حريتها.
إنه يشبه مربية تربي ابن ملك، عندما ينال الابن سلطان أبيه تتمتع هي معه بالخيرات، هكذا أيضًا بالنسبة للخليقة معنا.
ها أنت ترى في كل الأمور أن الإنسان يحتل مركز القيادة، فمن أجله خُلقت كل الأشياء.
انظر كيف يلطف (الرسول) المصارع، مظهرًا محبة الله غير المنطوق بها من نحو الإنسان، إذ يود أن يقول: لماذا أنت مرتبك عند تجاربك؟ فإن كنت تتألم من أجل نفسك فإنه حتى الخليقة تتألم بسببك. وليس فقط يلطف، وإنما يظهر أيضًا أن ما ينطق به أمر ذو أهمية. لأنه إن كانت الخليقة التي أوجدت بكاملها لأجلك هي “علي رجاء” فكم بالأولى يليق بك أنت أن تكون علي رجاء، يا من مِنْ خلالك ستتمتع الخليقة بتلك الخيرات؟
كما أن الآباء إذ يرون الأبناء في طريقهم لنوال كرامة يُلبسون الخدم ثيابًا بهية من أجل مجد الابن، هكذا يلبس الله الخليقة عدم الفساد من أجل مجد حرية الأبناء[32].]
ويرى القديس غريغوريوس أسقف نيصص[33] أن الخليقة التي تئن علي رجاء هي جماعة السمائيين الذين كمن هم يئنون من أجل الإنسان ليفرحوا بتمتعه بالبنوة، وكما قال السيد المسيح إن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب (لو 15).
ويرى القديس إيريناؤس أن “الخليقة” هنا تعني “الجسد”، إذ يقول: “[من العدل أنه في ذات الخليقة التي فيها تعبوا وتألموا متزكين بكل طرق الاحتمال أن يتقبلوا مكافأة أتعابهم، وأنه في الخليقة التي فيها ذُبحوا من أجل محبتهم لله، فيها ذاتها ينتعشون مرة أخرى. الخليقة التي احتملوا فيها العبودية يملكون. فإن الله غنى في كل شيء، وكل شيء هو له. يليق إذن أن تُعاد الخليقة عينها إلي حالتها الأولى فتصير بلا مقاومة تحت سلطان البرّ كما أوضح الرسول في الرسالة إلى أهل رومية[34].]
ثالثا: الخليقة توبخنا برجائها كما بأنينها: إن كانت الخليقة التي تتمتع بالخيرات من أجلنا إذ سقطت تحت الفساد بسببنا تترجى مجدنا كأولاد لله لتلبس عدم الفساد، فإنها في هذا الانتظار كمن في حالة ولادة مستمرة تنتظر “جديدًا”، إذ يقول الرسول: “فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معًا إلى الآن” [22]. هذا هو حال الخليقة التي أُوجدت من أجلنا فكم بالحري يليق بنا أن نئن نحن أيضا ونتمخض بالآلام من أجل تمتعنا بكمال مجد البنوة لله ؟
رابعا: إن كانت الخليقة التي لم تنل شيئا قد امتلأت رجاءً وصارت كما في حالة ولادة تئن وتتمخض، فكم بالحري يليق بنا نحن الذين تمتعنا فعلاً بعمل الروح القدس في نفوسنا، فنلنا باكورة المجد في داخلنا لنترجى كمال عمله حين تخلص أجسادنا أيضا بقيامتها في يوم الرب العظيم، فتنعم مع النفوس بذات المجد، إذ يقول الرسول: “وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا” [23]؟
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن باكورة الروح الذي نلناه يدفعنا لهذا الأنين الداخلي المملوء رجاءً. هذه الباكورة عظيمة للغاية لا تقف عند غفران الروح لخطايانا، وإنما أيضا تهبنا البرّ والتقديس، وقد ظهرت هذه الباكورة في عصر الرسول بإخراج الرسل للشياطين وإقامة الموتى خلال ظلهم (أع 5: 15) وثيابهم (أع 19: 12). هذه هي الباكورة، فماذا يكون كمال الروح؟
إذن لنتوقع التبني كقول الرسول. كيف يكون هذا ونحن قد نلنا البنوة لله فعلاً؟ إننا نتوقع كمال مجد البنوة بقيامة الجسد من الأموات، كقول الرسول: “الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، ليكون علي صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته، أن يخضع لنفسه كل شيء” (في 3: 21)، “لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت” (1 كو 15: 53).
إذًا ما نلناه كباكورة الروح إنما يفتح باب الرجاء للإنسان ليجاهد بالصبر حتى يبلغ كمال الروح الذي يمجّد الإنسان بكليته نفسًا وجسدًا، علي مستوى أبدي، لذلك يكمل الرسول حديثه عن الرجاء لنوال كمال الروح قائلاً:
“لأننا بالرجاء خلصنا،
ولكن الرجاء المنظور ليس رجاءً،
لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضًا؟
وإن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر” [24ـ25].
أ. ماذا يعنى: “بالرجاء خلصنا“؟ يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:
[هذا يعنى أننا لا نطلب كل شيء لنا في هذه الحياة، وأن يكون لنا رجاء أيضًا، مؤمنين أن ما وعدنا به الله يحققه لنا، بهذا نحن خلصنا؛ فإن فقدنا الرجاء نفقد كل ما نلناه…
يود أن يقول: أتساءل، ألم تكن أنت خاضعًا لخطايا بلا حصر؟ ألم تكن يائسًا؟ ألم تكن تحت الحكم؟… ما الذي خلّصك إذن؟ الرجاء في الله وحده، وثقتك من جهة مواعيده وعطاياه، فإنه ليس لك شيء آخر تقدمه له. إن كان هذا هو الذي خلصك، فلنتمسك به الآن أيضًا. فمن قدم لك بركات عظيمة هكذا لا يمكن أن يخدعك في البركات المقبلة. لقد وجدك ميتًا ومحطمًا وسجينًا وعدوًا، فجعلك صديقًا وابنًا وحُرًا وبارًا ووارثًا معه، مقدمًا لك أمورًا عظيمة هكذا لم يكن يتوقعها أحد. هل بعد التمتع بمثل هذه العطايا بسخاءٍ وحبٍ يخونك في الأمور المقبلة؟…
هذا الطريق (الرجاء) خلصك من البداية؛ إنه العربون الذي أحضرته وحده إلى العريس. فلنتمسك به ولنحتفظ به، فإنك إن طلبت شيئًا في هذا العالم تفقد صلاحك الذي به صرت بهيًا، لهذا يكمل الرسول: قائلا: “ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا[35]؟”]
يقول القديس أغسطينوس: [وإذ ننتظر خلود الجسد وخلاص نفوسنا في المستقبل نتسلم العربون فيُقال إننا قد خلصنا[36].]
يشبه القديس أغسطينوس هذا الرجاء بالبيضة التي تحمل في داخلها حياة تقدمها خلال دفء الضيقات والآلام، إذ يقول: [إنها بيضة، وليس بعد (كتكوت). إنها مغلفة بقشرة، لكن لا تنظر إليها هكذا بل انتظر في صبر، ولتجعلها في دفء فستقدم حياة. اضغط عليها[37].]
ب. إن كانت باكورة الروح تدفعنا للتمسك بالرجاء لنوال كمال المجد الذي يهبه الروح للأبناء، فإن هذا الرجاء ليس بالعمل السلبي، بمعنى آخر يلتزم المؤمن أن يمارس دورًا إيجابيًا باحتماله الأتعاب الكثيرة والآلام من أجل رجائه في غير المنظورات، إذ يقول الرسول “نتوقعه بالصبر” [25]. هذا ما يؤكده الرسول علي الدوام: إبراز عمل النعمة الإلهية المجانية، لكن دون سلبية من جهة المؤمن!
ج. إن كان المؤمن في رجائه بالتمتع بكمال عمل الروح ليُعلن مجد أبناء الله أبديًا وذلك خلال الصبر، فإن هذا الصبر عينه هو عطية إلهية نقتنيها بالله نفسه، إذ يسندنا الروح القدس نفسه في جهادنا، حتى في الأمور البسيطة والضعفات، وكما يقول الرسول: “وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا” [26].
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لكي تعرف أنه ليس بأتعابك وحدها والمخاطر التي تواجهها إنما تقف النعمة بجانبك، حتى في الأمور التي تبدو هينة للغاية، إذ يعمل معك، وفي كل الأحوال يقوم بدوره في الاتحاد[38].]
د. إذ يتعرض الرسول بولس لعون الروح القدس لنا في جهادنا حتى في الضعفات البسيطة كي نلتهب بالرجاء ونثابر بالصبر، يبرز عملاً رئيسيًا للروح القدس في حياتنا، بقوله: “لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا يُنطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين” [26ـ27].
يرى القديس يوحنا الذهبي الفم[39] أن “الروح” هنا الذي يشفع فينا إنما يعنى القلوب الملتهبة بالروح القدس خلال “موهبة الصلاة “، إذ يعطى الروح القدس للبعض موهبة الصلاة عن الآخرين… فالروح يقترح علي النفوس المقدسة ما تصلي به من أجل إخوتها، لأنها لا تعلم ما تصلي لأجله كما ينبغي، فقد صلى بولس طالبًا أن يرى روما، وصلى موسى مشتهيًا رؤية فلسطين (تث 3: 26)، وطلب إرميا عن اليهود (إر 15: 1) وتشفع إبراهيم عن أهل سدوم (تك 18: 23)، ومع ما لهذه الصلوات من قيمة كبرى تكشف عن قلوب مقدسة محبة للآخرين، لكنها في رأي القديس يوحنا الذهبي الفم لم يكن هؤلاء يعرفون ما يصلون لأجله كما ينبغي، فالإنسان مهما بلغت قداسته يحتاج إلى عون الروح ليرشده حتى في الصلاة عن الآخرين.
الروح يسند ليس فقط في الصلاة عن الآخرين وإنما حتى من أجل الإنسان نفسه، لأنه كما يقول الأب إسحق تلميذ القديس أنبا أنطونيوس: [أحيانًا نسأل أمورًا تضاد خلاصنا، وبواسطة عنايته الإلهية يرفض طلباتنا، لأنه يرى ما هو لصالحنا بحق أعظم مما نستطيع نحن. وهذا ما حدث مع معلم الأمم عندما صلى أن ينزع منه ملاك الشيطان الذي سمح به الرب لأجل نفعه. “من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل” (2 كو 12: 8-9) [40].]
يعلق القديس أغسطينوس علي أنّات الروح القدس فينا، قائلاً: [لا يئن الروح القدس في ذاته مع نفسه في الثالوث القدوس، في جوهره الأبدي… إنما يئن فينا، أي يجعلنا نئن. فإنه ليس بالأمر الهين أن الروح القدس يجعلنا نئن، إذ يهبنا أن ندرك أننا غرباء نسلك في أرض غربتنا، ويعلمنا أن ننظر نحو وطننا، فنئن بشوق شديد[41].]
3. المسيح المبرر
إدراك تدبير الله لمحبيه
أبرز الرسول بولس حاجة المؤمن لإدراك خطة الله الخلاصية في حياته هو شخصيًا، إذ يقول: “ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده” [28].
خطة الله بالنسبة لنا فائقة، فهو لا يغير مجرى الأحداث والظروف حسب أهوائنا الشخصية، إنما يحّول كل الأمور بلا استثناء لبنيان نفس المؤمن الحقيقي، فتعمل حتى الظروف المضادة لمجده.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم علي هذه العبارة، قائلاً بأنه يليق بالمؤمنين ألا يختاروا لأنفسهم الحياة حسب فكرهم حاسبين أن هذا نافع لهم، إنما يقبلون ما يقترحه الروح القدس، لأن أمورًا كثيرة تبدو للإنسان نافعة تسبب له مضارًا كثيرة. كمثال قد يظن الإنسان أن الحياة الهادئة التي بلا مخاطر ولا متاعب نافعة له، لذلك طلب الرسول ثلاث مرات أن يرفع الله عنه التجربة، فجاءته الإجابة: “تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل” (2 كو 12: 8-9). بمعنى آخر لنترك كل الأمور في يديّ الروح ليحولها لبنيان نفوسنا.
مرة أخرى يؤكد القديس يوحنا الذهبي الفم إن كل الأمور التي تبدو مؤلمة تعمل لخير الذين يحبون الله، أما الذين لا يحبونه فحتى الأمور التي تبدو صالحة ومقدسة تعمل ضدهم إن لم يرجعوا إليه بالحب. ضرب أمثلة منها لم ينتفع اليهود بالناموس الصالح بل وتعثروا حتى في السيد المسيح.
- حتى الضيقات أو الفقر أو السجن أو المجاعات أو الميتات أو أي شيء آخر يحلّ بنا يستطيع الله أن يحول كل الأمور إلي نقيضها.
- كما أن الأمور تبدو ضارة تكون نافعة للذين يحبون الله، فإنه حتى الأمور النافعة تصير ضارة للذين لا يحبونه[42].
القديس يوحنا الذهبي الفم
- بالنسبة للكاملين والحكماء يُقال: “كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله”، أما بالنسبة للضعفاء الأغبياء فقد قيل أن كل شيء ضد الشخص الغبي (أم 14: 7)، فلا ينتفع من النجاح ولا ينصلح شأنه من المصائب … إذ ينهزم الإنسان بأكثر سهولة بالنجاح أكثر من الفشل، لأن الفشل يجعل الإنسان أحيانًا يقف ضد إرادته، وينال تواضعًا، خلال حزنه المفيد يقلل من خطيته وينصلح شأنه، أما النجاح فقد يدفع بالإنسان إلي الكبرياء العقلي والعظمة الكاذبة[43].
الأب تادرس
- ماذا يعنى بـ “كل الأشياء” إلا تلك الآلام المرعبة القاسية التي تحل بنا؟ فإنه بالحق يصير حمل المسيح الثقيل خفيفا بالرغم من ضعف محبتنا[44].
القديس أغسطينوس
يقدم لنا القديس جيروم[45] أيوب مثلاً حيًا لمن تتحول الأضرار بالنسبة إلى خيره، فلم يترك العدو شيئا في أيوب غير مضروبٍ سوى لسانه لعله يجدف به على الله، لكن هذه كلها آلت إلى خيره، فقد جاء إليه الله وتحدث معه علي مستوى الصديق مع صديقه.
يعلق كثير من الآباء على تسمية الذين يحبون الله هكذا: “الذين هم مدعوون حسب قصده” [28]، نقتطف الآتي:
- لو أن الدعوة وحدها كانت كافية فلماذا لم يخلص الكل؟… ليست الدعوة وحدها تحقق الخلاص، وإنما نِيَّة المدعوين. فالدعوة ليست ملزمة لهم ولا هي قهرية، إذ الكل مدعوون لكن لا يطيع الكل الدعوة[46].
القديس يوحنا الذهبي الفم
- يقول المخلص نفسه:”إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي” (يو 8: 31).
هل يحسب يهوذا من بين تلاميذه مادام لم يثبت في كلامه؟
هل يحسب من تلاميذه الذين قيل عنهم: “فعلم يسوع إن تلاميذه يتذمرون علي هذا، فقال لهم: أهذا يعثركم؟…” (يو 6: 59-66)؟
ألم يلقبهم الإنجيل “تلاميذ”؟ ومع هذا لم يكونوا تلاميذ حقيقيين، لأنهم لم يثبتوا في كلمته، كقوله: “إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي” (يو 8: 31). فإذ ليس لهم المثابرة بكونهم ليسوا تلاميذ حقيقيين، ليسوا أبناء حقيقيين حتى وإن ظهروا هكذا أو دُعوا هكذا.
إذن نحن ندعو الناس مختارين وتلاميذ المسيح وأولاد الله، لأنهم هكذا يدعون إذ يتجددون (بالمعمودية) ونراهم يعيشون بالتقوى، ولكن هذا يصير حقيقة إن ثبتوا فيما دعوا فيه[47].
القديس أغسطينوس
اهتمام الله بمجدنا
إن كان الروح الإلهي يحول حتى الأمور التي تبدو لضررنا لخيرنا، لأنا مدعوون حسب قصده، فما هو هذا القصد الإلهي؟ قصد الله من جهة الإنسان أن يرفعه إلى المجد؛ فالله ليس في حاجة إلى تعبده أو خدمته إنما يحبه كابن، يوده شريكًا في المجد. هذا هو الأمر الذي في ذهن الله من جهة مختاريه الذين سبق فعرفهم لذلك عينهم، “ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرًا بين إخوة كثيرين”[29].
- انظر سمو هذه الكرامة! فما هو للابن الوحيد بالطبيعة ينالونه بالنعمة.
إنه لم يكتف بهذه الدعوة أن يكونوا مشابهين له، بل يضيف نقطة أخرى: “ليكونوا بكرًا بين إخوة كثيرين” [29]... هكذا يستخدم كل وسيلة ليقيم العلاقة بوضوح شديد[48].
القديس يوحنا الذهبي الفم
- استخدم الرسول الملهم هذا التعبير “بكرًا” في أربع مناسبات: مرة يدعوه “بكر كل خليقة” (كو 1: 15)، وأخرى: “بكرًا بين إخوة كثيرين” (رو 8: 29)، وأيضًا “بكر من الأموات” (كو1: 18). وفي مناسبة أخرى يستخدم التعبير بطريقة مطلقة دون ربطه بكلمة أخرى، قائلاً: “وأيضًا متى أُدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله” (عب 1: 6) فبأي معنى صار بكرًا بين إخوة كثيرين؟ بالتأكيد هذا واضح أنه من أجلنا نحن الذين بالميلاد جسد ودم وُلد بيننا واشترك هو أيضًا في اللحم والدم (عب 2: 14)، لكي يغيّرنا من الفساد إلى عدم الفساد بميلادنا نحن من فوق بالماء والروح. لقد قاد بنفسه طريق هذا الميلاد منزلاً الروح القدس على المياه بعماده، حتى يصير في كل شيء بكرًا للذين يولدون روحيًا معطيًا اسم “إخوة” للذين يشتركون معه في الميلاد ويتشبّهون به بعمادهم بالماء والروح[49].
القدّيس غريغوريوس أسقف نيصص
- لنفهم هذه الكلمات “مشابهين صورة ابنه” [29] عن الإنسان الداخلي، لذلك يقول في موضع آخر: “ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم” (رو 12: 2). قدر ما نتغير عن شكل هذا الدهر نتشكل كأبناء لله.
يمكننا أيضًا أن نفهم هذه الكلمات هكذا، أنه كما تشكّل بنا فظهر كمن هو مائت هكذا نتشكّل نحن به بعدم الموت، وهذه الحقيقة ترتبط بقيامة الجسد[50].
القدّيس أغسطينوس
- في الجسد يصير الرب قائدنا (بكرنا) إلى ملكوت السماوات وإلى أبيه، قائلاً: أنا هو الطريق، والباب، ومن خلالي ينبغي أن يدخل الكل (يو 14: 6، 10: 9)[51].
البابا أثناسيوس الرسولي
يعالج الرسول بولس موضوع اختيار الله لنا أو تعيينه لمختاريه، مؤكّدًا أنه لا يوجد قهر ولا إجبار في قبول نعمة الله، إنما يعين الله الذين يعرف أنهم يقبلون نعمته في كمال حريتهم، إذ يقول: “الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم… والذين سبق فعيّنهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم فهؤلاء برّرهم أيضًا، والذين برّرهم فهؤلاء مجّدهم أيضًا” [29-30].
ويلاحظ في هذا النص أن الله. “سبق فعرف الذين له“، فاختياره وتعيينه لهم، لا على أساس محاباة، وإنما على أساس معرفته السابقة لهم، لا بمعنى أن لهم الفضل في شيء إلا قبولهم لدعوته وتجاوبهم لعمله فيهم بالمثابرة والجهاد. الله هو الذي يدعو وهو الذي يُبرّر وهو الذي يمجّد، لكن ليس في سلبيّة من جهتنا!
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على تبرير الله وتمجيده لنا بالقول: [لقد برّرهم بتجديد جرن المعموديّة، والذين برّرهم مجّدهم بالعطيّة أي بالتبنّي[52].]
- كثيرون دُعوا فعلاً وتبرروا (بالمعموديّة خلال الإيمان)، ومن يبقى إلى النهاية فهؤلاء “مجّدهم أيضًا“، وهذا لم يتم بعد.
بالرغم من أن هذين الأمرين، أي دعاهم وبرّرهم، لم يتحقّقا بعد في كل من قيل عنهم، إلا أنه لايزال يوجد كثيرون إلى نهاية العالم سيدعون وسيتبرّرون. وقد استخدم صيغة الماضي – حتى بالنسبة للأمور المستقبلة – كما لو كان الله قد سبق فأعدّها منذ الأزل[53].
القدّيس أغسطينوس
مرافقة الله لنا في الجهاد الروحي
إذ تحدّث عن عطيّة الله لنا أنه عيّننا عن معرفته السابقة لنا بأننا نقبل عمله فينا، ودعانا، وبرّرنا بالمعموديّة، ومجّدنا بالبنوّة لنصير مشابهين صورة ابنه، يقف معنا كل أيام جهادنا، لنقول مع الرسول: “فماذا نقول لهذا: إن كان الله معنا فمن علينا؟” [31].
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم، قائلاً:
[إن كان الله نفسه قد صار (للمؤمن) فحتى الأمور التي تبدو ضده تتحوّل لحسابه… المؤمن الذي يهتّم بنواميس الله لا يقف أمامه إنسان ولا شيطان ولا شيء ما!
فإن سلبْته ماله تصير بالأكثر صرّافًا لمكافأته.
وإن تحدثت ضده بشرّ يُحسب هذا الشرّ مصدر بهاء جديد في عيني الله.
إن حرّمته حتى من الطعام يتمجّد بالأكثر وتعظم مكافأته.
إن قدمته للموت، الذي هو أقسى ما يقع على الكل، فإنك تربطه بإكليل الاستشهاد.
أي طريق حياة مثل هذا؟ هذا الذي لا يقدر شيء ما أن يقف ضد هذه حتى أن الذين يدبِّرون مكائد له يكونون بالنسبة له ليس أقل من الذين يخدمونه! لهذا يقول: “إن كان الله معنا فمن علينا[54]“؟]
الفداء، أعظم عطيّة!
بلا شك أن حب الله الفائق الذي خلاله بذل ابنه الوحيد عنّا يسحب كل المشاعر ويمتص كل الأحاسيس ليقف الإنسان في عجز، ماذا يطلب بعد؟ يقول الرسول: “الذي لم يشفق على ابنه بل بذل لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضًا معه كل شيء؟” [32]
قدّم ابنه مبذولاً ونحن بعد أعداء لمصالحتنا، فماذا يحجبه عنّا بعد المصالحة؟ أو كما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [الذي وهب الأمور العظيمة لأعدائه، أفلا يهب الأمور الأقل لأصدقائه[55]؟]
يقول الرسول: “الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين” [32]. وكأن الأب هو الذي قدّم الكأس للابن، لكن الابن أيضًا بحبّه أراد أن يشرب الكأس، فالبذل مشترك: “الآب بذل ابنه الحبيب، والابن بذل ذاته”، وكما يقول القدّيس أغسطينوس: [واضع هذا الكأس واحد مع شاربه، إذ يقول الرسول نفسه: “أحبّنا المسيح أيضًا، وأسلم نفسه لأجلنا قربانًا وذبيحة لله رائحة طيبة“ (أف 5: 2)[56].] كما يقول القدّيس أمبروسيوس: [يُظهر الإناء المختار بوضوح وحده الحب الإلهي، فإن كلاً من الآب والابن قد بذلا، الآب بذل إذ لم يشفق على ابنه لأجلنا أجمعين (رو 8: 32)، والابن بذل إذ “أسلم ذاته لأجلي“ (غل 2: 20)[57].]
على أي الأحوال إن التطلع إلى الصليب يسحب قلب المؤمن بالحب، إذ يرى في الله “الحب الباذل”، فيخجل أن يطلب بعد شيئًا، إلا أن يرتفع بالصليب إلى الحضن الأبوي بالروح القدس ليبقى فيه أبديًا ينعم بأبوته الإلهية الفائقة.
حقا إن التطلع إلى الصليب يسحب القلب ليبقى في حالة شكر وتسبيح بلا انقطاع، الأمر الذي يزداد قوّة وبهاءً عندما نرتفع إلى السماوات لندرك بالأكثر فاعلية هذا الحب، حين نوجد مع الله أبناء له وأحباء! هناك يبقى الصليب تسبحتنا السماويّة غير المنقطعة.
رعاية حتى النهاية
إن كان الفداء الإلهي هو قمّة ما قدّمه الله للإنسان، معلنًًا كمال حُبّه لا بالكلام والعواطف، وإنما بالبذل حتى الصليب، يبقى الصليب حدثًا فوق الزمن، ويبقى المصلوب حتى بعد صعوده إلى السماء يرعى البشريّة، مشتاقًا أن يسحبهم إلى مجده الأبدي. رعايته دائمة وهو في السماوات لا تنقطع حتى يدخل بنا إلى حيث هو قائم. هذا العمل الإلهي يعطي الرسول الجرأة ليقول:
“من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرّر.
من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات،
بل بالحري قام أيضًا،
الذي هو أيضًا عن يمين الله،
الذي أيضًا يشفع فينا” [33-34].
- إنه لا يترك رعايته لنا، بل لا يزال يشفع فينا محتفظًا بذات الحب لنا.
- إن كان الروح نفسه يشفع فينا بأناّت لا ينطق بها [26]، والمسيح مات ويشفع فينا، والآب لم يشفق على ابنه من أجلك وقد اختارك وبررّك، فلماذا تخاف بعد؟[58]
القدّيس يوحنا الذهبي الفم
- إنه يشفع فينا كل يوم غاسلاً أقدامنا، ونحن أيضًا نحتاج إلى غسل أقدامنا يوميًا بسلوكنا بالحق بخطوات روحية، فنعرف الصلاة الربانية، قائلين: “واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين إلينا“ (مت 6: 12) [59].
- ليُصلِ كل واحد منّا عن الآخر كما يشفع المسيح عنّا[60].
القدّيس أغسطينوس
هذا وقد وجد القدّيس أمبروسيوس[61] في هذه العبارات الرسولية باب الله مفتوح لكل نفس ترجع إليه، فاستخدمها في الرد على أتباع نوفاتيانوس الذين أغلقوا الباب على الراجعين بالتوبة لله، بعد إنكارهم للسيد المسيح أو سقوطهم في خطايا بشعة، مثقّلين النير عليهم باليأس.
4. محبتنا للمسيح المبرر
إذ انتقل الرسول بولس من الناموس الموسوي فاضح الخطيّة دون معالج لها (ص 7) إلى ناموس روح الحياة في المسيح يسوع كاشفًا عن عمل الروح القدس فينا خلال عمل المسيح الفدائي، إذ يرفعنا من اهتمام الجسد إلى اهتمام الروح، وعوض العبوديّة يهبنا رح البنوّة لله مقدسًا نفوسنا وأجسادنا، واهبًا إيّانا القيامة الداخليّة ورجاء قيامة الأجساد أيضًا، يسندنا في كل جهادنا حتى في الضعفات، محوّلاً كل الأمور لخيرنا ليحقّق غايته فينا، ألا وهو “مجدنا السماوي”… أمام هذا العمل الإلهي العجيب الذي جاء ثمرة مجيء المسيح وبذل حياته عنّا، لم يعرف الرسول إلا أن يردّ الحب بالحب إذ ينشد لحن محبته للسيد المسيح، قائلاً:
“من سيفصلنا عن محبّة المسيح؟
أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟
كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حُسبنا مثل غنم للذبح.
ولكنّنا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
فإني متيقّن أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات،
ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، ولا علو ولا عمق، ولا خليقة أخرى،
تقدر أن تفصلنا عن محبّة الله التي في المسيح يسوع ربنا” [35-39].
سحبت هذه التسبحة قلب الكنيسة ليشتهي أبناؤها الألم كل يوم من أجل المحبوب، ليقدّموا حياتهم ذبيحة حب لذاك الذبيح الذي سبق فبادر بالحب مقدمًا حياته مبذولة عنّا.
لم تعد الآلام والضيقات تحطم النفس، بل علّة الدخول إلى موكب الغلبة والنصرة تحت قيادة المسيح يسوع المتألم والمصلوب.
- “من أجلك نمات كل النهار”… من الواضح أننا سنرحل ومعنا أكاليل كثيرة إذ نعيش أيامًا كثيرة، أو بالحرى ننال أكاليل أكثر من الأيام بكثير، إذ يمكن أن نموت في يوم واحد لا مرة ولا مرتين بل مرات كثيرة. لأنه من كان مستعدًا لهذا يبقى ينال مكافأة كاملة على الدوام.
- لقد أظهر (الرسول) أيضًا أن أجسادنا قد صارت ذبيحة، فيليق بنا ألا نرتبك ولا نضطرب عندما يأمر الله بتقديمها.
- لأنه بالحقيقة لأمر عجيب، ليس فقط أننا غالبون وإنما غالبون بذات الأمور التي وُضعت كمكائد لنا. نحن لسنا غالبين فحسب وإنما “أكثر من غالبين”، إذ نمارس الغلبة بسهولة بلا تعب ولا مشقة، لأن الله يصارع بجوارنا، فلا تشك، فإننا وإن ضُربنا نحسب أفضل من الضاربين، وإن طردنا نغلب الذين يضطهدوننا، وإن متنا يبقى الأحياء (الذين يقتلوننا) في صراع… أنهم لا يحاربون البشر بل يقاومون القدير الذي لا يُغلب![62]
القدّيس يوحنا الذهبي الفم
- العبارة “ذبحت ذبحها” (أم 9: 2) تعبر عن الشهداء في كل مدينة حيث يذبحون يوميًا من أجل الحق بواسطة غير المؤمنين، صارخين بصوت عالٍ: “إننا من أجلك نُمات كل النهار، قد حُسبنا مثل غنم للذبح”[63].
القدّيس هيبوليتس
- ليس شيء من هذه الأمور يقدر أن يفصل المؤمنين أو ينزع الملتصقين بجسده ودمه… الاضطهاد هو اختبار للقلب وفحص له. الله يسمح به لنا لكي نمحص ونتزكى، إذ يودّ أن يزكي شعبه على الدوام، لكن معونته لا تقصر عن مساعدة المؤمنين في كل وقت وسط التجارب[64].
الشهيد كبريانوس
- هنا تعبير “كل النهار” يعني كل الزمان الذي فيه تحتمل اضطهادات ونذبح فيه كغنم. هذا النهار لا يعني نهارًا يحتوي على اثنتي عشر ساعة إنما كل الزمان الذي فيه يتألم المؤمنون في المسيح يموتون لأجله[65].
القدّيس إبريناؤس
ربّما نتساءل: هل يمكن للملائكة أو القوات أن تفصلنا عن محبّة الله التي في المسيح يسوع؟
- لم يقل هذا كما لو كانت الملائكة تحاول هذا أو القوات الأخرى، حاشا! إنما أراد أن يظهر عظم الحب نحو المسيح. فإنه لا يحب المسيح من أجل الأشياء الخاصة بالمسيح (ولو كانت السمائيين)، وإنما من أجل المسيح يحب الأشياء التي له. فيتطلّع إليه وحده، ويخاف أمرًا واحدًا هو السقوط عن محبته للمسيح. هذا الأمر في ذاته أكثر رعبًا من جهنم، أمّا التمتّع بالحب فيشتاق إليه أكثر من الملكوت[66].
القدّيس يوحنا الذهبي الفم
هذا وقد لاحظ القدّيس أمبروسيوس[67] في هذا الحديث الرسولي، أن الرسول لا يميّز بين محبتنا للآب ومحبتنا للمسيح [35، 39]، علامة وحدة اللاهوت، مقدّمين كل شيء فداء حبنا لله.
[1] Cassian: conf. 23: 13.
[2] In Rom. hom 13.
[3] On Ps. hom 7.
[4] In Matt. hom 16.
[5] In Ioan. tr 41: 6; 108: 4.
[6] Conc. Repentance, 1: 3(12).
[7] Sermons on N. T. 19: 4.
[8] Ep.10 ad Adelphium; against Arians, discourse. 1: 51.
[9] In Rom. hom 13.
[10] In Rom. hom 13.
[11] Adv. Haer.5: 10: 2.
[12] Adv. Haer 5: 8: 1.
[13] Stromata, 2: 22.
[14] In Rom. hom 13.
[15] In Rom. hom 13.
[16] Of the Holy Spirit 3: 19(149).
[17] In Rom. hom 14.
[18] Ser. On N. T. 78: 9.
[19] In Rom. hom 14.
[20] In Ioan. Tract., 85: 3.
[21] On Ps. hom 59.
[22] Reproach & Grace 4; Grace& Free- will 23.
[23] On Jealousy & Envy 14.
[24] Adv. Eunomius 10: 4.
[25] Harmony. Of Gospels, 3: 4.
[26] In Rom. hom 14.
[27] In Rom. hom 14.
[28] Ep 22: 40; 14: 16, 10.
[29] Ep 76: 7.
[30] Ser. On N. T. 20: 3.
[31] In Rom. hom 14.
[32] In Rom. hom 14.
[33] Adv. Eunomius 4: 3.
[34] Adv. Haer 5: 32: 1.
[35] In Rom. hom 14.
[36] In Ioan. Tr 86: 1.
[37] Ser On N. T.55: 7.
[38] In Rom. hom 14.
[39] In Rom. hom 14.
[40] Cassian: Conf. 9: 34.
[41] In Ioan. Tr 6: 1.
[42] In Rom. hom 15.
[43] Cassian: Conf. 6: 8.
[44] Grace& Free- will 33.
[45] On Ps. hom 6.
[46] In Rom. hom 15.
[47] Reproach & Grece 22.
[48] In Rom. hom 15.
[49] Adv. Eunomius 2: 8.
[50] City of God 22: 16.
[51] Against Arians 2: 61.
[52] In Rom. hom 15.
[53] Reproach & Grace 23.
[54] In Rom. hom 15.
[55] In Rom. hom 15.
[56] In Ioan. tr 112: 5.
[57] Of the Holy Spirit 1: 12 (129).
[58] In Rom. hom 15.
[59] In Ioan. tr 56: 4.
[60] In Ioan. tr. 58: 5.
[61] Conc. Repent. 1: 3 (14).
[62] In Rom. hom 15.
[63] Fragments from Comm. on Prov 9: 1.
[64] Ep. 7: 5.
[65] Adv. Haer 2: 22: 2.
[66] In Rom. hom 15.
[67] Of the Christian faith 5: 16 (187).