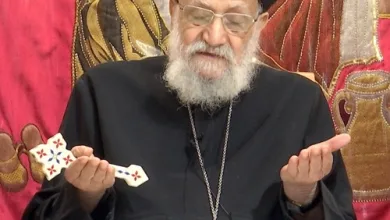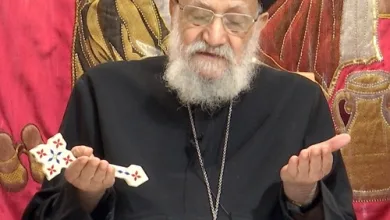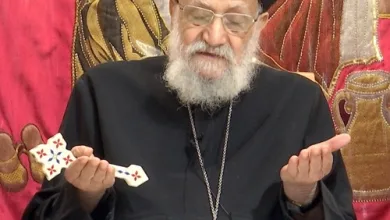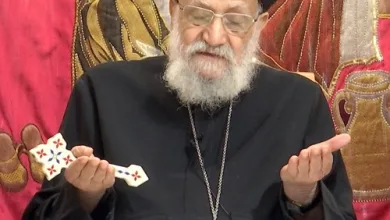تفسير رسالة رومية 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 3 الأصحاح الثالث - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة رومية 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثالث
حاجة الكل للخلاص
بعد عرض الرسول لعلاقة البشريّة بالله انتهي إلى هذا الأصحاح ليُعلن أنه وإن اختلفت خطايا البشر عن بعضهم البعض، لكن النتيجة واحدة، وهي سقوط الكل تحت نير الخطيّة، أي إعلان أن الكل غير بار ويحتاج إلى تبرير حقيقي فعَال. بمعنى آخر جاء هذا الأصحاح أشبه بحكم عام على البشرية كلها أنها بلا برّ حقيقي، في عوز إلى من يبرّرها.
- الاتهام: عدم أمانتنا مع أمانة الله 1- 8.
- علّة الاتهام: الكل بلا برّ 9–20.
- الحكم: دينونة الكل، والحاجة إلى تبرير عام 21-31.
- الاتهام: عدم أمانتنا مع أمانة الله
الاتهام الموجّه للبشرية كلها: إنها بلا بر،ّ أي بلا أمانة في قبول وعد الله لها، بالرغم من برّ الله في وعده لها؛ في هذا يشترك اليهودي مع الأممي، ويتساوى الكل. هذا الاتهام قد يُسيء اليهود فهمه فيحسبونه مستهينًا بما نالوه من امتيازات، لذلك جاء الاتهام مفصلاً بطريقة لائقة لا تجرح مشاعرهم، يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
أولاً: أن كان الأممي قد كسر الناموس الطبيعي فهلك (ص 1)، واليهودي كسر الناموس المكتوب واستهان بالخِتان الروحي فسقط في دينونة أكثر مرارة من التي يسقط تحتها الأممي، فما الحاجة إذن لاختيار الله لشعبه؟ وتقديمه عهد الخِتان والناموس المكتوب؟ هذا هو التساؤل الذي وضعه الرسول بولس في نهاية حديثه عن ما بلغ إليه الأممي واليهودي، ولئلاّ يظن القارئ أن بولس الرسول يستهين بنعم الله وعطاياه في العهد القديم، لذلك يقول الرسول:
“إذًا ما هو فضل اليهودي؟ أو ما هو نفع الخِتان؟
كثير على كل وجه، أمّا أولاً فلأنهم أستؤمنوا على أقوال الله.
فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعلّ عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟
حاشًا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبًا،
كما هو مكتوب: لكي تتبرّر في كلامك،
وتغلب متى حوكمت” [1–4].
خشي الرسول أن يُساء فهم حديثه السابق، فيظنه البعض أنه يقلل من شأن معاملات الله مع شعبه، خاصة تقديمه ناموسه كعطيّة يؤتمنوا عليها، أو اختيارهم كشعبٍ مقدس له، أو دخوله في عهد معهم مقدمًا الخِتان علامة عهد. لذلك أسرع ليؤكّد أن العيب لا في العطيّة ولا في العاطي، وإنما في عدم أمانة من تسلمها. بمعني آخر، إنه ينتقد تصرف اليهود نحو نعم الله لا نعم الله في ذاتها، فإن الله في أمانته قدّم عطايا إلهية ونعم مجّانية مقدّسة، لكن الإنسان في غير أمانة أساء استخدامها، وأفسد عملها في حياته.
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على عبارات الرسول هذه، قائلاً:
[إن كان المقصود هو أن كل هذه الأشياء بلا قيمة، فلماذا دُعي الشعب؟ ولماذا أُقيم عهد الخِتان؟
ماذا يفعل الرسول هنا؟ وكيف يحل هذه المشكلة؟
يحلها بنفس الطريقة التي سبق فاتبعها، إذ تغني بهبات الله لا بفضل اليهود، فبكونهم يهودًا عرفوا إرادة الله، وأدركوا الأمور الأسمى، ذلك ليس بفضل عملهم الذاتي، إنما هو عمل نعمة الله. وكما قال المرتّل في المزمور: “لم يصنع هكذا بإحدى الأمم وأحكامه لم يعرفوها”. وكما أعلن موسى بسؤاله: “هل جرى مثل هذا الأمر العظيم؟ أو هل سُمع نظيره؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلّم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟” (تث 4: 32-33). هذا ما يفعله بولس هنا، إذ اتّبع ذات الوسيلة إذ قال بأن الخِتان ذو نفع إن أُقترن بفعل الصلاح (رو 2: 25) ولم يقل أن الخِتان بلا نفع، لذلك تساءل: إن كنت متعديًا الناموس فقد صار ختانك غرلة (رو 2: 25). كأنه يقول: يا من أختتنت صار ختانك غُرْلة، ولم يقل: يا من اختتنت ختانك بلا نفع على الإطلاق. لهذا يطيح بالأشخاص ويؤيد الناموس؛ هذا ما يفعله هنا إذ بعدما تساءل: ما هو فضل اليهودي؟ لم يجب بالنفي، بل أكدَ فضله ليعود فيدحضهم موضحًا عقوبتهم خلال الميزات التي نالوها.
أردف السؤال بسؤال، قائلاً: أو ما هو نفع الخِتان؟
ويجيب على السؤالين، قائلاً: “كثير على كل وجه، أمّا أولاً فلأنهم أستؤمنوا على أقوال الله“.
ترون إذن أنه في كل مناسبة يعدد نعم الله لا أفضال اليهود.
ما معني: “استؤمنوا“؟ معناها أن الناموس قد وُضع بين أيديهم، لأن الله جعل لهم قيمة فأقامهم أمناء على أقواله التي نزلت من فوق. بقوله هذا يقيم شكوى ضدهم، إذ يهدف إلى إظهار نكرانهم للفضل بالرغم من المزايا التي وُهبت لهم.
يستطرد فيقول: “فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء، أفلعلّ عدم أمانتهم تبطل أمانة الله؟ حاشًا” [3-4].
لاحظوا هنا كيف يبرز الاتهام في شكل اعتراض، وكأنه يقول: رب معترض يتساءل: ما نفع الخِتان إذًا ما داموا قد أساءوا استخدامه؟ وهو لا يقف هنا موقف المشتكي العنيف، إنما موقف من يلتزم بتبرير الله من الشكاوى الثائرة ضده، فيحولها من ضد الله إلى ضد اليهود. يقول لهم: لماذا تتذمّرون من أن البعض لم يؤمنوا؟ كيف يؤثر هذا في الله من جهة عطاياه، فهل نكران مستخدميها يغيَر من طبيعتها؟ أو يجعل من الأمر المكرّم هوانًا؟ هذا هو معنى تساؤله: “أفلعلّ عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟” يجيبهم: “حاشا”، وكأنه يقول: لقد أكرمت فلانًا، فلم يقبل إكرامي، فهل يُحسب عدم قبوله الإكرام علّة شكوى ضدي؟ أو يقلّل هذا من إكرامي؟…
تأمّلوا إذن كيف وضعهم الرسول في قفص الاتهام خلال ذات الأمور التي ينتفخون بها!… لقد عمل الله ما في وسعه، أمّا هم فلم يعرفوا أن ينتفعوا بأعماله معهم، إذ يردّد قول المرتّل في المزمور: “لكي تتبرّر في كلامك وتغلب متى حوكمت[1]“.]
[انظروا إلى خطّة بولس فإنه لم يَتّهم الكل بعدم الأمانة، بل قال: “إن كان قوم” [3] هؤلاء كانوا غير أمناء، وهكذا يبدو الرسول غير قاسٍ في اتهاماته حتى لا يظهر كعدوٍ[2].]
هكذا لم يحقِّر الرسول من العطايا الإلهية سواء بالنسبة للختان كعلامة للعهد الإلهي إن فهم روحيًا وأيضًا لعطيّة الأقوال الإلهية، إنما يهاجم عدم أمانة الإنسان، الأمر الذي لا يبطل أمانة الله.
لم يتجاهل رجال العهد الجديد عطايا الله لرجال العهد القديم، خاصة أقوال الله، ففي خطاب الشماس استفانوس جاء حديثه عن موسى النبي هكذا: “الذي قبل أقوالاً حيّة ليعطينا إيّاها” (أع 7: 38).
في حبٍ قدّم الله أقوالاً حيّة تحمل المواعيد الإلهيّة، لكن قابل الإنسان الحب بالجمود، فعصى أقوال الله، وتجاهل حفظها روحيًا وعمليًا بالرغم من افتخاره بها، وتمسكه بحفظها في حرفيتها. ومع هذا يبقي الله أمينًا في تحقيق ما وعد به.
رفض الإنسان اليهودي “الحق” برفضه وعود الله الواردة في أقواله خاصة ما جاء بالنسبة للمسيا المخلص، فحُسب كاذبًا، أمّا الله فيبقي صادقًا يحقّق ما وعد به.
هذا ويقدّم لنا القدّيس جيروم تفسيرًا روحيًا لعبارة: “ليكن الله صادقًا وكل إنسان كاذبًا” [4]، معلنًا أنه ما دام الإنسان يسلك بفكره وإمكانياته البشريّة الذاتية، إنما يعيش بالكذب، لكنه متى التقى بالله “الحق” وحمل سماته ويحسب ابنًا لله، ينعم بالحق فيه، فيكون بالله صادقًا، إذ يقول: [يصير الإنسان بالقداسة إلهًا، بهذا يكف عن أن يكون إنسانًا ينطق بالكذب[3].]
ويرى القدّيس كبريانوس خلال ذات العبارة أنه لا يليق بنا أن نيأس حين نرى البعض ينحرف عن الإيمان أن ينكره، إنما كرجال الله نتشدّد ونسلك بالحق، حتى وإن سلك كثيرون بالكذب، فمن كلماته:
[إن كان كل إنسان كاذبًا والله وحده صادق يليق بنا نحن خدام الله، خاصة الكهنة، ماذا نفعل سوى أن ننسى الأخطاء البشريّة والكذب، ونستمر في حق الله، ونحفظ وصايا الرب[4]!]
[اختار الرب يهوذا من بين الرسل، وقد خان يهوذا الرب، فهل ضعُف إيمان الرسل أو وَهن ثباتهم لأن يهوذا الخائن قد فشل في تبعيتهم؟ هكذا فإن قداسة الشهداء وكرامتهم لا تنقصان لأن إيمان البعض قد تحطّم[5].]
[ينصحنا بولس أيضًا ألا نضطرب حين يهلك الأشرار خارج الكنيسة، ولا يضعف إيماننا بمفارقة غير المؤمنين لنا… فمن جانبنا يلزمنا أن نجاهد ألا يهلك أحد تاركًا الكنيسة بسبب خطأ ارتكبناه، لكن أن هلك أحد بإرادته وخطيته ولا يودّ العودة أو التوبة والرجوع إلى الكنيسة، فإننا لا نُلام في يوم الدين، مادمنا كنّا مهتمين بإصلاحه، إنما يسقط هو وحده تحت الدينونة لرفضه العلاج بنصيحتنا الصالحة[6].]
ويقدّم لنا الأب بولاس أسقف يوبا Bobba بموريتانيا ذات الفكر قائلاً أنه يلزم ألا نضطرب حين يرفض إنسان إيمان الكنيسة[7].
يرى القدّيس أغسطينوس أن الكذب هنا يعني الفراغ، والصدق أو الحق يعني الملء، إذ يقول: [الله الملء والإنسان فارغ. أن أراد أحد أن يمتلئ فليذهب إلى ذاك الذي هو الملء: “تعالوا إلى واستنيروا” (راجع مز 34: 5). فإن كان الإنسان كاذبًا، فهو بهذا فارغ يطلب أن يمتلئ، فيجري بسرعة وغيرة نحو الينبوع ليمتليء[8].]
يقول أيضًا: [عندما يعيش إنسان حسب الحق يعيش لا حسب نفسه بل حسب الله القائل: “أنا هو الحق” (يو 14: 6). من يحيا حسب نفسه، أي حسب الإنسان لا الله، فبالتأكيد يعيش حسب الكذب، ليس لأن الإنسان نفسه كذب إذ الله موجده وخالقه، وهو بالتأكيد ليس موجدًا للكذب ولا خالق له، إنما لأن الإنسان الذي خُلق مستقيمًا لكي يحيا حسب الله خالقه لا حسب نفسه، أي يتمّم إرادة الله لا إرادته الذاتية، صار يعيش بغير ما خُلق ليعيش به، وهذا هو الكذب… لذلك لم يقُل أن كل خطيّة هي كذب باطلاً[9].]
ثانيًا: إذ عالج الرسول المشكلة الأولي وهي: ما نفع بركات الله ونعمه على اليهودي، إن كان اليهودي قد أساء استخدامها، فصارت البركات وهي مقدّسة ومباركة علّة عقوبة أعظم لمن أساء استخدامها؟ إذ أظهر الرسول أن بعضًا منهم كانوا غير أمناء، لكن يبقي الله أمينًا بالرغم من عدم أمانتهم، وأنه لا يليق أن نشين كرامة واهب النعم، إن أساء الذين قبلوها استخدامها. الآن يعالج الرسول مشكلة أخرى مشابهة للأولى ومكمّلة لها، وهي كما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن الوثنيّين قد استهانوا بكلمات الرسول بولس: “حيث كثرت الخطيّة ازدادت النعمة جدًا”… فحسبوا أن النتيجة الطبيعية لذلك هي أننا نخطيء لكي تزداد النعمة، أو بمعنى آخر لنكن غير أمناء فتتجلي أمانة الله.
يقول الرسول: “ولكن إن كان إثمنا يبين برّ الله، فماذا نقول: ألعلّ الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان: حاشًا، فكيف يدين الله العالم إذ ذاك؟ فإنه أن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أُدان أنا بعد كخاطئ؟ أمّا كان يُفتري علينا، وكما يزعَم قوم أننا نقول: لنفعل السيّئات لكي تأتي الخيرات، الذين دينونتهم عادلة” [5-8].
نستخلص من هذا النص الآتي:
أ. لا يتوقف عدو الخير عن محاربة خدمة السيد المسيح بكل طرق، فإن كان اليهود يهاجمون الكرازة بدعوى أن الرسول بولس يُهين الناموس ويستخفّ بالخِتان، ويقاوم أمة اليهود، فإن الأمم من جانبهم أيضًا يقاومون هذا العمل بإساءة فهمه، حاسبينه أنه ينادي بفعل السيئات لكي تأتي الخيرات، وكأن الشرّ هو علّة الخير، وعدم أمانتنا هو مجد لأمانة الله، وهذا بلا شك افتراء كاذب. لذا إذ يُعلن الرسول عن سقوط العالم كله في الشرّ، ليتحدّث عن حاجة الجميع إلى المخلص، يوضّح أنه لا ينادي بما أُتُّهم به، مُظهرًا أن هذا القول يستلزم أحد أمرين: إمّا أن يكون الله غير عادل، لأنه يجازي الإنسان على شرّه وعدم أمانته، وهو علّة نصرة الله ومجده، أو أنه إن لم يعاقبنا تقوم نصرته على رذائلنا، وكِلا الأمران ممقوتان عند الرسول.
ب. يودّ الرسول تأكيد أن الله الذي يتمجّد حتى في شرّنا بإعلان برّه وحبّه للخطاة لا يعفي الإنسان من مسئوليته عن ارتكابه للإثم. فقد اعتاد الإنسان منذ بدء سقوطه أن يلقي باللوم على غيره، كما فعل آدم الذي ألقى باللوم على المرأة التي جعلها الله معه (تك 3: 12)، وكما فعلت حواء التي ألقت باللوم على الحيّة.
يقول الرسول: “أتكلم بحسب الإنسان” [5] وكأنه إذ يلتزم بتقديم هذا الاعتراض الذي يخطر على فكر البعض، إنما يتكلّم كإنسان متكابر على الله، إذ ينسب لله الظلم في إدانته للإنسان الأثيم ويفتح الباب للإنسان أن يتمادى في ارتكاب الآثام بحجّة إعلان “برّ الله”. لهذا جاءت هذه الرسالة تؤكد أن برّ الله وأمانته في مواعيده وفيض نعمته على الخطاة ليست فرصة للشر، إذ يقول: “أنبقى في الخطيّة لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين مُتنا عن الخطيّة كيف نعيش بعد فيها؟” (رو 6: 1-2).
ج. يُعلّق القدّيس إكليمنضس السكندري[10] على العبارات الرسولية التي بين أيدينا موضحًا أن الله يوقع العقوبة ليس عن انفعال، إنما لتحقيق العدالة، فيختار الأثيم لنفسه أن يسقط تحت العقوبة بكامل حريته، هو الملوم لا الله.
- 2. علّة الاتهام: الكل بلا برّ
الآن بعد أن ردَ على اليهود الذين اتهموا الرسول أنه يستخف بعطايا الله لهم كيهود أهل الخِتان وأصحاب الناموس، كما ردَ على الأمميّين الذين حسبوه ينادي بفعل الشرّ لكي يجلب الخير، بدأ يؤكّد من جديد فساد البشريّة كلها ليُعلن حاجة الكل إلى طريق واحد للخلاص، هو التمتّع ببرّ المسيح خلال الإيمان بفدائه، إذ يقول:
“فماذا إذًا، أنحن أفضل؟ كلا البتة.
لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيّين أجمعين تحت الخطيّة.
كما هو مكتوب: أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله.
الجميع زاغوا وفسدوا معًا، ليس من يعمل صلاحًا ليس ولا واحد.
حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا.
سمَ الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة.
أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه.
ليس خوف الله قدام عيونهم” [9–18].
الآن إذ يُعلن فساد البشريّة كلها يلجأ إلى رجال العهد القديم ليقتطف كلماتهم التي تؤكد ذلك:
يلجأ إلى داود النبي القائل: “ليس من يفهم، ليس من يطلب الله” (مز 14: 2 الترجمة السبعينيّة)، وقد جاءت الترجمة العبرية: “هل من فاهم طالب الله!” فإذ أخطأ الكل في حق الله، انطمست عيون أذهانهم، فلم تعد تستطيع أن تراه، ولا أن تدرك أسراره الإلهية، كآدم الذي أخطأ، فصار غير قادرٍ على إدراك محبّة الله، وأصبح هاربًا من وجهه لا يقدر أن يطلبه. لكن هل ينطبق هذا على اليهود الذين صارت لهم معرفة الله بالناموس، ويطلبونه خلال طقوسهم وعبادتهم غير المنقطعة؟ يجيب المرتّل: “ليس من يفهم، ليس من يطلب الله”، غير مميّز اليهودي عن الأممي، لأن اليهودي في حرفيته لم يستطع إدراك أعماق الناموس وغايته الإلهية كما تحوّلت الطقوس إلى شكليات لا تمس القلب ليُدرك الله ويعاينه.
ويقتطف من نفس المزمور: “الجميع زاغوا وفسدوا معًا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد” (مز 14: 3). مرة أخرى يؤكّد أن “الجميع” بلا تمييز بين يهودي أو أممي إذ لم يفهموا، ولم يعد للصلاح موضع فيهم. هذا أيضًا ما يعلنه إشعياء النبي القائل: ” كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحدٍ إلى طريقه” (إش 53: 6).
بعد أن تحدّث عن فساد الكل بوجه عام بدأ يُعلن فساد الإنسان في كُلّيته، فتحوّلت الحنجرة إلى قبر مفتوح (مز 5: 9) تخرج رائحة موت ونتانة، وانشغل اللسان بالمكر، وتحوّلت الشفاه إلى مخزن خفي لسمَ الأصلال (مز 140: 3)، وفمهم ينبوع لعنة ومرارة (مز 10: 7)، وأرجلهم تسرع إلى سفك الدم (إش 59: 7؛ أم 1: 16) لا تعرف طريق السلام، بل طريق السحق والمشقة، أمّا أعماقهم ففقدت البصيرة الداخليّة، فلم يعد خوف الله أمام عيونهم (مز 36: 1). وكأن الفساد قد دبَّ في حياة الإنسان الداخليّة، كما في أعضائه الظاهرة.
- الحكم: دينونة الكل، والحاجة إلى تبرير عام
إن كان الذين بلا ناموس مكتوب قد سقطوا تحت الهلاك، والذين تحت الناموس قد صاروا تحت الدينونة، فكيف يمكن الخلاص؟ يقدّم لنا الرسول بولس العلاج معلنًا الحاجة إلى المخلص الذي يقدّم حياته فِدْية عن العالم كله، واهبا البرّ الإلهي لمؤمنيه. ويلاحظ في هذا العلاج الآتي:
أولاً: يقول الرسول: “وأما الآن فقد ظهر برّ الله بدون الناموس” [21]. وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [لا يكتفي بقوله “البرّ”، إنما يصفه “برّ الله” مظهرًا مدي النعمة وعظمة الوعد مادام الله هو مصدرهما.]
إن كان الإنسان قد فشل في نوال البرّ خلال الناموس الطبيعي أو الناموس المكتوب، إذ ظهر كاسرًا للناموس، فإن الله قدّم برّه لنا، باتحادنا مع الآب في ابنه البارّ الذي بلا خطيّة، نحمله في داخلنا، ويحملنا هو فيه، فنحسب به أبرارٌا. فالبرّ الذي صار لنا ليس وليد جهادنا الذاتي ولا طاعتنا الذاتية، إنما هو ثمرة عمل روحه القدوس الذي يهبنا الشرّكة مع الآب في ابنه، فنحمل سمات الابن فينا، ويصير برّه برًا لنا.
بمعني آخر إذ فقد الكل “البرّ” صارت الحاجة إلى برّ الله، الأمر الذي تحدّث عنه الله بلسان النبي إشعياء:
“اسمعوا لي يا أشدّاء القلوب البعيدين عن البرَّ، قد قربت برّي، لا يبعد، وخلاصي لا يتأخر” (إش 46: 12-13).
“قريب برّي، قد برز خلاصي… أمّا خلاصي فإلى الأبد يكون، وبرَّي لا ينُتقص… أمّا برّي فإلى الأبد يكون، وخلاصي إلى دور الأدوار” (إش 51: 5، 8).
“احفظوا الحق واِجروا العدل، لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان برّي” (إش 56: 1).
ثانيًا: بقوله: “ظهر برّ الله“. وليس “قدّم برّ الله” يُعلن أن هذا البرّ الإلهي ليس جديدًا، إنما هو في ذهن الله يودّ أن يقدمه لنا، إنما في الوقت المعيّن، لذا يقول: “مشهودًا له من الناموس والأنبياء”. وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [يودّ أن يقول لهم: لا تضطربوا لأنكم لم تنالوا قبل الآن، ولا تفزعوا… لأن الناموس والأنبياء أشاروا إليه منذ القديم[11].]
هذا البرّ الذي أنبأ الله به على أفواه الأنبياء، أعلنه في ابنه يسوع المسيح البارّ لحسابنا، إذ يقول: “برّ الله بالإيمان بيسوع المسيح، إلى كل وعلي الذين يؤمنون، لأنه لا فرق” [22]. أشار الأنبياء على البرّ من بعيد، أمّا المسيح فهو وحده جاء نائبًا عنّا لكي إذ يحمل المؤمنين فيهن ينعمون ببرّ الآب الذي هو أيضًا برّ الابن. هذا ما أعلنه السيد في صلاته الوداعية: “أنا مجّدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجّدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم“ (يو 17: 4-5). هذا المجد الأزلي الذي له، يحمله الآن وهو في الجسد كبَرّ إلهي، ليكون لنا برًا نعيشه ونمارسه، فنقول: “الرب برَنا” (إر 23: 6، 33: 16، 51: 10).
ثالثًا: جاء الحكم: “إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله” [24]، جاء حكمًا جامعًا وشاملاً لليهود وللأمم.
في موضع آخر يضم الرسول نفسه بين الخطاة بل ويحسب نفسه “أول الخطاة“ (1 تي 1: 15)، بينما نجده أيضًا يقول: “من جهة البرّ الذي في الناموس بلا لوم” (في 3: 6). فكيف يحسب نفسه أول الخطاة وفي نفس الوقت بلا لوم من جهة البرّ الذي في الناموس؟ يجيب القدّيس يوحنا الذهبي الفم أنه بالنسبة لبرَ الله يُحسب حتى الذين يتبرّرون في الناموس خطاة. ويشبه ذلك بإنسان جمع مالاً وحسب نفسه غنيًا لكنه متي قارن نفسه بالملوك ظهر فقيرًا للغاية وأول الفقراء. [بالمقارنة بالملائكة يُحسب حتى الأبرار خطاة، فإن كان بولس الذي مارس البرّ الذي في الناموس هو أول الخطاة، فأي إنسان آخر يحسب نفسه بارًا[12]؟]
يقول القدّيس أغسطينوس: [جاء المسيح للمرضي فوجد الكل هكذا. إذن لا يفتخر أحد بصحته لئلاّ يتوقف الطبيب عن معالجته… لقد وجد الجميع مرضى، لكنه وجد نوعين من القطيع المريض؛ نوع جاء إلى الطبيب، والتصق بالمسيح، وصار يسمعه ويكرمه ويتبعه فتغيرَ… أمّا النوع الآخر فكان مفتتنًا بمرض الشرّ ولم يدرك مرضه، هذا النوع قال لتلاميذه: “لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟“ (مت 9: 11). وقد أجابهم ذاك العارف لهم ولحالهم: “لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضي[13]“.]
إن كان الرسول يعقوب يقول: “من عثر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل” (يع 2: 7)، فمن منا لم يعثر في واحدة؟ إذن الكل يحتاج إلى الطبيب، إذ صاروا فاقدين للمجد الحقيقي: “أعوزهم مجد الله”.
صارت البشريّة كلها في حالة عوز وجوع إلى “المجد “، لكن للأسف أرادوا أن يشبعوا بمجد الناس لا الله (يو 12: 43).
رابعًا: يبلغ الرسول إلى غاية حديثه، ألا وهو وإن جُرح اليهودي فاقدًا المجد الإلهي لأن الناموس صار فاضحًا لخطاياه عِوض أن يكون مبرّرًا له وممجّدًا، لكنه يتمتّع مع الكل بعمل المسيح الفدائي خلال الدم بخطة إلهية سبق فأعدّها لتظهر في ملء الأزمنة، إذ يقول: “متبرّرين مجانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدّمه الله كفّارة بالإيمان بدمه لإظهار برّه” [24].
إن كان الحكم جماعيًا بأن الكل بلا استثناء قد فقدوا “المجد” الحقيقي وسقطوا في الفساد الداخلي والخارجي، لكن الطبيب يقدّم العلاج “مجّانًا”، لا لأنه علاج رخيص، وإنما لأن ثمنه لا يُقدر، لا يستطيع أن يدفعه سوى الابن، الذي بنعمته قدّم حياته كفّارة عنّا لإظهار برّه فينا. لذلك وقف السيد المسيح ينادي: “من يرد فليأخذ ماء الحياة مجّانًا” (رؤ 22: 17)، أي ماء نعمته المجّانية.
لقد جاء السيد المسيح “كفّارة” عنّا، وهو مبدأ سبق فهيأ له في العهد القديم، فقد هيّأ الله كبشًا لإبراهيم يُصعده مُحرقة عِوضًا عن ابنه (تك 22: 13)، أو كفّارة عنه. وقد أمر الله موسي أن يقدّم كل واحد فِدْية نفسه للرب (خر 30: 11)، أمّا في العهد الجديد فيقول الرسل:
“هو كفّارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضًا” (1 يو 2: 2).
“هو أحبّنا وأرسل ابنه كفّارة لخطايانا” (1 يو 4: 10).
“الذي لنا فيه الفداء (الكفّارة) بدمه غفران الخطايا” (أف 1: 7؛ كو 1: 14).
“عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى… بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح” (1 بط 1: 19).
خامسًا: بقوله: “ليكون بارًا، ويُبرّر من هو بالإيمان بيسوع المسيح” [26]، يُعلن أن برّه سهل المنال، يُمنح للجميع. لذلك يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم مشجعًا كل مؤمن ليتمتع ببرّ المسيح؛ [لا تتشكّك إذن… ولا تبتعد عن برّ الله لأنه بركة سهلة المنال وممنوحة للجميع بلا استثناء. لا تخجل ولا تخزي، لأنه أن كان الله يُعلن استعداده أن يفعل هذا لك، بل ويفرح بذلك ويعتز، فكيف تغتم أنت وتخزى وتخفي وجهك خجلاً ممّا يتمجّد به سيدك؟[14]]
هذا هو عمل الله القدوس وشهوة قلبه، أنه كقدوس يودّ أن يقدس الكل، وقادر على ذلك لكن ليس بدون إرادتنا. يقول القدّيس أغسطينوس: [الله قدوس ويقدِّس، الله بار ويُبرّر[15].]
سادسًا: ينتهز الرسول هذه الفرصة ليعود فيؤكّد أن برّ المسيح لا يتحقّق بأعمال الناموس بل بالإيمان، قائلاً: “فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلاّ، بل بناموس الإيمان” [27]. وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [لو كان للناموس فاعلية لظهرت قبل مجيء (الفادي)، أمّا الآن وقد جاء الفادي فإنه لا يطلب غير الإيمان، إذ زالت الحاجة إلى عمل الناموس. ومادام الكل قد سقطوا فقد جاء ليفتديهم بنعمته، وقد جاء الآن لهذا السبب. فلو أنه جاء قبل ذلك ظنوا بأنه من الممكن أن يخلصوا بجهادهم الذاتي وصلاحهم طوعًا للناموس… كأنهم أشبه بإنسان صدر عليه الحكم بالإعدام، وبينما هو مُساق إلى المشنقة صدر العفو الملكي لكنه توقح هذا الإنسان مدعيًا أنه خلّص نفسه بنفسه، أفلا يسخر به الآخرون، قائلين: كان الأولي به أن ينطق بهذا وهو في الطريق إلى المشنقة قبل صدور العفو، أمّا وقد شمله العفو الملكي فلا مجال له للافتخار. هذا هو حال اليهود، إذ خانوا العهد مع أنفسهم، وجاء المسيح يفديهم، نازعًا عنهم سبيل الافتخار. لأن ذاك الذي وصف نفسه أنه معلِّم الأطفال ومهذِّب الأغبياء وله صورة العلم والحق في الناموس، وجد نفسه في حاجة إلى معلِّم ومخلِّص، تمامًا كالذين يَدّعي أنه يعلِّمهم، فكيف يفتخر بعد؟[16]]
سابعًا: إن كان الرسول يؤكّد من وقت إلى آخر أنه لا خلاص بأعمال الناموس الحرفيّة كالخِتان والغسالات والتطهيرات، إنما “بناموس الإيمان” [27] لننعم ببرّ المسيح. فإنه يؤكّد أن للإيمان أيضًا “ناموس”، بمعنى أن للإيمان شريعة أو قانون يلتزم به المؤمن، وليس الإيمان حالة من التشويش أو الاستهتار. فإن كنّا بالإيمان بالمسيح قد تحرّرنا من عبودية حرف الناموس، إنما لنعيش “الحرّية في المسيح”، سالكين بروح لائق بالحياة الإيمانية الخاضعة لقانون الحب أو ناموس السماء أو تدبير الروح الجاد المدقق. لهذا يُعلّق القدّيس أغسطينوس على حديث الرسول بولس: “إذًا نحسب الإنسان يتبرّر بالإيمان بدون أعمال الناموس” [28]، قائلاً: [توجد أعمال تبدو أنها صالحة، لكنها إذ هي خارج الإيمان بالمسيح فهي غير صالحة، لأنها لا تحقّق غاية الأعمال الصالحة، “لأن غاية الناموس هي المسيح للبرَ لكل من يؤمن” (رو 10: 4). لهذا لا يريدنا الله أن نميز الإيمان عن الأعمال، إنما نعلن الإيمان نفسه بكونه عملاً، إذ الإيمان ذاته عامل بالمحبّة (غل 5: 6) [17].]
ثامنًا: إذ أوضح الرسول أن الخلاص يتحقّق خلال الإيمان بالمسيح يسوع دون أعمال الناموس الحرفيّة ليفتح الباب على مصراعيه لجميع الأمم، استصعب اليهود أن يدخل الأمم معهم على قدم المساواة، لذلك تساءل الرسول: “أم الله لليهود فقط؟ [29]. وكما يُعلّق الذهبي الفم: [كأنما يقول لهم: على أي أساس يبدو لكم تخطئة مبدأ خلاص الجميع؟ ألعلّ الله يحابي؟ وهكذا يوضّح لهم أنهم باحتقارهم الأمم إنما يهينون مجد الله، لأنهم لا يريدونه إله الجميع. فإن كان إله الكل فإنه يعتني بالكل وبالتالي يخلص الكل بذات الطريق، أي طريق الإيمان[18].]
هكذا يجيب الرسول على اعتراضهم مظهرًا أن الله “هو الذي سيُبرّر الخِتان بالإيمان، والغُرْلة بالإيمان” [30]… أنه يمطر محبّته على الجميع ليُبرّر الكل، وكما يقول القدّيس إكليمنضس السكندري: [إنه يمطر نعمته الإلهية على الأبرار والظالمين (مت 5: 45) [19].]
تاسعًا: أوضح الرسول أنه إذ يُعلن فتح باب الخلاص للجميع لا يستخف بالناموس، وإن كان الناموس بأعماله الحرفية يعجز عن تحقيق الخلاص، إذ يقول: “أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس“ [30]. إنه يثبت الناموس، لا لكي يلزِم الأمم بأعمال الناموس، وإنما يثبته بتحقيق غايته. أنه هبة الله ليفضح شرّنا، فنكشف حاجتنا للخلاص والمخلص، وقد جاء الإيمان يحقّق هذه الغاية في كمالها.
[1] In Rom. hom 6.
[2] In Rom. hom 6.
[3] On Ps. hom 20.
[4] Ep.67: 8.
[5] Unity of the Church 22.
[6] Ep. 54: 6, 7.
[7] Seventh Council of Carthage under Cyprian.
[8] Ser.on N.T. Lessons 83: 6.
[9] City of God 14: 4.
[10] Paedagogus, 1: 8.
[11] In Rom hom 7.
[12] In 1 Tim. hom 4.
[13] Ser. 0n N.T. lessons 30: 4.
[14] In Rom. hom. 7.
[15] City of God 17: 4.
[16] In Rom. hom. 7.
[17] In Ioan tr 25: 12.
[18] In Rom. hom 7.
[19] Strom 5: 3.