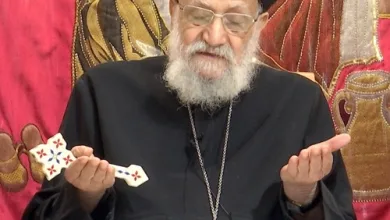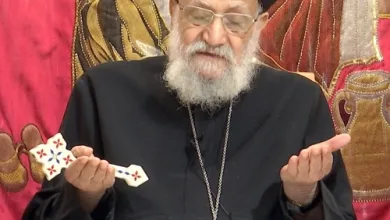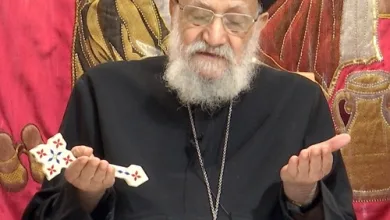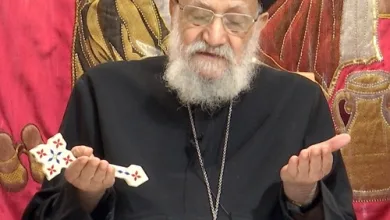تفسير رسالة رومية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 1 الأصحاح الأول - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة رومية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة رومية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
الباب الأول
حاجة الكل إلى الخلاص
ص 1
مقدمة الرسالة ص 1
الأصحاح الأول
مقدمة الرسالة
يمثل هذا الأصحاح مقدمة للرسالة، فيها يكشف الرسول عن جوهر الرسالة كلها، إذ لا يقدم افتتاحية شكلية تحمل مجاملة لطيفة لأهل رومية، وإنما يكتب بحكمة ليكشف في كلمات قليلة عن “إنجيل الله“، وفاعليته في حياة المؤمنين. كما يعلن خلالها عن مركز الرسول في الرب وفكره وحكمته ورسالته واشتياقاته الروحية. ولما كان الرسول يود أن يقاوم حركة التهوّد، لا في هجوم سلبي، وإنما بفتح كل قلب إيجابيًا لحب خلاص كل الأمم يبدأ بإبراز أخطاء الأمم أولاً ليعطي فرصة لأصحاب حركة التهوّد (أي للمطالبين بالعودة إلى أعمال الناموس الموسوي الحرفية) ألا يشعروا أنه إنسان متحيز للأمم على حسابهم، إنما هو محب للكل.
- البركة الرسولية 1-7.
- افتتاحية تشجيعية 8-17.
- شرور الأمم 18-32.
1. البركة الرسولية
لم يقدم الرسول بولس “البركة الرسولية” كأكلشيه يختم به مقدمة الرسالة، وإنما قدم البركة في المسيح يسوع بما يليق ببنيان من يتحدث معهم وموضوع حديثه لهم، إذ نلاحظ فيها الآتي:
أولاً: يبدأ الرسالة بدعوة نفسه بثلاثة ألقاب، قائلاً: “بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسولاً، المفرز لإنجيل الله” [1].
اللقب الأول هو “عبد doulas“، ولعله ابتدأ بهذا اللقب لأنه يكتب إلى أناسٍ يثيرون تفرقة عنصرية بين اليهود المتنصرين والأمميين المتنصرين، فإن كان هو عبدًا ليسوع المسيح، ففي هذا يتساوى جميع المؤمنين، إذ الكل عبيد للسيد المسيح، أيّا كان أصلهم أو ديانتهم السابقة.
كان أتقياء العهد القديم يعتزون بهذا اللقب بكونهم “عبيد يهوه” (مز 27: 9؛ 31: 16؛ 89: 50)، والآن إذ صار الكل في المسيح يسوع يتمتعون ببرّه وتقواه، يتأهلون لهذا اللقب “عبيد ليسوع المسيح”، ويفخرون به دون سواه، الأمر الذي يشترك كل الأعضاء فيه.
هذا وقد كان هذا اللقب يُنسب بالأكثر لمن قاموا بدور في تاريخ الخلاص خلال خدمتهم ليهوه، مثل موسى (2 مل 18: 12)، ويشوع (قض 2: 8)، وإبراهيم (مز 105: 42). وكأن بولس كرسول وهو مفرز لإنجيل الله يقوم بدور في تاريخ الخلاص، هو امتداد للدور الذي قام به آباء وأنبياء العهد القديم، لذا يليق باليهود المتنصرين أن يسمعوا ويتقبلوا رسالته بلا غضاضة.
أما اللقب الثاني فهو: “المدعو رسولاً“… لم يقل “رسول” بل “المدعو رسولاً”، لأن موضوع هذه الرسالة هو “دعوة الأمم للإيمان” كما سبق فدُعي اليهود قديمًا للإيمان؛ فإن كان القديس بولس يشعر بالفضل لله الذي دعاه للرسولية، فإنه حتى في إيمانه القديم كان مدعوًّا، وفي قبوله الصليب يحسب نفسه”مدعوٌا”… كأن لا فضل لنا في إيماننا كما في شهادتنا للرب، أيّا كان مركزنا الكنسي، إنما يرجع الفضل للذي دعانا.
اللقب الثالث: “المفرز لإنجيل الله“. هذا اللقب “المفرز” في الأرامية “برسي” أو “فريسي”، وتعني “منفصل”، وكأن فريسيته الأولى قد مهدت لفريسية من نوع جديد، لا فريسية الحرف القاتل القائمة على الاعتداد بالذات والكبرياء، إنما “فريسية روحية” تقوم على التكريس والفرز للتفرغ للكرازة لحساب إنجيل الخلاص للعالم كله.
بهذه الألقاب الثلاثة يعلن القديس بولس أنه “عبد“، حياته هي امتداد لحياة عبيد الله العاملين في العهد القديم خلال تاريخ الخلاص، يقوم بالعمل الرسولي بدعوة إلهية وليس من عندياته، لا عمل له ولا هدف سوى تقديم إنجيل الله لكل أحد إن أمكن!
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذه الألقاب الثلاثة، قائلاً:
[“بولس عبد ليسوع المسيح”… إنه يدعو نفسه عبدًا للمسيح، ليس بطريقة واحدة، إذ توجد أنواع من العبودية.
توجد عبودية أساسها الخلقة، كما قيل: “لأن الكل عبيدك“ (مز 119: 91)، وأيضًا: “نبوخذراصر عبدي“ (إر 25: 9)، لأن المخلوق عبد لخالقه أو صانعه.
توجد أيضًا عبودية من نوع آخر تنبع عن الإيمان، إذ قيل: “فشكرٌا لله أنكم كنتم عبيدًا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أُعتقتم من الخطية صرتم عبيدًا للبرّ“ (رو 6: 17-18).
نوع آخر يقوم على الخضوع للعمل، كما قيل: “موسى عبدي قد مات“ (يش 1: 2). حقًا كان كل الإسرائيليين عبيدًا، لكن موسى كان عبدًا بطريقة خاصة يتلألأ ببهاءٍ شديدٍ في الجماعة.
هكذا كان بولس عبدًا بكل هذه الأشكال (الثلاثة) من العبودية العجيبة، وقد وضعها كلقبٍ مكرمٍ، قائلاً: “بولس عبد ليسوع المسيح”… “المدعو رسولاً“، معطيًا لنفسه هذا الطابع في كل رسائله: “المدعو“، مظهرًا إخلاصه، وأنه قد وُجد ليس خلال سعيه الذاتي، إنما دُعي فجأة وأطاع.
هكذا أيضًا يعطي نفس الطابع للمؤمنين بقوله أنهم “مدعوون قديسين”. ولكن بينما هم مدعوون ليصيروا مؤمنين نال هو بجانب هذا أمرًا مختلفًا يسمى “الرسولية”؛ هذا الأمر مشحون بالتطويبات غير المحصية، أعظم وأسمى من كل العطايا… إذ يتحدث بولس بصوت عال،ٍ ويمجد العمل الرسولي، قائلاً: “إذًا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا“ (2 كو 5: 20)، بمعنى أننا نحمل دور المسيح (سفراء عنه). “المفرز لإنجيل الله”، كما في البيت يقوم كل واحد بعمل مغاير، هكذا في الكنيسة، توجد خدمات متنوعة تُوزع. وهنا يبدو لي أنه يلمح إلى أنه لم يُقم لهذا العمل باختيار الجماعة فحسب، وإنما عُيّن منذ القديم لهذا العمل، الأمر الذي يتحدث عنه إرميا قائلاً بأن الله قال عنه: “قبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيًا للشعوب” (إر 1: 5). فإذ يكتب الرسول إلى مدينة تتسم بالمجد الباطل، كل واحد فيها يفتخر متعاليًا، لذلك يكتب بكل وسيلة ليظهر أن اختياره (للرسولية) كان من قبل الله؛ الله هو الذي دعاه وهو الذي أفرزه[1]].
ثانيًا: يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على قوله: “المفرز لإنجيل الله”، قائلاً: [إنه يقول “إنجيل الله” لكي يفرح السامعين منذ البداية (لأن كلمة إنجيل تعني بشارة مفرحة)، فقد جاءهم بأخبار لا تحزن ملامحهم كما سبق ففعل الأنبياء خلال التوبيخات والاتهامات والانتهار، إنما بأخبار سارة، أي “إنجيل الله“، الحاوي للكنوز غير المحصية ذات البركات الثابتة غير المتغيرة[2].]
ثالثًا: يستخدم القديس أمبروسيوس هذه العبارة مع عبارات أخرى (2 كو 13: 14) للرد على الأريوسيين الذين نادوا بأن الآب أعظم من الابن مدللين على ذلك بأن الآب يُذكر أولاً في الترتيب، وههنا الرسول يذكر الابن قبل الآب، إذ يقول: “عبد ليسوع المسيح” أولاً ثم “المفرز لإنجيل الله”، هذا علامة على وحدة اللاهوت[3].
وفي نفس المقال يقول بأن الرسول بولس الذي يمنعني من التعبد للخليقة أجده هنا يحثني على التعبد للسيد المسيح، إذ يدعو نفسه “عبد ليسوع المسيح”، مظهرًا أنه الخالق وليس مخلوقًا[4].
رابعًا: إن كان الرسول يلتزم بصد حركة التهوّد المُعطلة لإنجيل الله وسط الأمم، فقد أراد أن يؤكد لليهود المتنصرين أنه لا يحمل أفكارًا غنوصية كتلك التي حملها البعض والتي ظهرت بالأكثر في مرقيون فيما بعد في القرن الثاني، حيث تجاهل العهد القديم، بل واستخف به. لقد أراد الرسول أن يُبرىء نفسه من هذه الأفكار الخاطئة، فأعلن أن “إنجيل الله” الذي أُفرز له ليس إلا تحقيقًا لخطة الله الخلاصية القديمة التي يمثل العهد القديم جزءًا منها، إذ يقول: “الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة” [2]؛ فما يكرز به إنما هو شهوة رجال وأنبياء العهد القديم وتحقيق لنبواتهم المقدسة.
إن كان محور إنجيله هو “المسيح ابن الله”، فإن هذا القدوس هو أيضًا مركز خدمة رجال العهد القديم، عنه تنبأ الأنبياء، وبه جاءنا الوعد في الكتب المقدسة (العهد القديم). أو ربما أراد أن يؤكد لهم أنه لن ينسى أن منهم جاء الأنبياء، ولهم قد سُلمت الشريعة والكتب المقدسة التي هيأت الطريق للمسيًا المخلص.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم هكذا: [إذ يريدا أن يصنع أعمالاً عظيمة علانية يسبق فيُعلن عنها زمانًا طويلاً ليُهييء مسامع البشر لقبولها عندما تتحقق. يقول “في الكتب المقدسة“، لأن الأنبياء لم يتكلموا فقط وإنما كتبوا ما نطقوا به، بل وقدموا ظلالاً لها خلال الأعمال مثل إبراهيم الذي رفع اسحق، وموسى الذي رفع الحيّة، وبسط يديه ضد عماليق، وقدم خروف الفصح[5].]
خامسًا: لما كانت الرسالة في مجملها هي إعلان عن “إنجيل الله”، لذلك عرّفه هنا في المقدمة بقوله: “عن ابنه، الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا”. إنجيلنا إذن هو قبول “ربنا يسوع المسيح”، الذي يكرر الرسول مؤكدًا أنه “ابن الله”، إذ خلاله ننال البنوة لله. هو الابن الذي باتحادنا فيه ننتقل من مركز العبيد إلى “الأبناء” بالمعمودية، لنُحسب موضع رضا الآب وسروره، وهذا هو مركز الرسالة كلها.
هذا أكد نسب المسيح لداود من جهة الجسد، أولاً لكي يشجع اليهود على متابعة حديثه، إذ لا يتجاهل أن مخلص العالم كله جاء متجسدًا منهم، ومن جهة أخرى ليؤكد أن فيه تحققت النبوات خاصة بكونه ابن داود الملك ليجلس على كرسي أبيه خلال ملكوت روحي سماوي (مت 21: 9؛ يو 12: 13؛ لو 1: 32؛ 2 تى 2: 8). وكما يقول القديس كيرلس الأورشليمي: [تقبل إذن المولود من ذرية داود وأطع النبوة القائلة: “ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب، إيّاه تطلب الأمم” (إش 11: 10) [6].]
هذا هو نسل داود الذي قيل عنه: “أُقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأُثبّت مملكته، هو يبني بيتًا لاسمي وأنا أُثبِّت كرسي مملكته إلى الأبد“ (2 صم 8: 12-13). وكما يقول القديس أغسطينوس: [إن نسل داود الذي بنى البيت الإلهي ليس سليمان بل السيد المسيح، إذ أقام هيكل الله غير المصنوع من خشب وحجارة، بل من البشر، أي من المؤمنين الذين قال عنهم الرسول: “أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟” (1 كو 3: 16)، لأن السيد المسيح لا سليمان هو الذي تثبت مملكته إلى الأبد حسب هذا الوعد الإلهي (2 صم 8: 13) [7].]
أما كلمة “تعيّن”، فكما يرى القديس يوحنا ذهبي الفم وغيره من الآباء الشرقيين، فتعني “أُعلن” أو “أُظهر”. فالكنيسة الأولى كانت ترى أنه لم يكن ممكنًا أن يُعلن عنه كمسيّا ورب إلا بعد قيامته (أع 2: 34-36؛ في 3: 10؛ 1 كو 15: 45). هذا ما رأيناه بوضوح في دراستنا للإنجيل بحسب مرقس، إذ كان السيد نفسه يخفي لاهوته ويؤكد لتلاميذه إلا يعلنوا عن شخصه حتى يقوم. قيامته هي الدليل القاطع على بنوته الطبيعية لله. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [بماذا إذٌا “أعلن” عنه؟ لقد أظهر وأعلن عنه واعترف به خلال مشاعر الكل وشهادتهم، وذلك بواسطة الأنبياء، وخلال ميلاده حسب الجسد بطريقة عجيبة، وبقوة العجائب، وبالروح الذي به يهب التقديس، وبالقيامة التي بها وضع نهاية لطغيان الموت[8].]
سادسًا: يقول: القديس يوحنا ذهبي الفم إن الرسول إذ ذكر أنه مفرز لإنجيل الله، تحدث عن تجسد ابن الله خلال نسل داود حتى نقبله، فيرتفع بنا إلى أسراره السماوية. بدون التجسد الإلهي والتواضع لا نقدر أن نرتفع معه إلى سمواته، إذ يقول: [من يريد أن يقود البشر بيده إلى السماء، يلزم أن يرتفع بهم من أسفل، وهكذا كان عمل التدبير (الإلهي). فقد نظروه أولاً إنسانًا على الأرض وعندئذ أدركوا أنه الله. بنفس الاتجاه إذ شكّل (السيد) تعاليمه هكذا استخدم تلميذه ذات الطريق ليقودنا إلى هناك[9].]
يقول القديس أمبروسيوس: [من جهة الجسد صار من نسل داود، لكنه هو الله المولود من الله (الآب) قبل العوالم[10].]
يقول أيضًا القديس غريغوريوس النزينزي: [لقد دعيَ من نسل داود؛ ربما بهذا نظن إن الرجل قد كُرم (لأنه جاء رجلاً ومنتسبًا إلى رجل)، لكنه وُلد من عذراء، وبهذا تُكرم المرأة من جانبها[11].]
سابعًا: بعد أن سجل اسم الراسل وألقابه خلال دعوته للرسولية وعمله الإنجيلي، كاشفًا عن مفهوم الإنجيل الإلهي الذي أُفرز له، سجل اسم المرسل إليهم ومركزهم من هذه الرسالة الإلهية، قائلاً: “الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، الذين بينهم أنتم أيضًا مدعوو يسوع المسيح، إلى جميع الموجودين في رومية أحباء الله مدعوين قديسين” [5-7].
قبل أن يدخل معهم في حوار بخصوص النزاع القائم بين اليهود المتنصرين والأمم المتنصرين أخذ يشجع الكل، معلنًا للجميع أن ما ناله القديس بولس إنما هو من قبيل نعمة الله المجانية كهبة مقدمة، لا لفضل فيه ولا فيهم كيهود أو أمم، وإنما لأجل اسمه، إذ يقول: “لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة (رسولية)”.
إن كانت هذه الرسالة تكرر الحديث عن نعمة الله، سواء في حياة الرسول، إذ نقلته لا من عدم الإيمان إلى الإيمان فحسبK وإنما من مضطهدٍ إلى كارزٍ ورسولٍ، أو في حياة المخدومين من يهود وأمم، فإن الرسول لم يقدم لنا تعريفًا عن “النعمة”، إنما حديثًا عن قوة النعمة وفاعليتها في حياة الكنيسة وكل عضو فيها. وكأن الرسول لم يرد أن يشغلنا بتعاريف نظرية وفلسفات فكرية، إنما أراد لنا معرفة التلامس الحقيقي والتمتع الواقعي بهذه الأمور. هذا هو أيضًا منهج الكنيسة الشرقية كما سبق فرأينا عند عرضنا “للنعمة” عند العلامة أوريجينوس[12].
ما هي هذه النعمة إلاَّ عطية الله المجانية، عطية الآب الذي في محبته قدم ابنه الحبيب مبذولاً عن خلاص العالم (يو 3: 16؛ رو 8: 32). نعمة الابن الوحيد الذي أحبني، وأسلم ذاته لأجلي. كما أرسل لنا روحه المعزي من عند الآب يشهد له في حياتنا (يو 15: 26)، يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل ما قاله لنا (يو 14: 26)، كما ارتبطت النعمة بالروح القدس، فإن كان الروح هو واهب العطايا، لكنه في نفس الوقت هو عطية، إذ صار ساكنًا فينا، حالاً في داخلنا بكوننا هياكل الله وروح الله ساكن فينا.
يعلن الآب عن نعمته خلال تدبير الخلاص، والابن يعلن عن ذات النعمة خلال حمله الصليب عنا، والروح القدس يقدم ذات النعمة بسكناه فينا لنقبل عمل المسيح الخلاصي في حياتنا.
هذه هي النعمة الإلهية المجانية التي تعمل في الكنيسة، لتهب الكل العضوية في الجسد الواحد، لكن لكل عضو تمايزه دون انفصال عن الرأس أو بقية الأعضاء، ولكل عضو بالنعمة خدمته ومواهبه، فقد ميّز الروح القديس بولس بالرسولية لأجل الكرازة والرعاية. هذه العطية “الرسولية” دفعته أن يكتب لهم كما لغيرهم بسلطانٍ لكي يحقق عمل النعمة الإلهية فيه وفيهم.
ثامنًا: إن كان الروح القدس قد ميّز القديس بالرسولية، فبنعمته صار يعمل في سامعيه لا للدخول في مناقشات ومجادلات، وإنما لقبول الإيمان في طاعة وخضوع: “لإطاعة الإيمان في جميع الأمم” [5]. هذا هو عمل النعمة الإلهية أو عمل الروح القدس نفسه في المخدومين. يقول: القديس يوحنا ذهبي الفم: [انظروا صراحة العبد، فإنه لا يود أن ينسب شيئًا لنفسه بل لسيده، فإن الروح بالحق هو الذي يهب هذا. لذلك يقول السيد: “إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق” (يو 16: 12)… وجاء في الرسالة إلى أهل كورنثوس: “فإنه لواحد يُعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم“ (1 كو 12: 8)، “الروح الواحد بعينه قاسمًا لكل واحد بمفرده كما يشاء” (1 كو 12: 11) [13].]
إذن نعمة الله التي قدمت للقديس بولس “الرسولية” هي التي تعمل لطاعة الإيمان لا في اليهود وحدهم، وإنما “في جميع الأمم”.
هذا ويرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن قوله “في جميع الأمم” يكشف أن الرسول إذ يتكلم عن عمل النعمة فيه كرسول يضم معه بقية الرسل، إذ تعمل النعمة في الكل لأجل جميع الأمم، أو ربما يقصد أنه وإن كان لا يعمل هنا في جميع الأمم فإنه حتى بعد موته لا يكف عن العمل في جميع الأمم. وربما يقصد الذهبي الفم أن الرسول يبقى في الفردوس خادمًا بحبه لخلاص العالم وبصلواته غير المنقطعة من أجل الكل.
تاسعًا: دعاهم “مدعوّي يسوع المسيح”، فالفضل لمن “دعانا” مجانًا لنعمته. كما دعاهم “مدعوّين قديسين”. فإن كان شعب إسرائيل قد دُعي قديمًا بالجماعة المقدسة (حز 12: 16؛ لا 23: 2، 44) بكونهم الشعب المفرز لله القدوس (لا 11: 24، 19: 2)، فإن هذا الشعب قد فشل في تحقيق القداسة إلا من خلال الرموز والنبوات، أما الآن فقد جاء مسيحنا القدوس يدعونا للدخول فيه والثبات فيه، فنُحسب به أبرارًا وقديسين.
أراد الرسول في أبوته الحانية أن يوضح نظرته لهم، أنه يحترمهم ويقدّرهم، لأنهم “مدعوّو يسوع المسيح” [6]، “أحباء الله” [7]، “مدعوّون قديسين” [7]، كأنه يفتخر أن يكون خادمًا لهم!
يحسب القديس يوحنا الذهبي الفم أن هذه الدعوة للقداسة هي كرامة فائقة ترافق المؤمنين حتى بعد عبورهم الحياة، إذ يقول: [الكرامات الأخرى تُعطى لزمان ثم تنتهي مع الحياة الحاضرة، هذه يمكن أن تُقتنى بمال… أما الكرامات التي يهبها الله، أي عطية التقديس والتبني، فلا يقدر حتى الموت أن يحطمها. إنها تجعل البشر مشهورين هنا، كما ترافقنا في رحلتنا إلى الحياة العتيدة[14].]
هذا وسرّ تقديسنا هو قبول “النعمة والسلام” [5]… فقد كانت كلمة “نعمة” هي تحية اليونانيين[15]، و”سلام” أو “شلوم” هي تحية العبرانيين؛ أما وقد صار الكل جسدًا واحدًا فلم يقبلوا “النعمة والسلام” من بعضهم البعض، إنما تمتعوا بهما كعطية إلهية للجسد الواحد الذي يضم اليونانيين واليهود معًا. تقبلوا نعمة الله الفائقة، أي عطاياه المجانية والتي تتجلى في سكنى الله نفسه في داخلهم ليُعلن ملكوته فيهم باستحقاقات دم الصليب، وسلامه السماوي الذي يوّحد الإنسان مع خالقه والجسد مع الروح والإنسان مع أخيه، أيّا كان جنسه!
يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول بحكمة يبدأ بالنعمة ثم بالسلام، إذ لا نستطيع أن ننعم بالسلام الداخلي، بعد أن دخلنا خلال عصياننا في حرب روحية شرسة ما لم تعمل نعمة الله فينا لتهبنا بالمسيح يسوع روح الغلبة والنصرة؛ فنعيش في سلام حقيقي، كأبناء لأبٍ سماويٍ. هذه هي عطية الله لنا، ونعمته التي تسندنا في هذا الزمان الحاضر وترافقنا حتى تدخل بنا إلى الحضن الأبوي أبديًّا. يقول القديس:
[إنها تحية تقدم لنا بركات بلا حصر.
هذا (السلام) هو ما أمر به المسيح الرسل أن يستخدموه كأول كلمة ينطقون بها عندما يدخلون البيوت (لو 10: 5). لهذا يبدأ الرسول بالنعمة والسلام. فقد كانت توجد حرب ليست بهينة، وضع المسيح لها نهاية؛ كانت بالحقيقة حربًا متنوعة من كل صنف استمرت زمنًا طويلاً، وقد انتهت خلال نعمة المسيح وليس بمجهوداتنا الذاتية.
الحب جلب النعمة، والنعمة جلبت السلام، لذلك جاء ترتيب التحية لائقًا (النعمة والسلام)، طالبًا لهم أن يعيشوا في سلامٍ دائمٍ غير متزعزع، حتى لا يشتعل لهيب حرب أخرى، سائلاً الله أن يحفظ لهم هذه الأمور ثابتة، قائلاً: “نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح” [7].
عجبًا! يا لقدرة حب الله، نحن الذين كنا قبلاً أعداء ومطروحين صرنا قديسين وأبناء! فإنه إذ يدعو الله “أبانا” يظهرهم أبناء له، وعندما يدعوهم أبناء يكشف عن كنز البركات كلها[16].]
السلام هو عطية الله التي يلزم أن نطلبها بالصلاة، فيهبها لنا إن صارت لنا الإرادة المقدسة، وكما يقول القديس جيروم: [يلزمنا أن نقتني السلام بالصلاة، هذا الذي يوجد ليس بين الجميع، بل بين من لهم الإرادة الصالحة… “لأن مسكنه (الله) في السلام“ (مز 76: 10) .]
لاحظ القديس أمبروسيوس أن النعمة والسلام قد نُسبا للآب كما للسيد المسيح، إذ يقول: [ها أنتم ترون إننا نقول بأن نعمة الآب والابن واحدة، وسلام الآب والابن واحد، لكن هذه النعمة وهذا السلام هما ثمر الروح كما يعلمنا الرسول نفسه، قائلاً: “وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة” (غل 5: 22) [17].]
2. افتتاحية تشجيعية
تكشف افتتاحية هذه الرسالة كما في باقي الرسائل عن جانب هام من منهج الرسول بولس في خدمته ومعاملاته، فإنه بروح الحكمة يشجع ويسند، حتى إن أراد أن يحاور أو يوبخ، فإن كان يكتب في جوهر الرسالة عن مشكلة حركة التهوّد التي سببت متاعب كثيرة للكنيسة، لكن بروح الحب يكسب من يوجه إليهم رسالته، إذ يعلن في الافتتاحية الآتي:
أولاً: تزكيته لإيمانهم: “أولاً أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم، أن إيمانكم ينادى به في كل العالم” [8]. يبدأ بالجانب الإيجابي لا السلبي، فلا يتحدث مثلاً عن خطورة حركة التهوّد ولا عن ضعفات هذا الشعب، إنما يعلن تزكيته لإيمانهم الذي صار علة كرازة في كل العالم، مقدمًا الشكر لله بابنه يسوع المسيح. هذا المنهج أساسي في اللاهوت الرعوي. أن نشجع أولاً ونسند، مبرزين الجوانب الحيّة والناجحة في حياة المخدومين قبل الجوانب السلبية والخاطئة.
يقدم الشكر للآب إلهه كعبادة حيّة، يقدمه في يسوع المسيح، لكي يكون مقبولاً. إذ لا نقدر أن نلتقي مع الآب، ولا أن نقدم له ذبيحة حب وشكر، إلا خلال رأسنا يسوع المسيح موضع سروره.
وقد استلفت نظر القديس يوحنا الذهبي الفم في تسبحة الشكر هذه أمران:
أ. أن الرسول بولس يقدم باكورة أعماله وكلماته تسبحة شكر لله، فيبدأ رسائله بالشكر، والعجيب أنه لا يشكر الله على عطاياه له فحسب، وإنما على عطاياه للآخرين، حاسبًا ما يتمتع به الآخرون يتمتع هو به. لذا يشكر الله هنا من أجل إيمانهم وكأنه مكسب له. يقول ابن كاتب قيصر في تفسيره للرسالة إلى أهل رومية: [هذا هو أول الرسالة. كان الشكر لمقدم النعم واجبًا، وكان هو أكثر منهم معرفة بقدر هذه النعمة التي وُهبت لهم، خاصة أنه يجد في إيمانهم نجاحًا لسعيه، إذ لم يسعَ إلا ليؤمنوا، لذلك قدم الشكر عنهم بسبب إيمانهم، ليعلمنا أن نفتتح أقوالنا وأفعالنا بالشكر.]
ب. ينسب الله إلى نفسه، إذ يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: [بأية مشاعر يقدم الشكر، إذ لا يقول: “الله” بل “إلهي“، الأمر الذي يفعله الأنبياء أيضًا، حاسبين ما هو عام للكل كأنه خاص بهم. وأي عجب إن فعل الأنبياء هكذا؟ فإن الله نفسه يفعل هذا دائمًا وبوضوح، فينسب نفسه لعبيده، قائلاً أنه إله إبراهيم واسحق ويعقوب، كما لو كان خاصًا بهم[18].]
ثانيًا: بجانب كشفه عن جوانب نجاحهم يعلن حبه نحوهم بالصلاة من أجلهم، مشهدًا الله نفسه على أعماقه المتسعة نحوهم: “فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم” [9].
لم يكن ممكنًا أن يذكر المخدومين، حتى وإن كان لم ينظرهم بعد حسب الجسد، بالصلاة الدائمة غير المنقطعة لو لم يكن قلبه وفكره وكل طاقاته قد تكرّست وأُفرزت لله، هذا ما عناه بقوله “أعبده بروحي”، أي أضع نفسي بكل طاقاتي الروحية والنفسية والجسدية للعبادة لله والتمتع بإنجيله.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة موضحًا نقطتين، هما:
أ. الرسول وهو يكرز بالإنجيل يعبد الله بالروح والحق: [لأن طريق خدمتنا ليس بخرافٍ وتيوسٍ ولا بدخانٍ وشحومٍ، وإنما بنفسٍ روحية، كقول المسيح: :”الله روح والذين يسجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا” (يو 4: 24)[19].]
ب. يخدم إنجيل الابن الذي هو بعينه إنجيل الآب: [قال قبلاً أنه إنجيل الآب، أما هنا فيقول إنجيل الابن، فلا اختلاف بين القولين، إذ تعلّم الرسول من الصوت الطوباوي أن ما للآب هو للابن، وما للابن هو الآب، إذ قيل: “ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي” (يو 17: 10)[20].]
ثالثًا: حبه مترجم عمليًا ليس فقط بذكرهم المستمر بلا انقطاع في صلواته، وإنما بشوقه الحقيقي لرؤيتهم ليهبهم “هبة روحية” هي إنجيل المسيح، الذي يثبتهم ويعزيهم كما يعزيه هو أيضًا، الإنجيل الذي يفرح قلب السامعين والكارزين معًا، إذ يقول: “متضرعًا دائمًا في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم، لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعًا، إيمانكم وإيماني“ [10-12].
بالحق هم موضوع حبه، يشغلون فكره وخطته وصلواته، وأيضًا تصرفاته من أجل غاية واحدة: تمتعتم بالهبة الروحية الإلهية، إنجيل الله! وقد حقق الله للرسول شوقه الروحي المقدس، لكن بخطة إلهية فائقة، إذ ذهب إليها كأسير من أجل الإنجيل بعد أن تعرض لضيقات كثيرة كانكسار السفينة به (أع 27: 43). ليقف أمام كرسي قيصر (أع 27: 24).
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على كلمات الرسول هذه لأهل رومية مبرزًا حب الرسول الشديد للكرازة، خاصة بين الأمم، لكن في حكمة الروح يلح في الطلب بلا انقطاع، مسلمًا الأمر بين يديّ الله العارف ما هو لبنيان الكنيسة، إذ يقول: [تضرعه الدائم دون توقف بسبب عدم نواله طلبه يكشف عن حبه الشديد لهم. لكنه وهو يحب مستمر في خضوعه لمشيئة الله… في موضع آخر يقول: “تضرعت إلى الرب ثلاثة مرات” (2 كو 12: 8)، وليس فقط لم ينل طلبته، إنما قبل عدم نواله الطلبة بشكرٍ شديد، ففي كل الأمور كان ينظر إلى الله. هنا نال الرسول، لكنه لم ينل عندما طلب بل في وقت متأخر، ومع هذا لم يكن متضايقًا. أشير إلى هذه لكي لا نتبرم نحن عندما لا يُستجاب لنا، أو عندما تأتي الاستجابة ببطء، فإننا لسنا أفضل من بولس الذي كان يشكر في الأمرين، مسلمًا نفسه في يدّ مدبر الكل، خاضعًا له تمامًا، كالطين في يدّ الخزّاف، يسير حيثما يقوده الله[21].]
رابعًا: كان الرسول ليس فقط خاضعًا لمشيئة الله التي سمحت له بتأجيل ذهابه إلى روما بالرغم من حبه الشديد لافتقادها، لا بهدف أرضي وإنما بتقديم “هبة روحية” هي “إنجيل الله”، وإنما أعلن الرسول تواضعه بقوله: “لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعًا، إيمانكم وإيماني“ [12].
في تواضع صادق بلا تزييف يشعر الرسول أنه محتاج إلى مخدوميه، فهو يفتقدهم ليس فقط لكي يرشد ويعلم ويوصي، وإنما أيضًا ليتعزى بإيمانهم. هم محتاجون إلى نعمة الله العاملة فيه، وهو محتاج إلى إيمانهم وتعزيتهم.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [يا لعظم تواضع فكره! لقد أظهر نفسه أنه في حاجة إليهم وليس هم فقط المحتاجين إليه. يضع التلاميذ موضع المعلمين، غير حاسبًا نفسه أعلى منهم، بل مقدمًا كمال مساواتهم له، لأن النفع مشترك، يقصد أنه يتعزى بهم وهم به. كيف يتحقق ذلك؟ “بالإيمان الذي فينا جميعًا، إيمانكم وإيماني”. وذلك كما في حالة النار، فإن أضاف إنسان مشاعل إلى بعضها البعض يشتعل بالأكثر اللهيب ويتقد الكل؛ هذا أيضًا يحدث بين المؤمنين طبيعيًا[22].] كما يقول أيضًا: [يقول هذا لا كمن هو في حاجة إلى أي عون منهم، وإنما لكي لا تكون لغته ثقيلة عليهم وتوبيخه عنيفًا، لهذا يقول أنه في حاجة إلى تعزياتهم. ربما يقول أحد أن تعزيته تكمن في فرحه بنمو إيمانهم، هذا هو ما يحتاج إليه بولس، هذا المعنى ليس بخاطيء[23].]
يقول ابن كاتب قيصر أن كلمة التعزية هنا تعنى الفرح والسرور، هو يتعزى لأنه كان مضطهدًا وصار رسولاً مبشرًا دُعي لهذا الرجاء الصالح، وهم يفرحون إذ كانوا قبلاً في ضلالة عبادة الشياطين وصاروا أولاد الله، عابدين له، مترجين ملكوته الأبدي.
خامسًا: يرى القديس إكليمنضس السكندري في حديث الرسول هنا التعزية التي ينالها كما ينالونها هم خلال الإيمان المشترك، إنما يعني أن الإيمان يحمل حركة نمو مستمر[24]، إذ يرى أن هناك إيمانًا مشتركًا يكون أساسًا خفيًّا في حياة جميع المؤمنين، هذا الإيمان لا يحمل جمودًا، بل حركة نمو مستمرة، لذا طلب التلاميذ من السيد المسيح: “زد إيماننا”. بمعنى آخر يمكننا أن نقول بأن الإيمان حركة حياة ديناميكية غير جامدة، يعيشها المؤمن كل يوم منطلقًا من خبرة معرفة عملية وتلاقٍ مع المسيح إلى خبرة أعمق، ومن قوة إلى قوة، ومن مجد داخلي إلى مجد، مشتاقًا كل يوم أن يبلغ إلى قياس قامة ملء المسيح كقول الرسول بولس.
سادسًا: إذ يعلن حبه عمليًا بشوقه لزيارتهم بل ومحاولاته العملية وقد مُنع حتى لحظات الكتابة، يكشف عن رسالته، بقوله: “ليكون لي ثمر فيكم أيضًا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية أيضًا، لأني لست استحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص، لكل من يؤمن لليهودي أولاً ثم لليوناني، لأن فيه معلن برّ الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيا” [13-17].
أ. إن كان الرسول قد صار له ثمر متكاثر في أمم كثيرة، لكنه مترقب الثمر أيضًا في روما بكونها عاصمة العالم الروماني الأممي، حاسبًا الكرازة بينهم وثمرهم هو تحقيق ونجاح لمهمته الرسولية؛ مستعد للعمل مهما بلغ الثمن بلا خجل.
إن كانت روما بكونها عاصمة للدولة الرومانية فيها تصب كل الشعوب أوثانها ورجاساتها وما يحملونه من انحطاط، فقد كانت مرآة للعالم الوثني بكل شروره وبؤسه، موضع غضب الله، لذا أراد الرسول أن تكون هذه المدينة هي بعينها مركزًا للخدمة، مقدمًا لها مفهوم إنجيل الله في كمال قوته. بمعنى آخر يودّ الرسول أن يخدم حيث يزداد بالأكثر الشرّ، إذ لا يريد الطريق السهل المتسع، بل الضيق الكرب لكي تعلن قوّة الإنجيل بالأكثر، ويظهر عمل النعمة الإلهية وفاعليتها بأكثر وضوح. هذا ما نستنبطه من قوله: “ما هو لي مستعدّ لتبشيركم”، بمعنى أنه مستعدّ لاحتمال كل ضيق وألم من أجل تقديم كلمة الإنجيل، إذ كان الرسول يُدرك أن الكرازة بينهم تستوجب أتعابًا كثيرة. لذلك يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [يا لها من نفس نبيلة! لقد وضع الرسول على عاتقه أن يقوم بعمل ذي مخاطر عظيمة، إذ يقوم برحلة عبر البحر تعترضها تجارب ومكايد… ومع توقعه لاحتمال هذه الأتعاب العظيمة لم يقلل هذا الأمر من همته بل كان يُسرع مجاهدًا، مستعدًا بذهنه لاحتمالها[25].]
ب. كان القدّيس بولس يخجل من الصليب قبل أن يلتقي بالمصلوب الممجّد، حاسبًا الصليب عارًا لا يليق بالمسيّا ملك اليهود، أمّا الآن فقد أدرك أنه قوّة الله للخلاص، يلزم أن يُكرز به للجميع.
يُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على كلمات الرسول قائلاً:
[يقول لأهل غلاطية: “حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح“ (غل 6: 14). كان الرومانيّون شديدي التعلّق بالزمنيّات بسبب غناهم وإمبراطوريتهم وكرامتهم، فكانوا يحسبون ملوكهم في مصاف الآلهة، حتى أقاموا لهم المعابد، وقدّموا لهم القرابين، وهم يتشامخون بهذا. أمّا بولس فكان يودّ أن يكرز لهم بيسوع الذي ظنوا أنه ابن نجار نشأ في اليهوديّة، في بيت امرأة فقيرة لا يحيط بها الخدم والحشم ثم مات ميّتة اللصوص والمجرمين، متحمّلاً أصناف السُخرية والإهانات، الأمور التي حاول (بعض الرومانيّون الذين تنصروا) الاختباء منها قبل إدراكهم عظمة هذه الأمور غير المنطوق بها: لهذا يقول الرسول أنه لا يستحي، إذ كان يعلمهم هم أيضًا ألا يستحوا من هذه الرسالة المجيدة، حتى إذا ما بدأ هكذا بعدم الاستحاء ينتهي بهم إلى الافتخار أيضًا. فإن سألكم أحد: أتعبدون المصلوب؟ لا تستحوا، ولا تنظروا إلى الأرض بل ارفعوا رؤوسكم… أجيبوا باعتزاز، نعم نعبده!… الصليب بالنسبة لنا هو عمل المحبّة اللانهائية نحو البشر، وعلامة عناية الله غير المنطوق بها[26].]
ج. أدرك الرسول أن الإنجيل أو الكرازة بالصليب هو “قوة الله الخلاص”، اختبر هذه القوّة في حياته فأراد أن يقدّمها للجميع، كارزًا لليونانيّين أي أصحاب الفكر الهيِليني، وللبرابرة أي بقية الأمم. يودّ أن يتمتّع الكل بعمل الصليب: الحكماء أصحاب الفلسفات، والبسطاء الذين يُحسبون كجهلاء.
إن كان الصليب قد أنقذه، فإنه مدين للعالم كله، حاسبًا الوثنيّين دائنين له، يلتزم أن يرد لهم الدين بالكرازة لهم ليتمتّعوا بما تمتّع هو به!
د. يدعو الإنجيل “قوة الله للخلاص”، إذ هو ليس رسالة نظرية أو فلسفة فكرية تعليمية إنما “عمل إلهي ديناميكي” في حياة الإنسان، حركة حب إلهي لا تتوقف تبلغ به إلى شركة الأمجاد الإلهية.
ه. إنجيل المسيح مُقدّم لليهودي أولاً ثم اليوناني، هنا الأولوية لا تقوم على محاباة الله لجنسٍ على حساب آخر، وإنما أولوّية الالتزام بالمسئولية والعمل. فإن كانوا قد ائتمنوا على الناموس المكتوب، وتقبلوا إعلانات ونبوّات، ومنهم خرج رجال الله، فقد لاق بهم أن يتلّقفوا عمل السيد المسيح الخلاصي، ويحتضنوا الصليب حتى يخرجوا إلى الأمم، حاملين نير البشارة بالخلاص.
يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [كلمة “أولاً” ليست إلا تعبيرًا عن الناحية الزمنيّة فقط، إذ لا يوجد امتياز في مقدار البرّ الذي يحصل عليه، ولكن كمن ينزل في جرن المعمودية أولاً ثم يليه الآخر نعمة أعظم من التالي له، إنما ينعم الكل بنعمة واحدة. هكذا يتساوى اليهودي واليوناني في مواهب النعمة متى قبِلوا الإنجيل[27].]
و. ماذا يعني بقوله: “إيمان لإيمان؟” يرى العلامة ترتليان[28] والعلامة أوريجينوس وابن كاتب قيصر أن برّ الله بإيمان الناموس حين نُقل المؤمنين إلى الإيمان بالإنجيل، وكأن الثمر الذي يشتهيه الرسول لكل عالم هو ذات الثمر الذي ترجّاه رجال الإيمان في العهد القديم، وقد حلّ الوقت المعيّن لينعم العالم به خلال الإيمان بالإنجيل الإلهي. يقول القدّيس إكليمنضس السكندري: [يعلّمنا أن خلاصًا واحدًا من الأنبياء إلى الإنجيل يحقّقه الرب الواحد عينه[29].] ويري القدّيس أمبروسيوس أن برّ الله يُعلن خلال أمانة الله في مواعيده، فتنتقل أمانته إلى إيمان الإنسان الذي ينعم ببرّ الله.
يقدّم لنا الرسول مفتاح كل عطيّة صالحة إلهية: “أما البارّ فبالإيمان يحيا“ [17]. فالإنسان الذي يرتبط بالله يحمل برّ المسيح فيه، لكنه لا يعني هذا أنه يصير معصومًا من الخطأ كما يظن البعض، إنما يتمتّع بالنمو المستمر في برّ المسيح بلا توقف. وقد حذّرنا القدّيس أغسطينوس من فهم هذه العبارة بمعنى أننا نصير بلا خطيّة[30].
ويُعلّق القدّيس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة بالقول:
[مادامت عطيّة الله تفوق الإدراك تمامًا فمن المنطق أننا نحتاج إلى الإيمان.
أما ترون أن عدم الإيمان هو هوّة سحيقة، أمّا الإيمان فحصن حصين. لأن عدم الإيمان أهلك الآلاف بينما الإيمان لم يُؤدِ إلى خلاص الزانية وحدها بل جعلها أيضًا أمّا لكثيرين.
إننا نستضيف برقةٍ أم كل البركات، وهو الإيمان، لكي نكون كمن هم يسيرون في ميناء هادئ مستقر تمامًا، محافظين على إيماننا الأرثوذكسي، فنقود سفينتنا باستقامة ونحظى بالبركات بالنعمة ومحبة البشر التي لربنا يسوع المسيح[31].]
- شرور الأمم
إذ يواجه القدّيس بولس حركة التهوّد ليُعلن عن عمومية الخلاص لليوناني كما لليهودي، لم يبدأ بضعفات اليهود وشرورهم، بل بالعكس يتحدّث بصراحة ووضوح عن شرور الأمم، لكي يكون ذلك مدخلاً لنقد اليهود أيضًا، في صراحة وتفنيد كل حججهم دون اتهامه بالمحاباة. فقد وُجّه إليه هذا الاتهام: “إنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى، قائلاً أن لا يختنوا أولادهم، ولا يسلكوا حسب العوائد“ (أع 21: 21). هذا ما دفع الرسول إلى البدء بإعلان شرور الأمم ومسئوليتهم عنها، ليس تشهيرًا بهم ولا تحقيرًا، وإنما كمدخل لاجتذاب اليهود المتنصّرين لقبولهم معهم في العضوية في الجسد الواحد على قدَم المساواة، إذ يُعلن أن الأممي كاسر للناموس الطبيعي واليهودي كاسر للناموس الموسوي، لذلك صار الكل في حاجة إلى تدخل إلهي كي يتبرّروا لا بالناموس الطبيعي ولا بالناموس الموسوي، وإنما بالإيمان بالمسيح يسوع مخلص الجميع.
في حديثه عن شرور الأمم أصحاب الناموس الطبيعي يبرز الرسول الآتي:
أولاً: إن كان الله قد أعطى اليهود الناموس الموسوي، فإنه لم يهمل الأمم ولا تركهم بلا شاهد لنفسه بينهم، فقد أعلن نفسه خلال الطبيعة المنظورة، إذ يقول: “إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر” [20].
“الله لم يترك نفسه بلا شاهد فإن السماء تحدِّث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه“ (مز 19: 1). يُعلن قدرته السرمدية ولاهوته خلال أعمال الخليقة الفائقة، التي أقامها بكلمته، لا لاستعراض إمكانياته، وإنما من أجل أعماق محبته لنا. فحب الله الفائق غير المنظور نلمسه خلال رعايته العجيبة، إذ قدّم لنا هذه المصنوعات لراحتنا.
بينما يتهم الرسول بولس البشر أنهم يحجزون الحق بالإثم [18]، وكأن الإنسان يتفنن في اختراع الطرق الأثيمة المتنوعة ليحجز “الحق” فلا يُعلن، إذ بالله يُعلن “الحب” لنا بطرق متنوعة خلال المصنوعات المباركة التي هي من عمل يديه. الإنسان يستميت في حجز الحق، والله يبذل لإعلان الحب السرمدي!
يرى القديس أغسطينوس في هذا القول الرسولي أن الله يقدم لنا العالم كعطية نستخدمها و ليس نتلذذ بها، فنرى خلالها أموره غير المنظور، نمسك بالروحيات والسماويات خلال الماديات والزمنيات[32].
يُعلّق القدّيس أمبروسيوس على التعبير “قدرته السرمدية”، قائلاً: [إن كان المسيح هو قدرة الله السرمدية، فالمسيح إذن سرمدي[33].]
هذا وإذ يحجز الإنسان الحق بالإثم يسقط تحت الغضب الإلهي [18]، أمّا من يرجع إليه بالتوبة فيسمع الصوت الإلهي: “هلم يا شعبي أدخل مخادعك وأغلق أبوابك خلفك، اختبئ نحو لُحيظة حتى يعبر الغضب، لأنه هوذا الرب يخرج من مكانه، ليعاقب إثم سكان الأرض فيهم، فتكشف الأرض دماءها ولا تغطي قتلاها فيما بعد” (إش 26: 20-21). ما هي المخادع التي تدخل فيها إلا الحياة السرية في المسيح يسوع حيث فيه نختبئ من الغضب، ونصير موضع سرور الآب! وأمّا قوله “هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب…” إنما يعني أنه يودّ أن يبقى في مكانه يُعلن حُبّه ورحمته، لكن إصرار سكان الأرض على الإثم تلزمه أنه يعاقب!
ثانيًا: لم يستطع الأممي خلال هذه المعرفة المعلَنة بالناموس الطبيعي، والمُسجلة خلال المنظورات أن يخلص، بل على العكس أخذ موقف المقاومة التي تظهر في الآتي:
أ. “لأنهم لما عرفوا الله، لم يمجّدوه أو يشكروه كإله، بل حمَقوا في أفكارهم، واِظلمّ قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات” [21-23].
هذا الاتهام كما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم أخطر من الاتهام السابق، فإن الأمر لم يقف عند رفض الله الذي أعلن عن محبته وقدرته خلال مصنوعات يديه، وإنما لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه، بل استبدلوا عبادة الله الحيّ بالعبادة الوثنيّة. وكما قال الله على لسان إرميا: “لأن شعبي عمل شرين: تركوني أنا ينبوع المياه الحيّة لينقروا لأنفسهم أبارًا أبارًا مشققة لا تضبط ماءً“ (إر 2: 13). أمّا علّة انحرافهم فهو اتكالهم على الفكر البشري المجرد دون عون الله، “وبينما هو يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء“، فصاروا كما يقول الذهبي الفم كمن يبحِّرون في مياه مجهولة، فتتحطم سفينتهم على صخور صلدة، إذ حاولوا بلوغ السماء بعدما أطفأوا النور المضيء في داخلهم، متّكلين على ظلمة أفكارهم.
يرى القدّيس أغسطينوس أن سرّ هلاكهم هو جحودهم وعدم شكرهم، إذ يقول: [بجحودهم صاروا أغبياء، فما يهبه الله مجانًا (أي الحكمة) ينزعه عن غير الشاكرين[34].] كما يقول: [لقد رأوا إلى أين يجب أن يذهبوا، لكنهم بجحودهم نسبوا هذه الرؤية التي وهبهم الله إيّاها لأنفسهم، وإذ سقطوا في الكبرياء فقدوا ما قد رأوه، وارتدّوا إلى عبادة الأوثان والتماثيل والشياطين، يعبدون المخلوق ويحتقرون الخالق[35].]
هذا ويرى القدّيس أغسطينوس أن هؤلاء الذين نسبوا لأنفسهم الحكمة فسقطوا في العبادات الرذيلة هم الرومان واليونان والمصريّون الذين مجدوا أنفسهم تحت اسم الحكمة[36].
ب. إذ تركوا الله الذي يُعلن ذاته لهم خلال الطبيعة تخلَّى هو أيضًا عنهم كشهوة قلوبهم، هذا هو ما عناه الرسول بقوله: “لذلك أسلمهم الله أيضًا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة، لإهانة أجسادهم بين ذواتهم” [24]. تركوه بإرادتهم، وإذ هو يُقدر الحرّية الإنسانيّة ويكرمها، أعطاهم سؤل قلبهم وهو تركهم، فمارسوا شهوات قلوبهم الشرّيرة، حيث ارتكب الرجال والنساء قبائح لا تليق حتى بالطبيعة [26-27].
ويرى القدّيس يوحنا كاسيان[37] أن الإنسان إذ يسقط في الكبرياء حتى وإن كان طاهرًا جسديًا، يسمح الله بالتخلّي عنه لكي إذ يسقط في شهوات جسديّة ظاهرة أمام عينيه يقدر أن يدرك الكبرياء الخفي الذي لا يراه.
لهذا السبب نجد كثير من الشباب يسقطون في الرجاسات الجسديّة بالرغم من مواظبتهم على وسائل الخلاص، من دراسة في الكتاب وتقديم صلوات، وربّما اعتراف وتناول، لكن العلّة الرئيسية لسقوطهم هو كبرياء قلوبهم. بالكبرياء يفقد الإنسان نعمة الله التي تهبه القداسة، فينهار تحت ثقل شهوات جسده وفساده.
ويحدّثنا القدّيس بفنوتيوس عن سماح الله لنا بهذا الانحراف، معلنًا أننا نحن السبب في هذا الفساد، إمّا بسبب كبريائنا أو إهمالنا، إذ يقول: [علينا أن نعرف أن كل شيء يحدّث، إمّا بإرادته أو بسماح منه، فكل ما هو خير يحدّث بإرادة الله وعنايته، وكل ما هو ضدّ ذلك يحدّث بسماح منه، متى نُزعت حماية الله عنّا بسبب خطايانا أو قسوة قلوبنا أو سماحنا للشيطان، أو للأهواء الجسديّة المخجلة أن تتسلط علينا، ويُعلمنا الرسول بذلك، مؤكدًا: “لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان” (رو 1: 25)، وأيضا: “كما لم يستحسنوا أن يُبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق” (رو 1: 28). ويقول الله بالنبي: “فلم يسمع شعبي لصوتي، وإسرائيل لم يرضَ بي، فسلّمتهم إلى قساوة قلوبهم، ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم” (مز 81: 11-12)[38].]
يقول الأب يوحنا كاسيان: [من عدل الحكم الإلهي أن تُعطى المواهب الصالحة للمتواضعين، وتُمنع عن المتكبِّرين المرفوضين الذين يقول عنهم الرسول أنهم مستحقون أن يُسلّموا إلى ذهن مرفوض (رو 1: 28)[39].]
إذًا اختار الإنسان في شرّه الفساد، حلّ الفساد به، أمّا الله فهو “مبارك إلى الأبد، آمين” [25] وكأن ما يرتكبه الإنسان إنما يحلُ به لا بالله. وكما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [إن كان الفيلسوف لا يتأثر بإهانة الجهلاء له، فكم بالحري الله الأزلي غير المستحيل، لا تبلغ وقاحة الناس إلى طبيعته المجيدة التي لا يعتريها ظلّ دوران[40].]
يقف القدّيس الذهبي الفم هنا قليلاً ليسألنا أن نتشبّه بالله الذي يحتمل الأشرار ولا يتأثّر بشرّهم، فإن طبيعته أسمى من أن تتأثر بهم، هكذا إذ نتشبّه به نحتمل نحن أيضًا شرور الأشرار، إذ يقول: [يليق بنا ألاّ نحاول الهروب من الإهانات بل بالأحرى نحتملها، لأن مثل هذا الاحتمال هو الشرّف بعينه. لماذا؟ لأنه في قدرتك أنت أن تحتمل، أمّا تصليح الآخرين فهو من عمل الغير. أتسمع صدى الضربات التي تسقط على الماس؟ قد تقول هذه هي طبيعة الماس. حسنًا، وأنت في مقدورك أن تتدرّب على ما هو للماس بالطبيعة. ألم تسمع كيف لم تؤذِ النار الثلاثة فتية؟ وكيف ظلّ دانيال في الجب سالمًا؟ فما حدث لهؤلاء ممكن بالنسبة لنا، إذ يوجد حولنا أسود الشهوة والغضب مستعدّة لتمزيق من يسقط تحت قدميها. إذن كن كدانيال واِثبت، فلا تجعل الانفعالات تنشب بأظفارها في نفسك. تقول: هذا من فعل النعمة. حقًا، لكن النعمة تنساب خلال تدريب الإرادة، فمتى كنّا مستعدّين لتدريب أنفسنا على نمط هؤلاء الرجال، تنساب النعمة في داخلنا، عندئذ تقبع الوحوش في مذلّة قدّامنا بالرغم من جوعها. فإن كانت الوحوش قد تراجعت أمام عبد، أفلا تتراجع بالأحرى أمام أعضاء جسد المسيح (أمامنا)! [41].]
ج. ربّما يعتذّر البعض بأن ما يرتكبوه من شرور هو ثمرة ضعف الطبيعة البشريّة وجرْيها وراء اللذّات بلا ضابط، لذا أوضح الرسول أن الإنسان في شرّه صار يمارس حتى ما هو مخالف للطبيعة، يسيء للطبيعة عنه لتحوّل حياتهم إلى جحيم، إذ يقول: “لأن إناثهم استبدلْن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضًا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق” [26-27].
يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [هنا إذ يتحدّث عن العالم يضع أمامهم اللذّة الطبيعية التي كان في مقدورهم الاستمتاع بها في طمأنينة وفرح قلبي، متحاشين الأعمال المخزية، لكنهم لم يريدوا… إذ أهانوا الطبيعة عينها… جلبوا عارًا على الطبيعة، وداسوا على القوانين الإنسانيّة في نفس الوقت[42].]
يرى القدّيس بوحنا الذهبي الفم أن الإنسان قد حوّل حياته إلى حرب داخليّة وجحيم لا يُطاق، فإن كان الله قد وهب بالطبيعة أن يتزوج الرجل بامرأة، ويصير الاثنان جسدًا واحدًا في انسجام الحب والألفة، أهان الاثنان نفسيهما ودخل كلاهما في حرب داخليّة، فجرت النساء وراء بعضهن البعض وأيضًا الذكور، فتحوّلت الحياة الإنسانيّة إلى انشقاقات وحروب داخليّة لا تنقطع، تقوم ليس فقط بين الرجل وامرأته، وإنما بين النساء وبعضهن البعض، والذكور وبعضهم البعض، فنالوا في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق [27]. هذا ما أكّده كثير من الآباء وهو أن الخطيّة تحمل فسادها فيها، فتسكب من هذا الفساد على مرتكبها ليحمل عقوبته، ليس فقط كأمرٍ يصدر ضده من الخارج، وإنما خلال ممارسته الشرّ عينه.
د. قدّم صورة بشعة للإنسان في شرّه، إذ صار لا يطلب اللذّة الطبيعية فحسب، وإنما صار مفسدًا للطبيعة عِوض السُمو بها. فبدلاً من أن يرتفع بالروح، ليسمو بغرائزه الحيوانية، ليصير جسده بغرائزه مقدسًا للرب، صار في بشاعته مفسدًا للطبيعة، يفعل ما لا يرتكبه الحيوان خلال العلاقات الجسديّة الشاذة، سواء بين الإناث وبعضهن البعض أو الذكور وبعضهم البعض. الآن يقدّم لنا قائمة مرّة بما ترتكبه البشريّة المنحرفة، وقد لاحظ القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول يذكر في قائمته هذه التعبيرات: “مملوءين“، “من كل“، “مشحونين“. وكأن الآثام لم تعد أمرًا عارضًا في حياة الإنسان، لكنها تملأ كيانه الداخلي، وتشحنه تمامًا ليرتكب لا إثمًا أو إثمين وإنما “كل إثمٍ”!
ه. العجيب أن الخطايا والآثام تحطِّم سلام الإنسان وتفقده فرحه الداخلي، لكنها في نفس الوقت تدفع مرتكبها نحو العجرفة والكبرياء، لذلك جاءت القائمة تصفهم هكذا: “مفترين، مبغِضين لله، ثالبين، متعظمين…” [30]. يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم: [التشامخ مع الخطيّة طامة كبرى… إن كان الذي يعمل صلاحًا يفقد تعبه إن انتفخ، فكم يكون إثم الذي يضيف إلى خطاياه خطيّة التشامخ؟ لأن مثل هذا لا يقدر أن يمارس التوبة[43].]
و. إن تأملنا هذه القائمة من الآثام والشرور نشعر أن البشريّة إذ سلّمت نفسها بنفسها للعصيان ومقاومة الله مصدر حياتها وتقديسها، صارت ملهى للخطايا، كل خطيّة تلهو بالإنسان، لتُلقي به في أيدي خطايا أخرى، وهكذا يصير أضحوكة كل الآثام والشرور، ويمكننا هنا في شيء من الاختصار أن نورد ترتيب هذه القائمة هكذا:
* يبدأ الإنسان يلهو بلذّة الجسد فيستسلم للزنا [29].
* إذ يتقوقع الإنسان حول لذته الجسديّة، يطلب ما هو لذاته، حتى وإن بدا في الظاهر سخيًا ومبذِّرًا، لكن يتملكه حب الطمع، الأمر الذي يدفعه أيضًا إلى الخبث لتحقيق غايته هذه [29].
* أمّا الطمع فيسبب حسدًا وخصامًا ومكرًا وربّما يؤدى إلى القتل [29].
* هذا الحسد والمكر يدفع الإنسان إلى الاعتداد بذاته، فيصير متعاظمًا [30].
* حب العظمة ينحرف بالإنسان إلى الابتداع وترك الحق [30].
* رفض الحق يدفع الإنسان إلى تعدى الطبيعة، فيصير غير مطيعًا للوالدين [30].
* إذ يتعدى الإنسان حتى أبسط نواميس الطبيعة يفقد الفهم [31]، ويكسر كل عهد طبيعي أو مكتوب، ويخسر طبيعة الحب والحنوّ [31]، بهذا يسقط تحت تحذير الرب: “لكثرة الإثم تفتر المحبّة” (مت 24: 12)، فيصير أبشع من الحيوانات المفترسة التي تتحد معًا كجماعات بحكم الغريزة، أمّا الإنسان فيكره أخاه.
ز. في هذا الانحدار البشري إلى ما هو أدنى من الطبيعة تبلّدت القلوب البشريّة فلم يستكينوا للشر فحسب، وإنما صاروا يفرحون بمن يسقط مثلهم، إذ يقول الرسول: “الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط، بل أيضًا يُسرّون بالذين يعملون” [32].
ط. يلاحظ في هذا السفر بوجه عام أنه إذ يتحدّث عن الأمم يُعلن دور الناموس الطبيعي بكونه، كما يقول العلامة ترتليان[44]، ناموس الله الذي يسود العالم منقوشًا على لوحي الطبيعة، لذلك يقول الرسول: “لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس…“ (2: 14). وفي هذا الأصحاح يتحدّث عن الأمم في شرٍ ككاسري ناموس الطبيعة الذين “يفعلون ما لا يليق” (1: 28)، كأن تستبدل الإناث “الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة” (1: 26). وعندما يتحدّث الرسول عن التزام المرأة بغطاء الرأس أثناء الصلاة، يقول: “أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم…؟” (1 كو 11: 14).
فالمسيحي إذن ملتزم بناموس الطبيعة، بل ويسمو ليبلغ لا إلى تكميل الناموس الموسوي، بل إلى الوصيّة الإنجيليّة العالية.
[1] In Rom, hom 1.
[2] In Rom, hom 1.
[3] Of the Christian Faith, 5: 9 (115).
[4] Of the Christian Faith, 1: 16 (104).
[5] In Rom. hom 1
[6] Cat. Lect., 12: 23.
[7] City of God, 17: 8.
[8] In Rom. hom 1.
[9] In Rom. hom 1.
[10] Of Christian Faith, 3: 5 (34).
[11] Oration. 37: 7.
[12] للمؤلف: آباء مدرسة إسكندرية الأولون، العلامة أوريجينوس، النعمة.
[13] In Rom. hom. 1.
[14] In Rom. hom. 1.
[15] Erdman: The Epistle to Romans, p 25.
[16] In Rom. hom., 1.
[17] Of the Holy Spirit 1: 12 (126).
[18] In Rom. hom 2.
[19] In Rom. hom 2.
[20] In Rom. hom 2.
[21] In Rom. hom 2.
[22] In Rom. hom 2.
[23] In Rom. hom 2.
[24] Strom. 5: 1.
[25] In Rom. hom 2.
[26] In Rom. hom 2.
[27] In Rom. hom 2.
[28] Adv. Marc. 5: 13.
[29] Strom 2.6.
[30] City of God 20: 26.
[31] In Rom. hom 2.
[32] On Christian Doctrine 1: 4.
[33] Of Christ. Faith 1: 10 (62).
[34] In Ioan. tr 14: 3.
[35] In Ioan. Tr 2: 4.
[36] City of God 8. 10.
[37] Instit. 12: 21.
[38] Conf. 3: 20.
[39] Conf. 3: 20.
[40] In Rom. hom 3.
[41] In Rom. Hom. 4.
[42] In Rom. Hom. 4.
[43] In Rom. Hom. 5.
[44] De Corona 6.