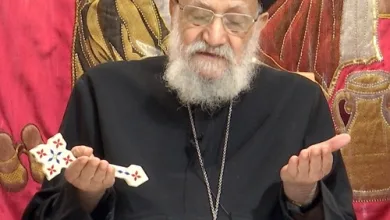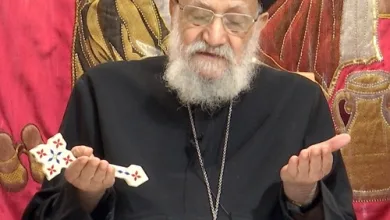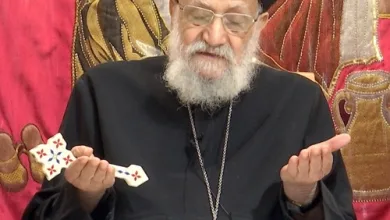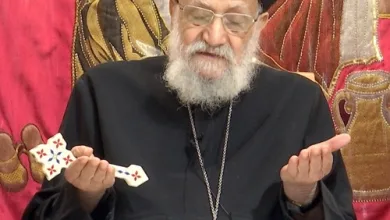تفسير انجيل لوقا 17 الأصحاح السابع عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير انجيل لوقا 17 الأصحاح السابع عشر - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير انجيل لوقا 17 الأصحاح السابع عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير انجيل لوقا 17 الأصحاح السابع عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح السابع عشر
الإيمان والصداقة الإلهية
جاء السيد المسيح يبحث عنّا كراعٍ يطلب خروفه الضال ليحتضنه، ويرتفع به إلى سماواته، وكأب يطلب ابنه الضال ليُقيم له وليمة مفرحة، ويسأل عروسه الكنيسة أن تجدّ في البحث عنّا كدرهمٍ مفقودٍ حتى تجدنا وتغسلنا بدمه فنحمل صورته الإلهية (ص 15). ومن جانبنا كما رأينا في الأصحاح السابق يلزمنا لكي نقبل هذه الصداقة أن نسلك بحكمة طالبين ما هو لبنياننا في الحياة الأبدية، لا اللذة الوقتية (مثل الوكيل الظالم)، محتملين الآلام بشكر كلعازر المسكين غير ممتثلين بالغني في انغماسه بالملذات وقساوة قلبه على أخيه. الآن يقدم لنا العنصر الأساسي لهذه الصداقة وهو الإيمان، مترجمًا عمليًا في حياتنا خلال الحياة الواقعية السلوكية، والواقع الداخلي في النفس وترقب مجيء الرب.
- تجنب العثرات في سلوكنا 1-2.
- اتساع القلب للمخطئين إلينا 3-4.
- زد إيماننا 5-10.
- الشكر والإيمان ـ (العشرة برّص) 11-19.
- الإيمان بالملكوت الداخلي 20-21.
- بين الملكوت الداخلي والأخروي 22-37.
1.تجنب العثرات في سلوكنا
تقوم صداقتنا مع السيد المسيح على الشركة الخفية داخل القلب، خلالها ننعم بالحياة الجديدة بروحه القدوس. هذه الشركة تتجلى عمليًا في سلوكنا الواقعي، خاصة في تجنب العثرات باتساع القلب بالحب، خاصة للمخطئين. فنعلن عن مسيحنا محب البشر الذي أحبنا ونحن بعد أعداء وصالحنا مع أبيه (رو 5: 10)، بحبنا حتى للمقاومين لنا. أما بالنسبة لتجنب العثرة، فيقول الإنجيلي:
“وقال لتلاميذه لا يمكن إلاّ أن تأتي العثرات،
ولكن ويل للذي تأتي بواسطته.
خير له لو طوق عنقه بحجر رحى، وطُرح في البحر،
من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار” [1-2].
يؤكد السيد المسيح أن العثرة قائمة، ولكن تأكيده لا يعفي المعثرين من الدينونة أو المسئولية، إذ لا يلزم أحدًا أن يكون عثرة، إنما هو طبيب يشَّخص المرض، فيرى في البشرية من رفض منهم الطعام تمامًا برفضه الإيمان به، فينحدر إلى الهلاك ويكون عثرة للآخرين.
جاء هذا الحديث بعد أن كشف السيد المسيح عن عثرة المال، الذي عبده الفريسيون في قلوبهم الداخلية، فحملوا إلهًا غير الله، وصاروا عثرة في طريق الخلاص. وكأن السيد المسيح إذ عالج في الأصحاح السابق موضوع “محبة المال”، سأل تلاميذه أن يحترزوا من هذا الإله المعّثر للنفس، لئلا يصيروا كالفريسيين عثرة للشعب.
- ما هي العثرات التي يشير إليها المسيح التي لابد أن تحدث؟ يوجد نوعان من العثرات: عثرات ضد مجد الكائن الأعظم، تقاوم جوهره ذاك الذي هو فوق الكل… أما العثرات الأخرى فتحدث من حين إلى آخر ضد أنفسنا، كل ما تجلبه هو ضرر الإخوة شركائنا في الإيمان.
الهرطقات التي تظهر، والبدع التي تقاوم الحق، في الحقيقة هي عثرات تقاوم مجد اللاهوت الأسمى، إذ تسحب الذين اصطادهم (الله) لتفسد استقامة تعاليمهم المقدسة الدقيقة. عن مثل هذه العثرات يقول المخلص نفسه: “ويل للعالم من العثرات” (مت 18: 7)، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. مثل هذه العثرات التي يبثها الهراطقة الأشرار لا توجه ضد فردٍ معينٍ، إنما يقصد بها العالم، أي سكان الأرض كلها. ينتهر الطوباوي بولس مثيري هذه العثرات، قائلاً: “هكذا إذ تخطئون إلى الإخوة، وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح” (1 كو 8: 12). ولكي لا تتغلب مثل هذه العثرات على المؤمنين يقول الله لسفراء كلمة الحق المستقيمة والمهرة في تعليمها: “اعبروا أبوابي، هيئوا طريق شعبي، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة” (إش 62: 10 الترجمة السبعينية). وقد وضع المخلص عقوبة مُرة على الذين يضعون مثل هذه العثرات في طريق الناس[1].
القديس كيرلس الكبير
إن كان السيد المسيح يؤكد لنا: “لا يمكن إلاّ أن تأتي العثرات” [1] كحقيقة قائمة في كل عصر، إذ لا يتوقف عدو الخير عن مهاجمة المؤمنين خلال الهراطقة كما خلال أخطاء بعض الكهنة والخدام والمؤمنين من الشعب حتى يحطم النفوس الضعيفة، فإن السيد المسيح يحذرنا من جانبين: ألاّ نكون عثرة للغير، وألا نتعثر نحن كصغار في الإيمان خلال أخطاء الغير.
في حديثنا عن هذه العبارات الإنجيلية (مت 18: 6-7؛ مر9: 42) رأينا أنه كان من عادة اليهود حين يقطعون الأمل في إنسان ويريدون أن يجعلوه عبرة للغير، يربطون عنقه في حجر، ويلقون به في البحر، فلا يظهر بعد، هكذا يرى البابا غريغوريوس (الكبير) أن الخادم أو الكاهن الذي يعثر شعبه يلزمه أن يترك عمله الرعوي ويهرب لخلاص نفسه مختفيًا عن أن يُدان عن النفوس التي يعثرها في خدمته عوض أن يكون علة خلاصها بالصليب.
نكرر أيضًا مع القديس يوحنا الذهبي الفم قوله أن كانت هذه هي عقوبة من يعثر الصغار، فماذا تكون مكافأة من ينقذ النفوس المتعثرة والضعيفة؟ [فلو لم يكن خلاص نفس واحدة عظيم جدًا لدى المسيح ما كان يهدد بعقوبة كهذه لمن يعثر إنسانًا.]
- اتساع القلب للمخطئين إلينا
إن كنا نود صداقة أصيلة وعميقة مع المخلص السماوي يلزمنا أن نحمل عمله فينا وهو الاهتمام بخلاص كل نفس، فلا نسمح لأنفسنا أن نكون عثرة لصغير في الإيمان ولا أن نتعثر نحن في طريق خلاصنا بسبب ضعفات الغير، فإن العلة الأولى للعثرة هي ضيق القلب وعدم اتساعه بالحب نحو الآخرين خاصة المخطئين إلينا، لذا يقول:
“احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه،
وإن تاب فاغفر له؛
وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم
ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلاً: أنا تائب،
فاغفر له” [3–4].
في اتساع قلبنا أن أخطأ إلينا أخ نوبخه، لا لنبرر أنفسنا أو نلقي باللوم عليه، وإنما لكي بالحب نربحه ونربح خلاص نفسه، لذا يقول السيد المسيح في موضع آخر: “عاتبه بينك وبينه وحدكما، وإن سمع منك فقد ربحت أخاك” (مت 18: 15). وكأن غاية هذا العتاب المملوء محبة هو “اقتناء نفسه” كربحٍ لنا ومكسبٍ فلا نفقده عضوًا في الجسد المقدس. لم يضع السيد المسيح للحب حدودًا، بل طالبنا أن نغفر لمن يخطىء إلينا ويرجع نادمًا إلى سبع مرات في اليوم، أي إلى مرات بلا عدد، لأن رقم 7 يشير إلى الكمال.
إن كان السيد المسيح يطالبنا أن نغفر للمخطئين إلينا هكذا كل يوم، كم بالأكثر يغفر هو لنا متى رجعنا إليه؟ بحديثه هذا يفتح لنا باب الرجاء غير المنقطع لنعود إليه بالتوبة معترفين بخطايانا.
- يا لحكمة الله! فبعد أن ذكر مثل عذاب الغني في موضع الآلام (أصحاح 16) عاد ليوصي بالغفران للراجعين بالتوبة نادمين، حتى لا ييأس أحد قط من رجوعه عن خطاياه!
يا للحكمة، فإنه لكي لا يكون الإنسان قاسي القلب في تقديم المغفرة (للآخرين) ولا أيضًا متهاونًا في رحمته، فلا يصطدم الغير بعنف التوبيخ، كما لا يسترسل متهاونًا في الخطأ، لذا قال في موضع آخر: “إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما” (مت 18: 15). العتاب الودّي أفضل من الاتهام العلني؛ الأول يوحي بالخجل، أما الثاني فيثير الغضب… من الأفضل أن يعتبرك من أخطأ إليك إنسانًا تنذره كصديق، ولا تهاجمه كعدوٍ. فإنه يسهل على الإنسان أن يقبل النصيحة عن أن يخضع للعنف، لذا يقول الرسول: “انذره كأخ” (2 تس 3: 15). الخوف حارس ضعيف على المثابرة أما الخجل فمعلم صالح للواجبات.
- حسنًا قيل: “إن أخطأ إليك“، فإن الوضع يختلف بين أن تُوجه الخطية ضد الله أو ضد الإنسان، لذا يقول الرسول المفسر الحقيقي للنبوّة: “الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين أعرض عنه” (تي 3: 10)، فلا يغفر للإيمان المنحرف كما لخطأ (ضد إنسان)[2].
القديس أمبروسيوس
- أنت تُدعى ابنًا، فإن رفضت أن تتمثل بالله (غافرًا لأخيك) فلماذا تطلب ميراثه؟
- أريدكم أن تغفروا إذ أراكم تطلبون الغفران[3].
القديس أغسطينوس
إن كان قد طالبنا أن نوبخ أخانا المخطىء إلينا، فلا نقف عند التوبيخ، إنما إذ ننطلق به بالحب نغفر له. ولكن إلى أي مدى؟ إلى سبع مرات، أي بلا حدود.
- يقول إن كان الذي يخطئ إليك يتوب ويعرف خطأه اغفر له، ليس مرة واحدة فحسب بل مرات كثيرة.
يليق بنا ألا نظهر ناقصين في المحبة المشتركة، مهملين في الاحتمال، فإنه يمكن لكل أحد أن يضعف ويخطئ مرة ومرات. إنما بالحري يلزمنا أن نتمثل بالذين يعالجون أمراض أجسادنا، فإنهم لا يعالجون المريض مرة ومرتين فحسب، وإنما كلما سقط في مرض.
لنذكر أننا نحن أنفسنا معرضون للضعفات، ويمكن أن تتسلط علينا أهواؤنا، لهذا نطالب الذين لهم حق التوبيخ وفي سلطانهم أن يؤدبوننا أن يترفقوا بنا ويغفروا لنا. هكذا من واجبنا نحن أيضًا أن تكون لنا مشاعر مشتركة، فنشعر بالضعف ونحمل أثقال بعضنا البعض، بهذا نكمل ناموس المسيح (غل 6: 2)[4].
القديس كيرلس الكبير
يقدم لنا القديس أمبروسيوس تفسيرًا لغفراننا لأخينا المخطىء سبع مرات كل يوم، وهو أن رقم 7 يذكرنا باليوم السابع الذي فيه استراح الله من جميع عمله (تك 2: 2)، فصار اليوم السابع مقدسًا عند اليهود، وأيضا الشهر السابع والسنة السابعة الخ. إن كان الرب استراح في اليوم السابع، بمعنى أنه وجد راحته بعد أن خلق الإنسان في اليوم السادس وأقام العالم لأجله، ففرح به، هكذا إذ يرى فينا أننا نغفر لإخوتنا بلا انقطاع يستريح فينا، إذ يجد عمله الإلهي قد كمل. هذا هو سبت الرب المفرح إذ يجد أولاده حاملين سمته كمحب للبشر، غافرين أخطاء الآخرين، متسعة قلوبهم بالحب. لم يعد سبت الرب مجرد يوم لكنه “حياة مقامة فيه”، من يحفظه إنما يعيش قائمًا به لا يخضع لموت البغض ولا لفساد الانتقام بل يحيا حرًا بحب الله الشامل!
- زد إيماننا
لعل الرسل أدركوا أن ما يوصي به السيد المسيح هو فوق حدود الطبيعة، لذا طلبوا عونًا إلهيًا، فيحملوا بالإيمان الطبيعة الغافرة لأخطاء الغير، إذ يقول الإنجيلي:
“فقال الرسل للرب: زد إيماننا.
فقال الرب: “لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل
لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر،
فتطيعكم” [5-6].
ويلاحظ في هذا الحديث الآتي:
أولاً: أن كان “الإيمان” هو سرّ قوة الكنيسة، بدونه لن ننعم بطبيعة المسيح المُقامة عاملة فينا، وبدونه لا نقدر أن نقدم الحب الحقيقي الغافر لأخطاء الغير، فإن هذا الإيمان هو عطية الله، ننعم به إن سألناه مع الرسل: “زد إيماننا“… هو عطية الله لكن ليس في سلبية من جانبنا.
- ما يعطي بالضرورة فرحًا لنفوس القديسين ليس نوال الخيرات الزمنية الأرضية، لأن هذه الخيرات قابلة للفساد، وبسهولة نفقدها، إنما التمتع بالخيرات المكرمة الطوباوية التي للنعم الروحية وهي عطية الله. أحد هذه النعم هو “الإيمان” الذي له تقديره الخاص، أقصد به الدخول إلى الإيمان بالمسيح مخلصنا جميعًا، هذا الذي يعرفه بولس كأعظم بركاتنا جميعها، إذ يقول “بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه” (عب 11: 6). هذا الذي به نال القدامى شهادتهم لله.
لاحظ كيف تمّثل الرسل القديسون بسلوك قديسي العهد القديم. ماذا سألوا المسيح؟ زد إيماننا. لم يطلبوا إيمانًا مجردًا، لئلا تظن أنهم كانوا بلا إيمان، بل بالحري طلبوا من المسيح أن يزيد إيمانهم، ويقويه فيهم.
يعتمد الإيمان علينا جزئيًا، ومن الجانب الآخر هو عطية النعمة الإلهية. ففي البدء يعتمد علينا (لنا أن نقبله أو نرفضه)، ففي سلطاننا أن نثق في الله ونؤمن به، وأما تثبيته وتقويته، فيتطلب النعمة الإلهية. لهذا السبب، إذ كل شيء ممكن لدى الله، قال الرب: “كل شيء مستطاع للمؤمن” (مر 9: 23). القوة التي تحل بنا خلال الإيمان هي من الله. إذ يعرف الطوباوي بولس ذلك يقول في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس: “فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد” (1 كو 12: 8-9). ها أنت تراه يضع الإيمان في قائمة النعم الروحية. هذا هو ما طلبه التلاميذ لينالوه من المخلص… وقد وهبهم إيّاه بعد إتمام التدبير بحلول الروح القدس عليهم. فإنه قبل القيامة كان إيمانهم هزيلاً، كان لهم قلة إيمان – قدم القديس موقف التلاميذ عند هياج الأمواج كمثل لقلة إيمانهم – (مت 8: 26؛ 14: 31، لو8: 25، يو 6: 19)… لا تعجب إن كانوا يطلبون زيادة إيمانهم من المسيح مخلصنا جميعًا. وقد أوصاهم ألا يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب حتى يلبسوا قوة من الأعالي (أع 1: 4). عندما حلت بهم القوة التي من الأعالي صاروا بالحق شجعان وأقوياء، حارين في الروح، يحتقرون الموت، ولا يبالون بالمخاطر التي كان غير المؤمنين يهددونهم بها، بل وصاروا قادرين على صنع المعجزات[5].
القديس كيرلس الكبير
ثانيًا: في كلمات الرسل “زد إيماننا” كشف عن حقيقة الإيمان، أنه ليس أمرًا جامدًا قبلناه وتوقف، لكنه هو “خبرة حياة معاشة”. إيماننا قبول لعمل الله فينا بلا توقف حتى نبلغ شهوة معلمنا بولس الرسول “قياس قامة ملء المسيح” (أف 4: 3). وكما يقول القديس أغسطينوس أن إيماننا يزداد [عندما يعلن “حكمة الله” ذاته علانية وجهًا لوجه مع قديسيه[6].]
إيماننا ليست كلمات نرددها، ولا فلسفة نعتنقها، لكنه حياة وخبرة عمل بالله الذي يعمل فينا بلا انقطاع، ويعمل بنا لنشهد له بلا توقف فنقتني نفوسًا لحساب ملكوته.
ثالثًا: جاءت إجابة السيد المسيح: “لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر، فتطيعكم” [6]، تكشف عن حاجتنا لا إلى زيادة مادية من جهة الكم، وإنما إلى زيادة من جهة النوع. فإنه لا يوجد وجه مقارنة بين حبة الخردل التي كان اليهود يعتبرونها أصغر الحبوب وبين شجرة الجميزة الضخمة، فإن إيمانًا حيًا كحبة الخردل الصغير قادر على المستحيلات أن يقلع شجرة جميزة بجذورها من الأرض ليغرسها في البحر وسط الأمواج؟ الإيمان الحيّ هو صانع المستحيلات!
رابعًا: يرى القديسان أمبروسيوس ويوحنا الذهبي الفم أن “شجرة الجميز” هنا تشير إلى الشيطان، فإن كانت حياتنا قد صارت أرضًا غُرس فيها العدو كشجرة جميز، بالإيمان نطرد الشيطان بكل أعماله من حياتنا فلا يكون له موضع فينا، وإنما يُلقى في البحر كما في الأعماق، وذلك كما سمح السيد للشياطين أن تخرج من الرجل الذي في كورة الجدريين وتدخل في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق (لو 8: 33).
ويرى البابا كيرلس الكبير أن “شجرة الجميز” هنا تعني قدرة الإيمان على تحقيق ما يبدو لنا مستحيلاً. بالإيمان تُقتلع من الأرض رغم تأصلها بالجذور العميقة، وبالإيمان تثبت في مياه البحر المتحركة، وكأن الإيمان يصنع المستحيلات، إذ يقول: [من يثق في المسيح لا يتكل على قوته الذاتية، بل ينسب للمسيح كل ما يحققه، معترفًا أن به تتحقق كل الخيرات في نفوس البشر، وإن كان يليق بالبشر أن يهيئوا أنفسهم لقبول هذه النعمة العظيمة. للإيمان سلطان أن يحرك ما هو ثابت ومؤسس في الأرض وليس شيء على الإطلاق لا يمكن للإيمان أن يحركه متى صارت الحاجة ملزمة لتحريكه. لقد اهتزت الأرض فعلاً عندما صلى الرسل كما جاء في أعمال الرسل (4: 31). ومن جانب آخر فإن الإيمان يستطيع أن يوقف ما هو متحرك، كما أوقف جريان مجرى نهر سريع (الأردن يش 3: 16) وأوقف حركة نور الشمس التي لا تتوقف في السماء (يش 10: 13). لكن ما يجب ملاحظته تمامًا أن الله لا يود تقديم ما هو مُبهر وعجيب بطريقة باطلة أو بلا هدف، فإن مثل هذا بعيد عن جوهر الله الذي لا يعرف الكبرياء ولا العجرفة، إنما يعمل ما هو لخير البشرية وسلامها. أقول هذا لكي لا يتوقع أحد من الإيمان المقدس والقوة الإلهية أن تتم تغيرات بلا نفع مثل تغيير عناصر معينة وتحويلها أو تحريك جبال أو مزروعات… أنه يتحقق ذلك أن كان فيه نفع حقيقي، عندئذ لا ينقص الإيمان قوة للتنفيذ[7].]
إن كان الإيمان هو سرّ قوة الكنيسة، لا لممارسة أعمال خارقة بلا هدف، وإنما أولاً به ننال الحياة المقامة في المسيح يسوع. فنعيش بروح المحبة الغافرة لأخطاء الآخرين، وبه نطرد الروح الشرير وكل أعماله، فنقتلعه من حياتنا كالجميزة، لنلقى به كما في هاوية البحر وأعماق المحيطات، فإن ما يفسد إيماننا هو “اتكالنا على برنا الذاتي”. فننسى أن ما وُهب لنا من بنوة، ومن أعمال مقدسة، وقدرة على تنفيذ الوصية. أنه عطية الله المجانية، وأننا في حقيقتنا عبيد بطالون، مهما كان سلوكنا. هذا ما أكده السيد المسيح، إذ قال بعد حديثه عن الإيمان مباشرة:
“ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له إذا دخل من الحقل
تقدم سريعًا واتكئ.
بل ألا يقول له: اعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى أكل وأشرب،
وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت.
فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أُمر به؟ لا أظن.
كذلك أنتم أيضًا متى فعلتم كل ما أُمرتم به
فقولوا: أننا عبيد بطّالون،
لأننا إنما نعمل ما كان يجب علينا” [7-10].
ماذا عنى السيد المسيح بهذا المثل؟ أراد أن يؤكد لنا مركزنا الحقيقي خارج نعمته أننا عبيد بطّالون، أي عبيد لله لم نوفِ حقه كما ينبغي. فإن جعلناه الأول في حياتنا، وقدمنا كل شيء لحسابه، نبقى عبيدًا مدينون له بحياتنا، نشعر في أعماقنا أننا بطّالون، أما خلال نعمته فقد صرنا أبناء له، ما نمارسه هو من قبيل عطيته المجانية، وليس ثمنًا لجهادنا الذاتي أو فضلاً منا.
- إذ أراد الرب أن يظهر أنه بالرغم من إلزامنا بكل وصية، لكنه يهب البنوة للبشر في استحقاق دمه، لذلك قال: “متى فعلتم كل ما أُمرتم به فقولوا أننا عبيد بطّالون، لأننا إنما نعمل ما كان يجب علينا“. هكذا فإن ملكوت السماوات هو هبة يعطيها الرب للعبيد المؤمنين وليس جزاءً لأعمالنا.
فالعبد لا يطلب التحرر (من العبودية) جزاء عمله، وإنما يحاول أن يقدم كل ما في وسعه كمدينٍ، وينتظر التحرر كهبة.
“المسيح مات من أجل خطايانا” (1 كو 15: 3)، وهو يهب الحرية لمن يخدمونه حسنًا، إذ يقول: “نعمًا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك” (مت 25: 23).
- يظن البعض أنهم يؤمنون بالحق وهم لا ينفذون الوصايا، والبعض بينما ينفذون الوصايا يتوقعون الملكوت كجزاء عادل (لاستحقاقاتهم الذاتية)؛ كلاهما يخطئان ضد الحق.
- إن كان المسيح قد مات لأجلنا “كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام” (2 كو 5: 15)، فمن الواضح أننا ملزمون أن نخدمه حتى الموت؛ فكيف إذن ننظر إلى البنوة كجزاءٍ عادلٍ (لأعمالنا الذاتية)؟
نحن الذين وهب لنا الحياة الأبدية، نصنع الأعمال الصالحة لا لأجل الجزاء، بل لحفظ النقاوة التي وُهبت لنا[8].
القديس مرقس الناسك
- في العبارات السابقة وجه الرب إلينا حديثًا طويلاً وهامًا ليظهر لنا الطرق التي تقودنا إلى الكرامة، معلنًا أمجاد الحياة غير الملومة لكي نتقدم فيها، وننمو بغيرة إلى ما هو مدهش، فننال مكافأة دعوتنا العليا (في 3: 14). ولما كانت طبيعة فكر الإنسان تتجه نحو المجد الباطل وتميل إليه… وهذه خطية خطيرة يبغضها الله؛ هذا وتقود الحية ـ أصل الشر ـ البشر إلى مثل هذا الفكر، فيظنون أن الله يهبهم الكرامات العليا من أجل حياتهم المجيدة المميزة (أي من أجل استحقاقاتهم الذاتية)؛ لذلك أراد الرب أن يسحبنا من هذه الأهواء (أفكار المجد الباطل). فوضع أمامنا فحوى هذه الدروس التي قُرأت حالاً علينا، معلمًا إيانا بهذا المثل أن قدرة السلطان الملوكي (الإلهي) تتطلب من العبيد أن يخضعوا لها كدين يلتزمون به. أنه يقول بان الرب لا يقدم شكرًا للعبد حتى وإن فعل ما وجب عليه عمله لأنه عبد.
أسألكم أن تلاحظوا هنا أن التلاميذ، نعم وكل الذين يخضعون لقضيب المسيح مخلص جميعنا يُحثون على المثابرة لكنهم لا يمارسون الخدمة كفضلٍ من جانبهم، وإنما كمن يفي دين الطاعة الذي يلتزم به العبيد. بهذا يُنزع مرض المجد الباطل اللعين.
إن كنت تفعل ما هو واجب عليك فلماذا تفتخر؟ ألا ترى أنك إن لم تفِ دينك تكون في خطر، وإن وافيته فلا تستحق شكرًا على ذلك؟ هذه الحقيقة تعلمها حسنًا العبد العجيب بولس وأدركها تمامًا، إذ يقول: “لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة عليّ، فويل لي إن كنت لا أبشر” (1 كو 9: 16). مرة أخرى يقول: “إني مديون” (رو 1: 14) أن أكرز لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء.
فإن صنعت حسنًا، وحفظت الوصايا الإلهية، وأطعت ربك، فلا تسأل كرامة الله كاستحقاق لك، بل بالحري اقترب منه واسأله عطايا جوده…
نعم! وإن كنا عبيدًا، لكنه يدعونا أبناء، ويكللنا بمجد الأبناء![9]
القديس كيرلس الكبير
- مادمنا على قيد الحياة يلزمنا أن نعمل على الدوام.
اعترف أنك عبد ملتزم بتقديم خدمات كثيرة، ولا تتكاسل لأنك دُعيت ابنًا لله!
استسلم لعمل النعمة دون أن تتجاهل الطبيعة (أنك عبد).
لا تفتخر أن كنت عبدًا صالحًا، فهذا واجب ملتزم أنت به. فالشمس تقوم بعملها، والقمر أيضا يطيع، والملائكة تخدم، والإناء المختار الذي استخدمه الرب للأمم يقول: “ليس مستحقًا أن أُدعى رسولاً لأني اضطهدت كنيسة الله” (1 كو 15: 9). وفي موضع آخر إذ أشار أنه فعل ذلك بجهالة، أضاف: “ولكني لست بذلك مبررًا” (1 كو 4: 4).
إذًا ليتنا لا نسعى لننال مجدًا لأنفسنا؛ فلا نسبق دينونة الله، ولا نتكهن بحكم الديان إنما نترك ذلك لحينه، بكونه الديان الحقيقي[10].
القديس أمبروسيوس
- [يربط القديس أغسطينوس بين طلبة الرسل من السيد المسيح أن يزيد إيمانهم وبين هذا المثل الذي ضربه السيد، إذ يرى فيه العبد الذي ينطلق من الخدمة في الحقل كحارث للأرض أو راعٍ للخراف، لكي يدخل بيت سيده يأكل ويشرب هناك، وكأنه خلال الإيمان المتزايد ينتقل من خدمة هذا العالم إلى حياة التأمل، أو ينطلق من حياة الجهاد والعمل إلى التمتع بالملكوت الأبدي، إذ يقول:]
الذين لا يفهمون هذا الإيمان بالحق يظنون أن الرب لم يستجب لطلبة تلاميذه. فإنه يبدو وجود صعوبة للربط بين طلبتهم (زيادة إيمانهم) وهذا المثل، ما لم نفترض أن الرب يقصد بهذا المثل الانطلاق من إيمان إلى إيمان؛ من الإيمان الذي به نخدم الرب إلى الإيمان الذي به نتمتع بالرب. إيماننا يزداد في البداية عندما نقبل كلمة الكرازة، ثم ننعم بعد ذلك بالحق حاضرًا، إذ ننال التأمل المفرح والسلام الكامل، هذا الذي يوهب لنا في ملكوت الله الأبدي.
ليت العبد الذي في الحقل يحرث أو يرعى، أي يمارس العمل الزمني (بأمانة) ويخدم الناس الأغبياء كقطيع، يعود بعد العمل إلى بيته، أي يتحد مع الكنيسة (يتمتع بحياة التأمل)…
- بينما عبيد المسيح يخدمون، أي يكرزون بالإنجيل، يأكل ربنا ويشرب إيمان الأمم واعترافهم به.
يكمل الحديث: “وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت” [8]. وكأن السيد يقول: بعدما أتمتع بعمل كرازتكم، وأتغذى أنا نفسي بطعام توبتكم، عندئذ تأتون أنتم وتتمتعون بالوليمة أبديًا، وليمة الحكمة الخالدة[11].
القديس أغسطينوس
- الشكر والإيمان (العشرة بُرص)
قلنا أن الإيمان هو سرّ قوة الكنيسة، به ننعم على الصداقة الإلهية، هذا الإيمان ليس حكرًا لشعب ما أو أمة معينة إنما هو مُقدم لكل البشرية. هذا ما أوضحه لنا الإنجيلي عندما حدّثنا عن لقاء السيد المسيح بعشرة رجال بُرص يطلبون منه أن يرحمهم، عندئذ أمرهم: “اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة” وفيما هم منطلقون طهروا، فعاد إليه واحد منهم يقدم الشكر له وكان سامريًا، فاستحق دون سواه أن يسمع: “قم وامض إيمانك خلصك” [18].
ويلاحظ في قصة تطهير هؤلاء الرجال البرص الآتي:
أولاً: يقول الإنجيلي: “وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل. وفيما هو داخل إلى قرية استقبله رجال برص، فوقفوا من بعيد” [11-12]. كانت أنظار السيد المسيح تتجه إلى أورشليم لكنه اجتاز عمليًا في وسط السامرة والجليل، فإن كانت أورشليم هي مركز عبادة الشعب اليهودي، فقد جاء إلى خراف إسرائيل الضالة لكي يردها لكنه دون تجاهل للسامرة، وأيضا للجليل حيث يوجد عدد كبير من الأمم، أنه يود صداقة الكل!
يبقى السيد المسيح متحركًا نحو أورشليمه، أي مدينته السماوية أو ملكوته الأبدي حيث الهيكل غير المصنوع باليد، ينطلق إلى هناك حاملاً أعضاء جسده من كل أمة ولسان، من السامرة والجليل.
التقى بالعشرة رجال البرص خارج القرية، فإنه بحسب الشريعة الموسوية لا يسكن الأبرص وسط المحلة أو داخل المدينة أو القرية إنما خارج الأسوار أو وسط القبور، ويكون مشقوق الثوب، ورأسه يكون مكشوفًا ويغطي شاربيه، وينادي: نجس، نجس (لا 13: 45-46)، وقد رأينا في تفسيرنا لسفر اللاويين ما يحمله هذا الطقس من معنى، حيث يكشف عن بشاعة نجاسة الخطية وتحطيمها للإنسان وحرمانه من الشركة مع الجماعة المقدسة.
هؤلاء الرجال العشرة يمثلون البشرية التي صارت خلال الخطية محرومة من “الشركة المقدسة”، تسكن كما في خارج الأسوار في عداوة مع السماء والسمائيين، تحمل نجاستها عليها… وقد التقى بهم السيد المسيح خارج القرية إذ نزل إلينا من سماواته كغريبٍ ليلتقي بنا ويحملنا على كتفيه، ويدخل بنا إلى مقادسه السماوية.
ثانيًا: وقف هؤلاء الرجال بأجسادهم من بعيد، لكنهم اقتربوا إليه جدًا بالإيمان، إذ “رفعوا صوتًا، قائلين: يا يسوع، يا معلم ارحمنا” [13]. كبرصٍ حُرموا من السُكنى وسط الناس، وربما لم يشهدوا بأعينهم المعجزات التي صنعها السيد المسيح، إنما سمعوا عنها، لكنهم بالإيمان اقتربوا منه جدًا ونالوا تطهيرًا، بينما رأى كثير من الفريسيين والصدوقيين السيد المسيح وشاهدوا أعماله الفائقة وبعدم الإيمان حرموا أنفسهم من صداقته.
ثالثًا: أمرهم السيد المسيح أن يذهبوا إلى الكهنة ليروا أنفسهم لهم؛ ليؤكد أنه ما جاء لينقض الشريعة بل يكملها، وكي يعطي للكهنة اليهود دليلاً ماديًا على قدرته على الإبراء والتطهير، الأمر الذي يعجز عنه الناموس، لعلهم يؤمنون أن نعمته تفوق الناموس. وفي هذا التصرف أيضًا يوجهنا السيد المسيح للخضوع للكنيسة، كما يعلم الخدام روح التواضع. ومن جانب آخر يعطي فرصة للذين تطهروا أن يقدموا ذبيحة شكر لله[12].
رابعًا: حدث ما لم يتوقعه أحد فإن واحدًا من العشرة، إذ رأى أنه شُفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، مقدمًا العبادة والشكر للمخلص، إذ خرّ على وجهه عند رجليه شاكرًا له، وكان سامريًا، بينما التسعة اليهود لم يرجعوا إليه، لذا قال السيد:
“أليس العشرة قد تطهروا؟ فأين التسعة؟
ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدًا لله غير هذا الغريب الجنس؟
ثم قال له: قم وامضِ، إيمانك خلصك” [17-19].
نال العشرة تطهير الجسد أما هذا الغريب الجنس فاغتصب بحياة الإيمان العملية المترجمة بالشكر والعبادة الحقيقية خلاص نفسه وتطهيرها.
خامسًا: يرى القديس أغسطينوس[13] في هؤلاء العشرة برص معنى رمزيًا، إذ يشيرون إلى الذين لم يقبلوا الإيمان المستقيم بل يسلكون كهراطقة ومبتدعين، هؤلاء يقيمون خارج المدينة، إذ يحرمون من شركة الكنيسة، فإن قدموا توبة وتلاقوا مع السيد خلال الرجوع إلى الإيمان الحق، يسألهم أن يُروا أنفسهم للكاهن، أي يعودوا إلى شركة الكنيسة لتقبلهم وتهبهم حلاً.
أما أن تسعة منهم لم يعودوا بينما واحد فقط سامري يسجد أمام السيد حتى الأرض ويقدم ذبيحة شكر ممجدًا الله، فهذا يمكننا أن نفسره بأنه لا يكفي عودة الهراطقة للإيمان نظريًا أو بالشفاة، إنما يلزم عودتهم بالقلب مع العمل. فالسامري يمثل الإنسان الجاد في خلاصه، لأن كلمة “سامري” معناها “حارس”، فمن كان يقظًا وحارسًا بالروح القدس على خلاص نفسه يتقدم للرب بروح الانسحاق فيسجد له بتواضعٍ، ويشكره على فيض محبته التي قبلته في شركة جسده المقدس أي الكنيسة.
يرى القديس أغسطينوس أن الشاكر له هو واحد فقط إشارة إلى أن كنيسة المسيح واحدة، يجب ألا يكون في انقسام!
سادسًا: يقدم لنا القديس البابا أثناسيوس الرسولي في رسالته الفصحية السادسة هذا الأبرص السامري مثلاً حيًا لحياة الشكر التي تكشف عن قلبٍ يتعلق بواهب العطية (الله) أكثر من العطية ذاتها، إذ يقول: [أحب (الرب) ذاك الذي قدم الشكر، بينما غضب من الآخرين ناكري المعروف، لأنهم لم يعرفوا المخلص، بل انشغلوا بتطهيرهم من البرص أكثر من الذي طهرهم.]
- الإيمان بالملكوت الداخلي
إذ حدثنا عن الإيمان كطريقٍ للتمتع بملكوت الله، محذرًا إيانا من ضيق القلب المفسد للإيمان، وأيضًا من الكبرياء الاعتداد بالذات، مطالبًا إيانا أن نتمثل بالسامري الذي حمل إيمانًا عمليًا مترجمًا خلال شهادته العلنية للسيد المسيح مع تواضعه وتقديم شكره… الآن إذ التهب قلب السامعين بالشوق نحو التمتع بهذه الصداقة صار الفريسيون يسألون لا عن كيفية تمتعهم بها وإنما عن موعد هذه الصداقة وزمانها، فسألوه: “متى يأتي ملكوت الله؟” [20]
هذا السؤال ليس بغريبٍ، فإن غاية عدو الخير أن يشغلنا عن خلاص أنفسنا بالاهتمام بالأزمنة والأوقات. هذا ما نلاحظه بوضوح في العصر الحاضر، فنجد مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية يهتم كثير من الدارسين بسفر الرؤيا لا كسفر السماء الذي يلهب القلب نحو مجيء العريس الأبدي، وإنما لمجرد البحث عن معرفة زمان انقضاء هذا الدهر. لذا يحذرنا السيد المسيح: “ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات”.
لقد أجاب السيد المسيح تساؤلهم بتوجيه فكرهم من البحث عن الأزمنة والتعرف على الأوقات إلى الاهتمام بالتمتع بالملكوت كملكوتٍ حاضر، ملكوت داخلي في أعماق النفس. بمعنى آخر يودنا أن نهتم بعلاقتنا به على مستوى القلب الداخلي عوض الانشغال بالأمور الخارجية والمناقشات البحتة الفلسفية.
- لقد أعطى الإجابة بما فيه نفع كل البشر، أن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة؛ أنظروا، فإن ملكوت الله هو داخلكم. يقول لا تسألوا عن الأزمنة التي فيها يأتي ملكوت الله، وإنما كونوا مشتاقين أن توجدوا متأهلين له، لأنه في داخلكم، أي يعتمد على إرادتكم، وفي سلطانكم أن تقبلوه أو ترفضوه. كل إنسان يقبل التبرير بالإيمان بالمسيح ويتزين بكل فضيلة يُحسب أهلاً لملكوت السماوات[14].
القديس كيرلس الكبير
- ملكوت الله داخلكم يعني الفرح الذي يغرسه الروح القدس في قلوبكم، بكونه أيقونة وعربون للفرح الأبدي الذي تتمتع به نفوس القديسين[15].
القديس غريغوريوس أسقف نيصص
- بلوغ القصر السماوي أسهل من الوصول إلى بريطانيا أو أورشليم، لأن ملكوت الله داخلكم.
أنطونيوس وطغمات رهبان مصر وما بين النهرين وبنطس وكبادوكية وأرمينيا لم ينظروا أورشليم لكن باب الفردوس انفتح لهم.
الطوباوي هيلاريون مع كونه من مواطني فلسطين وسكانها لم ينظر أورشليم سوى يومًا واحدًا، إذ لم يرغب وهو قريب من الأماكن المقدسة أن يتجاهلها، وفي نفس الوقت لم يرد أن يحصر الله بحدود مكانية محلية[16].
القديس جيروم
- في داخلكم إما معرفة الحق أو جهله، الابتهاج بالفضيلة أو الرذيلة، بهذا نعد قلبنا إما لملكوت المسيح أو ملكوت إبليس[17].
الأب موسى
ليتنا بالإيمان الحيّ العامل نقبل تجلي ملكوت المسيح فينا، فيعلن في داخلنا ملكًا، يوجه عواطفنا وأحاسيسنا وأفكارنا وكل طاقاتنا الروحية والنفسية والجسدية لحساب ملكوته الأبدي. بهذا تكون حصانتنا ضد هجمات عدو الخير وضد الشر قائمة على الأعماق الداخلية في الرب التي لا يمكن أن تُغلب. هذا ما يؤكده الأب بيامون بقوله: [لا نقدر أن نهرب من عواصف التجارب وهجمات الشيطان إذا ما اعتمدنا في حماية صبرنا، لا على قوة إنساننا الداخلي، إنما على مجرد غلق باب قلايتنا أو مجرد التوغل في الصحراء ومصاحبة القديسين أو أي حماية خارجية من أي نوع[18].]
- بين الملكوت الداخلي والملكوت الأخروي
إذ وجه أنظارنا إلى ملكوته الداخلي حتى نقتنيه فينا حالاً عوض الانشغال بمعرفة الأزمنة والأوقات، عاد أيضًا ليهيئنا لمجيئه الأخير بكونه امتدادًا لمجيئه الحاضر وحلوله فينا. بمعنى آخر سكناه في داخلنا وإعلان ملكوته في أعماقنا هو عربون يلهب قلبنا لمجيئه الأخير. وكأن صداقتنا معه تبدأ الآن لكي تنمو بالأكثر حين نلتقي معه وجهًا لوجه.
جاء حديث السيد المسيح يوضح النقاط التالية:
أولاً: أظهر السيد المسيح أنه سيأتي وقت فيه يشتهي المؤمنون يومًا من أيام وجود السيد على الأرض حين يكتشفون شخصه، ويتذوقون حلاوة صداقته، إذ يقول: “ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يومًا واحدًا من أيام ابن الإنسان، ولا ترون” [22].
يرى القديس كيرلس الكبير أن السيد المسيح إذ تحدث مع تلاميذه عن ملكوته الداخلي فيهم، أراد أن يكشف لهم عن الآلام التي تعانيها الكنيسة ويسقط تحتها المؤمنون، حتى ليحسب الكل أن أيام وجود السيد المسيح على الأرض تحسب كما لو كانت أيام بلا أتعاب أن قورنت بما سيمر به المؤمنون. أنهم يشتهون الأيام التي عاش فيها التلاميذ مع المخلص حيث يحمل السيد الآلام وحده وهم مستريحون. بهذا لا يريد السيد أن يرعبهم، وإنما بالحري يهيئهم لاحتمال الضيق ومواجهة المتاعب بقوة، إذ سبق فأخبرهم بها.
- هل بقوله هذا كان الرب يخيف تلاميذه؟
هل كان يضعفهم مقدمًا، ويجعلهم خائرين في احتمال الضيقات والتجارب التي لا يقدرون على احتمالها؟
ليس هذا هو ما يقصده بل بالحري أراد بالعكس أن يهيئهم لقبول كل ما يحزن البشر، فيكونون مستعدين لاحتماله بصبرٍ، فيتزكون، ويدخلون ملكوت الله.
لقد سبق فحذرهم قبل مجيئه من السماء في نهاية العالم، بأن التجارب والضيقات تسبقه حتى أنهم يشتهون أن يروا يومًا واحدًا من أيام ابن الإنسان، أي يروا يومًا من الأيام التي كانوا فيها مع المسيح يتحدثون معه. ومع أن اليهود ـ حتى في هذه الأيام ـ استخدموا عنفًا ليس بقليلٍ ضده، إذ حاولوا رجمه بالحجارة، واضطهدوه لا مرة بل مرات عديدة، واقتادوه إلى تل ليلقوه من القمة، وأهانوه وصنعوا وشايات ضده، ولم يتركوا أي شكل من الشر إلا ومارسه اليهود ضده، فكيف يقول إذن أن التلاميذ يشتهون أن يروا يومًا من أيامه؟ هذا بالمقارنة بالشرور الكثيرة التي ستحل فتحسب هذه قليلة ومشتهاه[19]!
القديس كيرلس الكبير
- إذ كانت حياتهم في ذلك الحين بلا متاعب، لأن المسيح كان مهتمًا بهم ويحميهم، فإنه إذ يأتي الوقت ليُرفع المسيح يتعرضون لمخاطر، ويقفون أمام ملوك وولاة فيشتهون الأيام الأولى وهدوءها[20].
الأب ثيؤفلاكتيوس
ثانيًا: التحذير من التضليل
إذ حدثهم بطريقة غير مباشرة عن الآلام التي يواجهونها قبل مجيئه، صار يحذرهم عن التضليل، وهذا يمثل خطرًا أكثر مرارة، لأنه يحمل خداعًا للنفوس غير القادرة على التمييز بين مجيء ضد المسيح ومجيء المسيح نفسه.
أوضح السيد التمييز بينهما بقوله:
“ويقولون لكم: هوذا ههنا أو هوذا هناك.
لا تذهبوا ولا تتبعوا،
لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء
يضيء إلى ناحية تحت السماء،
كذلك يكون أيضًا ابن الإنسان في يومه” [23-24].
مجيء ضد المسيح يكون بلا شك مملوء خداعًا، إذ يصحبه أتباع كثيرون ينادون به في كل موضع للتضليل، ويصحبه ظهور آيات مخادعة من عمل الشيطان، ويميل العالم إليه، يبحث عنه هنا وهناك. أما المسيح الحقيقي فسيأتي علانية على السحاب، كقول الرسول بولس: “لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة، وبوق الله سوف ينزل من السماء” (1 تس 4: 6). يأتي ببهائه كالبرق فيراه الكل، ولا يحتاج إلى من يعلن عنه. يأتي ليدين الأحياء والأموات، مبرقًا في قلوب الكل وأفكارهم، فيصير كل شيء واضحًا أمام الجميع… تنكشف سرائر الناس الخفية!
- سينزل من السماء في أواخر الدهور، لا بطريقة غامضة أو سرية وإنما في مجد لاهوته، بكونه “ساكنًا في نورٍ لا يُدنى منه” (1 تي 6: 16). هذا أعلنه بقوله أن مجيئه سيأتي كالبرق. حقًا لقد وُلد في الجسد من امرأة ليحقق التدبير لأجلنا، ولهذا السبب أخلى ذاته، وصار فقيرًا، ولم يظهر نفسه في مجد اللاهوت. لقد حمل التواضع من أجل الوقت نفسه ولتحقيق التدبير. أما بعد القيامة من الأموات إذ صعد إلى السماوات وجلس مع الله الآب، فإنه ينزل ثانية لكن ليس بدون مجده، ولا في تواضع الناسوت، وإنما في عظمة الآب تحرسه صحبة الملائكة الذين يقفون أمامه بكونه إله الكل ورب الجميع. أنه سيأتي كالبرق وليس سريًا[21].
القديس كيرلس الكبير
- كما أن البرق لا يحتاج إلى من يعلن عنه ويخبر به، بل يُنظر في لحظة في العالم، فإنه حتى بالنسبة للذين يجلسون في بيوتهم سيأتي ابن الإنسان، ويُنظر في كل موضع دفعة واحدة بسبب بهاء مجده.
القديس يوحنا الذهبي الفم
ثالثًا: رفض المسيح
إذ كان الرب يحث تلاميذه على قبول صداقته لهم على مستوى أخروي أو انقضائي، معلنًا أنه قادم لا محال، قادم كالبرق أمام الجميع في مجد لاهوته، لكن يسبق هذا المجد “رفض العالم له”، فلا طريق للأمجاد بغير الآلام، بهذا يحثنا على قبول “المسيح المرفوض” حتى يقبلنا في أمجاده. يؤكد السيد المسيح لتلاميذه: “ولكن ينبغي أولاً أن يتألم كثيرًا ويُرفض من هذا الجيل” [25].
احتمل الرأس ـ المسيح ـ الآلام الكثيرة وصار مرفوضًا، وها هو يأتي ممجدًا، ونحن أيضا جسده لن نشاركه أمجاده ما لم يرفضنا هذا الجيل ويضغط علينا بالآلام. وكما يقول الرسول بولس: “إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضًا معه” (رو 8: 17).
رابعًا: اليقظة والسهر
لا يكف السيد المسيح عن أن يوجه تلاميذه إلى حياة اليقظة والسهر الدائم حتى لا يكون مجيء الرب بالنسبة لهم مفاجأة محزنة، بل يكون عرسًا مبهجًا طالما تترقبه النفس بشوق داخلي حقيقي. قدّم لنا مثلين، الأول الطوفان في أيام نوح حيث كان الناس منهمكين في الملذات: “يأكلون ويشربون، ويزوجون ويتزوجون، إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع” [27]، والثاني حرق سدوم في أيام لوط، إذ “كانوا يأكلون ويشربون، ويشترون ويبيعون، ويغرسون ويبنون” [28]. ليس الأكل خطية ولا الشرب ولا الزواج أو البيع والشراء أو الغرس والبناء، إنما الخطية هي انغماس الإنسان ولهوه بعيدًا عن خلاص نفسه. كل هذه الأعمال يمكن أن تكون مقدسة ومباركة إن مارسها الإنسان الروحي وهو مقدس في الرب، مهتمًا بمجيء المخلص، منتظرًا العرس الأبدي.
- لكي يظهر أنه سيظهر بطريقة غير متوقعة، في وقت لا يعرفه إنسان، عند نهاية العالم قال بأن النهاية ستكون كما في أيام نوح ولوط… ماذا إذن يعني بهذا؟ إنه يطالبنا أن نكون يقظين على الدوام، ومستعدين للمجاوبة أمام محكمة الله. وكما يقول بولس: “لأنه لابد أننا جميعًا نُظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحدٍ ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرًا كان أم شرًا” (2 كو 5: 10). “فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار”، ثم يقول (الملك) للذين عن يمينه: “تعالوا يا مباركي أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم” (مت 25: 33)، أما بالنسبة للجداء فينطق بعبارة مرعبة، إذ يرسلهم إلى نار لا تُطفأ[22].
القديس كيرلس الكبير
خامسًا: التحذير من النكوص
إذ يدعونا لقبول صداقته الحالية عربونا للصداقة الأبدية الخالدة، لا يطالبنا بالسهر فحسب، وإنما بالنمو الدائم في علاقتنا معه دون تراجع أو نكوص، مقدمًا لنا ثلاثة أمثلة:
أ. من ارتفع حتى بلغ السطح لا ينزل إلى الأطباق الدنيا يبحث عن أمتعته، بل يبقى مرتفعًا على السطح مترقبًا بعيني الإيمان العامل مجيء العريس من السماء.
ب . من انطلق إلى حقل الخدمة ليعمل لحساب مملكة الله، لا يرجع إلى الوراء يطلب الزمنيات.
ج . من يخرج من سدوم، لا ينظر إلى الوراء، كامرأة لوط فيصير عمود ملح.
هذه هي الأمثلة التي قدمها لنا السيد قائلاً:
“في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت،
فلا ينزل ليأخذها،
والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء؛
اذكروا امرأة لوط” [31-32].
وقد سبق لنا عرض المفاهيم الروحية لهذه العبارات في تفسير مت 24: 17-18، مر 13: 15-16، وأقوال بعض الآباء فيها.
يرى القديس كيرلس الكبير[23] الإنسان الذي على سطح هو الغني الذي صار كمن على السطح يعرفه الجميع، ومشهورًا بين من هم حول بيته. ليته لا يضع قلبه في مخازنه التي في داخل البيت، بل يهتم بحياته الروحية، إذ يقول الحكيم: “كنوز (الشر) لا تنفع، أما البرّ فينجي من الموت” (أم 10: 2). أما القديس هيلاري أسقف بواتييه[24] فيرى المرتفع إلى السطح هو الإنسان الكامل في قلبه، المرتفع روحيًا والمتجدد على الدوام يلزمه ألا يرتبك بأمور زمنية. ويرى القديس أمبروسيوس[25] فيه الإنسان الذي يرتفع مع الرسول بطرس إلى السطح ليدرك سرّ الكنيسة (أع 10: 9) التي لا تنسب النجاسة لشعب ما، بل تفتح باب الكرازة للجميع.
أما الذي في الحقل فيرى القديس كيرلس الكبير أنه الإنسان الذي كرّس حياته للجهاد والعمل من أجل الثمر الروحي؛ هذا الذي وضع يده على المحراث فلا ينظر إلى الوراء (لو 9: 62)،
أما امرأة لوط فقد خلصت بخروجها من سدوم، وعدم تعرضها للنيران، لكنها لم تكمل طريق خلاصها، ففقدت كل شيء برجوع قلبها إلى الوراء.
نختم حديثنا عن هذه الأمثلة بكلمات القديس يوحنا كاسيان: [عندما تبلغ آمان قمة سطح الإنجيل لماذا تنزل لتحمل شيئًا من البيت، من الأمور التي سبق لك الاستهانة بها؟ عندما تكون في الحقل تعمل في الفضيلة لماذا ترتد محاولاً أن ترتدي أمور هذا العالم مرة أخرى بعد أن خلعتها ونبذتها[26]؟]
سادسًا: الاهتمام بخلاص النفس
حقًا قد يعمل الإنسان، ويظن أنه مجاهد في طريق الصداقة الإلهية والتمتع بالملكوت، لكنه لا يدري أنه فقد هدفه بانحرافه عن التمتع بخلاص نفسه. هذا الخلاص ثمنه “دم المسيح الثمين” لذا يستحق أن نرفض كل شيء، ونحتمل كل شيء من أجله، إذ يقول: “من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها” [33].
كثيرًا ما تحدث القديس أغسطينوس عن خبرة عاشها، ملخصها أن من يحب ذاته (himself) يهلك نفسه (his soul)، ومن يبغض ذاته أو يهلكها يحب نفسه. بمعنى آخر متى تقوقع الإنسان حول “الأنا”، وظن أنه يعيش لذاته يشبع شهوات جسده أو يطلب كرامة زمنية إنما في حقيقته يهلك نفسه، في هذا العالم وفي الدهر الآتي. قدر ما يهلك الإنسان ذاته ego ليحيا منطلقًا خارج الأنا، حرًا، يعمل لحساب ملكوت الله ولأجل سلام الناس وبنيانهم، يحب نفسه ويخلصها بالله المحب! لنحمل طبيعة البذل فينا، أي طبيعة صديقنا محب البشر، فننعم بالحياة الحقيقية هنا والأبدية أيضًا!
يرى الأب ثيؤفلاكتيوس أن الحديث هنا يخص تصرف المؤمن خاصة في أيام “ضد المسيح” حيث يتعرض المؤمنون لضيقات كثيرة وللموت. فإن كان الإنسان يطلب أن يخلص نفسه، أي ينقذ حياته الزمنية، إنما يهلك نفسه، أما إذا لم يبالِ بالأتعاب حتى الموت، ففيما هو يهلك نفسه (حياته الزمنية) يخلصها، إذا لا يخضع للطاغية “ضد المسيح” من أجل حب البقاء.
يقول القديس كيرلس الكبير: [ يليق بالذين اعتادوا على الترف أن يمتنعوا عن هذا الكبرياء في ذلك اليوم، ويكونوا مستعدين لاحتمال المشقة. بنفس الطريقة يليق بالذين يجاهدون حسنًا أن يثابروا بشجاعة حتى يبلغوا العلامة الموضوعة أمامهم، لأن “من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها” [33]. وقد أظهر بولس بوضوح الطريق الذي به يهلك الإنسان نفسه لكي يخلصها… بقوله عن القديسين: “ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات” (غل 5: 24). الذين صاروا بحق للمسيح مخلصنا يصلبون جسدهم، ويقدمونه للموت، خلال الجهاد المستمر والصراع من أجل التقوى وإماتة شهواته الطبيعية. لقد كُتب: “فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية، الطمع” (كو 3: 5). أما الذين يعيشون حياة شهوانية، فربما يحسبون أنهم يربحون أنفسهم بحياة اللذة والتدليل، بينما في الواقع هم يهلكونها، “لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادًا” (غل 6: 8). من يهلك حياته بالتأكيد يخلصها؛ هذا هو ما فعله الشهداء الطوباويون، محتملين المتاعب حتى الدم وبذل الحياة، متوجين رؤوسهم بإكليل المحبة الحقيقية للسيد المسيح. أما الذين من أجل ضعف عزيمتهم وذهنهم أنكروا الإيمان، وهربوا من موت الجسد، فصاروا قتلة لأنفسهم، إذ أنهم ينحدرون إلى جهنم ليعانوا العذابات من أجل جبنهم الشرير[27].]
هذا وقد أراد السيد المسيح أن يؤكد بأن الاهتمام بخلاص النفس غالبًا ما يكون أمرًا خفيًا لا يعرفه إلا الله والنفس ذاتها. أما الإنسان فيصعب أن يحكم على أخيه إن كان مهتمًا بخلاص نفسه أم لا، لذا يقول السيد المسيح:
“أقول لكم أنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد،
فيؤخذ الواحد ويُترك الآخر.
تكون اثنتان تطحنان معًا،
فتؤخذ الواحدة وتُترك الأخرى.
يكون اثنان في الحقل،
فيؤخذ الواحد ويترك الآخر” [34-36].
لقد قدم لنا ثلاث عينات من الناس، وفي كل عينه يوجد من هو مؤهل للتمتع بالملكوت، ومن قد حرم نفسه بنفسه من هذا الملكوت. فما هي هذه العينات الثلاث؟
أ. يرى القديس أغسطينوس[28] أن هذه العينات تمثل ثلاث طبقات من الناس، في كل طبقة يُوجد الصنفان: الطبقة الأولى الاثنان النائمان، وهي طبقة الذين ليس لهم أعمال لا في العالم ولا في الكنيسة (وربما يقصد الأعيان والأشراف الذين يعيشون على ريع ممتلكاتهم). هؤلاء يحبون الحياة الهادئة التي يُشار إليها بالسرير. أما الطبقة الثانية فيُرمز لها بالاثنتين اللتين تطحنان، وهما امرأتان تعملان تحت مشورة رجليهما، وهي طبقة الذين يعملون كما بحجر الرحى ويقدمون من تعب أيديهم خبزًا للمؤمنين، أي الذين يمارسون وظائفهم الزمنية بأمانة مقدمين من تعبهم صدقة للمساكين. أما الطبقة الثالثة التي يُرمز لها باللذين يعملان في حقلٍ واحدٍ، فهي جماعة الكهنة والخدام الذين يعملون في كرم الرب. وكأنه يوجد أبناء للملكوت بين الأغنياء كما بين المجاهدين في حياتهم اليومية وأيضًا بين خدام الكلمة، ويوجد من لا نصيب لهم في الملكوت بين هذه العينات جميعها. وكأن صداقتنا مع السيد المسيح، وتمتعنا بملكوته، لا يتوقف على ظروفنا الخارجية ونوع عملنا وإنما على حياتنا الخفية الداخلية.
ب. ربما يُقصد بالاثنين الراقدين على فراش واحد رجل وزوجته، فإنهما وإن صار جسدًا واحدًا، وتعرفا على أسرار بعضهما البعض، لكن يبقى لكل منهما حياته الخاصة مع الله، لا يدرك أسرارها الطرف الآخر، لأنه لا يقدر أن يفحص أعماق قلبه أو يدرك أسرار فكره. أما المرأتان العاملتان على حجر رحى فتشيران إلى الزمالة في العمل، بينما العاملان في الحقل فيشيران إلى الزمالة في الخدمة. ففي كل الظروف لكل إنسان حياته السرية مع صديقه السماوي. هذا ويُلاحظ أن الثلاثة أمثلة شملت: رجل وامرأة، إمرأتين، رجلين، بمعنى أن الصداقة البشرية في كل مستوياتها وبين كلا الجنسين لا تقدر أن تخترق أعماق القلب لإدراك صداقة الغير مع الله.
ج. في المثل الأول يقول: “في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر“[34]. ستكون فترة ما قبل مجيء السيد المسيح حالكة الظلام، لذا قال “في تلك الليلة“. ليلة مرة يظهر فيها “ضد المسيح” والأنبياء الكذبة، ويحدث ارتداد حتى أن أمكن المختارين أيضا أن يضلوا.
يقول القديس أمبروسيوس: [وجود أضداد المسيح هي ساعة ظلمة، إذ يسكب ضد المسيح سحابة مظلمة على أذهان البشر عندما يعلن عن نفسه أنه المسيح، ويأتي الأنبياء الكذبة ليؤكدوا مجيء المسيح في البرية فيخدعوا القلوب المتزعزعة ويضللونها، أما السيد المسيح فيأتي كالبرق القوي يسكب على العالم شعاع نوره… يشع بضوء برقه لنرى مجد القيامة وسط هذا الليل[29].]
يقول القديس أغسطينوس: [أنه يقول: “في تلك الليلة” ليعنى وسط هذا الضيق[30].] ويرى القديس كيرلس الكبير[31] أن الفراش هنا رمز للراحة، والنائمين معًا هما جماعة الأغنياء، فمنهم من هم أشرار وطماعين ومنهم من هم رحماء يترفقون بالفقراء؛ كلاهما نالا غنى لكن واحد كسب بغناه أصدقاء في المظال الأبدية، وآخر تعبد للمال والغنى.
د. إن كان الأولان يشيران إلى الأغنياء، ففي رأى القديس كيرلس الكبير[32] أن المرأتين تشيران إلى جماعة الفقراء، فليس كل غني شرير ولا كل فقير صالح، اذ يقول: [البعض يحتمل ثقل الفقر بنضوج، ممارسًا حياة مكرمة عاقلة وفاضلة بينما يحمل آخرون شخصية مختلفة، إذ يحتالون ممارسين شرورا وأعمالاً دنيئة.]
هـ. يرى القديس أمبروسيوس أن هاتين الامرأتين اللتين تطحنان معًا هما الكنيسة والمجمع اليهودي، فإنهما يطحنان القمح لتقديم خبز تقدمة لله، إذ كلاهما يفسران العهد القديم بشرائعه ونبواته، لكن المجمع في جحوده يُترك بينما كنيسة العهد الجديد التي تسلمت من المجمع أسفار العهد القديم تتمتع بالعرس السماوي.
وما نقوله عن المرأتين ينطبق على الرجلين العاملين في حقل واحد، فالمجمع بفكره الحرفي لم يستطع أن يقدم ثمر الروح الذي يفرح قلب الله، أما كنيسة العهد الجديد فتقدم “رأسها” ثمرًا حقيقيًا وبكورًا يشتمه الآب رائحة رضا.
سابعًا: اجتماع النسور حول الجثة [37] وقد سبق الحديث عنه بفيض في مت 24: 28. إذ رُفع السيد المسيح على الصليب وقبل الموت بإرادته انطلق المؤمنون كالنسور يجتمعون حوله ليجدوا فيه طعامهم الروحي واهب القيامة والحياة. وبموت ضد المسيح يجتمع الأشرار أيضا حوله كنسور يطلبون ما يناسب طبيعتهم.
- ما هي النسور؟ وما هي الجثة؟ تشبه أرواح الصديقين بالنسور، إذ ترتفع في الأعالي وتترك الأمور الدنيا، كما تعمر طويلاً، لذا يناجي داود نفسه، قائلاً: “يتجدد مثل النسر شبابك” (مز 103: 5).
إذ عرفنا النسور لا يمكن أن نشك في الجثة، خاصة ونحن نتذكر أن يوسف قد أخذ الجسد من بيلاطس (يو 19: 38). ألا ترى النسور حول الجسد؟ مريم امرأة يوسي ومريم المجدلية ومريم أم الرب وجماعة التلاميذ يحيطون بقبر الرب؟ ألا ترى النسور عندما يأتي الرب على السحاب وتبصره كل عين (رؤ 1: 7)؟ أما الجسد فهو ذاك الذي قيل عنه: “جسدي مأكل حق” (يو 6: 55)، حوله تطير النسور بأجنحة الروح، هذه النسور هي التي تؤمن بأن يسوع قد جاء في الجسد (1 يو 4: 2)… هذا الجسد أيضًا هو الكنيسة، التي فيها تهبنا نعمة المعمودية التجديد الروحي فلا تكون شيخوخة إذ يتجدد الشباب والحياة[33].
القديس أمبروسيوس
[1] On Luke hom 113- 6.
[2] In Luc 17: 3, 4.
[3] Ser. On N.T. 64: 3, 5.
[4] On Luke Ser 113- 6.
[5] On Luke hom 113- 6.
[6] Quaest. Evang. 2: 39.
[7] On Luke hom 113- 6.
[8] المؤلف: الفيلوكاليا، 1966، ص 143، 136.
[9] On Luke hom 113- 6.
[10] In Luc 16: 7- 10.
[11] Quaest . Ev 2: 39.
[12] الإنجيل بحسب متى، ص193- 195.
[13] Quaest. Ev 2: 40.
[14] On Luke hom 117.
[15] De Prop. Sec. Deum.
[16] Ep. 58: 3.
[17] Cassian: Conf 1: 13.
[18] Cassian : Conf 18: 16.
[19] On Luke hom 117.
[20] Catena Aurea.
[21] On Luke hom 117.
[22] On Luke hom 117.
[23] On Luke hom 118.
[24] In Matt. Canon 25.
[25] In Luc 17: 20- 37.
[26] Instit. 7: 27.
[27] On Luke hom 118.
[28] Quaest Ev. 2: 41.
[29] In Luc 17: 20- 37.
[30] Quaest Ev. 2: 41
[31] In Luke hom 118.
[32] In Luke hom 118.
[33] In Luc 17: 20- 37.