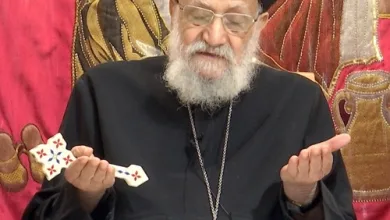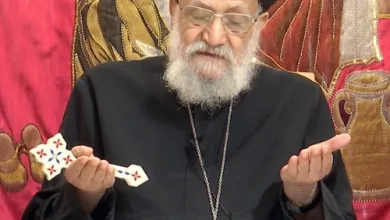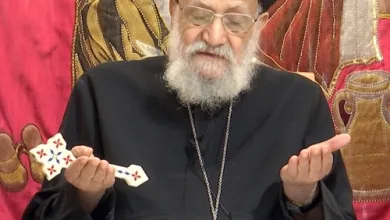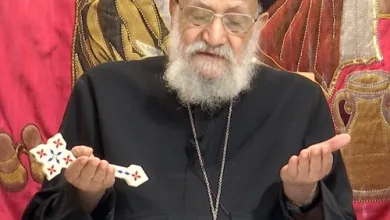تفسير انجيل لوقا 14 الأصحاح الرابع عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير انجيل لوقا 14 الأصحاح الرابع عشر - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير انجيل لوقا 14 الأصحاح الرابع عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير انجيل لوقا 14 الأصحاح الرابع عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الرابع عشر
أساسيات الصداقة الإلهيَّة
إذ حدثنا عن التوبة كطريقٍ، بدونه لن نلتقي مع صديقنا السماوي، فإن هذه التوبة يجب أن تترجم عمليًا في الآتي:
- السمو فوق الحرف 1-6.
- عدم اشتهاء المتكآت الأولى 7-11.
- اتساع القلب للمحتاجين 12-14.
- الاهتمام بالدعوة للوليمة 15-24.
- حمل الصليب 25-35.
- السمو فوق الحرف
“وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفرِّيسيِّين في السبت ليأكل خبزًا،
كانوا يراقبونه.
وإذا إنسان كان مستسقٍ كان قدامه.
فأجاب يسوع وكلّم الناموسيين والفرِّيسيِّين، قائلاً:
هل يحل الإبراء في السبت؟
فسكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه.
ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر
ولا ينشله حالاً في يوم السبت؟!
فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك” [1-6].
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي فيها يقبل السيِّد المسيح الدعوة ليأكل في بيت فرِّيسي أو أحد رؤساء الفرِّيسيِّين، ولعل قبوله دعوتهم له كان أحد ملامح كرازته التي تقوم أولاً على علاقات الصداقة والحب. فإنه ما جاء لينافسهم على كراسيهم، بل ليفتح قلبه بالحب لهم كما لغيرهم ليكسبهم في ملكوته أحبَّاء وأصدقاء على مستوى أبدي.
يروي لنا الإنجيلي لوقا قبوله دعوة سمعان الفرِّيسي (7: 36-50) حيث التقى هناك بالمرأة الخاطئة التي قدَّمت بدموعها وحبها وليمة فائقة، فاقتنت غفران خطاياها الكثيرة. كما قبل دعوة فرِّيسي آخر حيث كشف له السيِّد مفهوم التطهير الداخلي والنقاوة القلبية عوض الاهتمام بالغسالات الجسديَّة وحدها (11: 37 الخ.). والآن للمرة الثالثة يقبل الدعوة ليأكل خبزًا في بيت أحد رؤساء الفرِّيسيِّين ليكشف له عن المفهوم الحقيقي للسبت. في الدعوة الأولى يدعو السيِّد المسيح الفرِّيسيِّين للتوبة خلال الحب، وفي الثانية يطلب نقاوتهم الداخليَّة، وفي ثالثة يطلب العبادة الروحيَّة.
لقد دعاه الفرِّيسي وكان مع زملائه الفرِّيسيِّين “يراقبونه” [1]؛ يريدون أن يصطادوا له أخطاء عوض الانتفاع بصداقته.
يقول القدِّيس كيرلس الكبير:
[دعا فرِّيسي ذو رتبة عاليَّة يسوع إلى وليمة؛ ومع معرفة السيِّد لمكر الفرِّيسيِّين ذهب معه وأكل وهو في صحبتهم. تنازل وقبل ذلك لا ليكرم من دعاه، وإنما ليفيد من هم في صحبته بكلماته وأعماله المعجزية، لكي يقودهم إلى معرفة الخدمة الحقيقيَّة، ولكي يعلمنا نحن أيضًا ذلك في إنجيله. لقد عرف أنه سيجعلهم شهود عيان – بغير إرادتهم – لسلطانه ومجده الفائق للمجد البشري، لعلهم يؤمنون به أنه الله وابن الله، الذي أخذ بالحق شبهنا دون أن يتغير أو يتحول عما هو عليه. صار ضيفًا للذين دعوه، لكي يتمم عملاً ضروريًا كما قلت، أما هم فكانوا يراقبونه، ليروا أن كان يستهين بالكرامة اللائقة بالناموس فيمارس عملاً أو آخر محرمًا في السبت.
أيها اليهودي فاقد الإحساس، لتفهم أن الناموس كان ظلاً ورمزًا ينتظر الحق، وأن الحق هو المسيح ووصاياه. فلماذا تتسلَّح بالرمز ضد الحق؟ لماذا تقيم الظل مضادًا للتفسير الروحي؟ احفظ سبتك بتعقل، فإن كنت غير مقتنع بفعل هذا، فإنك تنزع عن السبت الأمور التي ترضي الله، وتكون غير مدرك للراحة (السبت) الحقيقيَّة، التي يطلبها الله منا، والتي تحدَّث عنها قديمًا في ناموس موسى. لنكف عن الخطايا، ولنسترح بترك المعاصي، ولنغتسل من الأدناس، ولنترك محبَّة الجسد الشهوانية، ولنهرب من الطمع والنهب ومن الربح القبيح ومحبَّة المال الحرام. لنجمع أولاً مئونة لنفوسنا تسندنا في الطريق، الطعام الذي يكفينا في العالم العتيد، ولنلجأ للأعمال المقدَّسة، فنحفظ السبت بطريقة عاقلة.
الذين يمارسون الخدمة بينكم اعتادوا أن يقدَّموا لله الذبائح المعينة في السبت، يذبحون الذبائح في الهيكل، ويتممون أعمال الخدمة الموكل بها إليهم ومع ذلك لم ينتهرهم أحد، بل والناموس نفسه صمت! إذن، الناموس لم يمنع البشر من الخدمة في السبت.
هذا كان رمزًا لنا، وكما قلت، أنه من واجبنا أن نحفظ السبت بطريقة عقليَّة، فنُسّر الله بالرائحة الذكيَّة الروحيَّة. وكما قلت قبلاً، نحقَّق هذا عندما نكف عن الخطايا، ونقدَّم لله تقدَّمة مقدَّسة، حياة مقدَّسة تستحق الإعجاب، متقدَّمين بثبات في كل الفضيلة. هذه هي الذبيحة الروحيَّة التي تسر الله.
إن لم يكن لك هذا في ذهنك، فإنك إنما تلتصق بغلاظة القلب التي ذكرها الكتاب المقدَّس، تاركًا الحق كأمرٍ لا تقدر أن تقتنيه، منصتًا لقول الله الذي يخبرك بصوت إشعياء النبي: “غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه، وأطمس عينيه، لئلاَّ يبصر بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويفهم بقلبه، ويرجع فيُشفى” (إش 6: 10)…
ماذا كانت المعجزة التي كانوا يراقبونها؟
كان يوجد قدامه إنسان مستسقٍ، فسأل الرب الناموسيين والفرِّيسيِّين أن كان يحل الإبراء في السبت أم لا؟ فسكتوا…
لماذا سكت أيها الناموسي؟ اقتبس شيئًا من الكتاب المقدَّس، لتظهر أن ناموس موسى يمنع عمل الخير في السبت. برهن لنا أنه (الله) يريدنا قساة القلب بلا رحمة، من أجل راحة أجسادنا، وأن يمنع اللطف من أجل تكريم السبت. هذا ما لا تستطيع برهانه من أي جزء في الكتاب المقدَّس.
إذ سكتوا بسبب المكر، فنّد المسيح عارهم الذي لا يحل، مقدَّما لهم البراهين.
يقول: “من منكم يسقط ابنه (في بعض النسخ ابنه والأخرى حماره) أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالاً في يوم السبت؟!” [5] إن كان الناموس يمنع إظهار الرحمة في السبت، فلماذا تمارسون الشفقة على الساقط في حفرة؟ لا ترتبك بالخطر الذي يحيق بابنك في السبت، بل انتهر العاطفة الطبيعيَّة التي تحثك بالحب الأبوي! لتدفع بابنك إلى القبر وأنت مبتهج، لكي تكرم واهب الناموس. كما لو كان قاسيًا غير رحيم! اترك صديقك في خطر، ولا تعطه أي اهتمام، بل وإن سمعت بكاء طفل صغير يطلب العون قل له: لتمت، فإن هذه هي إرادة الناموس!
إنك لا تقبل هذا، بل تبسط يديك للمتضايق، معطيًا إيَّاه اهتمامًا أكثر من تكريمك للناموس، أو للراحة (السبت) التي بلا أحاسيس، حتى وإن كنت لم تعرف بعد أن السبت يلزم أن يُحفظ بطريقة روحيَّة.
إله الجميع لا يكف عن أن يترفق، فهو صالح ومحب للبشر، لم يؤسس ناموس موسى لتحقيق الغلاظة، ولا أقامه كمعلم للقسوة، بل بالحري ليقودك لمحبَّة قريبك…
إذ لم يعط اهتمامًا لحسد اليهود خلّص الرجل من مرضه أي الاستسقاء[1].]
على أي الأحوال إن كان اليهودي حتى في حرفيته للناموس إن رأى حماره أو ثوره ساقطًا في حفرة لا يستطيع أن يقف جامدًا بل يتعدى الحرف لينقذ الحيوان من الخطر، أفليس بالأولى الله كلي الحب والرحمة إذ رأى البشريَّة وقد صارت شعبين، اليهود الذين تثقّلوا بنير الحرف القاتل فصاروا كالثور في حفرة الهلاك، والأمم قد امتلئوا غباوة خلال العبادة الوثنية فصاروا كالحمار الذي بلا فهم… أفلا يهتم الله بخلاصهم ليهبهم سبتًا حقيقيًا، وراحة على مستوى أبدي؟!
هذا ويرى القدِّيس أغسطينوس أن المريض بالاستسقاء كلما شرب ماءً يزداد عطشًا، لأن الماء يُفرز عن الدم، هكذا مُحب الغنى كلما نال من البركات الزمنيَّة زاد عطشه إليها بلا شبع إذ يقول: [بحق يقارن المريض بالاستسقاء بالغني الطمّاع. الأول كلما نال رطوبة غير طبيعيَّة زاد عطشه هكذا الغني الطامع نال غنى بفيض يسيء استخدامه فيزداد شغفًا لمحبَّة الغنى[2].]
يقدَّم لنا الإنجيلي إبراء هذا المريض بالاستسقاء، قائلاً: “فأمسكه وأبرأه وأطلقه” [4]. إنها ثلاث مراحل يجتازها الإنسان لينعم بعمل السيِّد المسيح الخلاصي، وهي:
أ. أمسكه: إن كان المرض قد أمسك بحياتنا، فنحن نحتاج إلى كلمة الله، الطبيب الحقيقي الذي نزل إلينا لكي يمسك بنا، فنكون في حوزته، نقبل الالتصاق به والدخول إلى الشركة معه. يمسكنا الرب بكشفه عن أسرار حبه خلال الصليب، فيأسر حياتنا ويمتص كل مشاعرنا وأحاسيسنا لحسابه كما قدَّم حبه لنا، فنقول: “حبيبي لي وأنا له” (نش 2: 16).
ب. أبرأه: إذ يمسك بنا ونحن به، ننعم بخلاصه فنبرأ من خطايانا… بمعنى آخر لقاؤنا معه يقوم على الصراحة الكاملة، نعترف له بخطايانا لننهل بالمغفرة ونتمتع بأعمال محبَّته الخلاصيَّة بلا انقطاع.
ج. أطلقه: غاية الالتقاء مع المخلِّص أن نتمتع بانطلاقة الحريَّة كأولاد الله، لكي نوجد على الدوام ثابتين فيه، ونحسب ورثة الله أبينا ووارثون مع المسيح (رو 8: 17).
هذا هو عمل السيِّد المسيح فينا: نلتقي به مُمسكين بمحبَّته، نبرأ به من خطايانا، نتحرَّر كأولاد الله لنوجد فيه أبديًا.
- عدم اشتهاء المتكآت الأولى
إذ أراد لنا السيِّد المسيح أن نقبل صداقته لنا سألنا أن نرتفع فوق الحرف، فلا نحفظ السبت بطريقة ماديَّة جافة، وإنما بطريقة روحيَّة لننعم بالراحة الأبديَّة، بإبرائنا لا من مرض الاستسقاء بل من كل خطيَّة، وتحريرنا لنوجد معه أبديًا، هذا ما رأيناه في العبارات السابقة، أما الآن فكصديقٍ لنا يريدنا أن نحمل سماته فينا حتى نقدر أن نلتقي معه، ولعل أهم هذه السمات هي التواضع وعدم محبَّة المتكآت الأولى. إنه لا يدعونا لعدم اشتهاء هذا الموضع لإذلالنا ولا ليقلل من كرامتنا، وإنما لأنه إذ اتضع واحتل المركز الأخير “كعبدٍ”، أرادنا أن نشتهي هذا المركز لنوجد معه خلال روح التواضع المملوء حبًا. بمعنى آخر سعْينا للمتكأ الأخير لا يقوم على شعور بالنقص ولا عن تغصب، وإنما عن حب حقيقي لحمل المسيح صاحب المتكأ الأخير. فيتجلَّى فينا، وتعلن سماته بقوَّة مشرقة على من حولنا، فيصير ذلك سرّ مجد داخلي في الرب.
“وقال للمدعوين مثلاً،
وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكآت الأولى، قائلاً لهم:
متى دعيت من أحد إلى عرسٍ،
فلا تتكئ في المتكأ الأول،
لعل أكرم منك يكون قد دُعي منه،
فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك أعطي مكانًا لهذا،
حينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير” [7-9].
- ربما تبدو مثل هذه الأمور للبعض تافهة ولا تستحق إعارتها الانتباه، لكن متى ركز الإنسان عيني ذهنه عليها فسيتعلم من أي عيب تخلّص الإنسان، وأي تدبير حسن توجده فيه. فإن الجري وراء الكرامات بطريقة غير لائقة لا تناسبنا ولا تليق بنا، إذ تظهرنا أغبياء وعنفاء ومتغطرسين، نطلب لا ما يناسبنا بل ما يناسب من هم أعظم منا وأسمى.
من يفعل هذا يصير كرهًا، غالبًا ما يكون موضع سخريَّة عندما يضطر بغير إرادته أن يرد للآخرين الكرامة التي ليست له… يلزمه أن يعيد ما قد أخذه بغير حق.
أما الإنسان الوديع والمستحق للمديح الذي بدون خوف من اللوم يستحق الجلوس بين الأولين لكنه لا يطلب ذلك لنفسه بل يترك للآخرين ما يليق به، فيُحسب غالبًا للمجد الباطل وسيتقبل مثل هذه الكرامة التي تناسبه، إذ يسمع القائل له: “ارتفع إلى فوق” [10].
إذن العقل المتضع عظيم وفائق الصلاح، يخّلص صاحبه من اللوم والتوبيخ ومن طلب المجد الباطل…
إن طلبت هذا المجد البشري الزائل تضل عن طريق الحق الذي به يمكنك أن تكون بالحق مشهورًا وتنال كرامة تستحق المنافس! فقد كُتب: “لأن كل جسد كعشبٍ، وكل مجد إنسان كزهر عشب” (1 بط 1: 24). كما يلوم النبي داود محبي الكرامات الزمنيَّة، قائلاً لهم هكذا: “ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يُقلع” (مز 129: 6). فكما أن العشب الذي ينبت على السطح ليس له جذر عميق ثابت لذا يجف سريعًا، هكذا من يهتم بالكرامات الدنيويَّة بعد أن يصير ظاهرًا في وقت قصير كالزهرة يسقط إلى النهاية، ويصير كلا شيء.
إن أراد أحد أن يسبق الآخرين فلينل ذلك بقانون السماء، وليتكلل بالكرامات التي يهبها الله. ليسمو على الكثيرين بشهادة الفضائل المجيدة، غير أن قانون الفضيلة هو الذهن المتواضع الذي لا يطلب الكبرياء بل التواضع! هذا هو ما حسبه الطوباوي بولس أفضل من كل شيء، إذ كتب إلى أولئك الذين يرغبون في السلوك بقداسة: احبوا التواضع (كو 3: 12). وقد مدح تلميذ المسيح ذلك، إذ كتب هكذا: “ليفتخر الأخ المتضع (المسكين) بارتفاعه، وأما الغني فبتواضعه لأنه كزهر العشب يزول” (يع 1: 9-10). الذهن المتضع والمنضبط يرفعه الله، إذ “القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره” (مز 51: 17).
من يظن في نفسه أمرًا عظيمًا وساميًا فيتشامخ في فكره وينتفخ في علو فارغ يكون مرذولاً وتحت اللعنة، إذ يسلك على خلاف المسيح القائل: “تعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب” (مت 11: 29). كما قيل: “لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة” (1 بط 5: 5). لقد أظهر الحكيم سليمان في مواضع كثيرة الأمان الذي يحل بالذهن المتضع، إذ يقول: “لا تنتفخ كي لا تسقط” (ابن سيراخ 1: 30)؛ كما يعلن ذات الأمر بطريقة تشبيهية: “المعلي بابه (بيته) يطلب الكسر” (أم 17: 19). مثل هذا يبغضه الله بعدل إذ يُخطئ في حق نفسه ويود أن يتعدى حدود طبيعته بغير شعور…
أسألك، على أي أساس يظن الإنسان في نفسه أمرًا عظيمًا؟!…
ليت كل إنسان ينظر إلى حاله بعينين حكيمتين فيصير كإبراهيم الذي لم يُخطئ في إدراك طبيعته بل دعي نفسه ترابًا ورمادًا (تك 18: 27)[3].
القدِّيس كيرلس الكبير
- هل ترفض أن تتواضع وأنت بالفعل ساقط؟! شتان ما بين من يتضع ومن هو بالفعل ساقط على الأرض. أنت مُلقى على الأرض، أفلا تريد أن تتواضع؟![4]
القدِّيس أغسطينوس
- لا يحصل طالب الكرامة على ما يطمع فيه إنما يعاني من خيبة أمل، وإذ يشغل نفسه بكيفيَّة تثقله بكرامات إذا بها يجد إهانات. وإذ لا يوجد شيء أفضل من التواضع لذلك يقود السيِّد السامع له لا إلى رفض طلب الأماكن المرموقة، وإنما يوصيه بالبحث عن الأماكن المتضعة[5].
القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
- لا يظن أحد في وصايا المسيح هذه أنها تجعله شخصًا تافهًا غير مستحق لسمو كلمة الله وجلالها.
الأب ثيؤفلاكتيوس
هذا ويحذِّرنا القدِّيس باسيليوس من إساءة فهم كلمات السيِّد المسيح، فإنه طلب منا ألا نشتهي المراكز الأولى بل نطلب المتكأ الأخير، لكننا نطلبه بهدوء وفي تواضع ونظام لا خلال العنف أو حب الظهور، فإن سألنا صاحب الدعوة أن نأخذ المتكأ الأول نقبل بهدوء أيضًا ولا نفسد نظامه… بمعنى آخر أن كلمات السيِّد تمس أعماق القلب لكي لا يشتهي الإنسان المجد الباطل، سواء جلسنا هنا أو هناك. الله يطلب القلب لا المظهر الخارجي. لذلك ختم السيِّد المثل بقوله: “لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع” [11].
يمكننا أن نقول بأن صاحب العرس أو الوليمة هو رب المجد يسوع نفسه الذي دعانا جميعًا لنتكئ في كنيسته، الوليمة المفرحة للنفس، فيجتاز في وسطها بلا توقف لأنها مقدَّسة ليرى أصحاب القلوب المتواضعة، فيفيض عليهم من ثمر روحه القدُّوس بغنى، ويرفعهم في أعين السمائيين والأرضيين، وكما قالت القدِّيسة مريم حين قبلت صاحب الوليمة في أحشائها: “أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين” (لو 1: 52).
3.اتساع القلب للمحتاجين
إذ قدَّم لنا السيِّد بتواضعه أساسًا بقبول صداقته أن نحمل فينا فكره، فنسلك بروح التواضع طالبين المتكأ الأخير، مشتهين ترك المتكآت الأولى لإخوتنا، مقدَّمين بعضنا البعض في الكرامة (رو 12: 10)، الآن يسألنا أيضًا أن نتمثل به بكونه صديقنا السماوي فنحمل قلبًا متسعًا للمحتاجين والمعوزين والمعوقين والمطرودين. إن كان الرب في تجسده قد جاء إلى الإنسان الضائع تاركًا خليقته السماويَّة، أي التسعة والتسعين حَمَلاً ليطلب الخروف الضال، محتملاً بالحب آلام الصليب ليرفعه علي منكبيه ويحمله إلى مجد سماواته، هكذا يليق بنا أن نبحث عن كل محتاج وذليل.
“وقال أيضًا للذي دعاه:
إذا صنعت غذاءً أو عشاءً فلا تدع أصدقاءك
ولا أخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء،
لئلاَّ يدعوك هم أيضًا فتكون لك مكافأة.
بل إذا صنعت ضيافة، فادع المساكين الجدع العرج العُمي.
فيكون لك الطوبى،
إذ ليس لهم حتى يكافؤك،
لأنك تكافئ في قيامة الأبرار” [12-14].
- إن كنا نخجل من هؤلاء الذين لا يخجل منهم المسيح، فنحن نخجل من المسيح نفسه بخجلنا من أصدقائه. لتملأ مائدتك من العرج والمشوهين، فإن المسيح يأتيك خلالهم لا خلال الأغنياء[6].
- إن دعوت صديقًا يبقى يشكرك حتى المساء، لكن الصداقة تبقى إلى حين وتنتهي سريعًا جدّا فلا توازي ما تكلفته من مصاريف. أما أن دعوت فقيرًا أو مشوهًا، فإن الشكر لا يفسد، لأن الله يذكره لك أبديًا، لن ينساه، إذ يكون هو نفسه مدينًا لك[7].
- لنتبع الصداقات التي حسب الروح لأنها قويَّة ويصعب حلها، وليس الصداقات التي تقوم حول المائدة[8].
- كلما كان أخونا متواضعًا يأتي المسيح خلاله ويفتقدنا. لأن من يستضيف إنسانًا عظيمًا غالبًا ما يفعل هذا عن مجدٍ باطلٍ… ليتنا لا نطلب القادرين أن يكافؤننا، بل نتبع القول: “فيكون لك الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافؤك”.
ليتنا لا نضطرب حينما لا يُرد لنا اللطف باللطف، لأننا إن تقبلناه من الناس لا ننال ما هو أكثر، أما إذا لم يُرد لنا من البشر فالله يرده لنا.
- يليق بك أن تستقبل (الفقراء) في أفضل حجراتك، فإن أحجمت عن هذا فلا أقل من أن تتقبل المسيح في الحجرات الدنيا حيث يوجد الذين يقومون لك بالأعمال الحقيرة والخدم.
ليكن الفقير علي الأقل حافظًا بابك، لأنه حيث توجد الصدقة لا يقدر الشيطان أن يقتحمه ويدخل.
إن لم تجلس معهم، فعلى الأقل ارسل لهم الأطباق من مائدتك[9].
القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
يستعرض القدِّيس كيرلس الكبير[10] تعليقاته علي هذا المثل قائلاً بأن المهتمين بتقديم صور جميلة لا يكتفون باستخدام لون واحد، هكذا إله الجميع واهب الجمال الروحي ومعلمه يزين نفوسنا بفضائل متنوعة لنحمل حياة مقدَّسة من جوانب متنوعة [ليكمل فينا شبهه.] لهذا أمر السيِّد المسيح الناموسيين والفرِّيسيِّين والكتبة أن يسلكوا بروح التواضع ويتحرَّروا من محبَّة المجد الباطل وألا يطلبوا المتكآت الأولى، والآن يطلب منهم محبَّة الفقراء، فلا يستضيفوا في ولائمهم الأغنياء لطلب المديح وحب الظهور بل المحتاجين والمعوقين والمتألَّمين بكل أنواع الأمراض الجسديَّة للحصول علي الرجاء في العلويَّات من الله نفسه. يكمل القدِّيس كيرلس الكبير حديثه عن هذه الفضيلة التي تزين النفس، قائلاً:
[الدرس الذي يعلمنا إيَّاه هو حب الفقراء، الأمر الثمين في عيني الله…
هل تشعر بالسرور عندما يمدحك أصدقائك وأقاربك الذين تستضيفهم في الوليمة؟ أخبرك بما هو أفضل، فإن الملائكة تمدح سخاءك، والقوات العلويَّة العاقلة والقدِّيسون يفعلون ذلك، بل والله أيضًا يقبل هذا الذي يسمو بالكل ويحب الرحمة وحنون. اقرضه ولا تخف، فسيرده إليك ومعه ربا، إذ قيل “من يرحم الفقير يقرض الرب” (أم 19: 17). أنه يعرف القرض ويعد بالوفاء به (مت 18: 23 الخ)…
اقتن النعمة النابعة عن الله. اقتن لك رب السماء والأرض صديقًا، فإنه بالحق يقتني الإنسان صداقة البشر غالبًا بذهبٍ كثيرٍ، فإن تصالح معنا أصحاب الرتب العاليَّة نشعر بفرحٍ عظيمٍ بتقديم هدايا أكثر من طاقتنا بسبب نوالنا كرامة الالتصاق بهم، ومع هذا فإن هذه الأمور زائلة، تنتهي سريعًا تعبر كخيال الأحلام.
ألا يليق بنا أن نحسب عضويتنا في بيت الله تستحق أن نقتنيها؟ أما نحسبها أمرًا عظيمًا؟! فبالتأكيد بعد القيامة من الأموات سنقف في حضرة المسيح، وتُقدَّم المكافأة للمترفقين والرحماء، وتكون الدينونة قاسيَّة علي العنفاء الذين لم يكن لهم الحب الطبيعي… إذ قيل: “لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة” (يع 2: 13).]
أما العلامة أوريجينوس فإذ يأخذ بالتفسير الرمزي. يرى في الوليمة، المائدة الروحيَّة حيث يليق بنا نطرد عنا المجد الباطل ونستضيف الفقراء أو المساكين أي الجهلاء الذين تعوزهم الحكمة، لكي يجدوا في مائدتنا السيِّد المسيح الذي يغني الكل. ونستضيف الضعفاء الذين يقاومون الضمير الداخلي لكي يبرأوا داخليًا. كما نستضيف العرج، أي الذين ضلّوا عن السلوك في الحق لكي يجدوا الطرق المستقيمة في الرب؛ ونستضيف العُمي الذين ليس لهم بصيرة روحيَّة لإدراك الحق لكي يتمتعوا بالنور الحقيقي… هؤلاء ليس لهم ما يكافؤننا به إذ لا يجدوا ما يجيبون به علينا أمام الكرازة المملؤة حبًا!
- الاهتمام بالدعوة للوليمة
إذ أراد السيِّد المسيح كفنانٍ ماهرٍ أن يصوّر أذهاننا بألوان الفضيلة المتباينة كما قال القدِّيس كيرلس الكبير ليشكل أيقونة جميلة علي مثاله، تحمل صورته، أوصانا أن نفتح قلوبنا بالحب للمساكين والمعوزين والمشوهين جسديًا وروحيًا لإشباعهم لحساب الرب نفسه، منتظرين المكافأة العلويَّة من الله وحده. لكننا لن نقدر أن نفتح قلبنا بالحبٍ كوليمة نستضيف فيها اخوتنا الأصاغر ما لم ننعم نحن أولاً كأطفالٍ أصاغر بالدخول إلى الوليمة الإلهيَّة. لهذا جاء حديث رب المجد موجهًا إلينا لكي نقبل التمتع بوليمته ولا نرفض دعوته إلينا… ندخل إلى وليمته الروحيَّة، فتصير قلوبنا ذاتها وليمة محبَّة لإخوتنا في الرب.
“فلما سمع ذلك واحد من المتكئين،
قال له: طوبى لمن يأكل خبزًا في ملكوت الله.
فقال له: إنسان صنع عشاءً عظيمًا ودعا كثيرين.
وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين:
تعالوا، لأن كل شيء قد أعد” [15-17].
إذ سمع المتكئون حديث السيِّد المسيح السابق، أراد أحدهم أن يتمتع بالمكافأة التي وعد بها السيِّد من يدعو الفقراء في ولائمه، فظن أن المكافأة هي تمتع بولائم ماديَّة في ملكوت السماوات، إذ قال: “طوبى لمن يأكل خبزًا في ملكوت الله“. هكذا كان قادة الفكر اليهودي ماديين في تفكيرهم حتى بالنسبة لملكوت الله، أما أولاد الله فيجدون شبعهم لا في الطعام المادي، بل في الله نفسه “الحب الحقيقي”، لذلك يقول القدِّيس إكليمنضس السكندري: [الفلاسفة أحكم من الأغنياء، إذ لا يدفنون أذهانهم في الطعام، ولا ينخدعون بملذّاته. الحب (أغابي) هو الطعام السماوي، مائدة العقل. المحبَّة تحتمل كل شيء، وتصبر علي كل شيء، وتترجى كل شيء. المحبَّة لا تسقط أبدًا (1 كو 13: 7-8)[11].]
يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [ربما لم يكن هذا الإنسان قد صار روحيًا بعد، بل كان جسديًا، لا يقدر أن يفهم ما نطق به المسيح بطريقة سليمة، لأنه لم يكن ممن آمنوا ولا نال العماد. ظن أن مكافآت القدِّيسين عن أعمال محبَّتهم المشتركة تخص أمور الجسد[12].]
إذ كان هذا الرجل – غالبًا من الفرِّيسيِّين المدعوين عند أحد رؤسائهم – يمثل الفكر اليهودي المادي حتى في الأمور السماويَّة، لهذا قدَّم لهم السيِّد المسيح المثل التالي ليكشف لهم عن سرّ رفض الكثيرين للدعوة السماويَّة، ألا وهو انحدار الفكر نحو الأمور الماديَّة، وانغماس النفس في الزمنيات، واستعبادها للشهوات الزائلة، إذ قال الرب:
“إنسان صنع عشاءً عظيمًا، ودعا كثيرين.
وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين:
تعالوا لأن كل شيء أُعد.
فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون.
قال له الأول: إني اشتريت حقلاً، وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني.
وقال آخر: إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماضِ لأمتحنها، أسألك أن تعفيني.
وقال آخر: إني تزوجت بامرأة، فلذلك لا أقدر أن أجيء.
فأتي ذلك العبد وأخبر سيِّده بذلك” [16-21].
- نفهم الإنسان هنا يشير لله الآب… هو خالق المسكونة، وأب المجد، قد أعد عشاءً عظيمًا، أي وليمة للعالم كله تكريمًا للمسيح. في الأيام الأخيرة للعالم، أي أيامنا هذه قام الابن لأجلنا، فيها أيضًا احتمل الموت من أجلنا وسلم جسده مأكلاً، بكونه الخبز النازل من السماء، يعطي حياة للعالم.
نحو المساء أيضًا، علي ضوء السراج كان الحمل يُقدَّم ذبيحة حسب شريعة موسى، لهذا فالدعوة التي قدَّمها المسيح دُعيت عشاءً.
بعد ذلك، من هو الذي أُرسل، والذي قيل عنه أنه عبد؟ ربَّما يقصد المسيح نفسه، فمع كونه بالطبيعة هو الله الكلمة، ابن الله الآب… لكنه أخلى نفسه وأخذ شكل العبد. بكونه إله من إله فهو رب الكل، لكن يمكن تسميته عبدًا من جهة ناسوته. ومع أنه أخذ شكل العبد كما قلت فهو رب بكونه الله.
متى أُرسل؟ عند العشاء، فإن ابن الله الآب الوحيد لم ينزل من السماء ويصير في شكلنا في بداية هذا العالم، بل بالحري عندما أراد الكلي القدرة نفسه ذلك في الأزمنة الأخيرة كما سبق فقلت.
وما هي طبيعة الدعوة؟ “تعالوا، لأن كل شيء قد أعد”، لأن الله الآب يُعد لسكان الأرض في المسيح المواهب التي تُعطى للعالم خلاله، من غفران للخطايا، وغسل الأدناس، وشركة الروح القدس، والتبني المجيد كأبناء، وملكوت السماوات. دعا المسيح إسرائيل لهذه البركات بوصايا الإنجيل قبل الآخرين كلهم. ففي موضع يقول بصوت المرتل: “قد أقمت ملكًا بواسطته – أي بالله الآب – علي صهيون جبل قدسي لأخبر بوصايا الرب” (راجع مز 2: 6-7). مرة أخري قيل: “لم أُرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة” (مت 15: 24).
هل كان تصميمهم هذا لصالحهم؟ هل أُعجبوا بلطف ذاك الذي أمرهم وعمل ذاك الذي جاء ليخدمهم بالدعوة؟ بلى، إذ “ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون”، بمعنى أنهم بدون تأجيل استعفوا عن قبول الدعوة… ها أنت تدرك كيف لم يستطيعوا أن يدركوا الأمور الروحيَّة بتسليم أنفسهم للأمور الزمنيَّة فصاروا كمن هم بلا إحساس، إذ غلبتهم محبَّة الجسد صاروا بعيدين عن القداسة، طامعين، شغوفين نحو الغنى. طلبوا الأمور الدنيا ولم يعطوا أقل اهتمام للرجاء فيما يخزنه الله فوق. فإن اقتناء مباهج الفردوس لهو أفضل من الحقول الأرضية؛ وجمع ثمار البرّ أفضل من الثمار الزمنيَّة التي نبتغيها من نير الثيران، إذ كُتب: “ازرعوا لأنفسكم بالبّر، اجمعوا ثمر الحياة كحصاد كرم السنة” (راجع هو 10: 12). ألم يكن من واجبهم عوض أن ينجبوا أولادًا حسب الجسد أن يكون لكم الثمر الروحي؟ لأن الأولين يخضعون للموت والفساد، أما الآخرون فيسكنون أبديًا كقدِّيسين[13].
القدِّيس كيرلس الكبير
نعود للمثل لنجد صاحب الوليمة يرسل قبل العشاء مباشرة ليدعو الكل، إذ كانت العادة في الشرق هكذا يرسل صاحب الوليمة عبيده أولاً ليدعو أصدقائه، وقبل الأكل مباشرة يرسل ثانية يتعجلهم. هكذا سبق فأرسل الله لنا الأنبياء أولاً، حتى قبل وليمة الصليب أرسل ابنه الوحيد مخليًا ذاته كعبدٍ يدعونا إلى وليمة الحب الإلهي، إلى ذبيحته التي يمكن أن تشبع الكل. وكما يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: [حقًا، لقد قدَّمت الذبيحة عن البشريَّة كلها، وهي كافيَّة لخلاص الجميع، لكن لا يتمتع ببركتها سوى المؤمنون وحدهم[14].]
من هم المعتذرون؟ يقول القدِّيس أغسطينوس[15] أنهم ثلاثة أنواع:
أولاً: الإنسان الذي اشترى حقلاً: يمثل من له سلطان علي بقعة معينة، فيرمز للكبرياء.
ثانيًا: من اشترى خمسة أزواج بقر، يشير إلى المرتبك بالأمور الحسيَّة الجسديَّة، إذ لكل إنسان خمس حواس جسديَّة (النظر، السمع، اللمس، الشم، التذوق) لها أثرها علي النفس، كمن يحمل خمس حواس خفيَّة. فمن يرتبك بهذه الحواس في الأمور الأرضية تشغل جسده كما نفسه عن التمتع بملكوت الله.
ثالثًا: المعتذر بالزواج: يشير إلى من حوّل حتى المقدَّسات إلى لذة جسديَّة تعوقه عن اللذة الروحيَّة.
يلخص القدِّيس أغسطينوس هذه الأعذار قائلاً: [ليتنا نترك الأعذار الباطلة الشرِّيرة، ونأتي إلى العشاء الذي يجعلنا في شبع داخلي. ليتنا لا ننتفخ بالكبرياء الذي يعوقنا، ولا أيضًا حب الاستطلاع الذي يفزعنا ويبعدنا عن الله، ليت ملذّات الجسد لا تعوقنا عن لذة القلب. لنأتِ ولنشبع[16]!]
ويرى القدِّيس أمبروسيوس[17] في تعليقاته علي إنجيل لوقا أن المعتذرين الثلاثة يمثلون محبَّة العالم بطرق متنوعة، الأول ينشغل بالأرضيات فيقتني لنفسه مسكنًا أرضيًا يشغله عن ملكوت الله، لذا جاءت وصيَّة الرب: “بع أملاكك…وتعال اتبعني” (مت 19: 21). وأيضًا شراء البقر يشير إلى الارتباك بأعمال العالم، لذلك ذبح إليشع فدان بقر وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب ليأكلوا (1 مل 19: 21). والثالث الذي تزوج يشير إلى من يهتم بما للعالم ليرضي زوجته (1 كو 7: 33).
يمكننا أن نقول ليس العيب في الحقل (المسكن الأرضي)، ولا في البقر (العمل)، ولا في الزوجة (العلاقة الأسريَّة)، إذ يمكن للإنسان أن يتقدس جسده مع نفسه أن يكون بيته وعمله وأسرته مقدَّسا للرب، إنما العيب في الارتباك بهذه الأمور خارج دائرة الحب الإلهي والاهتمام بالميراث الأبدي.
يقول القدِّيس أمبروسيوس[18] أن البعض يقدَّمون تفسيرًا آخر وهو أن المستبعدين من الوليمة ثلاثة: الأمم الوثنية، واليهود (الجاحدون)، والهراطقة. فالأمم يمثلون محبَّة المال والطمع، لذا يوصينا الرسول أن نهرب من الطمع (رو 1: 29) لئلاَّ نُعاق من الوليمة كالأمم، كما يقول: “فإنكم تعلمون هذا أن كل زانٍ أو نجسٍ أو طماعٍ الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله” (أف 5: 5). ويحمل اليهود (كالخمسة أزواج بقر) نير الناموس بطريقة حرفيَّة قاتلة، وهي خمسة أزواج، أي عشرة إشارة إلى الوصايا العشرة. وقد قيل للسامريَّة: “كان لك خمسة أزواج” (يو 4: 18). أما نحن فقد أخذنا المسيح الذي وضع علينا نير محبَّته الإلهيَّة (مت 11: 30). ولعل الهراطقة يشّبَهون بالمرتبك بامرأته إذ يرفضون الكنيسة العروس الحقيقيَّة للسيد المسيح ليقيم لأنفسهم زوجة تعوقه بالتعاليم الفاسدة عن العرس السماوي.
ويرى البابا غريغوريوس (الكبير)[19] أن المرتبك بالحقل يشير إلى من يهتم بالأمور الخارجيَّة لحياته لا بالحياة الروحيَّة الداخليَّة. والمهتم بالخمسة أزواج بقر يشير إلى من يهتم بالأمور الحسيَّة الجسديَّة لا الحياة السرائريَّة العميقة. والمرتبك بزوجته يشير إلى من يشوه الزواج، فعوض قبوله للإنجاب يتحول إلى مجالٍ لشهوة الجسد وملذّاته.
ويرى العلامة أوريجينوس أن من يقتني الحقل مستهينًا بالوليمة هو ذاك الذي يتقبل تعاليم لاهوتيَّة مغايرة رافضًا كلمة الحق. ومن يشتري خمسة أزواج بقر هو من يستهين بطبيعته العاقلة الروحيَّة ليخضع لحواس الجسد، فلا يدرك الروحيات. وأما من يتزوج فيشير لمن ارتبط بالجسد، مهتمًا بالملذّات الجسديَّة أكثر من الله.
أخيرًا فإن كثير من الآباء تحدَّثوا عن رافض الدعوة بسبب زواجه، مؤكدين أن القرابات العائليَّة خاصة الزوجيَّة مقدَّسة إن كانت في الرب لبنيان النفس:
- إنني لا أرفض رباط الزواج، لا بل أسلم به في حب أعظم، لأنني بهذا أشهد معترفًا لزوجتي التي عينها لي الرب وأكرّمها، ولا أرفض الارتباط بها برباط الحب في المسيح الذي لا ينفك أبدًا[20].
الأب ثيوناس
- إله السلام الذي يحثُّنا أن نحب أعدائنا لا يدخل فينا الكراهية والانحلال من جهة من هم أعزاء علينا. إن كنا نحب أعداءنا فبالأكثر نرتفع لنحب الأعزاء القريبين منا…
إن كان أب أو ابن أو أخ شرِّيرا يعوق الإنسان عن الإيمان ويصده عن الحياة العلويَّة فلا يصادقه ولا يتفق معه إنما لينحل من رباطاته الجسديَّة (في هذا الشأن)[21].
القدِّيس إكليمنضس السكندري
الآن إذ كشف السيِّد المسيح في مثله عن العينات الرافضة لوليمته الإنجيليَّة بسبب الارتباط بالأمور الزمنيَّة والشهوات الجسديَّة، أكمل حديث رب البيت هكذا: “أخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة وأزقتها، واِدخِل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي” [21]. إن كان الرافضون للوليمة في المرتبة الأولى يمثلون اليهود جاحدي الرسالة الإنجيليَّة، فإن حديث رب البيت هنا يشير إلى فتح باب الإيمان لجميع الشعوب والأمم التي عاشت زمانًا في العبادات الوثنية ورجاساتها. فكانت أشبه بالمساكين، ليس لهم كنوز الوصايا الإلهيَّة أو التنبؤات، وكالجدع والعرج مشلولي الحركة الروحيَّة، كالعمي بلا بصيرة داخليَّة. كانوا كمن هم في الشوارع والأزقة ليس لهم بيت الله يستريحون فيه. والآن تنفتح لهم أبواب المدينة السماويَّة لينعموا بالمائدة الإلهيَّة ويوجدوا في حضرة الله أعضاء جسد المسيح، أبناء الله الحي.
- جاء الأمم من الشوارع والأزقة، ليت الهراطقة يرجعون من السياجات ويتخلصون من الأشواك![22]
القدِّيس أغسطينوس
- الذين هزمتهم مصائب هذا العالم ألزمهم حب الله بالعودة والدخول.
مرعبة هي العبارة التاليَّة: “لأني أقول لكم أنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي” [24]. ليته لا يحتقر أحد الدعوة، لئلاَّ إذ يُدعى يعتذر، وعندما يود الدخول لا يستطيع ذلك![23]
البابا غريغوريوس (الكبير)
- يرسل عبيده ليدعو المساكين والجدع والعرج والعمي، لأن “الحكمة تنادي في الخارج” (أم 1: 20).
أرسل يدعو الخطاة، ليَّاتوا من الطريق الرحب إلى الضيق (مت 7: 13).
أرسل عبده إلى شوارع المدينة وأزقتها، فإن الذين يتأهلون لملكوت الله يلزمهم أن يتركوا اشتهاء الأمور الحاضرة ويسرعون إلى الخيرات العتيدة (التي كما في سياج وليس في الشوارع والأزقة). فإن السياج تفصل الأراضي المزروعة عن الشوارع لتمنع الحيوانات من الدخول فلا تتلف الزرع. هكذا بدرع الإيمان (كما بسياج) نميز الخير عن الشر لنقاوم تجارب الأرواح الشرِّيرة. لهذا عندما أراد الرب أن يُظهر محافظته على كرمه قال: “أحاطه بسياج” (مت 21: 33)[24].
القدِّيس أمبروسيوس
- الذين كان لهم المركز السامي بين عامة الشعب لم يخضعوا للمسيح، عندما قال لهم: “احملوا نيري” (مت 11: 29)، بل رفضوا الدعوة، ولم يقبلوا الإيمان، وبقوا مبتعدين عن الوليمة، محتقرين العشاء العظيم خلال عصيانهم العنيف. يظهر عدم إيمان الكتبة والفرِّيسيِّين بالمسيح من كلماته لهم: “لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم، والداخلون منعتموهم” (لو 11: 52). عوضًا عنهم قدَّمت الدعوة للذين في الشوارع والأزقة المنتسبين أيضًا لعامة الشعب اليهودي، الذين كانوا أيضًا مرضى فكريًا وضعفاء ومعوقين… فيُحسبون كعمي وعرج، لكنهم صاروا في المسيح أقوياء وأصحاء تعلموا المشي باستقامة وتقبلوا النور الإلهي في ذهنهم…
لاحظ أيضًا دعوة الأمم بعدما دخل هؤلاء (البسطاء من) اليهود في الإيمان. فقد كان الأمميون في القديم مساكين في أذهانهم ليس لهم ثقافة (روحيَّة) من جهة الفهم، قل أنهم كانوا خارج المدينة، يعيشون بلا ناموس كقطيع حملانٍ أكثر منهم بشر، قليلاً ما يستخدمون العقل. لهذا السبب أرسل من يدعو للعشاء إلى الذين هم في الطرق خارج المدينة… بل كمن يلزمهم بالدخول. مع هذا فدعوة البشريَّة للإيمان عمل اختياري، يقبلونه بكامل حريَّة إرادتهم، فيصيرون مقبولين لدى الله، ويتمتعون بفيض عطاياه[25].
القدِّيس كيرلس الكبير
كيف يلزمهم بالتمتع بالوليمة مع أن الدعوة اختياريَّة للإيمان؟ يجيب القدِّيس كيرلس الكبير بأن الأمم صارت كمن في عبوديَّة إبليس غير قادرة على الحركة، تحتاج إلى من يجتذبها من هذه العبوديَّة كقول السيِّد: “لا يقدر أحد أن يقبل إليّ أن لم يجتذبه الآب” (يو 6: 44). هذا الاجتذاب يتحقَّق بقوَّة الله العامل في الأمم ليقبلوا السيِّد المسيح. فالالتزام هنا لا يعني فقدان الإنسان حريَّة إرادته، إنما تقديم العون الإلهي الذي يدفعه للإيمان.
الإنسان في إيمانه أيضًا يسأل الرب بكمال حريته أن يقتنصه لملكوته كمن يلزمه، بمعنى أنه بإرادته يسلم حياته في يّد الرب ليعمل الله فيه حسب إرادته الإلهيَّة.
لعل أيضًا الإلزام هنا لا يعني إلزام الأفراد لقبول الدعوة، وإنما إلزام الأمم بعد أن رفض اليهود، فدخلت الشعوب الأممية إلى الإيمان المسيحي.
- حمل الصليب
إن كانت الصداقة الإلهيَّة تستلزم فينا حمل سمات صديقنا الأعظمk وقبول دعوته لوليمته الإنجيليَّة، فإن هذه الصداقة تقوم داخل دائرة الصليب. حمل صديقنا الصليب من أجلنا، فلنحمله نحن أيضًا من أجله! هذا هو حساب النفقة التي سألنا السيِّد أن نضعها في الاعتبار لبناء برج الصداقة.
“وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم:
إن كان أحد يأتي إليّ،
ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته
حتى نفسه، فلا يقدر أن يكون لي تلميذًا” [25-26].
إذ كانت الجموع تلتف حوله، وتسير وراءه، يعلن السيِّد لهم مفهوم “الصداقة معه” والالتفاف حوله والسير وراءه. إنه لا يطلب المظهر الخارجي المجرد، إنما يطلب اللقاء القلبي أولاً حينما يرفض القلب ألا يدخل أحد فيه لا الأب ولا الأم ولا الابن…إلا عن طريق الصديق الأعظم يسوع المسيح. حتى نفوسنا لا نحبها خارج الله! هذا هو مفهوم الحب الحقيقي، ألا وهو قبول الصليب مترجمًا عمليًا ببغض كل علاقة خارج محبَّة الله. بمعنى آخر إن كنت أبغض أبي وأمي وأبنائي وإخوتي حتى نفسي، إنما لكي أتقبلهم في دائرة حب أعمق وأوسع، إذ أحبهم في الرب، أحب حتى الأعداء والمقاومين لي في الرب الذي أحبني وأنا عدو ومقاوم ليغتصبني لملكوته صديقًا ومحبوبًا لديه.
- ربما يقول البعض: ما هذا يا رب؟ أتحتقر نواميس العاطفة الطبيعيَّة؟ أتأمرنا بأن يكره أحدنا الآخر وأن نستهين بالحب الواجب من الآباء نحو الأبناء، والأزواج نحو الزوجات، والإخوة نحو بعضهم البعض؟
هل نحسب أعضاء البيت أعداء لنا، مع أنه يليق بنا أن نحبهم؟ هل نجعلهم أعداء لكي نقترب إليك ونقدر أن نتبعك؟
ليس هذا هو ما يعنيه المخلِّص، فإن هذا فكر باطل غير لائق؛ لأنه أوصانا أن نكون لطفاء حتى مع الأعداء القساة، وأن نغفر لمن يسئ إلينا، قائلاً: “أحبوا أعدائكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم”، كيف يمكنه أن يرغب فينا أن نبغض من ولدوا في نفس العائلة، وأن نهين الكرامة اللائقة بالوالدين وأن نحتقر إخوتنا؟ نعم حتى أولادنا بل وأنفسنا؟…ما يريد أن يعلمنا إيَّاه بهذه الوصايا يظهر واضحًا لمن يُفهم مما قاله في موضع آخر عن ذات الموضوع: “من أحب أبًا أو أمًا أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنًا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني” (مت 10: 37). فبقوله: “أكثر مني” أوضح أنه يسمح لنا بالحب لكن ليس أكثر منه. أنه يطلب لنفسه عاطفتنا الرئيسيَّة، وهذا حق، لأن محبَّة الله في الكاملين في الذهن لها سموها أكثر من تكريم الوالدين ومن العاطفة الطبيعيَّة للأبناء[26].
القدِّيس كيرلس الكبير
- واضح أن الإنسان يبغض قريبه حينما يحبه كنفسه. فإننا بحق نبغض نفوسنا عندما لا ننهمك في شهواتها الجسديَّة، بل نخضعها ونقاوم ملذّاتها. بالبغضة نجعل نفوسنا في حالة أفضل كما لو كنا نحبها بالبغضة (كراهية شرها)[27].
البابا غريغوريوس (الكبير)
- الله لا يريدنا أن نجهل الطبيعة (الحب الطبيعي العائلي) ولا أيضًا أن نُستعبد لها، وإنما نُخضع الطبيعة، ونكرم خالق الطبيعة، فلا نتخلى عن الله بسبب حبنا للوالدين.
القدِّيس أمبروسيوس
لقد أبرز هنا ما يعنيه السيِّد بوصيته هذه، قائلاً: “ومن لا يحمل صليبه، ويَّاتي ورائي، فلا يقدر أن يكون لي تلميذًا” [27]. فهو لا يطالبنا بطبيعة البغضة للآخرين، وإنما بقبول الموت اليومي عن كل شيء من أجل الله، فنحمل معه الصليب بلا انقطاع، لا خلال كراهيتنا للآخرين أو حتى أنفسنا، وإنما خلال حبنا الفائق لله الذي يبتلع كل عاطفة وحب!
يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم أن السيِّد لا يطالبنا أن نضع صليبًا من خشب لنحمله كل يوم وإنما أن نضع الموت نصب أعيننا، فنفعل كبولس الذي يحتقر الموت.
- نحن نحمل صليب ربَّنا بطريقتين، إما بالزهد فيما يخص أجسادنا أو خلال حنونا علي أقربائنا نحسب احتياجاتهم احتياجاتنا. ولما كان البعض يتنسكون جسديًا ليس من أجل الله، بل لطلب المجد الباطل، ويظهرون حنوًا لا بطريقة روحيَّة بل جسدانية لذلك بحق قال: “وتعال اتبعني”. فإن حمل الصليب مع تبعيَّة الرب يعني استخدام نسك الجسد والحنو علي أقربائنا من أجل النفع الأبدي[28].
البابا غريغوريوس (الكبير)
إن كان حمل الصليب هو نفقة صداقتنا الحقيقية مع السيِّد المسيح، فإنه يسألنا أن نحسب حساب النفقة، مقدَّما لنا مثلين: الأول من يبني برجًا يلزمه أن يحسب النفقة أولاً قبل أن يحفر الأساس، والملك الذي يحارب ملكًا آخر يراجع إمكانياته قبل بدء المعركة. صداقتنا مع السيِّد المسيح تحمل هذين الجانبين: بناء برج شاهق خلاله نلتقي بالسماوي لنحيا معه في الأحضان السماويَّة، والثاني الدخول في معركة مع إبليس الذي يقاوم أصدقاء المسيح، ولا يتوقف عن مصارعتهم ليسحبهم إلى مملكة الظلمة عوض مملكة النور.
أولاً: مثال بناء البرج
“ومن منكم وهو يربد أن يبني برجًا،
لا يجلس أولاً ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله،
لئلا يضع الأساس، ولا يقدر أن يكمل.
فيبتدئ جميع الناظرين يهزءون به،
قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني، ولا يقدر أن يكمل” [28-30].
- لنحسب حساب نفقة البرج الروحي الشاهق العلو، ونتعمق في ذلك مقدَّما بحرص… لنأخذ في اعتبارنا أولاً الأخطاء بصورة واضحة، فنحفر ونزيل الفساد ونفايات الشهوات حتى يمكننا أن نضع أساسات البساطة والتواضع القويَّة فوق التربة الصلبة التي لصدرنا الحيّ، أو بالحري توضع الأساسات علي صخر الإنجيل (6: 48)، بهذا يرتفع برج الفضائل الروحيَّة، ويقدر أن يصمد ويعلو إلى أعالي السماوات في آمان كامل ولا يتزعزع[29].
الأب اسحق
- الذين اختاروا السلوك في حياة مجيدة بلا لوم يلزمهم أولاً أن يخزنوا في ذهنهم غيرة كافيَّة، متذكرين القائل: “يا ابني إن أردت أن تخدم الرب أعدد نفسك لكل تجربة وليكن قلبك مستقيمًا وصبورًا” (ابن سيراخ 2: 1).أما من ليس لهم غيرة كهذه كيف يستطيعون بلوغ العلامة التي أمامهم؟![30]
القدِّيس كيرلس الكبير
- إذ أعطانا وصايا عاليَّة جدّا وسامية لذلك قدَّم لنا مثل بناء البرج… إن أردنا أن نبني برج التواضع، يلزمنا أولاً أن نهيئ أنفسنا ضد متاعب هذا العالم[31].
البابا غريغوريوس (الكبير)
- البرج هو برج مراقبة عالٍ لحراسة المدينة واكتشاف اقتراب الأعداء. هكذا بنفس الطريقة يليق بفهمنا أن يحفظ الصلاح ويحذِّر الشر[32].
القدِّيس باسيليوس الكبير
- يلزمنا أن نجاهد علي الدوام لنبلغ نهاية كل عمل صعب بالاهتمام المتزايد بوصايا الله، وبهذا نكمل العمل الإلهي. فإنه لا يكفي حجر واحد لعمل البرج، هكذا لا تكفي وصيَّة واحدة لكمال النفس، إنما يلزمنا أن نحفر الأساس وكما يقول الرسول نضع حجارة من ذهب وفضة وأحجار كريمة[33] (1 كو 3: 12).
القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص
ليتنا إذن ونحن نود أن تكون نفوسنا برجًا شامخًا يعلو نحو السماء، أو مقدَّسا للرب أن نجلس مع أنفسنا لنحسب النفقة، ألا وهي “الإيمان الحيّ العامل بالمحبَّة”. هذا الإيمان المعلن بحملنا لصليب الرب. هو يبدأ معنا العمل، لأننا إنما نحمل صليبه هو. وهو الذي يرافقنا طريق الصليب الكرب، لأنه قد اجتازه، وحده ولا يقدر أحد أن يعبر فيه ما لم يختفِ داخله. وهو الذي يكمل الطريق، رافعًا إيَّانا إلى بهجة قيامته.
بدون قبول الصليب نحمل اسم المسيح دون حياته فينا، ويكون لنا منظر الصليب دون قوَّته، لهذا تتطلع إلينا القوات الشرِّيرة وتهزأ بنا، قائلة: “هذا الإنسان ابتدأ يبني، ولم يقدر أن يكمل” [30]. وكما يقول القدِّيس كيرلس الكبير أن لنا أعداء كثيرين يودون الاستهزاء بنا، من أرواح شرِّيرة وناموس الخطيَّة وشهوات الجسد الخ.
ثانيًا: مثال الملك الذي يحارب
“وأي ملك أن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب
لا يجلس أولاً ويتشاور،
هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفًا.
وإلا فمادام ذلك بعيدًا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح.
فكذلك كل واحد منكم، لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذًا.
الملح جيد، ولكن إذ فسد الملح، فبماذا يصلح،
لا يصلح لأرض ولا لمزبلة، فيطرحونه خارجًا.
من له أذنان للسمع فليسمع” [31-35].
في مثال البرج تحدَّث عن حساب نفقة البناء، أي عن الجانب الإيجابي. فقد دُعينا إلى الصداقة الإلهيَّة لبناء نفوسنا كبرجٍ شامخٍ يرتفع إلى السماويات عينها، خلالها تتمتع البصيرة بالأمور التي لا تُرى. تدخل في خلوة مع الله لتتأمَّل أسرار محبَّته الفائقة، وتتعرف علي أمجاده في داخلها. هذا وبناء البرج كما رأينا إنما يعني خلال صداقتنا مع ربَّنا يسوع نصير به برجًا حصينًا، لا يقدر العدو أن يقتحم مقدَّسنا الداخلي، ولا يجد له فينا موضع راحة. فنقول مع السيِّد المسيح: “رئيس هذا العالم آتٍ، وليس له فينا شيء”! أما في مثال الملك، فيشير إلى صراع عدو الخير ضدنا، فهو إذ يرى برج حياتنا الداخليَّة يُبنى بالروح القدس ليتجلَّى رب المجد فيه، فترتفع نفوسنا إلى حضن الآب، يلتهب حسدًا وغيرة، ولا يتوقف عن محاربتنا بكل طرق الخداع ليحطم أعماقنا.
إن كان عدو الخير يصارع بكونه ملكًا يريد أن يقتنص الكل إلى مملكة الظلمة، فإننا كمؤمنين قد ارتبطنا بملك الملوك فصرنا “ملوكًا” (رؤ 1: 6)، أصحاب سلطان روحي، لنا إمكانية العمل بالروح القدس لكي نغلب بالمسيح الذي “خرج غالبًا ولكي يغلب” (رؤ 6: 2).
ودعوتنا للصداقة مع المسيح الغالب هي دعوة للغلبة به، والتمتع بالإكليل السماوي وشركة أمجاده، لذا يقول القدِّيس كيرلس الكبير:
[ماذا يعني هذا؟ “مصارعتنا ليست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحيَّة في السماويَّات” (أف 6: 12).
لنا نحن أيضًا إكليل كما بالغلبة علي أعداء آخرين: الفكر الجسداني، الناموس الثائر في أعضائنا، الشهوات بأنواع كثيرة: شهوة اللذة وشهوة الجسد وشهوة الغنى وغيرها، نصارع مع هذه كفرقة عنيفة من الأعداء.
كيف نغلب؟ بالإيمان “بالله نصنع ببأس، وهو يدوس أعدائنا” (مز 60: 12)… يحدثنا أحد الأنبياء القدِّيسين عن هذه الثقة، قائلاً: “هوذا السيِّد الرب يعينني، من هو الذي يعيرني؟!” (إش 50: 9 الترجمة السبعينيَّة)، ويترنم أيضًا داود الإلهي، قائلاً: “الرب نوري ومخلِّصي ممن أخاف؟! الرب عاضد حياتي ممن أجزع؟!” (مز 27: 1). هو قوتنا، وبه ننال النصرة، إذ يعطينا السلطان أن ندوس علي الحيات والعقارب وكل قوَّة العدو[34].]
- الملك هو الخطيَّة التي تملك علي أعضائنا (رو 6: 17، 25)، لكن فهمنا (الروحي) قد خُلق ملكًا، فإن أراد أن يحارب ضد الخطيَّة لينظر أن يعمل بكل ذهنه.
الأب ثيؤفلاكتيوس
إذ يخرج المسيحي الحقيقي للحرب الروحيَّة يلاقي بعشرة آلاف من يأتيه بعشرين ألفًا [31]، فإنه يمثل “القطيع الصغير” (12: 32) الذي يُسر الآب أن يعطيه ملكوت السماوات. يبدو في المظهر أقل وأضعف أمام مقاومة عدو الخير لكنه بقدر ما يترك “جميع أمواله” [33]، أي لا يتكل على ذاته، ولا بره الذاتي، ولا إمكانياتهن يصير ملحًا جيدًا يملح حتى الآخرين فلا يفسدوا.
يحمل المسيحي “عشرة آلاف”، لأن رقم 10 تشير للوصايا ورقم “1000” يشير إلى الفكر الروحي السماوي. فإنه يحارب بالمسيح يسوع سالكًا في الوصيَّة بالفكر السماوي. أما عدو الخير فيأتيه كملك له “عشرون ألفًا” إذ يحاربه بحروب روحيَّة (1000) خلال ضربة الشمال (10) وضربة اليمين (10)، تارة يثير فيه الشهوات كضربة شماليَّة، وأخرى يثير فيه البرً الذاتي كضربة يمينيَّة.
أما سّر الغلبة فهو ترك كل شيء [33]، ليكون الله هو الكل في الكل، والتسلَّح بالملح الجيد، أي الوصايا الإلهيَّة كما يقول القدِّيس كيرلس الكبير[35] التي هي لخلاصنا، فإن احتقرنا كلمة الله ووصاياه تتحول حياتنا إلى الفساد فلا نصلح لشيء. وقد سبق لنا الحديث عن الملح الجيد في شيء من التوسع[36].
[1] In Luc Ser 101.
[2] Quaest Evang 2: 29.
[3] In Luc Ser 102.
[4] Ser. On N.T. 32: 6.
[5] Catena Aurea.
[6] In 1 Thess. Hom.11.
[7] In Colos hom 1.
[8]In Colos hom 1.
[9] In Acts hom 45.
[10] In Luc. Ser.103.
[11] Instr. 2: 1.
[12] In Luc. Ser 104.
[13] In Luc Ser. 104.
[14] In Gal. hom 2: 20.
[15] Ser. On N.T. 62: 6.
[16] Ser. On N.T. 62: 6.
[17] In Luc 14: 1- 24.
[18] In Luc 14: 1- 24.
[19] In Evang. hom 36.
[20] Cassian: Conf 21: 9.
[21] Who is the Rich man …22.
[22] Ser. On N.T.62: 8.
[23] In Evang. hom 36.
[24] In Luc 14: 1- 24.
[25] In Luc. Ser 104.
[26] In Luc. Ser 105.
[27] In Evang. hom 37.
[28] In Evang. hom 37.
[29] Cassian: Conf. 2: 9.
[30] In Luc Ser 105.
[31] In Evang hom 37
[32] In Esai 1.
[33] De Virgin. 18.
[34] In Luc Ser 105.
[35] In Luc Ser 105.
[36] الإنجيل بحسب متى (مت 5: 13).