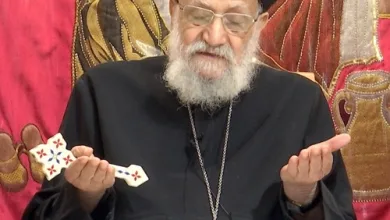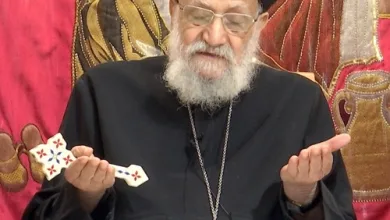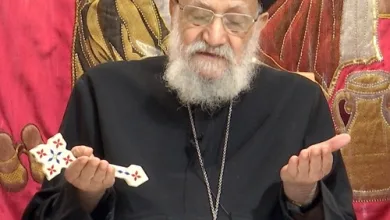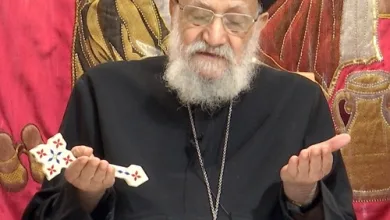تفسير انجيل لوقا 11 الأصحاح الحادي عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير انجيل لوقا 11 الأصحاح الحادي عشر - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير انجيل لوقا 11 الأصحاح الحادي عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير انجيل لوقا 11 الأصحاح الحادي عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الحادي عشر
العبادة الروحيَّة
إذ هو الصديق السماوي الروحي، لا نقدر إن نتقبله فينا وننعم بصداقته بطريق آخر غير العبادة الروحيَّة الحقيقية:
- الصلاة الربانيَّة 1-4.
- الصلاة بلجاجة 5-13.
- وحدة الروح (اتِّهامه ببعلزبول) 14-26.
- الصداقة وكلمة الله 27-28.
- الصداقة وآية يونان النبي 29-32.
- العين البسيطة 33-36.
- التطهير الداخلي والعبادة بالروح 37-54.
1. الصلاة الربانيَّة
حدَّثنا الإنجيلي عن دخول السيِّد المسيح بيت مريم ومرثا، فعبَّرت كل منهما عن محبَّتها له بطريق أو بآخر، انطلقت مرثا تخدمه بينما بقيت مريم جالسة عند قدميه تسمع كلامه (10: 39)، يلتهب قلبنا شوقًا للجلوس مع مريم عند قدميه باللقاء معه والصلاة. لهذا جاء الحديث التالي مركزًا على “الصلاة” يقول الإنجيلي: “وإذ كان يصلِّي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علِّمنا إن نصلِّي كما علَّم يوحنا أيضًا تلاميذه” [1].
بلا شك حَفظ التلاميذ الكثير من الصلوات من العهد القديم أو خلال التقليد اليهودي، لكن سؤال التلميذ: “يا رب علِّمنا إن نصلِّي” يكشف عما رآه التلاميذ في السيِّد المسيح وهو يصلِّي. أدركوا صورة جديدة لم يذوقوها من قبل في عبادتهم، فاشتهوا إن يحملوا ذات الفكر والروح الواحد.
مرَّة أخرى نقول إن أردنا إن يدخل الرب بيتنا ونخدمه كمرثا أو نتأمَّله كمريم فلا طريق للتمتَُّع باللقاء معه في الخدمة أو التأمُّل سوى الصلاة التي بها ننعم بحياة الكنيسة وكمالها على مستوى العمل والتأمُّل.
يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [إن كان السيِّد له كل الصلاح بفيض فلماذا يصلِّي مادام كاملاً ولا يحتاج إلى شيء؟ نجيب: يليق به حسب تدبير تجسُّده إن يمارس العمل البشري في الوقت المناسب. فإن كان قد أكل وشرب فبحق اعتاد إن يصلِّي، معلِّمًا إيَّانا ألا نكون متهاونين في هذا الواجب، بل بالأحرى مجتهدين وملتهبين في صلواتنا[1].] هذا وقد جاء رأسًا للكنيسة، يحملنا فيه كأعضاء جسده، إذ يصلِّي إنما يصلِّي نائبًا عنَّا ولحسابنا، حملنا بصلاته إلى حضن أبيه، وصارت صلواتنا مقبولة لدى الآب خلال ابنه موضع سروره. بمعنى آخر بصلاته قدَّس صلواتنا، وفتح لنا أبواب اللقاء مع الآب فيه.
إذ التهب قلب التلاميذ بحب الصلاة لما رأوه في السيِّد المصلِّي. بدأ يحدِّثهم عن الصلاة الربانيَّة، التي سبق لي الحديث عنها مستشهدًا بأقوال الآباء[2]، لهذا اَكتفي بعرضها في شيء من الاختصار مع اقتباس أقوال أخرى للآباء غير التي سبق لي نشرها.
“فقال لهم: متى صليَّتم فقولوا:
أبانا الذي في السماوات” [2].
لا نستطيع إن نصلِّي كما ينبغي ما لم ندرك أولاً مركزنا بالنسبة له، فقد اختارنا أبناء الله، نحدِّثه من واقع بنوَّتنا التي نلناها كهبة مجانيَّة في مياه المعموديَّة بالرغم من شعورنا أننا لا نستحق إن نكون عبيدًا له. فيما يلي بعض تعليقات للآباء علي هذه العبارة:
- يا لعظمة حب الله للبشر! فقد منح الذين ابتعدوا عنه وسقطوا في هاوية الرذائل غفران الخطايا، ونصيبًا وافرًا من نعمة، حتى أنهم يدعونه أبًا: “أبانا الذي في السماوات”. السماوات هي أيضًا هؤلاء الذين يحملون صورة العالم السماوي، والذي يسكن الله فيهم ويقيم[3].
القدِّيس كيرلس الأورشليمي
- حين تبدأ الصلاة اِنسى كل خليقة منظورة وغير منظورة، وابدأ الصلاة بمدح الله خالق الكل، لذلك قيل: “فقال لهم متى صلَّيتم فقولوا أبانا[4]“.
القدِّيس باسيليوس الكبير
- اُنظر أي إعداد عظيم تحتاجه لكي تستطيع إن تقول بدالة “أبانا”. فإن كانت عيناك مركَّزتين علي الأرضيَّات وتطلب مجد الناس ومستعبدة لشهواتك، فإن نطقتَ بهذه الصلاة يبدو لي إن الله يجيبك: “ما دمت تحمل الحياة الفاسدة فلتدعو الفساد أبًا لك، إنك تُدنِّس بشفتيك النجستين الاسم الذي لا يتدنَّس”. لقد أوصاك إن تدعوه أبًا فلا تنطق كذبًا[5].
القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص
- تبدأ الصلاة بالشهادة عن الله (كأب لنا) كأنها مكافأة عن الإيمان… لقد وُضعت (هذه الصلاة) للذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا إن يصيروا أولاد الله (يو 1: 12). على أي الأحوال غالبًا ما يعلن الرب عن الله (الآب) كأب لنا، وقد أعطانا وصيَّة ألا ندعو لنا أبًا علي الأرض، بل الآب الذي في السموات (مت 23: 9)، فبهذه الصلاة نطيع الوصيَّة.
مطوَّبون هم الذين يعرفون أباهم! وقد وجَّه هذا التوبيخ ضد إسرائيل إذ يُشْهد الروح السماء والأرض، قائلاً: “ربَّيْتُ بنين ولم يعرفونني” (إش 1: 2)…
عندما نذكر الآب نستدعي أيضًا الابن، إذ يقول: “أنا والآب واحد” (يو 10: 30)، وأيضًا لا نتجاهل الكنيسة أُمِّنا، إذ تُعرف الأم خلال الآب والابن، وخلالها يظهر اسم كل من الآب والابن.
بتعبير واحد عام، أو بكلمة، نحن نكرم الآب مع ابنه… ونذكر الوصيَّة، ونضع علامة للذين نسوا أبيهم[6].
العلامة ترتليان
- [إذ نصلِّي لله أبينا يليق بنا ألا ننشغل بغيره، لا بخليقة أرضيَّة ولا أرواح شرِّيرة أو حتى ملائكة.]
كان قدِّيس آخر يعيش حياة الوحدة في البرِّيَّة، هاجمته الشيَّاطين وأحاطت به لمدة أسبوعين، يتقاذفونه في الهواء ويتلَّقونه علي حصيرة، لكنهم باطلاً حاولوا إن يسحبوه من صلاته الملتهبة.
وجاء ملاكان إلى آخر كان محبَّا لله، مكرِّسًا حياته للصلاة، فإذ كان سائرًا في البرِّيَّة وقد رافقاه في رحلته، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، لكنه لم يلتفت إليهما لئلاَّ يفقد ما هو أفضل، واضعًا في ذهنه نصيحة الرسول بولس “لا ملائكة ولا رئاسات ولا قوات تقدر إن تفصلنا عن محبَّة المسيح” (رو 8: 38).
بالصلاة الحقيقيَّة يصير الراهب ملاكًا آخر، إذ يتوق لرؤية وجه الآب في السموات في غيرة متَّقدة.
- من يحب الله يحيا معه ويصلِّي إليه علي الدوام كأب، متجرِّدًا من كل فكر هوَى[7].
الأب أوغريس
“ليتقدَّس اسمك” [2].
يرى العلامة أوريجينوس إن الوثنيِّين يُجدّفون على اسم الله إذ ينسبونه للأصنام، وكأن الصلاة هنا هي صرخة الكنيسة لله إن ينزع العبادة الوثنيَّة عن العالم ليُعرف اسمه مقدَّسا في كل البشريَّة. بنفس المعني يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [إذ يُزدرى باسم الله بين الذين لم يؤمنوا به بعد، فإنه عندما تشرق أشعَّة الحق عليهم يعترفون بقدُّوس القدِّيسين.]
على أي الأحوال إن كان اسم السيِّد المسيح يمجد الآب، فإننا إذ نقتني اسمه بالحق فينا يتقدَّس اسم الآب في حياتنا ويتمجَّد فينا، فمن كلمات الآباء في هذا الشأن:
- كما إذ تطلَّع إنسان إلي جمال السماوات يقول: المجد لك يا رب، هكذا من ينظر أعمال إنسانٍ فاضلٍ يرى فضيلته تمجِّد الله أكثر من السماوات[8].
القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
- اسم الله مقدَّس بطبيعته، إن قلنا أو لم نقل، لكن بما أن اسم الله يُهينه الخطاة كما هو مكتوب: “اسمي يُجدَّف عليه بسببكم بين الأمم” (رو 2: 24؛ إش 52: 5)، فنحن نطلب إن يتقدَّس اسم الله فينا، لا بمعنى إن يصبح مقدَّسًا، كأنه لم يكن مقدَّسا فينا نحن الذين نسعى إلى تقديس أنفسنا وممارسة الأعمال اللائقة بتقديسنا[9].
القدِّيس كيرلس الأورشليمي
يري العلامة ترتليان[10] إن عمل الملائكة هو الترنُّم بتسبحة الثلاث تقديسات: “قدُّوس، قدُّوس، قدُّوس” (إش 6: 3، رؤ 4: 8)، ونحن أيضًا إذ نقدس اسمه نرتفع إلى الله لنمارس شركة المجد العتيد، نشارك السمائيِّين تسابيحهم.
إن كان السيد المسيح يمجد اسم الآب (يو 17: 6)، فإننا إذ نثبت فيه ونمارس حياته يتمجَّد الآب بابنه الحال فينا.
“ليأت ملكوتك” [2].
- يليق بالنفس الطاهرة إن تقول بثقة “ليأت ملكوتك“، لأن الذي يسمع بولس يقول: “لا تملُكن الخطيَّة في جسدكم المائت” (رو 6: 12)، يعمل علي تطهير نفسه بالفعل والفكر والقول، ويستطيع القول: “ليأت ملكوتك[11]“.
القدِّيس كيرلس الأورشليمي
- نسأل أيضًا الرب إن يُخلِّصنا من الفساد لينزع الموت أو كما قيل “ليأت ملكوتك“، أي ليحل الروح القدس علينا ويطهرنا.
القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص
- الذين ينطقون بهذا يبدو أنهم يرغبون في مخلِّص العالم إن ينير العالم مرَّة أخرى.
القدِّيس كيرلس الكبير
- رغبتنا هي إن يُسرع ملكنا بالمجيء فلا تمتد عبوديَّتنا (في هذا العالم[12]).
العلامة ترتليان
إن كان الشهداء يتعجَّلون مجيء الرب لوضع حد للشرّ، قائلين: “حتى متى أيها السيِّد القدُّوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين علي الأرض؟” (رؤ 6: 10)، فإن المؤمنين وقد انفتح أمامهم باب السماء وأدركوا نصيبهم في الميراث الأبدي يتعجلون مجيئه الأخير لينالوا هذا المجد الأبدي.
“لتكن مشيئتك، كما في السماء، كذلك علي الأرض” [2].
- ملائكة الله الطوباويون الإلهيون يصنعون مشيئة الله كما يرنَّم داود قائلاً: “باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوَّة، الفاعلين كلمته” (مز 103: 20) فعندما تُصلِّي بقوَّة تود القول: كما تتم مشيئتك في ملائكتك، فلتتم هكذا فينا نحن علي الأرض يا رب[13].
القدِّيس كيرلس الأورشليمي
- كأنه يقول: اجعلنا يا رب قادرين إن نتبع الحياة السماويَّة، فنريد نحن ما تريده أنت.
القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
- إذ قيل إن حياة الإنسان بعد القيامة ستكون كحياة الملائكة، وجب علينا إن ندبِّر حياتنا في هذا العالم بوقارٍ، حتى أننا ونحن نعيش بعد في الجسد لا نسلك حسب الجسد. هنا يحطِّم طبيب النفوس طبيعة المرض، إذ صار الممسَكون في المرض هاربين من الإرادة الإلهيَّة، لذلك فإنهم يبرأون منه بارتباطهم بهذه الإرادة الإلهيَّة. صحَّة النفس هي تتميم إرادة الله اللائقة[14].
القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص
- نحن نصلِّي إن تتم مشيئته في الكل. من الجانب الرمزي تفسر: “كما في الروح كذلك في الجسد”، فإننا نحن سماء وأرض[15].
العلامة ترتليان
“خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم” [3].
يوصينا الرب أن نطلب حتى الأمور الخاصة بإشباع الجسد من الله، إذ هو أبونا الذي يهتم بنفوسنا كما بأجسادنا. لكنه يسألنا لا إن نطلب ترف الجسد وتدليله إنما الكفاف، لكي يسندنا الجسد حتى نتمم رسالتنا.
يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [ربَّما يظن البعض أنه لا يليق بالقدِّيسين إن يطلبوا من الله الجسديَّات، لهذا يعطون لهذه الكلمات مفاهيم روحيَّة، لكن وإن كان يليق بالقدِّيسين أن يعطوا الاهتمام الرئيسي للروحيات لكنهم يطلبون بلا خجل خبزهم العام كوصيَّة الرب. في الحقيقة يسألهم إن يطلبوا خبزًا، أي طعامًا يوميًا، وفي هذا دليل أنهم لا يملكون شيئًا بل يمارسون الفقر المكرم، فإنه لا يطلب الخبز من كان لديه خبزًا بل من هو في عوز إليه.]
ويرى القدِّيس باسيليوس إن هذه الصلاة التي علَّمنا إيَّاها السيِّد تعني التزامنا بالالتجاء لله، لنخبره كل يوم عن احتياجات طبيعتنا اليوميَّة.
ويرى كثير من الآباء هذا الخبز اليومي هو “المسيح” يسوع ربَّنا، الذي ننعم به كخبز سماوي يومي، بدونه تصير النفس في عوَز. يقول العلامة ترتليان: [المسيح هو خبزنا، لأنه هو الحياة، والخبز هو الحياة. يقول السيِّد: “أنا هو خبز الحياة” (يو 6: 35)، يسبق ذلك قوله: “خبز الله هو (كلمة الله الحيّ) النازل من السماء” (يو 6: 33). جسده أيضًا يُحسب خبزًا[16].]
ويرى القدِّيس أغسطينوس إن هذا الخبز اليومي هو التمتُّع بقيامة السيِّد المسيح، لكي نختبر كل يوم قوَّة قيامته عاملة فينا.
“واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضًا نغفر لكل من يُذنب إلينا” [4].
- الإساءات إلينا صغيرة وطفيفة، ومن السهل علينا إن نغفرها، أما إساءتنا نحن نحو الله فكبيرة ولا سبيل لنا غير محبَّته للبشر، فاحذر إذن من إن تمنع الله – بسبب ما لحق بك من إساءات صغيرة طفيفة – إن يغفر لك ما ارتكبته نحوه من ذنوب كبيرة[17].
القدِّيس كيرلس الأورشليمي
- الطلبة للمغفرة مملوءة اعترافًا، فإن من يسأل الغفران إنما يعترف بجريمته[18].
العلامة ترتليان
- حتى يوسف حين صرف إخوته لإحضار أبيهم قال لهم: “لا تتغاضبوا في الطريق” (تك 45: 24 الترجمة السبعينيَّة). هكذا يحذِّرنا مؤكِّدًا لنا أنه يليق بنا إذ نكون في طريق الصلاة ألا نذهب إلى الآب غاضبين.
- أي تهوُّر، إن تقضي يومًا بدون صلاة عندما ترفض التصالح مع أخيك، أو تحتفظ بالغضب فتخسر صلاتك؟
- كل عمل انتقامي تأتيه ضِد أخ أذاك، سيكون لك حجر عثْرة عند الصلاة[19].
الأب أوغريس
- الحقد يعمي عقل المُصلِّي، ويغلِّف صلاته بسحابة ظلام.
- ليس أحد يحب الصلاة الحقيقية ويعطي لنفسه مجالاً للغضب أو الحقد… فإنه يشبه إنسانًا يريد إن يكون ذا نظر ثاقب ويقلع عينيه[20].
الأب أوغريس
“ولا تُدخلنا في تجربة” [4].
- ربَّما تعني: لا تدع التجربة تغمرنا وتجرفنا باعتبار التجربة سيلاً عارمًا يصعب اجتيازه، فالذين لا تغمرهم التجربة يجتازون السيل كالسبَّاحين الماهرين الذين لا يتركون التيَّار يجرفهم[21].
القدِّيس كيرلس الأورشليمي
- لا يليق بنا إن نطلب الضيقات الجسديَّة في صلواتنا، إذ يأمر المسيح البشر بوجه عام إن يصلُّوا كي لا يدخلوا في تجربة، لكن إن دخل أحد فعلاً فيلزمه إن يطلب من الرب قوَّة اِحتمال لتتحقِّق فينا الكلمات: “الذي يصبر إلى المنتهي فهذا يخلُص” (مت 10: 22)[22].
القدِّيس باسيليوس
يميِّز العلامة ترتليان[23] بين التجربة التي هي بسماح من الله، وهي لا تعني “تجربة” بالمفهوم العام إنما “امتحان” لأجل تزكيتنا، أما عدو الخير فيجُرِّبنا بمعنى أنه يخدعنا، وكأننا نصلِّي ألا ندخل في تجربة بمعنى أن يسندنا ضد حِيَل إبليس وخداعاته.
” لكن نجِّنا من الشرِّير” [4].
- لو كانت عبارة: “لا تدخلنا في تجربة” تعني ألا نُجرَّب أبدًا، لما أضاف الرب “لكن نجِّنا من الشرِّير“. الشرِّير هو عدوُّنا إبليس، ونحن نطلب النجاة منه[24].
القدِّيس كيرلس الأورشليمي
أخيرًا فإن العلامة ترتليان[25] يؤكِّد إن الصلاة الربَّانيَّة هي الأساس الذي وضعه السيِّد المسيح لصلواتنا؛ تفتح لنا بابًا للصلاة لكي يطلب كل منَّا ما يناسبه لكن خلال ذات الفكر الذي لهذه الصلاة. هذا وأن الصلاة الربَّانيَّة مع صِغر حجمها تحوي الكثير، ألا وهو:
[مجد الله بالقول: “أبانا”،
شهادة الإيمان بالقول: “يتقدَّس اِسمك”،
تقديم الطاعة في “لتكن مشيئتك”،
تذكار الرجاء في “خبزنا كفافنا”،
المعرفة الكاملة لخطايانا (لديوننا) خلال الصلاة من أجل نوال المغفرة.
الرعب الشديد من التجربة بطلب الحماية.
يا للعجب! الله وحده يقدر إن يعلِّمنا بنفسه ما يريدنا إن نصلِّيه[26].]
- 2. الصلاة بلجاجة
إن كان السيِّد قد قدَّم لنا نموذجًا حيًا للصلاة، فإنه إذ يطلب منَّا العبادة الملتهبة بالروح، سألنا إن نصلِّي بلجاجة، ليس لأنه يستجيب لكثرة الكلام، وإنما ليُلهب أعماقنا نحو الصلاة بلا انقطاع. يشتاق الله إن يعطي، وهو يعرف اِحتياجاتنا واِشتياقاتنا الداخليَّة، لكنه يطالبنا باللجاجة لنتعلَّم كيف نقف أمامه وندخل معه في صلة حقيقيَّة.
يقول الأب إسحق: [الله في اشتياقه إن يهبنا السماويات والأبديَّات يحثُنا إن نضغط عليه بلجاجتنا. أنه لا يحتقر اللجاجة، ولا يستخف بها، بل بالفعل يُسر بها ويمدحها[27].] ويقول القدِّيس أغسطينوس: [ما كان ربَّنا يسوع المسيح الذي في وسطنا يسألنا إن نطلب من الله كعاطي، يحثُّنا هكذا بقوَّة إن نسأل، لو لم يرد إن يعطي. إنه يُخجل تهاوننا، إذ يود إن يعطي أكثر من رغبتنا نحن في الأخذ. يود إن يُظهر رحمة أكثر من رغبتنا نحن في الخلاص من البؤس… الحث الذي يقدِّمه لنا إنما هو لأجلنا[28].] ويقول الأب أوغريس: [إن كنت لم تنل بعد موهبة الصلاة أو التسبيح فكن لجوجًا فتنل[29].] ويقول القدِّيس كيرلس الكبير: “علِّمنا المخلِّص من قبل في إجابته على سؤال تلاميذه كيف ينبغي علينا إن نصلِّي. ولكن ربَّما يمارس الذين يتقبُّلون هذا التعليم الصلاة بنفس الشكل الذي قدَّمه الرب، وإنما بإهمال وفتور، فإن لم يُسمع لهم في الصلاة الأولى والثانية يتركون الصلاة. ربَّما يكون هذا هو حالنا، لذلك يقدِّم لنا السيِّد هذا المثل ليعلن لنا إن التخوُّف في الصلاة مضِر، وأما الصبر فنافع جدًا.]
قدَّم لنا الرب هذا المثل:
“من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له:
يا صديق اِقرضني ثلاثة أرغفة.
لأن صديقًا لي جاءني من سفر، وليس لي ما أقدِّم له.
فيجيب ذلك من داخل، ويقول:
لا تزعجني، الباب مغلق الآن،
وأولادي معي في الفراش،
لا أقدر إن أقوم وأعطيك.
أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه،
فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج” [5-8].
ويلاحظ في هذا المثال الآتي:
أولاً: إن كان غاية هذا المثَل الأولى هي حثِّنا على اللجاجة في الصلاة حتى ننعم بطلبتنا، فإننا نلاحظ هنا إن السيِّد المسيح يقدِّم الأب صديقًا للبشريَّة، إذ يقول: “من له صديق ويمضي إليه نصف الليل”. يقول الأب ثيوفلاكتيوس: [الله هو ذاك الصديق الذي يحب كل البشريَّة ويريد إن الكل يخلُصون”. ويقول القدِّيس أمبروسيوس: [من هو صديق لنا أعظم من ذاك الذي بذل جسده لأجلنا؟ فمنه طلب داود في نصف الليل خبزات ونالها، إذ يقول: “في نصف الليل سبَّحتك على أحكام عدلك” (مز 119: 62)، نال هذه الأرغفة التي صارت غذاء له. لقد طلب منه في الليل: “أُعوِّم كل ليلة سريري” (مز 6: 6)، ولا يخش لئلاَّ يوقظه من نومه إذ أنه عارف إن (صديقه الإلهي) دائم السهر والعمل. ونحن أيضًا فلنتذكَّر ما ورد في الكتب ونهتم بالصلاة ليلاً ونهارًا مع التضرُّع لغفران الخطايا، لأنه إن كان مِثل هذا القدِّيس الذي يقع على عاتقه مسئوليَّة مملكة كان يسبِّح الرب سبع مرَّات كل يوم (مز 119: 164)، ودائم الاهتمام بتقدِّمات في الصباح والمساء، فكم بالحري ينبغي علينا إن نفعل نحن الذين يجب علينا إن نطلب كثيرًا من أجل كثرة سقطاتنا بسبب ضعف أجسادنا وأرواحنا حتى لا ينقصنا لبنياننا كسرة خبز تسند قلب الإنسان (مز 103: 15)، وقد أرهقنا الطريق وتعبنا كثيرًا من سبل هذا العالم ومفارق هذه الحياة[30].]
كأن السيِّد المسيح يطالبنا إن نلجأ إليه كصديق إلهي حقيقي، في كل وقت، حتى في منتصف الليل، نتوسَّل إليه ليمدِّنا بالخبز السماوي المشبع للنفس والجسد.
ثانيًا: إن كان الله يقدِّم نفسه صديقًا لنا نسأله في منتصف الليل ليهبنا خبزًا سماويًا من أجل الآخرين القادمين إلينا أيضًا في منتصف ليل هذا العالم جائعين، فإن السيِّد حسب هؤلاء أيضًا أصدقاء لنا؛ فنحن نطلب من الصديق الإلهي لأجل أصدقائنا في البشريَّة. يرى القدِّيس أغسطينوس[31] إن هذا الصديق القادم من الشارع أي من العالم، قادم إلينا كما من طريقه الشرِّير، مشتاقًا إن يتمتَّع بالحق، فلا نستطيع إن نستضيفه ونشبعه ما لم نسأل الله أولاً فنتأهَّل للتمتُّع بالثلاث خبزات، أي بالإيمان الثالوثي.
ثالثًا: إن كان الشخص قد جاء إلى صديقه في منتصف الليل يطلب من أجل صديقه الذي قدُم إليه من سَفر، أمَا كان يكفي إن يسأل رغيفًا واحدًا أو يطلب رغيفين، فلماذا طلب ثلاثة أرغفة؟
أ. إننا إذ نلتقي بعريسنا المخلِّص وسط هذا العالم بتجاربه الشرِّيرة، كما لو كنا في نصف الليل، نطلب لأنفسنا كما للآخرين ثلاثة أرغفة لكي تشبع أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا؛ فالله وحده هو المُشبع للإنسان لكل كيانه. وكما يقول الأب ثيؤفلاكتيوس بطريرك بلغاريا: [نطلب من الله ثلاث خبزات، أي اشباع احتياجات جسد الإنسان ونفسه وروحه، فلا يصيبنا خطر في تجاربنا.]
هنا ندرك الفهم الإنجيلي للحياة المقدَّسة أو للعفَّة، فالإنسان العفيف أو المقدَّس في الرب لا يعيش في حرمان، إنما يتقبَّل من يديّ الله ما يُشبع حياته كلها ويرويها، فتفرح نفسه وتتهلَّل روحه، ويستريح أيضًا جسده حتى وإن عانى أتعاب كثيرة من أجل الرب. لهذا كان المعمَّدون حديثًا في الكنيسة الأولى ينشدون بعد عمادهم مباشرة هذا المزمور: “الرب راعيّ فلا يعْوِزني شيء، في مراعٍ خضر يربضُني، وإلى مياه الراحة يورِدني، يرُد نفسي، يهديني إلى سبل البرّ…”
ب. يرى القدِّيس أغسطينوس إن هذه الخبزات الثلاث هي إيماننا الثالوثي، فإن أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا لن تشبع داخليًا إلا بالثالوث القدُّوس، ثالوث الحب الذي يملاْ الداخل ويفيض علينا بالطوباويَّة، إذ يقول:
[من كان وسط التعب يلزمه إن يسأل الله فينال فهم الثالوث، به يستريح من متاعب هذه الحياة الحاضرة. فإن ضيقته هي نصف الليل التي تدفعه نحو طلب الثالوث. لنفهم الثلاث خبزات الثالوث الذي هو جوهر واحد…
حينما تنال الثلاث خبزات، أي طعام معرفة الثالوث، يكون لك مصدر الحياة والطعام، فلا تخف، ولا تتوقَّف، فإن هذا الطعام بلا نهاية، إنما يضع نهاية لعوزك. تعلَّم وعلِّم، عش واِطعِم[32].]
في موضع آخر يقول: [ما هذه الخبزات الثلاث إلا طعام السرّ السماوي؟[33]]
وفي شيء من التفصيل أيضًا يقول: [الآن لا حاجة للخوف من قدوم غريب إليك من طريقه، وإنما باستضافتك له في الداخل يمكنك إن تجعله مواطنًا وابنًا للبيت، لا تخف فإن الخبز لن ينتهي. الخبز هو الله الآب والابن والروح القدس… تعلَّم وعلِّم، عش واِطعم الآخرين. الله هو الذي يعطيك، لا يعطيك أفضل من ذاته. أيها الطمَّاع ماذا تطلب بعد؟[34]]
ج. يرى أيضًا القدِّيس أغسطينوس في هذه الخبزات الثلاث عطايا الله الفائقة للبشريَّة، ألا وهي الإيمان والرجاء والمحبَّة، إذ يقول: [من الضروري إن تأخذ محبَّة وإيمانًا ورجاءً، فإن ما يعطيه لك يكون لك حلوًا. هذه الأمور ـ الإيمان والرجاء والمحبَّة ـ ثلاثة، وهي عطايا الله، فإنك تتقبَّل الإيمان من الله، إذ قيل: “كما قسَّم الله لكل واحدٍ مقدارًا من الإيمان” (رو 12: 3). وأيضًا الرجاء نتقبَّله من ذاك الذي قيل له: “جعلتني أترجَّاه” (مز 118: 49). ومنه نتقبَّل المحبَّة، إذ قيل: “لأن محبَّة الله قد اِنسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا” (رو 5: 5)[35].]
رابعًا: يقول السيِّد: “فيجيب ذلك من داخل، ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن، وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك” [7].
يصوِّر لنا السيِّد المسيح هذا الصديق أنه يجيب من داخل، لا يخرج إليه مع إن الوقت حرج، وكان يليق بالصديق إن يفتح ليطمئن على القارع؛ وفي إجابته يعلن أن تصرُّف هذا السائل أو القارع مزعج، وأن الباب مغلق، وأولاده في الفراش، وأنه عاجز عن القيام والعطاء. ومع هذا استطاع صديقه بلجاجته أن يغتصب منه طلبه! فكم بالأكثر الله يهب سائليه إن طلبوا بإلحاح، علامة صدق طلبهم، خاصة وأن الله ليس كهذا الصديق يجيب من داخل، بل خرج إلينا خلال التجسَّد، وجاءنا كلمة الله حالاً في وسطنا، يحدِّثنا فمًا لفمٍ، نازعًا الحجاب الحاجز بين السماء والأرض. وهكذا لم يعد بعد الباب مغلقًا بل هو مفتوح للجميع، يريد إن الجميع يخلُصون وإلى معرفة الحق يُقبلون. أولاده ليس معه في الفراش، إذ هو لا ينام وملائكته وقدِّيسوه أيضًا يسهرون، عاملين بصلواتهم وتضرُّعاتهم من أجل النفوس التائهة والمحتاجة. لا يقول الرب: “لا أقدر إن أقوم وأعطيك”، إذ قام الرب من الأموات وأعطانا حياته المُقامة عاملة فينا!
هكذا قدَّم لنا الرب صورة مؤلمة للصديق البشري، الذي ننال منه طلباتنا خلال اللجاجة، بالرغم من الظروف المقاومة، فكم بالأكثر ننال من الرب نفسه؟
يقول القدِّيس أغسطينوس: [إن كان الشخص النائم التزم إن يعطي قسرًا بعد إزعاجه من نومه لذاك الذي يسأله، فكم بالحري إن يُعطى بأكثر حنو ذاك الذي لا ينام، بل ييقظنا من نومنا لكي نسأله إن يعطينا؟[36]]
لعلَّ قوله: “الباب مغلق الآن” يشير إلى إغلاق باب فهمنا عن إدراكه، فإن الله لا يريد بابًا مغلقًا يحجب أعماقنا عن الالتقاء معه، لكننا نحن نُحكم إغلاق الباب خلال عِصياننا وجهلنا لأعماله الخلاصيَّة. يقول القدِّيس أوغسطينوس: [الوقت الذي يُشار إليه هنا هو وقت مجاعة الكلمة حين يُغلَق الفهم، والذين يوزِّعون حكمة الإنجيل كخبزٍ، خلال الكرازة في العالم الآن هم في مواضع راحة مع الرب.]
فإن كان العالم قد أغلق الباب بعصيانه، فإن عمل الكنيسة إن تطلب ليفتح الرب هذا الباب للكارزين، حتى ينطلقوا بالنفوس إلى حيث الراحة والشبع في الرب.
يقول القدِّيس أمبروسيوس: [اِطرح عنك نوم الغفلة لتقرع باب المسيح. لقد طلب بولس إن يُفتح له هذا الباب ليتكلَّم عن سِرّ المسيح (كو 3: 4)، ربَّما هذا هو الباب الذي رآه يوحنا مفتوحًا: “بعد هذا نظرت، وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلَّم معي قائلاً: اِصعد إلى هنا، فأُريك ما لابد إن يصير بعد هذا” (رؤ 4: 1) فُتح الباب ليوحنا وأيضًا لبولس لينالا من أجلنا أرغفة لغذائنا، لأنهما ثابَرَا وقرعا الباب في وقت مناسب ووقت غير مناسب (2 تي 4: 2)، ليُعيد الحياة للأمم الذين تعِبوا وأُرهَقوا من طريق العالم بوفرة الغذاء السماوي[37].]
خامسًا: يحثُّنا ربَّنا يسوع على الصلاة بلجاجة، إذ يختم المثَل بقوله: “أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اِسألوا تعطوا، اُطلبوا تجدوا، اِقرعوا يفتح لكم” [8-9].
يقول القدِّيس أغسطينوس: [ماذا يعني بقوله: لأجل لجاجته؟ لأنه لم يكف عن القرع، ولا رجع عندما رُفض طلبه… قد يبطئ الله أحيانًا في إعطائنا بعض الأمور، لكي يُعرِّفنا قيمة هذه الأشياء الصالحة، وليس لأنه يرفض إعطاءها لنا. الأمور التي نشتاق إليها كثيرًا ما ننالها بفرحٍ عظيم، أما التي توهب لنا سريعًا فإنها تُحسب زهيدة. إذن لتسأل وتطلب وتلح، فبالسؤال نفسه والطلب أنت نفسك تنمو فتنال أكثر[38].] كما يقول: [بالصلاة التي نمارسها خلال الطلبات التي نشتهيها ننال ما هو مستعد أن يمنحه. عطاياه عظيمة جدًا لكننا نحن صغار وضيِّقون في إمكانيَّاتنا عن أن ننالها[39].]
يقول القدِّيس باسيليوس: [ربَّما يؤخِّر الطلبة عن عمد لكي تضاعف غيرتك ومجيئك إليه، ولكي تعرف ما هي عطيَّة الله، وتحرص عليها بشغف عندما تنالها. ما يناله الإنسان بتعبٍ شديدٍ يجاهد على حفظه لئلاَّ بفقده يفقد تعبه أيضًا[40].]
لماذا يقول: [اِسألوا… اُطلبوا… اِقرعوا]؟
أ. ربَّما للتأكيد، فإنه يلحْ علينا أن نسأل ونطلب ونقرع، لأنه يريد أن يعطينا، وكما يقول القدِّيس أغسطينوس: [ما كان يشجِّعنا هكذا أن نسأله لو لم يرد أن يعطينا. ليُنزع عنَّا الكسل البشري فإنه يود أن يعطينا أكثر مما نسأل[41].]
يقول القدِّيس باسيليوس: [يليق بنا أن نسأل العون الإلهي لا بكسلٍ ولا بفكر مشتَّت هنا وهناك، فإن إنسانًا كهذا ليس فقط لا ينال ما يسأله، بل بالحري يُغضب الله، لو أن إنسانًا يقف أمام رئيس تكون عيناه ثابتتين في الداخل والخارج حتى لا يتعرَّض للعقوبة، فكم بالحري يليق بنا أن نقف أمام الله بحرص ورعدة؟ لكنك إن كنت تُثار بخطيَّة ما، فلا تقدر أن تُصلِّي بثبات بكل قوِّتك. راجع نفسك حتى متى وقفت أمام الله تركِّز فكرك فيه، والله يغفر لك، لأنك ليس عن إهمال بل عن ضعف لم تستطع إن تظهر أمامه كما ينبغي. إن ألزمت نفسك بهذا فإنك لا تتركه حتى تنال. فإن لم تنل ما تسأله يكون ذلك لأن سؤالك غير لائق أو بغير إيمان، أو لأنك قدَّمته باستهانة، أو تسأل أمورًا ليست بصالحك، أو لأنك تركت الصلاة. كثيرًا ما يسأل البعض لماذا نصلِّي؟ هل يجهل الله ما نحتاج إليه؟ أنه بلا شك يعرف ويعطينا بفيض كل الزمنيَّات حتى قبل أن نسألها، لكن يجب علينا أولاً أن نطلب الصالحات وملكوت السماوات، عندئذ ننال ما نرغب لنسأل بإيمان وصبر، نسأل ما هو صالح لنا، ولا نعوق الصلاة بعصيان ضميرنا[42].]
ب. لعلَّ التكرار ثلاث مرات: اِسألوا، اُطلبوا، اِقرعوا، يعني أننا لا نسأله فقط بأفكارنا أو نيَّاتنا الداخليَّة، وإنما أيضًا بشفاهنا كما بأعمالنا. وكأنه يليق أن تنطلق صلواتنا خلال تناغم الفكر مع الشفتين والسلوك، فتخرج رائحة بخور مقدَّسة من أعماق مقدَّسة وكلمات مباركة وأعمال مرضيَّة لدى الله. لعلَّه بفكر مشابه يقول القدِّيس ساويرس الأنطاكي: [ربَّما يعني بكلمة “اِقرعوا” اُطلبوا بطريقة فعّالة، فإن الإنسان يقرع باليد، واليد هي علامة العمل الصالح. وربَّما التمايز بين الثلاثة يكون بطريقة أخرى، ففي بداية الفضيلة نسأل معرفة الحق، أما الخطوة الثانية فهي أن نطلب كيف نسلك هذا الطريق. والخطوة الثالثة عندما يبلغ الإنسان الفضيلة يقرع الباب ليدخل حقل المعرفة المتَّسعة. هذه الأمور الثلاثة كلها يطلبها الإنسان بالصلاة. وربَّما “يسأل” تعني “يصلِّي“، و”يطلب” تعني “يصلِّي بواسطة الأعمال الصالحة التي نمارسها بطريقة تتناسب مع صلواتنا”، و “نقرع” تعني الاستمرار في الصلاة بلا انقطاع.]
بمعنى أخر إن السؤال والطلب والقرع إنما يعني وِحدة الصلاة مع الحياة العمليَّة في الرب، نسأل أن يبدأ معنا، ونطلب إليه إن يكمِّل الطريق، ونقرع لكي ينهي جهادنا بالمجد الأبدي، فهو البداية والنهاية كما أنه هو المرافق لنا وسط الطريق، أو بمعنى أدَق هو طريقنا: به نبدأ وبه نستمر وبه نكمِّل.
ولكي يشجِّعنا السيِّد المسيح على السؤال والطلب والقرع، كشف حقِّنا البنوي في الطلب، فمن حقِّنا كأبناء أن نطلب من أبينا ونأخذ، إذ يقول: “فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزًا، أفيعطيه حجرًا؟ أو سمكة، أفيعطيه حيَّة بدل السمكة؟ أو إذ سأله بيضة، أفيعطيه عقربًا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيِّدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه؟”
ويلاحظ في هذا الحديث الآتي:
أ. كما سألنا أن نسأل ونطلب ونقرع أي ثلاث مرَّات، هكذا قدَّم لنا ثلاثة أمثلة في الطلب: نسأل خبزًا أو سمكة أو بيضة… والعجيب أنها ثلاثة أنواع من الطعام، وكأن سؤالنا من الرب إنما هو أن يشبعنا روحيًا ونفسانيًا وجسديًا.
ب. يرى القدِّيس أغسطينوس أن الخبز هو المحبَّة، والسمكة هي الإيمان، والبيضة هي الرجاء، فإننا نطلب من أبينا السماوي أن نحب ونؤمن ونترجَّى. إنه يقول:
[يعني بالخبز المحبَّة، إذ هي أعظم ما نرغبه، وهي ضروريَّة، بدونها يُحسب كل شيء آخر كلا شيء، كمائدة بلا خبز. أما عكس المحبَّة فهي قسوة القلب تُقارن بالحجر. أما بالنسبة للسمكة فهي تشير إلى الإيمان بالأمور غير المنظورة، هذه التي ننالها خلال مياه المعموديَّة دون أن تراها عين. ومن جانب آخر فإن الإيمان كالسمكة، يُهاجَم بأمواج العالم ولا يهلك، أما ضدَّها فهي الحيَّة بسبب سُم الخداع حيث بإغرائها الشرِّير ألقت بذارها في الإنسان الأول. أما البيضة فيُفهم بها الرجاء، لأن البيضة وهي الأصغر لم يتشكَّل فيها (الطائر) بعد لكننا نترجَّى ذلك. ضد البيضة العقرب التي بلدغتها السامة ترد الإنسان إلى خلف مرتعبًا، عكس الرجاء الذي يطلقنا إلى قدَّام فوق الأمور التي أمامنا[43].]
بمعنى آخر الخبز يشير إلى المحبَّة، يقابله الحجر يشير إلى قسوة القلب، والسمكة تشير إلى الإيمان تقابلها الحيَّة تشير إلى جحد الإيمان حيث خدعت الحيَّة حواء بمكرها وأفسدت ذهنها عن النقاوة (2 كو 11: 2-3)، والبيضة تشير إلى الرجاء حيث يخرج ممَّا يبدو جسمًا جامدًا طائرًا فيه حياة ويقابلها العقرب التي تحطَّم حياة الإنسان.
يريد الله أن يشبعنا فنطلبه، هو يملاْ حياتنا حبًا وإيمانًا ورجاءً، فتشبع أعماقنا، ولا يعوزها شيء، أما عدو الخير فهو المقاوِم الذي يريد أن يقدِّم حجرًا عوض الخبز، إذ قال للسيِّد المسيح: “قل للحجارة أن تصير خبزًا”، إذ اِعتاد أن يهبها قسوة القلب طعامًا عوض خبز الحياة، وهو الذي بعث بالحيَّة عوض السمكة، وتُشبَّه أعماله بالعقرب…
لنطلب الله نفسه يملأ حياتنا ويهبنا من عنده، لذا يقول القدِّيس أغسطينوس: [أيها الإنسان الطمَّاع، ماذا تطلب؟ إن كنت تطلب شيئًا آخر، ماذا يشبعك إن كان الله نفسه لا يشبعك[44]؟] كما يقول: [لتعطِ نفسك طعامها فلا تهلك من المجاعة. أعطها خبزها. تقول: وما هو هذا الخبز؟ لقد تحدَّث الرب معك، فإن أردت أن تسمع وتفهم وتؤمن به، فهو يود أن يقول لك بنفسه: “أنا هو الخبز الحيّ النازل من السماء” (يو 6: 41)[45].]
يُعلِّق القدِّيس كيرلس الكبير على طلب الخبز من الآب، قائلاً: [إن سألك ابنك خبزًا تعطه إيّاه بسرور، لأنه يطلب طعامًا صالحًا، لكن إن طلب عن عدم معرفة حجرًا يأكله، فلا تعطيه بل تمنعه من تحقيق رغبته الضارة. هذا هو المعنى.] ويرى العلامة أوريجينوس في السمكة التي نطلبها حب التعلُّم.
كما يُعلِّق القدِّيس أغسطينوس على البيضة بكونها رمزًا للرجاء، قائلاً: [لنضع بيضتنا تحت أجنحة دجاجة الإنجيل التي تصيح من أجل المدينة الباطلة الخرِبة، قائلة: “يا أورشليم يا أورشليم… كم مرَّة أردتُ أن أجمع بنيكِ كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي” (راجع مت 23: 37)[46].] كما يقول: [إننا نلاحظ كيف تمزِّق الدجاجة العقرب قطعًا، هكذا تمزِّق دجاجة الإنجيل المجدِّفين وتحطِّمهم، هؤلاء الذين يتسلَّلون من جحورهم ويلدغون بنيها بلدغات مؤذية[47].]
أخيرًا يؤكِّد الرب شهوة قلبه نحونا بقوله: “فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه؟” إن كان آباؤنا الأرضيُّون يهتمُّون أن يقدِّموا خبزًا وسمكة وبيضة لكي نقدر أن يعيش على الأرض، فإن الآب الذي من السماء يعطيٍ الروح القدس الذي وحده روح الشركة، يثبِّتنا في الابن الوحيد الجنس منطلقًا بنا بالروح القدس إلى حضن الآب السماوي… عمله أن يهبنا “الحياة الجديدة” الحاملة للسِمة السماويَّة. لكي نعود إلى الحضن الأبوي من جديد. يقول القدِّيس إكليمنضس السكندري: [إن كنَّا ونحن أشرار نعرف أن نعطي عطايا صالحة فكم بالحري طبيعة أب المراحم، أب كل تعزية، الصالح، يترفَّق بالأكثر وبرحمة واسعة يطيل أناته منتظرًا الراجعين إليه؟ الرجوع إليه في الحقيقة هو التوقُّف عن الخطايا وعدم النظر إلى الوراء مرَّة أخرى[48].]
- 3. وحدة الروح (اتِّهامه ببعلزبول)
إن كانت صداقتنا مع الله تقوم على الصلاة بلجاجة، فإن هذه الصلاة يلزم أن تسندها وحدة الروح. فالله في صداقته معنا يريدنا أن نسلك معًا بالروح الواحد، وذلك بعمل روحه القدُّوس واهب الشركة والوحدانيَّة. لهذا يحدِّثنا الإنجيلي لوقا عن إبراء من به شيطان أخرس، وقد أخرجه السيِّد فأتُهم بأنه ببعلزبول رئيس الشيَّاطين. وجد السيِّد بهذا الاتهام فرصته لتأكيد الحاجة إلى وحدة الروح بلا انقسام، وذلك بعمل روحه واهب الشركة. وقد سبق لنا الحديث في هذا الأمر أثناء دراستنا لإنجيل متَّى 12: 22-37، ولإنجيل مرقس 3: 22-30، في شيء من التفصيل، لذا اَكتفي هنا بالملاحظات التالية:
أولاً: أثارت معجزة إخراج الشيطان الأخرس دهشة الجماهير وإعجابهم، الأمر الذي أثار قومًا غالبًا من الفرِّيسيِّين، وإذ اِمتلأوا حِقدًا وحسدًا لم يقدروا أن ينكروا المعجزة، لكنهم اِتَّهموا السيِّد أنه ببعلزبول رئيس الشيَّاطين يخرج الشيَّاطين.
“بعلزبول” هي الصيغة الآرامية للكلمة: “بعل زبوب”، أي إله الذباب عند العقرونيِّين (2 مل 1: 3)، الذين كانوا يعتقدون أن فيه القدرة على طرد الذباب من المنازل.
تشكَّك البعض في أمره، فطلبوا آية من السماء، ليتأكَّدوا أن ما يفعله بقوَّة سماويَّة إلهيَّة وليس بطريق شيطاني، فكانوا يتوقَّعون أن يُنزِل نارًا من السماء كما فعل إيليَّا، ولم يدركوا أن الذي في وسطهم هو السماوي الذي بتنازله حل في وسطهم كواحد منهم.
ثانيًا: لم يستجب لطلبتهم فيرسل نارًا من السماء لإِِفنائهم، إذ طلبوا آية من السماء، بل انتهر يوحنا ويعقوب تلميذيه حين سألاه أن يطلبا نارًا لحرق قرية بالسامرَّة رفضته (لو 9: 54). وإنما في طول أناة أجابهم، لا ليُفحِمهم وإنما ليرُدهم إلى الحق، غير متراجعٍ عن حبُّه حتى لمقاوميه، باذلاً حياته فدية عن الجميع. لهذا يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: [اِحتمل كل هذه الأمور لكي نسلك على أثر خطواته، ونحتمل هذه السخريات التي تقلق أكثر من أي توبيخ[49].]
ثالثًا: جاءت إجابة السيِّد المسيح لمقاوميه كالعادة ليست دفاعًا عن نفسه بقدر ما هي لبنيان نفوسهم وإصلاح حياتهم، وقد حملت الإجابة جانبين:
أ. الجانب السلبي، وهو أنه لا ينقسم عدو الخير على نفسه وإلا هلكت مملكته. وهنا يسألنا ألا ننقسم نحن على أنفسنا، سواء على مستوى الممالك أو مستوى العائلات، إذ يقول:
“كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب،
وبيت منقسم على بيت يسقط،
فإن كان الشيطان أيضًا ينقسم على ذاته،
فكيف تثبت مملكته؟
لأنكم تقولون إني ببعلزبول أخرج الشيَّاطين؟” [17-18].
ب. الجانب الإيجابي، فيه يعلن فاعليَّة الروح القدس الذي هو واحد معه في اللاهوات، إذ يعمل بروحه القدُّوس وقوَّته، ويدعوه إصبع الله. في هذا يدعونا الرب ليس فقط ألا نسلك بروح الانقسام على أنفسنا أو على مستوى العائلات أو الكنائس، وإنما أن نقبل روح الله الذي هو روح الشركة عاملاً فينا بقوَّة، لبنيان ملكوت الله. إنه يقول:
“إن كنتُ أنا ببعلزبول أخرج الشيَّاطين،
فأبناؤكم بمن يُخرجون؟
لذلك هم يكونون قضاتكم،
ولكن إن كنتُ بإصبع الله أُخرج الشيَّاطين،
فقد أقبل عليكم ملكوت الله” [19-20].
لا يكفي أن نرفض روح الانقسام حتى لا نهلك، وإنما يليق بنا أن نقبل روحه عاملاً فينا، لكي يقبل علينا ملكوته في داخلنا بقوَّة!
رابعًا: يسمي السيِّد المسيح الروح القدس “إصبع الله“، ربَّما لأن الإنسان صاحب السلطان حين يشير بإصبعه يتحقَّق كل ما يريده، وكأن الآب والابن يعملان بروحهما القدُّوس كما بالإصبع. يقول القدِّيس كيرلس [يدعى الروح القدس إصبع الله لهذا السبب. قيل عن الابن أنه يد الله وذراعه (مز 98: 1)، به يعمل الآب كل شيء. ولما كان الإصبع غير منفصل عن اليد بل بالطبيعة هو جزء منها، هكذا (مع الفارق) الروح القدس متَّحد مع الابن، وخلاله يعمل الابن كل شيء[50].]
هذا والأصابع مع اختلاف مواضعها وأحجامها وأطوالها تعمل معًا بلا اِنقسام، فتشير إلى تنوُّع الخدمات أو المواهب والروح واحد. كقول الرسول بولس: “فأنواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد، وأنواع خِدم موجودة، ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة، ولكن الله واحد، الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة” (1 كو 12: 4-7).
يقول القدِّيس أغسطينوس: [يُدعى الروح القدس إصبع الله بسبب توزيع المواهب، فيه ينال كل واحد موهبته، سواء للبشر أو الملائكة، إذ لا يوجد في أعضائنا تقسيم مناسب أكثر من أصابعنا[51].] كم يقول القدِّيس أمبروسيوس [لقب “الإصبع” يشير إلى الوحدة لا إلى اِختلاف السلطان[52].]
خامسًا: من هم أبناؤهم الذين يُخرجون الشيَّاطين ويكونون قضاة عليهم، إلا جماعة من التلاميذ البسطاء، الذين هم من الأُمّة اليهوديَّة يعيشون ببساطة قلب بينهم، وأُميُون، يُخرجون الشيَّاطين بقوَّة وسلطان، فيدينون بهذا كل اِتهام يوجِّهه الفرِّيسيُّون والكتبة ضد سلطان السيِّد المسيح. يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [كان التلاميذ الطوباويُون يهودًا، وأبناء لليهود حسب الجسد، وقد نالوا سلطانًا من المسيح باستدعاء هذه الكلمات: “باسم يسوع المسيح”. فإن بولس أيضًا مرَّة أمر الروح النجس بسلطان رسولي: “أنا آمرك باسم يسوع أن تخرج منها” (أع 16: 18). فإن كان أبناؤكم ـ كما يقول ـ باسمي يطئون بأقدامهم على بعلزبول باِنتهارهم أتباعه (شيَّاطينه) وإخراجهم من الساكنين فيهم، أفليس واضح أنه تجديف بجهل عظيم أن تتَّهمونني بأني أحمل سلطان بعلزبول؟ أنتم الآن متَّهمون خلال إيمان أبنائكم[53].]
ينتقل السيِّد المسيح من إظهار أنه يخرج الشيَّاطين بروحه القدُّوس (إصبع الله) إلى السلطان الذي وهبه لتلاميذه الذين هم أبناء اليهود، ليجذب أنظارهم وأفكارهم من المناقشات الغبيَّة التي يُثيرونها خلال حقدهم وحسدهم إلى التطلُّع نحو السلطان الجديد الذي وُهب للتلاميذ خلاله، وإلى الإمكانيَّة التي صارت للبشريَّة خلال السيِّد المسيح. فما يفعله المسيح يسوع ربَّنا ليس اِستعراضًا لقوَّته الإلهيَّة وإنما هو رصيد يقدِّمه لحساب مملكته في قلوبنا، أي لحساب كنيسته التي في داخلنا، لذلك يقول: “فقد أقبل عليكم ملكوت الله” [20]. بمعنى آخر يوَد إن يقول لهم: عوض إن تتَّهموني بأن أعمل بقوَّة بعلزبول تمتَّعوا بسلطاني الذي أهبه للبشر لتحطيم بعلزبول وطرد أرواحه الشرِّيرة من النفوس والأجساد المحطَّمة. في هذا يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [يقول: إن كنتٌ كإنسان قد صرتُ مثلكم، وأخرج الشيَّاطين بروح الله، فقد نالت الطبيعة البشريَّة فيّ أولاً الملكوت الإلهي، إذ صارت ممجَّدة بكسر سلطان الشيطان واِنتهار الأرواح الدنسة، هذا هو معنى الكلمات: “أقبل عليكم ملكوت الله“. لكن اليهود لم يفهموا تدبير الابن الوحيد في الجسد، وأنه كان يجب عليهم بالحري إن يتأمََّلوا أن الابن الوحيد الجنس، كلمة الله قد صار جسدًا دون أن يتغيَّر عما هو عليه، ممجِّدًا طبيعة الإنسان، إذ لم يستنكف أن يأخذ حقارتها لكي يُضفي عليها غناه هو[54].]
سادسًا: إذ نالت البشريَّة في المسيح يسوع سلطانًا بروحه القدُّوس وأعلن عن ملكوت الله فيها، فإنه لم يعد هناك مجال لمملكة الظلمة التي سادت زمانًا، والتي تملَّكت بشراسةٍ وعنفٍ وسلطانٍ خلال ضعفنا. لقد جاء القوي الذي يحطِّم من ظن في نفسه قويًا وأعطيناه الفرصة زمانًا ليسيطر علينا، إذ يقول السيِّد المسيح: “حينما يحفظ القوي داره متسلِّحًا تكون أمواله في أمان. ولكن متى جاء من هو أقوى منه، فإنه يغلبه، وينزع منه سلاحه الكامل الذي اتكل عليه، ويوزِّع غنائمه” [21-22].
هكذا يقدِّم لنا العمل المسيحاني في حياتنا بمثل إنسانٍ قوي متسلِّح في داره، تملك على القلب والعالم كدارٍ له، أسلحته الخبث والدهاء، لكن جاء المسيَّا الأقوى، سلاحه الحب والبذل يحطِّم بالحق الباطل، وبالحب الخبث، وبالنور الظلمة، فيطرد من استعمر القلب وملك على العالم، ساحبًا منه الغنائم. هكذا يوضِّح السيِّد أنه لا هوادة بين النور والظلمة، ولا اِتِّفاق بين المسيح وبليعال.
يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: [دُعي الشيطان قويًا، ليس لأنه بالطبيعة هو هكذا، إنما بالإشارة إلى سلطانه القديم الذي صار له بسبب ضعفنا[55].] ويقول القدِّيس كيرلس الكبير: [هذا هو مصير عدوُّنا العام، الشيطان الخبيث، ذي الرؤوس المتعدِّدة، مبتدع الشرّ. فإنه قبل مجيء المخلِّص، كان في قوَّة عظيمة، يسوق القطعان التي ليست له إلى حظيرته، ويغلق عليها، هذه التي هي قطعان الله، فكان كلصٍ مفترسٍ ومتصلِّف للغاية. لكن إذ هاجمه كلمة الله الذي هو فوق الكل، واهب كل قوَّة، رب القوات، بكونه قد صار إنسانًا، فنهب منه أمتعته ووزَّع غنائمه. فإن أولئك الذين كانوا قبلاً قد أُسروا بواسطته في الخطأ والجحود دعاهم الرسل القدِّيسون إلى معرفة الحق والاقتراب إلى الله الآب خلال الإيمان بالابن[56].]
سابعًا: بعد أن قدَّم السيِّد المسيح هذا المثل، قال هذا المبدأ: “من ليس معي فهو عليّ، ومن لا يجمع معي فهو يُفرِّق” [23]. هنا يبرز السيِّد المسيح خطورة الحياة السلبيَّة التي خلالها يظن الإنسان أنه يقف في منتصف الطريق. فإن السيِّد المسيح يقدِّم طريقين لا ثالث لهما: النور أو الظلمة، مملكة الله أو إبليس. من كان يعمل بروح بعلزبول لا يطرد الشيَّاطين لحساب مملكة الله، إنما ينحني لمملكة الظلمة، وهكذا من يحمل روح الله لا يقبل إلا أن يعمل لحساب مملكة الله. وكأنه يطالبهم بمراجعة أنفسهم ليعرفوا بالحق أين هو مركزهم؟ هل هم معه يعملون على الجمع لحسابه، أو ضدُّه يعملون على تشتيت النفوس؟
كأنه يقول لهم قد جئت لأجمع أبناء الله فيّ، هؤلاء الذين شتَّتهم العدو إبليس، فالشيطان لا يعمل معي، بل يود تشتيت من أجمعهم، فهل تطلبونني لتعملوا للجمع أم تطلبونه فتقومون بالتشتيت؟ وكما يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [إنه يقول: جئت لأخلِّص كل إنسان من يدّ الشيطان، لأنقذهم من خبثه الذي اِصطادهم به، لأحرِّر المأسورين، وأُشرق نورًا على الذين في الظلمة، أُقيم الساقطين وأشفي منكسري القلوب، وأجمع أبناء الله المشتَّتين. وأما الشيطان فهو ليس معي، بل عليّ. بالعكس هو ضدِّي، إذ يتجاسر ليشتِّت الذين أجمعهم وأخلِّصهم. كيف إذن يمكن لذاك الذي يقاومني ويبُث شروره ضد غاياتي أن يعطيني سلطانًا ضدُّه؟ أليس من الغباوة إن تتخيَّلوا هذا؟[57]]
يُعلِّق القدِّيس يوحنا الذهبي الفم على كلمات السيِّد، قائلاً على لسانه: [إن كان الذي لا يعمل معي يكون خصمًا لي، فكم بالأكثر من يقاومني؟ على أي الأحوال يبدو لي أنه قد أشار بهذا المثل إلى اليهود الذين ثاروا ضدَّه بواسطة الشيطان، إذ كانوا يعملون ضدَّه ويُشتِّتون من يجمعهم[58].]
ثامنًا: بعد أن عرض المثَل الأول الخاص بالأقوى الذي يطرد القوي ويوزِّع غنائمه معطيًا إيَّانا رجاء أن نختفي فيه لكي به نحارب العدو ونطرده من أعماقنا، يقدِّم لنا مثلاً آخر لتحذيرنا:
“متى خرج الروح النجس من الإنسان
يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة،
وإذ لا يجد يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجتُ منه.
فيأتي ويجده مكنوسًا مزيَّنًا.
ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أُخر أشرّ منه،
فتدخل وتسكن هناك،
فتصير أواخر ذلك الإنسان أشرّ من أوائله” [24- 26].
بالمثلين وضَّح السيِّد المسيح الفارق بين عمل السيِّد المسيح وعمل الفرِّيسيِّين، ففي المثل الأول أظهر السيِّد المسيح بكونه الأقوى الذي يحرِّرنا ممن اِستقْوَى علينا وأسَرْنا بخُبثه، وفي المثَل الثاني أظهر عمل الفرِّيسيِّين وقادة اليهود الذين يجولون البَرّ والبحر لاصطياد إنسانٍ، وبعد قبوله الإيمان يجعلونه أشرّ منهم، إذ يتعثَّر فيهم. هكذا ينحرف للشرّ أكثر مما كان عليه قبل قبوله الإيمان. وكما قال الرب: “ويلٍ لكم أيها الكتبة والفرِّيسيُّون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبَرْ، لتكسبوا دخيلاً واحدًا، ومتى حصل تصنعونه ابنًا لجُهنَّم أكثر منكم مضاعفًا” (مت 23: 15).
بهذا المثَل يحذِّرنا لئلاَّ نبدأ الطريق ولا نكمِّله، فإننا إذ نبدأ نطرد الشيَّاطين من قلوبنا كما من مسكنه، لكنه لا يجد راحته إلا في العودة من حيث طُرد، وهكذا يبقى متربِّصًا لعلَّه في تهاوننا يرجع بصورة أشرّ وأقوى لكي يسكن من جديد. هذا هو حال كثير من المسيحيِّين بدأوا بالروح وللأسف كمَّلوا بالجسد (غل 3: 3)، فعاد إبليس ليجد قلوبهم مسكنًا له مكنوسًا ومزيَّنًا لاستقباله.
هذا هو حال اليهود الذين سبقوا الأمم في معرفة الله، وكأنهم قد تمتَّعوا بطرد إبليس من قلوبهم، لكنهم إذ جحدوا الرب صاروا أشرّ ممَّا كان عليه قبل الإيمان، بل وأشرّ من الأمم. هذا ما يقوله القدِّيس أمبروسيوس: [بإنسان واحد يُرمز لكل الشعب اليهودي، فالروح النجس خرج بالناموس، ولما لم يجد راحة في الأمم، إذ قبلوا الإيمان المسيحي الذي يحرق الروح النجس، وقد ارتوت قلوب الأمم الجافة بندى الروح القدس وانطفأت سهام العدو الملتهبة نارًا (أف 6: 16)، رجع الروح النجس إلى الشعب اليهودي ومعه أرواح أشرّ منه. هنا رقم 7 يشير إلى كمال العدد[59].] بنفس المعنى يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [إذ كانوا تحت العبوديَّة بمصر، يعيشون حسب عادات المصريِّين ونواميسهم المملوءة دنسًا سلكوا حياة دنسة وسكن الروح النجس فيهم، إذ يسكن في القلوب الشرِّيرة. ولكن إذ خلصوا بواسطة موسى خلال رحمة الله وتقبَّلوا الشريعة كمعلِّم في مدرسة، ودُعوا إلى نور معرفة الله الحقيقيَّة، طُرد منهم الروح النجس الفاسد. ولكنهم إذ لم يؤمنوا بالمسيح بل جحدوا المخلِّص، هاجمهم الروح النجس من جديد، فوجد قلبهم فارغًا، خاليًا من مخافة الله، كما لو كان مكنوسًا فسكن فيهم. فكما أن الروح القدس إذ يجد قلبًا متحرِّرا من كل دنس، طاهرًا، يأتي ويسكن فيه ويستريح هناك، هكذا الروح الشرِّير اعتاد على السُكنى في قلوب الأشرار، لأنهم ـ كما قلت ـ خالون من كل فضيلة وليس فيهم خوف الرب. بهذا صار أواخر الإسرائيليِّين أشر من أوائلهم[60].]
- 4. الصداقة وكلمة الله
“وفيما هو يتكلَّم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع. وقالت له:
“طوبى للبطن الذي حَملك، والثدْيين اللذيْن رضعتهما.
أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه” [27-28].
إذ سمعت المرأة حديث السيِّد طوّبت من حملته وأرضعته. وبلا شك فإن القدِّيسة مريم تستحق الطوبى، غير إن السيِّد لم ينزع عنها التطويب، إنما حثنا لننال نحن أيضًا الطوبى بقوله: “طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه”. وكما يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم أن القدِّيسة مريم قد تزكَّت بالأكثر بهذه الكلمات إذ حملته في نفسها كما حملته في جسدها. ويقول القدِّيس أغسطينوس: [اقترابها كأُم لا يفيد مريم لو لم تكن قد حملته في قلبها بطريقة طوباويَّة، أكثر من حملها إيّاه في جسدها[61].]
لقد فتح لنا الرب باب اللقاء معه والتمتُع بصداقته، فإن كان قد طالبنا في بداية الأصحاح بالصلاة بلجاجة ثم حثَّنا على وحدانيَّة الروح بلا انشقاق والتمتُع بعمل الروح القدس فينا، فإنه الآن يحثُنا على الالتصاق بكلمة الله وحفظها قلبيًا وسلوكيًا. إن كنَّا لم ننعم بحمل السيِّد المسيح جسديًا أو اللقاء معه كمن كانوا معه في أيامه، لكن إنجيله بين أيدينا، إن سمعناه وحفظناه رأيناه متجلِّيًا في الداخل.
يرى القدِّيس أغسطينوس أن هذا الحديث الإلهي يمس حياة الكنيسة كلها التي تختبر حياة الوحدة كجسد واحد للرب، إذ يقول: [ليته لا يفرح أحد من أجل نسله المؤقت، بل بالحري بالروح الذي يربطهم بالله[62].]
- 5. الصداقة وآية يونان النبي
“وفيما كان الجموع مزدحمين اِبتدأ يقول:
هذا الجيل شرِّير،
يطلب آية، ولا تُعطى له إلا آية يونان النبي.
لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى،
كذلك يكون ابن الإنسان أيضًا لهذا الجيل.
ملِكة التيْمَنْ ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم،
لأنها أتَتْ من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان،
وهوذا أعظم من سليمان ههنا.
رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه،
لأنهم تابوا بمناداة يونان” [29-33].
لقد طلب قوم منه آية من السماء أما هو فيُقدِّم نفسه لهم آية، معلنًا يونان النبي كرمزٍ لشخصه الذي انطلق من الجوف كما من القبر قائمًا من الأموات (مت 12: 40) وبكرازته أنقذ أهل نينوى الشعب الأممي، وأيضًا سليمان الحكيم الذي اجتذب الأمميَّة ملكة التيْمَنْ من أقاصي الأرض تمثِّل كنيسة الأمم القادمة، لا لتسمع حكمة بل تمارسها. تلتقي مع حكمة الله نفسه. في الرمزين ظهرت كنيسة الأمم واضحة تلتصق برأسها يونان الحقيقي، القائم كما من الجوف، وسليمان الحكيم واهب السلام والحكمة.
يوضِّح القدِّيس كيرلس الكبير في تعليقه على إنجيل لوقا إن الآية ليست عملاً استعراضيًا كما ظن اليهود، فحينما قدَّم لهم موسى قديمًا بعض الآيات كانت هادفة، خاصة للكشف عن خطاياهم من أجل التوبة فعندما طرح العصا على الأرض فصارت حيَّة ثم أمسك بذنَبها عادت عصا، إنما أشار بالعصا إلى اليهود الذين طُرحوا بين المصريِّين، فصاروا كالحيَّة لتمثلهم بعاداتهم ورجاساتهم وبُعدهم عن الله، وكأنهم قد سقطوا من يديه كما طُرحت العصا من يديّ موسى، لكن إذ أمسك الله بهم كما أمسك موسى بذَنَب الحيَّة عادوا إلى حالهم الأول، إذ صارت الحيَّة عصا، مغروسة في الفردوس، إذ دعوا لمعرفة الله الحقيقية، واغتنوا بالشريعة كطريق للحياة الفاضلة.
هكذا تكرَّر الأمر عندما أدخل يده في عِبِّه ثم أخرجها، وإذ هي برصاء مثل الثلج. ثم عاد فردَّها إلى عِبِّه لينزع عنها البرص، فإن هذه الآية لم تُصنع بلا هدف، إنما تشير إلى إسرائيل الذي كان تحت رعاية الله وحمايته حين كان متمسِّكًا بعادات آبائه سالكًا بروح الحياة الفاضلة اللائقة به، والتي له في إبراهيم وإسحق ويعقوب. فكان كمن في حضن (عِبّْ) الله، لكن إذ خرج عن ذلك كيَدّْ موسى، أي خرج عن حياة آبائه الإيمانيَّة الفاضلة أُصيب بالبرص، أي النجاسة. وإذ عاد فقبل العودة إلى حضن الله وتحت رعايته الإلهيَّة نُزع عنه دنس المصريِّين.
كان يليق باليهود كما يقول القدِّيس كيرلس الكبير أن يدركوا خطأهم، لكنهم اِنشغلوا بطلب آية من السماء بمكرٍ، إذ يقول:
[نبع طلبهم عن مكرٍ، فلم يُستجاب لهم، كقول الكتاب: “يطلبني الأشرار ولا يجدونني” (راجع هو 5: 6)… لقد قال لهم أنه لا تعطى لهم سوى آية يونان التي تعني آلام الصليب والقيامة من الأموات، إذ يقول: “لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام… لم يقدِّم آية لليهود لكنه قدم هذه الآلام الضروريَّة لخلاص العالم… في حديثه معهم قال: “انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمة” (يو 2: 19). فإن إبادته للموت وإصلاحه الفساد بالقيامة من الأموات هو علامة عظيمة على قوَّة الكلمة المتجسِّد وسلطانه الإلهي، وبرهانًا كافيًا كما أظن في حكم الناس الجادِّين. لكنهم رشوا عسكر بيلاطس بمبلغٍ كبيرٍ من المال ليقولوا أن “تلاميذه أتوا ليلاً وسرقوه” (مت 28: 13). لقد كانت (قيامته) علامة ليست بهيِّنة، بل كافية لإقناع سكان الأرض كلها إن المسيح هو الله، وأنه تألَّم بالجسد باختياره، وقام ثانية. أمر قيود الموت أن ترحل، والفساد أن يُطرح خارجًا، لكن اليهود لم يؤمنوا حتى بهذا، لذلك قيل عنهم بحق: “ملِكة التيْمَنْ ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه”… هذه المرأة مع أنها من المتبربرين، لكنها طلبت بشغفٍ أن تسمع سليمان، وقد تحمَّلت السفر لمسافة طويلة بهذا الهدف لكي تسمع حكمته بخصوص طبيعة الأمور المنظورة والحيوانات والنباتات. أما أنتم فحاضر بينكم “الحكمة” ذاته الذي جاء إليكم ليحدِّثكم عن الأمور السماويَّة غير المنظورة، مؤكِّدًا ما يقوله بالأعمال والعجائب وإذا بكم تتركون الكلمة وتجتازون بغير مبالاة طبيعة تعاليمه العجيبة[63].]
ويقول القدِّيس أمبروسيوس: [بعد إن حكم على شعب اليهود، ظهر بوضوح سرّ الكنيسة: شعب نينوى يتوب (يونان 3: 5)، وتسعى ملكة الجنوب لتتعلَّم الحكمة (1 مل 10: 1)، فتأتي من أقصى الأرض لتتعلَّم حكمة سليمان، صاحب السلام. إنها ملكة لمملكة غير منقسمة تتكوَّن من شعوب مختلفة متباعدة مثل جسدٍ واحدٍ، كالمسيح والكنيسة (أف 5: 32). لقد تحقَّق الآن ذلك ليس خلال رمز، بل بالحقيقة تم ذلك. قديمًا كان سليمان رمزًا، أما هنا فنجد المسيح قد جاء متجسِّدًا، وتظهر الكنيسة من جانبين: ترك الخطيَّة وهدمها خلال التوبة (كأهل نينوى)، وطلب الحكمة (كملكة سبأ)[64].]
- 6. العين البسيطة
“ليس أحد يوقد سراجًا ويضعه في خفية،
ولا تحت المكيال،
بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور.
سراج الجسد هو العين،
فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيِّرًا،
ومتى كانت شرِّيرة، فجسدك يكون مظلمًا.
اُنظر اذًا لئلاَّ يكون النور الذي فيك ظلمة.
فإن كان جسدك كله نيرًا ليس فيه جزء مظلم،
يكون نيرًا كله، كما حينما يضيء لك السراج بلَمعانه” [33-36].
هذه العبارات الإلهيَّة كما أظن تكشف عن أساس “الصداقة الإلهيَّة”، فإن كان الله هو “نور”، يليق بنا أن نكون السراج الحامل للنور، الذي لا يختفي عنه عمل الله النوراني، بل يكون حاملاً له وشاهدًا لفاعليَّته. في صداقتنا نلتقي بالنور ليس تحت مكيال معين ولا بمقاييس بشريَّة، وإنما نُحمل على الحق الذي يرفعنا إلى فوق، فلا نخضع للزمن ولا للمكان، بل نحيا كملائكة الله السمائيِّين، نحلِّق في العلويَّات. صداقتنا هي “شركة في النور الإلهي”، أو “حياة علويَّة ملائكيَّة”.
إن كنَّا نتساءل: كيف نصير سراجًا منيرًا، نحمل شهادة حق على منارة الحياة السماويَّة؟ يجيب الرب: “سراج الجسد هو العين“. كأنه يُعلِّق التزامنا بالعين البسيطة لكي نقدر أن نعاين الرب البسيط. لتكن لنا البصيرة النقيَّة، التي لا تحمل تعقيدًا بل في بساطتها تحمل هدفًا واحدًا هو معاينة الرب. بهذا يرى القلب، الذي هو عين النفس وبصيرتها، الله متجلِّيًا في كل شيء، فتستنير النفس ويتقدَّس الجسد، ويصير الإنسان بكليَّته مقدِسًا للرب، وسراجًا يحمل النور الإلهي. وقد سبق لنا الحديث عن هذه العين البسيطة المقدَّسة بالله البسيط في دراستنا لإنجيل متى 6: 22-23.
يحدِّثنا القدِّيس أمبروسيوس عن السراج المنير بكونه إيماننا الإنجيلي أو إيماننا بكلمة الله التي هي النور الذي يكشف لنا الطريق، وبه نبحث عن الدرهم المفقود، إذ يقول:
[السراج هو الإيمان، كما هو مكتوب: “سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي” (مز 119: 105).
كلمة الله هو موضوع إيماننا، وهو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيًا إلى العالم” (يو 1: 9)، هذا السراج لا يمكن أن ينير ما لم نستمد نوره من مصدر آخر (السيد المسيح).
السراج الذي نوقده هو قوَّة أرواحنا وعواطفنا، به نجد الدرهم المفقود (لو 15: 8).
لا يليق بالإنسان أن يضع هذا الإيمان (السراج) تحت مكيال الناموس، لأن الناموس محدود أما النعمة فبلا حدود، الناموس يقدِّم ظلاً أما النعمة فتنير. ليته لا يغلق أحد إيمانه في حدود مكيال الناموس، بل يأتي إلى الكنيسة فتزيِّنه نعمة الرب.
ليسلِّط رئيس الكهنة النور على عظائم اللاهوت الملوكي، فلا يخنقها ظل الناموس. قديمًا كان رئيس الكهنة يوقد الأسرجة حسب الطقوس اليهوديَّة بانتظام صباحًا ومساءً، لكنها قد انطفأت، لأنها وُضعت تحت مكيال الناموس، واختفت أورشليم الأرضيَّة التي قتلت الأنبياء (مت 23: 37)، أما أورشليم السماويَّة فقبلت إيماننا ووضعته على أعلى قمم الجبال أي على المسيح، لذلك أقول أنه لا يمكن للكنيسة أن تخفيها الظلمة ولا ظلال هذا العالم إنما تشع ببهاء الشمس الأبديَّة وتضيء علينا بأشعَّة نعمة الروح[65].]
- 7. التطهير الداخلي والعبادة بالروح
بعد أن قدَّم لنا الإنجيلي سرّ صداقتنا مع الله السماوي، أي العبادة بالروح والحق، خلال الصلاة بلجاجة، ووحدة الروح التي بلا انقسام، والالتصاق بكلمة الله وحِفظها عمليًا، والتوبة مع الإيمان بيونان الحق، واستنارة العين الداخليَّة، يختم حديثه بالإعلان عن الحاجة إلى “التطهير الداخلي” لتكون عبادتنا بالروح والحق لا ترتكز على شكليَّات خارجيَّة بلا أعماق.
جاء هذا الحديث خلال انتقاد أحد الفرِّيسيِّين للسيِّد المسيح لأنه لم يغتسل أولاً. وقد سبق لنا الحديث عن طقس الاغتسال عند اليهود وضرورته في أعينهم في دراستنا لإنجيل معلِّمنا مرقس 7: 1-23، كما سبق لنا دراسة أحاديث السيِّد المسيح ضد تصرُّفات الفرِّيسيِّين والناموسيِّين الشكليِّين والحِرَفيِّين في العبادة في دراستنا لإنجيل معلِّمنا متى الأصحاح 23). غير أننا نقدِّم هنا التعليقات التالية:
أولاً: كان هذا الفرِّيسي الذي دُعي السيِّد المسيح ليأكل عنده حاضرًا يسمع كلماته، وقد شاهد المرأة التي طُوِّبت من حملت به وأرضعته [27]، وربَّما كان هو أحد الفرِّيسيِّين الذين طلبوا منه آية من السماء. على أي الأحوال غالبًا ما كانت دعوته للسيِّد المسيح ليست نابعة عن حب خالص، وإنما لينصب له فخًا، ليراه هل يتبع التقاليد الفرِّيسيَّة في أكله وشربه أم لا. وقد قبِل السيِّد المسيح الدعوة، وعن عمد لم يغتسل ليس لأن في الاغتسال قبل الطعام خطأ، وإنما لأن مفاهيم الفرِّيسيِّين للاغتسال خاطئة، فأراد بتصرُّفه هذا أن يصحِّح مفاهيمهم، ويدخل بهم إلى العبادة اللائقة التي تُمارس بالروح والحق.
كان السيِّد يحدِّثهم عن العين البسيطة والسراج المنير، ولو إن عيني هذا الفرِّيسي بسيطة وسراجه الداخلي منير لانشغل قلبه بالمسيَّا وأدرك حقيقة شخصه أنه “مشتهى جميع الأمم”، فيه تتحقَّق النبوَّات، وبموته تهلَّل إبراهيم، لكنه خلال العين الشرِّيرة انشغل الفرِّيسي بالغسالات الخارجيَّة وانتقد المسيَّا مخلِّص العالم.
ثانيًا: إذ تعجب الفرِّيسي أن السيِّد المسيح لم يغتسل أولاً قبل الغذاء، قال له الرب:
“أنتم الآن أيها الفرِّيسيُّون تُنقُّون خارج الكاس والقصْعَة،
وأمَّا باطنكم فمملوء اختطافًا وخبثًا.
يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضًا؟” [39-40]
يرى القدِّيس أمبروسيوس أن الكأس التي يذكرها الرب إنما تشير إلى الجسد، فالكأس سريعة الانكسار، تسقط على الأرض فتتحطَّم. هكذا أيضًا الجسد يموت في لحظة ويفسد. أيضًا تشير الكأس إلى آلام الجسد، التي يحتملها الإنسان إن كانت اشتياقات قلبه الداخليَّة ملتهبة. إذن ليتنا لا نركِّز على الكأس في مظهره الخارجي، إنما نستطيع أن نشربه محتملين آلام الجسد إن كان القلب ملتهبًا بالحب. لذا يقول ربَّنا: “أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف” (مت 26: 42). وكأنه يليق بنا أن نبدأ بالروح الداخلي ليكون قويًا فنحتمل ضعفات الجسد.
يقول القدِّيس كيرلس الكبير:
[كانوا يغتسلون قبل الطعام كمن يتطهَّرون من كل دنس. لكن هذا العمل كان فيه غباوة شديدة. فإن الاغتسال بالماء مفيد للغاية لمن هم غير أنقياء في الجسد، لكن كيف يمكنه أن يطهِّر البشر من دنس الفكر والقلب؟…
اَخبِرنا أيها الفرِّيسي الغبي أين قدَّم موسى هذه الوصيَّة؟ أيَّة وصيَّة يمكنك أن تشير إليها بأن الرب شرَّعها لتطالب الناس بالاغتسال قبل الأكل، حقًا إن ماء الرش كان قد أُعطيَ بوصيَّة موسى لأجل التطهير الجسدي، بكونه رمزًا للمعموديَّة التي هي بالحق مقدسة ومطهرة في المسيح. الذين دعُوا للكهنوت اغتسلوا في الماء، إذ هكذا فعل موسى بهرون وباللاويِّين معه. بهذا أعلن الناموس عن المعموديَّة خلال الرمز والظل، مظهرًا أن كهنوته لا يحمل ما يكفي للتقديس، وإنما على العكس كان في حاجة إلى المعموديَّة الإلهيَّة المقدَّسة لأجل التطهير الحقيقي. لقد أظهر لنا الناموس وبطريقة جميلة أن مخلِّص الكل قادر على التقديس والتطهير من كل الدنس خلال المعموديَّة المقدَّسة الثمينة، بالنسبة لنا نحن الجيل الذي تقدَّس لله وصار مختارًا له…
ماذا قال المخلِّص؟
كثيرًا ما انتهز الفرصة ليوبِّخهم، قائلاً: “أنتم الآن أيها الفرِّيسيُّون تنقُّون خارج الكأس والقصْعة، وأما باطنكم فمملوء اِختطافًا وخبثًا” [39]… فإنه إذ كان وقت الأكل والجلوس حول المائدة، قدَّم مقارنة بالكأس والقصْعة (طبق) مظهرًا أنه يليق بالذين يخدمون الله بإخلاص أن يكونوا أنقياء وأطهارًا ليس من الدنس الجسدي، وإنما أيضًا من الدنس الخفي في الذهن، وذلك كالذين يخدمون في المطبخ ويعدُّون المائدة إذ يلزمهم إن يغسلوا الأدناس التي في الخارج كما يغسلون حسنًا ما هو في الداخل. أما قوله: “أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضًا؟” [40]، فيعني أن الذي خلق الجسد خلق النفس أيضًا…
لكن الكتبة والفرِّيسيِّين لم يفعلوا هذا… إذ قال المخلِّص: “تُشبهون قبورًا مْبيضَّة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة” (مت 23: 27). لا يريدنا المسيح أن نكون كهؤلاء بل بالحري نكون عُبَّادًا روحيِّين، مقدَّسين، بلا لوم في النفس والجسد. ويقول واحد من الذين في شركتنا: “نقُّوا أيديكم أيها الخطاة، وطهِّروا قلوبكم يا ذوي الرأيين” (يع 4: 8). ويتغنَّى النبي داود قائلاً: “قلبًا نقيًا اِخلقه فيّ يا الله، وروحًا مستقيمًا جدِّده في أحشائي” (مز 51: 10). مرَّة أخرى يتحدَّث إشعياء النبي على لسان الله: “اغتسلوا، تنقُّوا، اعزلوا شرَّ أفعالكم (نفوسكم) من أمام عيني، كفُّوا عن فعل الشرّ” (إش 1: 16). لاحظوا دقَّة التعبير: “اعزلوا شرّ نفوسكم من أمام عينيَ”. إذ يهرب الشرّ أحيانًا من عيني البشر، لكنه لن يقدر أن يهرب من أمام عينيّ الله. فمادام الله ينظر الخفيَّات، لهذا فمن واجبنا أن ننزع الشرّ من أمام عينيه[66].]
يقول القدِّيس أغسطينوس: [لقد أظهر أن المعموديَّة التي أُعطيت تُطهِّر بالإيمان، لأن الإيمان أمر داخلي لا خارجي. لقد احتقر الفرِّيسيُّون الإيمان، واستخدموا الغسلات التي هي من الخارج بينما بقيَ الداخل فيهم مملوء دنسًا[67].]
ثالثًا: لئلاَّ نظن الحياة الروحيَّة الداخليَّة تحمل تجاهلاً للتصرُّفات الظاهرة خاصة الترفُّق بإخوتنا المحتاجين، قال: “بل اِعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون لكم نقيًا” [41]. العبادة الروحيَّة الحقَّة تقوم على الانطلاق خارج “الأنا” والتي تترجم عمليًا خلال الصدقة المملوءة حبًا، وقد تحدَّث كثير من الآباء عن الصدقة وفاعليَّتها في بنياننا الروحي:
- الصدقة أعظم من ذبيحة… إنها تفتح السماوات! فقد قيل: “صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارًا أمام الله” (أع 10: 4). إنها أكثر أهميَّة من البتوليَّة، فقد طَردت عذارى خارج حجال العرس (بعدم الصدقة) بينما دخلت عذارى أخريات داخلاً[68].
- الصدقة ليست علاجًا هيِّنًا، فهي توضع على كل جرح… إنها أفضل من الصوم أو النوم على الأرض، إذ إن هذه الأمور مؤلمة وشاقة، أما الصدقة فأكثر نفعًا.
القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
- اصنع صدقة حقيقيَّة. ما هي الصدقة ! إنها الرحمة! اسمع الكتاب يقول: “اِرحم نفسك فتُرضي الله” (ابن سيراخ 30: 23). نفسك هي شحَّاذ أمامك. ارجع إلى ضميرك مهما كنت تعيش في الشرّ أو الجحود، فتجد نفسك تشحذ، إذ هي في عوز وفقيرة، إنها في حزن… أعطها خبزًا… لو سأل الفرِّيسي: أي خبز أقدِّمه لها؟ يجيب الرب: أعطها صدقة… (بمعنى آخر حب نفسك كما يليق بأن تحب الآخرين، وتصدَّق على نفسك بأن تعطي الغير[69].
القدِّيس أغسطينوس
- انظروا هذه المجموعة العظيمة من الأدوية! فرحمة الله تنقِّينا، وكلمته تطهرنا، كما هو مكتوب: “أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلَّمتكم به” (يو 15: 3)، كما تجد اللحن الشجي: “الصدقة تنجِّي من الموت” (طو 12: 9)، “خبِّئ الصدقة في قلب المسكين يشفع عنك في الأيام “الشرِّيرة[70]” (سيراخ 29: 12).
القدِّيس أمبروسيوس
- إننا نؤكِّد أنه توجد طرق متعدِّدة للسلوك الفاضل مثل الوداعة والتواضع وغير ذلك من الفضائل اللطيفة، فلماذا حذف السيِّد هذه وأمرهم بالترفُّق؟ أيَّة إجابة نقدِّمها؟ لقد كان الفرِّيسيُّون طمَّاعين، عبيدًا للربح القبيح يجمعون الغنى بطريقة شرهة ويخزِّنوه. تحدَّث عنهم إله الكل قائلاً: “كيف صارت القرية (المدينة) الأمينة (صهيون) زانية؟ ملآنة حقًا، كان العدل يبيت فيها، وأما الآن فقاتلون. صارت فضَّتِك زغْلاً، وخمرك مغشوشة بماء، رؤساؤك متمرِّدون ولغفاء اللصوص، كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا، لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم” (إش 1: 21-23).
لقد تطلَّع عن عمد إلى مرضهم الذي سيطر عليهم ونزع طعمهم من جذوره ليخلُصوا من شرِّه وينالوا نقاوة الذهن والقلب فيصيروا عابدين حقيقيِّين.
هكذا عمل المخلِّص في كل هذا بما يناسب خطَّة الخلاص، وإذ دُعي إلى وليمة قدَّم هو طعامًا روحيًا لا لمستضيفه وحده بل لكل الذين معه في الوليمة[71].
القدِّيس كيرلس الكبير
- أمرنا الرحوم أن نُظهر رحمة، وإذ يطلب أن ينقذ الذين خلَّصهم بثمنٍ عظيمٍ، أمَر الذين تدنَّسوا بعد نوالهم نعمة المعموديَّة أن يتطهَّروا جيِّدًا من جديد[72].
القدِّيس كبريانوس
رابعًا: لئلاَّ تُمارس الصدقة بغير نقاوة، أي بضميرٍ معوجٍ، أوضح لهم أنه إذ يسألهم الصدقة يطلب فيهم الحق ومحبَّة الله، وليس الممارسة في شكليَّاتها الظاهرة، إذ يقول: “ولكن ويل لكم أيها الفرِّيسيُّون لأنكم تعشِّرون النعنع والسذاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبَّة الله، كان ينبغي إن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك” [42]. إنهم يهتمون بالصغائر لأجل المجد البشري. فيقدِّمون العشور عن النعناع والبقول والسذاب المزروع في بيوتهم أو حدائقهم، ليظهروا للناس أنهم مدقِّقون في تنفيذ الناموس، بينما يتجاهلون الحق ومحبَّة الله، الأمور الإيمانيَّة الحيَّة. يتجاهلون الحق الإلهي ولا يحملون محبَّته في داخلهم، لكنهم يتسربلون بثوب التدقيق في تنفيذ الشريعة، مع أنه كان ينبغي عليهم أن يعملوا هذه ولا يتركوا تلك.
هذا والسذّاب هو شجرة من فصيلة “النجمة” تنمو في فلسطين، تُستخدم في أغراض طبيَّه.
يقول القدِّيس أمبروسيوس: [يحفظون الأمور العديمة الفائدة، ويهملون الأمور التي تهب الرجاء[73].]
يرى القدِّيس كيرلس الكبير[74] أن الفرِّيسيِّين كانوا يدقِّقون في الوصايا التي تمس الزمنيَّات، مثل دفع العشور لكي يكون لهم نصيب فيها، أما الأمور التي تخص القلب والأبديَّات فلا تشغلهم… فالاهتمام بوصايا “العشور” لا تقوم على غيرتهم على إتمام الشريعة بل بسبب طمعهم.
خامسًا: لعل أخطر عدو يفسد الحياة الروحيَّة هو حب الرئاسات والكرامة الزمنيَّة، لذا يحذِّرنا السيِّد بقوله للفرِّيسيِّين:
“ويل لكم أيها الفرِّيسيُّون،
لأنكم تحبُّون المجلس الأول في المجامع والتحيَّات في الأسواق.
ويل لكم أيها الكتبة والفرِّيسيُّون المراؤون،
لأنكم مثل القبور المختفية، والذين يمشون عليها لا يعلمون” [43-44].
يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: [هذا هو بالحقيقة البؤس الدنيء، أننا بينما نُحسب أهلاً لأن نكون هياكل، إذ بنا نصير فجأة قبورًا مملوءة فسادًا[75].]
ويقول القدِّيس كيرلس الكبير: [إن كان الغير يُعجبون بنا بلا فحص ولا إدراك وبغير معرفة لحقيقة حالنا، فإن هذا لن يجعلنا مختارين في عينيّ الله، العالم بكل الأشياء. لذلك ينصحنا المخلِّص: “الويل لكم لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون”. أسألكم أن تلاحظوا قوَّة المثل بوضوح شديد. فإن الذين يريدون أن يحيُّوهم كل الناس في الأسواق، ويحسبوه أمرًا عظيمًا أن ينالوا المتكآت الأولى في المجامع، لا يختلفون قط عن المقابر المختفية التي تبدو من الخارج مزيَّنة حسنًا مع أنها مملوءة كل فساد. أسألكم أن تنظروا كيف يُلام الرياء تمامًا، فإنه مرض خبيث يكرهه الله والناس… ليتنا نكون عبادًا حقيقيِّين لا نطلب أن نرضى الناس، لئلاَّ نُفقد من مركزنا كخدَّام المسيح. يقول الطوباوي بولس: “أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب إن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدًا للمسيح” (غل 1: 10)… كما أن العملات الذهبيَّة المغشوشة مرذولة، هكذا المرائي يحتقره الله والناس[76].]
سادسًا: إذ أبرز خطورة الرياء ومحبَّة المال وحب الكرامات الزمنيَّة على الحياة الروحيَّة الداخليَّة، وجَّه حديثه نحو ناموسي ليُحذره من فكره الحرفي الناموسي، الذي بلا روح، إذ يقول الإنجيلي:
“فأجاب واحد من الناموسيِّين، وقال له:
يا معلِّم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضًا.
فقال: وويل لكم أنتم أيضًا أيها الناموسيِّون،
لأنكم تُحمِّلون الناس أحمالاً عسرة الحمل،
وأنتم لا تمسُّون الأحمال بإحدى أصابعكم” [45-46].
يرى القدِّيس كيرلس الكبير أنه كان يليق بهذا الناموسي إذ سمع كلمات المخلِّص وشعر أنها تمس ضعفاته، أن يأتي بروح التواضع مقدِّما التوبة، كمريضٍ يطلب الشفاء من الطبيب، قائلاً: اِشفني يا رب فأُشفَى، خلِّصني فأخلُص” (إر 17: 14)… لكن هذا الناموسي تقدَّم للمخلِّص يتهمه أنه بهذا الحديث عن الفرِّيسيِّين يشتم الناموسيِّين أيضًا، وكأنه قد ثار لكرامته عوض طلب الخلاص من ضعفاته.
لقد اِشترك الفرِّيسيُّون مع الناموسيُّين في كثير من الأخطاء. كان الفرِّيسيُّون يعتزلون الشعب كطبقة دينيَّة أرستقراطيَّة، أما الناموسيُّون فيحسبون أنفسهم معلِّمي الناموس، يجاوبون على الأسئلة الخاصة بالناموس أو الشريعة. وقد حمل الفريقان روح العجرفة والكبرياء، ولهم صورة التقوى دون روحها.
كشف السيِّد المسيح عن جراحات الناموسيِّين بقوله: “ويل لكم أيها الناموسيُّون، لأنكم تُحمِّلون الناس أحمالاً عسرة الحمل، وأنتم لا تمسُّون الأحمال بإحدى أصابعكم” [46].
يقول القدِّيس كيرلس السكندري:
[كان الناموس بالنسبة للإسرائيليِّين محزنًا كما اِعترفوا، وقد عرف التلاميذ اللاهوتيُّون ذلك، إذ انتهروا الذين سعوا لإرجاع الذين آمنوا إلى الطقوس الناموسيَّة، قائلين: “فالآن لماذا تجُرِّبون الله بوضع نيرٍ على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن إن نحمله؟” (أع 15: 10)… وقد علِّمنا المخلِّص نفسه ذلك، إذ صرخ قائلاً: “تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. اِحملوا نيري عليكم وتعلَّموا منِّي، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لأنفسكم” (مت 11: 28-29). إذن يقول بأن الذين تحت الناموس هم تعابى وثقيلوا الأحمال، بينما يدعو نفسه وديعًا لأنه ليس في شخصه شيئًا من الناموس. وكما يقول بولس: “من خالف ناموس موسى، فعلى شاهديْن أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة” (عب 10: 28). إذن ويل لكم أيها الناموسيُّون- كما يقول- لأنكم تُحمِّلون من هم تحت الناموس أحمالاً عسِرة الحمل، وأنتم لا تمسُّون الأحمال. لأنهم بينما يأمرون بالتزام حفظ وصايا موسى بلا كسر للوصيَّة، ويحكمون بالموت على من يستهين بها، إذا بهم لا يُبالون بتحقيق أصغر الوصايا الهيِّنة. وإذ كان ذلك أمرًا عاديًا قال الحكيم بولس موبِّخًا إيَّاهم: “هوذا أنتَ تُسمَّى يهوديًا، وتتكل على الناموس، وتفتخر بالله، وتعرف مشيئته، وتميِّز الأمور المتخالفة متعلِّمًا من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة، ومهذب للأغبياء، ومعلِّم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذًا الذي تعلِّم غيرك ألست تعلِّم نفسك؟ الذي تكرز ألا يُسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يُزني، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس، أبتعدِّي الناموس تُهين الله؟” (رو 2: 17-23). فإن المعلِّم يُحتقر وتسوء سمعته حينما يكون سلوكه غير متَّفق مع كلماته[77].]
يُعلِّق الأب ثيوفلاكتيوس على كلمات السيِّد ضد الناموسيِّين، قائلاً: [بحق قيل أنهم لا يريدون أن يلمسوا أحمال الناموس بإحدى أصابعهم، بمعنى أنهم لا يُتمِّمون أقل نقطة في الناموس، بينما يظهرون كمن يحفظونه ويسلِّمونه محفوظاً للآخرين، فهم يسلكون على نقيض آبائهم بدون إيمان وبغير نعمة المسيح[78].]
يقول القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص: [أنهم قضاة قاسون على الخطاة مع أنهم مصارعون ضعفاء، يحمِّلون أثقال وصايا الناموس وهم واهنون في حملها، لا يرغبون في الاقتراب إليها أو لمسها خلال الحياة الجادة[79].]
سابعًا: لم يقف أمر الناموسيِّين عند التمسُّك بالحرف القاتل دون روح الوصيَّة، فجعلوا من الناموس ثقلاً يئن تحته البشر، بينما يجدون لأنفسهم مبرِّرات للهروب حتى من لمس أصغر الوصايا. لم يقفوا عند حدّ الادعِّاء بالمعرفة والتعليم دون الممارسة للحياة الفاضلة، لكنهم صنعوا ما هو أيضًا مرّ وقاسي، فإنهم يبنون قبور الأنبياء ويزيِّنونها، لينالوا مجدًا من الناس. وهم لا يدركون أنهم بهذا يشهدون على أنفسهم أنهم أبناء قتلة الأنبياء، يكملون عمل آبائهم. بقتل الوارث نفسه أو المسيَّا المخلِّص، ما حدث في الماضي يرتبط بالحاضر والمستقبل إذ كان الصليب حاضرًا في عيني السيِّد، ويرى أياديهم تمتد لسفك دمه البريء. بهذا يشترك معاصرو السيِّد المسيح في جريمة آبائهم الخاصة بقتل جميع الأنبياء من دم هابيل إلى دم زكريَّا الذي أُهُلك بين المذبح والبيت.
يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [آباؤهم قتلوا الأنبياء، وإذ آمنوا أنهم أنبياء قدِّيسون صاروا قضاه ضد الذين قتلوهم. لقد صمَّموا أن يكرموا الذين حُكم عليهم بالموت، وبتصرُّفهم هذا أدانوا من أخطاؤا . ولكن الذين أدانوا آباءهم على جرائمهم القاسية كانوا في طريقهم أن يرتكبوا جرائم مشابهة، بل وأبشع منها، إذ قتلوا رئيس الحياة، مخلِّص الجميع، وأضافوا إلى جريمة قتلهم له جرائم أخرى. فقد أُقتيد استفانوس للموت، ليس لاتهامه بشيء دنيء، وإنما لأنه نصحهم وتحدَّث معهم ممَّا ورد في الكتب الموحَى بها. وجرائم أخرى ارتكبت بواسطتهم ضد كل قدِّيس كرز بالإنجيل رسالة الخلاص. هكذا برهن الناموسيُّون والفرِّيسيُّون بكل طريقة أنهم مبغضو الله ومتكبِّرون ومحبَّون للملذَّات أكثر من حبِّهم الله، وبكل وسيلة يكرهون الخلاص لأنفسهم، لذلك أضاف السيِّد كلمة ” الويل” لهم على الدوام[80].]
يقول القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: [لم يُصلح حال اليهود خلال الأخطاء الماضيَّة، بل عندما رأوا الآخرين يخطئون ويعُاقَبون لم ينصلحوا إلى ما هو أفضل، بل ارتكبوا مثلهم نفس الأخطاء، ومع ذلك فلا يُعاقب إنسان على خطايا الآخرين[81].] بمعنى آخر لا يستطيعون أن يقدِّموا عُذرًا بعدم مسئوليَّتهم عمَّا فعله آباؤهم، لأنهم وإن كانوا لا يُدانون على ذلك فهم يرتكبون ذات شرّ آبائهم.
ماذا يعني بقوله: “من دم هابيل إلى دم زكريَّا، الذي أهُلك بين المذبح والهيكل” [51]؟
قلنا أنه في عصر القدِّيس جيروم وُجد ثلاثة آراء من جهة زكريَّا هذا، إما زكريَّا النبي أحد الأنبياء الصغار، أو زكريَّا والد يوحنا المعمدان، أو زكريَّا بن يهوياداع (1 أي 14: 21)، وقد رجَّح القدِّيس الرأي الثالث[82]. أما القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص[83] فيرى أنه زكريَّا والد يوحنا المعمدان. فإن أخذنا برأي القدِّيس جيروم والذي يرجِّحه كثير من الآباء، فإن هابيل قُتل في الحقل بينما قتل زكريَّا في ساحة الهيكل. وكأن دماء الشهداء التي بذُلت ظلماُ قد ملأت الأماكن العامة كما في داخل مقدَّسات الرب نفسه. أيضًا إن صح اعتبار هابيل ليس بكاهن بينما كان زكريَّا كاهنًا، فإن الشهداء قد اِنضم إلى صفوفهم من كان من الشعب، وأيضًا من كان من الكهنة!
ثامنًا: يختم السيِّد المسيح ويلاته للناموسيِّين بقوله: “ويل لكم أيها الناموسيُّون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم” [52].
يقول القدِّيس أمبروسيوس: [ينتهر الرب اليهود، ويعلن أنهم مستحقُّون الدينونة العتيدة، لأنهم بينما أخذوا على عاتقهم تعليم المعرفة الإلهيَّة للآخرين إذ بهم يعوقونهم، لأنهم هم أنفسهم لا يعترفون بما يُعلِّمون به[84].]
يقول القدِّيس كيرلس الكبير: [الذين يبحثون في الكتب المقدَّسة، ويعرفون إرادة الله، إن كانوا أناسًا فاضلين وغيورين على صلاح الناس، ومهرة في قيادتهم قيادة سليمة في كل أمر عجيب، يكافئون بكل بركة إن تمَّموا واجباتهم بغيرة. هذا ما يؤكِّده المخلِّص بقوله: “فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيِّده على خدَمِه ليعطيهم الطعام في حينه، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيِّده يجده يفعل هذا، الحق أقول لكم أنه يُقيمه على جميع أمواله” (مت 24: 45-47). أما إن كان متراخيًا ومهملاً ومعثرًا لمن هم في عهدته، فينحرفون عن الطريق المستقيم، مثل هذا يكون بائسًا ويسقط في خطر العقوبة بلا رجاء. مرَّة أخرى يقول المسيح نفسه: “من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فخير له أن يُعلَّق في عنقه حجر الرحي ويغُرَّق في لُجَّة البحر” (مت 18: 6). هكذا برهن المسيح للذين حسبوا أنفسهم مهرة في الناموس أنهم يرتكبون أخطاء جسيمة كهذه، أقصد بهم الكتبة والناموسيِّين. إذا قال لهم “ويل لكم أيها الناموسيِّين لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة…” نفهم مفتاح المعرفة أنه الناموس ذاته، والتبرير بالمسيح أقصد الإيمان به. فمع كوْن الناموس ظلاً ورمزًا، فإن هذه الظلال تشكِّل لنا الحق وهذه الرموز تصوِّر لنا سرّ المسيح بطرق متعدِّدة… فإن كل كلمة في الكتاب المقدَّس الإلهي الموحَى به تنظر إليه وتشير نحوه… فكان من واجب الذين يُدعون ناموسيِّين بكونهم يدرسون ناموس موسى وعارفين لكلمات الأنبياء القدِّيسين، أن يفتحوا أبواب المعرفة لجماهير اليهود. لأن الناموس يقود البشر إلى المسيح وإعلانات الأنبياء التقويَّة تقود إلى التعرُّف عليه… لكن هؤلاء الذين دُعوا ناموسيِّين لم يفعلوا ذلك، بل على العكس أخذوا مفتاح المعرفة الذي به يُفهم الناموس والإيمان المُحق بالمسيح، لأنه بالإيمان معرفة الحق، كما يقول إشعياء “إن لم تؤمنوا فلا تفهموا“ (إش 7: 9)… لقد أخذوا مفتاح المعرفة، إذ لم يسمحوا للناس أن يؤمنوا بالمسيح مخلِّص الجميع[85].]
أخيرًا إذ فضح الرب جراحات الكتبة والفرِّيسيِّين ابتدءوا “يحنِقون جدًا ويصادرونه على أمور كثيرة. وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئًا من فمه ليشتكوا عليه” [53-54].
لقد أراد لهم الشفاء من جراحات النفس الداخليَّة، لكنهم في جهالة اِزدادوا مقاومة خلال قسوة القلب إذ حنقوا جدًا، وفساد الإرادة، إذ صاروا “يصادرونه“، وخلل العقل إذ صاروا يراقبونه بكل فكرهم ليقتنصوا له خطأ من فمه. يهذا أعلنوا بالأكثر فسادهم الداخلي عاطفيًا وإراديًا وفكريًا.
[1] Catena Aurea.
[2] الإنجيل بحسب متى ص140–158.
[3] Cat. Lac. 23:11.
[4] Monast. Cap 1.
[5] Orat. Dom. 2.
[6] On Prayer 2.
[7] On Prayer 111 – 3, 54 (J.Bamberger: Evagrius Ponticus, Te Praktikos, Chapters on Prayer, 1981, P 74, 63).
[8] Cat. Aurea.
[9] Cat. Lect. 23:12.
[10] On Prayer 3.
[11]Cat. Lect. 23:13.
[12] On Prayer 5.
[13] Cat. Lect. 23:14.
[14] Orat. Dom. 4.
[15] On Prayer 4.
[16] On Prayer 6.
[17] Cat. Lect 23 :16.
[18] On Prayer 7,11.
[19] On Prayer 13 (Bamberger, P 57).
[20] I bid 21, 64.
[21] Cat. Lect. 23:17.
[22] In reg. Brev. Ad inter 221.
[23] On Prayer 8.
[24] Cat. Lect 23:18 .
[25] On Prayer 10.
[26] On Prayer 9.
[27] Cassian: Conf. 9:34.
[28] Ser. On N. T. 11:6.
[29] On Prayer 87.
[30] In Luc 11:5-13.
[31] Ser. On N. T. 55:2,3.
[32] De Quaest. Ev. Lib 2 qu 21.
[33] Ser. 105.
[34] Ser . on N. T. 55:4.
[35] Ser . on N. T. 55:5.
[36] Ep. 130:8.
[37] In Luc 11:15 -13.
[38] Ser. On N.T. 11: 6.
[39] Ep. 130 – 8.
[40] Const. Mon. 1.
[41] Ser. 105.
[42] Const. Mon. 1.
[43] De Quaest Evang. Lib 2 – Qu 22- (Ser. On N. T. 55).
[44] Ser. 105.
[45] Ser. On N.T. 56:4.
[46] Ser. On N.T. 55:11.
[47] Ser. On N.T. 55:12.
[48] Who is the Rich man… 39.
[49] In Ioan . hom 84: 3.
[50] Catena Aurea (In Luc 81) .
[51] De Quaest Evang . 1: 2 .
[52] Catena Aurea .
[53] In Luc. hom 81 .
[54] In Luc. hom 81 .
[55] In Matt. hom 41.
[56] In Luc. hom 81 .
[57]In Luc. hom 81 .
[58] In Matt. hom 41.
[59] In Luc 11:14– 26.
[60] In Luc Ser 81.
[61] Of Holy Virginity 3.
[62] In Ioan tr 10:3 .
[63] In Luc Ser 82 .
[64] In Luc 11:29-32 .
[65] In Luc 11:33–36.
[66] In Luc Ser 83.
[67] Ser. 106.
[68] In Matt. hom 50:5.
[69] Ser. On N. T.56:4.
[70] In Luc 11:37-54.
[71] In Luc Ser. 83.
[72] Catena Aurea.
[73] In Luc 11:37-54.
[74] In Luc Ser. 84.
[75] In Matt. hom 73.
[76] In Luc Ser 84.
[77] In Luc Ser 85.
[78] Catena Aurea.
[79] Catena Aurea.
[80] In Luc Ser 85
[81] In Matt. Hom 74.
[82] الإنجيل بحسب متى، 1983م، ص489.
[83] Orat. In Diem Nat. Christi.
[84] In Luc 11:37-54.
[85] In Luc Ser 86.