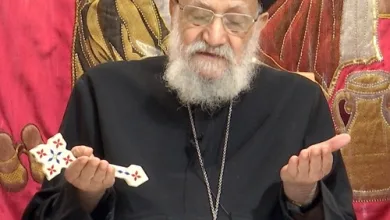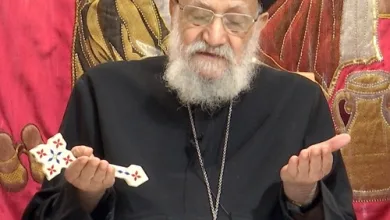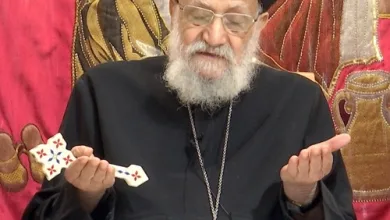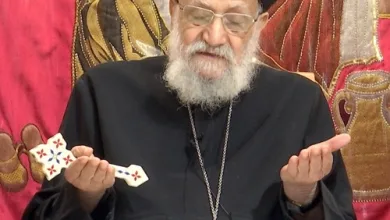تفسير رسالة أفسس 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة أفسس 2 الأصحاح الثاني - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة أفسس 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة أفسس 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثاني: الكنيسة وسرّ المصالحة
إن كانت الكنيسة في جوهرها هي تمتع بالثبوت “في المسيح” لننعم بحياته عاملة فينا، وننال معرفة أسراره الإلهية على مستوى الخبرة الحيّة العملية، فإن هذه الحياة لها صعيدان: صعيد رأسي وآخر أفقي. على الصعيد الرأسي ننعم بالحياة المقامة في المسيح فنجلس معه في السماويات نمارس وحدتنا مع الله، وعلى الصعيد الأفقي نقترب جميعنا نحو الرأس الواحد، فينشق الحجاب الحاجز بين اليهود والأمم، وبين الشعوب، ليشعر الكل بالعضوية لبعضنا البعض. هذان الصعيدان يتحققان معًا خلال ثبوتنا “في المسيح”. كلما اتحدنا مع الآب في ابنه نتحد أيضًا مع بعضنا البعض فيه.
- القيامة وسرّ المصالحة مع الله ١ – ١٠
- سرّ مصالحة البشرية معًا ١١ – ٢٢
1. القيامة وسرّ المصالحة مع الله
يرى القديس أغسطينوس أن الصليب يتكون من عارضيتن، عارضة رأسية وأخرى أفقية، الأولى تمثل مصالحة الإنسان مع الله وخليقته السمائية، والثانية تمثل مصالحته مع أخيه الإنسان. هذا الصليب بعمله المتكامل يتحقق في الكنيسة كما أعلن الرسول بولس في هذا الأصحاح حيث أوضح قيامة الإنسان المؤمن من موته، وانطلاقه إلي السماويات ليجلس في حضن الآب، واتساع قلبه بالحب لينضم الكل إليه كأعضاء معه في الجسد الواحد.
الآن بالنسبة للجانب الأول يقول الرسول:
“وَأَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا،
الَّتِي سَلَكْتُمْ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْرِ هَذَا الْعَالَمِ،
حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ،
الرُّوحِ الَّذِي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ،
الَّذِينَ نَحْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً بَيْنَهُمْ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا،
عَامِلِينَ مَشِيئَاتِ الْجَسَدِ وَالأَفْكَارِ،
وَكُنَّا بِالطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ الْغَضَبِ كَالْبَاقِينَ أَيْضًا،
اَللهُ الَّذِي هُوَ غَنِيٌّ فِي الرَّحْمَةِ،
مِنْ أَجْلِ مَحَبَّتِهِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَحَبَّنَا بِهَا،
وَنَحْنُ أَمْوَاتٌ بِالْخَطَايَا أَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ –
بِالنِّعْمَةِ أَنْتُمْ مُخَلَّصُونَ” ]١– ٥[.
لكي يكشف عن قوة النعمة، وعمل المصالحة التي تمت بين الله والإنسان، أبرز أولاً حالة الموت التي بلغناها، والعبودية التي سقطنا فيها تحت سلطان عدو الخير، والفساد الذي دبّ في جسدنا لنتمم الشهوات. عندئذ أظهر غنى رحمة الله المجانية النابعة عن محبته، فقدم لنا الحياة بموت الصليب، ووهبنا الخلاص بنعمته.
يلاحظ في هذا النص الآتي:
أولاً: أن ما ورد في هذا الأصحاح ككل يقابل ما جاء في الإنجيل بحسب لوقا البشير عن الابن الضال (لو ١٥: ١١ – ٣٢)، كما يقول D. M. Stanley:
أف ٢ | لوقا ١٥ |
الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها… [4] | وإذ كان لم يزل بعيدًا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبّله. [20] |
وأنتم إذ كنتم أمواتًا بالذنوب…[1] | لأن ابني هذا كان ميتًا فعاش. [24] |
أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين…[13] | وسافر إلي كورة بعيدة. [14] |
الذين إذ هم فقدوا الحس… [19] | اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه [22] |
لكي لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس… [14-16] | فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه … [28-32] |
ثانيًا: هذا الأصحاح مشحون بالمقابلات الصارمة بين ضعف الإنسان الشديد وفاعلية عمل الله وقدرته العجيبة.
- الأول يبلغ إلي الموت ]١[، والثاني يقيمه من جديد ]٥[.
- الأول ينحط إلي شهوات الجسد ]٣[، والثاني يرفعه إلي السماوات ]٦[.
- الأول يهرب إلي التغرب عن الله وعن أخيه الإنسان ]١2[، والثاني يرده ليصير أهل بيت الله ]١٩[، واحدًا مع أخيه ]١٤[.
ثالثًا: بدأ حديثه بفاعلية الخطية القاتلة لإنسانيتنا، والطامسة للصورة والتشبه بالله، وكما يقول الأب دورثيؤس من غزة: [بالخطية نطمس ما يخص شبهه فينا، لذا صرنا تحت الموت كقول الرسول: ” كُنْتُمْ أَمْوَاتًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا” (أف ٢: ١). إذ خلقنا الله على شبهه، وهو متحنن على خليقته وشبهه صار إنسانًا لأجلنا، وقبل الموت عوضًا عنا، ليقودنا نحن الأموات، ويردنا إلي الحياة التي فقدناها[1].] هذا التفسير قدمه الأب عند عرضه لسرّ المسيح، في تفسيره لتسبحة القيامة التي وضعها القديس غريغوريوس النزينزي.
رابعًا: بالخطية انحدرنا إلي فقدان الحياة، بتركنا الله مصدر حياتنا وقبولنا العبودية لعدو الخير إبليس، بالطاعة له وعصياننا لله، وقد دعا الرسول إبليس هذا: “رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ“، كما دعانا ” أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ“.
كان ينظر إلي “الْهَوَاءِ” كمسكن للشياطين، لهذا أراد تأكيد كمال نصرة المسيح عليه قال: “سنخطف جميعًا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء” (١ تس ٤: ١٧). فإن الشياطين تقطن الهواء، فسيغلبه الرب في عرينه، ويحملنا في ذات الموضع كأبناء الميراث عوض أن كنا أبناء المعصية.
هنا نلاحظ أن اليهود – ككثير من الأمم – كانوا يعتقدون أن لإبليس وجنوده مملكة تقوم في ثلاث مناطق: في المياه، وفي البرية، وفي الهواء. ولعل اختيار هذه الثلاث مناطق يقوم على استحالة استقرار الإنسان وتمتعه بالسلام فيها. ففي البحر يشعر الإنسان بالخطر من الغرق، وفي البرية يواجه القفر والجفاف مع الحيوانات المفترسة، وفي الهواء إنما يعني خروج النفس من الجسد خلال الموت لتنطلق في الهواء.
إن كانت هذه المناطق في نظر اليهود هي مراكز العدو “إبليس”، فقد أعلن السيد المسيح غلبته عليه في ذات الناطق، ففي المياه اعتمد محطمًا عدو الخير تحت قدميه، واهبًا مؤمنيه قوة الغلبة عليه خلال المعمودية. لذا كان “جحد الشيطان” خطًا واضحًا في طقس العماد، وكما يقول العلامة ترتليان: [في الكنيسة، تحت يد الأسقف نشهد أننا نجحد الشيطان وكل موكبه وكل ملائكته[2].] أما بالنسبة للبرية فقد جُرب السيد المسيح فيها وغلب المجرب وجاءت ملائكة تخدمه (مر١: ١٣). وفي الهواء فقد ارتفع السيد المسيح على الصليب كما في الهواء ليعلن بصليبه تحطيم سلطان إبليس وانهيار مملكته.
خامسًا: يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول بولس إذ أعلن بشاعة ما بلغ إليه الإنسان بالذنوب والخطايا، ألا وهو موت النفس الذي هو أمرّ من موت الجسد، بل ويمثل جريمة يسقط فيها الإنسان بإرادته، أراد أن يشجع السامعين بإعلان دور عدو الخير “رئيس سلطان الهواء” في حياة البشرية كمثير ومحرض.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [ها أنتم تلاحظون لطف بولس، كيف يشجع المستمع في كل المناسبات ولا يثقل عليه. فمع أنه قال لهم: قد بلغتم أقصى درجات الشر (هذا هو معنى أنهم صاروا أمواتًا) فلكي لا يفرطوا في الحزن الشديد (إذ يخجل الناس عندما تُفضح أعمالهم الشريرة السابقة، حتى وإن كانت قد انتهت ولا تمثل خطرًا)، أوضح لهم شريكًا معهم في الجريمة، لكي لا يظنوا أن كل ما فعلوه هو من عندياتهم، وإنما يوجد شريك قوي معهم؛ من هو؟ إنه إبليس[3].]
هكذا أراد الرسول بولس أن يحمل عدو الخير المسئولية معنا، كعدوٍ عنيف يحث البشرية على الشر ويثيرها، لكنه لم يدخل إلي حياتنا قهرًا وإنما بسبب عصياننا لله، إذ يقول: “الرُّوحِ الَّذِي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ” ]٢[. فإن كان العدو شريكًا معنا لكننا مسئولون عن تصرفاتنا وعن عمل العدو فينا.
إبليس يجد موضعًا له في “أبناء المعصية“، أما “أبناء الطاعة” فلا يقتحمهم هذا الروح إنما يتجلى فيهم روح الله القدوس.
سادسًا: أوضح الرسول أن ما بلغ إليه الإنسان يستوي فيه اليهودي مع الأممي، إذ سقط الاثنان تحت سلطان الخطية، فعندما قال: “الَّتِي سَلَكْتُمْ“، عاد فقال: “الَّذِينَ نَحْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً بَيْنَهُمْ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا، عَامِلِينَ مَشِيئَاتِ الْجَسَدِ وَالأَفْكَارِ، وَكُنَّا بِالطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ الْغَضَبِ كَالْبَاقِينَ أَيْضًا” ]٣[. كأن بقوله ليس فقط أنتم وحدكم أيها الأمم قد سلكتم في الخطايا، وإنما نحن أيضًا سقطنا معكم تحت الخطية وحُسبنا معكم أبناء معصية، فلا نستطيع كيهود أن نفتخر بأننا أسمى منكم (رو ٣: ٩ – ١٠).
لقد كان الكل بالطبيعة “أبناء الغضب” أو كما يقول القديس بفنوتيوس إنهم كانوا في بيت أبيهم القديم أي “إبليس” الذي سحبهم إلي أسفل، لذا وجب على الكل أن يخرجوا منه، مرتفعة أنظارهم إلي بيت أبيهم الجديد، أي أورشليم العليا، إذ يقول: [نخرج من بيت أبينا القديم… إذ كنا بالطبيعة أبناء غضب كالباقين أيضًا، مثبتين أنظارنا تجاه العلويات[4].]
كنا “بالطبيعة أبناء الغضب”، لذا وجب علينا أن نخرج من هذه الطبيعة، طبيعة الإنسان العتيق، ونلبس الإنسان الجديد (في مياه المعمودية). بهذا نكون قد انطلقنا من بيت أبينا القديم الذي خضعنا له في مذلة العبودية إلي بيت أبينا الجديد القدوس.
سابعًا: علة موتنا وعصياننا لله ليس “الجسد” بل “مشيئات الجسد وشهواته وأفكاره“. فالجسد خليقة مقدسة من عمل الله الصالح القدوس، لكنه إذ انحرف عن غايته وترك خضوعه صارت له “مشيئات متضاربة” وأفكار مقاومة لعمل روح الله. الجسد ليس شرًا، فقد صار الكلمة جسدًا (يو ١: ١٤)، لكنه فسد حين صار آلة إثم تعمل لحساب الشهوات؛ إن تقدست تتحول إلي آلة برّ تعمل لحساب ملكوت الله.
- إذن كيف يمكننا أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية لله (رو ١٢: ١)؟ إن كنا لا نعود نتبع مشيئات الجسد وأفكارنا الذاتية (أف ٣: ٢)، بل نسلك بالروح ولا نتمم شهوات الجسد (غلا ٥: ١٦)[5].
الأب دورثيؤس من غزة
هكذا يكشف الرسول بولس عن سرّ الموت الروحي… السلوك حسب شهوات الجسد والعمل حسب مشيئاته وأفكاره ]٣[، لكن هذا لا يعفي النفس المسئولية، فإن الإنسان الجسداني، إذ يخضع لشهوات الجسد ومشيئاته وأفكاره تشاركه النفس ويشاركه العقل حتى يصيرا كما لو كانا جسدين. بمعنى آخر، الإنسان يمثل وحدة واحدة، إما أن يكون جسديًا، فيعمل بكليته حسب شهوات الجسد، أو روحانيًا فيعمل بكليته كما لو كان روحًا. في الأول تخضع النفس للجسد كما بغير إرادتها، أما الثاني فيخضع جسده لنفسه كما بغير إرادة الجسد. ولعل هذا ما قصده الأب سرابيون حين قال: [الخطايا الجسدية هي التي تعمل على إشباع شهوات الجسد وملذاته. هذه تهيج العقل أحيانًا ليقبل رغباتها بغير إرادته[6].]
ثامنًا: بعد أن تحدث عما بلغة الكل من يهود وأمم بسبب العصيان أكدّ محبة الله الفائقة نحو الإنسان وترفقه به حتى بعد السقوط، إذ يقول: “اَللهُ الَّذِي هُوَ غَنِيٌّ فِي الرَّحْمَةِ، مِنْ أَجْلِ مَحَبَّتِهِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَحَبَّنَا بِهَا” ]٤[، وقد أكد “غنى” رحمة الله، مكررًا هذا التعبير خمس مرات في هذه الرسالة.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [الله ليس رحيمًا فحسب وإنما هو غني في الرحمة، وكما قيل في موضع آخر: “ككثرة رحمتك التفت إليّ” (مز ٦٩: ١٦)، وأيضًا: “ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك امح أثمي” (مز ٥١: ١)[7].]
تاسعًا: أوضح هذه الرحمة عمليًا، بقوله: “أَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ… أَقَامَنَا مَعَهُ، وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ” ]٥-٦[. لقد تحنن علينا لا بكلمات لطيفة أو مشاعر رقيقة وإنما بنزوله إلينا لنشاركه، فنحيا مع المسيح ]٥[ ونقوم معه ]٦[ ونجلس مع في السماويات ]٦[… يؤكد الرسول الشركة مع المسيح بكل قوة!
- “وَنَحْنُ أَمْوَاتٌ بِالْخَطَايَا، أَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ” ]٥[.
هنا أيضًا يُذكر المسيح، وهو موضوع جدير بإيماننا، لأنه إن كان البكر حيًا، فنحن أيضًا نكون هكذا. لقد أحياه (الآب) وأحيانا نحن. انظر، أليس هذا قد قيل عن المسيح المتجسد؟ أما ترى “عَظَمَةُ قُدْرَتِهِ الْفَائِقَةُ نَحْوَنَا نَحْنُ الْمُؤْمِنِينَ” (١: ١٩)؟ الذين كانوا أمواتًا وأبناء الغضب أحياهم، انظر إلي “رَجَاءُ دَعْوَتِهِ” ]١٨[!
“وَأَقَامَنَا مَعَهُ، وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ” ]٦[.
أما ترى مجد ميراثه، واضح أنه “َأَقَامَنَا مَعَهُ“…
حقًا إنه إلي الآن لم يقم أحد فعلاً إلاَّ الرأس الذي قام فقمنا نحن معه، وذلك كما سجد يعقوب ليوسف فقيل أن زوجته أيضًا سجدت معه (تك ٣٧: ٩، ١٠). بنفس الطريقة يُقال: “أجلسنا معه نحن أيضًا“، فإذ يجلس الرأس يجلس الجسد أيضًا معه، لهذا أضيف: “في المسيح يسوع“[8].
القديس يوحنا الذهبي الفم
- خلال الجسد (الذي أخذه)، الذي هو عربون خلاصنا، أجلسنا في السماويات.
- إنه أساس الكل، ورأس الكنيسة (أف ٥: ٢٣)، فيه استحقت طبيعتنا العامة حسب الجسد أن تجلس في العرش السماوي، لقد كُرم الجسد إذ وجد له نصيبًا في المسيح الذي هو الله، بل وكُرمت كل طبيعة الجنس البشري إذ وجدت لها نصيبًا في الجسد.
نحن نجلس فيه بأخذه طبيعتنا الجسدية[9].
القديس أمبروسيوس
إذن قيامة المسيح وجلوسه في السماويات كباكورة لنا حُسبا قيامة لنا وجلوسًا لنا معه في السماويات. هذا من جانب ومن جانب آخر، فإننا ننعم بذلك حقًا خلال قيامة النفس من موت الخطية وتمتعها بعربون الحياة السماوية.
قيامة النفس التي نلناها في المسيح يسوع المقام أعظم من قيامة الجسد، لأن قيامة الجسد تتحقق بدون إرادتنا. حينما قال السيد للميت: “لعازر، هلم خارجًا” (يو ١١: ٤٣)، أطاع للحال وقام الميت. وتكرر الأمر في أكثر من مرة حين أقام السيد المسيح ابنة يايرس وابن أرملة نايين. بل وبطرس الرسول إذ صلى إلي الله استطاع أن يقيم طابيثا (أع ٩: ٤) باسم المسيح.
وفي اليوم الأخير سيقيم الأموات في لحظة في طرفة عين (١كو ١٥: ٥٢). أما قيامة النفس فتتم خلال إيماننا بالمسيح المقام وتمسكنا به حتى النهاية، الأمر الذي لا يتم بطريقة آلية وإنما خلال إرادتنا الحرّة. استمع إلي عتاب السيد المسيح المؤلم: “كم مرة أردت أن أجمع أولادك ولم تريدوا” (مت ٢٣: ٣٧). الأمر الذي يستلزم خضوع إرادتنا البشرية لإرادة الله الصالحة نحونا. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [التأثير على الإرادة أصعب من التأثير على الطبيعة[10].]
عاشرًا: يقول القديس يوحنا الذهبي الفم بأنه لئلا يظن أحد أن قيامة المسيح وجلوسه في السماوات أمران يخصانه دوننا، أكد الرسول فاعليتهما في البشرية عبر العصور حتى نهاية الأزمنة، إذ يقول:
“لِيُظْهِرَ فِي الدُّهُورِ الآتِيَةِ غِنَى نِعْمَتِهِ الْفَائِقَ بِاللُّطْفِ عَلَيْنَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ.
لأَنَّكُمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالإِيمَانِ، وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ.
هُوَ عَطِيَّةُ اللهِ. لَيْسَ مِنْ أَعْمَالٍ كَيْلاَ يَفْتَخِرَ أَحَدٌ” ]٧– ٩[.
يقول “لِيُظْهِرَ“، هنا الكلمة اليونانية لا تعني مجرد “الكشف عن” أو “إظهار”، وإنما تعني “البرهان”… فقيامة المسيح وجلوسه في السماوات هما برهان أكيد لغنى نعمة الله الفائق الذي تفجر لحساب الكنيسة خلال الدهور، فينعم المؤمنون بلطف الآب بثبوتهم في المسيح يسوع. صار المسيح الرأس الذي يقدم تأكيدات وبراهين على ما ينعم به المؤمنون خلال إتحادهم به.
من هنا نجد أن خلاصنا يتحقق خلال إيماننا به كنعمة مجانية، أو كعطية إلهية، وليس عن استحقاق لبرٍّ ذاتي.
- يقول: “لأَنَّكُمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ” لكي لا تدفعك عظمة البركات الموهوبة نحو التشامخ، لاحظ كيف نزل بك… حتى الإيمان ليس من عندياتنا، لأنه لو لم يأتِ (المسيح) ولو لم يدعنا كيف كان يمكننا أن نؤمن؟!… عمل الإيمان نفسه ليس من ذواتنا. إنه عطية الله، ليس من أعمال. ربما تقول هل يكفي الإيمان لخلاصنا؟ كلا…
- اعترف أنك بالنعمة تخلص، حتى تشعر أن الله هو الدائن… فإن أسندنا لله (أعمالنا الصالحة) تكون مكافأتنا عن تواضعنا أعظم من المكافأة عن الأعمال نفسها…
- لو كانت النعمة لا تنتظر ما يتحقق من جانبنا لانسكبت بفيض في كل النفوس، لكنها إذ تطلب ما هو من جانبنا تسكن في البعض بينما تترك البعض الآخر، ولا تظهر في البعض، لأن الله يشترط أولاً الاختيار السابق[11].
القديس يوحنا الذهبي الفم
- ما أن تتكبر حتى تفقد في الحال ما نلته[12].
القديس أغسطينوس
إذن تتحقق مصالحتنا مع الآب خلال النعمة الإلهية الغنية التي فاضت بصليب ربنا يسوع، فغيّرت مركزنا من حالة العداوة إلي البنوة، ورفعتنا من الموت الروحي إلي الحياة المقامة، ومن الانحطاط إلي الجلوس في السماويات. هذا العمل في حقيقته هو أشبه بتجديد للخلقة، تكلفته أكثر من الخلقة الأولى، إذ الأولى احتاجت أن الله يقول فيكون، أما الخلقة الجديدة فثمنها تسليم الابن ذاته لتجديدنا خلال دم صليبه. لهذا يكمل الرسول بولس كلماته معلنًا عمل الله الفائق فينا بقوله:
“لأَنَّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ،
مَخْلُوقِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ،
قَدْ سَبَقَ اللهُ فَأَعَدَّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا” ]١٠[.
- لاحظ الكلمات التي استخدمها. إنه يلمح هنا إلي الميلاد الجديد، الذي هو بالحقيقة خلقة ثانية. إننا وُجدنا من العدم إلي الوجود. فما كنا عليه قبلاً، أي الإنسان العتيق، إنما كنا أمواتًا. ما صرنا عليه الآن لم يكن لنا من قبل. إذن، بالحق هو عمل خلقة، نعم خلقة أنبل من الأولى. ففي الأولى صار لنا الوجود، أما بالأخيرة هذه فنلنا ما هو أعظم وأفضل، ألا وهو صلاحنا.
” لأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، قَدْ سَبَقَ اللهُ فَأَعَدَّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا” ]١٠[. ليس فقط لكي نبدأ وإنما لكي نسلك فيها، فإننا نحتاج إلي صلاح يبقى معنا في الطريق ويرافقنا حتى يوم الممات.
إن كان علينا أن نسافر في طريق يؤدي إلي مدينة ملوكية، وعبرنا الجانب الأكبر منه ثم جلسنا وتراخينا بالقرب من المدينة جدًا، فلا ننتفع شيئًا. فرجاء دعوتنا “لأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ” كما يقول إلا فلا ننتفع شيئًا.
إنه لا يفرح لأننا تممنا عملاً واحدًا بل كل الأعمال. فإن كان لنا خمس حواس يلزمنا أن نستخدم جميعها في الوقت المناسب، وهكذا يلزم أن تكون لنا فضائل كثيرة[13].
القديس يوحنا الذهبي الفم
2. سرّ مصالحة البشرية معًا
يكمل أن الصليب بعارضتيه الرأسية والأفقية، بلا انفصال، فبمصالحة الإنسان مع السماء تاركًا خطاياه خلال نعمة الله المجانية والحياة المقامة ينفتح قلبه بالحب نحو أخيه أيًا كان أصله! لهذا بعدما تحدث الرسول عن مصالحتنا مع الله، عالج موضوع مصالحة البشرية معًا؛ فإذ نُزع الحجاب الذي كان يفصل الإنسان عن المقادس السماوية يلزم بالضرورة، وفي نفس الوقت، أن يُنقض حائط السياج المتوسط الذي أُقيم بين اليهود والأمم.
بدأ الرسول حديثه بعرض تغّرب الأمم عن رعوية إسرائيل وتغربه أيضًا عن الله، قائلاً:
“لِذَلِكَ اذْكُرُوا أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الأُمَمُ قَبْلاً فِي الْجَسَدِ،
الْمَدْعُوِّينَ غُرْلَةً مِنَ الْمَدْعُوِّ خِتَانًا مَصْنُوعًا بِالْيَدِ فِي الْجَسَدِ،
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِدُونِ مَسِيحٍ،
أَجْنَبِيِّينَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ،
وَغُرَبَاءَ عَنْ عُهُودِ الْمَوْعِدِ،
لاَ رَجَاءَ لَكُمْ، وَبِلاَ إِلَهٍ فِي الْعَالَم” ِ]١١، ١٢[.
هذه هي صورة الأمم قبل قبولهم الإيمان بالسيد المسيح، يُلاحظ فيها الآتي:
أولاً: كان الأمم بلا ختان (في الغرلة)، لا يحملون علامة الميثاق مع الله التي طالب بها إبراهيم وبنيه (تك ١٧: ٩ – ١٤)، إنهم بلا عهد معه. على أن اليهود وإن كانوا قد نالوا العلامة لكنهم للأسف نالوها في الجسد دون أن تكون لها أعماق داخلية، إذ يقول “ مَصْنُوعًا بِالْيَدِ فِي الْجَسَدِ” ]١١[، إي لا تحمل اتجاهًا داخليًا، ولا تمييزًا حقيقيًا عن الأمم. وكما أوضح في رسالته إلي رومية: “لأن اليهودي في الظاهر ليس يهوديًا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانًا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله” (رو ٢: ٢٨، ٢٩).
بعد أن عرض عمل نعمة الله الفائقة في الكل: “نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقِينَ فِي الْمَسِيحِ“، لم يعد بعد يوجد مجال لافتخار اليهود بختان الجسد، الذي هو ليس إلاَّ من “صنع اليد”. شتان ما بين “عمل الله” و”صنع اليد البشرية”!
نال الكل ختانًا جديدًا، ليس مصنوعًا باليد في الجسد، وإنما كما يقول الرسول: “ختنتم ختانًا غير مصنوع بيدٍ، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية، التي فيها أقمتم أيضًا معه بإيمان …” (كو 2: ١١، ١٢). هكذا لا وجه للمقارنة بين ختان الجسد الرمزي وبين الختان الجديد في مياه المعمودية.
ثانيًا: كان الأمم “أَجْنَبِيِّينَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ” ]١٢[، أي لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، وبالتالي كانوا غرباء عن المواطنة الإلهية، الأمر الذي أفقدهم الرجاء، لأنهم لم ينالوا الشريعة الإلهية ولا تمتعوا بنبوات الأنبياء التي أشارت بقوة عن مجيء المسيا مخلص العالم.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لم يقل الرسول إنهم معزولون بل “أَجْنَبِيِّينَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ“، إي ليس لكم نصيب في هذه الرعوية. التعبير مؤثر جدًا يدل على عزل واسع جدًا. الإسرائيليون أنفسهم كانوا خارج هذه الرعوية لك ليس كغرباء بل عن إهمال، لذلك سقطوا عن العهود، لا كأجنبيين بل كغير مستحقين لها[14].]
ثالثًا: “وَبِلاَ إِلَهٍ فِي الْعَالَمِ” ]١٢[. التعبير هنا لا يعني أنهم كانوا ملحدين أو منكرين لوجود الله، وإنما كانوا بلا معرفة عنه، كقوله: “كالأمم الذين لا يعرفون الله” (١ تس ٤: ٥).
الآن إذ اقتربوا من السيد المسيح، وقبلوه بالإيمان تغيرت صورتهم تمامًا، وتغير مركزهم بالنسبة لله ولليهود، إذ يقول:
“وَلَكِنِ الآنَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ،
أَنْتُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ قَبْلاً بَعِيدِينَ صِرْتُمْ قَرِيبِينَ بِدَمِ الْمَسِيحِ.
لأَنَّهُ هُوَ سَلاَمُنَا، الَّذِي جَعَلَ الإثْنَيْنِ وَاحِدًا،
وَنَقَضَ حَائِطَ السِّيَاجِ الْمُتَوَسِّطَ، أَيِ الْعَدَاوَةَ.
مُبْطِلاً بِجَسَدِهِ نَامُوسَ الْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ،
لِكَيْ يَخْلُقَ الإثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا، صَانِعًا سَلاَمًا” ]١٣– ١٥[.
في العهد القديم صار اليهود قريبين لله، لا بعلامة الختان فحسب، وإنما بدم الذبائح أيضًا، كقول موسى النبي حين أخذ الدم ورش على الشعب: “هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال” (خر ٣٤: ٨)؛ أما في العهد الجديد فصار البشر قريبين إلي الله في عهد أخوة خلال ذبيحة المسيح.
إذ بذل المسيح نفسه ذبيحة حب ضمنا معه في رباط وحدة، ونقض حائط السياج المتوسط الذي أقامه اليهود حول الهيكل حتى لا يعبره غريب، هذا الحائط يمثل العداوة بين اليهود والأمم، والفصل الكامل بينهما، لا من جهة عدم العبور إلي الهيكل اليهودي فحسب، وإنما اعتزال اليهود الحياة الأممية، والانفصال عنهم في كل اتجاهات الحياة، حتى لا يتدنسوا برجاساتهم.
يخبرنا يوسيفوس أن هذا الحائط الحجري كان يرتفع ٣ بوصات يفصل الدار الخارجية للهيكل عن الدار الداخلية، وُجدت عليه علامات تهدد بالموت كل أجنبي يتعداه[15]. وفي الحفريات التي قام بها Clermont– Ganneua بأورشليم عام ١٨٧1 وُجدت إحدى هذه التحذيرات، جاء فيها: “لا يجوز لشخصٍ من أمة أخرى أن يدخل في المنطقة المسوّرة حول الهيكل، ومن يُمسك يحكم على نفسه بالموت”.
هذا الحاجز ولّد لدى الأمم اتجاهين: البعض أُعجب بنقاوتهم من الرجاسات الوثنية فقبلوا التهود، والبعض الآخر حسبوا هذا تعصبًا فامتلأوا مرارة ضد اليهود واحتقارًا لهم.
لم ينقض حائط السياج الحجري لكي يدخل الأمم مع اليهود إلي هيكل أورشليم، وإنما نزع العداوة بدمه ليدخل بالكل إلي العضوية في جسده، ” فيَخْلُقَ الإثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا” ]١٥[.
ربما يقدم هنا تلميحًا إفخارستيًا، حيث يشترك الكل معًا في جسد المسيح الواحد، فيتحقق في الجميع تجديدًا دائمًا وانسجامًا مستمرًا حتى تعلن “الكنيسة الواحدة المتجددة”. في الإفخارستيا تلتقي البشرية المؤمنة فتجد لها موضعًا حقيقيًا للسكنى معًا على صعيد الثبوت في المسيح. هذه المصالحة التي تمت في الصليب أكدها الرسول في أكثر من موضع: “ليس يهودي ويوناني، ليس عبد ولا حرّ، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعًا واحد في المسيح” (غلا ٣: ٢٨). “وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوات” (كو ١: ٢٠).
- “لأَنَّهُ هُوَ سَلاَمُنَا، الَّذِي جَعَلَ الإثْنَيْنِ وَاحِدًا” ماذا يعني: “جَعَلَ الإثْنَيْنِ وَاحِدًا”؟
لا يعني أنه أقامنا إلي مركزهم الوضيع، وإنما أقامنا وإياهم إلي ما هو أعلى. لكن البركة بالنسبة لنا أعظم، لأن لهم كان الوعد، وكانوا هم أقرب منا، أما نحن فلم يكن لنا الوعد وكنا أكثر بعدًا منهم، لهذا قال: “وأما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة” (رو ١٥: ٩). حقًا لقد أعطى الوعد للإسرائيليين، لكنهم لم يستحقوه، وأما نحن فلم يعطنا وعدًا وإذ كنا غرباء، وليس لنا معهم شركة في شيء ما لكننا صرنا واحدًا لا بإتحادنا معهم، وإنما بإتحادنا وإياهم معًا في واحد.
أقدم لكم تشبيهًا: هب أنه يوجد تمثالان، أحدهما من الفضة والآخر من الرصاص، وأذيب الاثنان معًا، فصار الاثنان من ذهب، هكذا جعل الاثنين واحدًا.
يمكن وضع الأمر بصورة أخرى: لنفرض أن اثنين، أحدهما عبد والآخر ابن بالتبني، وأن الاثنين أذنبا ضده، فصار أحدهما ابنًا غير مستحق للميراث والآخر شريدًا ذاك الذي لم يعرف له أبًا قط. صار الاثنان وارثين، وابنين حقيقيين. كلاهما ارتفعا إلي ذات الكرامة، فصار الاثنان واحدًا، واحد جاء من بعيدٍ جدًا والآخر من مسافة أقل، لكن العبد صار أكثر نبلاً مما كان عليه قبل أن يذنب.
- يكمل حديثه: “وَنَقَضَ حَائِطَ السِّيَاجِ الْمُتَوَسِّطَ“، وقد فسر معنى حائط السياج المتوسط بقوله: “أَيِ الْعَدَاوَةَ التي أبطِلها بِجَسَدِهِ، نَامُوسَ الْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ“.
حقًا يؤكد البعض أنه قصد الحائط الذي وضعه اليهود ضد اليونانيين، إذ لم يكن يُسمح لليهودي أن يختلط باليونانيين. أما بالنسبة لي فيبدو لي أن المعنى غير هذا، بل بالحري قال: “العداوة في الجسد”، الحائط المتوسط، كحاجز عام الذي يعزلنا كلنا في وجه المساواة عن الله. وكما يقول النبي: “آثامكم صارت فاصلة بينكم وبيني” (إش ٥٩: ٢)، تلك العداوة التي كانت بين الله وبين اليهود كما الأمم، بكونها حائطًا متوسطًا.
هذا الحائط لم يُنقض حين وُجد الناموس بل بالعكس تقوّى، كقول الرسول: “لأن الناموس ينشيء غضبًا” (رو ٤: ١٥). وبنفس الطريقة بقوله “الناموس ينشيء غضبًا” لم ينسب كل التأثير للناموس ذاته، وإنما يجب أن نفهم أن السبب هو آثامنا؛ هكذا هنا أيضًا يقول: “حَائِطَ السِّيَاجِ الْمُتَوَسِّطَ” لأنه خلال عصياننا نشأت العداوة.
كان الناموس سياجًا، عُمل لأجل الحماية، ولهذا دُعي “سياجًا” ليحيط بما هو في داخله. أنصت أيضًا إلي النبي القائل: “أقمت خندقًا حوله” (إش ٥: ٢).
على أي الأحوال، صار (الناموس) حائطًا متوسطًا لا لسلامهم بل ليعزلهم عن الله. وهكذا تكوّن الحائط المتوسط من السياج. ولكي يشرح ذلك أكمل: “أبْطل العداوة بِجَسَدِهِ، أي نَامُوسَ الْوَصَايَا“. كيف تم ذلك؟ بقتله (على الصليب) مبطلاً العداوة. ليس فقط بهذه الوسيلة وإنما بحفظ الناموس …[16]
القديس يوحنا الذهبي الفم
- “لِكَيْ يَخْلُقَ الِاثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا” ]١٥[. لاحظ أن الأممي لم يصر يهوديًا، بل كلاهما – هذا وذاك – صارا في حالة جديدة…. وُهب الاثنين خليقة جديدة. استخدم كلمة “خلق” في كل المناسبات وليس “غيّر”، ليظهر قوة عمله.
- ” لِكَيْ يَخْلُقَ الِاثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ“، أي بنفسه، فلم يعهده بهذا الأمر لآخر، بل قام به بنفسه، أذاب هذا وذاك وأقام واحدًا مجيدًا… أمسك اليهود باليد الواحدة، والأمم بالأخرى، وكان هو في الوسط، فمزجهما معًا، وانتزع الخلافات التي كانت بينهما وشكّلهما من جديد من فوق بالنار والماء وليس بالماء والتراب.
- ” إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا، صَانِعًا سَلاَمًا“، صانعًا سلامًا لكليهما مع الله، ومع بعضهما البعض.
- ” فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ” أي في جسده… إذ تحمل هو العقوبة المستحقة.
- ” بِالصَّلِيبِ، قَاتِلاً الْعَدَاوَةَ بِهِ“، لا توجد كلمات حاسمة وقوية أكثر من هذا، إذ يقول الرسول أن موته قتل العداوة. لقد جرحها وقتلها، لا بتكليفه آخر ليعمل ذلك، ولا خلال عمله فقط وإنما خلال ألمه. لم يقل “حل العداوة” أو “أبطلها” بل ما هو أقوى: “قتلها”، حتى لا تقوم ثانية… مادمنا ثابتين في جسد المسيح ومتحدين معه، لا تقوم العداوة بل تبقى ميتة[17].
القديس يوحنا الذهبي الفم
إن كان السيد المسيح قد دفع ثمن هذه المصالحة في جسده المبذول عنا، فإنها مصالحة مفرحة ومبهجة للكل، لذلك يقول الرسول: “فَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلاَمٍ، أَنْتُمُ الْبَعِيدِينَ وَالْقَرِيبِينَ” ]١٧[.
وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لم يرسل المسيح إلينا هذه الأخبار (المفرحة) على يد آخر، ولا أعلنها لنا خلال الغير، وإنما جاء بشخصه. لم يرسل ملاكًا ولا رئيس ملائكة ليتمم هذا الأمر… بل كان الأمر يستدعي مجيئه[18].]
جاء بنفسه ليبشر الكل – البعيدين والقريبين – لا بكلمات سلام، وإنما أيضًا بعمل سلام… هذه البشرى نظرها إشعياء النبي من بعيد خلال ظلال النبوة، فقال: “سلام سلام للبعيد وللقريب، قال الرب وسأشفيه” (إش ٥٧: ١٩).
المصالحة التي تتم بين الفريقين تحققت بالصليب في جسد المسيح. لكن للآب والروح القدس دورهما الإيجابي في هذا العمل. إذ يقول الرسول: “لأَنَّ بِهِ لَنَا كِلَيْنَا قُدُومًا فِي رُوحٍ وَاحِدٍ إلي الآبِ” ]١٨[. إنه نص ثالوثي قوي، حيث يعلن الرسول أنه خلال تجسد الابن اقترب البشر إلي الآب بفعل الروح القدس. بمعنى آخر المصالحة هي: اقتراب للآب، خلال الابن المتجسد، وذلك في الروح.
تمتع الأمم بعمل الثالوث القدوس، فنزعت عنهم الغربة القديمة وصاروا مع اليهود رعية أهل بين الله، إذ يقول: “فَلَسْتُمْ إِذًا بَعْدُ غُرَبَاءَ وَنُزُلاً، بَلْ رَعِيَّةٌ مَعَ الْقِدِّيسِينَ وَأَهْلِ بَيْتِ اللهِ” ]١٩[. كان الأمم واليهود طفلين غريبين ضمهما السيد المسيح في جسده بروحه القدوس في أخوّة ليصيرا ابنين للآب من “َأَهْلِ بَيْتِ اللهِ“، ليس لأحدهما فضل على الآخر.
صار للأمم – بعد قبلوهم الإيمان بالمسيح – ذات حقوق اليهود، إذ دخلوا في بناء الكنيسة الجامعة التي أساسها الرسل والأنبياء وحجر زاويتها السيد المسيح. بمعنى آخر لم يعد أنبياء العهد القديم، ولا رسل العهد الجديد، ولا المسيح نفسه، حكرًا على أمة اليهود دون غيرهم.
يقول الرسول:
“مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ،
الَّذِي فِيهِ كُلُّ الْبِنَاءِ مُرَكَّبًا مَعًا يَنْمُو هَيْكَلاً مُقَدَّسًا فِي الرَّبِّ.
الَّذِي فِيهِ أَنْتُمْ أَيْضًا مَبْنِيُّونَ مَعًا،
مَسْكَنًا لِلَّهِ فِي الرُّوحِ” [٢٠ – ٢٢[.
لقد تحقق باليهود كما بالأمم بناء روحي واحد أساسه الرسل والأنبياء، يربطهما معًا حجر الزاوية السيد المسيح، الذي فيه تحققت نبوات العهد القديم وباسمه تتم كرازة العهد الجديد.
إن كانت أورشليم العليا في حقيقتها هي “مسكن الله مع الناس” (رؤ ٢١: ٣)، فقد شاهد القديس يوحنا أسماء الرسل الإثني عشر مكتوبة على أساساتها (رؤ ٢١: ١٤) وأسماء الإثني عشر سبطًا على أبوابها (رؤ ٢١: ١٢).
في أكثر من موضع يشرح لنا القديس أغسطينوس دور السيد المسيح كحجر الزاوية الذي ربط اليهود مع الأمم في بناء واحد، كحائطين ذوي اتجاهين مختلفين التحما معًا. فمن كلماته: [حدث في ذلك اليوم الذي هو يُدعى ميلاده رآه الرعاة اليهود، بينما في هذا اليوم يليق أن يُدعى “الظهور الإلهي” أي “الإعلان” سجد له المجوس الأمميون… حقًا لقد وُلد كحجر زاوية للاثنين، وكما يقول الرسول: “لِكَيْ يَخْلُقَ الاثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا، صَانِعًا سَلاَمًا، وَيُصَالِحَ الاثْنَيْنِ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ مَعَ اللهِ بِالصَّلِيبِ” ]١٥-١٦[.
ما هو حجر الزاوية إلاَّ ربط حائطين ذوي اتجاهين مختلفين، وكأنهما يتبادلان القبلة! المختونون مع غير المختونين، أي اليهود مع الأمم، اللذان كانا يحملان عداوة مشتركة، ولهما أمور أساسية تعزلهما عن بعضهما البعض، فاليهود كانوا يعبدون الله الواحد الحق، والأمم كانوا يعبدون آلهة كثيرة باطلة. الأولون كانوا قريبين والآخرون كانوا بعيدين. لقد قاد الفريقين إلي نفسه، ذاك الذي صالحهما مع الله في الجسد الواحد، وكما قال نفس الرسول: وذلك بالصليب قاتلاً العداوة[19].]
يرى القديس أغسطينوس[20] أنه بدعوة السيد المسيح رأس الزاوية، وهو رأس الكنيسة، بهذا تكون الكنيسة هي الزاوية التي ضمت اليهود من جانب والأمم من الجانب الآخر.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [ما هو هدف هذا البناء؟ لكي يسكن الله في هذا الهيكل. كل واحد منكم هو هيكل، وكلكم معًا هيكل. الله يسكن فيكم بكونكم جسد المسيح وهيكل روحي. لم يستخدم الكلمة التي تعني مجيئنا نحن إلي الله، بل ما يعني أن الله هو الذي يحضرنا إلي نفسه. فإننا لم نأت من تلقاء أنفسنا، بل الله هو الذي قرّبنا إليه. يقول المسيح: “ليس أحد يأتي إلي الآب إلاَّ بي”، وأيضًا: “أنا هو الطريق والحق والحياة” (يو ١٤: ٦)[21].]
[1] Dorotheos of Gaza: Comm.. on an Easter Hymn.
[2] Chaplet 3.
[3] In Eph. hom 4.
[4] Cassian: Conf. 3: 7.
[5] Comm. on Easter Hymn.
[6] Cassian: Conf. 5: 4.
[7] In Eph. hom 4.
[8] Ibid
[9] Of the Christian Faith 5: 178, 180, 181.
[10] In Eph. hom 3.
[11] Ibid 4: De Gompunct. PG 47: 408.
[12] Ser. on N.T. 81: 5.
[13] In Eph. hom 4.
[14] Ibid 5.
[15] Josephus: Antiq. 15: 11, 5; Jew War. 5: 52; 6: 2: 4.
[16] In Eph. hom 5.
[17] Ibid.
[18] Ibid 6.
[19] Hom for Epiphany, Ser. 204, PL 38: 1037.
[20] Ser on N.T. 39: 4.
[21] In Eph. hom 6.