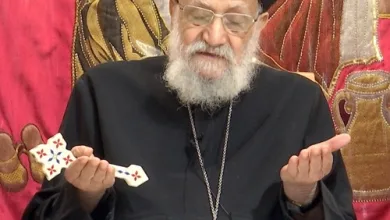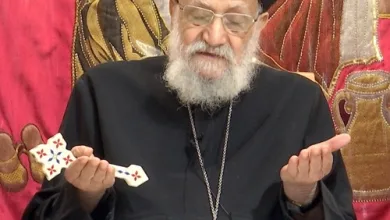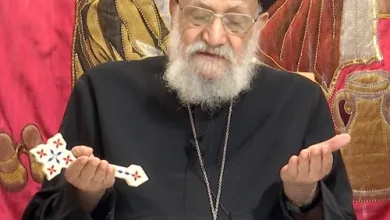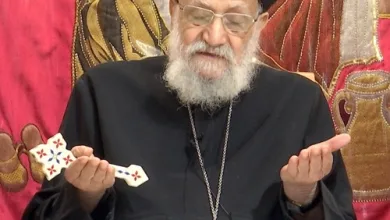تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 1 الأصحاح الأول - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الأول: روح القوة
إذ يكتب الرسول بولس من سجنه وصيته الوداعية لكل أولاده، خاصة الرعاة، في شخص تلميذه القديس تيموثاوس، وقد أحاطت الضيقة بالكنيسة بسبب ظلم نيرون. لهذا فإن النغمة الذي سادت الرسالة ككل هي “روح القوة” التي صارت لنا في المسيح يسوع غالب الموت. أما مفتاح السفر فهو: “لأن الله لم يعطنا روح الفشل (التهيب)، بل روح القوة والمحبة والنصح” (1: 7). هكذا يحيا الخادم بروح القوة في كرازته بالإنجيل، وفي خدمته وتشجيعه الخدام، وفي قبوله حب إخوته، كما في مناهضته للبدع والأضاليل:
1. الافتتاحية ١ – ٢.
2. تعلق الرسول بأولاده ٣ – ٧.
3. الكرازة بروح القوة ٨ – ١٢.
4. التمسك بالتعليم الصحيح ١٣ – ١٤.
5. مساندة أولاده له ١٥ – ١٨.
1. الافتتاحية
“بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله،
لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح،
إلى تيموثاوس الابن الحبيب.
نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا” [1-2].
تقاربت الافتتاحية هنا بتلك الخاصة بالرسالة الأولى، فهي موجهة من ذات الرسول إلى نفس المرسل إليه، وفي نفس البلد. ومع ذلك فقد وُجدت بعض الاختلافات التالية:
أ. في الرسالة الأولى يركز القديس بولس على أنه رسول بأمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح ليؤكد أن عمله الرسولي لا يقوم على إعلان بشري بل بمشيئة الله نفسه. أما هنا وإن كان قد أكد ذات الأمر، لكنه يركز عينيه على المكافأة الأبديّة، قائلاً: “لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح“. في الرسالة الأولى كان يجاهد في الخدمة متذكرًا أن الدعوة قد وُجهت إليه كأمر إلهي، وأن الله في محبته يلتزم، إن صح هذا التعبير، أن ينجح طريقه، أما هنا فقد أدرك أنه يسكب سكيبًا ووقت انحلاله قد حضر (٤: ٦). لهذا سُمرت عيناه على المكافأة التي طالما كان يترقبها. إنها تمتع بالمسيح يسوع نفسه بكونه الحياة (يو ١٠: ١)، فهو رجاؤنا ومكافأتنا!
إن كانت هذه الرسالة الوداعية تدور حول موضوع “روح القوة“، فإن سرّ القوة هو “الحياة” التي صارت لنا بدخولنا في المسيح يسوع حياتنا، لننعم به في كمال المجد على مستوى فائق. كأن الحياة التي ينتظرها كمكافأة ينعم بها هنا خلال الإيمان في عربونها، إذ ننال مسيحنا هنا بالإيمان أما هناك فننعم به وجهًا لوجه.
ب. يدعو الرسول بولس تلميذه: “الابن الحبيب“، فقد قاربت لحظات انتقاله ويخشى ألاَّ يراه. لذا كتب إليه بروح الحب والود ليكشف عن أعماق أحاسيسه الداخلية. ويرى القديس يوحنا الذهبي الفم في هذا اللقب: “الابن الحبيب” إعلانًا عن طاعة القديس تيموثاوس[1]، إذ كان للقديس أبناء كثيرون، لكن دعوته “الحبيب” تُقدم له على وجه الخصوص من أجل طاعته له كأبيه الروحي.
على أي الأحوال، إن كانت رسائل القديس بولس قد كشفت عن شخصيته من جهة جهاده وجديته وحزمه كما عن عمق مفاهيمه اللاهوتيّة، فإنها أبرزت أيضًا مشاعر الحب الفائقة! لقد عاش الرسول بولس محلقًا في السماويات على مستوى لا يُعبَر عنه، وفي نفس الوقت كإنسان واقعي يؤمن بتقديس الجسد بكل مشاعره وأحاسيسه وعواطفه في المسيح يسوع. إنه لا يكبت المشاعر الإنسانية بل يطلقها بطريقة روحية عالية. هذا ما ظهر بأكثر وضوح في ختام رسالته إلى أهل رومية كاشفًا عن مشاعر الحب التي تربطه بكثيرين بأسمائهم. وقد تحدث القديس يوحنا الذهبي الفم عن هذه المشاعر التي ملأت قلب الرسول في استطالة، نذكر منها:
[بولس هذا العجيب، الذي بذل لحمه، وأنكر جسده، الذي جال في كل الأرض يحمل نفسه وحدها (كأنها بلا جسد)، وقد ألقى عنه كل هوى، وتمثل بالقوات الروحية العلوية، وقطن في الأرض كما في السماء، وارتفع مع الشاروبيم، واشترك معهم في التسبيح السماوي واحتمل الآلام… بولس هذا عندما ابتعد عن نفس عزيزة عليه اضطرب وتكدر، حتى هرب من المدينة التي لم يجد فيها من كان يتوقع أن يراه هناك… لقد ترك ترواس لذات السبب إذ لم تقدر أن تقدم له صديقه: “ولكن لما جئت إلى تراوس لأجل إنجيل المسيح، وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحة في روحي، لأني لم أجد تيطس أخي، لكن وعدتهم فخرجت إلى مكدونية” (٢ كو ٢: ١٢).
ما هذا يا بولس؟ أنت الذي قُيدت … ودخلت السجن، وحملت آثار السياط، فكان ظهرك لايزال ينزف دمًا!… أنت الذي لم تحتقر إنسانًا واحدًا يحب أن يخلص، عندما بلغت ترواس ورأيت الأرض صالحة للزرع، ومستعدة للبذر، وكان الصيد كثيرًا وسهلاً، ألقيت من بين يديك هذا المكسب الهام الذي من أجله أتيت؟ تقول: “لأجل إنجيل المسيح“، بمعنى أنه لا يقف أحد في طريقك من أجل إنجيل المسيح، وتقول: “انفتح لي باب في الرب“، ومع هذا تهرب سريعًا؟
نعم، بالتأكيد سقطت تحت سطوة الحزن، فإن غياب تيطس قد آلمني كثيرًا. غلبني الحزن وسيطر عليّ حتى وجدت نفسي مضطرًا لهذا… الذين يحبون بعضهم بعضًا لا يكفيهم الارتباط بالنفس لتعزيتهم، بل هم محتاجون إلى وجودهم معًا بالجسد، وإن لم يوهبوا ذلك ينقصهم الكثير من سعادتهم[2].]
2. تعلق الرسول بأولاده:
في لحظات الصلب تجلت روح قوة ربنا يسوع المسيح حيث انكشف اهتمامه بكل البشرية، مقدمًا حياته فدية عن الجميع، طالبًا المغفرة حتى عن صالبيه، دون أن ينسى إعالة أمه فسلمها لتلميذه القديس يوحنا الحبيب أمًا له، وقدمه ابنًا لها. إنها مشاعر الحب الفائقة التي تعلو الألم حتى مرارة الصليب. هكذا تشبه الرسول بولس بمعلمه فحمل “روح القوة” الذي هو “روح المسيح”، الذي به وهو يدرك أنه ينسكب سكيبًا لا يوصي تلميذه عن أمورٍ خاصة بنفسه ولا يحدثه عن سجنه وآلامه، إنما في قوة يتحدث عن اهتمامه به بعمق، قائلاً: له: “إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلاً ونهارًا، مشتاقًا أن أراك، ذاكرًا دموعك لكي أمتلىء فرحًا” [٣-٤].
هكذا تبرز روح القوة بحق في حياة المؤمنين خلال اتساع قلبهم بالحب نحو إخوتهم وأولادهم الروحيين فلا يفكرون حتى في لحظات انتقالهم فيما هو لأنفسهم بل فيما هو للغير، مظهرين كل حبٍ وتعلقٍ بهم، ليس فقط خلال العمل الظاهر، وإنما أيضًا في الطلبات المستمرة لدى الله.
لعل الرسول بولس وهو يكتب إلى تلميذه مذكرًا إياه أنه نشأ في أحضان أم وجِدة تقيتين، عاد بذاكرته إلى أجداده هو أيضًا، إذ يقول: “الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر“، فهو إنسان لا ينكر الجميل. إن كان قد اضطهد كنيسة الله وافترى عليها مجدفًا على مسيحها الأمر الذي كان يردده كثيرًا، لكنه لا يتجاهل بركة آبائه اليهود الذين سلموا له الإيمان الحق إلى مجيء المسيا. يرى الرسول بقلبٍ متسعٍ في آبائه الجذور الصالحة لكرمة الله التي أثمرت في العهد الجديد بالمسيح يسوع.
ماذا يقصد الرسول بقوله: “بضمير طاهر“؟ حقًا كان الرسول مجدفًا ومفتريًا، لكنه حتى في هذا لم يكن سييء النية، إنما ظن أنه يخدم الله، مشتهيًا أن يعمل بضمير صالح طاهر. وقد صار له هذا الصلاح أو تلك الطهارة بالأكثر عندما التقى بالقدوس، وتمتع بالإتحاد معه في المسيح يسوع ربنا. لهذا بكل جرأة يقول: “إني بكل ضمير صالح قد عشت إلى هذا اليوم” (أع ٢٣: ١)، كما يعلن أنه يدرب نفسه كل يوم ليكون له ضمير بلا عثرة (أع ٢٤: ١٦). يقصد الرسول بولس بهذا “الضمير” الحياة الداخلية التي تحمل انعكاسًا على تصرفاته الظاهرة. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [يتحدث هنا عن حياته التي بلا لوم، ففي كل موضع يدعو حياته ضميره[3].]
ومما استرعى انتباه القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول يعتبر مجرد تذكره لتلميذه فيطلب عنه بلا انقطاع هو عطية إلهيّة يقدم عنها ذبيحة شكر!
طلبات الرسول غير المنقطعة ليلاً ونهارًا من أجل تلميذه لكي يهبه الرب نجاحًا في حياته الروحية وفي خدمته، هي جزء لا يتجزأ من حياة الرسول بولس نفسه بكونها إعلانًا عن اتساع قلبه لإخوته وأولاده، وجزء لا يتجزأ عن عمله الكرازي وخدمته. فإنه لا يكفي الكرازة بالفم والقدوة فحسب، وإنما تلزم الصلاة الدائمة من أجل كل خادمٍ ومخدومٍ. هذا هو سرّ قوة الرسول بولس وقوة أولاده الروحيين!
أقول بصدق ما أحوج العالم كله في هذا العصر إلى رجال صلاة حقيقيين متسعي القلب ومملوءين إيمانًا بالله العامل في خدامه! كرازة بلا صلاة هي خدمة جوفاء، وعمل بشري لا يدوم!
أخيرًا، فإن الرسول بروح القوة المعلنة خلال الحب يكشف عن شوقه العميق أن يراه، وكما قلت قبلاً إنه يرى في المشاعر الإنسانية الرقيقة تقديسًا فلا تُكبت أو تُكتم أنفاسها. إن منظر تلميذه وهو يبكي عند فراق الرسول أو عند سجن الرسول لا يفارق عينيه قط، إذ يقول: “مشتاقًا أن أراك، ذاكرًا دموعك لكي أمتلىء فرحًا“. لقد امتلأت حياة الرسول والملاصقين له بالعواطف المقدسة، فيسكبون الدموع عند مفارقته لهم (أع ٢٠: ٣٧، ٣٨؛ ٢١: ٣١)، ويعلن هو عن شوقه إلى كل أولاده: “فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح” (في ١: ٨).
“وأما نحن أيها الإخوة فقد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم…” (١ تس ٢: ١٧-١٨). ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على العبارة الأخيرة هكذا: [ماذا تقول: أنت الإنسان الكبير والعظيم؟ أنت الذي صُلب العالم لك وأنت للعالم (غل ٩: ٢٤)، أنت الذي تركت كل ما هو جسدي، أنت الذي كمن هو بلا جسد، بلغت هذه الدرجة من العبودية في الحب حتى اندفعت بهذا الجسد الترابي – المصنوع من الطين – الذي تراه؟ يجيب: نعم، إني لا أخجل من أن أعترف بذلك، بل أفتخر، إذ أحمل داخلي محبة عظيمة، هي أم كل الفضائل[4].]
لا يقف الرسول بولس عند هذه العواطف مجردة إنما يستخدمها بالروح القدس لحث أولاده على الجهاد بروح القوة، إذ يقول: “إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولاً في جدتك لوئيس وأمك افنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضًا. فلهذا السبب أُذَكِّرُك أن تُضرِم موهبة الله التي فيك بوضع يدي. لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح” [٥–٧].
يدفعه الرسول للعمل بروح القوة والحب والمشورة، مذكِّرًا إياه بثلاثة أمورٍ: علاقته بأسرته، علاقته بالرسول، علاقته بالله.
أولاً: من جهة أسرته فالقديس تيموثاوس مدين لجدته وأمه بالإيمان الحيّ عديم الرياء الذي تسلمه منذ الطفولة. هذا هو ما يفرح قلب الرسول يرى العائلات المقدسة كنيسة حيّة يتربى فيها أولاد الله على الإيمان الحيّ، فيتسلمون الحق كسرّ حياة يمارسونها كل يوم وليس معرفة نظرية أو شكليات في العبادة. يقول القديس يوحنا: “فرحت جدًا لأني وجدت من أولادك بعضًا سالكين في الحق” (٢ يو ٤). وكتب القديس چيروم إلى لئيتا يرشدها في تربية ابنتها جاء فيها: [كوني مدرسة لها، نموذجًا لما تريدين أن تكون عليه في طفولتها… لا تفعلي أنتِ أو والدها شيئًا مما إذا قلدتكما فيه تكون قد ارتكبت خطية… بسيرتكما تعلماها أكثر مما تعلمانها بوصاياكما[5].]
أما قوله عن الإيمان المُسَلَّم إليه من عائلته أنه “عديم الرياء“، فإن الكلمة اليونانية لها تستخدم في اختبار السوائل على ضوء الشمس لتظهر إن كانت نقية بلا شوائب. وكأن الرسول بولس يقول له: لقد اختُبِرَ إيمان عائلتك على ضوء السيد المسيح شمس البرّ، فوُجِدَ نقيًا بلا شوائب؛ إيمان غايته خلاص النفس والتمتع بالله لا الظهور أمام الناس لأجل كلمة مديح.
نستطيع أن نقول أن البيوت المقدسة بحقٍ، المؤمنة بغير رياء، الملتهبة بنار الحب الحقيقي تقدِّم للأبناء إمكانيّة حياة مع الله، تسندهم في شبابهم بل حتى في مماتهم. أما البيوت الحاملة صورة التقوى بلا حب حقيقي، فهي تقدم صورة سيئة للأبناء تجعلهم ينفرون من الإيمان ويكرهون الحق أكثر من الذين نشأوا في بيوت مملوءة شرورًا. فالطفل قادر على إدراك ما في قلبي والديه ومعرفة صدق إيمانهما أو ريائهما!
ثانيًا: من جهة علاقته به يقول: “أُذَكِّرَك أن تُضرِم موهبة الله فيك بوضع يدي“. إن كنت قد وضعت يدي عليك لتتقبل موهبة الكهنوت والرعاية، فإن علاقتي بك الملتهبة نارًا إنما هي في الرب النار المقدسة. محبتك لي تظهر في إشعالك أو إضرامك لهذه النار الإلهيّة بالتجاوب مع عمل الروح القدس الناري الساكن فيك. هنا يرفع الرسول مستوى العلاقة بينهما إلى الالتقاء في الرب، لكي يحثه على العمل بلا انقطاع، إذ موهبة الله المجانيّة لا تُضرَم في حياة الرعاة الكسالى بل العاملين.
وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [كما تحتاج النار إلى وقود، هكذا تتطلب النعمة نشاطنا لكي تكون دائمة الحرارة، “أُذَكِّرَك أن تُضرِم موهبة الله التي فيك بوضع يدي“، أي نعمة الروح التي تقبلتها لكي تدبر الكنيسة وتعمل المعجزات وتقوم بكل خدمة. ففي مقدورنا أن نُلهب هذه النعمة أو نُطفئها، لهذا يقول في موضع آخر: “لا تطفئوا الروح” (١ تس ٥: ١٩). فبالخمول والإهمال تنطفىء، وبالسهر والاجتهاد تبقى حيّة. حقًا إن الموهبة فيك، فلتلهبها أي املأها ثقة وفرحًا وبهجة، وكن رجلاً[6].]
ثالًثا: علاقته بالله: إن كانت علاقته بأسرته هي في الرب، وأيضًا علاقته مع الرسول في الرب، فإن الرب نفسه يهبه أيضًا روح القوة والحب والنصح، وليس روح الفشل (التهيب). وكأن الرسول بولس يسند تلميذه بالتطلع إلى الله نفسه لا الظروف المحيطة به فلا يخاف ولا يتهيب بالفشل بل يمتلىء قوة وحبًا ونصحًا. أما الظروف المحيطة فيمكننا تلخيصها في العبارات التالية:
أ. حداثة سنه مع كبر المسئولية، ففي الرسالة السابقة قال له: “لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة” (١ تي ٤: ١٢).
ب. سجن الرسول بولس، وربما علم القديس تيموثاوس بكل ما لحق الرسول من أتعاب أثناء السجن.
ج. شعوره بالفراغ الذي يتركه الرسول برحيله من العالم.
د. وجود مقاومين من المتهودين وأصحاب البدع الغنوسية المفسدة للإيمان المسيحي.
إنه يشجعه على العمل لا بروح الخوف والتهيب، وإنما بروح القوة القادرة على مواجهة المتاعب، وروح الحب القادر على البذل والعطاء، وروح النصح القادر على التمييز بحكم سليم في غير تهور أو تطرف. هذه هي عطايا الروح القدس الذي يهب المؤمنين خاصة الرعاة سلطانًا أن يدوسوا بقوة على الحيات والعقارب وكل قوة العدو، فيخدموا بروح الشجاعة لكن ليست الشجاعة الجسدية المظهرية، ولا القوة التي بالمفهوم البشري، لذا رافقها بالحب.
فالقوة هنا هي قوة الله الملهبة للقلب بالحب نحو كل إنسان. ويرافق الحب “النصح“، فالراعي في محبته يلزم أن يكون حكيمًا وناصحًا. ولعله قصد بالنصح روح المشورة، فلا يخدم الراعي بفكرٍ انفراديٍ منعزلٍ، إنما يسلك بروح الكنيسة الجماعي طالبًا المشورة، أيًا كان مركز الراعي أو درجته الكهنوتية. هذا ما نلاحظه في الرسول بولس نفسه الذي وهو يؤمن أنه مفرز من بطن أمه للعمل الرسولي، وأن الابن الوحيد نفسه أعلن ذاته له (غل ١: ١٦)، إذا به يعرض إنجيله الذي يكرز به بين الأمم على المعتبرين، لئلا يكون قد سعى باطلاً (غل ٢: ٢).
يهب الله بروحه القدوس خدامه روح القوة للعمل بلا تخوف، بينما الأشرار “تقع عليهم الهيبة والرعب” (خر ١٥: ١٦). يغرس الله في أولاده الشجاعة الروحية، ويترك الرعب يفسد قلوب الأشرار. ويعطي مع القوة روح الحب، فيدرك الخدام حب الله ليتسع قلبهم بالحب نحوه ونحو كل البشرية. فيرافق القوة لطفًا وحنانًا، أما الذي يقدم توازنًا بين القوة والحب فهو روح النصح والتمييز، حيث يعرف الخادم الشجاعة دون فقدان اللطف، واللطف دون الحرمان من الشجاعة؛ أو هو روح النصح الذي يعني روح المشورة المتبادلة بين الخدام وبعضهم البعض الذي يهب الخادم اتزانًا في عمله وخدمته.
3. الكرازة بروح القوة
إذ يحمل الراعي روح القوة والحب والنصح، يكرز بإنجيل المسيح بغير خجلٍ. لذا يقول الرسول: “فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل، بحسب قوة الله الذي خلصنا، ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أُعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزليّة” [٨-9].
يوصيه الرسول أن يخدم الله ويشهد للإنجيل وسط الآلام، أما سرّ القوة فيكمن في الصليب، الذي هو سرّ خلاص البشرية، وسرّ تقديسنا. على الصليب شهد ربنا يسوع المسيح للحب الإلهي، متممًا المقاصد الأزلية، وخلال الصليب دخل الرسول إلى الأسر شاهدًا لمحبته للمصلوب. وكأن الرسول يحث تلميذه ألاَّ يكرز بحماسٍ بشريٍ أو غيرةٍ إنسانيّةٍ، وإنما خلال تمتعه بقوة الصليب.
رأينا في دراستنا السابقة كيف أفسد بعض الغنوسيين نفوس البعض، إذ انحرفوا بهم عن الإيمان إلى المعرفة المجردة كعلة خلاص. فصار الإيمان بالنسبة لهم مباحثات مجردة ومناقشات غبية بلا هدف، سوى الوصول إلى المعرفة الذهنية بمجهودهم الذاتي، متجاهلين قوة الإيمان بالصليب كسرّ حياة المؤمنين وخلاصهم وتقديسهم[7]. هذا ما دفع الرسول لإبراز عمل الصليب كسرّ شهادة يسوع المسيح نفسه عن الحب الإلهي الأزلي نحو الإنسان، وسرّ خلاص البشريّة وتقديسها.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا النص، قائلاً:
[ليس شيء أشر من أن يقيس الإنسان الأمور الإلهيّة ويحكم عليها خلال المباحثات البشريّة (كالغنوسي)، فإنه بهذا يسقط من صخرة (الإيمان) إلى مسافة بعيدة، ويُحرم من النور. فمن أراد أن يبصر أشعة الشمس بعينيه البشريتين ليس فقط لا يعاينها، وإنما يصيبه ضررًا جسيمًا. هكذا وبصورة أشد من يفعل هذا مفسدًا عطية الله بتطلعه إلى النور (الإلهي) خلال بصيرة المباحثات البشريّة.
لاحظ كيف أدخل مرقيون وماني وفالنتينوس وغيرهم هرطقاتهم وتعاليمهم المهلكة إلى كنيسة الله، إذ يقيسون الأمور الإلهيّة بقياس المباحثات البشريّة، فصاروا في خجل من جهة التدبير الإلهي.
وإنني إذ أتحدث عن صليب المسيح أقول أنه ليس موضوع خجل، بل بالحري موضوع مجد! فإنه ليس من علاقة عظيمة هكذا تكشف عن محبة الله للبشر مثل الصليب. فلا السماء ولا البحر ولا الأرض ولا خلقة هذا كله من العدم ولا شيء آخر مثله!
هنا مجد الرسول: “حاشا لي أن أفتخر إلاَّ بصليب ربنا يسوع المسيح” (غل ٦: ١٤). أما الطبيعيون فيتعثرون فيه ويخجلون منه… من البداية يحث الرسول تلميذه، ومن خلاله يحث الآخرين، قائلاً: “لا تخجل بشهادة ربنا”، أي لا تخجل من الكرازة بالمصلوب بل بالحري تتمجد فيه. فالموت والسجن والسلاسل هذه كلها أمور مخجلة في ذاتها وعار، لكن إن أُضيف إليها السبب ظهر السرّ واضحًا فتصبح أمورًا مجيدة وموضوع افتخار.
إنه الموت الذي خلص العالم ويبيد الموت ذاته!
إنه الموت الذي ربط الأرض بالسماء، محطم قوة الشيطان، وجعل البشر ملائكة وأبناءً لله، وأقام طبيعتنا إلى العرس الملوكي[8].]
هذا هو “روح القوة“، أن ننعم بالصليب الذي يبيد الموت المهلك ويهبنا الحياة السماوية. فلا نخجل منه، بل نقبله عمليًا في حياتنا، ونشترك في احتمال المشقات من أجله. هذا ما يعلنه الرسول لتلميذه، مقدمًا نفسه مثلاً حيًا، إذ صار أسيرًا للرب المصلوب.
يتحدث القديس يوحنا الذهبي الفم على لسان الرسول، قائلاً: [لا تخجل، فإنني أنا الذي أقمت موتى، وصنعت معجزات، وحولت العالم إلى الإيمان، قد صرت أسيرًا، لكنني لست أسيرًا كصانع شر بل أنا أسير من أجل المصلوب. إن كان ربي لم يخجل من الصليب فلا أخجل أنا من السلاسل… إن كان ربنا وسيدنا قد احتمل الصليب فيليق بنا بالحري أن نُربط بالسلاسل. من يخجل مما احتمله السيد (الصلب والسلاسل) إنما يخجل من المصلوب نفسه. الآن، فإنني لا أحتمل هذه السلاسل لحساب نفسي، فلا تستسلم للمشاعر البشريّة، بل بالحري احتمل نصيبك من هذه المشقات[9].]
ولئلا يظن القاريء أن احتمال المشقات في ذاته هو ثمن خلاصنا وتقديسنا أكد الرسول أننا مدينون في ذلك للمقاصد الإلهيّة والنعمة المجانيّة، إذ يقول: “لا بمتقضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أُعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزليّة” [٩]. حقًا إن الصليب واشتياقنا للخلاص وقبولنا للدعوة الإلهيّة هذا كله يدفعنا لاحتمال مشقات الصليب عمليًا، لكن ليست هذه المشقات هي ثمن لهذه العطايا، إنما سرّ القوة يكمن في عمل الله نفسه لخلاصنا وتقديسنا: “لأن الله هو العامل فيكم، أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مسرته” (في ٢: ١٣).
ظهرت المراحم الأزليّة والتدابير الإلهيّة في المسيح يسوع الذي ظهر في ملء الزمان مصلوبًا لخلاصنا، إذ يقول الرسول: “وإنما أُظهِرَت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جُعلت أنا له كارزًا ورسولاً ومعلمًا للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضًا، لكنني لست أخجل لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم“ [١٠-١١].
هكذا يؤكد الرسول أن ظهور مخلصنا يسوع المسيح وتقديمه الإنجيل خلال صليبه هو سرّ قوتنا وينبوع النعمة الإلهيّة المجانيّة القادرة على خلاصنا من الموت وتقديم الحياة والخلود لنا. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [ها أنت ترى القوة، ترى العطيّة الممنوحة لنا لا بالأعمال وإنما خلال الإنجيل!
هذا هو موضوع الرجاء، الذي تحقق في جسده (بالصليب)؛ وكيف يتحقق فينا؟ بالإنجيل[10].] في جسده كسر شوكة الموت عنا (١ كو ١٥: ٢٦) بحمله الصليب، وفتح أعين بصيرتنا الداخلية للتمتع بالنور والحياة الخالدة خلال قبولنا الإنجيل. في موضع آخر يؤكد الرسول أن ابادة الموت هو غاية ظهوره، إذ يقول: “فإنه إذ قد تَشَارَك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضًا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفًا من الموت كانوا جميعًا كل حياتهم تحت العبودية” (عب ٢: ١٤-١٥).
هذا هو ما دفع الرسول بولس أن يحمل روح القوة في كرازته وتعليمه الإنجيل بين الأمم، محتملاً المشقات كسيده، قائلاً: “الذي جُعلت أنا له كارزًا ورسولاً ومُعلمًا للأمم“.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لماذا يكرر هذا ملقبًا نفسه رسول الأمم؟ لأنه يود أن يقتفوا أثاره، ويلتصقوا هم أيضًا بالأمم! لا يرتاعوا من مشقات (الإنجيل) فقد تراخت أوتار الموت. إنه لا يتألم كفاعل شرٍ، وإنما كمعلم للأمم[11].]
هكذا يقدم الرسول بولس نفسه مثالاً لاحتمال الآلام من أجل الكرازة بغير خجل، قائلاً: “لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضًا لكنني لست أخجل“. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [ها أنت ترى كيف يوضح تعليمه بأعماله، قائلاً: “أحتمل هذه الأمور“. “لقد أُلقيت في ذلك اليوم” ما هي هذه الوديعة؟ إنها الإيمان والكرازة بالإنجيل. الله الذي أودعه هذه يحفظها مصونة. إنني أحتمل كل شيء حتى لا أفسد الكنز، وإنني لا أخجل من هذه الأمور ما دامت محفوظة لا يصيبها ضررًا. ولعله يقصد بالوديعة المؤمنين أنفسهم الذين عهد الله بهم إليه، أو عهد هو بهم لدى الله، قائلاً: “والآن أستودعكم الله” (أع ٢٠: ٣٠)… إنه يستودع ثمر الوديعة بين يدي تيموثاوس[12].]
حقًا يظهر الرسول بولس مثلاً حيًا للمعلم الذي يحفظ الوديعة – سواء الإيمان الحق أو المؤمنين أنفسهم – وذلك لاحتماله المشقات المستمرة وتسليمها لتلاميذه ليسلكوا بنفس روحه، حاملين المشقات من أجل الوديعة. وكأن الرسول بولس يقدم لنا نفسه مثلاً حيًا للراعي الأمين، لا في حفظ الوديعة فحسب، وإنما في قدرته على تلمذة أناس قادرين أن يكملوا عمله، سالكين ذات منهجه في حفظ الوديعة باحتمالهم الآلام.
هذا ويلاحظ أن الرسول وهو يتكلم هنا عن المشقات لا يدفع نفسه إليها دفعًا، لكنه متى وُجدت يحسبها مجدًا له. كما جاءت كلمة “يحفظ” في اليونانية كتعبير عسكري يعني “الحماية الكاملة”. هذه هي إحساسات المؤمن الحقيقي، أنه تحت الحماية الإلهيّة الكاملة، إذ يقوم الله بحفظ مؤمنيه في وديعة إيمانهم، مما يعطي الخادم طمأنينة ورجاءً. يقول القديس بطرس: “فإن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالقٍ أمينٍ في عمل الخير” (١ بط ٤: ١٩).
- التمسك بالتعليم الصحيح
“تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني،
في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع.
احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا“[١٣-١٤].
طبع الرسول على قلب تلميذه صورة حيّة لوديعة الإيمان سواء من جهة العقيدة “الكلام الصحيح” أو من جهة السلوك “المحبة“. لقد نقش في نفس تلميذه نسخة من دستور الإيمان والخطوط العريضة للحياة العمليّة، فصار التلميذ نفسه أشبه بنسخة حيّة وفعَّالة للإيمان المُسَلَّم عبر الأجيال. هذا هو التسليم الحيّ أو التقليد. إنه تمسك بالإنجيل العملي، معلنًا في حياة الرعاة والرعيّة، ليعبر من جيل إلى جيل كحياة في المسيح يسوع ربنا.
كيف نتمسك بالوديعة ونحفظها؟ “بالروح القدس الساكن فينا[13]“. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [ليس في قدرة نفس بشريّة أن تحفظ أمورًا عظيمة كهذه؛ لماذا؟ لأنه يوجد لصوص كثيرون يتربصون لها، وظلمة كثيفة وشيطان على الأبواب يدبر خططًا ضدها! كيف إذن يمكننا أن نحفظها؟ بالروح القدس؛ بمعنى إن كان الروح ساكنًا فينا، إن كنا لا نطرد النعمة فيسقف (الله) معنا. فإنه “إن لم يبن الرب البيت فباطلاً يتعب البناءون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلاً يسهر الحراس“ (مز ١٢٧: ١). هذا هو حصننا، هذه هي قلعتنا هذا هو ملجأنا! إن كان الروح ساكنًا فينا وهو حارسنا، فما الحاجة للوصية؟ لكي نتمسك بالروح ولا نجعله يهجرنا[14].]
- مساندة أولاده له:
لقد هجر البعض الرسول وهو في السجن في اللحظات الحرجة، واعتبر الرسول هذا التصرف نوعًا جديدًا من المشقات التي يحتملها من أجل السيد المسيح، بينما يقف البعض بجواره. كان هذا التصرف منقوشًا في قلب الرسول الرقيق المشاعر، فهو يصلي من أجلهم حتى يكافئهم بالسماويات.
“أنت تعلم هذا أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني،
الذين منهم فِيجَلُّس وهَرموجانِس.
ليُعطِ الرب رحمة لبيت أُنيسيفورُس،
لأنه مرارًا كثيرة أراحني، ولم يخجل بسلستي،
بل لما كان في رومية طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني.
ليُعطِه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم.
وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدًا” [١٥–١٨].
قدم الرسول لتلميذه مثالاً للذين هجروه وقت آلامه، وهم “جميع الذين في آسيا“، هؤلاء الذين كانوا في روما وقد ارتدوا عنه. وقد قصد بآسيا هنا الولاية الرومانيّة في آسيا الصغرى، والتي كانت عاصمتها أفسس. هؤلاء الذين من آسيا إمّا أنهم وُجدوا في روما أثناء سجنه، أو جاءوا معه إليها كما فعل ديماس (٤: ١٠).
كان الرسول في سجنه محتاجًا إلى محبتهم وخدمتهم لكنهم قدموا جفافًا عوض الحب، بل استغلوا سجنه لعمل انشقاق في الكنيسة وإثارة هياج ضده، أو لعلهم خافوا من نيرون، فخجلوا من بولس السجين. على أي الأحوال، كان تصرفهم هذا صليبًا حمله الرسول بقوة من أجل الإنجيل. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [أشار الرسول إلى سلوكهم دون أن يلومهم، إنما مدح ذاك الذي أظهر حنوًا، طالبًا له آلاف البركات لكي تحل عليه[15].]
لقد طلب رحمة لبيت أُنيسيفورُس[16]، وهو ابن للقديس بولس في الإيمان، قَبِلَ الإيمان على يديه في أيقونيّة، عمل كتاجر في أفسس، وقد أراح الرسول أثناء سجنه، ربما اهتم بتضميد جراحاته، أو قام بزيارته مرارًا في السجن، مُعَرِّضًا حياته للخطر.
يرى غالبية المفسرين أن أُنيسيفورُس كان قد انتقل من العالم في ذلك الحين، وقد طلب الرسول أن يجد رحمة لدى الله في يوم الرب العظيم. وقد أُخذ هذا النص كمثال للصلاة من أجل الراقدين. فنطلب لهم الراحة لا بمعنى أن الصلاة عنهم تسند الأشرار غير التائبين، وإنما نطلب عنهم من أجل أي توانٍ أو تفريط سقط فيه المؤمنون. لهذا تصلي الكنيسة في أوشيّة (صلاة) الراقدين، هكذا: [إن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدًا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالحٍ ومحبس البشر، اللهم انعم لهم بغفران خطاياهم.] وقد حوت جميع القداسات الرسوليّة صلوات عن الراقدين.
يقول القديس ديوناسيوس الأيوباغى: [إن كانت خطايا المتوفي حقيرة فتجد منفعة مما يعمل بعده، وإن كانت باهظة ثقيلة فقد أغلق الله الباب في وجهه[17].]
ويقول القديس أغسطينوس: [تُقدَّم القداسات من أجل المؤمنين المنتقلين، فإن كانوا صالحين تُدعى شكرًا، وإن كانوا أشرارًا فلا تفيدهم شيئًا، ولكنها تكون تعزية للأحباء[18].]
يقول القس روبرتسون: [يقينًا أن أُنيسيفورُس كان ميتًا عندما كتب بولس الرسول هذه الكلمات التي تعتبر دليلاً معقولاً على أن موت أي شخص لا يحرمنا من الحق أو الواجب للصلاة عنه، ويقينًا أن أمثال هذه الصلاة من أجل الموتى توجد في قداسات العصور المسيحية الأولى، وهي إلى الآن تكون جزءًا من القداسات المستخدمة في جزء كبير من العالم المسيحي[19].]
[1] In 2 Tim. hom 2.
[2] Ep. 2: 10 (ترجمة مدام عايدة حنا بسطا)
[3] in 2 Tim. hom 1.
[4] Ep. 2: 10.
[5] للمؤلف: الحب الأخوي، ١٩٦٤، ص ٢٨٧..
[6] In 2 Tim. hom 1.
[7] للمؤلف: رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، ١٩٨٢، ص ١١.
[8] In 2 Tim. hom 2.
[9] In 2 Tim. hom 2.
[10] In 2 Tim. hom 2.
[11] In 2 Tim. hom 2.
[12] In 2 Tim. hom 2.
[13] لدراسة سكنى الروح القدس فينا، وهل هو يهجرنا أم لا، راجع مقال: “لا تطفئوا الروح” للقديس مار فيلوكسينوس.
[14] In 2 Tim. hom 3.
[15] In 2 Tim. hom 3.
[16] اسم يوناني يعني “يجد راحة”.
[17] القس مرقس داود: تفسير رسالتي بولس الرسول الأولى والثانية إلى تيموثاوس (لمتى هنري)، ١٩٧٥، ص ١٣٠.
[18] القس مرقس داود: تفسير رسالتي بولس الرسول الأولى والثانية إلى تيموثاوس (لمتى هنري)، ١٩٧٥، ص ١٣٠.
[19] Rev. Robertson: The Expostior’s Bible, p. 324–9.