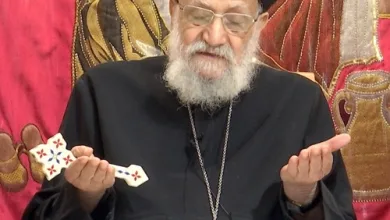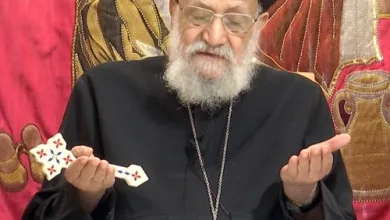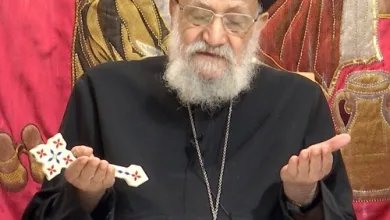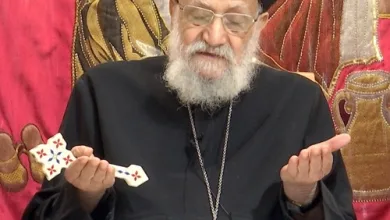تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 6 الأصحاح السادس – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 6 الأصحاح السادس - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 6 الأصحاح السادس – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 6 الأصحاح السادس – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح السادس العلاقات الاجتماعية
بعد أن تحدث عن التنظيمات الكنسية موضحًا علاقة الراعي بفئات الشعب من شيوخ وأحداث وعجائز، ومسئولية الكنيسة نحو الأرامل والكهنة، وسيامة الكهنة الخ. يقدم لنا الرسول صور حية عن العلاقات الاجتماعية خاصة بين العبيد والسادة في الرب.
- وصايا للعبيد ١ – ٢.
- الاهتمام بالجانب العملي ٢ – ٥.
- توجهيات للأغنياء ٦ – ١٩.
- وصية ختامية ٢٠ – ٢٢.
1. وصايا للعبيد
يقدم الرسول الخطوط العريضة لتلميذه في توجيهاته للعبيد كما للسادة الأغنياء لكي تكون خدمته عملية ومثمرة، بعيدة عن المماحكات الكلامية الباطلة. “جميع الذين هم عبيد تحت نير، فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام، لئلا يُفتري على اسم الله وتعليمه” [1].
اهتم الرسول في كتاباته بالعبيد الذين قبلوا الإيمان المسيحي، مقدمًا لهم وصايا يلتزمون بها كما قدم للسادة المسيحيين وصايا تجاه العبيد. إن كان الرسول لم يقم بثورة علنية ضد نظام العبيد، لكنه بالحب والإيمان كان يهدم النظام من جذره. لقد رفع من معنوية العبد، وقدم له رسالة إيمانية خلال حياته التقوية حتى تجاه سيده القاسي.
يوجه الرسول حديثه إلي العبيد الذين هم “تحت النير”، وكأنه يعلن لهم أنه يتحدث معهم كمن يشعر بآلامهم وأثقالهم، ويدرك أنهم تحت نير، يتحدث خلال الواقع العملي لا الفكر الفلسفي النظري. حقًا ليس في مقدوره أن يرفع عنهم هذا النير، لكنه إذ يقدم لهم إمكانية الحياة الجديدة في المسيح يسوع يرفع نفوسهم فوق كل ما هو مادي أو نفسي. فلا يتطلع العبد إلى نفسه وهو تحت نير العبودية كمن هو في مذلة ومرارة، لكنه إذ يحمل فيه “المسيح يسوع” يرتفع بقلبه وفكره وأحاسيسه فوق النير، ليعلن الحق الإنجيلي لسيده العنيف، لا خلال المماحكات الكلامية، ولا العنف، وإنما خلال الحياة الإنجيلية وسلوكه الإيماني المملوء حبًا.
فيأسر سيده بالحب، ويجتذبه بالحياة العملية. بهذا يعيش العبد في طاعة لسيده العنيف، لا عن خوف أو قسر، إنما خلال إيمانه بالله في المسيح يسوع ربنا. وقد كشف لنا التاريخ عن عبيدٍ كثيرين استطاعوا أن يجتذبوا سادتهم إلى الإيمان، بل وخرج من السادة أنفسهم من ثار على هذا النظام الجائر.
بهذا المنظار الروحي يرفع الرسول الإنسان فوق كل الظروف المحيطة به، فيحقق غايته حتى وإن كان عبدًا لسيدٍ عنيفٍ. في هذا يقول القديس أمبروسيوس: [مع أن يوسف جاء عن أسرة البطاركة الشرفاء لكنه لم يخجل من عبوديته الوضيعة، بل زينها بخدمته الحاضرة، وجعلها مجيدة بفضائله. لقد عرف كيف يتواضع، ذاك الذي صار سلعة في يدي المشتري والبائع، ودعاهما “سيدي”.
أنظر إلى تواضعه وهو يقول: “هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئًا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطىء إلى الله؟” (تك ٣٩: ٨-٩). كلماته مملوءة تواضعًا وعفة، مملوءة تواضعًا، إذ كان مطيعًا لسيده بروحٍ كريمة يعترف بجميله، ومملوءة عفة، إذ حسبها خطية مرعبة أن يتدنس بجريمة عظيمة كهذه[1].]
لقد رفع السيد المسيح روح العبيد، فإنه وهو ابن الله الكلمة جذب إليه البشرية لا بالكشف عن أمجاده الإلهية، وإنما بقبوله “العبودية”. فجاء يغسل الأقدام بيديه كعبدٍ والقلوب بدمه الطاهر! لهذا لم يستنكف الرسول بولس أن يعلن أنه قد استعبد نفسه لكثيرين، حتى يرفعهم من حالة العبودية للخطية إلى البنوة الحرة لله! إذن في حبنا للغير لا نستنكف من خدمهتم، بل بكل فرح نستعبد أنفسنا لهم في المسيح يسوع، نحبهم ونطيعهم ونخضع لهم في الرب، حتى نأسر عنفهم وقسوتهم وندخل بهم إلى حرية الحب الإلهي.
هذا بالنسبة للعبيد في علاقتهم بسادتهم غير المؤمنين أو المرؤوسين في معاملاتهم مع الرؤساء العنفاء، فما هو موقفهم مع المؤمنين اللطفاء؟ يقول الرسول: “والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبون، علّم وعظ بهذا” [2].
إن كان العبد المؤمن يخضع بالطاعة للسيد غير المؤمن من أجل تمجيد الله وإعلان إنجيله حتى لا يجدف على الله، فإنه ملتزم أيضًا بالخضوع للسيد المؤمن من أجل الأخوة والحب. حقًا في الإيمان يدخل الكل في أخوة صادقة إذ “ليس عبد ولا حرّ في المسيح يسوع” (غل ٣: ٢٨، ١ كو ٣: ١١).
لكن هذه الأخوة لا تعني أن نسلب الكرامة ممن لهم الكرامة أو نهضم حق إخوتنا من نحونا. إيماننا في المسيح يسوع يهبنا المساواة في الروح والحق أمام الله والكنيسة، لكنه لا يعفينا من التزاماتنا الزمنية سواء الخاصة بالعمل أو القرابة، كخضوع الابن لأبيه، وأمانة العامل لحساب صاحب العمل. الأخوة لا تعني استهتارًا أو استحقاقًا بحقوق المؤمنين، إنما بالعكس تدفع المرؤوس للأمانة في تقديم واجباته نحو المؤمنين بجدية صادقة. يقول الرسول: “بل ليخدمونهم لأنهم مؤمنون ومحبوبون”، ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم: [كأنه يقول: إن كنتم تحسبونه نفعًا عظيمًا أن يكون سادتكم إخوة لكم، فعلى هذا الأساس يلزمكم بالأكثر أن تخضعوا لهم[2].]
إن كان هكذا يليق بالعبيد أن يطيعوا سادتهم ويحبونهم فكم بالحري يليق بنا أن نخضع لسيد البشرية كله ونحبه. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لنخجل أيها الأحباء ولنخف! ليتنا نخدم سيدنا كما يخدمنا عبيدنا[3].] كما يقول عن العبيد: [خوف سادتهم أمام أعينهم، وخوف سيدنا ليس أمامنا على الإطلاق[4].]
2. الاهتمام بالجانب العملي
“علم وعظ بهذا.
إن كان أحدًا يعلم تعليمًا آخر
ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة
والتعليم الذي هو حسب التقوى،
فقد تصّلف، وهو لا يفهم شيئًا،
بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي فيها يحصل الحسد
والخصام والافتراء والظنون الردية،
ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق يظنون أن التقوى تجارة.
تجنب مثل هؤلاء” [2-5].
يوصي الرسول تلميذه أن يعلم ويعظ، لعله قصد بالتعليم تقديم الإيمان المستقيم والعقيدة المسيحية، وبالوعظ أي تحويل العقيدة إلى حياة عملية وتطبيقات سلوكية. كأن الرسول يوصيه أن يمزج العقيدة بالسلوك، والإيمان بالعمل! ويرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن امتزاج التعليم بالوعظ إنما يعني امتزاج السلطة كمعلم بالحنو كواعظ، قائلاً: [لا يحتاج المعلم إلى السلطان وحده وإنما إلى اللطف أيضًا، وليس إلى اللطف وحده وإنما إلى سلطان أيضًا[5].]
يقول الرسول: “علّم وعظ بهذا” ماذا يقصد “بهذا”؟ أي بما سبق فأعلنه بروح المسيح، روح التقوى العملية في المسيح يسوع ربنا. هذه التي إن انحرف عنها أحد ليتكلم من عنده حسب الحكمة البشرية وليس بما يعلمه الروح القدس (١ كو ٢: ١٣) يكون متصلفًا ومتكبرًا. فإن الكبرياء يحوّل الإيمان إلى مماحكات ومباحثات غبية تفسد حياة الإنسان الروحية، وتنزع منه روح التقوى، بل وتدفع الكنيسة كلها إلى الحسد والخصام والافتراءات والظنون الرديئة، فتنشأ منازعات فاسدة كلها خبث ودهاء واحتيال، ليس فيها شيء من الحق. بهذا تتحول التقوى إلى تجارة، إذ يعمل أصحاب المنازعات لا لحساب المسيح وبنيان الكنيسة، وإنما لحسابهم الخاص. لذا يؤكد الرسول: “تجنب مثل هؤلاء”.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على العبارات السابقة: [لا ينبع التصلف عن المعرفة، إنما عن عدم المعرفة، فمن يعرف تعاليم التقوى يميل بالأكثر إلي التواضع. من يعرف الكلمات المستقيمة لا يكون غير مستقيم]، كما يقول: [من يعرف ما لا يلزم معرفته فهو عديم المعرفة، والكبرياء تنشأ عن عدم المعرفة[6].]
يتحدث القديس كبريانوس عن خطورة هؤلاء الهراطقة المتصلفين الذين يقسمون الكنيسة ويفسدون الإيمان، قائلاً: [يقول الرسول: “لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية فلا تكونوا شركاءهم” (أف ٥: ٦-٧). ليس هناك علة للانخداع بكلماته الباطلة والاشتراك معه في فساده. اهرب من مثل هذا. أتوسل إليك وأرجوك يا من تسكب صلوات يومية للرب، يا من ترغب في أن تنسحب إلى الكنيسة خلال رأفات الله، يا من تصلي من أجل سلام الله الكامل (الكنيسة) الأم وللأولاد (المؤمنين).
لتلتحم طلباتك وصلواتك مع طلباتنا وصلواتنا، ولتختلط دموعك بنحيبنا. لنحذر الذئاب التي تفصل القطيع عن الراعي. تجنب لسان الشيطان السام، الذي هو مخادع وكذاب منذ بدء العالم، يكذب لكي يخدع، ويداهن لكي يضر، يعد بالحسنات لكي يبث شرورًا، يعد الحياة ليقدم موتًا… يعد بالسلام لكي لا يتحقق السلام، وبالخلاص حتى لا يبلغ الخاطيء للخلاص، ويعد بالكنيسة مع أنه يبذل كل الجهد لكي يدفع كل من يؤمن به إلى الهلاك تمامًا خارج الكنيسة[7].]
3. توجهيات للأغنياء
“وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة” [6]. إذ يسقط أصحاب المناقشات الفاسدة والمماحكات في محبة الأرضيات، محولين التقوى إلى تجارة، مستغلين الروحيات لصالحهم الخاص، إذ بهم في الحقيقة يخسرون، لأن “التقوى مع القناعة هي تجارة عظيمة”. كلما ترك الإنسان محبة العالم وراء ظهره أشبعه الله روحيًا ونفسيًا وماديًا أيضًا. كلما زهد الإنسان فيما هو للعالم يعطيه الله بالأكثر، إذ لا يخشى عليه من أمور العالم، وذلك كما حدث مع أبينا إبراهيم. بقدر ما ترك كان يأخذ، وعلى العكس بقدر ما طمع لوط في الأرضيات خرج فارغ اليدين حتى زوجته فقدها. لذلك يقول مار اسحق السرياني بأن من طلب الكرامة هربت منه، ومن تركها جرت وراءه وتعلقت به.
بروح التقوى يدرك المؤمن الحقيقي هذه الحقيقة: “لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كانت لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما” [7-٨]. إدراكه أنه يدخل العالم بلا شيء، وخروجه منه بلا شيء، يجعل قلبه مقتنعًا بالقليل جدًا، فيعيش لا للترف وإنما لمجرد الحياة. يريد ما يكفي قوت جسده وما يستره ليحيا بقوة الروح حتى يخرج. أما من يشتهي غنى هذا العالم، فيعيش في حالة فقر داخلي لا تقدر أمور العالم أن تشبعه، إذ يقول الرسول: “وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة، تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان، وطعنوا أنفسهم بأوجاعٍ كثيرةٍ” [٩-١٠].
وللقديس يوحنا الذهبي الفم تعليق هام، [يقول الرسول: “الذين يريدون أن يكونوا أغنياء” ولم يقل “الذين هم أغنياء” بل الذين يشتهون الغنى. فالإنسان الذي له مال يستخدمه حسنًا دون أن يبالغ في تقييمه له، مقدمًا إياه للفقراء، مثل هذا لا يُلام، إنما يلام من كان طماعًا[8].] لقد اهتم القديس إكليمنضس السكندري بمعالجة هذا الأمر فكتب مقالاً تحت عنوان “هل يخلص الغني؟” موضوعه الرئيسي تأكيد أن الغنى ليس شرًا في ذاته، إنما شهوة الغنى هي الشر. بدون المال ما كان يمكن تقديم العون للفقراء والمرضى والغرباء الخ.
ليس الغنى وإنما الاستعباد للغنى هو الذي يدفع الإنسان إلى الدخول في تجارب وفخاخ وشهوات كثيرة غبية مضرة تغرق الناس في الهلاك. يثقل الإنسان فيحطمه في الأعماق، فلا يقدر أن يرتفع على مياه العالم. أما النفس التي تحررت من محبة الغنى وشهوته، فتقدر أن ترتفع لتطأ أمواجه تحت قدميها، وتعلو فوق كل تياراته. النفس المتحررة من حب العالم تعيش في حرية صادقة لا يقدر أحد أن يقتنصها.
“لأن محبة العالم أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان، وطعنوا أنفسهم بأوجاعٍ كثيرة” [١٠]. هكذا يرى الرسول محبة المال أصل كل الشرور، إن أسر قلبًا ينحرف به عن الإيمان المستقيم، يطعن الإنسان الداخلي بآلام كثيرة. بسبب المال قد ينكر الإنسان إلهه، أو يعصى وصيته الإلهية، فيلجأ إلى السرقة أو القتل أو إثارة الانقسامات الخ.
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا القول الرسولي هكذا:
[انزع محبة المال تنتهي الحروب والمعارك والعداوة والصراعات والنزاعات. لذا يجب طرد محبي المال من العالم، فإنهم كالذئاب والأوبئة. وكما أن الرياح العنيفة المضادة إذ تكتسح بحرًا هادئًا تثيره من أعماقه، فتجعل الرمال الراكدة في الأعماق مختلطة بالأمواج العالية، هكذا يربك محبو المال كل شيء، ويسببون اضطرابًا. الإنسان الطامع لا يعرف له صديقًا قط. ولماذا أقول صديقًا، فإنه لا يعرف حتى الله نفسه!…
إنه كالنار التي تمسك في الخشب فتدمر كل ما حولها. هكذا يحطم هذا الألم (محبة المال) العالم.
يتعرض لهذا الألم الملوك والعظماء، الشرفاء والفقراء، النساء والرجال والأطفال، مع أننا نسمع في الأماكن العامة والخاصة عظات عن الطمع، لكن ليس منهم من ينصلح حاله. إذن ماذا نفعل؟ كيف نطفيء هذا اللهيب؟ فإنه وإن كان قد ارتفع حتى السماء لكن يلزم إطفائه. لتكن لنا الإرادة، وعندئذ يمكننا السيطرة على الحريق الهائل!
كما أنه بإرادتنا التهب هكذا بإرادتنا يجب إخماده!… إذن لتكن لنا الإرادة. ولكن كيف تتولد هذه الإرادة؟ إن أدركنا بطلان الغنى وعدم نفعه، وعرفنا أنه لا يرحل معنا من هنا، بل سيتركنا حتى ونحن بعد هنا. إنه يتراجع وراءنا، تاركًا إيانا في جراحات ترافقنا عند رحيلنا.
إن أدركنا وجود غنى هناك (في السماء) إن قورن به غنى هذا العالم يظهر الأخير أكثر حقارة من الروث. إن أدركنا أنه محفوف بمخاطر لا حد لها، فمع ما فيه من لذة مؤقتة لكنه مرتبط بالحزن. إن تأملنا غنى الحياة الأبدية الحقيقية نقرر احتقار غنى العالم، إن تذكرنا أنه لا ينفع شيئًا سواء من مجد أو صحة أو شيء آخر، بل على العكس يغرق الناس ويدفع بهم إلى الهلاك والدمار[9].]
يربط الرسول بين محبة المال والانحراف عن الإيمان، إذ يقول: “الذي إذا ابتغاه قوم، ضلوا عن الإيمان“. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [يجتذب الطمع أعينهم إليه، ويسرق أذهانهم، ولا يسمح لهم أن ينظروا طريقهم. وذلك كما لو أن إنسانًا يسير في طريق مستقيم غالبًا لا يعرفه، فيعبر على المدينة التي يسرع إليها وتتعب قدماه بطريقة عشوائية، إذ يسير بلا هدف. هذا هو ما يعمله الطمع[10].]
يتحدث القديس كبريانوس عن رباطات شهوة الغنى، إذ يقول: [كيف يقدرون أن يتبعوا المسيح من تثقلوا بأغلال غناهم؟ أو كيف يقدرون أن يطلبوا السماء، ويتسلقون المرتفعات السامية العالية، هؤلاء الذين تثقلوا بالشهوات الأرضية؟ يظنون أنهم يملكون مع أنهم مملوكون، إنهم عبيد لأرباحهم وليسوا سادة على ما لهم![11]]
ربما يتساءل البعض: لماذا تحسب محبة المال أصل لكل الشرور، مادمت لا أطلب مال الغير بل ما هو لي؟ يجيب العلامة ترتليان: [يعلن روح الرب بالرسول: “محبة المال أصل لكل الشرور”. ليتنا لا نفسر “محبة المال” هذه بكونها مجرد اشتهاء ما للغير، وإنما محبة ما يبدو أنه ملك لنا، فإن هذا أيضًا هو ملك للغير، فإنه ليس شيء ملكًًا لنا مادام كل شيء هو لله، بل حتى أنفسنا هي ملك له[12].]
نختم حديثنا عن “محبة الغنى” بقول القديس إكليمنضس السكندري: [أفضل الغنى هو الافتقار في الشهوات.] لنطلب الغنى الحقيقي والأفضل حيث لا يكون في القلب شهوات، بل يكون في حالة فقرٍ فيها، ذلك إن كان القلب في حالة شبع حقيقي في المسيح يسوع مصدر الغنى الحقيقي، كقول الرسول لأهل كورنثوس: “إنكم في كل شيء استغنيتم فيه” (١ كو ١: ٥).
يقدم لنا الرسول بولس في الجانب الإيجابي للهروب من محبة الغنى الزمني بطلب الغنى فيما للمسيح، بل الغنى في المسيح نفسه، إذ يقول: “وأما أنت يا إنسان الله، فاهرب من هذا، واتبع البرّ والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة” [١١].
إذ يريد تحريرنا من محبة الغنى الزمني يذكرنا بمركزنا الحقيقي، قائلاً: “يا إنسان الله” فإن رجل الله يطلب غناه فيما هو لله لا فيما هو زمني وزائل. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [يا له من قلب عظيم الكرامة! إننا جميعًا نُحسب كأناس الله، لكن البار على وجه الخصوص هو “إنسان الله“… إن كنت إنسان الله فلا تطلب الأمور الكمالية التي لا تقودك لله، بل “اهرب من هذا واتبع البرّ“. لا تكن طماعًا، بل اتبع “التقوى” أي سلامة التعليم، والإيمان الذي هو ضد المباحثات، والمحبة، والصبر، والوداعة[13].]
هكذا يعالج الرسول الطمع بكل وسيلة إيجابية وسلبية، فبعد أن أبرزه كأصل لكل الشرور وعلة الانحراف الإيماني كما السلوكي، أبرز مركز المؤمن كإنسان الله، تعلو نفسه فوق الزمنيات المؤقتة، ليطلب الأحضان الأبوية الأبدية. فإنه لن يقدر أن يهرب من الطمع مادامت نظرته ملتصقة بالسفليات، وقلبه يزحف على الأرض، أما إن أدرك مركزه يرتفع قلبه إلى حيث كنزه في حضن الآب. هذا والهروب من الطمع ومحبة الزمنيات ليست خسارة أو فقدان بل هي حالة امتلاء وشبع من المسيح يسوع نفسه بكونه “البرّ” الحقيقي، والحب الإلهي الخ. ففيه تختبر النفس حياة التقوى لتعيش في غنى داخلي خلال القناعة، ولا تشعر بالعوز إلى شيء. إذن عوض محبة الزمنيات ننعم بالحياة الجديدة في المسيح يسوع بواسطة روحه القدوس، لندخل في حضن الآب.
هذه الحياة الغنية والمجيدة، التي ترفعنا فوق الزمنيات تتطلب في المؤمن الجهاد المستمر، والتمسك بالوعود الأبدية، وإعلان اعترافنا أو شهادتنا الإيمانية أمام الجميع، إذ يكمل الرسول: “جاهد جهاد الإيمان الحسن، وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دُعيت أيضًا، واعترف الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين” [ ١٢]. هكذا ينتقل الرسول بولس من حديثه عن محبة المال أو الطمع الذي يأسر محبي الغنى إلى ما هو أعمق، أي الدخول في آلام الجهاد، فلا يقف المؤمن عند عدم اشتهائه للزمنيات، وإنما يتقبل الآلام من أجل المكافأة السماوية الموعود بها.
يضع أمامه الجعالة العليا التي هي الحياة الأبدية المدعو إليها حتى يقدر أن يجاهد جهاد الإيمان الحسن، ويعترف الاعتراف المستقيم عمليًا أمام شهودٍ كثيرين. بهذا نكون كالمشتركين في مباريات الألعاب الرياضية الذين من أجل نوالهم المكافأة يحرمون أنفسهم من الكثير من الملذات الجسدية لتهيئة أجسامهم وتدريبها على الألعاب.
هذه الوصية الخاصة بالجهاد الإيماني الحسن أمام الشهود لا تخص الشعب وحده، وإنما يلتزم بها الراعي نفسه أيضًا. إذ يقول الرسول: “أوصيك إمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس بنطس الاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح” [١٣-١٤].
إذ هي وصية خطيرة يشهد عليه الله الآب وابنه الوحيد يسوع المسيح لكي يحفظها بلا دنس حتى النهاية، أي حتى المجيء الأخير إلى ملاقاة السيد نفسه.
يوصيه لا بعدم الطمع فحسب، وإنما احتمال الآلام أيضًا، مشهدًا عليه الله الآب واهب الحياة ومعطي القيامة من الأموات، وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [هنا يقدم له تعزية وسط المخاطر التي تنتظره، مذكرًا إياه بالقيامة التي تعمل فيه[14].]
يشهده أيضًا أمام السيد المسيح الذي قدم نفسه مثالاً لنا في الشهادة الحقيقية أمام بيلاطس بنطس. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [تنبع الوصية عن مثال السيد، فيلزمكم أن تعملوا ما فعله السيد. لهذا السبب أشهد المسيح حتى تتبع خطواته (١ بط ٢: ٢١). يقول “الاعتراف الحسن”، متحدثًا مع تلميذه تيموثاوس ما قاله أيضًا في رسالته إلى العبرانيين: “ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهينًا بالخزي، فجلس عن يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في أذهانكم (نفوسكم)” (عب ١٣: ٢-٣).
وكأنه يقول: لا تخف الموت مادمت خادم الله واهب الحياة. ولكن أي اعتراف حسن يشير إليه الرسول؟ ذاك الذي صنعه عندما سأله بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ (يو ١٨: ٣٧) قال: “لهذا قد ولدت”، كما قال: “ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. انظروا إنه يسمع لي”. ربما قصد الرسول هذه الشهادة، أو قصد ما حدث عندما سأله: “أفأنت ابن الله؟” فأجاب: “أنت تقول” (لو ٢٢: ٧٠)، وشهادات أخرى كثيرة واعترافات قدمها[15].]
هذه الشهادة التي قدمها السيد المسيح أمام بيلاطس بقوة هي التي تدفع المؤمن – كاهنًا أو من الشعب – لحفظ الوصية، سواء من جهة التعليم أو السلوك، شاهدًا للحق سواء من جهة العقيدة الإيمانية أو العمل الروحي. هذه الشهادة التي يعلنها المؤمن هنا تتجلى عند ظهور السيد المسيح، إذ يقول الرسول: “الذي سيبينه في أوقاته، المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب” [ ١٥]. ففي الوقت المناسب يعلنه رب المجد، المبارك أي الذي نقدم له تسبحة البركة بكونه واهب البركات، والعزيز، أي صاحب العزة والقوة والسلطان، ملك الملوك ورب الأرباب. إنه صاحب السلطان الذي لا يعلو عليه سلطان، فإن كان يسمح لنا هنا بالآلام ذلك ليس عن ضعف، وإنما كطريق لدخولنا معه إلى أمجاده.
“الذي وحده له عدم الموت،
ساكنًا في نور لا يُدنى منه،
الذي لم يره أحد من الناس، ولا يقدر أن يراه،
الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين” [ ١٦].
مرة أخرى إذ قدم لنا السيد نفسه كمثالٍ للشهادة الحسنة فدخل إلى الآلام، ليس عن عجزٍ أو ضعفٍ، إذ هو ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده لا يقدر الموت أن يغلبه، ولا الظلمة أن تقترب إليه، إذ هو وحده له عدم الموت وساكن في نورٍ لا يُدنى منه، بل هو فوق كل الإدراكات، لم يره أحد قط في جوهره ولا يقدر أن يراه. هذا الإله يحمل اعترافًا حسنًا أمام بيلاطس الضعيف، فكيف يخاف المؤمن من الشهادة الحسنة؟ لقد شهد بالحق حتى يسندنا، فنشهد نحن للحق خلال اتحادنا به. بهذا نقدم له الكرامة واالقدرة الأبدية، حينما نحمل اعترافه الحسن وتظهر سماته فينا.
ولعل الرسول في وصفه للسيد أن له وحده عدم الموت، وأنه ساكن في نورٍ لا يُدنى منه الخ. أراد أن يكشف عن شخص ذاك الذي ننعم به خلال شهادتنا الحسنة معه وبه ولحسابه. فإن كنا بالشهادة الحسنة نتقبل الألم حتى الموت، إنما لكي ننعم بذاك الذي له وحده عدم الموت، وندخل فيه حيث النور الذي لا يُدنى منه. وكما يقول القديس إكليمنضس السكندري: [ماذا يطلب الإنسان بعد أن ينال النور الذي لا يُدنى منه؟]
ولئلا يُفهم حديثه السابق أنه هجوم ضد الغنى والأغنياء، قدم الرسول وصايا للأغنياء المؤمنين، إذ يقول: “أوصِ الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا، ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحًا، وأن يكونوا أغنياء في أعمالٍ صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسًا حسنًا، لكي يمسكوا بالحياة الأبدية” [١٧–١٩].
يمكننا تلخيص الوصايا السابقة في النقاط التالية:
أ. عدم الاستكبار: يوصي أغنياء هذا الدهر ألا يستكبروا، مميزًا بين أغنياء الدهر الحاضر وأغنياء الدهر الآتي. فهو مطمئن من جهة الآخرين أنهم متواضعون إذ هم أغنياء بالسيد المسيح واهب التواضع، لكنه يخشى على أغنياء الدهر الحاضر من الكبرياء، حيث يسحبهم المال إلى الاعتداد بالذات. هذه هي أولى ضربات الأغنياء، إذ يتكلون على أموالهم، حاسبين أنهم قادرون على فعل كل شيء بالمال، فيسقطون في الكبرياء.
لقد تمتعت القديسة مريم بغنى الدهر الآتي في تواضع عجيب، حيث صار لها مسيحها كنزها الخفي، في أحشائها الجسدية والروحية. وكما يقول القديس أغسطينوس أن السيد المسيح المتواضع لن يعلم أمه الكبرياء. إذن لنحمل مسيحنا في داخلنا كما فعلت القديسة مريم فيهبنا الغنى الحق دون كبرياء!
ب. يحذرهم من الاعتماد على ثروتهم، مؤكدًا ضرورة وضع الرجاء كله في الله لا المال.
ج. الغنى الحق هو التمتع بالأمور التي لا تفنى، لذا يليق بهم إن أرادوا أن يكونوا أغنياء، فليمارسوا أعمال الحب التي يبقى رصيدها سرّ غناهم الأبدي.
د. السخاء في العطاء، فالغنى وزنة مقدمة لهم لا لاكتنازها بل لإضرامها بالعطاء المستمر، حتى يتحول الكنز من الأرض إلى السماء. وقد سبق لنا عرض كثير من أقوال الآباء في العطاء[16].
4. وصية ختامية
“يا تيموثاوس احفظ الوديعة،
معرضًا عن الكلام الباطل الدنس،
ومخالفات العلم الكاذب الاسم،
الذي إذا تظاهر به قوم زاغوا عن الإيمان.
النعمة معك. آمين” [20–٢٢].
يختم الرسول حديثه مع تلميذه مطالبًا إياه بحفظ الوديعة، الإيمان الحي، التي سُلمت مرة للقديسين. هذه الوديعة التي ندعوها “التقليد” أو “التسليم الرسولي”.
أما علامة اهتمامنا بحفظ الوديعة فهو الإعراض عن الكلام الباطل الدنس، أي المباحثات الغبية تحت اسم “العلم” أو “المعرفة”، (الغنوسية)، فيتحول الإيمان الحي إلى تعبيرات وألفاظ لغوية بلا حياة ولا خبرة، هذا الذي يفقد الإنسان حياته. ولعله قصد بذلك الغنوسيين الذين كما سبق فقلنا، استبدلوا الإيمان بالمعرفة، فسقطوا في العلم الكاذب.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [حسنًا يدعوها الرسول هكذا “العلم الكاذب الاسم”، فإنه حيث لا يوجد الإيمان لا توجد المعرفة (الحقة)[17].]
[1] Duties of the clergy 2 : 17.
[2] In 1 Tim. hom 16.
[3] In 1 Tim. hom 16.
[4] In 1 Tim. hom 16.
[5] In 1 Tim. hom 17.
[6] In 1 Tim. hom 17.
[7] Ep. 39 : 6.
[8] In 1 Tim. hom 17.
[9] In 1 Tim. hom 17.
[10] In 1 Tim. hom 17.
[11] Treat. on the lapsed 12.
[12] On Patience
[13] In 1 Tim. hom 17.
[14] In 1 Tim. hom 18.
[15] In 1 Tim. hom 18.
[16] الحب الأخوي، 1964، العطاء.
[17] In 1Tim. hom 20.