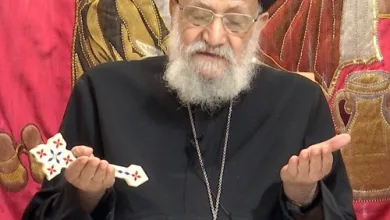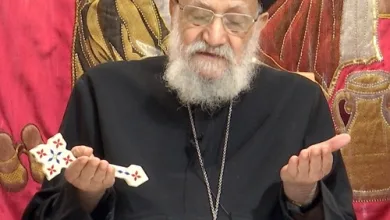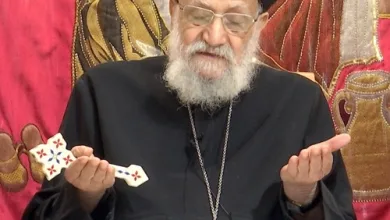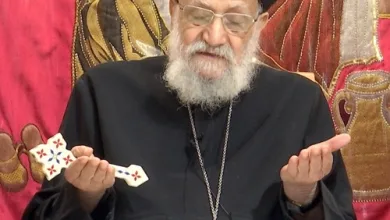تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 2 الأصحاح الثاني - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة تيموثاوس الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثاني
العبادة الكنسية العامة
بعدما كشف الرسول لتلميذه عن مفهوم الوصية كموضوع الرعاية لكي يتسع قلبه بالحب لخدمة الجميع خاصة الأشرار، فلا ينشغل بالمباحثات الغبية، بل بخدمة الحب العملي، باذلاً كل الجهد كجندي روحي صالح، بدأ يحدثه عن العبادة الكنسية الجماعية.
- الصلاة من أجل كل البشرية ١ – ٧.
- إرشادات للرجال في العبادة ٨.
- إرشادات للنساء في العبادة ٩ – ١٥.
- الصلاة من أجل كل البشرية
“فاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس” [١].
يكشف الرسول بولس عن رسالة الكنيسة، سواء على المستوى المسكوني أو المحلي، أو على مستوى كل عضوٍ فيها. فإن الكنيسة ليست مؤسسة تنافس العالم فيما له، لكنها أولاً وقبل كل شيء هي جماعة متعبدة لله لأجل تقديس العالم، تقدم الطلبات والصلوات والابتهالات والتشكرات عن جميع الناس.
يرى الأب إسحق[1] أن ما ذكره الرسول هنا يمثل مراحل حياة الشركة مع الله التي ينعم بها المؤمن، كمراحل متصاعدة، وفي نفس الوقت متكاملة معًا. فيبدأ المؤمن بالطلبة أي السؤال عن احتياجاته الضرورية ليرتفع من الطلبة إلى الصلاة أي الالتصاق بالله والدخول معه في صلة عميقة وحب لأجل الله ذاته. خلال هذا الحب الإلهي يرتفع إلى الابتهال أو التشفع عن الآخرين، فلا يطلب ما لنفسه بل ما هو للغير، وينسى احتياجاته أمام محبته لإخوته. وأخيرًا يمارس التشكرات بكونها الحياة الملائكية التي تقوم على أساس الشكر الدائم بلا انقطاع والتسبيح لله بغير انقطاع.
على أي الأحوال، تمارس الكنيسة في صلواتها وليتورچياتها كل هذه الأنواع من الصلاة، خاصة في ليتورچيا الإفخارستيا، أي القداس الإلهي. فيطلب الإنسان من أجل نفسه لنوال غفران خطاياه والتمتع بالنمو الروحي وإشباع كل احتياجاته وأعوازه الروحية والنفسية والجسدية، وتمتزج هذه الطلبات بالصلوات فيدخل المؤمن في حديث سري مع الله في ابنه الوحيد بالروح القدس. ولا تكف الكنيسة عن ممارسة الابتهالات فتشفع عن جميع الناس، أما جوهر الإفخارستيا فهو التمتع بالحياة الجديدة الشاكرة، خلال ثبوتنا في المسيح يسوع ربنا، حتى دُعيّ القداس الإلهي بالافخارستيا أي “الشكر”.
وتحدث العلامة أوريجينوس[2] بشيء من التفصيل عن التمييز بين هذه الأنواع من الصلاة معطيًا أمثلة لذلك. فيرى أن الطلبة هي توسل برجاء أن ينال الإنسان شيئًا هو في عوز إليه، كطلبة زكريا الكاهن، إذ يقول له الملاك: “لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنًا، وتسميه يوحنا” (لو : ١٣). أما الصلاة، فهي تعبير يقدم لله وحده يمثل عبادة فيها مديح له. وكما يقول أوريجينوس أنه يمكن تقديم التعبيرات الثلاث الأخرى لغير الله كأن يطلب إنسان شيئًا من آخر أو يشفع (يبتهل) عن آخر لدي أخيه، أو يشكر من صنع معه معروفًا، أما الصلاة فلا تقدم لغير الله.
من أمثلة الصلاة، ما جاء في (١ صم ١: ١٠) عن حنة امرأة القانة أنها “صلت إلى الرب وبكت بكاءً” أما البتهال ففي رأيه هو طلب يُقدم لله من أجل أمور معينة يقدمه من له ثقة أكثر من المعتاد. أما المثل الفريد في الابتهال فهو عمل الروح كقول الرسول: “لكن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها”، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين” (رو ٨: ٢٦–٢٧).
أخيرًا الشكر هو عرفان بالجميل مع صلاة بسبب عطية الله وبركاته. وجاء حديث السيد المسيح مع أبيه مثلاً فريدًا، إذ يحمده لأجل عطاياه التي يقدمها للبسطاء، إذ يقول الكتاب: “في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال” (مت ١١: ٢٥).
ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا النص بكونه دعوة لعمل كنسي مملوء حبًا للكل يشترك فيه الكاهن مع الشعب صباحًا ومساءً، مصلين عن البشرية كلها حتى المقاومين الوثنيين، إذ يقول: [الكاهن أب كما لو كان للعالم كله، لذا يليق به أن يهتم بالجميع كالله الذي يخدمه… وهذا يؤدي إلى نفعين: أولاً نزع الكراهية من جهة من هم من الخارج إذ لا يقدر أحد أن يشعر بالكراهية نحو من يصلي من أجله، وثانيًا أن هؤلاء أنفسهم يصيرون في حالة أفضل بفعل الصلوات المرفوعة عنهم، فيتركون وحشيتهم التي يصوبونها ضدنا، فإنه ليس شيء يجتذب البشر للتعلم مثل أن يُحبوا ويحبوا.
تطلع إلى الذين اضطهدوا المسيحيين وجلدوهم ونفوهم وقتلوهم، فإن المسيحيين كانوا يقدمون صلوات حارة لدى الله من أجل الذين عاملوهم ببربرية كهذه. وكما أن أبًا إن لطمه طفل صغير على وجهه يحمله على كتفيه، إذ أن تصرف الطفل لا ينزع عنه حنوه من جهته هكذا يليق بنا ألا نفقد إرادتنا الصالحة نحو من هم من الخارج حتى وإن ضربونا… ماذا يعني الرسول بقوله “أول كل شيء” [1]؟ أي في الخدمة اليومية وكما تعرفون كيف نقدم صلوات يومية في المساء والصباح من أجل العالم كله، عن الملوك وكل من هم في منصب[3].]
يكشف لنا هذا النص عن ممارسة الكنيسة لليتورچيات جماعية صباحية ومسائية، فيها تبتهل الكنيسة عن الملوك (الرؤساء) ومن هم في مراكز قيادية مع بقية الابتهالات عن كل البشرية. ونحن نجد في القداس الباسيلي الصلاة عنهم كجزء من الصلاة من أجل سلام الكنيسة قبل صلاه الصلح، وفي القداس الغريغوري تقدم أوشية خاصة بالملك (الرؤساء) والعاملين في البلاط (القصر) وجميع العاملين في الدولة والجند لأجل سلامهم.
“لأجل الملوك، وجميع الذين هم في منصب،
لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار” [2].
يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم إن كان يمكن الصلاة من أجل ملك وثني أثناء الاحتفال بالأسرار الإلهية؟ ويجيب قائلاً: [لقد أظهر الرسول فائدة ذلك بقوله: “لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة”. وكأنه يقول إن سلام (المسئولين) هو آمان لنا. وفي رسالته إلى أهل رومية يأمرهم بالطاعة للحكام “ليس بسبب الغضب فقط بل أيضًا بسبب الضمير” (رو ٣: ٥)، فقد أقام الله الحكومة لأجل الصالح العام… ليس في تملقٍ، وإنما نطيع في اتفاق مع أحكام العدل. فإنهم إن لم يكونوا محفوظين ومنتصرين في الحروب ترتبك أمورنا حتمًا وندخل في متاعب، وإن هلكوا نتشتت[4].]
ماذا يعني الرسول بقوله: “لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار“؟ يجيب القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا السؤال قائلاً بأنه يوجد ثلاث أنواع من الحروب: حرب تنشأ عن هجمات جيوش غريبة ضدنا، وحرب تثور فيما بيننا، والثالثة الحرب التي تنشأ داخل الإنسان نفسه. ويرى القديس أن هذه الطمأنينة وها الهدوء المذكور هنا يشير إلى هدوء النفس الداخلي، والراحة من جهة الحرب الثالثة، لذا يكمل الرسول “في كل تقوى ووقار“.
إن صلواتنا وطلباتنا من أجل جميع الناس وطاعتنا الصادقة للمسئولين تعطي سلامًا في القلب الداخلي كأبناء يحملون سمات عريسهم المحب المطيع! علاقتنا مع الآخرين لا تقوم على أساس نفعي مادي أو أدبي، ولا على أساس الخوف، وإنما على أساس إلهي، حيث نلتقي مع الجميع ونعمل على راحة الجميع من أجل الله محب البشر.
يكمل الرسول: “لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون” [3-٤]. ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم قائلاً: [ما هو هذا المقبول؟ الصلاة من أجل جميع الناس! هذا هو المقبول لدى الله، هذه هي إرادته!… تمثل بالله، فإنه يريد أن جميع الناس يخلصون! وها هو سّر صلاة الإنسان من أجل الجميع! إن كان الله يريد أن جميع الناس يخلصون، فلترد أنت أيضًا هذا! وإذ تكون هذه هي إرادتك، فصلِ لكي تتحقق هذه الإرادة، فإن الإرادة (الرغبة) تقود إلى الصلوات[5].]
ربما يسأل أحد: هل نصلي من أجل الأمم الوثنيين؟ يجيب القديس يوحنا الذهبي الفم: [لا تخف من أن تصلي من أجل الأمم، فإن الله يريد ذلك، إنما خف من أن تصلي ضد أحد، إذ لا يريد الله هذا. إن كنت تصلي من أجل الوثنيين فالطبع يلزمك أيضًا الصلاة من أجل الهراطقة. فلنصل من أجل الجميع ولا نضطهد أحدًا[6].]
قد يتساءل البعض: لماذا أصلي من أجلهم؟ أما تكفي إرادة الله نحوهم؟ يجيب القديس يوحنا الذهبي الفم: [للصلاة نفع عظيم لهم ولك فإنها تجتذبهم للحب، وتهبك أنت لطفًا. الصلاة قادرة على جذبهم للإيمان[7].]
أخيرًا فإن الرسول يؤكد حب الله لخلاص الجميع ليس فقط لكي نصلي في عبادتنا الكنسية والخاصة عن الجميع، إنما لينزع الثنائية الغنوسية التي تقسم المؤمنين إلى كاملين وبسطاء[8].
يربط الرسول بين الصلوات الكنسية العامة وما تحمله من حبٍ خالص نحو كل البشرية ووساطة السيد المسيح الكفارية لدى الآب عنا جميعًا، قائلاً: “لأنه يوجد إله واحد ووسيط بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية، لأجل الجميع الشهادة في أوقاتها الخاصة” [ ٥-٦].
لعل الرسول بولس أراد أن يؤكد أن اتساع قلبنا بالحب نحو البشرية ليس من عندياتنا، وإنما يتحقق فينا خلال اتحادنا بالوسيط الواحد الذي لم يقدم مجرد صلوات لفظية عن البشرية، لكنه تجسد وتألم ليفدي الكل! إن سمة الحب التي لنا في عبادتنا الجماعية الكنسية الشخصية هي سمة السيد المسيح نفسه “الإله الواحد” الذي صار “الإنسان” ليفتدي الكل!
يليق بنا أن نقف قليلاً عند كلمات الرسول بولس هنا، التي شغلت فكر الكنيسة الأولى وابتلعت مشاعر الآباء وهزت أعماقهم الداخلية.
من جهة لم يكن مجال الحديث هنا مهاجمة وساطتنا لبعضنا البعض بالحب لدى الله، وإنما كما نعلم أن الغنوسيين آمنوا بوجود انبثاقات متتالية بدأت من الكائن الأعظم وانتهت إلى مجيء السيد المسيح، هذه الانبثاقات هي أيونات تقدم المعرفة كطريق الخلاص. ففي نظرهم ينطلق الغنوسي خلال المعرفة إلى يسوع الذي يرفعه بالمعرفة أيضًا إلى أيون أعظم، وهذا يرفعه إلى ثالث أعظم، وهكذا يرتفع على سلم الأيونات حتى يبلغ بالمعرفة الكاملة إلى الكائن الأعظم. والرسول هنا يؤكد أن الحق الذي يريد الله أن يُقبل إليه جميع الناس [4] هو الإيمان بالآب الواحد الذي أرسل ابنه الوحيد الوسيط الكفاري الوحيد ليصالح البشرية المؤمنة معه، هادمًا بهذا فكرة الأيونات الغنوسية.
بهذا لا يمكننا بتر هذه العبارة عن مجالها الكامل ليستشهد بها البعض في إنكار الشفاعة أو صلوات الكنيسة عن بعضها البعض، سواء بالنسبة للأعضاء الراقدة في الرب أو المجاهدة على الأرض. فإن هذا انحراف بعيد عن فكر الوحي الإلهي. إنما ما أراد الوحي تأكيده هو عمل المسيح الفريد في خلاصنا ومصالحتنا مع أبيه، الأمر الذي لن يمكن لكائنٍ سماوي أو بشري القيام به!
يؤكد الرسول “إله واحد”، ليعود فيقول: “الإنسان يسوع المسيح“. وكأنه لا طريق للمصالحة إلاَّ بالتجسد الإلهي. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن الوسيط يتصل بالطرفين ليتوسط بينهما. فلا يمكن للسيد المسيح أن يتوسط لدى الآب وهو منفصل عنه ولا أن يتوسط عن الناس منفصلاً عنهم. إنه كوسيط بين الله والناس يليق به أن يحمل الوحدة مع الآب في الجوهر، كما يحمل الوحدة مع الطبيعة البشرية. جاء مصالحًا الاثنين معًا بكونه ابن الله المتأنس، لقد حمل في طبيعته الواحدة اتحاد الطبيعتين معًا دون خلطة أو امتزاج أو تغيير.
يرى القديس غريغوريوس أسقف نيصص أن غاية التجسد الإلهي هو تحقيق هذه الوساطة الفائقة، إذ وهو ابن الله أخذ ناسوتنا لينزع العداوة التي كانت قائمة بين الله والإنسان، أو بين الطبيعة الإلهية والبشرية[9]… لقد نزع عنا تغربنا عن الحياة الحقيقية، حيث ردنا نحن البشر إلى الشركة مع أبيه.
- صار ابن الله بالتجسد ابن الإنسان، حتى بشركته يوحدهما معًا في نفسه، هذين الذين انقسما بالطبيعة[10].
القديس غريغوريوس النيسي
- لم يرد الله أن يكون أي ملاك هو الوسيط بل الرب يسوع المسيح نفسه بقدر ما تنازل وصار إنسانًا.
- هكذا ابن الله نفسه ،كلمة الله، هو وسيط بين الله والناس، ابن الإنسان المساوي للآب في وحدة اللاهوت وشريكنا بأخذه ناسوتنا.
إنه يتوسط عنا لدى الآب بكونه قد صار إنسانًا، دون أن يكف عن أن يكون هو الله، الواحد مع الآب. إنه يقول: “لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضًا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدًا كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضًا واحدًا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد” (يو ١٧: ٢٠-٢١)[11].
- يوجد وسيط فاصل، ووسيط آخر مصالح. الوسيط الفاصل هو الخطية، أما المصالح فهو للرب يسوع المسيح… هذا الذي ينزع الحائط الفاصل أي الخطية. لقد جاء وسيطًا وصار الكاهن وهو نفسه الذبيحة.
- إنه الباب المؤدي إلى الآب، ليس هناك طريق للاقتراب من الآب إلاَّ به[12].
- لا يتصالح إنسان مع الله خارج الإيمان الذي في المسيح يسوع، سواء قبل التجسد أو بعده[13].
القديس أغسطينوس
- في آخر الأزمنة أعادنا الرب بتجسده إلى الصداقة، فقد صار وسيطًا بين الله والناس. استرضي الآب عنا نحن الذين أخطأنا إليه، مبددًا عصياننا بطاعته، واهبًا إيانا عطية الشركة مع خالقنا والخضوع له[14].
القديس إيريناؤس
- إنه يصالح الله مع الإنسان، والإنسان مع الله!
يصالح الروح مع الجسد، والجسد مع الروح!
فيه اتحدت كل الطبائع، وتوافق الكل كعريس وعروس، في وحدة شركة الحياة الزوجية[15].
- حفظ في نفسه وديعة الجسد الذي أخذه بكلا جانبيه كعربونٍ وضمانٍ لكماله التام، كما وهبنا غيرة الروح (٢ كو ٥: ٥).
أخذ منا غيرة الجسد، ودخل به إلى السماوات كعربون عن الكل…
إذن، لا تضطرب أيها الجسد، ولا تحمل أي هم، فقد نلت في المسيح سماوات وملكوت الله![16]
العلامة ترتليان
- الوسيط بين الله والناس، إذ صار بكرًا للطبيعة البشرية كلها، أعلن لإخوته فيما قد شاركهم فيه… قائلاً: إني أرحل لكي أجعل بنفسي الآب الحقيقي الذي انفصلتم عنه أبًا لكم، وأجعل الله الحقيقي الذي تمردتم عليه إلهًا لكم. بالبكورية التي صرت أنا فيها أقدم البشرية جميعها لإلهها وأبيها في شخصي أنا[17].
القديس غريغوريوس النيسي
لقد أنكر الغنوسيون حقيقة تأنس ابن الله، إذ ظنوا في الجسد أنه عنصر ظلمة لا يمكن للمخلص أن يتحد به، فنادوا بأن جسده كان خيالاً، والبعض قالوا حمل جسدًا روحيًا أخذه من السماء وعبر به في أحشاء العذراء دون أن يأخذ منها لحمًا ودمًا، لذلك يؤكد الرسول “الإنسان يسوع المسيح” لأن من ينكر تأنسه إنما ينكر عمله الخلاصي، وينزع عنه وساطته عنا. يقول القديس أغسطينوس: [من يعرف المسيح بكونه الله وينكره كإنسان، لا يكون المسيح قد مات عنه. إنه مات كإنسان. من ينكر المسيح كإنسان لا يجد مصالحة مع الله بواسطة الوسيط… إنه لا يتبرر، لأنه كما بمعصية إنسان كثيرون صاروا خطاة، هكذا بإطاعة إنسان واحد يتبرر الكثيرون (رو ٥ : ١٩)[18].]
إذ حمل طبيعتنا لم يقدم الوساطة عنا بالكلام وإنما بالعمل، باذلاً حياته خلال الصليب، إذ يكمل الرسول: “الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة في أوقاتها الخاصة” [٦]. لقد قدم حياته فدية لصالح البشرية كلها مع الآب. هذه هي المصالحة العملية التي دفع ابن الله المتأنس ثمنها. هنا مرة أخرى يقول “لأجل الجميع” لينزع الثنائية الغنوسية في حياة المؤمنين: أي وجود الكاملين والبسطاء.
لقد قدم السيد حياته فدية حتى من أجل الوثنيين. لهذا نلتزم نحن بتقديم الصلوات من أجل الجميع والحب للكل. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [بلا شك مات المسيح حتى من أجل الوثنيين، فهل تقدر أن لا تصلي من أجلهم؟[19]] بهذا الحب العملي الشامل قدم الابن الوحيد الشهادة الحقة للحب الإلهي في الوقت المناسب.
هذا العمل الإلهي والشهادة الماسيانية خلال الفداء المقدم عن الجميع هو موضوع كرازة الرسول، إذ يقول: “التي جعلت أنا لها كارزًا ورسولاً. الحق أقول في المسيح ولا أكذب، معلمًا للأمم في الإيمان والحق” [ ٧]. لقد تفرغ الرسول بولس للكرازة بالخلاص لجميع الأمم، إذ امتدت نعمة الله لتشمل جميع البشرية. لقد صار معلمًا للأمم في الإيمان والحق. إن كان الإيمان قد امتد خارج دائرة اليهود، لذا صار الحق أو المعرفة غير قاصرة على فئة دون أخرى.
في اختصار نقول إن المبدأ الأساسي في عبادتنا الجماعية والشخصية هو اتساع القلب بالحب ليضم كل البشرية، نصلي للجميع ونطلب خلاص الكل.
- إرشادات للرجال في العبادة
“فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان،
رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال” [8].
يطلب الرسول من الرجال أن يرفعوا أياديهم طاهرة عندما يصلون في كل مكان، أي في الاجتماعات الكنسية العامة كما في العبادة العائلية وأيضًا في المخدع، مع أن السيد المسيح يقول: “وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي في الخفاء يجازيك علانية” (مت ٦: ٥-٦). كيف يتحدث الرسول عن الصلاة “في كل مكان” بينما يحدد السيد موضع الصلاة بالمخدع؟
يجيب القديس يوحنا الذهبي الفم: [ليس في هذا تناقض بل تناغم. يلزمنا أولاً أن ندرك ماذا يعني بالقول “أدخل إلى مخدعك”؟ ولماذا يأمرنا المسيح بذلك مادمنا نصلي في كل مكان؟ هل لا نصلي في الكنيسة ولا في أي موضع داخل البيت وإنما فقط في المخدع؟ إذًا ماذا يعني هذا القول؟ إن ما ينصحنا به المسيح هو تجنب الافتخار، آمرًا إيانا أن نقدم صلواتنا لا بطريقة محدده وإنما نقدمها سريًا. عندما يقول: “لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك” (مت ٦: ٣)، لا يقصد الأيدي (الشمال واليمين) وإنما يحذر بشدة من الافتخار. هذا هو ما يقصده هنا، فإنه لا يود أن يحدد الصلاة بوضع محدد إنما يسأل شيئًا واحدًا وهو ترك المجد الباطل.
أما ما قصده بولس فهو التمييز بين الصلوات المسيحية واليهودية، لذا يقول: “في كل مكان، رافعين أيادي طاهرة”، الأمر الذي لم يسمح به اليهود، إذ لم يكن يُسمح لهم بالاقتراب إلى الله وتقديم ذبيحة وتكميل خدماتهم في أي مكان، بل يجتمع الكل من كل العالم في مكانٍ واحد، ويرتبطون معًا في الهيكل لتتميم عبادتهم. على خلاف ذلك يوصي الرسول بالتحرر من هذا، وكأنه يقول: إن طريقنا مختلف عن الطرق اليهودية، فكما أمرنا المسيح أن نصلي من أجل كل الناس لأنه مات من أجل الجميع، يليق أن نصلي في كل مكان، وكأن المقصود هنا هو طريقة الصلاة[20].]
إذن الصلاة في كل مكان لا تتنافى مع وصية السيد المسيح الخاصة بالصلاة في المخدع، الأولى تعني الصلاة بلا حدود مكانية حيث يتسع القلب بالحب للصلاة في كل موضع من أجل الجميع، والثانية تعني تقديم الصلاة بعيدًا عن المجد الباطل وحب الظهور.
هذه الوصية لا تخص الرجال وحدهم إنما هي وصية للكنيسة كلها، رجال ونساء، أطفال وشيوخ، شباب وفتيان. الكل ملتزم أن يحيا بروح الرجولة أي النضوج الروحي، فيبسط كل مؤمنٍ يديه الداخليتين كما بسط السيد المسيح يديه على الصليب بالحب لينزع كل غضب عن البشرية.
ماذا تعني الأيدي الطاهرة إلاَّ الحياة العاملة خلال تقديس الروح. فالصلاة وإن كانت تصدر عن القلب في الداخل ومن الفم من الخارج، لكن لا يمكن أن تُقبل ما لم تتحد بالعمل الروحي والجهاد الحق في المسيح يسوع. يلزم أن يرافق عملنا الروحي صلواتنا وتسابيحنا للرب!
تشير الأيدي الطاهرة إلى نقاوة الروح والجسد معًا، وكما يقول القديس چيروم: [قيثارتنا إنما هي جسدنا ونفسنا وروحنا يعملون معًا في توافق لتقدم أوتارهم جميعًا النغم!][21]
لا تعني الطهارة الغسل بالماء وإنما بالتوبة ليعمل الروح القدس فينا لنقاوة إنساننا كله، الداخلي والخارجي. يقول العلامة ترتليان: [ما الداعي للذهاب للصلاة بأيدٍ مغتسلة حقًا بينما الروح متسخة؟! يلزم رفع أيادي روحية طاهرة، نقية من الباطل والإجرام والقسوة والسموم وعبادة الأوثان وغير ذلك من الأمور المخجلة… هذه هي الطهارة الحقيقية[22].] كما يقول: [بعدما اغتسل الجسد كله، أي تطهر في المعمودية، صارت الحاجة إلى التطهير بالتوبة المستمرة عما يلحق بأيدينا من دنس[23].]
- إرشادات للنساء في العبادة
إذا كان الرجل – بل كل نفس ناضجة روحيًا – يلزمه أن يتمثل بالسيد المسيح فيبسط يديه كما على الصليب بالطهارة الداخلية ليطلب لا بالكلام فحسب وإنما أيضًا بالعمل، في حب بلا جدال أو غضب، فإنه يلزم بالمرأة – وكل نفس صارت كعروس للسيد – أن تهتم في عبادتها بالزينة الداخلية لتفرح قلب عريسها السماوي. يقول الرسول بولس: “وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآليء كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة” [ 9-١٠].
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا القول الرسولي: [ماذا؟ هو تقتربين لله للصلاة بضفائر وحلى ذهبية؟ لعلك تأتين إلى مرقص؟ أو حفلات خليعة؟ فإن الضفائر والثياب الثمينة تليق بهذه الأماكن، أما هنا فلا حاجة إلى مثل هذه الأمور. إنك تأتين إلى الصلاة لتطلبين المغفرة عن خطاياكِ… وتتوسلين إلى الرب، وتترجين فيه أن يجيب عليك بسماحة! لماذا تتزينين؟ إنها ليست ملابس تليق بمن يتوسل! كيف تتنهدين؟ كيف تبكين؟ كيف تصلين بحرارة وأنتِ مزينة هكذا؟[24]]. كما يقول: [المسيح هو عريسك أيتها البتول، فلماذا تجتذبين الأحباء البشريين؟… الزينة التي ترضي الله هي الوداعة والعفة والالتزام بالترتيب واحتشام الملبس؟… كفى غباء أيتها السيدة! حولي اهتمامك إلى نفسك، وإلى زينتك الداخلية[25].]
يمكننا أن نلتمس في كلمات الرسول بولس أن الامتناع عن الزينة الخارجية في ذاته ليس فضيلة، إنما الفضيلة هي قبول زينة القلب الداخلي خلال الحياة التقوية (الورع) والتعقل! فضيلة الإنسان أن يلبس السيد المسيح بكونه سرّ بهاء النفس بكل عواطفها وأحاسيسها والعقل بكل طاقاته. يقول الرسول: “يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتقوى… متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة”، أي يحملن ورع الله وسماته في داخلهن.
ما نقوله عن الزينة نردده أيضًا بخصوص الاحتشام، فإن لباس الاحتشام لا يعني مجرد ارتداء أنواع معينة من الملابس، إنما نحمل فينا مسيحنا ليهب للقلب والفكر والنظر واللسان الخ. احتشامًا داخليًا خارجيًا، إذ يليق لا بالنساء فقط وإنما بكل مسيحي أن يكون محتشمًا في نظراته وكلماته بل وأفكاره الخفية، مرددًا مع المرتل: “ضع يا رب حافظًا لفمي وبابًا حصينًا لشفتي”. من هو الحافظ للفم، وما هو الباب الحصين للشفتين، إلاَّ الروح القدس الذي يقدس الخارج والداخل، والسيد المسيح نفسه الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح.
بعد هذا تحدث عن التزام المرأة بالاحتشام الداخلي الروحي وعدم المبالغة في الزينة الخارجية خاصة أثناء العبادة الكنسية، تكلم عن صمتها في الكنيسة وعدم قيامها بتعليم الرجال في الاجتماعات الكنسية العامة، إذ يقول: “لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت، لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء، وآدم لم يغوَ بل حواء أغويت، فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل” [11–١٥].
ربما يتساءل البعض لماذا تصمت النساء ولا تعلم في الكنيسة؟ ولماذا يُنسب لها الخضوع؟
لكي نفهم هذا النص يلزمنا أن نتعرف على الظروف المحيطة بالكنيسة في ذلك الحين، ففي المجتمع اليهودي كانت المرأة ممنوعة من دراسة الناموس، ولا يُسمح لها أن تقوم بأي دور قيادي في خدمة المجتمع، وكان الرجل يشكر الله كل صباح على أنه لم يخلقه “أمميًا ولا عبدًا ولا امرأة”. هذا وإن كنا لا ننكر أن بعض النساء خلال التهاب قلوبهن بمحبة الله تسلمن أدوارًا قيادية في العهد القديم في الجانب الديني والسياسي، حيث كان الدين لا يفصل عن السياسة عند اليهود، الأمر الذي صححه السيد المسيح.
فعرفن في العهد القديم أربعة نبيات هن مريم قائدة النساء في التسبيح (خر ١٥: ٢٠)، ودبورة النبية وقاضية إسرائيل (قض ٤: ٤)، وخلدة النبية في أيام يوشيا (٢مل ٢٢: ٤)، ونوعدية النبية في أيام نحميا (نح ٦: ١٤)، يُضاف إليهن حنة المذكورة في إنجيل معلمنا لوقا (٢: ٣٦). حقًا لقد تمتعت المرأة بالكثير من الحقوق من خلال الشريعة الموسوية إن قورنت بمركزها في العالم في ذلك الحين. لكنها بقيت بعيدة عن خدمة المقدسات والعمل التعليمي الكنسي الخ.
أماعند اليونان فقد ضم معبد افروديت في كورنثوس ألف كاهنة كن يعرضن أجسادهن على المتعبدين كنوع من العبادة، وضم معبد ديانا بأفسس مئات من الكاهنات الشريرات.
إن كانت الكنيسة المسيحية قد رفعت من شأن المرأة، وأعطتها الكثير من الحقوق، لكن لم يسمح لها بالتعليم العام حيث يوجد الرجال حتى لا يُساء الفهم. لقد رفع السيد من شأن المرأة، فنقرأ في الإنجيل المقدس أن بعض النساء كن يسرن وراء السيد وتلاميذه الاثني عشر أثناء كرازته، وكن يخدمنه من أموالهن الخاصة (لو ٨: ١–٣)، وٍذكرت أسماء بعضهن أيضًا اللواتي رافقن إياه حتى الصليب (مت ٢٧: ٥٦، ٦١؛ ٢٨: ١)، وكانت النساء أول من بشر بقيامة السيد للتلاميذ (لو ٢٤: ١٠-١١).
وفي العصر الرسولي مع بدء انطلاق الكنيسة كانت النساء من بينهن القديسة مريم يواظبن على الصلاة والطلبة مع التلاميذ (أع ١: ١٤)، ويروي لنا لوقا البشير في سفر الأعمال الدور الإيجابي لطابيثا في خدمة الفقراء والأرامل (أع ٩: ٣٦)، وفي التحيات الطويلة في رسائل معلمنا بولس الرسول نتلمس دور كثير من النساء في العمل الكنسي الكرازي، اللواتي لم يكن أقل غيرة من الرجال في نشر كلمة الإنجيل. يتحدث الرسول عن فيبي شماسة كنخريا (رو ١٦: ١-٢) التي كانت تخدم الغرباء والمسافرين “إضافة الغرباء” كما فتحت بيتها للاجتماعات الدينية.
ويتحدث عن “بريسكلا وأكيلا” انهما “عاملان معه” في المسيح يسوع (رو ١٦: ٣)، والعجيب أنه يذكر اسم الزوجة قبل الزوج على خلاف العادات المتبعة في ذلك الوقت، لعلها كانت أكثر غيرة من زوجها، كما كان لها أثرها مع زوجها على أبولس في تصحيح إيمانه كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم ويتحدث أيضًا عن أخريات كثيرات يذكرهن بالاسم أنهن عاملات بقوة، وفي سفر الأعمال نسمع عن أربع بنات لفيلبس الإنجيلي كن يتنبأن (أع ٢١: ٩)، وردت أسماؤهن في مخطوط يرجع للقرن الرابع: هيرموان وكاريتينا وإيريس وأوطاخيانا[26]. هذا بخلاف خدمة الأرامل والعذارى التي نتكلم عنها في موضعها إن أذن الرب.
إذن لم تجحف الكنيسة المسيحية منذ انطلاقها حق المرأة، فلماذا رفضت قيامها بدور تعليمي وسط الرجال؟
يمكننا إدراك كلمات الرسول بولس إن عرفنا الفكر الغنوسي الذي كان يتسرب إلى الكنيسة منذ العصر الرسولي. لقد كان المجتمع في العصر الرسولي يضع فوارق بين الرجل والمرأة بصورة قاسية على المرأة، حتى تجاهلت القوانين المدنية والجنائية حقوقها الإنسانية. لكن جاءت المسيحية لتعلن: “ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعًا واحد في المسيح يسوع (غل ٣: ٢٨). أما الغنوسيون، فإذ يحتقرون الجسد ويحسبونه عنصر ظلمة يجب معاداته والتخلص منه، فرفضوا كل ما يخصه: رفضوا الزواج كأمر دنس، وبعض الأطعمة كقوتٍ للجسد، كما رفضوا قيامة الجسد في اليوم الأخير، وأخيرًا رفضوا الاعتراف بالتمايز الجنسي، فلا رجل ولا امرأة وإنما إنسان هو كائن له مواهبه التي لا ترتبط برجولته أو أنوثته.
بعنى آخر أرادوا أن يحيا المجتمع دون وجود أدنى اعتبار للرجولة أو الأنوثة! هذا الأمر أثار الكنيسة لتعلن أنه ليس رجل أو امرأة في المسيح كأعضاء في جسده المقدس، لكن دون تجاهل لدور الرجل كرجل، والمرأة كامرأة. لذلك حينما تحدث الرسول بولس عن التزام المرأة غطاء الرأس والرجل بتعرية رأسه (١ كو ١١: ٤–٥) لم يكن الرسول الملتهب روحيًا – على ما يظن الكثيرون – بالإنسان الذي يهتم بهذا الأمر في حرفيته، إنما أراد أن يؤكد أنه مع مساواة الرجل والمرأة في المسيح، لكن الخلاص أو العضوية في جسد المسيح أو الدخول في الحياة الجديدة لم ينزع عن المرأة أنوثتها ولا عن الرجل رجولته. كل له دوره الحيّ والفعال في الحياة الكنسية بروح الحب المتكامل.
نستطيع أن نقول بأن الرسول بولس الذي كان منفتح القلب والفكر لم يقصد بحديثه هنا عن صمت المرأة في الكنيسة وعدم تعليمها للرجل وعن خضوعها له أن يحقِّر من شأنها أو يقلل من دورها، إنما أرادها أن تعمل فيما يناسب طبيعتها كامرأة وإمكانياتها الجسدية والنفسية. فالجسد في خضوعه للرأس لا يعني أفضلية الرأس عليه أو احتقار الجسد، لأنه لا كيان للرأس منفصلاً عن الجسد ، ولا عمل له بدونه حقًا أن الرأس هو المدبر للجسد، لكن إن لم يتجاوب أحدهما مع الآخر يفقد الإثنان سلامهما وكيانهما.
لا ينكر الرسول بولس دور لوئيس وأفنيكي في حياة تيموثاوس وتعليمه الكتب المقدسة (٢تي ٣: ١٥) ولا تجاهل بريسكلا مع رجلها في خدمتهما الفردية مع كثيرين وفي بلاد مختلفة، هذان اللذان قادا بولس إلى معرفة الحق (أع ١٨: ٢٦)، وقد جاهدت أفودية وستيخي في الإنجيل (في ٤: ٢-٣).
لعل الرسول أيضًا أراد بهذا المنع أن ينزع كل مجال للعثرة في الكنيسة لكن دون تجاهل لدورها التعليمي على المستوى العائلي والفردي وأيضًا بين النساء.
يمكننا أن نكتشف مفهوم الرسول بولس مما كتبه العلامة ترتليان مهاجمًا الهراطقة، قبل أن يسقط في بدعة ماني، إذ يقول: [يا لنساء هؤلاء الهراطقة، إنهن خليعات! إنهن جسورات، حتى إنهن يعلمن ويناقشن ويخرجن شياطين ويقمن بأشفية – ألعلهن أيضًا يعمدن؟[27]“.] وحتى بعد انحرافه في الهراطقة لم ينحرف العلامة ترتليان عن الوصية الرسولية، بالرغم من اقتباسه بعض تعاليم للنبيتين ماكسميلا وبريسكلا[28]، إذ يقول [لا يُسمح للمرأة أن تتكلم في الكنيسة (١ كو ١٤: ٣٤-٣٥)، ولا أن تعلم أو تعمد أو تنسب لنفسها عملاً خاصًا بالرجل من كل الأعمال الكهنوتية[29].] هنا يظهر العلامة ترتليان أن الامتناع يقدم على أساس أنه لا يناسب طبيعتها كامرأة، وليس تحقيرًا من شأنها. لكن ترتليان عاد فتأثر قليلاً بالفكر الهرطوقي فسمح لها بالعمل النبوي[30].
أخيرًا، ماذا يقصد الرسول بولس بقوله: “لكنها ستخلص بولادة الأولاد، إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل” [١٥]؟ يرى البعض أن القديس مريم قدمت للنساء كرامة عظيمة إذ أنجبت لنا المخلص. ويرى آخرون أن النساء وإن كن قد حرمن من التعليم العام في الكنيسة في وجود الرجال، لكنهن ينلن أكاليلهن خلال تربية أولادهن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل، الأمر الذي لا يستطيع الرجال القيام به. إنهن بحق يقدمن للكنيسة أعضاء قيادية مباركة!
[1] مناظرات يوحنا كاسيان، مناظرة ٩.
[2] On prayer 14 : 2 – 5.
[3] In 1 Tim, hom. 6.
[4] In 1 Tim, hom. 7.
[5] In 1 Tim, hom. 7.
[6] In 1 Tim, hom. 7.
[7] In 1 Tim, hom. 7.
[8] راجع المقدمة: الهرطقات المعاصرة (رقم ٣).
[9] Adv. Eunomius 2 : 12.
[10] Adv. Eunomius 3 : 4.
[11] On Trinity 3 : 11, 4 : 8.
[12]In Joan tr. 41 : 5, 47 : 3.
[13]In Ps. 105.
[14]Adv. Haer 5 : 17 : 1.
[15]On the Resur. Of the Flesh 63.
[16] On the Resur. Of the Flesh 51.
[17] Adv. Eunom 2 : 8.
[18] In Joan. 66 : 2.
[19] In 1 Tim. hom. 7.
[20] In 1 Tim. Hom 8.
[21] On Ps. 21.
[22] On prayer 8.
[23] On prayer 8.
[24] In 1 Tim. hom. 8..
[25] In 1 Tim. hom. 8.
[26] Ibid, Roger Gryson: The ministry of Women in the Early Church, Minnesota, 1976, p. 128.
[27] De Paraescriptione 41 : 5.
[28] De Resurr. Carins 11 : 2 ; De Exhort. Castitalis 10 : 5.
[29] On Veiling of Virgins 9 : 1.
[30] Adv. Mare. 5 : 8 : 11 ; De Anima 9 : 4.