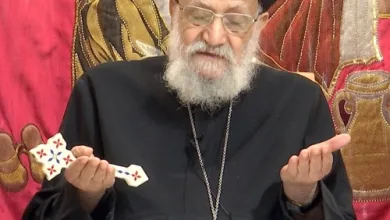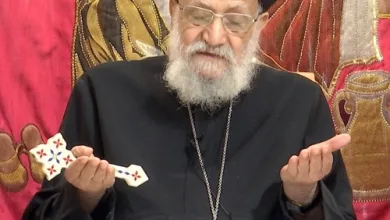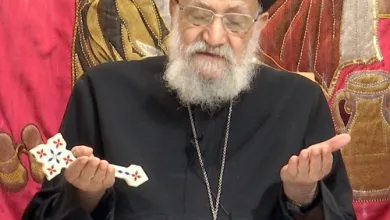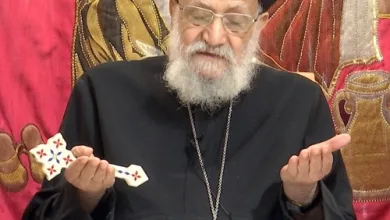تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 3 الأصحاح الثالث - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة تيموثاوس الثانية 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثالث: مقاومة روح الضلال
لا تقف رسالة الراعي عند الجهاد في حياته الخاصة ليحيا مقدسًا للرب، وإنما يليق به مقاومة البدع والهرطقات وكل ضلال سواء من جهة التعليم أو عدم السلوك بحكمة سماوية.
- الهرطقات والشر ١ – 5.
- المعلمون الفاسدون ٦ – ٩.
- احتمال مضايقاتهم 10- ١٣.
- الاستناد على كلمة الله ١٤ – ١٧.
- الهرطقات والشر
إذ تحدث عن المباحثات الغبية والمفسدة بدأ يتحدث عن الضلال خاصة من جهة السلوك، فغالبًا ما ترتبط الهرطقات والبدع بالحياة الشريرة، إذ هي في جوهرنا تقوم على حب الأنا والمجد الباطل وحب الانشقاق، فيتلاحم الفكر المنحرف عن الحق بالسلوك الشرير.
“ولكن اعلم هذا:
أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم” [1، ٢].
يقصد بالأزمنة الأخيرة بعد مجيء الابن الكلمة المتجسد، فإن كان في ملء الزمان تقدم الله بإعلان الحب بتحقيق خلاصنا خلال صليب ابنه، فإن الشيطان بدوره يثير العاملين لحسابه لمقاومة الحق. إنها أزمنة النعمة بالنسبة للمؤمنين، وأزمنة صعبة بالنسبة للمخدوعين بحيل إبليس وأضاليله.
على أي الأحوال في كل عصر يعلن الله محبته، وفي نفس الوقت يثير إبليس أتباعه للتضليل، وقد قدم الرسول بولس مثالاً بعصر موسى النبي، إذ يقول: “وكما قاوم يَنِّيس وَيَمْبِرِيس موسى، كذلك هؤلاء أيضًا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم، ومن جهة الإيمان مرفوضون” [8]. إذن فالعيب ليس في الزمان، وإنما في قلب الإنسان الشرير. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لا تُلِم الأيام والأزمنة بل الناس عبر الأزمنة، فقد اعتدنا الحديث عن أزمنة صالحة وأزمنة شريرة، وذلك خلال الأحداث التي تحدث لنا بواسطة الناس[48].]
أما جذر الشر وأساسه فهو الأنا أي محبة الإنسان لذاته، فيتقوقع حولها ويقيمها إلهًا له، يود أن الكل يخدمها عوضًا عن أن يخدم الآخرين، فيضر نفسه وهو لا يدري. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [من يهتم بأمور الآخرين إنما يهتم بشئونه الخاصة… ومن يستهين بأمور إخوته يهمل ما يخصه هو. فإن كنا أعضاء الواحد للآخر، فإن نفع أخينا لا يعود عليه وحده، إنما يعود على الجسد كله، والضرر الذي يصيب أخانا لا يقف عنده وحده، إنما يصيب بقية الجسد بالآلام.
هكذا في الكنيسة إن كنت تستخف بقريبك إنما تضر نفسك[49].] و أيضًا يعلق على كلمات الرسول: “لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم” [2]، قائلاً: [إنه يضع الجذر أو الأساس الذي تنبع عنه الشرور… فمن يحب نفسه (الأنا)، ويقال عنه إنه غير محب لنفسه، أما من يحب أخاه فهو محب لنفسه بالمعنى الحقيقي[50].]
هكذا يضع الرسول بولس محبة الذات أو الأنا أو الكبرياء كأساس للشر والهرطقة، لهذا إذ يتكلم القديس أغسطينوس عن الهراطقة، يقول: [كيف يقاومون الحق إلاَّ بواسطة غرور كبريائهم المتشامخ باطلاً؛ بينما يقيمون أنفسهم متشامخين إلى العُلَى كعظماء وأبرار، وإذا بهم يعبرون كالهواء الفارغ[51].]
خلال محبة الذات أو الكبرياء يضيق قلب الإنسان جدًا، فلا يطلب إلاَّ ما لذاته من محبة مال أو شهوات، فينسحب القلب من خطية إلى أخرى، تسلمه هذه إلى تلك ليصير ألعوبة الخطايا والنجاسات، يفقد إرادته الحُرّة وقدسيته ليعيش في مذلة وضعف.
“لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم،
محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين،
غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين،
بلا حنو، بلا رضى، ثالبين، عديمي النزاهة،
شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين،
متصلفين، محبين للذات دون محبة الله،
لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها،
فاعرض عن هؤلاء” [2–٥].
لاحظ القديس يوحنا الذهبي الفم في تعليقه على العبارات السابقة أن كل خطية تنتج الخطية التالية لها، إذ يقول: [تصدر محبة المال عن محبة الإنسان لذاته… وعن محبة المال تنبع محبة العظمة، وعن حب العظمة الكبرياء، وعن الكبرياء التجديف، وعن التجديف التحدي وعدم الطاعة… فمن يتكبر على الناس يتكبر على الله بسهولة.
هكذا تتولد الخطايا وترتفع من أسفل إلى أعلى، فمن يكون تقيًا في تعامله مع الناس يكون هكذا بالأكثر مع الله. ومن يكون وديعًا مع العبيد زملائه يكون بالأكثر وديعًا مع سيده. إذ يحتقر العبد زميله ينتهي به الأمر إلى احتقار الله نفسه. إذن ليتنا لا نحتقر بعضنا البعض، لأن هذه خبرة شريرة تُعلِّمنا احتقار الله[52].] هكذا لاحظ القديس أن الخطايا بدأت موجهة ضد الناس وانتهت موجهة ضد الله نفسه.
يقول القديس كبريانوس أن ما تنبأ عنه الرسول قد تحقق: [لقد اقتربت نهاية العالم، فظهرت العلامات من جهة الناس كما من جهة الأزمنة، فالأخطاء تخدع والخصم (إبليس) يهيج أكثر فأكثر، والعنف يشتد، والحسد يلتهب، والطمع يعمي العيون، والشر يغوي، والكبرياء ينفخ، والانشقاق يتزايد مرارة، والغضب يسرع برعونة[53].]
في اختصار نذكر أهم الشرور التي أوردها الرسول هنا:
أ. حب الذات: رأينا أنها أساس كل الشرور وجذورها، حيث تغلق النفس أو القلب عن محبة الله والناس.
ب. محبة المال أو الطمع: الإنسان المحب لذاته يطلب كل شيء لحسابها فيكون طماعًا يحب المال والكرامة على حساب إخوته، بل وعلى حساب نفسه. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن هذه الخطية تلتحم أيضًا بعدم الشكر، إذ يقول: [كيف يمكن للطماع أن يشكر؟ نحو من يشعر الطماع بالعرفان بالجميل؟ لا أحد، فإنه يحسب كل البشر أعداءه، مشتهيًا كل ما لهم، لو أنفقت عليه كل ما تملك لا يشعر بالجميل. إنه يغضب لأنك لا تملك أكثر لكي تعطيه أكثر.
ولو أقمته سيدًا على كل العالم لبقي جاحدًا، ويظن أنه لم ينل شيئًا. هذه الرغبة النهمة لا تشبع، فهي رغبة مريضة… من كان مصابًا بحمى لن يشعر بارتواء بل دائمًا يطلب أن يشرب كظمآنٍ، هكذا من كان في جنون نحو الغنى لا يشعر بإشباع رغبته مهما أُعطي له، وإنما يبقى في حالة عدم اكتفاء وبالتالي لا يشكر[54].]
ج. حب العظمة والكبرياء: كما أن محبة الذات تُوَلِّد عطشًا لا ينتهي نحو المال والغنى لا يمكن للعالم أن يرويه، هكذا ذات العلة قد تُوَلِّد عطشًا لا للمال بل إلى حب الكرامة الباطلة والمجد الزمني، الأمور التي تفقد الإنسان سلامه الداخلي.
د. التجديف: عطش الإنسان إلى الأرضيات سواء على مستوى المال والغنى أو على مستوى حب الكرامة الزمنيّة يحرف البصيرة الداخلية عن الله نفسه، فتحتقر النفس إلهها ولا تقدر أن تتلامس مع أعماله الخلاصيّة وعطاياه المجانيّة فتجدف عليه.
ه. عدم طاعة الوالدين: الإنسان الذي يستخف بالله يستخف بوالديه، ففي تجديفه يود أن يتحرر من الأبوة الإلهيّة، بكونها سلطة تحرمه الحريّة، وفي عصيانه للوالدين يحمل ذات الفكر تجاه الوالديّة الطبيعيّة الدمويّة.
و. عدم الشكر أو الجحود: رأيناه وضعًا طبيعيًا في حياة الإنسان محب المال، علامة شعوره بالفراغ الداخلي، الذي لا يستطيع العالم أن يملأه مهما قدم له. على العكس فإن السمائيّين إذ هم في حالة شبع روحي تتسم حياتهم بالشكر الدائم خلال تسابيحهم غير المنقطعة.
ز. الدنس: إن كان الفراغ الداخلي يخلق طبيعة جاحدة لا تقدر أن تشكر، فإن هذا الفراغ بعينه يلهب الإنسان نحو الأمور الدنسة لكي يلتهي فيها، حاسبًا أنه يجد شبعه وسروره الجسدي في التصرفات الدنسة.
ط. عدم الحنو: يُقصد به عدم وجود ود طبيعي، فالإنسان السالك في الدنس يطلب ما يشبع لذَّاته الخاصة، وإن أظهر حنوًا، فليس عن حنو داخلي لراحة الآخرين، وإنما لإشباع ملذاته الخاصة. والمثل الواضح في ذلك أمنون الذي مرض جدًا بسبب محبته الدنسة لأخته ثامار، ولما أخذ منها ما اشتهاه طردها. وأيضًا امرأة فوطيفار أحبت يوسف العفيف جسديًا، ولما تحدث معها بلطف رافضًا الشر سلمته للسجن وعرضت حياته للخطر.
ظ. عدم الرضا: يُقصد به نقض العهد الذي ارتبط به.
ع. الثلب: يُقصد به اتهام الآخرين زورًا. فلا يقف الأمر عند نقض العهد الذي ارتبط به بإرادته وإنما يتهم غيره زورًا، يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [الذين يشعرون بأنه ليس فيهم شيء صالح بينما هم يرتكبون خطايا ومعاصي كثيرة، يجدون تعزيتهم في تشويه شخصية الغير[55].]
غ. عدم النزاهة أو عدم العفة: بمعنى عدم قدرة الإنسان على ضبط نفسه من جهة لسانه وشهواته وكل شيء آخر. يريد أن يعيش في الملذات بلا ضابط. وكما يقول العلامة أوريجينوس: [من يعيش حسب الملذات يحب الطريق الواسع، فينحرف عن طريق يسوع المسيح الضيق والكرب (مت ٧: ١٣-١٤)، الطريق الذي ليس فيه أدنى منحنيات، كما ليس فيه زوايا قط (مت ٦: ٥)[56].]
ف. شراسة: طبيعة الخطية تفقد الإنسان إنسانيته ليحيا شرسًا، يقاوم الآخرين بلا سبب حقيقي.
ق. غير محبين للصلاح: أي يحتقرون الأمور الصالحة ويستهينون بها كأمورٍ تافهة.
ك. الخيانة: يقصد بها خيانة الإنسان للعهد الإلهي، ومن جانب آخر خيانته للعهد الطبيعي كأن يسلم الأب ابنه، أو الابن أباه (مت ١٠: ٢١) أو خيانة الصداقة.
ل. الاقتحام: يتدخلون بالشر فيما لا يعنيهم.
م. التصلف: أو الكبرياء بدون تروٍ.
ن. محبة اللذات: دون محبة الله، لأن محبة الإنسان لإشباع شهواته تقف حائلاً عن محبته لله.
أخيرًا يختم الرسول حديثه عن الأشرار بقوله: “لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها” [5]، وهذا هو أخطر أنواع الشر أن يحمل الإنسان المظهر البَرَّاق المُخادع أما الداخل فمملوء فسادًا. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن هذا الرياء يمثل لصًا خطيرًا يسلب المتدينين كل ما لديهم. فالخطايا السابقة واضحة يسهل على مرتكبيها أن يتوبوا عنها ويعترفوا بها، أما خطية الرياء، فغالبًا ما يصعب على مرتكبيها إدراكها. إذ لا يخدع الآخرين فحسب وإنما يخدع أيضًا نفسه، فيرى في نفسه أنه أفضل من الآخرين، ولا يقبل التعليم أو النصح.
المعلمون الفاسدون
“فاعرض عن هؤلاء،
فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت
ويسبون نُسَيَّات مُحَمَّلات خطايا،
مُنساقات بشهوات مختلفة.
يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدًا.
وكما قاوم يَنِّيس ويَمْبِريس موسى،
كذلك هؤلاء أيضًا يقاومون الحق.
أناس فاسدة أذهانهم،
ومن جهة الإيمان مرفوضون،
لكنهم لا يتقدمون أكثر،
لأن حمقهم سيكون واضحًا للجميع كما كان حمق ذَيْنِكَ أيضًا” [6 –٩].
استطاع الهراطقة المفسدون التسلل إلى البيوت للعمل خِفية، خاصة بين النساء الطائشات اللواتي يعتنقن كل ما هو جديد. هؤلاء النساء أعجبن بالأفكار الغنوسية، وسلم بعضهن أنفسهن لبعض هؤلاء المعلمين الذين يستهينون بتقديس الجسد، إذ يعتبرونه عنصر ظلمة لن يقوم في يوم الرب ولا ينال مكافأةً أو مجدًا، فتركوا له العنان يفعل ما يشاء. ويبدو أن بعض النساء في طيشهن تركن رجالهن، وانسقن إلى هؤلاء المخادعين، فانحرفن عن الطهارة كما انحرفن عن الحق. وقد دعا الرسول هؤلاء النساء “نُسَيَّات” أي سخيفات أو غير حكيمات.
إنهن يقبلن الأفكار المضللة التي يبثها المعلمون الفاسدون عند تسللهم إلى بيوتهن، وكأنهن يكررن ما قامت به أمهن الأولى حين تسللت إليها الحية القديمة إلى بيتها في الفردوس، ودخلت قلبها وفكرها لتبث فيه خداعها. هكذا يتسلل الهراطقة إلى بيوت المؤمنين عن طريق النساء غير الحكيمات. هنا لا يلوم الرسول الهراطقة وحدهم كمضللين ومفسدين، لكنه أيضًا يلوم النسوة الغبيات اللواتي يفتحن لهم بيوتهن، بل وقلوبهن وأفكارهن، ويسلمن لهم أجسادهن خلال عدم سهرهن الروحي وعدم تدقيقهن. لقد وجد الهراطقة فيهن استجابة داخلية قبل القبول الظاهري، وانفتحت القلوب والأفكار المنحرفة لهم، لأن هؤلاء النساء كن يستطبن الشر.
ضرب الرسول مثالاً للمعلمين المخادعين بما حدث في أيام موسى النبي وهرون حيث قاومهما الساحران المخادعان ينيس ويمبريس. لقد عرف الرسول الاسمين ليس من الكتاب المقدس وإنما من التقليد اليهودي. هذان الساحران خدعا المصريين إذ قاما بأعمال تبدو مشابهة لما قام به موسى النبي وهرون، لكنهما في حقيقتهما كانا رجلين فاسدي الذهن عديمي الإيمان مملوءين حماقة، أرادا بالمظهر المخادع أن يُدخلا الناس إلى الحماقة.
كأن الرسول يؤكد لنا أنه في كل عصر حيث يوجد العمل الإلهي يقابله الخداع الشيطاني! وُجد موسى وهرون من قبل الله، فأقام الشيطان مقابلهما الساحرين المخادعين. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم
[إن كان أحد يعترض على وجود هراطقة الآن، فليذكر أن الأمر هكذا منذ البداية، إذ كان الشيطان يقيم الضلال على الدوام في مقابل الحق. في البداية وعد الله بالصالحات، وقدم أيضًا الشيطان وعده. أقام الله الفردوس، وخدع الشيطان الإنسان بقوله: “تصيران كالله” (تك ٣: ٥)، فإن كان قد عجز عن تقديم عمل قدم وعودًا هي بالأكثر كلمات، وهذه هي طبيعة المخادعين.
بعد هذا جاء قايين وجاء معه هابيل،
أبناء شيث ومعهم بنات الناس،
حام ومعه يافث،
إبراهيم (وفي أيامه) وُجد فرعون،
يعقوب ومعه عيسو.
وهكذا جاء موسى (وهرون) وقاما الساحران.
الأنبياء ومعهم الأنبياء الكذبة.
الرسل والرسل الكذبة،
المسيح وسيجيء ضد المسيح.
هذا ما كان قبلاً، وما حدث إلى ذاك اليوم… وفي اختصار لم يكن هناك وقت لم يوجد فيه الباطل ليقف ضد الحق. إذن لا تقلقوا[57].]
احتمال مضايقاتهم
بعد أن تحدث الرسول عن وجود هراطقة في كل عصر يقاومون الحق، أوضح ضرورة احتمال مضايقاتهم بثبات، إذ يقول: “وأما أنت فقد تَبِعْتَ تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري، واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكية وإيقونية ولسترة. أية اضطهادات احتملت، من الجميع أنقذني الرب” [١٠–١١].
هنا يقدم لنا مفهومًا حيًا للتسليم أو التقليد الرسولي إنه ليس مجرد عقيدة إيمانيّة فكريّة يتقبلها التلميذ عن معلمه، أو الجيل عن الجيل السابق، إنما فيما هو يحوي الإيمان الحيّ بكل جوانبه إنما يتسلم أيضًا التعليم والسيرة المقدسة والمقاصد التي عاش لأجلها وطول الأناة والمحبة والصبر، الأمور التي مارسها الرسول، وتَلَمَّسها تلميذه فيه، وأيضًا اضطهاداته وآلامه. كأن ما تسلمه تيموثاوس الأسقف عن بولس الرسول إنما هو “الحياة مع المسيح” بكل دقائقها الظاهرة والخفية. وكما سبق وأكدت في أكثر من موضع، خاصة في كتاب “التقليد والأرثوذكسية” إن التسليم الرسولي ليس أمورًا خارجية أو مجموعة من العقائد والنظم الكنسيّة تحكم عبادة الكنيسة وسلوك الجماعة والعضو فيها، إنما هي “الحياة” كما عاشتها الكنيسة الأولى وسلمتها في كل جوانبها.
هنا يمكننا القول أن قبول الآلام واحتمالها هو جزء لا يتجزأ من التسليم الرسولي، فقد تتلمذ تيموثاوس على يدي الرسول المتألم، وهذا هو المعلم يُذَكِّر تلميذه أن يتمسك بما رآه وما لمسه لكي تكون له معه شركة في الرب، محتملاً الألم بطول أناة، له ذات مقاصد الرسول ونياته وأناته ومحبته لمضطهديه. بمعنى آخر ليس مجرد رؤية القديس تيموثاوس لمعلمه بولس الرسول متألمًا يبعث فيه احتمال الألم معه، وإنما تلمذته على يديه وإدراكه أعماق معلمه الداخلية من مفاهيم ومقاصد ومشاعر وأحاسيس خفية في المسيح يسوع، أي اكتشاف سرّ القوة الداخلية في الرسول أثناء ضيقه وآلامه.
يعلن القديس يوحنا الذهبي الفم على كلمات الرسول، قائلاً: [كن قويًا فإنك لم تكن حاضرًا معي فحسب وإنما تبعت تعليمي عن قرب… بقوله “تَبِعْتَ تعليمي” يشير إلى المناقشة (الإيمانيّة)، وبقوله “سيرتي” يشير إلى سلوكه، وبقوله “قصدي” يشير إلى غيرته وثبات نفسه. وكأنه يقول له: إنني لا أنطق بهذه الأمور دون أن أنفذها، لم أكن فيلسوفًا (حكيمًا) بالكلام وحده. وبقوله “إيماني وصبري” يقصد أنه ليس شيء من هذه الأمور قد أقلقه. يتحدث عن “محبته” التي لا توجد لدى هؤلاء (المفسدين)، “وصبره” التي ليست لهم. لقد أظهر طول أناته على الهراطقة وصبرًا في الضيقات[58].]
أما إشارته إلى الإضطهادات التي عانى منها الرسول في أنطاكية وإيقونية ولسترة [١١] لم تكن إلاَّ مجرد أمثلة لما عانى منه الرسول، وليس إحصاءً لكل أتعابه، فقد كانت نيته تقديم أمثلة لتلميذه وليس استعراضًا بقصد حب الكرامة. أما خبرته في هذه الآلام فلخصها في العبارة الجميلة: “ومن الجميع أنقذني الرب” [١١]، هذه هي الخُلاصة التي يود أن يقدمها لتلميذه.
لم تكن هذه الضيقات النابعة عن المعلمين المفسدين أو بالحري عن إبليس نفسه خاصة بالرسول بولس وحده، وإنما “جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يُضطهدون” [١٢]. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لا يمكن لإنسان يسلك في حياة الفضيلة ألاَّ يتعرض لحزنٍ أو تعبٍ أو تجربةٍ، إذ كيف يهرب منها من يسلك الطريق الكرب الضيق، ومن يسمع أنه في العالم يكون له ضيق (يو ١٦: ٣٣)؟ إن كان أيوب قال في زمانه أن حياة الإنسان تجربة (أي ٧: ١) كم بالأكثر يعاني من هم في هذه الأيام؟[59].] كما يتحدث على لسان الرسول، قائلاً: [لا تجعل أمرًا كهذا يقلقك إن كان (المعلمون الفاسدون) في وسع وأنت في تجارب، فإن هذا أمر طبيعي.
ففي المثال الخاص بي تتعلم أنه يستحيل على إنسان ما وهو في صراعه ضد الشرير لا يتعرض للضيق. لا يقدر أحد أن يكون في معركة ويسلك في ترفٍ، ولا أن يصارع وهو ينعم بالملذات. ليت أي مجاهد (روحي) لا يطلب الحياة السهلة المفرحة! الحياة الحاضرة إنما تمثل حالة صراع وحرب وضيق وكرب وتجارب وهي مسرح للصراعات (الروحية). الآن ليس وقت للراحة، بل هو وقت تعب وجهاد[60].] وفي تعبير اختباري يقول القديس أغسطينوس: [إن أردت ألاَّ تكون لك متاعب، فأنت لم تبدأ بعد أن تكون مسيحيًا… إن كنت لا تعاني من اضطهاد (ضيق) لأجل المسيح، فاحذر لئلا تكون لم تبدأ بعد أن تعيش بالتقوى في المسيح[61].]
هذا بالنسبة للمجاهدين الروحيّين، إذ يتقبلون الضيق، أيًا كان مصدره، من أجل المسيح، أما عن الأشرار فيقول: “ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مُضِلِّين ومُضَلِّين” [١٣]. لم يتحدث الرسول عنهم إن كانوا في ترف أو في ضيق، لأنهم حتى وإن عاشوا في ترفٍ وتدليلٍ، لكن الضيق يلازمهم داخل نفوسهم، وإن فرحوا فإلى حين، حيث لا يقدر العالم أن يُشبع أعماقهم. لكن الرسول اهتم أن يعلن حالهم أنهم يتقدمون إلى أردأ، يُسقِطون الآخرين في الضلال ويَسقطون هم معهم، فينحرفون من ضلالٍ إلى ضلالٍ، وينحدرون من هوان إلى هوان، متقدمين بالأكثر نحو الهاوية.
- الاستناد على كلمة الله
كأن الرسول يود أن يعلن سرّ قوة الإنسان الروحي وسط الضيق ألا وهو التحصن في كلمة الله. فإن الكتاب المقدس هو سند الراعي، كما هو سند الرعية – وسط المشقات – ومعين ضد هجمات المخادعين، إذ يقول الرسول: “وأما أنت فاثبُت على ما تعلمت وأيقنت، عارفًا ممن تعلمت. وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البرّ، لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهبًا لكل عمل صالح” [١٤–١٧].
وللقديس يوحنا الذهبي الفم تعليق رائعٍ على هذه العبارات، إذ يقول: [أُعطي الكتاب المقدس بهذا الهدف أن يكون إنسان الله كاملاً به، بدونه لن يمكن أن يكون كاملاً. يقول (الرسول): لديك الكتب المقدسة عوضًا عني. إن أردت أن تتعلم شيئًا فتعلمه منها. هذا كتبه لتيموثاوس المملوء من الروح، فكم بالأكثر يكون بالنسبة لنا![62]]
إن كان تيموثاوس قد رضع الإيمان خلال جدته وأمه اللتين ربتاه على الكتب المقدسة، فإنه وهو أسقف يليق به أن يثبت فيما تعلم فلا يكف عن التمتع بكلمة الله القادرة أن تثبته في إيمانه، وتدخل به من معرفة روحية إلى معرفة، ومن خبرة حياة إلى خبرة جديدة، ليحيا دائمًا في نموٍ، قادرًا أن يتعلم ويعلم، أن ينمو هو في الرب وأن يسند الآخرين في حياتهم الروحية. إنه الكنز المخفي في الحقل الذي يليق بالرعاة كما الرعية ألاَّ يكفوا عن اقتنائه في داخلهم، واللؤلؤة كثيرة الثمن التي من أجلها نبيع كل شيء لكي نقتنيها.
ما أخطر على الكنيسة أن يظن الأسقف أو الكاهن أنه قد عرف الكثير، فيتوقف عن التقوت بكلمة الله كل يوم، وكما يقول القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة: [يليق بالأسقف ليس فقط أن يُعَلِّم بل ويتعلم أيضًا، فمن كان في حالة نمو يومي متقدمًا إلى ما هو أفضل مثل هذا يعلم أفضل[63].]
ويحدثنا القديس إكليمنضس السكندري عن دور الكتاب المقدس كمصدر تعليم وتدريب في حياة الإنسان، راعيًا كان أو من الشعب، قائلاً: [حقًا مقدسة هي هذه الكتب التي تقدس وتؤله… ليس إنسان هكذا يتأثر بنصائح أي قديس من القديسين كما يتأثر بكلمات الرب نفسه محب البشر. لأن هذا هو عمله، بل عمله الوحيد، خلاص الإنسان، لهذا يحثهم على الخلاص ويفرح، قائلاً: “ملكوت السماوات داخلكم”… فالإيمان يقودك فيه، والخبرة تعلمك، والكتاب المقدس يدربك[64].]
كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [كلمة واحدة من الكتب الإلهيّة هي أكثر فاعلية من النار! إنها تلين قسوة النفس، وتُهيئها لكل عمل صالح[65].] [معرفة الكتب المقدسة تقوي الروح، وتنقي الضمير وتنزع الشهوات الطاغية، وتُعَمِّق الفضيلة، وتتسامى بالعقل، وتعطي قدرة لمواجهة المفاجآت غير المنتظرة، وتحمي من ضربات الشيطان، وتنقلنا إلى السماء عينها، وتحرر الإنسان من الجسد، وتهبه أجنحة للطيران[66].]
يقول القديس بولس لتلميذه أن كلمة الله نافعة للتعليم كما للتوبيخ، للتقويم كما للتأديب، فيقدمها بلا تنميق وبلا مجاملة، يقدمها بروح الحق الذي يلاطف وينتهر، يترفق ويحزم. لهذا يحذرنا القديس أغسطينوس في إحدى عظاته من أن يتحول الكارز بالكلمة إلى عازف موسيقي يهتم أن يبهج سامعيه بألحانه العذبة، مع أنه يلزم أن يقدم لهم في الوقت المناسب الكلمات المرّة لكي تعمل لتأديبهم، فتتحول لهم فيما بعد إلى عذوبة في قلوبهم.
[48] In 2 Tim. hom 7.
[49] In 2 Tim. hom 7.
[50] In 2 Tim. hom 7.
[51] On Ps. 37.
[52] In 2 Tim. hom 7.
[53] Treat. on the Unity of the Church, 16.
[54] In 2 Tim. hom 7.
[55] In 2 Tim. hom 8.
[56] On Prayer 19: 3.
[57] In 2 Tim. hom 8.
[58] In 2 Tim. hom 8.
[59] In 2 Tim. hom 8.
[60] In 2 Tim. hom 8.
[61] On Ps. 66.
[62] In 2 Tim. hom 9.
[63] Ep. 73: 9.
[64] Exhortation to the Heathen.
[65] In Matt. hom 2: 9.
[66] De Stud. paes PG 63: 485.