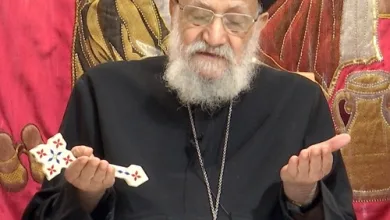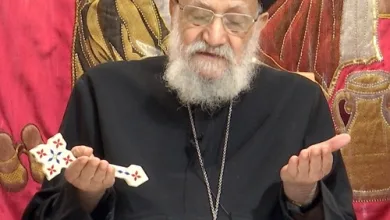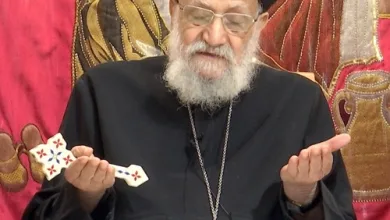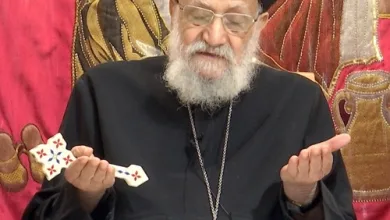تفسير رسالة تسالونيكي الثانية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تسالونيكي الثانية 1 الأصحاح الأول - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تسالونيكي الثانية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة تسالونيكي الثانية 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الأول افتخاره بهم
لم يكن ممكنًا للرسول بولس صاحب القلب المتسع وهو يكتب هذه الرسالة لكي يصحح المفاهيم الخاطئة بخصوص مجيء الرب الأخير، ويوصي ويوبخ من أهملوا أعمالهم اليومية، إلا أن يبدأ كعادته بالشكر لله من أجل ما يراه فيهم ناميًا في الروح، كاشفًا لهم الجوانب الطيبة في حياتهم الروحية، معلنًا لهم افتخاره بهم حتى يسندهم ويشجعهم! إنه في أبوة روحية صادقة يعرف كيف يشجع قبل أن ينتهر، ويعين الضعفاء حتى في لحظات توبيخهم.
- افتتاحية الرسالة 1-2.
- شكره للَّه وافتخاره بهم 3-4.
- دينونة اللَّه العادلة 5-10.
- صلاته لأجلهم 11-12.
1. افتتاحية الرسالة
“بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في اللَّه أبينا والرب يسوع المسيح.
نعمة لكم وسلام، من اللَّه أبينا والرب يسوع المسيح” [1-2].
لم تختلف هذا الافتتاحية عن تلك التي وردت في الرسالة السابقة، لأن ظروف الكنيسة من جهة الضيقة المحيطة بها كانت لا تزال كما هي. إنه يراها الكنيسة الثابتة في المسيح يسوع، غنية ومقدسة وممجدة وسط آلامها، لها موضع في حضن أبيها السماوي خلال اتحادها برأسها “الرب يسوع المسيح“. إلا أنه يكرر هنا وصف الآب أنه أبونا، وكأن الرسول وهو يتحدث في صلب الرسالة عن “الارتداد العظيم” بسبب ظهور “إنسان الخطية” في أواخر الدهور، يؤكد للكنيسة مركزها بالنسبة للآب، ودور الآب كأبينا السماوي الذي يرعانا ويحفظنا مهما اشتدت هجمات عدو الخير. إن أبوة الله تعلن بالأكثر حينما نتعرض لهجمات مرّة من الشيطان مقاوم الحق.
2. شكره للَّه وافتخاره بهم
“ينبغي لنا أن نشكر اللَّه كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق،
لأن إيمانكم ينمو كثيرًا،
ومحبة كل واحد منكم جميعًا بعضكم لبعض تزداد،
حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله،
من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها.” [3-4].
يفتتح معلمنا بولس الرسول رسالته بالكشف عن شعوره بالالتزام بتسديد الدين لله، بتقديم ذبيحة شكر لله من أجل عمله لا في حياته الخاصة، إنما في حياة “الإخوة”، أولاده الروحيين. هكذا يفرح الأب الروحي بنمو أولاده الروحيين في الرب، فتبتلع حياته بالشكر لله بكونه مصدر كل عطية صالحة وواهب الحياة الفاضلة.
لعل سرّ فشل كثير من الخدام الغيورين تطلعهم بنظرة متشائمة نحو نقائص حياتهم الروحية وحياة المخدومين قبل أن يشكروا الله من أجل عطاياه في حياتهم الخاصة وفي حياة الآخرين. أما الرسول بولس فكان يشكر “كل حين“. وكأن النقائص والضعفات لم تنزع عن قلبه حياة الشكر لحظة واحدة، إذ صارت حياته “أفخارستية” أي حياة شكر بلا انقطاع.
بكلمات أخرى يمكننا أن نقول أن الشكر في حياة الرسول لم يكن مجرد كلمات يرددها بشفتيه بين حين وآخر، أو تسابيح يترنم بها من وقت لآخر، وإنما كان الشكر يمثل طبيعة تمس إنسانه الداخلي الذي يسبح الله بلغة الروح التي لا تتوقف، فتخرج التسبحة معلنة مع كل نسمة من نسمات حياته. صارت حياته قيثارة جديدة يعزف عليها روح الله القدوس ليقدم سيمفونية الشكر للآب في ابنه المحبوب يتنسمها رائحة رضا مقبولة لديه.
خلال هذا المنظار الروحي المبهج أدرك الرسول في أهل تسالونيكي نجاحهم في أساسيات الحياة المسيحية: الإيمان والمحبة والرجاء، فلمس منهم الإيمان العملي النامي بلا انقطاع، والمحبة نحو الجميع المتزايدة، والرجاء واهب الصبر وسط الضيقات. هذا النجاح سبق فأعلنه أكثر من مرة في رسالته الأولى لهم، كأن يقول: “متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم“ (1 تس 1: 3).
أولاً: من جهة الإيمان يقول “لأن إيمانكم ينمو كثيرًا” [3]. لم يكن هذا بالأمر الغريب أن يعلن الرسول لهم عن نمو إيمانهم كثيرًا وهم وسط الآلام. فإن الإيمان، كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم يظهر متزايدًا خلال عواصف التجارب الشديدة وأمواجها. فإذ تهب الرياح الشديدة تتمرّر نفس المؤمن فيه ولا يجد له ملجأ إلا أن يختفي في مسيحه، ليدخل معه وفيه إلى بستان جثسيماني وينحني بالتمام أمام الآب، يصرخ ويئن. يدخل المؤمن في رؤيا جديدة تتكشف في أعماله ما كان يمكنه أن ينعم بها خارج الألم ولو قضى سنوات طويلة في عبادات مستمرة.
إن الضيق – من أجل المسيح – هو انفتاح لنفس المؤمن للتمتع بأعماق جديدة في صليب الرب ودفنه وقيامته، فيزداد إيمانه كثيرًا جدًا. الألم من أجل الرب يلزم القلب أن يصرخ من الأعماق مع الرسل، قائلاً: “زد إيماننا” (لو 17: 5)، فيجد أبواب السماء مفتوحة على مصراعيها لتمنح بلا مكيال!
تكشف التجربة أيضًا عن بهاء إيماننا، فنصير وسط الظلمة ككواكب متلألئة. فإن كان يليق بالمسيحي أن يحيا بالإيمان في أوقات الفرج، فإن نيران الضيق تكشف بالأكثر صدق إيماننا، وأتونه يعطيه بريقًا صادقًا.
ثانيًا: من جهة المحبة يقول: “ومحبة كل واحد منكم جميعًا بعضكم لبعض تزداد” [3]. إن كان الإيمان هو أساس الحياة المسيحية ومدخلها، فإن الحب هو مجدها، بكونه ثمر الروح (غل 5: 22) الذي لا يسقط أبدًا (1 كو 13: 8). إن كانت الضيقة أعطت لأهل تسالونيكي نموًا في الإيمان، فإنها بالأكثر ألهبت قلوبهم بالحب.
ففي أتون الضيق يلتقي المؤمن بالمصلوب، لا ليراه فحسب، وإنما ينعم بفكره، فيحمل في داخله اشتياقًا روحيًا ملتهبًا أن يقدم حياته من أجل كل إنسان كما فعل سيده، ينسى ما هو لنفسه مهتمًا بما هو للآخرين. هنا يدرك وصية الرسول: “لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحدٍ إلى ما هو للآخرين أيضًا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضًا” (في 2: 4).
يرى القديس يوحنا الذهبي الفم في قول الرسول “جميعًا” أثناء حديثه عن المحبة المتزايدة أنه يكشف عن طبيعة الحب التي لنا. فالحب لشخص أو اثنين أو أكثر ليس بحبٍ، إنما الحب هو اتساع القلب للجميع. حب الخاصة حب بشري، أما محبة الجميع حتى الأعداء فهو إلهي! وكأن المؤمن في لقائه مع المصلوب خلال الألم لا ينغلق قلبه نحو مضايقيه ولا يطلب النقمة لنفسه، وإنما على العكس يتسع قلبه بالحب نحوهم، مدركًا أن عدوه الحقيقي ليس الإنسان المقاوم له، وإنما عدو الخير الذي يثير البشر ضد بعضهم البعض.
ثالثًا: من جهة صبر الرجاء، يقول الرسول: “حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها” [4]. في الرسالة السابقة أعلن لهم الرسول أنه بسبب صبرهم في الضيقة صاروا قدوة للساكنين في مكدونية وأخائية، بل وأذيعت كلمة الله في كل مكان خلال حياتهم الحيّة حتى لم يكن له أن يتكلم عنهم، أما وقد طالت فترة الاضطهادات واشتدت عليهم الضيقات شعر بالمجد المتزايد الذي ينسب إليه بسببهم، فصار يفتخر بهم. حقًا إن مجد الكاهن أو الخادم يكمن في إيمان أولاده الروحيين في الرب، معلنًا عمليًا خلال الصبر برجاء وسط الضيق.
هنا يربط الرسول الصبر بالإيمان، فإن كثيرين لهم قوة احتمال بالطبيعة، لكن هذه السمة سرعان ما تخور حينما يسقط الإنسان تحت الظلم. أما الإيمان فيفتح العينين بالرجاء في دينونة الله العادلة ليتقبل من المصلوب صبره، ويشاركه سمته، فيفرح بالضيق كمجدٍ له، ملتهبة أعماقه بالشوق نحو اليوم الأخير.
موضوع فخر الرسول هو “الصبر” الذي اتسم به تلاميذه الروحيين، بكونه مشاركة عملية وصادقة في آلام المسيح وصلبه. هذا هو الكنز الذي اعتزت به الكنيسة في عصر الاستشهاد المبكر، وحينما انتهى الاضطهاد خرجت الجماهير إلى البرية لتتقبل خلال الحياة النسكية الألم بصبر فلا تُحرم من شركة الصليب في أعماق جديدة.
أقول بصدق هذا هو كنز المؤمن أن يقبل صبر المسيح فيه بالروح القدس كشركة آلام مع السيد، أيّا كان نوع الألم وأيّا كان مصدره! ليحرص أن يقتني الصبر الحقيقي في مرضه أو أتعاب أسرته أو عمله أو مضايقة الغير له! يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [يليق بنا أن نسلك في نفس الطريق حتى نشاركه في المجد والكرامة… ما أمجد الآلام؟ بها نتشبه بموته[1].]
3. دينونة الله العادلة
“ملكوت الله الأبدي” هو سرّ احتمال المؤمنين للآلام بصبر، إذ يقول الرسول: “بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت اللَّه الذي لأجله تتألمون أيضًا” [5]. ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا القول الرسولي بأن الإنسان الطبيعي في وسط الضيق والظلم يثور في قلبه شوق نحو النقمة من الظالمين، لكن المسيحي تلتهب مشاعره بانتظار الدينونة العادلة لنواله ملكوت اللَّه الأبدي، وتمتعه بالأمجاد السماوية.
المؤمن الحقيقي حينما يسقط تحت الظلم لا يطلب النقمة الإلهية من الظالمين، وإنما يتهلل فرحًا بحمله الصليب، وتسمو مشاعر الفرح فوق المرارة لتعلو بالإنسان إلى الأمجاد. أما من جهة الظالمين، فهو يكره الظلم لا الظالم، ويشعر بضعف الطبيعة البشرية التي يستخدمها الشيطان – عدو البشرية كلها – أداة لظلم الإنسان لأخيه، مشتاقًا أن يرى الظالمين وقد تحرروا من عبودية الظلم والقسوة، لينعموا بملكوت الحب الأبدي. بهذه النظرة الإيمانية يتقبل المؤمن الألم لا في استسلام وخضوع، وإنما بروح القوة والحب، متطلعًا إلى المجد الأعظم الذي يشتهيه لكل بني البشر.
لكن الرسول يكمل حديثه ليقرر حقيقة واقعة لا يشتهيها المؤمن، ألا وهي: “إذ هو عادل عند اللَّه أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقًا” [6].
لم يقل “لأنه عادل” وإنما “إذ هو عادل” وكأن الرسول يقرر حقيقة لا تحتاج إلى نقاش، وهي أن الله يجازي المضايقين ضيقًا إن أصرّوا على موقفهم بلا توبة. لقد كان الرسول نفسه يومًا يقاوم الكنيسة ويضايقها، لكنه إذ فعل ذلك في جهالة، وإذ قبل الحق عندما أشرق عليه، تلقّفته رحمة اللَّه الغافرة لا ليتخلّى عن مضايقته للمؤمنين، وإنما ليتقبل بفرح مضايقة الأشرار من أجل الإيمان. وكما قال الرب عنه لحنانيا: “لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي” (أع 9: 15).
أراد الرسول أن ينعشهم وسط ضيقتهم، ففتح أعينهم على استعلان ربنا يسوع المسيح من السماء قائلاً: “وإياكم الذين تتضايقون، راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته” [7]. ففي العالم علق السيد على الصليب بينما كان الأشرار هم أصحاب السلطان. وللأسف كان أصحاب السلطان الديني كرؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفريسيين الخ. أكثر عنفًا. هوذا يأتي اليوم الأخير ليعلن السيد المسيح كملك أبدي، أما الأشرار الذين لم يقدموا توبة فيهلكون. وكأنه يقول لهم: إنكم تشتركون مع السيد هنا في آلامه وضيقته لتشتركوا معه أيضًا في يوم مجده العظيم.
لم يكن منظر المجد الأبدي والراحة السماوية يفارق عيني الرسول، ففي قوله “راحة معنا” إنما يقول: مجيئه الأخير هو سرّ راحتنا نحن الرسل، وهو سرّ راحتكم، ستكونون معنا لننعم جميعًا بالملكوت عينه. في هذا اليوم يأتي الرب مع ملائكة قوته، فتشتركون ونحن معكم مع الطغمات السماوية في الحياة العلوية الممجدة كإعلان لقوة الرب.
يلقب الرسول الملائكة القادمين مع السيد في يوم مجده الأبدي بـ”ملائكة قوته“. وكأن الرسول يود أن يقول لهم: لقد دعيتم هنا للحياة الملائكية. لكن وسط الضيقات تظهرون كمن في ضعف، وستأتون أنتم أنفسكم مع الملائكة كأناس روحيين وأولاد لله وورثة ملائكة قوةّ! إن الضعف الذي يعيشونه الآن وسط أتون الضيق إنما هي البذار التي تُلقى في الأرض في ضعفٍ، لتأتي بثمرٍ كثير في قوة. إن السيد المسيح بضعف الصليب أظهر ما هو أعظم من القوة، مقدمًا للبشرية الطبيعة الجديدة على صورة الخالق، رافعًا إيّاها من انحطاطها وفسادها إلى العلو السماوي، فإننا بالاتحاد معه ننطق خلال ضعف الصليب إلى قوة القيامة وأمجادها.
العجيب أن الرسول بولس الذي يسجل هذا الرسالة ليصحح خطأهم من جهة ظنهم أن يوم الرب قد اقترب جدًا، فأهملوا أعمالهم اليومية، إذ به يحدثهم عن شوقه لهذا اليوم، واضعًا إيّاه نصب أعينهم كدافع لجهادهم وسط الضيقات، دون إهمال أعمالهم اليومية. فالرسول لا يقبل التطرف اليميني أو اليساري، فلا ينشغل الإنسان بالزمنيات فيفتر قلبه عن الشوق للأبدية، ولا يُمتص قلب الإنسان في الأبديات على حساب تقديسه للعمل الزمني.
يكمل الرسول حديثه، قائلاً: “في نار لهيب معطيًا، نقمة للذين لا يعرفون الله، والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح” [8].
يرى الرسول بولس ربنا يسوع قادمًا في ملكوته الأبدي في نار لهيب يحرق أعداءه، وكما يقول المرتل: “يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل، وحوله عاصف جدًا” (مز 50: 3)، “قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله“ (مز 97: 3). إنها نار العدل الإلهي التي لا تطيق الشر بل تبيده، فتحل النقمة على الذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيله المقدس.
لماذا يكتب الرسول عن النقمة الإلهية؟ هل في هذا ما يعطي الذين في ضيقة والساقطين تحت الظلم راحة؟ لست أظن أن الرسول بولس صاحب القلب المتسع بالحب لكل البشر، الذي يشتهي خلاص كل نفس في العالم، يقصد هذا. وإنما أراد الرسول أن يعلن حقيقة واقعة تحدث سواء اشتهاها الظالم أو رفضها، وهي أن الذين يصنعون الظلم ويصرون عليه يجتنون ثمرته الطبيعة كنقمة إلهية. الذين يختارون الفساد يحل بهم الفساد ليبيدهم، والذين يضايقون الغير ظلمًا يُكال لهم بذات الضيق والظلم، كقول الرسول نفسه: “الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقًا” [6]. فما يحدث للأشرار كنقمة إلهية ليس موضوع شهوة المؤمنين، ولا المؤمنون هم السبب في مجازاتهم، وإنما جهلهم أو عصيانهم هو السبب.
فبالنسبة للأمم الذين لا يعرفون الله يسقطون تحت الجزاء بسبب ظلمة جهلهم، أما الذين صارت لهم معرفة بالإنجيل فقبلوه في فكرهم دون حياتهم، فإنهم يسقطون تحت النقمة بسبب عصيانهم، وكأن الله يدين الأشرار، سواء كانوا من الأمم أو المؤمنين العصاة. ولعل الرسول قصد بقوله: “لا يطيعون إنجيل ربنا” جماعة اليهود الذين رفضوا الإنجيل بالرغم من وجود النبوات بين أيديهم، فصاروا في زمرة العصاة غير الطائعين للإنجيل المكتوب في نبوات العهد القديم.
حديث الرسول عن النقمة الأبدية لا يعطي المؤمنين راحة داخلية بسبب سقوطهم تحت ظلم الأشرار، وإنما يهبهم حذرًا داخليًا لئلا يسقطوا هم تحت النقمة. فإن كانوا يسقطون حاليًا تحت الظلم، فهذا الضعف يثمر قوة، لكن إن انحرفوا هم إلى الظلم يحسبون كمن هم بلا معرفة لله وعصاة لإنجيل ربنا يسوع، فيسقطون تحت العقوبة الأبدية. يذكرنا هذا بما كان يفعله أحد الآباء النساك إذ كان يبكي كلما رأى إنسانًا يصنع ظلمًا لأخيه، فلما سأله تلميذه عن سبب بكائه قال له أنه إذ يرى الآخرين يصنعون ظلمًا يذكر ضعف طبيعته، فيخشى لئلا يسقط هو في ذات الفعل، فيظلم غيره ويخسر خلاصه الأبدي. حقًا إن عقوبة الأشرار تثير فينا بالأكثر عطفنا عليهم لانتشالهم من الهلاك الأبدي، وحذرنا لئلا نسقط نحن فنهلك أبديًا.
يصف الرسول الهلاك الذي يسقط تحته الأشرار، قائلاً: “الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته” [9]. فمن جهة هو هلاك أبدي لا رجعة فيه ولا توقف له، يتحقق بظهور الرب نفسه وإعلان مجده الأبدي. كأن إعلان وجه الرب وظهور مجد قوته فيه هلاك طبيعي للأشرار، كالنور الذي يدين الظلمة ويفضحها مبددًا إيّاها. مجيئه الذي هو سرّ فرحنا ومجدنا وملكوتنا هو بعينه سرّ هلاك الأشرار أبديًا.
في العالم الحاضر يطلب الأشرار مجد أنفسهم فيظهرون ليختفي وجه الرب عنهم، ويمارسون القوة والعنف إن لم يكن واضحًا في السلوك، ففي القلب وبالإرادة في الداخل، أما في العالم الآتي فيظهر وجه الرب الذي قاوموه فلا يقدروا على اللقاء معه أو معاينته، إذ يقول الكتاب يظهر مجد قوة الرب معلنة في ملائكته وقديسيه وينفضح بطلان الأشرار وضعفهم الكامل. لذلك يُحسب إعلان مجيئه عقابًا للهالكين ومجدًا للقديسين. بهذا المفهوم يكمل الرسول حديثه، قائلاً: “متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب عنه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم” [10].
من الذي يتمجد اللَّه أم قديسوه؟ يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [هل يتمجد اللَّه؟ يجيب الرسول: نعم يتمجد في جميع القديسين. كيف؟ عندما يرى المتكبرون أن الذين سبقوا فجلدوهم واحتقروهم واستهزئوا بهم الآن هم قريبون منه جدًا. إنه مجد للَّه كما هو مجد لهم. إنه مجده ومجدهم معًا! مجد له إذ هو لم يتركهم، ومجد لهم أنهم تأهلوا لكرامة عظيمة كهذه[2].]
هذه هي إرادة اللَّه أن يتمجد هو في عروسه المتألمة، فتحمل سماته هنا وهناك، إذ يظهر صبره فيها خلال جهادها الروحي ومجده وجماله أيضًا فيها خلال تمتعها بالميراث الأبدي. ففي الصلاة الوداعية كانت كلماته مع الآب هكذا: “أنا ممجد فيهم” (يو 17: 10)، “وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد” (يو 17: 22). وجاء في إشعياء النبي:”تكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجًا ملكيًا بكف إلهك” (إش 62: 3) وفي حزقيال النبي: “خرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملاً ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب” (16: 14).
فإن كان اللَّه يسكب مجده عليها ويعلن بهاءه في داخلها، ويجعلها في يده إكليل جمال وتاجًا ملكيًا، وهي بعد تسلك على الأرض في هذه الحياة وسط الضيقة والألم، فكم بالأكثر حينما تخرج من عالم الألم لتحيا معه في أمجاده تشاركه ميراثه الأبدي، وتكون في حضرته تلتقي به وجهًا لوجه. حقًا سيكون ذلك اليوم المجيد شهادة مجد لله العامل في كنيسته وللعمل الرسولي بكونه الوساطة التي خلالها تمتعنا بالكرازة بالإنجيل، فدخلنا إلى الميراث الأبدي.
4. صلاته لأجلهم
“الأمر الذي لأجله نصلي أيضًا كل حين من جهتكم
أن يؤهلكم إلهنا للدعوة،
يكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة.
لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم، وأنتم فيه،
بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح” [11-12]
في هذا الحديث الختامي للقسم الأول من الرسالة الخاص بمساندتهم والافتخار بهم لاحتمالهم الآلام والضيقة بشكر، أبرز الرسول الجوانب التالية:
- عمله الدائم من أجلهم حتى في غيابه عنهم حسب الجسد، خلال الصلاة، “كل حين من جهتكم”. فالراعي الحقيقي لا يكف عن الصلاة من أجل رعيته، وكما يقول صموئيل النبي: “وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب، فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم” (1 صم 12: 23)، حاسبًا النبي توقفه عن الصلاة من أجل شعبه ولو إلى حين خطية يرتكبها ضد الله، وإهمالاً جسيمًا يوقف تعليمه للشعب لمعرفة الطريق الصالح المستقيم فالصلاة والتعليم أمران متلازمان في حياة الخادم بدونهما يخطئ في حق الله نفسه، خلال إهماله في تدبير الشعب وتعليمه. يتحدث القديس يوحنا الذهبي الفم عن أهمية الصلاة في حياة الكاهن، قائلاً: [إذ أؤتمن الكاهن على العالم كله وصار أبًا لجميع الناس، يتقدم إلى اللَّه متوسلاً في الصلوات الخاصة والعامة من أجل رفع الحروب في كل مكان، وإخماد الاضطرابات، ملتمسًا السلام والهدوء لكل نفس، والشفاء للمرضى[3].]
- موضوع صلاته الدائمة عن الشعب هو أن يحسبهم الله مستحقين للدعوة الإلهية. فإن كان الله قد دعاهم للمجد الأبدي بكونهم أولاد اللَّه المختارين، فإنهم محتاجون أن يبقوا، خلال صلاة خادمهم الروحي، ثابتين في هذه الدعوة، فتكمل مسرّة الله الصالحة من نحوهم، ويعلن الإيمان فيهم قويًا خلال العمل. وكأن الله له كل الفضل إذ هو الذي دعاهم للمجد الأبدي، وما على الرسول إلا الصلاة عنهم، سائلاً مقدم الدعوة أن يعمل فيهم بنعمته، ليتأهلوا للدعوة المجانية، ولكن دون تجاهل الجانب الإيجابي العملي لإيمان الشعب نفسه.
في كلمات قليلة وبسيطة وبطريقة غير مباشرة أبرز الرسول دور الله نفسه ودور الخادم كما دور الشعب في التمتع بالمجد الأبدي. الله هو صاحب الدعوة المجانية، له كل الفضل. والرسول ما هو إلا مقدم صلوات بلا انقطاع يستعطف الله ويستدر رحمته. إنه الآب المترفق الذي يعرف مصدر العطايا الصالحة لشعب الله فيطلبها من مصدرها. أما دور الشعب فهو إعلان الإيمان خلال العمل بقوة الروح.
بينما يكتب الرسول معلنًا محبته العملية لهم بالتفرغ للصلاة الدائمة من أجلهم دون أن يهمل بقية الكنائس، مبرزًا فضل نعمة الله الغنية إذا به يحثهم على العمل بقوة، لإعلان إيمانهم الحيّ، وتحقيق دعوة الله لهم. وكأن إرادة اللَّه بدعوتهم للمجد لا تتحقق ولا بصلوات الرسول المستمرة بدون إيمانهم الحيّ العامل بقوة الروح. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [النعمة دائمًا مستعدة! إنها تطلب الذين يقبلونها بكل ترحيب. هكذا إذ يرى سيدنا نفسًا ساهرة وملتهبة حبًا، يسكب عليها غناه بفيض وغزارة تفوق كل طلبته[4].] كما يقول: [يطلب اللَّه منا حجة صغيرة لكي يقوم هو بكل العمل[5].]
- إن كان غاية صلوات الرسول هي تحقيق إرادة الله فيهم بنوالهم المجد الأبدي، فإن هذا المجد في الواقع هو مجد مشترك، مجد للعريس كما للعروس، إذ يقول: “لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم، وأنتم فيه، بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح” [12]. المجد الذي ينعمون به خاصة في يوم مجيء الرب الأخير هو مجد اسمه القدوس. حينما يقدم السيد مجده لكنيسته إنما يرتد هذا المجد لاسمه القدوس، وكل مجد لاسمه القدوس إنما يعلن فيهم لحسابهم.
غاية حياتنا أن يتمجد اسمه القدوس، لذا نصلي يوميًا قائلين: “ليتقدس اسمك”، وكما يقول الرسول: “لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد اللَّه الآب” (في 2: 10-11). هذا التقديس يتم لحسابنا، إذ نتمجد نحن فيه “لأن المقدس و المقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة” (عب 2: 11)، ومعه تملك في المجد كقول الرسول: “إن كنا نصبر فسنملك أيضًا معه” (2 تي 2: 12)، “فإن كنا أولادًا فإننا ورثة أيضًا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضًا معه” (رو 8: 17).
يتحدث القديس يوحنا الذهبي الفم عن المجد المشترك بين السيد وكنيسته قائلاً: [إذ يتمجد السيد يتمجد أيضًا عبيده. الذين يمجدون سيدهم يتمجدون هم أنفسهم بالأكثر بذات المجد الذي له، وأيضًا بمجد خاص بهم… إن النعمة التي يهبها لنا إنما أن يتمجد فينا ونحن نتمجد فيه[6].]
[1] للمؤلف: القديس يوحنا ذهبي الفم، 1980، ص 327.
[2] In 2 Thess, Hom 2
[3] De Sacr 6:14
[4] In Gen. PG 53:76-77.
[5] In Rom. PG 60:499.
[6] In 2 Thess., hom. 3..