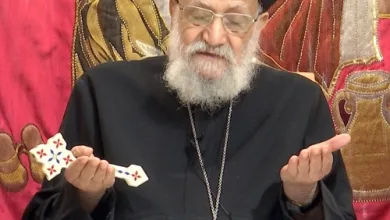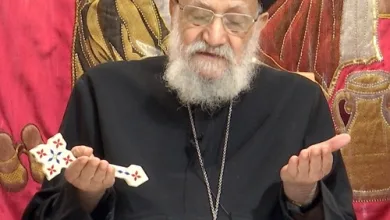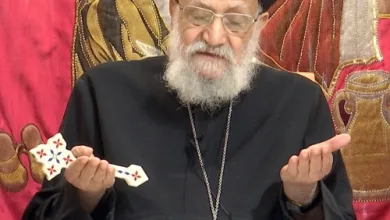تفسير رسالة بطرس الأولى 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة بطرس الأولى 3 الأصحاح الثالث - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة بطرس الأولى 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة بطرس الأولى 3 الأصحاح الثالث – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثالث
علاقتنا العائلية في المسيح يسوع
- وصايا زوجية
أولاً: خضوع المرأة للرجل ١.
ثانيًا: الاهتمام بالسيرة ٢ – ٦.
ثالثًا: علاقة الرجل بامرأته ٧ – ٨.
- علاقة المسيحي بالمضايقين له ٩ – ٢٢.
١. وصايا زوجية
أولاً: خضوع المرأة للرجل
“كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن
حتى إن كان البعض لا يطيعون الكلمة
يُربحون بسيرة النساء بدون كلمة.
ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف” [1-2].
كانت الشريعة الرومانيّة تبيح للرجل أن يتسلط على زوجته وأولاده، كما على عبده وحيواناته. فلم يكن للنساء أي حق مما دفع بعضهن إلى الهروب. ولما جاءت المسيحية تنادي بالحب، ظن البعض أنها في مناداتها بالحب والحرية تحث النساء على العصيان، لهذا وجهت الكنيسة وصايا واضحة للنساء خاصة بخضوعهن لرجالهن.
يطلب الرسول من المؤمنات أن يخضعن لرجالهن حتى وإن كان البعض غير مطيعين للكلمة، فإنهم يسمعون كلمة الكرازة العملية خلال سيرة النساء الطاهرة المملوءة خوفًا وتقوي لله. فإن كان لا يليق بها أن تُعَلِّم رجلها لأنه رأسها، لكنها تقدر أن تكسبه للرب، وتجتذب قلبه إليه بخضوعها وسلوكها الحسن.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [المرأة بطاعتها للرجل يصير وديعًا نحوها… بالمحبة تزول كل مقاومة، فإن كان الرجل وثنيًا يقبل الإيمان سريعًا، وإن كان مسيحيًا يصير أفضل[1].]
والخضوع هنا ليس عن خوف منه بل “في الرب” (كو ٣: ١٨)، إذ تستمده من خضوع الكنيسة لعريسها الرب يسوع (أف ٥: ٢٤). يقول القديس إكليمنضس السكندري:
[لقد قيل في الكتاب المقدس أن الله أعطى المرأة معينة للرجل. في رأيي أنه من الواضح أنها تقدر أن تقوم بعلاج جميع متاعب زوجها في تدبير خدمتها، وذلك خلال سلوكها الحسن وقدرتها.
فإن لم يخضع (متأثرًا بسلوكها) فإنها تسعى ما في استطاعتها أن تسلك في حياة طاهرة… آخذة في اعتبارها أن الله هو معينها والمساعد لها في سلوكها هذا، وأنه هو المدافع الحقيقي عنها، ومخلصها في هذه الحياة والحياة الأخرى.
لتأخذ الله قائدًا لها ومرشدًا لها في كل أعمالها، حاسبة الوقار والبرّ عملها، ناظرة إلى إحسانات الله غايتها.
بالنعمة يقول الرسول في رسالته إلى تيطس “كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة غير ثالبات غير مُسْتَعْبَدات للخمر الكثير معلمات الصلاح. لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويُحْبِبْنَ أولادهن. متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي لا يُجدَّف على كلمة الله” (٢: ٣–5)[2].]
ثانيًا: الاهتمام بالسيرة الحسنة
“لا تكن زينتكن الزينة الخارجية
من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب،
بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد،
زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن” [3-4].
يُقرأ هذا النص في قداسات تذكار انتقال المتبتلين… وكأن الكنيسة تريد أن توجه كل نفس لتتزين لعريسها ربنا يسوع بالزينة الداخلية.
وكما تتزين النفس المؤمنة لعريسها، تتزين المرأة الزانية بزينة خارجية لعريسها: “متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها، مملوء رجاسات ونجاسات زناها” (رؤ ١٧: ٤).
لتتزين أيضًا النساء لرجالهن، ولكن ليَعْلَمْن أن الرجال قد يُعْجَبْن بالزينة الخارجية لكن إلى حين، أما ما يجذب قلوبهم بحق فهو زينتهن الداخلية، بل وتجذب قلب المسيح أيضًا قائلاً: “ها أنت جميلة يا حبيبتي هذا أنت جميلة. عينيك حمامتان…” (نش ١: 15).
لهذا يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:
[أتريدين أن تكوني جميلة؟ تسربلي بالصدقة. البسي العطف، توشحي بالعفة. كوني خالية من التشامخ. هذه كلها أوفر كرامة من الذهب. هذه تُصَيِّر الجميلة جزيلة البهاء وغير الجميلة جميلة.
عندما تُغالين في التزين أيتها المرأة تكونين أشنع من العارية لأنكِ خلعتِ حسن الجمال…
قولي لي لو أعطاك أحد ثوبًا ملكيًا فأخذتيه ولبستِ فوقه ثوب العبيد، أما يكون لك خزي يليه عذاب؟ قد لبستِ سيد الملائكة، أترجعين إلى الأرض؟
قولي لي لماذا تتزينين، هل لكي ترضي زوجك؟ افعلي هذا في منزلك[3]!]
ويرى القديس إكليمنضس السكندري أن الزينة الحقيقية للمرأة ليست التي من عمل الآخرين، أي الزينة الخارجية، بل التي تَتعب هي بنفسها فيها أي زينة الروح المجاهدة إذ يقول:
[لأن عمل أيديهن يَهَب لهن جمالاً خالصًا أكثر من كل شيء، فيدرِّبْن أجسادهن ويزيِّن نفوسهن بمجهوداتهن وليس من عمل الغير.
المرأة الصالحة تنسج بيديها ما تريد. فإنه غير لائق بمن قد تشكَّلت بصورة الله أن تتزين بالأمور التي تباع في السوق، بل بعملها الداخلي[4].]
“فإنه هكذا كانت قديمًا النساء القديسات أيضًا،
المتوكلات على الله يزين أنفسهن، خاضعات لرجالهن.
كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها
التي صرتن أولادها صانعات خيرًا، وغير خائفات خوفًا البتة” [5-6].
يضرب الرسول مثلاً بسارة زوجة أب المؤمنين، إذ كانت متزينة:
- بالاتكال على الله، فلا تبالي بكلام الناس بل برضاء الله.
- بالخضوع لرجلها، حيث كانت تدعو زوجها بمحبة “يا سيدي“.
- صانعة خير، أي مثابرة على ما هو لخلاص نفسها والاهتمام بمنزلها.
- غير خائفة خوفًا البتة، لأن خضوعها لا عن خوف العبيد بل في حب زيجي.
ثالثا: علاقة الرجل بامرأته
“كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف،
معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضًا معكم نعمة الحياة،
لكي لا تعاق صلواتكم” [7].
يُحمَّل الرسول الرجال مسئولية عدم خضوع نسائهم، لأن التعامل معهن يحتاج إلى فطنة أي حكمة.
يقول القديس إكليمنضس الروماني: [لنوجه نساءنا إلى ما هو صالح حتى يظهرن شخصية طاهرة نُعْجَب بها، فيُظْهِرْن مشاعر التواضع الحقيقي[5].]
وقد عدَّد الرسول الأسباب التي تدفع الرجل إلى تكريم زوجته فقال:
- أنهن آنية ضعيفة، يحتَجْن إلى ترفّق حتى لا يهلكن.
2 أنهن أعضاء لنا، والرأس لا يكون مقدسًا ما لم تكن الأعضاء مكرمة.
- أنهن شريكات معنا في الميراث الأبدي، بلا تمييز بين رجل وامرأة.
- لكي نحفظ سلام القلب والبيت، فتخرج صلواتنا مملوءة حبًا، بروح واحد لا يعوقها غضب (١ تي ٢: ٨).
وأخيرًا بعدما تحدث الرسول عن العلاقات العائلية في المسيح يسوع قال:
“والنهاية كونوا جميعًا متحدي الرأي بحس واحد،
ذوي محبة أخوية مشفقين لطفاء” [8].
“والنهاية” أي غاية هذه الوصايا جميعها أن يكون ليس فقط بين الزوجين، بل نود أن يكون الكل برأي واحد (في ١: ٢٧) ومشاعر واحدة مملوءين حبًا أخويًا وحنوًا ولطفًا (في ٢: ٢).
هذه الوحدة طلبها الرب يسوع في صلاته الوداعية (يو ١٧: ٢١)، وأوصانا بها الرسول بولس قائلاً: “فرحًا مع الفرحين وبكاءً مع الباكين” (رو ١٢: ١٥).
أما قوله “لطفاء” ففي الأصل اليوناني تعني أنها ناشئة عن التواضع أمام الله، وكان الرومان يحسبون اللطف عدم شهامة.
٢. علاقة المسيحي بالمضايقين له
يصعب على الإنسان أن يحب مضايقيه لكن في المسيح يسهل ذلك لأنه:
- وارث للبركة، لا يخرج إلاَّ ما هو للبركة:
“غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة،
بل بالعكس مُبارِكين،
عالمين إنكم لهذا دُعيتم لكي ترثوا بركة” [9].
هذه هي دعوتنا أن نرث البركة، لهذا لا يليق بنا أن نُخْرِج من داخلنا إلاَّ ما هو للبركة، فلا نقاوم الشر بالشر بل نغلبه بالخير (رو ١٢: ٢١). فلم يعد غريبًا عنا أن ننفذ وصية الرب “باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم” (مت ٥: ٤٤).
- لكي يتدرب هنا على تذوق السلام
“لأنه من أراد أن يحب الحياة ويرى أيامًا صالحة،
فليَكْفُفْ لسانه عن الشر،
وشفتيه عن أن يتكلما بالمكر.
ليُعْرِض عن الشر،
وليصنع الخير،
ليطلب السلام، ويجِدّ في أثره” [10-11].
هذا دافع آخر وهو أننا راحلون إلى أبديّة السلام. فنتدرب هنا على الأرض، كمن هم في مدرسة، على حياة السلام التي نحياها مع ملك السلام. فإذ نحب الحياة (الأبديّة) وأن نرى أيامًا صالحة ليس فيها شر، عربون للحياة الأخرى يليق بنا الآتي:
أ. نكْفُف لساننا عن الشر، أي نُعرِض عنه، كالعبد الذي يخاف سيده.
ب. نصنع الخير، كالأجير الذي ينتظر مكافأة.
ج. وأخيرًا نطلب السلام ونجدّ في أثره، ليس خوفًا ولا من أجل الأجرة، لكن كأبناء لملك السلام لا نحيا ولا نريد إلاَّ أن نتذوق السلام!
يقول القديس دوروثيؤس:
[لقد عبَّر النبي داود عن هذا التسلسل في قوله التالي: “حد عن الشر واصنع الخير. اطلب السلامة واسعَ وراءها” (مز ٣٤: ١٤). “حد عن الشر“، أي تجنب الشر كله بصفة عامة. اهرب من كل عمل يدفعك نحو الخطية. لكن النبي لم يقف عند هذا الحد، بل أضاف قائلاً: “واصنع الخير“، لأنه أحيانًا لا يصنع إنسان شرًا ولكنه لا يصنع أيضًا خيرًا… وإذ قال داود هذا أكمل: “اطلب السلامة واسعَ وراءها”. إنه لم يقل فقط “اطلب” بل “اسعَ وراءها” أي مجاهدًا لنوالها.
فكر في هذه الكلمات بتدقيق، ولاحظ الدقة التي أظهرها القديس. فعندما يوهَب للإنسان أن يَحِدْ عن الشر، وبعون الله يجاهد لكي يصنع الخير، يمكنه أن يكون فريسة وموضوع هجوم العدو. لذلك عليه أن يتعب ويجاهد ويحزن، مرة كعبد بدافع الخوف حتى لا يرتد إلى الشر مرة أخرى، ومرة كأجير طالبًا المكافأة عن صنع الخير… ولكن عندما يتقبل معونة الله ويحصل على عادة معينة في صنع الخير، عندئذ يجد راحة (في صنع الخير) ويتذوق السلامة. عندئذ يختبر ماذا تعني تلك المعركة المحزنة، وما هو معنى فرح السلامة وسعادتها، عندئذ “يطلب السلامة” ويجاهد مثابرًا في داخله[6].]
يقول القديس أغسطينوس: [إنه سيكون لنا السلامة الكاملة عندما تلتصق طبيعتنا دون أن تنفصل عن خالقها، فلا يكون لنا في أنفسنا ما يضاد أنفسنا[7].]
إذن بترك الشر وصنع الخير تصير لنا السلامة، وهذا هو تدريبنا على الأرض.
- لكي يرضي الرب
“لأن عيني الرب على الأبرار، وأذنيه إلى طلبتهم،
ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر” [12].
وهنا لا يقصد الرسول أن الله لا ينظر إلى الأشرار أو يختفي حديثهم عن أذنيه، لكنه يقصد بالنظر والسمع الاستجابة لهم. غاية المؤمن أن يكون موضوع رضا الرب وسروره. فليس بالكثير عليه أن يقابل الشر بالخير، ويحب مضايقيه مادام هذا يرضي الرب.
- لأنه لا يقدر أحد أن يؤذيه
يدرك المؤمن هذه الحقيقة، أنه لا يقدر أحد من البشر ولا تستطيع الأحوال مهما قست والضيقات مهما اشتدت أن تؤذي نفسه، ما لم يؤذِ الإنسان نفسه بنفسه، بتركه صنع الخير. لهذا لا يضطرب من أحدٍ، بل يحب حتى الذي يريد قتله، متأكدًا أنه لا يقدر أن يحرمه من صنع الخير، وبالتالي كلما اشتدت الآلام حوله تزايدت أكاليله.
“فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير.
ولكن إن تألمتم من أجل البرّ فطوباكم“ [13].
كتب القديس يوحنا الذهبي الفم كتابًا عنوانه “لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانًا ما لم يؤذِ هذا الإنسان نفسه[8]” كشف فيه أنه لا يقدر شيطان أو ظلم أو مرض أو موت أو فقر أن يؤذي أحدًا ما لم يؤذ الإنسان نفسه بصنع الشر، بل بالعكس نجد الآلام طَوَّبَت أيوب، والفقر أفاد لعازر، والرياح والأمطار أكدت ثبوت البيت المبني على الصخر (مت ٧: ٢٤).
إن الحاسد لا يؤذي من يحسده بل يؤذي نفسه، والظالم يقتل نفسه ولا يهلك من يظلمه. وهكذا فإن الألم لا يجلب ضررًا، بل تطويبًا لمن يحتمله من أجل البر.
- تعطي فرصة للكرازة
“وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا.
بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم،
مستعدين دائمًا لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم
بوداعة وخوف” [14-15].
اقتبس الرسول هذا القول عن إشعياء النبي (8: 12-13). يطالب الرسول المؤمن ألا يخاف ممن يضايقونه ولا يضطرب منهم. والدافع لهذا هو تقديس الرب الإله في القلب. لأن من يقدس الرب الإله في قلبه لا يخاف البشر بل الله. ومن يخاف الله دون البشر يكون بهذا مُقَدِّسًا الرب في قلبه… وهذا خير كرازة وشهادة عملية للرب، وإجابة حقة لمن يسأله عن سبب الرجاء الذي فيه، محتملاً المضايقة بوداعة ومخافة الرب.
هكذا يَشْتَّمونَ رائحة المسيح الذكية في سيرة المؤمن الصالحة عندما يُفترى عليه ظلمًا، فيحتمل بضميرٍ صالح بغير رغبة في الانتقام، ولكن حبًا في خلاص الكل.
“ولكم ضمير صالح
لكي يكون الذين يَشْتُمُون سيرتكم الصالحة في المسيح يُخْزَوْن
في ما يفترون عليكم كفاعلي شر” [16].
لقد شهد فستوس وأغريباس عن بولس قائلين: “إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئًا يستحق الموت أو القيود” (أع ٢٦: ٣١).
وبقدر ما ازدادت الإضطهادات على المسيحيين كانوا يجتذبون المضطهِدين أنفسهم خلال احتمالهم الاضطهاد بفرح وشكر.
يقول الشهيد بوستينوس: [ها أنت تستطيع أن ترى بوضوح أنه حينما تُقْطَع رؤوسنا ونُصْلَب ونُلْقَى إلى الوحوش ونُقَيَّد بسلاسل ونُلقى في النار وكل أنواع التعذيب أننا لا نترك إيماننا، بل بقدر ما نُعاقَب بهذه الضيقات ينضم مسيحيون أكثر إلى إيماننا وديانتنا باسم يسوع المسيح[9].]
- إقتداء بالرب يسوع
“لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرًا
أفضل منه وأنتم صانعون شرًا.
فإن المسيح أيضًا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا،
البار من أجل الآثمة لكي يُقَرِّبنا إلى الله،
مماتًا في الجسد، ولكن محيي في الروح” [17-18].
يتدرب المسيحي على حياة الاحتمال والحب للمضايقين على يدي مُدرِّبه الرب يسوع المتألم. فمنه وبه ينال قوة داخلية لقبول الألم بشكر. بحسب المنطق البشري حينما يتألم الإنسان من أجل ذنب اقترفه يجد ما يعزيه أنه مستوجب لهذا الألم. أما فكر ربنا يسوع فهو منطق الحب الإلهي أنه يليق بنا بالحري أن نفرح عندما نتألم ظلمًا. إذ يكون مبعثها الحب وهذه “تُنْشِيءْ أكثر فأكثر ثقل مجد أبديًا” (٢ و ٤: ١٧).
تألم الرب بالجسد مرة واحدة. احتمل أجرة خطايانا في جسده. هذه هي آلام الحب التي دفعته أن يقبل برضا موت الجسد وهو محيي في الروح، لأنه لم يخطئ قط، فلم تذق روحه الموت.
مات الرب بالجسد بانفصال نفسه عن جسده، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته ولا فارق نفسه قط.
“الذي فيه أيضًا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن،
إذ عصت قديمًا حين كانت أناة لله تنتظر مرة في أيام نوح،
إذ كان الفلك يُبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي ثماني أنفس بالماء” [19-20].
إذ مات الرب بالجسد انفصلت نفسه عن جسده، أما لاهوته فلم ينفصل قط لا عن جسده ولا عن نفسه. فانطلقت النفس إلى الجحيم (السجن) تكرِز وتبشر للذين ماتوا على رجاء، لأن عدو الخير ليس له سلطان عليها.
وكما يقول القديس أمبروسيوس[10] بأنه من الواضح أن السيد المسيح لم يسقط تحت قوات الظلمة بل بالحري هو كسر سلطانها، كارزًا حتى بين الأموات الذين في الجحيم لكي يحررهم.
أما من هم الذين ذهب ليَكْرِز إليهم من الأموات فهناك تفاسير كثيرة منها:
أ. رأى القديسين أثناسيوس وكيرلس وايرونيموس
إن السيد المسيح بعد موته بالجسد نزل بروحه أي بنفسه إلى الجحيم، وبشًّر الذين كانوا في أيام نوح لا يصدقونه إذ كان ينذرهم بالطوفان. لكنهم لما رأوا انهمار المياه تاب بعضهم وطلبوا الرحمة.
ب. رأى القديس أغسطينوس
إن السيد المسيح بروحه القدوس سبق أن بشر الذين كانوا في أيام نوح على لسان نوح، وأنذرهم بحدوث الطوفان لعلهم يتوبون لكنهم لم يصدقوا. وبهذا فإن قوله “في السجن” يعني بها “الأرواح التي في الجسد”، ومع هذا لم يخلص بهذه الكرازة إلاَّ ثماني أنفس أي نوح وزوجته وأبناءه ونساءهم.
وقد استخدم العلامة ترتليان[11] هذا العدد “ثماني أنفس” ليظهر أن العالم كما بدأ به آدم وحواء دون أن يأخذ له زوجة أخرى، هكذا بدأ العالم الجديد بعد الطوفان وخرج نوح وأولاده كل منهم له زوجة واحدة.
ج. رأي الأب هيبوليتس
[لقد رتب الأمور التي على الأرض، إذ صار إنسانًا بين الناس ليُعِيد خِلقة آدمنا خلال نفسه Himself وأيضًا الأمور التي تحت الأرض إذ أُحْصِى مع الموتى مُبَشِّرًا بالإنجيل لنفوس القديسين (الذين ماتوا على رجاء) وبالموت داس الموت[12].
د. رأي القديس ايريناؤس
بعدما تحدث عن جميع القدماء أنهم أخطأوا قال: [لهذا السبب نزل الرب أيضًا إلى أعماق الأرض مُبَشِّرًا بصعوده مُعْلِنًا غفران الخطايا لمن آمنوا به. والآن كل الذين آمنوا به وترجوه وأعلنوا عن مجيئه وخضعوا لبركاته، أي الأبرار والأنبياء والآباء غفر لهم خطاياهم بنفس الكيفية التي صنعها معنا تمامًا[13].]
ه. رأي القديس إكليمنضس السكندري[14]
له رأي غريب اعتمد فيه على قول أيوب (٢٨: ٢٤) أن الله يبشر (ينظر) إلى أقاصي الأرض، فإنه نزل وبشر ليس فقط للذين ترجّوا خلاصه، بل والأمم الذين في جهل سلكوا كأبرارٍ حسب ناموسهم.
“الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية،
لا إزالة أوساخ الجسد،
بل سؤال ضمير صالح عند الله لقيامة يسوع المسيح” [21].
إذ تحدث الرسول عن فلك نوح رمز المعمودية بدأ يحدثنا عن فاعليتها:
“الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية” ويقول القديس أغسطينوس: [يعطي مسيحيو قرطاجنة اسمًا ممتازًا للأسرار عندما يقولون عن المعمودية أنها ليست سوي “الخلاص“، وسرّ جسد المسيح ليس إلاَّ “الحياة“. وكما أظن من أين أخذوا هذا إلاَّ من التسليم الرسولي الأول حيث كانت كنائس المسيح تعتمد عليه كأساس، لأنه بدون العماد والاشتراك في عشاء الرب يستحيل على الإنسان أن ينال ملكوت الله أو الخلاص والحياة الدائمة. هكذا يشهد له الكتاب المقدس بالأكثر… لأنه هل فِكْرُهم هذا بخصوص المعمودية وتعبيرهم عنها بالخلاص يختلف عما هو مكتوب “خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس” (تي ٣: ٥)، أو عبارة الرسول بطرس[15].]
وقد رأى هرماس في إحدى رؤياه الكنيسة المنتصرة كبرج مبني على الماء فلما سأل عن السبب قيل له [اسمع الآن لماذا يُبْنَى البرج على المياه، ذلك لأن حياتكم تخلص وستخلص خلال الماء[16].]
فالمعمودية لا تزيل وسخ الجسد، بل تهب ضميرًا صالحًا بقوة قيامة الرب، إذ فيها نُدفن مع المسيح ونقوم أيضًا. ولهذا السبب اعتادت الكنيسة أن تقوم بتعميد الموعوظين قُبَيْل عيد القيامة كما نرى ذلك واضحًا من التاريخ الكنسي ومن كتابات الكنيسة الأولى، ولازلنا إلى يومنا هذا نعيد بأحد التناصير في الأحد السابق لعيد القيامة مباشرة.
لهذا يليق بنا ألا نقف عند حد أخذ الإمكانيّة لحياة القداسة في سر المعمودية وننكره بسلوكنا، بل نسلك بضمير صالح بقيامة الرب يسوع[17].
وقد تحدث القديس باسيليوس الكبير عن فاعلية المعمودية في رده على سؤال مقترح: لماذا يكون العماد “بالماء”؟ فقال:
[يوجد (في المعمودية) تطهير للنفس من الوسخ الذي نما فيها من الفكر الجسداني، وكما هو مكتوب “اغسلني فأبيض أكثر من الثلج” (مز ٥١: ٩). على هذا الأساس فإننا لا نغسل أنفسنا بعد كل دنس كما يفعل اليهود بل لنا معمودية واحدة (أف ٤: ٥). إذ في العماد يُحمَل الموت عن العالم مرة، وتكون القيامة من الأموات مرة.
لهذا السبب أعطانا الرب واهب حياتنا “عهد العماد”، حاملاً فيه طابع الحياة والموت:
فالماء يحقق صورة الموت، والروح القدس (في نفس الوقت) يهب جِدة الحياة[18].]
بهذا صارت الإجابة على السؤال: لماذا ارتبط الماء بالروح (يو ٣: ٥) واضحة. إذ السبب هو أننا في العماد نبغي هدفين:
- أحدهما: إهلاك جسد الخطية (رو ٦: ٦)، حتى لا يحمل بعد ثمارًا للموت (رو ٧: ٥).
- والثاني: حياتنا في الروح (غل ٥: ٢٥)، ويكون لنا ثمره في القداسة. الماء باستقباله الجسد كقبر يحمل موتًا، بينما يفيض الروح قوة الإحياء مجددًا أرواحنا من موت الخطية إلى حياتها الأولى.
هذا إذن ما يعنيه أننا نولد من الماء والروح.
فبالمعمودية اعتمدنا لموت المسيح وقيامته، فكيف لا نقبل الآلام حتى الموت بفرحٍ وسرورٍ، منتظرين كأبناء لله مرتبطين بالرب المتألم أن تكون لنا معه شركة في الأمجاد السماوية.
“الذي هو في يمين الله،
إذ قد مضي إلى السماء وملائكة وسلاطين قوات مخضعه له” [22].
بعد ما اجتاز الرب الصليب عاد إلى يمين الآب. ونلاحظ أن كلمة “يمين” لا تعني اتجاهًا معينًا، لأن الآب ليس له شمال أو يمين لكنها تعبير بلغة بشرية لكي ندرك عظمة الابن.
مضى الرب إلى عرشه في السماوات، الذي لم يترك لاهوته قط حتى في أثناء وجوده بالجسد على الأرض…
عاد تمجده وتسجد له الملائكة والسلاطين وكل الطغمات السمائيّة. وفي عودته وهو حامل الجسد إنما يعلن نصرة البشرية في شخصه، وعودتهم إلى السماء، ليرثوا ما كانت الخطية قد حرمتهم منه. لهذا يقول: “من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضًا وجلست مع أبي في عرشه” (رؤ 3: ٢١).
[1] الحب الأخوي، 1964، صفات الأزواج المحبين ص ٣٥٨، ٣٦٠.
[2] Stromata or Miscllanies 4 : 29.
[3] مختصر عن “الحب الأخوي” ، 1964، ص ٢٦٢.
[4] Instructor 3 : 11.
[5] رسالة القديس إكليمنضس الروماني ص ٦.
[6] الفيلوكاليا، 1993، ص ١٦٢ – ١٦٨.
[7] “العفة” للقديس أغسطينوس، 1967، ص ٣٨.
[8] ترجم هذا الكتيب وطبع تحت عنوان “من يقدر أن يؤذيك؟”
[9] كتاب “جيش الله” لمجلة مرقس.
[10] The Christian Faith 3 : 4 : 23.
[11] On Monogomay 4.
[12] A. N. Frs V. 5 P. 209.
[13] Adv. Haer 4 : 27 : 2.
[14] The Stromato 6 : 6.
[15] On forgiveness of sins and Baptism 1 : 34.
[16] The Pastor: Book 1, Vision 3.
[17] راجع أقوال القديس أغسطينوس في “رده على فستوس من أتباع ماني ١٩.
[18] On The Holy Spirit 35.