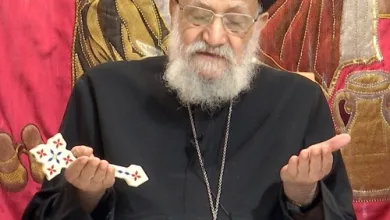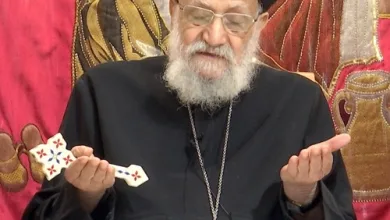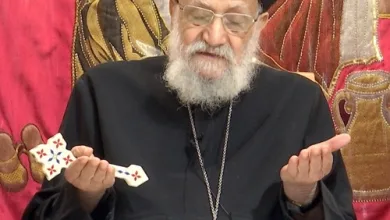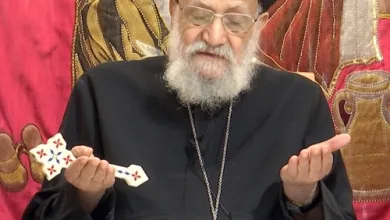تفسير رسالة بطرس الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة بطرس الأولى 2 الأصحاح الثاني - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة بطرس الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة بطرس الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثاني
مسئوليتنا كأولاد الله
- الجانب السلبي ١
- الجانب الإيجابي
أولاً: الارتباط بالأم ٢
ثانيًا: الارتباط بالرب الحجر الحي ٢ – ١٠
ثالثًا: الارتباط بالسلوك العملي ١١ – ١٢
- سلوكنا في المجتمع كأولاد الله
أولاً: الخضوع لنظم الدولة ١٣ – ١٧
ثانيًا: الأمانة في الخدمة ١٨ – ٢٥
١. الجانب السلبي
“فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة” [1].
إذ نلنا ميلادًا سماويًا يليق بنا أن نطرح عنا كل أعمال الإنسان العتيق وشهواته كخرقة دنسة لا يطيقها الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البرّ وقداسة الحق.
فنطرح كل خبث، أي عدم الإخلاص (١ كو ٥: ٨)، إذ هو من سمات عدو الخير والوثنيين المعاندين لروح الله (رو ١: ٢٩) الذين يتعمدون الشر والأذى.
ولنطرح كل مكر، فنكون كأبينا البسيط الذي ليس فيه خداع أو طرق ملتوية. بهذا نعود إلى بساطة الطفولة في عبادتنا وكرازتنا، فنكون أبناء الملكوت (مت ١٨: 3).
ولنستنكف من الرياء، فلا نحمل الثياب الفريسية المصطنعة بل نطلب المجد الخفي كعروس تتزين لعريسها دون سواه.
ولنترك الحسد الذي به يطلب الإنسان الفشل لأخيه. هذا الباعث هو الذي دفع الشيطان لمهاجمة آدم، والذي به أسلم اليهود الرب يسوع للصليب[1].
ولنطرح المذمة إذ يُهين الإنسان أخاه علنًا ويُحقِّر من شأنه. وهو الدرجة الثالثة من الغضب، إذ يقسم القديسون[2] الغضب إلى غضب داخلي – غضب مصحوب بكلمة تعبر عنه مثل “رقا” – غضوب مصحوب بكلمة ذم مثل “يا أحمق”.
٢. الجانب الإيجابي
أولاً: الارتباط بالأم
“وكأطفال مولودين الآن
اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش، لكي تنموا به” [2].
بداية الجانب الإيجابي هو أن يدرك المؤمن على الدوام أنه كطفلٍ رضيعٍ “مولود الآن”، لا يلهيه شيئًا سوى ثديي أمه الحنون، فيشتهي صدر أمه مرتميًا عليه. وميزة لبن الكنيسة الأم انه لبن عقلي محيي يهب نموًا باستمرار “لكي تنموا به”. ونلاحظ أن كلمة “عقلي” في اليونانية مشتقة من “اللوغوس” أي “الكلمة” أي اللبن الذي يهبه الرب يسوع كلمة الله في كنيسته.
وبماذا ترضعنا الكنيسة؟
- يقول القديس إكليمنضس السكندري: [إنه لبن الحب! طوبى لمن يرضع منه! إنه موجود في الشتاء كما في الصيف… لا يحتاج أن يسخن أو يبرد بل هو لبن جاهز[3].]
- إنه التعليم الروحي غير المغشوش تسلمناه جيلاً بعد جيلٍ، ليس فيه فلسفة ولا تنميق، بل روح وحياة اختبره القديسون عبر الأجيال.
- إنها الطقوس الحية التي تنعش النفس فتعين الجسد والروح في العبادة.
- إنها شفاعات القديسين وصلواتهم الذين يحبوننا.
ثانيًا: الارتباط بالرب الحجر الحي
“إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح،
الذي إذ تأتون إليه حجرًا حيًا مرفوضًا من الناس
ولكن مختار من الله كريم” [3-4].
حرف “إن” لا يفيد الشك بل القطع بمعنى “إذ ذقتم أن الرب صالح…” فإن من ذاق الرب أنه صالح يأتي إليه ليجده حجرًا حيًا.
ولعل بطرس تذكر ما دعاه به الرب أنه “بطرس، أو “صفا” أي صخرة، يوم أعلن إيمانه بالرب يسوع. هنا يُظهِر بطرس أن الرب يسوع هو الصخرة أو الحجر الحي الذي تبنى عليه الكنيسة.
ويقول الشهيد كبريانوس:
[لقد دُعِيَ المسيح “حجرًا”، ففي إشعياء قيل: “هأنذا أؤسس في صهيون حجرًا، حجر امتحان، حجر زاوية، كريمًا أساسًا مؤسسًا من آمن لا يهرب” (إش 28: ١٦). وأيضًا في المزمور الـ١١٧: “الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأسًا للزاوية”. وفي زكريا: “فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين. هأنذا ناقش نَقْشَه يقول رب الجنود وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد” (٣ : ٩). وفي سفر التثنية: “وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشًا جيدًا” (٧ : ٨). وأيضا في يشوع بن نون: “وأخذ حجرًا كبيرًا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. ثم قال يشوع لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهدًا علينا لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به فيكون شاهدًا عليكم لئلا تجحدوا إلهكم” (٢٤: ٢٦-٢٧)…
إنه الحجر المذكور في سفر التكوين الذي وضعه يعقوب تحت رأسه، إذ المسيح رأس الرجل، وإذ نام رأى سلمًا واصلاً إلى السماوات حيث يوجد الرب والملائكة صاعدون ونازلون…
إنه الحجر المذكور في سفر الخروج، الذي جلس عليه موسى على قمة التل عندما كان يشوع بن نون يحارب عماليق وبسر الحجر المقدس وثبات جلوسه عليه انهزم عماليق بيشوع كما انهزم الشيطان بالمسيح. إنه الحجر العظيم الوارد في سفر صموئيل الأول حيث وُضع تابوت العهد عندما أحضره الثور في المركبة إذ رده الغرباء. وأيضًا هو الحجر الوارد في سفر صموئيل الأول الذي به ضرب داود رأس جليات وذبحه إشارة إلى انهزام الشيطان وخدامه حيث لا تكون الجبهة في الرأس غير مختومة (باسم المسيح)، ذلك الختم الذي يهب أمانًا وحياة على الدوام. إنه الحجر الذي أقامه صموئيل عندما غلبوا الغرباء، ودعاه بحجر المعونة أي الحجر الذي يعين[4].]
فالرب يسوع هو الحجر الذي به نقهر الشيطان، وهو الحجر الحي الذي نأتي إليه. ومع أن الرسول يحدث المؤمنين فإنه لا يقول: “أتيتم” بل “تأتون”، لأنه يليق بنا أن نثابر مجاهدين على الدوام إلى الاقتراب منه إلى النفس الأخير.
وهو حجر حي أي مملوء حبًا وليس جامدًا، لنأتي إليه لا في عبادة جامدة بل في حب نناجيه ونسمع مناجاته، نعاتبه وننصت إلى عتابه، لنكشف له كل ما في قلبنا فهو لا يقف جامدًا أمام ضعفنا.
“كونوا أنتم أيضًا مبنيين كحجارة حية، بيتًا روحيًا.
كهنوتًا مقدسًا، لتقديم ذبائح روحية،
مقبولة عند الله بيسوع المسيح” [5].
إذ هو الحجر الحي نُبني عليه كحجارة حية. فكما هو حي نحن نحيا به (يو ١٤: ١٩).
لقد جعلنا بيتًا روحيًا، مسكنًا لله بالروح (أف ٢: ١٨–٢١) ونلاحظ في هذا البيت الآتي:
- إنه بيت واحد غير منقسم على ذاته، بل مرتبط برباط الحب فوق حدود الزمان والمكان، وكل مصاف الرسل والشهداء والسواح والعباد والمنتقلين، كحجارة حية، فالقديسة مريم تصلي من أجلنا نحن المجاهدين كحجارة حية أخرى، ونحن أيضًا نصلي ونحب الأجيال المقبلة.
رأى هرماس[5] في إحدى رؤياه الكنيسة المنتصرة كبناء، إذ نُقلت حجارة كثيرة من الأرض، وبُنِيَت بجوار بعضها البعض، واتحدت معًا حتى أن خطوط الصفوف لا يمكن إدراكها، وصارت برجًا كحجر واحد.
- رأى أيضًا هرماس أن حجارة كثيرة رفضت أن تكون في البناء. هذه الحجارة هي التي اعتمدت على ذاتها وظنت أنها قادرة أن تتأسس على المسيح خارج الكنيسة، فتركت روح الآباء، ورفضت تعاليمهم وأرادت أن تكون مستقلة بذاتها، فخرجت خارج البيت الروحي.
“كهنوت مقدس“، إذ صار لنا أن نقدم ذبائح روحيّة من داخل القلب، وذلك كقول العلامة ترتليان: [تخرج هذه الذبيحة من كل القلب، وتتغذى على الإيمان وتراعي الحق. تدخل في براءة ونقاوة، في عفة، تتزين بالحب. ويلزمنا أن نحرسها بعظمة الأعمال الصالحة مقدمين مزامير وتسابيح على مذبح الله لننال كل الأشياء منه[6].]
هذه الذبائح يقدمها جميع المؤمنين، لكن هناك كهنة مفروزين لأعمال الكهنوت كما جاء في رسالة يعقوب (ص ٥) والذين وضع الرسول بولس شروطهم[7].
وماهي الذبائح الروحية المقبولة عند الله بيسوع المسيح؟
- ذبح الإرادة البشرية أو الأنا… وهي أجمل ذبيحة… يرفع الإنسان يده بالصليب كسكين روحيّة يذبح إرادته الذاتية واشتياقاته الخاصة التي يتبناها، وذلك كما رفع إبراهيم السكين لذبح إسحق. وكما رجع اسحق حيًا. لكنه عاد ابن البركة والموعد، هكذا نذبح إرادتنا بالصليب فلا نصير بلا إرادة بل تعود لنا إرادة المسيح القوية واشتياقات وفكر المسيح. وبهذا نترنم مع الرسول قائلين “مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا” لقد صلبت “الأنا” ليصير لي “المسيح يحيا فيّ”.
- ذبيحة التواضع أمام الله والناس، وكما يقول المرتل “لأنك لا تُسَر بذبيحة وإلاَّ فكنت أقدمها، بمحرقة لا ترضي. ذبائح الله هي روح منسحقة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره” (مز ٥١: ١٦- ١٧).
- ذبيحة الأعمال الصالحة، وكما يقول الرسول: “ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله” (عب ١٣: ٦)، ويقول المرتل: “اذبحوا ذبائح البرّ” (مز ٤: ٥). فصنع الخير أو عمل البرّ فيه تَرْك وحرمان وبذل، فيه حَمْل صليب، لهذا فإن الله يشتّّمه خلال صليب الرب ذبيحة برّ مقبولة لديه.
- ذبائح الآلام والأتعاب من أجل الرب، وكما يقول الرسول “من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق… كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. قد حُسِبْنا مثل غنم للذبح” (رو ٨: ٢٥-٢٦).
- ذبيحة الجسد، فالمؤمن لا ينظر إلى الجسد ذاته كعدو، إنما بالعكس يلزمه كقول الرسول أن يحبه ويقوته ويربيه (أف ٥: ٢٥–٢٩). وعندما يتحدث الكتاب المقدس أو أحد الآباء عن معاداتنا للجسد إنما يقصد به شهوات الجسد وأعماله الأرضية.
وقد كتب القديس أغسطينوس كتابًا خاصًا عن ضبط النفس يقصد به الكشف عن أهمية الجسد ويرد فيه على الهراطقة الذين يعادون الجسد[8].
إذن ليُرْبَط الجسد بأربطة الحب، وليُقدم على المذبح، ولتمسك بصليب الرب، مُقَدِّمًا أعضاء جسدك ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله (رو ١٢: ١)، فتذبحه كأعضاء إثم للموت ليقوم بالرب يسوع أعضاء برّ لله. وهكذا تتقدس أعضاء الجسد وحواسه وميوله وشهواته، لتكون طاقة مُعينة للروح بدلاً من أن تكون محاربة لها.
- ذبيحة الحمد والشكر: يوصينا الرسول: “فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه[9]“ (عب ١٣: ١٥). وذبيحة الحمد والشكر هي ذبائح الملائكة. فالسمائيون ليس لهم جسد مادي مثلنا يقدمونه ذبيحة مقدسة، ولا ممتلكات مادية يدفعون منها لمحتاجين، ولا من يضايقهم فيسامحونه، وليست لهم إرادة مخالفة لإرادة سيدهم حتى يرفضوها، ولا يقعون تحت آلام جسدية. فماذا يقدمون لله سوى ذبيحة التسبيح والشكر الدائم!
لهذا تدرب الكنيسة أولادها على حياة التسبيح كما في الابصلمودية والمزامير والألحان لكي تمرن ألسنتهم على عمل الملائكة.
ويقدم لنا العظيم أنبا أنطونيوس أب الرهبان هذا التدريب: [عندما تنام على سريرك تذكر بركات الله وعنايته بك، واشكره على هذا. فإذ تمتلىء بهذا تفرح في الروح… مقدمًا لله تسبيحًا يرتفع إلى الأعالي. لأنه عندما لا يوجد شر في الإنسان، فإن الشكر وحده يرضي الله أكثر من تقدمات كثيرة[10].]
غير أن هذه الذبائح جميعها يتقبلها الآب بالرب يسوع المسيح.
“لذلك يتضمن أيضًا في الكتاب هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية،
مختارًا كريمًا،
والذي يؤمن به لن يخزى” [6].
- لقد وضع الآب ابنه حجر زاوية في صهيون أي في الكنيسة. به يدخل المؤمن في عضوية الكنيسة ليكون عضوًا في جسد الرب السري.
لقد رأي هرماس ربنا يسوع صخرة قديمة وبابًا جديدًا فسأل عن سبب ذلك فقيل له:
[هذه الصخرة وهذا الباب هما ابن الله.
قلت: كيف تكون الصخرة قديمة والباب جديدًا؟
قال لي: أنصت وافهم أيها الإنسان الجاهل. إن ابن الإنسان قديم عن كل الخليقة وهو شريك الآب في عمل الخلقة، لهذا فهو “أزلي“.
قلت: ولماذا الباب جديد يا سيدي؟
أجاب: لأنه قد “أُظْهِر في الأزمنة الأخيرة” (١ بط ١: ٢٠) لهذا صارت البوابة جديدة، حتى أن الذين يخلصون بها يدخلون ملكوت الله.
قال: أترى كيف أن الحجارة التي دخلت خلال البوابة استخدمت في بناء البرج (الكنيسة)، وأما التي لم تدخل فألقيت مرة أخرى إلى موضعها خارجًا؟
قلت: إنني أرى ذلك يا سيدي.
ثم أكمل قائلاً: هكذا لا يدخل أحد ملكوت الله ما لم يستلم اسم (المسيح) القدوس، لأنك متى رغبت… في دخول مدينة مسورة بسور وليس لها إلاَّ باب واحد، فإنك لا تقدر الدخول بغيره… هكذا بنفس الكيفية لا يقدر إنسانًا أن يدخل ملكوت الله إلاَّ بواسطة اسم ابنه الحبيب[11].]
- ربنا يسوع هو حجر الزاوية الذي يضبط البناء كله ويربط بعضه البعض. وكما يقول القديس أغسطينوس: [إن حجر الزاوية يربط بين حائطين، هكذا لما رفض اليهود الأشرار الإيمان به جمع الذين آمنوا به منهم مع كثيرين من الذين كانوا قبلاً أممًا… وبهذا ربط بين الاثنين دون أن يحابي اليهود كما كانوا يظنون في تعصبهم الأعمى[12].]
- ربنا يسوع هو أيضًا حجر الزاوية السري الذي ربط بين حائط العهد القديم وحائط العهد الجديد… فعلى جبل طابور اجتمع بموسى مستلم الشريعة وإيليا النبي وثلاثة من التلاميذ، رابطًا وموحدًا بين العهدين، معلنًا أنه حجر الزاوية للشريعة والنبوة والكرازة بالإنجيل.
“فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة،
أما الذين لا يطيعون
فالحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية” [7] .
قيل أنه في بناء هيكل سليمان جاءوا بحجرٍ ضخم جدًا فلم يجد البناءون له نفعًا فتركوه وأهملوه، ولما بحثوا عن حجرٍ ليكون رأسًا للزاوية لم يجدوا حجرًا يصلح لذلك سواه ففرح به البناءون.
هكذا رفض اليهود ربنا يسوع واحتقروه صالبين إياه. لأنهم يريدون مسيحًا حسب أهوائهم الأرضية يملك ملكًا أرضيًا. أما الذين آمنوا به فوجدوا “يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركبًا معًا، ينمو هيكلاً مقدسًا في الرب، الذي فيه أنتم مبنيون معًا مسكنا لله في الروح” (أف ٢: ٢٠–٢٢).
لقد وجدناه، الصخرة غير الجامدة، الصخرة الروحية التي تتابعنا ونشرب منها شرابًا واحدًا روحيًا (١ كو ١٠: ٤).
يقول القديس أغسطينوس: [عرفه اليهود فصلبوه، وأما العالم كله فسمع عنه وآمن[13].]
ويقول الرسول إنه بالنسبة للرافضين “حجر صدمة وصخرة عثرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جُعِلوا له” [8] .
قوله “الذي جُعِلوا له” لا يعني أن الله هو الذي أراد رفضهم، وإنما هم رفضوه وقد سبق فأعلن الرب عما سيفعلونه (أش ٨: ١٣-١٥)، بل وأعلنه بفمه الإلهي قائلاً: “كل من سقط على ذلك الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه” (لو ٢٠: ١٧-١٨). إنه كالحجر اصطدموا به، وحتى لا يلقى باللوم عليه قيل “وصخرة عثرة“. الصخرة بطبيعتها ضخمة يليق بالسائر أن يراها فلا يصطدم بها، لكنهم في عدم طاعتهم تعثروا فيه أما هو فلم يتأثر ولا تزحزح! بقلبهم الحجري لم يطيعوا اللوح الحجري (الكلمة المنقوشة على الحجر)، فاصطدموا بالحجر الحي وتعثروا فيه، أما نحن فإذ نطيعه لا نصطدم به.
ويقول القديس أغسطينوس:
[يمكنك بقلب غير حجري أن ترى في تلك الألواح الحجرية (العهد الجديد) ما يناسب الشعب غليظ الرقبة، وفي نفس الوقت تستطيع أن ترى أيضًا “الحجر” عريسك الذي نعته بطرس بحجر حي…
بالنسبة لهم هو “حجر صدمة وصخرة عثرة“، أما بالنسبة لك فهو “الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاوية”…
لا تخف عندما تقرأ هذه الألواح، فإنها مرسلة لك من عريسك. فبالنسبة لغيرك هي حجر إشارة إلى عدم الحساسية، وأما أنت فهي تشير إلى القوة والثبات.
بإصبع الله كُتِبَت هذه الألواح، وبإصبع الله تخرج الشياطين، وبإصبع الله تطرد تعاليم الشياطين التي تمزق الضمير[14].]
“وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء،
لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب” [9] .
إذ تأسسنا على حجر الزاوية وارتبطنا به فإننا بهذا نكون:
“جنس مختار“: هذه العبارة ينطق بها رسول الختان ليصحح مفاهيمهم، إذ يحسبون أنفسهم أنهم دون سائر البشر “جنس مختار“، وأن الاختيار من قِبَل الله واقع بسبب جنسيتهم كيهود. لكن مجيء الرب متجسدًا وفي نسبه أسلاف أمميات، ودعوة الرب ورُسله للأمم كشفت حب الله للبشرية كلها، وأن الاختيار هنا لا يدفع إلى الكبرياء والتعصب بل إلى حمل المسئولية.
“كهنوت ملوكي“: وقد اقتبس هذا النص من سفر الخروج (١٩: ١)، ومع هذا فنحن نعلم أنه في العهد القديم لم يكن الكل كهنة وملوكًا بل كانوا مختارين، هكذا فإن القول “كهنوت ملوكي” تعني أنه قد صار بيننا كهنة مفرزون لخدمة ملك الملوك.
“أمة مقدسة شعب اقتناء“، عملها الكرازة والشهادة للذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب، بحديث عملي، بسلوكنا كأولاد للنور.
فما نخبر به هو “فضائل الذي دعانا“… أي نعكس جمال المسيح الساطع علينا. فيرى الناس نوره الإلهي في داخل قلوبنا، ويدركونه خلال تصرفاتنا وسلوكنا في الحياة. عندئذ يتحقق قول المرتل “من صهيون (الكنيسة) كمال جمال الله أشرق” (مز ٥٠: ٢).
في هذا كله ليس لنا فضل بل للذي رحمنا، إذ يكمل الرسول قائلاً:
“والذين قبلاً لم تكونوا شعبًا،
وأما الآن فأنتم شعب الله،
الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون” [10].
لقد كنا في ظلمة فدعانا إلى نوره العجيب… ماذا نطلب بعد؟ لقد اختارنا شعبًا لله كما تنبأ هوشع بذلك (١: ٦، ٩، ٢: ٢٣)!
ثالثًا: الارتباط بالسلوك العملي
إذ أنهى حديثه عن “تأسيسنا على الرب يسوع” بأن نخبر بفضائله، بدأ يوضح لنا أهمية السيرة الحسنة قائلاً:
“أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء
أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس” [11].
يدعوهم “أيها الأحباء” لكي يستميلهم إلى الإنصات والتنفيذ. وقد كان هذا النداء محببًا إلى نفوس التلاميذ والرسل إذ تشربوه من ربنا يسوع المحب، وسمعوا صوت الآب تجاه الابن يقول: “ابني الحبيب” عند العماد والتجلي، لهذا شغفوا به.
يدعوهم أيضًا “غرباء ونزلاء“، أي غرباء وضيوف، فقد سبق أن أوصاهم أن يتركوا شهوات الجسد بكونهم أبناء لله يعافون هذه الأمور، وهنا يقدم باعثًا ثانيًا هو إحساسهم بغربتهم وعدم ارتباطهم بالأرض. وقد أخذ الآباء الرهبان هذا الباعث كتدريب لكل طالب الرهبنة، إذ كانوا يدربونه على زيارة المدافن يوميًا لساعات طويلة حتى يعرف حقيقة هذه الحياة.
عندما سقط ثيؤدور المتنسك صديق القديس يوحنا الذهبي الفم في حب السيدة Hermoine الشابة الجميلة الصورة كتب إليه ذهبي الفم يطالبه بالعودة إلى حياته النسكية الأولى مسجلاً له الكثير عن مراحم الله ومحبته، مقدمًا له من بين التداريب الهامة للانتصار على حرب الشهوة أن يزور المدافن ويتأمل التراب والرماد والدود، متذكرًا نهاية الأشرار وسعادة الأبرار[15].
ونلاحظ أن الرسول لم يقل “أن تمتنعوا عن الخطايا” بل طلب الامتناع عن الجذر العميق لها، أي “الشهوات الجسدية”، لأنه كما يقول الأب دوروثيؤس: [الخطايا هي تنفيذ هذه الشهوات عمليًا، بمعنى أن الإنسان ينفذ بجسده الأعمال التي تثيرها فيه شهواته[16].]
هذه الشهوات يلزمنا أن نقلع عنها حتى وإن لم تخرج إلى حيز التنفيذ لأنها “تحارب النفس“. هذه الحرب الداخلية بين شهوات الجسد وشهوات الروح قائمة على الدوام مادمنا في الجسد، لكن ليس لها سلطان علينا أو حق السيادة والملكية على إرادتنا مادمنا لا نذعن لها. إذن لنمتنع عن شهوات الجسد بعدم قبولنا لها أو إرضائها، بهذا تكون حربها بلا قوة التنفيذ أو السيطرة، إنما تصبح أعضاؤنا آلات برّ لله شاهدة له أمام الأمم، إذ يرون الثمار المنظورة كانعكاس لنقاء داخلي وغلبة لشهوات الروح، وطاعة الجسد للروح وخضوعه لها[17].
وقد شبه الأب Mathetes من رجال القرن الثاني[18] علاقة النفس بالجسد المحارب لها كعلاقة المسيحيين الحقيقيين بالعالم الوثني الشرير الذي كان مضطهدًا للكنيسة.
- النفس منتشرة خلال كل أعضاء الجسد، والمسيحيون منتشرون خلال كل مدن العالم.
تسكن النفس في الجسد لكنها ليست منه، ويسكن المسيحيون العالم وهم ليسوا من العالم (يو ١٧: ١١، ١٤، ١٦).
النفس غير المنظورة حافظة للجسد المنظور، والمسيحيون معروفون حقًا إنهم في العالم وصلاحهم غير منظور.
يبغض الجسد النفس ويحاربها مع أنها لا تؤذيه بل لأنها تمنعه من التمتع بالملذات، هكذا يبغض العالم المسيحيين مع أنهم لا يضرونه، إنما لأنهم يمنعونه عن الملذات.
تحب النفس الجسد الذي يبغضها ويحب المسيحيون أيضًا الذين يبغضونهم.
النفس مسجونة في الجسد ومع هذا تحفظ الجسد ذاته، والمسيحيون موجودون في العالم كما في سجن ومع ذلك فهم غير الفاسدين فيه.
تسكن النفس الخالدة خيمة الجسد القابلة للموت، ويقطن المسيحيون كغرباء في مسكنٍ زائلٍ متطلعين إلى المسكن غير الفاسد في السماوات.
عندما تزهد النفس الطعام والشراب تصير في حال أفضل، والمسيحيون مع أنهم يومًا فيومًا يخضعون للعقاب (الاضطهاد الوثني) لكنهم يزدادون عددًا. لقد عين الله لهم هذا المركز المرموق الذي يلزمهم ألا ينسوه[19].
الرسالة إلى ديوغنيتس
“أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة،
لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر،
يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها” [12].
ما أكثر الافتراءات التي وجهها الرومان ضد المسيحيين: يقول العلامة ترتليان: [لقد فاض نهر تيبار وأضر أسوار روما فنسبوا ذلك إلى المسيحيين. وكانوا إذا لم يفض نهر النيل كحده المعتاد نسبوه إليهم. وإذا حدث زلزال في المملكة أو جوع أو وباء نسبوه إليهم صارخين “القوهم إلى الأسود”.]
ومع هذا ففي يوم الافتقاد أي يوم مجيء الرب للدينونة، أو يوم يكشف الله عن عيونهم لمعرفة الحق، تنكشف سيرة المؤمنين الحسنة فيمجدوا أباهم السماوي (مت ٥: ١٦).
لهذا كتب الشهيد كبريانوس إلى الكاهن Rogatianus ومعترفين آخرين ملقين في السجون يقول لهم: [إنني أُسَر أن أقول لكم إن هذا هو العمل الأعظم المُلْقَى عليكم، وهو أن تكونوا في حال أفضل مهتمين بذلك حتى أنه خلال اعترافكم ذاته يلاحظون مجد (هذا الاعتراف) خلال حياتكم الفاضلة الهادئة[20].]
ويرى الأسقف الشهيد كبريانوس أن السيرة الحسنة تزين المعترفين والشهداء.
٣. سلوكنا في المجتمع كأولاد لله
أولاً: الخضوع لنظم الدولة
“اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب.
إن كان للملك فكمن هو فوق الكل” [13].
أثار اليهود الفتنة عند الحكام تتلخص في خضوع المسيحيّين للملك يسوع، فلا يخضعون للإمبراطور أو الولاة، عاصين لكل أمر وقانون. وحتى لا يختلط الأمر على المؤمن بين الخضوع للمملكة السماوية والطاعة للرؤساء نجد السيد نفسه يعلن ضرورة الخضوع للنًظم القائمة (مت ٢٢: ٢١). وهكذا سلك الرسول بولس على نفس المنوال (رو ١٣: ١-٧)، وطلب من تلميذه تيطس أن يُذَكِّر الشعب بالخضوع للرئاسات والسلاطين ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح (٣: ١).
فالمسيحية جوهرها الحب والخضوع (التواضع) والطاعة، وليس الكبرياء والعصيان لهذا بينما ينصح القديس أغسطينوس[21] شعبه ألا يخافوا من تهديد الولاة لإلزامهم عبادة الأوثان، يقول:
[هل نرفع أنفسنا في كبرياء أم أطلب إليكم أن تزدروا بالسلاطين المرئية؟ لا يكون!… فإن الرسول نفسه يقول “لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. لأنه ليس سطان إلاَّ من الله. السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله” (رو ١٣: ١-٢)].
ويقول العلامة ترتليان: [لذلك فإنه بخصوص الكرامات الواجبة للملوك والأباطرة، لدينا نص كافٍ أنه يليق بنا أن نكون في تمام الطاعة وذلك كوصية الرسول “أن يخضعوا للرياسات والسلاطين” (تي ٣ : ١) ولكن حدود الطاعة في هذا أن نحفظ أنفسنا منعزلين عن عبادة الأوثان. ولنا في هذا أيضًا مثال الثلاثة فتية، الذين مع طاعتهم للملك نبوخذنصر ازدروا بتقديم التكريم لتمثاله فلم يقبلوا العبادة له… وهكذا أيضًا دانيال، كان خاضعًا لداريوس في كل الأمور، ثابتًا في واجبه مادام بعيدًا عن أساس إيمانه (دا ٦)[22].]
“أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر
وللمدح كفاعلي الخير” [14].
أي لا نخاف من نواب الإمبراطور (الولاة) بل نحبهم ونخضع لهم، لأنهم معينون لأجل الانتقام من الأشرار ومدح فاعلي الخير (رو ١٣: ٣-٤). نخضع لهمk مهتمين فقط بصنع الخير، وهذا يسد الأفواه المشتكية ظلمًا “لأن هذه هي مشيئة الله أن تفعلوا الخيرً فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء” [15].
لكن قد يسأل أحد: لماذا نخضع لهم ألسنا أحرارًا؟ الحرية في المسيحية ليست فوضى ولا عصيانًا للنظم والقوانين، بل هي خضوع وطاعة برضا وفرح، صانعين الخير كاسرين الشر تحت أقدامنا.
“كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر
بل كعبيد لله” [16].
يقول القديس أنبا أنطونيوس: [لا نعتبر الأحرار هم أولئك الأحرار بحسب مركزهم، بل الذين هم بحق أحرار في حياتهم وطبعهم… حرية النفس وطوباويتها هما نتيجة النقاء الحقيقي والازدراء بالزمنيات[23].] وأيضًا [الإنسان الحر هو ذاك الذي لا تستعبده الملذات بل يتحكم في الجسد بتمييز صالح وعفة، قانعًا بما يعطيه الله، مهما كان قليلاً، شاكرًا إياه من كل قلبه[24].]
الحر ليس بمركزه بل أن يتحرر في داخله مما فيه، فيعيش غير خانعٍ لشهوة ولا تلعب به لذات. فالحرية لا تبعث فينا الاستهتار بل تحملنا المسئولية. وكما يقول القديس إيريناؤس: [يحاسب العبد عن أفعاله، أما الابن فإنه يطالب بأكثر من ذلك، فيحاسب عن كلماته (مت ١٢: ٣٦) وعما يدور في فكره (مت ٥ : ٢٨) فإذ نال الحرية هذا يجعله ممحص أكثر[25].]
“أكرموا الجميع.
أحبوا الإخوة.
خافوا الله.
أكرموا الملك” [17].
يبدأ الرسول بإكرام الجميع حتى لا يظنوا أنه عندما يتحدث عن إعطاء الكرامة لمن له الكرامة يكون فيه محاباة وإهانة للفقير والضعيف، إنما يلزمنا إكرام خليقة الله كلها التي مات المسيح من أجلها. فمن يحتقر إنسانًا يهين خالقه وفاديه. وإذ نكرم الجميع يليق بنا أن نحب الأخوة، ذلك الحب الذي تحدث عنه الرسول بولس (١ كو ١٣) والذي بدونه تفقد العبادة كيانها ووجودها. وبهذا الحب يمكننا أن نتقي الله ونخافه، لأن من لا يحب أخاه كيف يقدر أن يعبد الله؟ مخافتنا للرب تبعث فينا تكريم الرؤساء والملوك المرسلين منه. هذا الإكرام ليس مبعثه شخص الملك بل مخافة الرب.
ثانيًا: الأمانة في الخدمة
“أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة،
ليس للصالحين المترفقين فقط،
بل للعنفاء أيضًا” [18].
مادام الخضوع أساسه “مخافة الرب”، لهذا لا يليق بالمؤمن أن يفحص أعمال رؤسائه، بل يحترمهم ويحبهم حتى وإن كانوا عنفاء.
ويقصد الرسول بالخدام العبيد أيضًا، إذ كان عددهم في ذلك الوقت ضخمًا. فيذكر المؤرخ بلينوس أن لأحد أصدقائه ٤٠٠٠ عبدًا ليس لهم أي حق شرعي.
وإذ كان قد آمن عدد كبير منهم بالمسيحية لذلك كان لزامًا أن تُوَجَّه إليهم نصائح خاصة بعملهم. فتُطالبهم بالخضوع برضا، حتى وإن كان سادتهم عنفاء. وقد استطاعت المسيحية خلال العبيد أن تكسب كثير من السادة، وخلال المرؤوسين أن يكرزوا بالسيرة الحسنة ورائحة المسيح النابعة فيهم لرؤسائهم.
وتظهر أهمية الأمانة في العمل من الرسالة التي وجهها أبونا البابا ثيوناس الاسكندري إلى لوقيانوس كبير أمناء القصر الإمبراطوري نذكر منها مقتطفات[26]:
[ما أظن ولا أود يا عزيزي لوقيانوس أن تتباهى بهذا الأمر أن كثير من رجال قصر الإمبراطور قد بلغوا إلى معرفة الحق. بل بالحري يليق بنا أن نقدم الشكر لإلهنا الذي يستخدمنا كآنية صالحة لعمل صالح، وقد منحك كرامة عظيمة لدى الإمبراطور حتى تظهر رائحة اسم المسيحي الذكية التي هي لمجد المسيح ولخلاص كثيرين.
فإنه وإن كان الإمبراطور نفسه لم يتلامس تمامًا مع الإيمان المسيحي، إلاَّ أنه يضع ثقته بخصوص أموره الخاصة وحياته في أيدي المسيحيين لأنهم أكثر الخدام أمانة… لذلك يجدر بك أن تبذل كل ما في وسعك ألا تسقط في أمر دنيء معيب، ولا تنطق بأي حال من الأحوال بكلمة نابية حتى لا يجدف على اسم المسيح بسببك…
الله لا يسمح أن نكون من بين المرتشين لبلوغ مآرب لدى الإمبراطور…
إياك وشهوة الطمع الذي يخدم الأصنام لا المسيح (أف ٥: ٤-٥)…
لنفعل كل شيء بوداعة ولياقة واستقامة حتى يتمجد اسم إلهنا وربنا يسوع المسيح في كل شيء.
تمم الأعمال الموكولة إليك بمخافة الرب وفي محبة لرئيسك وبعناية كاملة.
انظر إلى كل أمر صادر من الإمبراطور، ولا يعارض الله، إنه صادر من الله ذاته. ولتتقد بالمحبة كما بالخوف وبكل فرح…
ولكي ما يتمجد الله فيكم، اطئوا تحت أقدامكم كل رذائلكم الذهنية وشهوات جسدكم.
التحفوا بالصبر والشجاعة وانتعشوا بالفضائل ورجاء المسيح.
احتملوا كل شيء من أجل خالقكم نفسه. احتملوا كل شيء. اغلبوا كل شيء، لكي تربحوا المسيح الرب…
عزيزي لوقيانوس إذ أنت حكيم احتمل بطيب قلب غير الحكماء (٢ كو ١١: ١٩) فربما يصيروا حكماء.
لا تسمح بأذية أحد في أي وقت ولا تدع أحدًا يغضب.
إن حدث لك ضرر فتطلع إلى يسوع المسيح… لا تترك يومًا يمر بغير قراءة نصيب في الكتاب المقدس مخصصًا وقتًا مناسبًا له تاركًا وقتًا للتأمل.]
“لأن هذا فضل، إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله
يحتمل أحزانًا متألمًا بالظلم.
لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون،
بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون،
فهذا فضل عند الله” [19-20].
كان اللطم هو القصاص العادي للخدام متى أخطأوا… فإن لُطِمْنا من أجل خطأ ارتكبناه ما هو مجدنا؟ أما من يُلْطَم متألمًا من أجل عمل الخير فيصبر، فهذا فضل عند الله. وكلمة “فضل” في اليونانية تحمل معنيين في نفس الوقت وهما “نعمة ومعروف”.
نقبل اللطم ظلمًا من أجله بسرورٍ ورضا. يذكر لنا الأب بيامون[27] قصة امرأة شريفة بالإسكندرية طلبت من البابا أثناسيوس أرملة تعينها في الخدمة فأعطاها أرملة تخاف الرب. عادت السيدة تطلب غيرها فأرسل لها أشر أرملة، حتى تطاولت وضربت سيدتها، فجاءت السيدة شاكرة البابا قائلة له: “لقد أعطيتني حقًا امرأة تعينني وتشددني… أما الأولى فكانت تكرمني بالأكثر وتدللني بخدماتها”.
السيد المسيح كمثال لنا
“لأنكم لهذا دُعِيتُم فإن المسيح أيضًا تألم من أجلنا،
تاركًا لنا مثالاً لكي تتبعوا خطواته” [21].
نزل السيد المسيح بنفسه وعاش بين الخدام ولُطِم منهم، حتى نستطيع نحن أيضًا أن نتبع خطواته.
“لأنكم لهذا دعيتم“، أي أن هذه هي دعوة المسيح لنا، كما يقول القديس أغسطينوس: [أن نرفع أنظارنا إلى العريس السماوي، فإنه عُلِّق على الصليب كعبد متألم ظلمًا[28].]
ويقول أبونا البابا أثناسيوس الرسولي: [سَبَقَنا ربنا في هذا عندما أراد أن يظهر للناس كيف يحتملون؟… عندما ضُرِب احتمل بصبر، وعندما شُتِم لم يشتم، وإذ تألم لم يهدد بل قدم ظهره للضاربين وخديه للذين يلطمونه، ولم يحول وجهه عن البصاق. وأخيرًا كانت إرادته أن يُقاد إلى الموت حتى نرى فيه صورة كل الفضائل والخلود، فنسلك مقتفين آثار خطواته، فندوس بالحق على الحيات والعقارب وكل قوة العدو (الخطية)[29].]
وماذا قدم لنا المسيح كمثال؟
- “الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر” [22] .
لم يقصد الرسول أن يتحدث هنا عن قداسة المسيح، فهو قدوس بلا خطية، لكنه يسير معنا في طريق الصليب لكي نقتفي آثار خطواته، فإنه لم يفعل خطية واتُّهِمَ بأنه صانع شر؛ ولا وُجِدَ في فمه مكر واتُّهِمَ كمضلل.
- “الذي إذ شُتِمَ لم يكن يشتم عوضًا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل” [23]. كديان من حقه الانتقام، لكنه قبل آلام الصليب، محتملاً الشتم “كنعجة صامته أمام جازيها لم يفتح فاه“ (إش ٥٣: ٧)، وهكذا كل من يختار السير مع المسيح المصلوب!
- “الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على خشبة، لكي نموت عن الخطايا، فنحيا للبرّ الذي بجلدته شفيتم. لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها” [24-25].
بطرس الرسول كشاهد عيان لآلام ربنا يسوع رآه مثالاً لاحتمالها. رآه وهو يعلن “نفسي حزينة جدًا حتى الموت”… دخل البستان ليحمل خطايا البشرية على كتفيه ويصلبها على الصليب. أما الرسول بولس فركز حديثه عن الرب يسوع كمثال في احتمال الموت على الصليب.
يكشف لنا الرسول مفهوم آلام الصليب إنها ليست مجرد شجاعة وقدرة على الاحتمال، بل أساسها حب وبذل، إذ أراد بجلدته أي جراحاته أن يشفي جراحاتنا، فأحنى ظهره باختياره، ليحمل بطريقة سرية خطايانا في جسده، إذ “قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين” (عب ٩: ٢٨). “إنه سكب للموت نفسه وأُحصي مع آثمة، وهو حَمل خطية كثيرين، وشفع في المذنبين” (إش ٥٣: ١٢).
بآلام الحب أوضح لنا رعايته لنا إذ هو “راعي نفوسنا وأسقفها“، يبحث عن كل نفس مريضة فاتحًا ذراعيه لكل ضال!
اختار الموت “على خشبة”، وهذا لم يكن جُزافًا، بل كما يقول أبونا البابا أثناسيوس الرسولي:
[لم يكن لائقًا بالرب أن يمرض وهو الذي يشفي الآخرين…
لقد جاء كمخلصٍ لا لينقذ موتًا خاصًا به، بل يموت نيابة عن الآخرين… لذلك قَبِل الموت الذي جاءه من البشر لكي ينزع بالكمال الموت.
لو أن الموت حدث بصورة سرية، لما كان موته يشهد للقيامة…
جاء بنفسه ليحمل اللعنة التي علينا (غل ٣: ١٣) وهذا هو الصليب.
كيف يدعونا (نحن الأمم) ما لم يُصلب باسطًا يديه لدعوتنا؟
من أجل أن الصليب كان أفظع وجوه الموت وأقصى غاية المعاقبين، لذلك احتمل السيد المسيح الصلب طوعًا بكيان ناسوته المحتمل ذلك فداءً لبني آدم من أقصى غاية العقوبات للموت[30].]
يقول القديس أغسطينوس: [اختار الصليب ليذوق أمَرّ العذابات، إذ يموت موتًا بطيئًا، إذ أطاع حتى الموت موت الصليب (في ٢: ٨).]
يقول العلامة ترتليان[31]: [إاختار الصليب إتمامًا للنبوات والرموز الواردة في العهد القديم.]
وكيف نقتدي بالمسيح المصلوب؟
يقول الرسول “لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبرّ”. يقول القديس أمبروسيوس: [لذلك هل صُلِبَتْ الخطية لكي نحيا لله؟ فمن يموت عن الخطية يعيش لله! هل تعيش لذاك الذي بذل ابنه حتى يَصْلِب شهواتنا في جسده؟ فإن المسيح مات عنا حتى نعيش في جسده المحيي لذلك فإنه لم تَمُتْ حياتنا بل مات عصياننا فيه… إذن خشب الصليب هو سفينة خلاصنا لعبورنا[32].]
ويقدم لنا القديس أمبروسيوس درسًا آخر إذ يقول: [من لا يتعلم أن يغفر لمضايقيه عندما يتطلع إلى المسيح وهو على الصليب يطلب من أجل مضطهديه؟ أما ترى أن هذه الصفات التي للمسيح – كما يحلو لك أن تقول – إنها قوتك[33].]
[1] راجع أقوال الآباء عن الحسد في كتاب “الحب الأخوي”، 1964.
[2] الحب الأخوي، 1964، ص ٢٣٢.
[3] Instructor 1 : 6.
[4] Three books of Testimonies against the Jews, 2 : 16.
[5] The Shepherd, Book 1 vision 3.
[6] Tert. On Prayer 28.
[7] راجع رسالة تيموثاوس الأولى.
[8] طبع باسم العفة سنة ١٩٦٧.
[9] راجع مزمور ٥٦ : ١٢، ١٠ : ٢٢.
[10] الفيلوكاليا، 1993، ص ٢٣.
[11] كتاب الراعي ك٣ رؤيا ١٢.
[12] راجع عظات عن فصول منتخبة من العهد الجديد (١ : ١٤، ١٥).
[13] راجع عظات عن فصول منتخبة من العهد الجديد (١٢ : ٤).
[14] Reply to Faustus the manchasan 15 : 5.
[15] ستعود بقوة أعظم ليوحنا ذهبي الفم، 1969، ص ٢٢.
[16] الفيلوكاليا، 1993، ص ١٥٢.
[17] راجع “العفة” 1967، لأغسطينوس.
[18] أحد تلاميذ القديس بولس الرسول أو رفقائه.
[19] The Epistle of Diognetus 6.
[20] رسالة ١٣ (طبعة اكسفورد) إلى الكاهن Rogatianus.
[21] عظات على فصول منتخبة من العهد الجديد ١٢.
[22] On Idolatry 15.
[23] الفيلوكاليا، 1993، ص ٣٤.
[24] الفيلوكاليا، 1993، ص ٤٣.
[25] Irenaeus against hereses 4 : 165.
[26] A. N. Fathers V. 6 P. 158/161.
[27] مناظرات كاسيان، ص ٤٦٤ – ٤٦٩.
[28] القيم الروحية لعيد النيروز، 1973، ص ٤.
[29] رسائل القيامة 1967، ص ١٢0 – ١٢١.
[30] ملخص من مقال “هل من ضرورة لعار الصليب؟!” بكتاب الحب الإلهي، 1967.
[31] A. N. Fathers V. 3 p. 164 – 165.
[32] A. N. Fathers V. 3 p. 164 – 165.
[33] The Christian faith 2 : 11: 95.