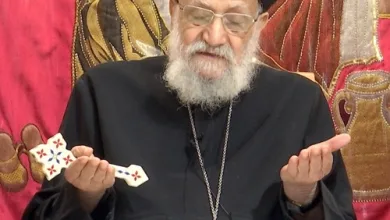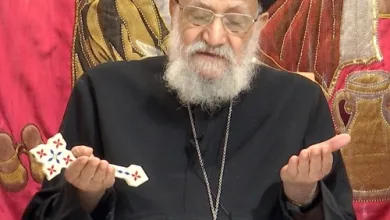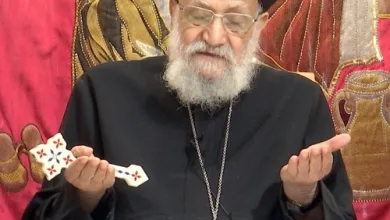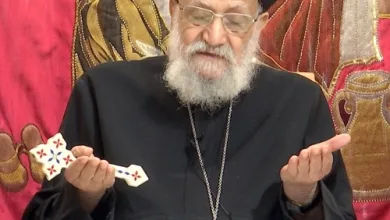تفسير رسالة بطرس الأولى 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة بطرس الأولى 1 الأصحاح الأول - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة بطرس الأولى 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة بطرس الأولى 1 الأصحاح الأول – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الأول
الخلاص والآلام
- تحية افتتاحية ١.
- عمل الله الخلاصي
أولاً: حب الثالوث لنا ٢.
ثانيًا: عطايا الله الجديدة ٣ – ٥.
- موقفنا تجاه الخلاص
أولاً: الإيمان والرجاء والمحبة ٦ – ١٢.
ثانيًا: الجهاد والعمل ١٣ – 25.
١. تحية افتتاحية
“بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين
من شتات بنتس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبثينيية” [1].
“بطرس” وهو الاسم الذي دعاه به الرب (يو ١: ٤٢)، ويسمى بالسريانية “صفا” أو “كيفا”، ومعناه “صخرة”، إشارة إلى الإيمان الذي نطق به من جهة الرب يسوع.
“رسول يسوع المسيح” وهنا يدعو نفسه رسولاً، أي أحد الإثني عشر، وليس برئيس عليهم بل واحدًا منهم.
“إلى المتغربين من شتات بنتس وغلاطية…“ وقد سبق لنا الحديث عن هذه البلاد. وهنا يدعوهم بالمتغربين والمشتتين، وهذا يتناسب مع روح الرسالة إذ هي موجهة إلى أناس متألمين. لا تقوم هذه الغربة على مجرد قصر الحياة الزمنية فحسب، لكن على ما هو أسمى وهو انتسابنا إلى ملكوت المسيح السماوي. وكما يقول الرسول، “فإن سيرتنا نحن في السماوات” (في ٣: ٢٠).
هذا الإحساس بالغربة النابع، لا عن نظرة تشاؤمية يائسة، بل نظرة مبهجة، وهو التعلق بالسماويات، هو الأساس لاحتمال الآلام بصبر ورفض الأرضيات، بل هو أساس حياتنا الروحية كلها.
وقد عرَّف القديس يوحنا الدرجي الغربة قائلاً: [الغربة تعني أننا نترك إلى الأبد كل ما في أرضنا من أمر زمني يعوقنا عن الوصول إلى غاية الحياة الروحية. الغربة هي سلوك متواضع… حكمة خفية… فطنة لا يعرفها الأكثرية… حياة مستترة… هدف غير منظور… تأمل غير مرئي… اشتياق للتواضع… رغبة في الألم… عزيمة دائمة على محبة الله… كثرة إحسان… نبذ المجد الباطل… صمت عميق[1].]
الغربة هي انطلاقة بالنفس البشرية بكل طاقاتها لتعبر فوق كل الآلام والأتعاب لتهيم في حب الثالوث القدوس.
٢. عمل الله الخلاصي
أولاً: حب الثالوث لنا
لما كانت الرسالة تدور حول “الألم في حياة المؤمن” فكان لِزامًا على الرسول أن يبدأ حديثه بالخلاص الذي يقدمه لنا الثالوث القدوس في حب لا ينطق به، لأن اكتشاف الإنسان لمحبة الله الباذلة هو الدافع القوي لاحتمال الآلام برضا، لذلك حدثنا عن:
- حب الآب المُعلَن في اختياره للإنسان.
- حب الروح القدس المُعلَن في تقديسنا للطاعة.
- حب الابن المُعلَن على الصليب.
- اختيار الآب لنا
“(إلى) المختارين بمقتضى علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة
ورش دم يسوع المسيح” [2].
أعلن الله حبه للإنسان باختيارنا للملكوت. هذا الاختيار فهمه اليهود المتعصبون فهمًا خاطئًا، إذ حسبوه قائمًا على محاباة الله لشعبٍ معينٍ أو جنس معين وإلزامهم بالسلوك في طريقه، لهذا التزم رسول الختان أن يتحدث عن اختيار الآب لنا إذ أوضح:
- أن الاختيار قائم “بمقتضى علم الله السابق“، هذا العلم غير الإرادة. فمن جهة الإرادة يود أن الجميع يخلصون، لكن بسابق علمه يعرف الذين يقبلونه ويؤمنون به ويثبتون فيه. وكما يقول الرسول: “لأن الذين سبق فغينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه” (رو ٨: ٢٩). على الصليب فتح الابن يديه معلنًا دعوة الآب لكل البشرية. لكن الآب يعرف الذين يتبعونه ويسلكون في وصاياه كما يعرف الابن خرافه (يو ١٠: ١٤).
- يقول القديس أغسطينوس بأن الرسول يدعو المؤمنين مختارين، ليس لأن جميعهم يثبتون في الاختيار إلى النهاية، لكن من قبيل أن المختارين هم بين صفوف المؤمنين.
- الاختيار هنا ليس فيه حرمان للإنسان حريته وقسره على سلوك معين، بل هو “في تقديس الروح للطاعة“، أي في الخاضعين لعمل روح الرب، السالكين في الطاعة.
وقد عالج القديس أغسطينوس هذا الموضوع فقال:
[يقول القديس بولس عن فليمون: “الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضًا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أشاء أن أفعل شيئًا، لكي لا يكون خيرك على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار”. وجاء في سفر التثنية “أنظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير، الموت والشر… فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك” (٣٠: ١٥، ١٩). وأيضًا في سفر ابن سيراخ: “هو صنع الإنسان في البدء وتركه في يد اختياره… فإن شئت حفظت الوصايا ووفيت مرضاته. وعرض لك النار والماء فتمد يدك إلى ما شئت” (سي ١٥: ١٤، ١٧). هكذا أيضًا نقرأ في سفر إشعياء “إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم” (١: ١٩-٢٠)… فإننا لا نبلغ إلى الغاية بغير إرادتنا، ولكن لا نستطيع أن نكمل الغاية ما لم ننل المعونة الإلهيّة[2].]
- تقديس الروح للطاعة
الآب يحبنا فاختارنا له، والروح القدس يحبنا بذات حب الآب لأنه روح الآب، وعمله أن يقدسنا للطاعة. فالإنسان لا يقدر بذاته أن يتقدس، ولا يقدر بذاته أن يجاهد، لذلك وهبنا الله روحه معينًا لنا. فخلال سرّي المعمودية والميرون سكن فينا روح الله وصرنا مُفرزين له. وخلال سر التوبة والاعتراف تغفر لنا خطايانا. وخلال سر الإفخارستيا نثبت في الله. كما يقدم لنا الروح أعماله التقوية من محبة وفرح وسلام ووداعة… بهذا كله يقدسنا الروح ويعيننا على الطاعة والمثابرة[3].
- “ورش دم يسوع المسيح”
حب الله في اختياره لنا وتقديسه حياتنا كلفة ثمنًا هذا مقداره! دم يسوع المسيح كفارة عن خطايانا وشفاءً لأمراض نفوسنا وعهدًا للشركة معه! أمام هذا الحب العملي الباذل نخجل أن نتذمر من جهة الآلام أو نشكو من ضيقات أو نخاف من الموت!
“لتكثر لكم النعمة والسلام”
إذ قدم لنا كل إمكانية إلهيّة، إذ دفع الثمن ووهبنا روحه معينًا في الجهاد، لذلك فهو يفيض علينا بالنعم والسلام.
- النعمة: أي نعمه المجانيّة وبركاته الإلهيّة التي تملأ القلب سلامًا.
- السلام: وهو يقوم على نعمة الله، فتدرك النفس مصالحتها مع الله مصدر سلامها وسعادتها، فتهيم معه في شركة حب وتسمو فوق كل الآلام. وهذا يعكس أيضًا سلامًا مع الغير حتى المضايقين لنا، لأن الداخل قوي وثابت فلا يضطرب الخارج[4]!
ثانيًا: عطايا الله الجديدة
يرسم لنا الرسول عظمة عطاياه المجانية التي نتمتع بها باستحقاقات الدم، فيقول “مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية” [3].
لك البركة أيها الآب إذ قدمت لنا برحمتك الغنية أثمن عطية… وهبتنا ميلادًا جديدًا بالمعمودية! هذا الميلاد الذي على أساسه تبني كل عبادتنا لك!
إذ وهبتنا:
- الميلاد الجديد به نُزِعنا من الزيتونة البرية وطُعمنا في الزيتونة الجديدة (رو ١١ : ٢4)، صُلب إنساننا العتيق ووهبنا أن نكون خلقة جديدة (٢ كو ٥: ١٧) “لا بأعمال برّ عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس” (تي ٣: ٥).
وكما يقول القديس ديديموس الضرير: [عندما نغطس في جرن المعمودية، فبفضل صلاح الله الآب وبنعمة روحه القدوس نتعرى من خطايانا، إذ نتخلص من إنساننا العتيق، ونتجدد، ونُختم بقوته لملكيته الخاصة. ولكن عندما نخرج من جرن المعمودية نلبس المسيح مخلصنا كثوبٍ لا يبلى، مستحقًا لكرامة الروح القدس عينها، الروح القدس الذي جددنا ودفعنا بختمه[5].]
- الرجاء الجديد: إذ يكمل الرسول قائلاً: “لرجاءٍ حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات” [4].
كانت الأنظار، في العهد القديم، تتركز حول أرض الموعد والبركات الزمنية كرمز لأورشليم السمائية والبركات الأبدية، مع تلميح بالأمور الأبديّة قدر ما تستطيع أعينهم أن ترى. أما الآن بعد أن صار لنا الميلاد الذي من أب سماوي وأم سماوية (الكنيسة) فإنه لا يليق بنا أن يكون لنا رجاء في الزمنيات.
هذا الرجاء الجديد يقوم على قيامة الرب من بين الأموات، إذ صار لنا نحن أعضاء جسده السري أن نخلع كل رجاء زمني متطلعين برجاء حي تجاه ميراث أبدي. إنه رجاء حي لأنه ينبع من قلب حي يفيض على الدوام بحياة حب لا ينضب!
- الميراث الأبدي: المولود من الجسد ينتظر ميراثًا ماديًا. والمولود من الروح يتعلق قلبه بميراث روحي. “فإن كنا أولادًا فإننا ورثةً أيضًا، ورثة الله ووارثون المسيح” (رو ٨: ١٧)… وما هي سمات هذا الميراث الروحي؟
- “لميراث لا يفنى” لأنه ليس ميراثًا أرضيًا، بل سماويً.
- “ولا يتدنس”، إذ يختلف عن الميراث الأرضي الذي يمكن أن يُغتصب بالخداع أو الاختلاس، كما يمكن أن يتبدد بالإسراف الشرير.
- “ولا يضمحل”، إذ لا يزول جماله ولا يفقد بهاءه.
- “محفوظ في السماوات لأجلكم”، إذ هو موضوع عناية الله وحراسته، يحفظه لأجلكم أي لأجل كل إنسان. فلا نيأس قط لأنه هيأ السماوات من أجلنا بالرغم مما بلغناه من انحطاط.
وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [انظروا إلى طبيعتنا كيف انحطت ثم ارتفعت؟ فإنه ما كان يمكن النزول أكثر مما هوى إليه الإنسان، ولا يمكن الصعود إلى أكثر مما ارتفع إليه المسيح (ورفعنا معه). اليوم (يوم صعود الرب) ارتفعت طبيعتنا فوق كل خليقة[6]!]
- قوة جديدة: “أنتم الذين بقوة الله محروسون، بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير” [5]. اليد الإلهية التي تحفظ الميراث هي التي تحرسنا نحن مهيئين للميراث، إذ تقدم لنا كل إمكانية لأجل تقديسنا للعرس السماوي الذي يُعلن يوم الرب العظيم.
٣. موقفنا تجاه الخلاص
أولاً: الإيمان والرجاء والمحبة
يقدم الله كل إمكانية إلهية لأجل خلاصنا، لكننا لن نتمتع بالسير في طريق الخلاص بغير اشتراكنا بالإرادة (النية) والعمل. هذه المشاركة من جانبنا لا تقلل من عمل الله الخلاصي، أو تنفي عنه مجانيته أو تدفع بنا إلى البرّ الذاتي. لأننا نؤمن أن إيماننا ورجاءنا ومحبتنا وأعمالنا رغم ضروريتها، إذ بدونها نحرم من الخلاص، إلاَّ أنها ليست من ذواتنا. لكنها هبة من الله يقدمها للمثابرين والمغتصبين، مبنية على استحقاقات دم المسيح.
فلا تبرير لإنسان بغير الإيمان والرجاء والمحبة (أعمال المحبة)، ولا انتفاع بأعمال الله القوية من أجل خلاصنا بدونها. فما هو التزامنا نحن؟
- الإيمان: “الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تُحزَنون يسيرًا بتجارب متنوعة. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار” [6-7].
وإذ يتكلم الرسول عن واجبنا أو موقفنا تجاه خلاصنا الثمين يطالبنا بالإيمان العملي:
أ. حياة مملوءة بهجة: فالإيمان بالرب الفادي يُشعل في النفس بهجة لا تطفئها الآلام أو التجارب أو أي ظرف خارجي. لنفرح ولنبتهج مع أمنا العذراء قائلين: “تبتهج نفسي بالله مخلصي”. ولنقل مع المرتل في توبته: “رُد لي بهجة خلاصك”.
ب. حياة مملوءة تجارب: “إن كان يجب تُحزَنون” أي أن التجارب ليست أمرًا ثانويًا في حياة المؤمن بل إلزاميّة، خلالها يشترك مع الرب المتألم. ولا يتعرض لتجربة أو اثنتين بل لتجاربٍ متنوعةٍ، حاملاً الصليب مثل سمعان القيرواني مع ربنا يسوع. هذه الآلام يسيرة من حيث أن زمان غربتنا مهما بلغ فهو قليل بالنسبة للأبديّة. هذا الاحتمال يزكي إيماننا، وإن كنا نناله بالجهاد من يدي النعمة الإلهيّة. لهذا فاحتمالنا هذا لا ينفي مجانية الخلاص، ولا يبعث فينا الشعور بفضلٍ إلاَّ فضل الله.
- الرجاء: “توجد للمدح والكرامة والمجد، عند استعلان يسوع المسيح” [7].
يسند الرجاء المؤمن في التجارب، إذ يرفع أنظاره إلى يوم الرب العظيم ليرى:
أ. المدح من الرب من أجل صبره إلى المنتهى “من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص”.
ب. الكرامة أمام إخوته المشاركين معه في أورشليم السماوية.
ج. المجد: إذ استحق أن يكون متحدًا بعريس هكذا سماوي ومجيد!
- المحبة: “الذي إن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن، لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرحٍ لا يُنطق به ومجيد” [8]. إن كنا لا نرى ما سنكون عليه وما سيكون لنا، لكننا نؤمن مترجين المجد الأبدي، لهذا نحب الله فرحين مبتهجين بعمله معنا.
نحب استعلان يسوع المسيح حيث يحمل جسدنا الفاسد عدم فساد، وترى النفس عريسها وجهًا لوجه. هذا هو غاية إيماننا “خلاص النفوس“.
وكما يقول القديس أغسطينوس:
[يقول الرسول بولس أيضًا أننا نخلص بغسل الميلاد الجديد، ومع ذلك يعلن في موضع آخر: “لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضًا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر” (رو ٨: ٢٤-٢٥). وبهدف مشابه أيضًا يقول زميله في الرسولية بطرس “الذي وإن لم ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبهجون بفرحٍ لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس” [9]. فإن كان الآن هو وقت الإيمان، وجزاء الإيمان هو خلاص نفوسنا، هذا الإيمان الذي فيه نعمل بالمحبة (غل ٥: ١٦) فمن يشك أنه سيأتي اليوم إلى نهاية. وفي نهايته ننال الجزاء ليس فقط خلاص أجسادنا الذي تحدث عنه بولس الرسول (رو ٨: ٢٣) بل ونفوسنا أيضًا كما قال الرسول بطرس…
إن الزمن الحاضر سينتهي، لذلك فإن الأمر هنا متوقف على الرجاء أكثر منه على نوال المكافأة.
ولكن يلزمنا أن نتذكر هذا وهو أن إنساننا الداخلي، أي النفس، يتجدد يومًا فيومًا (٢ كو ٤: ١٦) ولهذا فإننا ونحن ننتظر الخلود الذي للجسد والخلاص الذي لنفوسنا في المستقبل، فإننا بالعربون الذي نناله هنا نقول أننا خلصنا. حتى أننا ننظر إلى معرفة كل الأمور التي سمعها الابن الوحيد من الآب كأمورٍ نرجو نوالها في المستقبل ولو أن السيد أعلنها كما لو وهبت لنا فعلاً.]
هذا الحب للسماوات والاشتياق للخلاص الأبدي هو:
أ. موضوع نبوة الأنبياء.
ب. موضوع كرازة الإنجيل.
ج. موضوع دهش السمائيّين.
أ. موضوع نبوة الأنبياء: بالحب اشتهوا الأبديّة، فوهبهم الروح القدس “روح المسيح” أن يتنبأوا عن الخلاص إذ يقول الرسول: “الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذين كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها” [10-11].
لقد فتشوا وبحثوا عنه… وهذا دليل الحب. فوهبهم روح المسيح أن يشهدوا للأبديّة (الأمجاد) مرتبطة بالآلام التي للمسيح، لأنه لا خلاص بدون سفك دم. لقد كان الصليب هو محور الرموز والنبوات. تعلق به الآباء والأنبياء بعدما رأوه من بعيد، إذ يقول الرب “إبراهيم أبوكم رأى يومي فتهلل“.
رأوا الآلام بطريقة تفوق إدراكهم (دا ١٢: ٨-٩). وهنا يستخدم صيغة الجمع ليكشف الرسول عن شدتها وكثرتها، والأمجاد أيضًا بالجمع لأنه كلما كثرت الآلام تزداد الأمجاد. هنا تشويق خفي للنفس أن تحمل آلام المسيح ولا تستكثرها، لأنها تبغي أيضًا مشاركة أمجاد فائقة الوصف. وهذا هو مفهوم الحب الحقيقي.
ب. موضوع كرازة الإنجيل: إن كان الأنبياء خلال الظلال والنبوات أحبوا الرب واشتهوا أن يروا صليب الرب وأمجاده، فكم بالأكثر يليق بنا نحن أن نحبه إن كان هذا كله من أجلنا نحن!
“الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم،
بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن
بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المُرسل من السماء“.
لقد جاء بنا ملء الزمان الذي به نُبَشَّر ونُبَشِّر بما اشتهى الأنبياء أن يسمعوه ويروه. هنا يقول الرسول عن الأنبياء “يخدمون بهذه الأمور“، أي لم تكن موضوع كبرياء لهم بل خدمة وتواضع.
ج. موضوع دهش السمائيّين “التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها” [١٢].
- الحب من سمات الملائكة أيضًا، لذلك تشتهي أن تطلع على خلاص الإنسان، وشهوتهم هذه ليست من قبيل حب الاستطلاع لكن مشاركة للإنسان، واشتياقًا نحو توبته ورجوعه (لو ١٥: ١٠).
- صنيع الرب معنا هو موضوع دهش الملائكة وتسبيحهم للخالق!
ثانيًا: الجهاد والعمل
إذ نتطلع إلى الخلاص الذي يقدمه لنا الله، ونؤمن به ونترجى الميراث ونحب الأبديّة ماذا نفعل؟
- “لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين“
كأن الرسول يوقظ العروس الراحلة لملاقاة عريسها مكررًا لها النداء “اصحوا” ثلاث دفعات (4:
7، 5: 8) حتى تكون دائمة متهيئة لعريسها ممنطقة أحقاء ذهنها!
أ. أخذ الرسول هذا التشبيه مما كان يصنعه المسافرون، إذ كانت ملابسهم طويلة، فيشدوا أحقاءهم حتى لا تُعيقهم.
ب. وربما لأن الإنسان يقوم برفع أكمامه على ذراعيه (تشمير ساعديه) عندما يستغرق في تفكير عميق لأمر هام.
ج. أو لأن الصيادين اعتادوا أن يمنطقوا أحقاءهم عندما يغوصون في الماء حتى رُكَبهم.
إذن لنمنطق ذهننا بالبرّ ساهرين في حياة مقدسة متشبيهن بعريسنا. يقول البابا أثناسيوس الرسوليٍ: [لنمنطق أحقاء ذهننا متشبهين بمخلصنا يسوع المسيح الذي كتب عنه ويكون البرّ مِنطقة مَتنَيْهِ والأمانة مِنطقة حقويْه” (إش ١١: ٥)[7]ِ.]
- “فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم، عند استعلان يسوع المسيح” [١٣].
السهر بغير رجاء يخور، لهذا يلزم أن يكون كل رجائنا مُنصبًا في المجد (النعمة) الذي يؤتى به إلينا عند ظهور ربنا.
ليكن الرب هو رجاءنا (١ تس ١: ٣)، وليكن ظهوره أمام أعيننا، لأنه ليس ببعيدٍ عنا بل يؤتى به إلينا، وفي النص اليوناني تعني أنه في الطريق إلينا لنناله. وليكن رجاؤنا في الأبديّة “بالتمام” أي بكمال ونضوج، لأنه كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [الرجاء بالتأكيد يشبه حبلاً قويًا مُدَلَّى من السماوات يُعين أرواحنا، رافعًا من يمسك به بثبات فوق هذا العالم وتجارب هذه الحياة الشريرة، فإن كان الإنسان ضعيفًا وترك هذا الهلب المقدس يسقط للحال ويختنق في هوة الشر[8].]
- “كأولاد الطاعة، لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم” [11].
لنتطلع إلى حقيقة مركزنا أننا أولاد الآب سماوي كلي الصلاح، فكأولاد مطيعين لا نعود بعد نَسْلك فيما كنا فيه أيام جهلنا. وكما يقول القديس أغسطينوس:
[لنا والدان ولدانا على الأرض للشقاء ثم نموت. ولكننا وجدنا والدين آخرين. فالله أبونا والكنيسة أمنا، ولدانا للحياة الأبديّة. لنتأمل أيها الأحباء أبناء من قد صرنا؟ لنسلك بما يليق بأبٍ كهذا… وجدنا لنا أبًا في السماوات، لذلك وجب علينا الاهتمام بسلوكنا ونحن على الأرض. لأن من ينتسب لأبٍ كهذا عليه السلوك بطريقة يستحق بها أن ينال ميراثه[9].]
وأي سلوك يليق بنا؟
“بل نظير القدوس الذي دعاكم،
كونوا انتم قديسين في كل سيرة.
لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
وإن كنتم تدعون أبًا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد،
فسيروا زمان غربتكم بخوف” [15-17].
أوضح لنا الرسول: ما هو سلوكنا؟ ومصدره ودافعه ومجالاته.
أ. سلوكنا هو القداسة أي حب السماويات وبغض الخطية.
ب. دافعه هو:
أولاً: أن نسير كما يليق بالدعوة التي دُعينا إليها.
ثانيًا: كأولاد للطاعة نخضع لإرادة الآب القدوس وكما يقول العلامة ترتليان: [إرادة الله قداستنا (١ تس ٤: ٣)، لأنه يريد منا نحن صورته، أن نكون على مثاله، لنكون قديسين كما هو قدوس (لا ١١: ٤٤)[10].]
ثالثًا: يضعنا الرسول أمام الدينونة كدافع لحياة القداسة والورع.
ج. مصدره: الله القدوس، وهو أبونا. وهذه هي كل المسيحية، أن ندرك أبوة الله لنا ونتمتع بها. هذه الأبوة لا تقوم على أساس المحاباة، بل مبنية على مراحم الله وعدله، إذ “يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد”، فلا نيأس لأنه أبونا، ولا نستهتر لأنه ديان. هو أب عادل وديان مملوء حنانًا. بهذا نزع رسول الختان الفكر اليهودي الخاطيء من جهة أن الله يحابي جنسهم على حساب البشرية وعلى حساب عدله.
د. مجالاته: “في كل سيرة”، وفي اليونانية تعني طريق الحياة أو السلوك، أي في كل تصرف: في الصمت كما في الكلام، في الأفكار الخفية كما في العمل الظاهر، ليكن كل ما هو فينا “قدس الرب”.
- التأمل في عظمة الخلاص
إن كنا مُطالَبين بالسهر والرجاء والطاعة والقداسة والسير بخوف الله، هذه جميعها نحمل فيها أتعابًا وآلامًا نقبلها باختيارنا، وأما ما يدفعنا لهذا، فهو تأملنا المستمر في عظمة الخلاص إذ هو:
أ. ليس بفضة أو ذهب! د. يهبنا إمكانيّة التطهير.
ب. فداء أزلي! ه. أعطانا ميلادًا جديدًا.
ج. يُثَبِّت إيماننا ورجاءنا في الآب!
أ. ليس بفضة أو ذهب
“عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب
من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء.
بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح” [18-١٩].
كان يُدفَع فضة أو ذهب فدية عن أسرى الحرب أو للعتق من العبوديّة، أما الرب فلم يَدفع هذا أو ذاك ليفدينا من سيرتنا الباطلة التي أُسِرْنا فيها، بل قدم دمًا كريمًا، آلامًا وأتعابًا احتملها ابن الله، انتهت إلى عار الصليب!
قَدَّم دمًا كريمًا كما من حملٍ بلا عيب، والحمل هو أطهر البهائم (خر ١٢: ٥، تث ٢٨: ٣) لذلك كان حمل التقدمة إشارة للسيد المسيح القدوس الذي بلا شر (عب ٧: ٢٦، يو ١: ٢٩).
وكما يقول العلامة ترتليان: [قد اشتُريتم بثمن أي بالدم. قد نُزِعتُم من إمبراطورية الجسد لتمجدوا الرب في أجسادكم[11].]
التأمل في صليب الرب يُشوِّق النفس للآلام ويُزهِدها في غنى العالم، ويحثها على طلب الغنى الأبدي. وكما يقول القديس أمبروسيوس: [صليب الرب هو حكمتي! موت الرب هو خلاصي! لأننا نخلص بدمه الثمين كقول الرسول بطرس[12].]
ويُحَدِّث القديس أمبروسيوس الأغنياء ليتأملوا هذا الثمن قائلاً:
[لا يظن أحد أنه قد دُفع عنه ثمن مختلف بسبب غناه. فالغنى في الكنيسة هو الغنى في الإيمان، إذ المؤمن له كل عالم الغنى. أي عجب في هذا إن كان المؤمن يملك ميراث المسيح الذي هو أثمن من العالم؟
لقد قيل للجميع، وليس للأغنياء وحدهم: فقد افتُديتم بدم كريم.
فإن أردتم أن تكونوا أغنياء أطيعوا القائل “كونوا أنتم قديسين في كل سيرة”…
إنه يقول “فسيروا زمان غربتكم بخوف“، وليس بترفٍ أو تنعمٍ ولا في كبرياءٍ بل “بخوفٍ“.
إن لكم هنا على الأرض زمانًا ليس أبديًا، فاستخدموه كعابرين منه حتمًا[13]!]
ب. فداء أزلي
“معروفًا سابقًا قبل تأسيس العالم،
ولكن قد أُظهِر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم” [20].
لنتأمل محبته الأزليّة، فهذا العمل الفدائي ليس بجديدٍ، لكنه قبل أن يخلقنا، بل قبل تأسيس العالم، منذ الأزل خطة الله مدبرة تجاه الإنسان العاصي ليدفع عنه أجرة عصيانه.
هذا هو موضوع لذة المؤمنين الحقيقيّين أن يدركوا محبة الله الباذلة “من أجلهم هم”، فإن هذا يدفعهم لتقبيل الصليب، وحمله بسرورٍ بالرب يسوع.
ج. يثبت إيماننا ورجاءنا في الآب
“أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات،
وأعطاه مجدًا حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما في الله” [21].
لعل الرسول خشى من البدعة التي نادى بها فيلون السكندري فيما بعد إذ نادى بوجود إلهين: إله العهد القديم قاسي، يعاقب الخطاة ويهلكهم. وإله العهد الجديد وديع ومترفق بهم. لهذا يؤكد الرسول أن ما قام به الابن إنما في طاعة للآب، فإيماننا ورجاؤنا بالمسيح هما في الله الآب، وليس منفصلاً عنه.
لقد أطاع المسيح الآب فـ “مع كونه ابنًا تعلم الطاعة مما تألم به” (عب ٥: 8)، مُسَلِّمًا الإرادة للآب. فأخلى ذاته وتجسد وتألم وقام، وأخذ المجد الذي له بإرادة الآب التي هي وإرادة الابن واحدة[14].
د. يهبنا إمكانيّة التطهير
“طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح،
للمحبة الأخوية العديمة الرياء،
فأحبوا بعضكم بعضًا من قلبٍ طاهر] بشدة” [22].
لنتأمل عظمة هذا الخلاص إذ لا يسلب الإنسان حريته، بل طالبه بالعمل: “طهروا نفوسكم“، فلا خلاص لإنسان لا يُطَهِّر نفسه. هذا التطهير يتم بطاعة الحق بالروح، أي طاعة المسيح يسوع بالروح القدس.
فالطاعة هي بإرادتنا حيث نُخْضِع هذه الإرادة لإرادة المسيح فيعمل قصده فينا، والطاعة تستلزم الجهاد والعمل لكن سندنا في ذلك روحه القدوس!
هذه الطاعة تتلخص في حبنا الأخوي، لأن هذا هو قصد الرب يسوع، وهذه هي وصيته، لذلك يقول الرسول:
“للمحبة الأخوية“، حيث يتسع القلب لكل البشرية بلا تمييز أو محاباة.
“عديمة الرياء“، إذ لا تنبع عن دوافع مظهرية بل حب داخلي.
“من قلب طاهر“، قد تَطَهَّر بالروح القدس، وصار نقيًا في غاياته.
“بشدة“، لأنها على مثال حب المسيح الذي مات عنا.
ه. أعطانا ميلادًا جديدًا
“مولودين ثانية لا من زرع يفنى،
بل مما لا يفنى،
بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد.
لأن كل جسد كعشب،
وكل مجد إنسان كزهر عشب.
العشب يبس وزهره سقط.
وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد.
وهذه هي الكلمة التي بُشِّرْتُم بها” [23-25].
يركز الرسول حديثه على “الولادة الثانية“.، لأن خلالها نتمتع بعظمة الخلاص، وخلالها يكون لنا حق الميراث، ونجتاز الآلام والأتعاب ببهجة قلب.
هنا يقارن بين الميلاد الروحي والميلاد الجسدي. فالميلاد الروحي من زرع لا يفنى، مصدره كلمة الله الحيّة الباقية إلى الأبد. ويعني بهذه الكلمة:
- “اللوغوس[15]” أو الكلمة المتجسد إذ خلال صليبه ودفنه وقيامته صار لنا أن ندفن معه بالمعمودية ونقوم لابسين المسيح (غل ٣: ٢٧).
- كلمة الكرازة “التي بشرتم بها” وهي تدور حول الصليب الذي بدونه ما كان الميلاد السماوي أن يقوم. وكما يقول القديس أمبروسيوس: [لأن الماء بعد أن تكرس بسرّ صليب الخلاص يصبح مناسبًا لاستعماله في الجرن الروحي وكأس الخلاص. إذ كما ألقى موسى النبي الخشب في تلك العين، هكذا أيضًا ينطق الكاهن على جرن المعمودية بشهادة صليب الرب، فيصبح الماء عذبًا بسبب عمل النعمة[16].]
[1] سلم السماء ودرجات الفضائل ٣ : ١.
[2] Augustine: Man’s perfection in Righteousness 19.
[3] راجع الحب الإلهي، 1967، باب “الله مقدسي” أيضًا ٨٠١ – ١٠٤٤.
[4] راجع تفسير ٢ يوحنا ٣.
[5] الحب الإلهي، 1967، ص 852.
[6] الحب الإلهي، 1967، ص ٧٣٧ – ٧٤٠..
[7] رسائل القيامة رسالة ٣ أيضًا ٥٢.
[8] ستعود بقوة أعظم” للقديس يوحنا الذهبي الفم.
[9] الصلاة الربانية طبعة ٦٨ ص ٩.
[10] Tert. On Exhortation to Chastity.
[11] Tert.: On Modesty 16.
[12] On the Christian Faith 3 : 5.
[13] Letter 63.
[14] إذ لا يسمح المجال بالإطالة أرجو الرجوع إلى مقال “طاعته للآب” في كتاب الحب الإلهي، 1967، ص ٢٢٥ – ٢٢٨.
[15] راجع الأب هيببوليتس The Refutation of all heresies 4 : 5.
[16] الأسرار للقديس أمبروسيوس – مجلة مرقس..