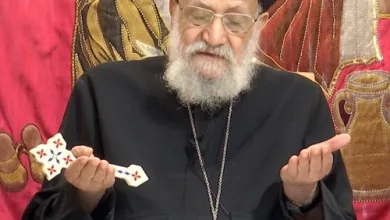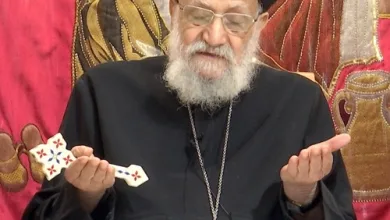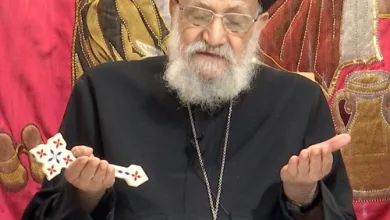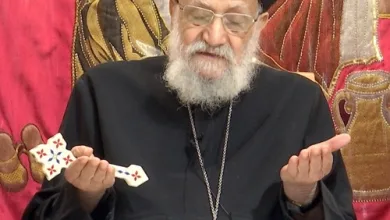تفسير رسالة تسالونيكي الأولى 5 الأصحاح الخامس – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تسالونيكي الأولى 5 الأصحاح الخامس - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة تسالونيكي الأولى 5 الأصحاح الخامس – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة تسالونيكي الأولى 5 الأصحاح الخامس – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الخامس
وصايا ختامية
يختتم الرسول بولس رسالته بوصايا عملية وذلك كعادته في كل رسائله، فيتحدث هنا عن:
- حياة السهر ١ – ١١.
- محبة الرعاة ١٢ – ١٣.
- وصايا أخرى ١٤ – ٢٢.
- ختام الرسالة ٢٣ – ٢٨.
١. حياة السهر
إذ يكتب الرسول إلى الكنيسة المتألمة المترقبة بصبر سرعة مجيء الرب، يطالبهم بالسهر الدائم مبرزًا النقاط التالية:
أولاً: أن يوم الرب لا يأتي بمراقبة، إذ لا يعلم أحد اليوم ولا الساعة (مت ٢٤: ٢6)، وكما يقول الرسول: “وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها” [١]. إنه يردد كلمات السيد المسيح قبيل صعوده: “ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه“ (أع ١: ٧)، ليس لأن الله يريد أن يخفي عنا أسراره، وإنما في محبته يود أن يجعلنا في حالة سهرٍ دائمٍ ملتهبة قلوبنا بمجيئه، ومستعدين للدخول معه في العرس الأبدي[1].
وكما أن يوم مجيئه سرّ خاص بالله، يتحقق عندما يكمل المختارون، ليس لنا أن نعرف زمانه، هكذا أيضًا في حياتنا الروحية، يلزمنا أن نجاهد بالروح القدس الساكن فينا لنمارس الحياة الفاضلة في الرب، وبيقين شديد أنه يعمل فينا لنمونا الروحي، لكننا لا ننتظر عطاياه الروحية بمراقبة. في رجاء حقيقي يجاهد الإنسان متكئًا على صدر الرب، مطمئنًا لمحبة الله الذي يهب بسخاء ولا يعيِّر.
لكننا نترك له موعد العطاء، فهو يهب ما لمجد اسمه وما لبنيان الكنيسة ولخلاصنا، ويحدد الموعد المناسب، ويعطي قدر ما يرى هو، كما ننتظر بشوقٍ مجيء الرب دون معرفة الأزمنة, نفتح قلوبنا بشوق لنعمه الروحية الغنية دون تحديد أزمنة. وما أريد أن أوضحه أن الله لا يبخل علينا، لكنه لهدفٍ معينٍ قد يتأخر في الاستجابة، كأن يعلمنا حياة المثابرة أو يدربنا على الصلاة بلجاجة، أو ليزكي إيماننا فيه، أو لكي لا نستخف بالعطايا الإلهية. فالتأخير في العطاء في الحقيقة هو جانب من جوانب رعاية الله الفائقة لفكرنا.
ثانيًا: يأتي هذا اليوم بالنسبة لغير المستعدين كلصٍ في الليل، في لحظة لا يتوقعونها أو كالمخاض للحبلى، إذ يقول: “لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب يأتي كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة، كالمخاض للحبلى فلا ينجون” [2-3]. إنه يوم ظلمة وقتام لغير المستعدين، فيكون كمن ينام ظانًا أنه في سلام وأمان، فيسطو عليه اليوم فجأة كلصٍ ينهبه، أو يكون كالحبلى غير المستعدة للمخاض فيفاجئها وتهلك. وكما يقوم عاموس النبي: “ويل للذين يشتهون يوم الرب، لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور؟“ (عا ٥: ١٨).
يرى القديس أغسطينوس أن عنصر المفاجأة يتحقق بالنسبة لغير المستعدين إما بمجيء الرب لإدانتهم أو انتقالهم، إذ يقول: [لتسهروا بالليل حتى لا تفاجئوا باللص، فإن نوم الموت قادم، إن أردتم أو لم تريدوا[2].]
ثالثًا: إن كان يوم الرب بالنسبة لغير المستعدين ظلامًا، فإنه بالنسبة للمؤمنين الساهرين يوم عرس مفرح ومنير، يقول الرسول: “وأما أنتم أيها الأخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. لسنا من ليل ولا من ظلمة، فلا ننم إذًا كالباقين، بل لنسهر ونصحُ. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون” [٤–٧].
لقد كنا قبلاً أبناء ليل وأبناء ظلمة كاللصوص والزناة الذين يترقبون الليل ليمارسوا نشاطهم الشرير، ويرتكبوا أعمال الظلمة من لصوصية وزنى .. وكما يقول القديس أغسطينوس: [من هم أبناء الليل؟ وأبناء الظلمة؟ أولئك الذين يرتكبون الشرور. إنهم أبناء ليل، إذ يخافون لئلا تُنظر الأمور التي يفعلونها… ليس أحد يعمل في الفجر (مع بدء النهار) إلاَّ الذي يعمل في المسيح![3]]
كنا قبلاً نسلك في الليل كمن في حالة نوم، يأتينا يوم الرب كلص، أو كالمخاض للحبلى غير المستعدة، أما الآن فإذ قبلنا شمس البرّ فينا، دخلنا إلى النور، وصرنا أبناء نور وأبناء نهار، نترقب مجيئه بفرحٍ، بقلبٍ متيقظٍ.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [كيف يمكن أن يوجد أبناء للنهار؟ ويجيب: يقال ابن الهلاك وابن جهنم أي الذين يعملون أعمالاً تناسب جهنم، إذ يقول المسيح للفريسيين: “ويل لكم لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلاً واحدًا ومتى حصل تصنعونه ابنًا لجهنم“ (مت ٢٣: ١٥). وأيضًا يقول بولس: “الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية“ (كو ٣: 6)، أي الذين يعملون أعمال المعصية. هكذا أيضًا أبناء الله هم الذين يعملون الأمور التي ترضي الله، وأبناء النهار وأبناء النور هم الذين يعملون أعمال النور[4].]
رابعًا: يلتزم أبناء النهار وأبناء النور بالسهر، لا بمعنى الامتناع عن النوم الطبيعي، وإنما دوام يقظة النفس الداخلية، فلا يكون لها ليل قط تسترضي فيه بل كما يأمرنا الرسول “لنسهر ونصح” تكون حياتنا كلها نهارًا وكلها نورًا. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أنه بالنسبة للجسد يوجد ليل ونهار بغير إرادتنا، فيلتزم الجسد بالنوم وقتًا ما، أما بالنسبة للنفس ففي سلطاننا أن يكون لنا نهار أو ليل، فإنه إذ نغمض أعيننا الداخلية ونفقد بصيرتنا الروحية ونسترخي تنام النفس. أما النفس اليقظة، فتقول: “أنا نائمة وقلبي مستيقظ“ (نش 5: 2)، حتى وإن نام الجسد وبدت الحواس مسترخية، فإن القلب لا يعرف الليل ولا الظلمة ولا الاسترخاء!
هذا ولا تنكر أهمية سهر الجسد أيضًا فيما هو لبنيان الروح، في الصلاة أو التسبيح أو دراسة الكتاب المقدس أو خدمة المرضى الخ .. يقول القديس يوحنا الدرجي: [العين الساهرة تجعل العقل نقيًا، وأما النوم الكثير فيقيد الروح، النوم الكثير يولد النسيان أما السهر فينقي الذاكرة[5].]
خامسًا: يقول الرسول: “لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون” [٧]. فالنفس لا تنم إلاَّ إذا قبلت أن يكون لها ليل وظلمة، حينئذ تسترخي. وأيضًا لا تسكر إلا إذا قبلت أن تشرب خمر الشر الذي يجعلها مترنحة، فتفقد كل اتزانها، ويضيع الهدف من أمام عينيها. النفس التي تشتهي غنى العالم، وتجري وراء المجد الباطل، وتسعى وراء الشهوات والملذات الجسدية تعيش كما في ليلٍ وظلمةٍ وكمن يشرب خمرًا، بل وتكون كمن هو في حلمٍ، فتستيقظ يومًا على أثر ندائها لتخرج من الجسد، فلا تجد شيئًا من كل ما كانت تسعى وراءه. لقد عاشت في حالة نومٍ وسكرٍ حين كانت في الجسد تسترخي وتترنح بخمر محبة العالم، فلا تطلب ما هو بحق ليبقى لها رصيدًا في أبديتها.
سادسًا: يقول الرسول: “وأما نحن الذين من نهار فلنصح، لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص“ [9]. إن كنا قد قبلنا ألاَّ يكون لنا ليل ولا ظلمة، فنحيا في النهار صاحين، نتقدم لله كجنودٍ روحيين نحتمي بدرع الإيمان والمحبة وخوذة الرجاء، هذه الأمور الثلاثة “الإيمان والمحبة والرجاء” هي أدوات الحرب الروحية التي اختبرها أهل تسالونيكي كما جاء في مقدمة الرسالة: “متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم” (1: 3).
مادمنا أبناء النور لن يقدر الشيطان “رئيس الظلمة” أن يتوقف عن تصويب سهامه النارية ضدنا. لهذا يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [ليلتف الإيمان والحب حول نفسك (كدرعٍ) فلا يقدر أي سهم ناري للشيطان أن يخترقه[6].]
يقول الأب سيرنيوس:
[الإيمان هو الذي يوقف سهام الشهوة الشريرة ويهلكها بالخوف من الدينونة العتيدة والإيمان بملكوت السماوات… والمحبة في الواقع هي التي تحيط المناطق الحيوية للصدر، فتحميه من التعرض لجراحات الأفكار المتزايدة المهلكة، وتحفظه من الضربات الموجهة ضده، ولا تسمح لسهام الشرير أن تتعمق إلى الإنسان الداخلي لأن “المحبة تحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء” (١ كو ١٣: ٧)… وخوذه رجاء الخلاص هي التي تحمي الرأس.
فالمسيح هو رأسنا، لذلك ينبغي علينا في التجارب أن نحمي رأسنا برجاء الأمور الصالحة العتيدة، وعلى وجه الخصوص أن نحفظ الإيمان كاملاً وطاهرًا. فمتى فقد إنسان جزء من جسده، يمكنه أن يعيش مهما كان هزيلاً، لكنه لا يستطيع أن يحيا ولا لفترة قصيرة بدون الرأس[7].]
لقد رتب الرسول أسلحة الروح هكذا: الإيمان فالمحبة ثم الرجاء. مع أنه في مواضع أخرى يرتبها هكذا: الإيمان فالرجاء ثم المحبة، لأن الإيمان هو سرّ لقائنا بالله والتمتع بالشركة معه في ابنه، والرجاء هو الذي يهبنا الفرح خلال اليقين الشديد أننا مدعوون للميراث الأبدي. فإن كان الإيمان يفتح بصيرتنا لندرك أسرار محبة الله، فإن الرجاء هو الذي يدفعنا لقبول هذه الأسرار بغير يأس. أما المحبة فهي ثوب العرس الأبدي، والنصيب الذي يبقى معنا في السماوات، لأن “المحبة لا تسقط أبدًا“.
فسينتهي الإيمان برؤيتنا لله وأسراره، والرجاء بتمتعنا العملي بالميراث، أما المحبة فلا تزول بل تبقى سرّ أبديتنا كلغة التفاهم في السماوات. أما هنا فإذ يتحدث إلى أهل تسالونيكي وهم في ضيقة مرّة مع الرسول المتألم لذلك ترك الحديث عن الرجاء بعد الإيمان والمحبة، لتأكيد حاجتهم إلى الصبر الدائم بغير يأس، حتى يكملوا طريق الآلام مترقبين بفرح مجيء الرب الأخير والتمتع بالأمجاد الأبدية.
أما سر قوتنا في جهادنا الروحي، فهو اختيار الله لنا وبذله ابنه الوحيد فدية عنا وخلاصًا لنفوسنا، إذ يقول الرسول: “لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح، الذي مات لأجلنا” [٩- ١٠]. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لا تيأس يا إنسان من جهة ذهابك إلى الله، فإنه لم يبخل عليك بابنه. لا تضعف أمام الشرور الحاضرة.
لقد قدم الله ابنه الوحيد ليخلصك وينقذك من جهنم، فأي شيء لا يقدمه لخلاصك؟ هكذا يليق بنا أن نترجى كل شيء بحنوٍ. فلا تخف لأننا ذاهبون إلى الديان ليحكم علينا، فإنه هو بنفسه الذي أظهر لنا حبًا عظيمًا مقدمًا ابنه ذبيحةً عنا. إذن فلنترجَ نوال أمور عظيمة ونبيلة ما دمنا قد نلنا الأساسيات، ولنؤمن إذ رأينا مثالاً أمامنا، ولنحب لأنه أي جنون ينسب لمن لا يحب من عوامل هكذا؟[8]]
إن كانت أسلحتنا الروحية هي الإيمان والمحبة والرجاء، فإننا خلال ذبيحة السيد المسيح ننعم بهذه الأسلحة، فنؤمن به كمخلص، وننهل من صليبه سرّ المحبة الإلهية المتدفقة، وخلاله نترجى التمتع بالأمجاد خلال هذه الذبيحة يمتليء المؤمن إيمانًا وحبًا ورجاء.
خلال هذه الذبيحة دخلنا في ملكية الله، فصرنا له، سواء كنا ساهرين في هذا العالم خلال حياة الجهاد المستمر أو نومنا أي رقادنا للراحة في الرب حتى تقوم أجسادنا من جديد. إذ يقول الرسول: “حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعًا معه“ [١٠]. وكما يقول: “لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله“ (١ كو ٦ :٢٠). ويقول القديس بطرس: “عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح“ (١ بط ١: ١٨-١٩).
بموت السيد المسيح صرنا في ملكية الله، له كل القلب موضعًا يستريح فيه، ولنا فيه موضعًا نستريح نحن فيه ومعه. بهذا صار لجهادنا على الأرض غاية واضحة هي الوجود مع الله. هذا هو سرّ تعزيتنا الحقيقية التي نسند بها إخوتنا، إذ يقول الرسول: “لذلك عزوا بعضكم بعضًا وابنوا أحدكم الآخر” [١١].
٢. محبة الرعاة
“ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم،
يدبرونكم في الرب وينذرونكم،
وأن تعتبروهم كثيرًا جدًا في المحبة من أجل عملهم” [١٢-١٣].
بعد أن حثهم على حياة السهر الروحي والجهاد، منتظرين مجيء الرب في صبرٍ بدأ يسألهم تكريم آبائهم الروحيين ومدبريهم الساهرين عليهم، طالبًا منهم أن يعتبرونهم كثيرًا جدًا في المحبة. ولعل السبب في هذا أن بعض المغرضين حاولوا تشويه صورة الرسول بولس عند الكنيسة في تسالونيكي إذ لم يحضر إليهم وسط ضيقتهم، مكتفيًا بإرسال تلميذه وشريكه في الخدمة الرسولية تيموثاوس. لقد سبق فرأينا كيف كشف الرسول عن أبوته لهم وحنانه نحوهم ومشاركته آلامهم. والآن لا يطلب لنفسه هذه الكرامة، وإنما يسألهم الحب لجميع من يخدمونهم روحيًا.
إذ طهر السيد المسيح أبرصًا قال له: “اذهب أر نفسك للكاهن” (مت 8: 4) ويقول الرسول: “أما الشيوخ المدبرون حسنًا فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم“ (١ تي ٥: ١٧). ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على عبارات الرسول في هذا الأصحاح، قائلاً: [من يحب المسيح يحب الكاهن – أيًا كان – فمن خلاله ينعم بالأسرار الشرعية… أما تحبه كثيرًا كعينيك؟ أما تقبله؟ إنه يفتح لك السماء، أفما تقبله وتكرمه؟ إن كانت لك زوجة فلتحبه بالأكثر، لأنه قدمها لك. إن كنت تحب المسيح إن كنت تحب ملكوت السماوات فاعرف أنك تقتني هذا خلاله[9].]
الكرامة التي نقدمها للكاهن، أو الحب الذي نظهره له، إنما يُعلن خلال طاعتنا لكلمة الله، وقبولنا لحياة الشركة مع الله، فإنه ليس شيء يبهج قلب الخادم ويشبع نفسه مثل أن يرى أولاده في أحضان الله. فالكاهن ليس في حاجة إلى كلمات مديح، ولا يسر بالمحبة العاطفية قدر ما يفرح بخلاص أولاده. تكريمنا له يتحقق بمساندته في رسالته خلال نمونا الروحي، وعملنا في كرم الرب لحساب ملكوت السماوات. هذا ما لمسناه بوضوح في دراستنا للقديس يوحنا ذهبي الفم إذ يصرخ لشعبه طالبًا أن يبسطوا أيديهم ويترفقوا به كمن هو في خطر، وذلك خلال التوبة الصادقة والعمل في كرم الرب[10].
يقول الرسول: “وأن تعتبروهم كثيرًا جدًا في المحبة من أجل عملهم” [١٣]. عمل الراعي الحكيم يتركز في جهاده المستمر وسهره ويقظته على كل إنسان لكي يدخل به إلى التمتع بالحياة في المسيح يسوع بواسطة الروح القدس، الأمر الذي يعرضه كثيرًا لمضايقة حتى من يخدمهم لأجل توبتهم وخلاصهم بالرب. لهذا يوصي الرسول بحب الرعاة واضعين في قلوبنا جهادهم ومحبتهم التي تدفعهم لمثل هذه التصرفات التي قد تكون في نظرنا مؤلمة. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [هكذا كما يضطر الأطباء إلى مضايقة المرضى لكن المرضى يقبلون ذلك من أجل فائدتهم، وكما أن الآباء كثيرًا ما يضايقون أبناءهم، هكذا بالأكثر جدًا يفعل المعلمون ذلك.
يتضايق المرضى من الطبيب ومع هذا فغالبًا ما يدخلون معه في علاقة ود… ويمارس الأب سلطانه على ابنه بسهولة شديدة بحكم الطبيعة وخلال القوانين الوضعية، فيقوم بتأديب ابنه بغير إرادة الابن ومع ذلك فلا يجد ما يعوقه ولا يقدر الابن أن يرفع نظره إليه، أما الكاهن فإن فعل هكذا يجد صعوبة شديدة. فمن جهة الكاهن ملتزم بتدبير أمور شعب يطيعونه بإرادتهم (دون إلزام) ويشكرونه على تدبير أمورهم، وإن كان هذا لا يتحقق بسهولة، فإن دان الكاهن شخصًا ووبخه، فبالتأكيد لا يشكره الشخص، بل يتحول إلى عدوٍ، وهكذا إن قدم نصيحة أو نذر.
فإن قلت لكم انفقوا غناكم على المحتاجين أكون كمن يهاجمكم ومن هو ثقيل عليكم. وإن قلت لكم اكبحوا غضبكم، واطفئوا غيظكم، واضبطوا شهواتكم الشريرة، وتخلوا عن الترف، تحسبوا هذا أمرًا ثقيلاً وهجومًا ضدكم. فإن عاقبت إنسانًا كسولاً أو طردته من الكنيسة أو استبعدته عن الصلوات العامة يحزن لا لأنه سيحرم من هذه الأمور، وإنما لأنه يحسب في ذلك إهانة عامة قد لحقت به[11].]
هكذا يلتزم الكاهن أحيانًا في محبته الأبوية أن يكون حازمًا، الأمر الذي يعرضه لمضايقة الناس منه، فلا تُقابل أبوته بالحب بل بالبغضة، لهذا يقول الرسول: “وأن تعتبروهم كثيرًا في المحبة من أجل عملهم”.
٣ . وصايا أخرى
ختم الرسول رسالته بوصايا قصيرة مترابطة معًا، وهي:
أولاً: “انذروا الذين بلا ترتيب”: ماذا يعني بالترتيب؟ في اليونانية تعني “طقس” أو “نظام”، وهي لا تقف عند حدود التنظيمات الخارجية وإنما تحوي منهج الحياة، كأن نقول “طقس الملائكة” أي الحياة الملائكية في نقاوتها وتسابيحها وتفكيرها الخ. وهكذا عندما نقول “طقس الرهبنة” يعني الفكر الرهباني العميق بما يحمله من اتجاهات داخلية مع تدابير. فالمسيحي له طقسه الخاص به الذي هو “الحياة في المسيح”، فتكون له إرادة المسيح وفكر المسيح وسلوك المسيح في عبادته الشخصية والعائلية والجماعية وحياته اليومية كما في حياته الخفية الداخلية.
يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: [من هم الذين بلا ترتيب؟ الذين يعملون ما يضاد إرادة الله… الإنسان الشتام يسلك بلا ترتيب، والسكير أيضًا، وكل الذين يخطئون. هؤلاء يسلكون بلا ترتيب يليق برتبتهم، إذ ينحرفون عنه، لهذا يطرحون خارجًا[12].]
الحياة المسيحية هي طقس متكامل، يحمل جوانب عديدة تعبدية وسلوكية، فكل من ينحرف عن العقيدة أو الترتيب التعبدي الكنسي أو السلوكي إنما يسلك بلا ترتيب.
ثانيًا: “شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع” [١4]. كأن الرسول يعلن لهم أن إنذار من هم بلا ترتيب يلزم أن يكون بحنوٍ وترفقٍ، حتى لا يسقط صغار النفوس ولا يتحطم الضعفاء. بمعنى آخر إذ ننذر الذين بلا ترتيب إنما نفعل هذا بكل أناة. فإن كان خدام الكنيسة ملتزمين أن ينذروا من هم بلا ترتيب، لكن الأساس في هذا العمل هو الحب المترجم عمليًا خلال طول الأناة، وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [ليس دواء يعادل هذا (طول الأناة) يناسب المعلم، ولا ما يناسب من هم تحت التدبير مثله[13].]
ماذا يقصد الرسول بصغار النفوس؟ إنهم الذين لا يحتملون الإهانة، فتصغر نفوسهم جدًا، ويتعرضون لليأس، مثل هؤلاء يلزم أن نستخدم معهم أسلوب التشجيع، فنترفق بهم حتى عند انتهارهم، فالانتهار ليس غاية في ذاته، ولا واجب يلتزم به المدبر، وإنما هو وسيلة للبنيان، فإن حطم نفسًا صغيرة تطلب هذه النفس من المدبر.
يجد الراعي بين شعبه من هم “ضعفاء” في الإيمان، فلا يحتقرهم بل يترفق بهم ويسندهم حتى يمتلئوا قوة، متشبهًا بالسيد المسيح نفسه الذي قيل عنه “قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفيء“.
أخيرًا يقول “تأنوا على الجميع“، فإن كل نفس، مهما بلغ سموها الروحي، تحتاج إلى طول الأناة.
ما أعذب الكلمات التي نطق بها القديس أمبروسيوس: [يا رب هب لي أن تكون سقطات كل إنسان أمامي، حتى احتملها معه، ولا أنتهره في كبرياء بل أحزن وأبكي. في بكائي من أجل الآخرين، أبكي على نفسي قائلاً: هي (ثامار) أبر مني (تك ٣٨: ٢٦)[14]]. وكلمات القديس يوحنا الدرجي: [أيها الراعي النشيط اطلب الضال، واحمله على منكبيك بفرح، فتقدر على شفاء الأمراض المميتة المؤلمة، فالمحبة تعظم الجبابرة وهي موهبة الطبيب[15].]
في دراستنا للحب الرعوي رأينا أن عمل الكنيسة أن تحل لا أن تربط، وإن ربطت عند الضرورة القصوى، إنما لكي تحل. تترفق بالجميع في طول أناة، مهما ثقلت الخطايا، ولكن بغير مهادنة[16].
ثالثًا: “انظروا أن لا يجازي أحد أحدًا عن شرٍ بشرٍ” [١٥]. وكأن الرسول يعلن أن الحب لا يقف عند حدود مساندة الضعفاء والترفق بالخطاة، وإنما يلزم احتمال شر الأشرار بقلبٍ متسعٍ دون انتقام الإنسان لنفسه.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [تقول أن إنسانًا كهذا شرير قد أحزنني وسبب لي أضرارًا جسيمة. أتريد أن تنتقم لنفسك؟ لا تثأر لنفسك، بل أتركه ولا تنتقم. هل تقف عند هذا الحد؟ لا، “بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع” [١٥]. هذا هو علو الفلسفة أننا لا نقابل الشر بالشر، بل نقابله بالخير. فإن هذا بحق هو انتقام يسبب لنفسك نفعًا، ويمكن للآخر أيضًا أن ينتفع إن أراد[17].] بمقابلة الشر بالخير ينتفع صانع الخير ويتزكى أمام الله والناس، بينما يفقد الشرير الكثير أمام الجميع إن لم يتب. هذا ويؤكد الرسول أن هذا التصرف لا يكون فقط في تعاملنا مع الإخوة، وإنما مع الجميع حتى الذين يضايقوننا باطلاً، فإن النار لا تُطفأ بالنار بل بالماء.
رابعًا: “افرحوا كل حين” [١٦]. إذ يتسع القلب بالحب للجميع حتى للأشرار ترتدي النفس ثوب العرس المفرح وتُحسب أهلاً للحياة السماوية فتنعم بالفرح كعطية سماوية حتى وسط الآلام، فلا يقدر الغم أن يتسرب إليها تحت أي ظرف، وإن تسرب لا يقدر أن يستقر فيها. حقًا إن الفرح الدائم وإن كان وصية إنجيلية لكنه في نفس الوقت هو عطية الروح القدس (غل ٥: ٢٢) يوهب للنفس خلال إتحادها بالله الآب في ربنا يسوع المسيح.
لذلك يقول القديس غريغوريوس صانع العجائب: [انظروا أيها الأعزاء المحبوبين كيف يهبنا الله في كل موضع وبطريقة متكاملة الفرح الدائم الفائق المعرفة[18].] ويقول القديس ديديموس الضرير: [لقد دعا الروح القدس الذي يرسله بالمعزي. ملقبًا إياه هكذا بسبب عمله، لأنه ليس فقط يريح من يجدهم مستحقين ويخلصهم من كل غم واضطراب في النفس، بل في نفس الوقت يمنحهم فرحًا أكيدًا لا ينحل، فيسكن في قلوبهم فرح أبدي حيث يقطن الروح القدس[19].]
خامسًا: “صلوا بلا انقطاع” [١٧]. ربما يتساءل البعض: كيف نتمم الوصايا السابقة أو كيف ننعم بالمواعيد السابقة من حبٍ بلا حدود، وفرح في كل حين؟ يجيب الرسول بوصية جديدة هي سرّ العطايا الإلهية: “صلوا بلا انقطاع. اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم” [١٧-١٨]. ما أحوجنا إلى الصلاة الدائمة، إنها عمل الملائكة خاصة التشكرات في كل شيء. بهذا تتحقق غاية الله فينا في المسيح حياتنا حيث تصير لنا الحياة السماوية معلنة في داخلنا كما في تصرفاتنا.
ماذا تعني الصلاة الدائمة؟
أ. إن كانت الصلاة تعني “الصلة”، فإن الصلاة الدائمة تعني العلاقة المستمرة مع الله وإدراك وجودنا في الحضرة الإلهية بلا انقطاع، في عبادتنا كما في أثناء عملنا، وفي يقظتنا كما في أثناء نومنا. يقول القديس چيروم: [كان العبرانيون مطالبين أن يظهروا أمام الرب ثلاث مرات في السنة (خر ٢٣: ١٧)… إذ كان الكتاب المقدس يتحدث في سفر الخروج إلى أناس صغار (في القامة الروحية)، أما هنا فيحث النبي (الرسول) المؤمنين بالله أن يطلبوه على الدوام، إذ يأمرنا العهد الجديد بالصلاة بلا انقطاع[20].]
ب. الصلاة الدائمة في ذهن القديس هيلاري أسقف پواتييه هي تخطي حدود الجسد ومطالبه التي تربطنا على الدوام لنهتم بالأكثر بالروحيات، إذ يقول: [إننا ملتزمون أن نستخف بمطالب الجسد وأن نستمر في الصلاة بلا عائق[21].]
لا يعني هذا تجاهل الجسد واحتقاره, وإنما لأننا قد أُسرنا باحتياجاته بطريقة مبالغ فيها يلزمنا أن نتحرر من هذه العبودية لنحيا روحيًا فنعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله, فيما نهتم باحتياجات الجسد دون استعباد له نهتم بالروح بلا انقطاع!
كيف نمارس الصلاة الدائمة؟
يقول القديس أغسطينوس: [هل بقوله: صلوا بلا انقطاع يعني أننا نحني ركبنا ونطرح أجسادنا أو نبسط أيدينا بلا انقطاع؟ لو كانت الصلاة تعني هذا فإنني أظن أننا لا نقدر على الصلاة بلا انقطاع. وإنما يوجد نوع آخر داخلي للصلاة بلا انقطاع، وهي رغبة القلب إلى أمر يعمله… فإن كنت مشتاقًا إلى السبت (الراحة الأبدية) فأنت لا تكف عن الصلاة. إن أردت ألاَّ تمتنع عن الصلاة، فلا تكف عن الشوق إليها، فإن استمرار الاشتياق إنما هو استمرار للصلاة[22].]
فالصلاة الدائمة إنما هي التهاب القلب المستمر بل والمتزايد، في حنين لا ينقطع نحو الحياة الأبدية أو السكنى مع الله وفيه إلى الأبد. هذا الحنين يلتهب كلما خلع الإنسان عنه ثوب الدنس وارتدى بالروح القدس الناري الحياة المقدسة، منطلقًا من حياة الخطية المثقلة للنفس إلى الحياة الفاضلة في الرب التي تسحب الفكر والقلب وكل الأحاسيس نحو الإلهيات. وكما يقول الأب إسحق: [لا نقدر أن ننفذ هذه الوصية (الصلاة بلا انقطاع) ما لم يتنقَ عقلنا من كل وصمات الخطية إلى الفضيلة حتى يكون صلاحه طبيعيًا، ويتغذى على التأمل المستمر في الإله القدير[23].]
هذه الصلاة المستمرة تسندها الصلوات اليومية للسواعي، وكما يقول القديس چيروم: [إن كان الرسول يأمرنا أن نصلي بلا انقطاع، وإن كان حتى النوم ذاته يُحسب توسلاً بالنسبة للقديسين، يلزمنا أن نحدد ساعات للصلاة، حتى إذا ما أعاقنا العمل يذكرنا الموعد نفسه بالتزامنا. الصلاة، كما يعرف الجميع، يلزم أن تمارس في الثالثة والسادسة والتاسعة وفي الفجر والغروب. لا تبدأ وجبة طعام بدون صلاة، وقبل ترك المائدة يلزم تقديم الشكر للخالق. يلزمنا أن نقوم في الليل مرة ومرتين ونراجع أجزاء من الكتاب المقدس التي نحفظها عن ظهر قلب. عندما نترك السقف الذي ننام تحته لتكن الصلاة هي سلاحنا، وعندما نعود من الشارع فلنصل قبل أن نجلس، ولا نعطي للجسد الهزيل راحة حتى تتقوت النفس[24].]
سادسًا: “اشكروا في كل شيء” [١٨]. قلنا أن الشكر في كل شيء هو سمة خاصة بالسمائيين، الذين إذ يدركوا الله كلي الحكمة والحب يشكرونه من أجل صلاحه وتدبيراته الصالحة. بهذا فإن المؤمن لا يقدر أن يشكر في كل شيء بلسانه ما لم يحمل، خلال المعمودية، الطبيعة الجديدة السماوية والمستنيرة، فيلهج قلبه بتسبحة شكر لا ينقطع. يشعر أنه مدين لأبيه السماوي بكل حياته، مدركًا أبوة الله له ورعايته الفائقة، فتصرخ أعماقه بتسابيح الحمد الخفية، وينفتح لسان إنسانه الداخلي بالترنم كما فعل الأطفال والرضع عند دخول السيد أورشليم.
سابعًا: “لا تطفئوا الروح” [١٩]. لقد شغلت هذه العبارة آباء الكنيسة، وقد سبق لي عرض آراء بعض آباء الكنيسة فيها في كتاب “الروح القدس بين الميلاد الجديد والتجديد المستمر[25].
الله الذي يهبنا روحه القدوس عطية مجانية ليعمل فينا بلا انقطاع يحذرنا على فم رسوله من أن نطفىء الروح، أي نوقف عمل استنارته فينا خلال مقاومتنا له. حقًا إن الروح لن يفارقنا قط مهما أخطأنا، لكنه يحزن علينا، وينطفيء عمله فينا خلال عدم تجاوبنا معه. يشبه القديس يوحنا الذهبي الفم عطية الروح القدس بمصباح أو سراج منير داخل البيت، فإن فتح إنسان بابين متقابلين دخل تيار الهواء بشدة وأطفأه. لهذا يقول [إن فتح إنسان باب فمه بكلمة إهانة ضدك فلا تفتح أنت بابك بإهانة مماثلة، فترد السب بالسب، لئلا يدخل في نفسك تيار هواء الحقد ويطفيء لهيب الروح المشتعل في داخلك! ليفتح الشرير بابه أمامك لكنك في حكمة إذ تترك بابك مغلقًا تبقي عطية الروح ملتهبة في الداخل[26].]
أما زيت هذا السراج فهو أعمال الحب، فإن الروح القدس الناري يبقى عمله ملتهبًا فينا مادامت أحشاؤنا تتجاوب معه بالحب لله والناس، أما إذا أغلقنا أحشاءنا تجاه الله والناس فإننا نفقد زيت الحب الذي ينير فينا. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن اللصوص عند سلبهم بيتًا ما، فإنهم إذ يدخلونه يطفئون السراج الذي فيه حتى يقدروا أن يحققوا غايتهم، وهكذا فإن عمل الشيطان الرئيسي عند إقتحامه قلب مؤمن هو تحطيم عمل الروح فيه حتى يسلبه كل حياته.
ثامنًا: “لا تحتقروا النبوات“[20]. كما تهتم الكنيسة أن يبقى عمل الروح القدس الناري دائم الالتهاب داخلنا، هكذا تهتم أيضًا أن يبقى ملتهبًا خلال منبرها، فلا يقف إنسان ليتكلم بنبوة (عظة) بغير اكتراث. بمعنى آخر، يلزمنا ألاَّ نحتقر عمل الروح فينا لئلا ينطفيء، ولا نحتقره في كلمة الوعظ بل تكون كجمرة نار متقدة يمسكها الكاهن كما بملقط وكأنه بشاروبيم يقدمها في قلوب أولاده الروحيين حتى يلتهبوا هم أيضًا بالنار الإلهية المقدسة ولا ينطفيء فيهم الروح.
حقًا ما أحوج الكنيسة إلى كهنة ملتهبين نارًا كالشاروبيم، يقدمون كلمة الله كجمرة نار قادرة على العمل في قلوب الناس.
تاسعًا: روح التمييز: “امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر” [٢١-٢٢]. إن كان يليق بالخادم ألاَّ يحتقر المنبر بل يقدم خلال حياته الملتهبة كلمة الله كنارٍ متقدة، فإنه يلزم للشعب أيضًا أن يحمل روح التمييز (١ كو ١٢: ١٠) فيقبل كلمة الله الصادقة ويرفض اللبن الغاش. بهذا الروح يقدر المؤمن أيضًا أن يفرز الفكر الذي يخطر به، فيقبل فكر الله ويرفض الفكر الشرير وما هو شبه شرير كالأفكار الباطلة التي وإن كانت ليست شرًا لكنها مفسدة للوقت ومضيعة للطاقة.
4. ختام الرسالة
يختم الرسول رسالته بالبركة الرسولية أو تقديم صلاة عنهم، إذ يقول: “وإله السلام يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم، عند مجيء ربنا يسوع المسيح” [٢٣].
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لاحظ حب المعلم، فإنه يصلي بعد أن ينصح، بل يضيف الصلاة إلى رسالته، فإننا في حاجة إليها كما إلى المشورة. لهذا السبب نقدم لكم نحن أيضًا المشورة وبعد ذلك نرفع عنكم الصلوات[27].]
ما هي طلبتنا ككهنة من أجل شعب الله إلاَّ أن يقدسهم إله السلام ويحفظ روحهم ونفسهم وجسدهم بلا لوم، فيأتي ليجد كل ما لهم قد تقدس له، وتهيأ لملاقاته، فيشترك معه في المجد. أننا نصلي إلى الثالوث القدوس، الله الواحد، ملك السلام، ليهب التقديس، وكما يقول القديس أمبروسيوس: [كما أن الآب يقدس هكذا أيضًا الابن والروح القدس[28].]
التقديس هو من عمل الثالوث القدوس، وإن كان يُنسب على وجه الخصوص للروح القدس، لأنه هو الذي يهب حياه الشركة والاتحاد مع الله في ابنه، مقدمًا لنا هذا العمل كسرّ غفران خطايانا وتقديس حياتنا الروحية والجسدية، وذلك في استحقاقات الابن الوحيد الذي قدم دمه ثمنًا لتقديسنا، منطلقًا بنا إلى الآب القدوس لنستقر في أحضانه المقدسة. فالروح القدس هو روح القداسة وواهبها، والابن هو الذي دفع الثمن، والآب هو الذي يريد تقديسنا، مرسلاً ابنه الحبيب إلينا بغية هذا الهدف.
لهذا ينسب الكتاب عمل التقديس للآب كقول السيد المسيح نفسه: “قدسهم في حقك، كلامك هو حق” (يو ١٧: ١٧)، كما ينسهب للابن كقول الرسول: “ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرًا وقداسةً وفداءً” (١ كو ١: ٣٠)، وينسب الروح القدس: “الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس للروح وتصديق الحق” (٢ تس 2: 13).
غاية الرسول من كرازته ورعايته وصلواته أن يرى شعب الله مقدسين في الحق، لتتحقق فيهم طلبة السيد المسيح نفسه في صلاته الوداعية: “قدسهم في حقك … لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضًا مقدسين في الحق” (يو ١٧: ١٩). هذا التقديس يمس حياة المؤمنين “روحهم ونفسهم وجسدهم”، كقول الرسول: “لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح” [٢٣]. ويعلق القديس ايريناؤس: [ماذا كان هدفه من الصلاة؟ أن يحفظ هؤلاء الثلاثة، النفس والجسد والروح، إلى مجيء الرب، فقد أدرك الرسول الحاجة إلى إعادة تكامل الإنسان، الأمر الذي يتحقق في الحياة العتيدة. فيتم إتحاد الثلاثة معًا ليرثوا معًا خلاصًا واحدًا بعينه[29].]
“الحياة المقدسة” ليست هدفًا لصلاة الرسول فحسب، وإنما غاية دعوة الله نفسه لنا، لذلك يقدم كل إمكانياته الإلهية لتحقيق دعوته لنا، إذ يقول: “أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضًا“ [٢٤]. ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة، قائلاً: [تطلع إلى تواضعه! لا تظن أن هذه (القداسة) تتحقق لهم بسبب صلاته عنهم وإنما بسبب دعوة الله لهم إليها. لقد دعاهم للخلاص، وهو صادق فسيخلصهم بالتأكيد، لأن هذه هي إرادته[30].]
بعد أن صلى من أجلهم طالبهم بالصلاة من أجله، مقدمًا نفسه مثالاً حيًا للخادم الحي الذي يعرف رسالته وغايته، فعمله الرئيسي هو الصلاة عن الآخرين كقول النبي صموئيل: “وأما أنا فحاشا لي أن أخطيء إلى الرب، فأكف عن الصلاة من أجلكم بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم” (١ صم ١٢: ٢٣)، وفي نفس الوقت يطلب صلوات شعبه من أجله مدركًا حاجته إلى مساندتهم خلال الصلاة.
أخيرًا يقول الرسول: “سلموا على الإخوة جميعًا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تُقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين” [٢٦– ٢٨].
إذ هو غائب عنهم بالجسد يود أن يقّبلهم بقبلات مقدسة في الرب، وإذ لا يستطيع أن يحقق ذلك يطلب منهم أن يقبلوا الإخوة نيابة عنه. هكذا يلتهب في قلبه نار الحب الروحي! أما طلبه أن تُقرأ الرسالة على جميع الإخوة فيحمل أيضًا علامة حبه للجميع، مشتهيًا أن يتحدث معهم ولو بالرسالة.
أخيرًا، يختم الرسالة بطلب نعمة ربنا يسوع المسيح تسندهم في ضيقهم في الحياة الفاضلة، وتحقق إرادة الله فيهم.
[1] يرى الآباء في كلمات السيد المسيح والرسول بولس ما يمنعنا من البحث عن معرفة الأزمنة، فيقول القديس أغسطينوس: [هذه العبارة تكفي بوضوح أنه ليس لإنسان أن يدعى لنفسه معرفة ذلك الزمان بأي تخمين] (تفسير المزامير 6: 1).
[2] Sermons on the N. T., hom 43: 8.
[3] On Ps. 63: 13.
[4] In 1. Thess, hom. 9.
[5] Ladder of Heaven 29: 3, 9
[6] In 1. Thess, hom 9
[7] مناظرات كاسيان 7: 5.
[8] In 1. Thess, hom., 9.
[9] In 1 Thess, hom 10.
[10] للمؤلف: القديس يوحنا ذهبي الفم، 1979؛ الحب الرعوي 1965، ص 74-82.
[11] In 1. Thess, hom., 10.
[12] In 1. Thess, hom., 10.
[13] In 1. Thess, hom., 10.
[14] الحب الرعوي، 1966، ص 592.
[15] الحب الرعوي، 1966، ص 594.
[16] الحب الرعوي، 1966، ص 570-601.
[17] In 1. Thess, hom., 10.
[18] Hom 2 On Annunciation to the Holy virgin Marry.
[19] الحب الرعوي، 1966، ص 946.
[20] On Ps. 31.
[21] On Ps. 1: 12.
[22] On Ps. 38: 13.
[23] مناظرات كاسيان 9: 3.
[24] Ep. 22: 37.
[25] الروح القدس بين الميلاد الجديد والتجديد المستمر، 1981.
[26] In 1. Thess., hom. 11.
[27] In 1. Thess., hom. 11.
[28] Of the Holy Spirit 3: 4.
[29] Adv. Haer 5: 6: 1.
[30] In 1. Thess., hom. 11.