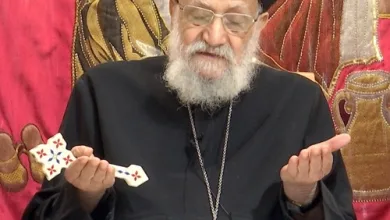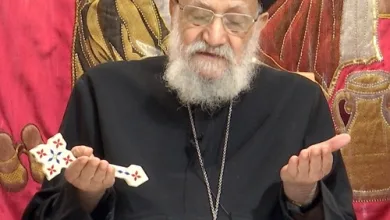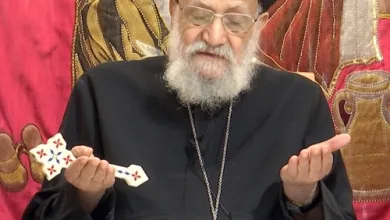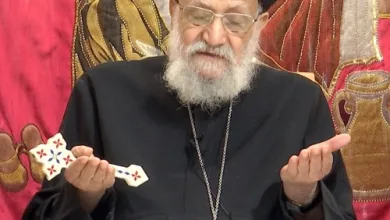تفسير رسالة يوحنا الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة يوحنا الأولى 2 الأصحاح الثاني - القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير رسالة يوحنا الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير رسالة يوحنا الأولى 2 الأصحاح الثاني – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثاني
الحب
يدور هذا الأصحاح حول موضوع الحب:
- حب المسيح لنا ١-٢.
- حبنا له بحفظنا وصاياه التي تتركز حول المحبة الأخوية 3-11.
- حبنا للَّه
أ. إمكانياتنا كأبناء محبين ١٢-١٤.
ب. رفضنا محبة العالم ١٥–١7.
ج. رفضنا للبدع المنشقة على اللَّه وكنيسته ١٨-٢٣.
د. ثباتنا في اللَّه ٢٤-٢٧.
- محبو اللَّه وبنوتهم له
أ. ينتظرون مجيئه ٢٨.
ب. يصنعون البرّ ٢٩.
- حب المسيح لنا
“يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا.
وإن أخطأ أحد فلنا شفيع Paraclete عند الآب يسوع المسيح البار.
وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم” [1-2].
يبدأ الرسول حديثه بقوله: “يا أولادي“. إنه أب محب يكشف لأولاده الدافع لكتابته هذه الرسالة “لكي لا تخطئوا“، أي لكي نعيش حياة مقدسة تليق بنا كسالكين في النور. بمعنى آخر يجدر بنا ألا نستهتر بالخطية بسبب أمانة اللَّه وحبه لنا، إنما نسلك في النور مثابرين في كل عملٍ صالحٍ. لكن من يستطيع ألا يتعثر في هذه الحياة الزمنية لذلك “إن أخطأ أحد فلنا شفيع…” يقوم هذا الشفيع كمحامٍ يدافع عنا ليبرئنا في القضية. ومن هو هذا الشفيع؟
أ. شفيع Paraclete أو Advocate. يقول العلامة أوريجينوس [لقد دُعي مخلصنا أيضًا بالباراكليت وذلك في رسالة يوحنا عندما قال “فلنا شفيع Paraclete… وهذه الكلمة في اليونانية تحمل معنيين: وسيط ومعزي. فالباراكليت تًفهم بمعنى شفيع يتوسط عند الآب بالنسبة لمخلصنا. وتفهم بمعنى المعزي بالنسبة للروح القدس إذ يهب تعزية للنفوس التي يعلن لها بوضوح المعرفة الروحية[1].]
يقول القديس أغسطينوس:
[إنه الشفيع فلنحاول ألا نخطئ. وإن باغتتك الخطية من أجل دنس الحياة أنظر إليها في الحال واحزن والعنها. فإن فعلت هذا تأتي في حضرة الديان مطمئنًا لأنه شفيعك. وباعترافك لا تخف من أن تخسر القضية.
غالبا ما يوكل الإنسان محاميًا Advocate بليغًا… وها أنت قد أوكلت الكلمة، فهل تهلك؟!…
انظر فإن يوحنا الذي كان بالتأكيد إنسانًا بارًا وعظيمًا، هذا الذي تشرب الأسرار الإلهية من صدر الرب وارتوى منه فكتب عن لاهوته… لم يقل “لكم شفيع”، بل “لنا شفيعًا” ولم يقل “إني شفيعكم” ولا “المسيح شفيعكم”، بل “لنا شفيع”… لقد اختار بالأحرى أن يحصي نفسه في عداد الآثمة ليكون المسيح شفيعًا له…
لكن قد يقول قائل: أما يطلب القديسون عنا؟ أما يطلب الأساقفة والمدبرون عن الشعب؟
نعم! فلنتأمل الأسفار المقدسة لنشاهد المدبرين أنفسهم يوصون الشعب أن يصلوا من أجلهم، وهكذا يطلب الرسول من الكنيسة “مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضًا” (كو ٤ :٣). فالرسول يصلي من أجل الشعب، والشعب يصلي من أجل الرسول.
يا إخوتي… إننا نصلي من أجلكم، فهل تصلون أنتم أيضًا من أجلنا؟ ليُصلِ كل عضوٍ منا من أجل الخير. وليشفع الرأس المسيح من أجل الجميع[2].]
ب. عند الآب: هذا المحامي كلمة الآب وابنه، واحد معه في الجوهر، لا ينفصل عنه قط، لهذا تطمئن نفوسنا، متى طلبناه نجده في الحال مدافعًا في شفاعة دائمة. “إنه حي في كل حين ليشفع فينا” (عب 7: 25).
ج. يسوع، أي مخلص، محب للخطاة كي يقدسهم ويبررهم.
د. المسيح، أي ممسوح لأجل خلاصنا، هذه هي اشتياقاته “أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون”. فمن يشعر بخطاياه ويتوق للتطهير المستمر يجد شفيعًا دائم الشفاعة، وفي اللحظة التي فيها نشعر بأننا أبرار غير محتاجين للتطهير لا ننتفع من الخلاص الذي قدمه لنا.
ه. البار “تألم مرة واحدة من أجل الخطايا. البار من أجل الآثمة” (1 بط 3: 18). لو لم يكن بارًا فكيف يدافع عنا؟! لقد حمل أثقالنا عنا، وأوفى ديوننا. [السبح للغني الذي دفع عنا ما لم يقترضه، وكتب على نفسه صكًا وصار مدينًا! بحمله نيره كسر عنا قيود ذاك الذي أسرنا[3]!]
ز. كفارة: محامينا بار، وبره يقتضي إلاَ يبرئنا في القضية ظلمًا. إنه لا يدافع عنا في السماء في غير عدل، لكن دفع عنا ديننا. [أحشاء الآب أرسلته إلينا، فلم يرفع آثامنا إلى العظمة الإلهية، بل بصلاحه قدم له كفارة عنا[4]!]
يعتز المؤمن بنعمة الشفاعة التي يقدمها كلمة اللَّه نفسه لدى الآب عنه. هذه الشفاعة الكفارية لا يشاركه أحد فيها، حيث يقدم السيد المسيح دمه الكفاري، ويخفينا في جراحاته، فنظهر أمام الآب بلا لوم، حاملين برّ مخلصنا. يحملنا مسيحنا كأعضاء في جسده، فنصير موضع سرور الآب. هذه الشفاعة تختلف عن شفاعتنا نحن عن بعضنا البعض، حيث نتوسل للَّه خلال حبنا لإخوتنا، ليهبهم نعمة التوبة والبنيان المستمر والشهادة الحقيقية.
- لنا شفيع، يسوع المسيح، بالحقيقة لا ينبطح أمام الآب متضرعًا من أجلنا. فإن مثل هذه الفكرة خاصة بالرقيق وغير لائقة بالروح! إنه لا يليق بالآب أن يطلب ذلك، وأيضًا بالابن أن يخضع لها، ولا يحق لنا أن نفكر بمثل هذه الأمور بالنسبة للَّه. ولكن ما تألم به كإنسان، فإنه إذ هو الكلمة والمشير يطلب من اللَّه أن يطيل أناته علينا. أظن هذا هو معنى شفاعته[5].
القديس غريغوريوس النزينزي
- إنني افتخر لأنني أخلص، وليس لأنني بلا خطايا، بل لأن الخطايا قد غُفرت. إنني لا أفتخر لأني نافع أو لأن أحدًا ما نافع لي، وإنما لأن المسيح هو شفيعي (محامي) أمام الآب، لأن دم المسيح سفك من أجلي[6].
القديس أمبروسيوس
- إن كان لديك قضية معروضة أمام قاضٍ ويلزمك أن تقيم محاميًا، وقد قبل المحامي قضيتك، فإنه يشفع في قضيتك قدر استطاعته. فإن سمعت قبل المرافعة أنه هو الذي يحكم كم يكون فرحك أنه يكون القاضي ذاك الذي كان منذ محاميك[7].
القديس أغسطينوس
- عندما يقول يوحنا أن المسيح قد مات لأجل خطايا “كل العالم”، ما يعنيه أنه مات عن الكنيسة كلها[8].
هيلاري أسقف آرل
حبنا له بحفظنا وصاياه
التي تتركز حول المحبة الأخوية
“وبهذا نعرف أننا قد عرفناه، إن حفظنا وصاياه.
من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه، فهو كاذب وليس الحق فيه” [3-4].
من يحب يحفظ وصية محبوبه، يخضع له ويود أن ينفذ رغبته… “إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي” (يو 14: 15). أما من يستصعب الوصية ويراها قاسية ومستحيلة، فالسبب ليس في الوصية لكن في القلب العاجز عن الحب والتعرف على اللَّه. بهذه المعرفة الإيمانية الاختبارية تدرك النفس قوة اللَّه وفاعلية الروح القدس الساكن فيها فتنهل بالوصايا، وتنفذ وتجاهد وتثابر. وفي هذا كله تشعر بالتقصير من أجل اتساع قلبها بالحب وتعرفها على الحق الذي فيها.
- الشخص الذي يعرف يعمل أيضًا الأعمال التي تليق بواجب الفضيلة، ولكن يوجد من يمارس الأعمال وهو ليس بالضرورة بين أصحاب المعرفة. أن قد يفهم أن يميز بين ما هو مستقيم وما هو خطأ، لكن ليس لديه معرفة بالأسرار السماوية. علاوة على هذا يفعل البعض الصلاح خشية العقوبة أو لنوال مكافأة، لذلك يعلمنا يوحنا أن الإنسان الذي له معرفة كاملة يمارس هذه الأعمال عن حب.
القديس إكليمنضس السكندري
- غالبًا ما تعني كلمة “يعرف” في الكتب المقدسة ليس بمعنى إدراكه أمرٍ ما، بل وجود علاقة شخصية بالشيء. فيسوع لم يعرف خطية، ليس لأنه لا يعرف عنها شيء، وإنما لأنه لم يرتكبها قط بنفسه. فمع كونه يشبهنا في كل طريق آخر إلا أنه لم يخطئ قط (عب 4: 15). بتقديم هذا المعنى لكلمة “يعرف” واضح أنه كل شخص يقول بأنه يعرف اللَّه يلزمه أن يحفظ وصاياه، لأن الاثنين يسيران معًا.
القديس ديديموس الضرير
- الذين يهلكون لا يعرفون اللَّه، وسينكر اللَّه أنه يعرفهم، كما قال: “ابعدوا عني لأني لا أعرفكم” (مت 7: 23)[9].
هيلاري أسقف آرل
“وأما من يحفظ كلمته، فحقًا في هذا تكملت محبة اللَّه” [5].
إذ يحفظ الإنسان المحب الوصايا، يراها وصية واحدة أو “كلمته“، لأن جميع الوصايا ترتبط بفكر واحد وتدور حول شخص الرب يسوع. وإذ يذوق الإنسان حلاوة تنفيذ الوصية يستعذب طعم محبة اللَّه في صورة أكمل “في هذا تكملت محبة اللَّه“، إذ لا يراها أوامر ونواهٍ بل حب وعشق من اللَّه نحو الإنسان، إذ يقدم لنا كلمته لتكون لنا شركة معه ونراه في داخلها.
- يختفي اللَّه في وصاياه، فمن يطلبه يجده فيها، لا تقل إنني أتممت الوصايا ولم أجد الرب، لأن من يبحث عنه بحق يجد سلامًا[10].
الأب مرقس الناسك
- الشخص الذي بحق يحب اللَّه يحفظ وصاياه، يؤكد بحفظه لها أنه يعرف محبة اللَّه. طاعتنا هي ثمرة حبه.
القديس ديديموس الضرير
يقول ربنا “الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني… وأظهر له ذاتي” (يو 14: 21). فربنا يريدنا حفظ وصاياه لنكتشفه ونقبله عريسًا لنا، وإذ نكون عروسًا له نلتزم بالامتثال به إذ “من قال أنه ثابت فيه، ينبغي أنه كما سلك ذلك، هكذا يسلك هو أيضًا” [6].
وأي طريق سلكه ربنا سوى الصليب؟ إذن، فلتسلك عروسه طريق الصليب، طريق الحب العملي الباذل الضيق. الطريق الهادف الذي فيه تصلب الأنا والشهوات والارتباطات الزمنية ليتعلق القلب بربنا وحده.
من هنا صار للرسول أن يتكلم عن قلب الرسالة ألا وهو “الحب” فيقول:
“أيها الأخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة،
بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء.
أيضًا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم” [7-8].
وصية المحبة ليست جديدة بل قديمة إذ عرفها الإنسان بالطبيعة، لذلك عندما قتل قايين أخاه أدرك خطأه.
- يتحدث الرسول هنا عن الحب. لم تكن الوصية جديدة، فقد أعلنها الأنبياء منذ زمن بعيد[11].
القديس كيرلس الكبير
وهي أيضًا جديدة حيث أدركها الإنسان لها كما ينبغي “ما هو حق فيه“، إذ على الصليب عرفنا الحب ليس مجرد عواطف وانفعالات أو كلمات مداهنة بل حب باذل لأجل خلاص البشر.
- الوصية هي “حق فيه“، لأنه أحبنا حتى مات لأجلنا، وهي “حق فينا” أيضًا، إن كنا نحب الواحد الآخر[12].
هيلاري أسقف آرل
وهي أيضًا جديدة من حيث الإمكانية، إذ صارت المحبة ليست ثقيلة علينا ولا صعبة، لأن “الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء” [8]. لقد صار لنا بالصليب أن نصلب “الأنا” ليحيا المسيح فينا، تذهب الأنانية والذاتية ليحل الحب الإلهي فينا، وكما يقول الرسول: “إذ خلعتم الإنسان العتيق… ولبستم الجديد” (كو 3: 9-10)، “كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن فنور في الرب” (أف 5: 8).
هذا هو جوهر المسيحية، أما “من قال أنه في النور“، أي قال أنه مسيحي “وهو يبغض أخاه، فهو إلى الآن في الظلمة” [9]. لأننا دعينا لتكون لنا شركة مع ربنا يسوع – الحب الحقيقي – فكيف نبغض بعد؟!
- النور هو نور الإيمان العامل فينا، حسب خطة اللَّه السابقة.
- النور هو الحق، والأخ ليس هو مجرد قريبنا، لكنه قريب الرب (يسوع) أيضًا.
القديس إكليمنضس السكندري
“من يحب أخاه يثبت في النور، وليس فيه عثرة” [10].
من يحب أن يسلك بربنا يسوع في النور، فهذا لا يتعثر، لا في المسيح ولا في الكنيسة، إذ يقول القديس أغسطينوس:
[من هم أولئك الذين يتعثرون أو يسببون عثرة؟! إنهم الذين يصطدمون بالمسيح والكنيسة. فالذين يصطدمون بالمسيح يكونون كمن احترق بالشمس، ومن يصطدم بالكنيسة يكون كمن احترق بالقمر. ويقول المزمور “لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل” (مز١٢١: ٦).
فإن ثبتم في المحبة لن تتعثروا في المسيح ولا في كنيسته، ولن تتركوا المسيح ولا الكنيسة.
ومن يترك الكنيسة، كيف يبقى في المسيح وهو غير باق في جسده؟!
الضربة (الواردة في المزمور) تعني العثرة. فإن الذين لا يطيقون احتمال بعض الأمور في الكنيسة يتركونها منسحبين عن اسم المسيح أو الكنيسة. يا لعارهم!!
انظروا كيف وصموا بالعار أولئك الجسدانيون الذين علمهم السيد المسيح عن جسده قائلاً: “إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم” (يو 6: 53-69). كثيرون قالوا هذا الكلام صعب ورجعوا من ورائه وبقي الإثنا عشر. لقد ضربتهم الشمس، ورجعوا إلى الوراء عاجزين عن احتمال قوة الكلمة…
أما الذين تضربهم الكنيسة كالقمر فهم أولئك الذين يسببون الانشقاقات (بالبدع)…
آه! لو كنتم تحبون إخوتكم ما كانت توجد فيكم عثرة![13]]
“وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك.
ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه” [11].
من يترك طريق الحب يتخبط في الظلمة ويتعثر ليصطدم بالرب الحجر الذي قُطع بغير يدين (دا 6: 53-69) فلا يطلب غفرانًا من الرب ولا يقبل وصايا ولا يصدق مواعيده. ويصطدم أيضًا بالكنيسة فلا يقبلها ولا يطيق العبادة فيها متعثرًا من كل شيء فيها، لأن الظلمة أعمت عينيه.
- من يفعل الشر ويبغض أخاه، أطفأ سراج الحب، ولهذا يسلك في الظلمة[14].
العلامة أوريجينوس
- إن أبغض إنسان أخاه يسلك في الظلمة ولا يعرف إلى أين يذهب. ففي جهله ينحدر إلى الهاوية، وفي عماه يسقط بتهور تحت العقوبة، لأنه ينسحب من نور المسيح[15].
الأب قيصريوس أسقف آرل
- حبنا للَّه
أ. إمكانياتنا كأبناء محبين للَّه
“أكتب إليكم أيها الأولاد،
لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه” [12].
يقول القديس أغسطينوس:
[لقد دُعينا أولادًا بالمعمودية ونلنا غفران الخطايا من أجل اسم المسيح. لأننا لم نعتمد باسم بولس ولا باسم بطرس ولا باسم آخر غير الثالوث القدوس.
تدعو المحبة أولادها الذين من أحشائها منتحبة عليهم من أجل الانقسام والانشقاق في الإيمان، مذكرة إيانا أننا قد اعتمدنا جميعًا وغفرت لنا خطايانا من أجل اسم المسيح الواحد.
“أكتب إليكم أيها الآباء،
لأنكم قد عرفتم الذي من البدء” [13].
لقد صار للآباء الكهنة الأبوة إذ عرفوا اللَّه الأبدي الذي وحده له الأبوة الحقيقية نحو البشرية جميعًا. أما هم فيستمدون أبوتهم منه.
“أكتب إليكم أيها الأولاد… أيها الآباء…
أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير“.
لقد حدث الأولاد عن الأبوة الغافرة للخطايا، والآباء عن الأبوة التي لهم من عند الآب السماوي الذي من البدء، والأحداث الذين وهبوا قوة للغلبة. فإن الشرير يحاربنا، لكنه لا يقدر أن يغلبنا، لأننا أقوياء بالمسيح يسوع، “لأنه إن كان قد صلب عن ضعف، لكنه حي بقوة اللَّه” (٢ كو 13: 4).
يعود الرسول فيؤكد ما سبق أن قاله:
“أكتب إليكم أيها الأولاد، لأنكم قد عرفتم الآب.
“كتبت إليكم أيها الآباء، لأنكم قد عرفتم الذي من البدء” [13-14].
يحذرنا الرسول لئلا ننسى الذي من البدء، فنفقد الأبوة الروحية. ويؤكد أيضًا للأحداث أنه يليق بهم أن يقاوموا حتى يغلبوا فيكللوا، وأن يمتلئوا بالرجاء في قتالهم، إذ يقول لهم: “كتبت إليكم أيها الأحداث، لأنكم أقوياء، وكلمة اللَّه ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير” [14].
وصيته للأولاد، “قد عرفتم الآب“، وللآباء: “قد عرفتم الذي من البدء“. فهو يوصي بالمعرفة، لكن ليست المعرفة التي تنفخ بل المملوءة حبًا فتبني (١كو 8: 1). فمن كانت له معرفة بغير حب يكون كالشياطين التي تعرف ابن اللَّه وتعترف به (مت 8: 29) لكن الرب انتهرها. أما المعرفة المطلوبة فهي المملوءة بحب اللَّه الذي يضاد محبة العالم. فإن تفرغت قلوبنا من المحبة الأرضية تشبع من الحب الإلهي، ويدخل اللَّه في قلوبنا كزارع في حقل يقتلع ما يجده من حطب، وينظفها ويهيئها ليغرس فيها شجرة “الحب”، أما الحطب الذي يقتلعه فهو محبة العالم[16].]
ب. رفضنا محبة العالم
“لا تحبوا العالم، ولا الأشياء التي في العالم.
إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الآب” [15].
يقول القديس أغسطينوس:
[نلنا الميلاد الجديد بالمعمودية منذ سنوات، فيجدر بنا ألا نحب العالم، حتى لا تتحول الأقداس التي فينا إلى لعنة بدلاً من أن تكون للقوة والخلاص.
كيف تتأسس المحبة في قلب مولع بمحبة العالم؟ لابد من انتزاع الحطب، وغرس البذور السمائية ولا نترك الشوك يخنق الزرع.
“لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة.
“والعالم يمضي وشهوته.
أما الذي يصنع مشيئة اللَّه، فيثبت إلى الأبد” [16-17].
يجرفنا نهر العالم مع أمواجه، لكن ربنا يسوع المسيح كشجرة مغروسة على مجاري المياه (مز١ :٣) تجسد ومات وقام وصعد إلى السماوات. هكذا بإرادته زرع ذاته بجوار المياه الجارفة حتى متى جرفتنا الأمواج نسرع ونمسك به. وإن استحوزت دوامة الأمور الزمنية حبنا، نسرع إلى ربنا يسوع ونمسك به، ذاك الذي من أجلنا أخذ الجسد الزمني لنصير نحن أبديين. ومع أنه أخذ ما هو زمني إلاَ أنه يبقى أبديًا.
لكن كيف لا نحب الأشياء التي في العالم؟
إن قدم عريس خاتمًا لعروسه فهل تحب الخاتم أكثر منه؟! فلتحب الخاتم كيفما تشاء، لكن هل يحق لها أن تكتفي بالخاتم قائلة: لا أريد أن أرى وجه العريس؟! هكذا من يحب الخليقة دون خالقها. فإن هذا الحب يُحسب زنًا.
ولقد جرب العدو “الشيطان” ربنا يسوع في هذه الأمور الثلاثة:
- شهوة الجسد: إذ قال له: “إن كنت ابن اللَّه فقل أن تصير هذه الحجارة خبزًا”. قال له هذا وهو جائع بعد صومٍ دام أربعين يومًا.
- شهوة العيون: وذلك من جهة اشتهاء صنع المعجزات (لينال كرامة بشرية) إذ قال له: “اطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك، لكي لا يصطدم بحجر رجلك”. لكن ربنا لم يكن يصنع المعجزات حبًا في الظهور، بل بدافع الحنان والترفق.
- تعظم المعيشة: إذ أخذه إبليس إلى جبل عالٍ جدًا وأراه ممالك العالم ومجدها، وقال له: “أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي”. فقد أراد أن يجرب ملك العالم كله بمجد العالم الباطل[17].]
ج. رفضنا للبدع المنشقة على اللَّه وكنيسته
“أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة،
وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي،
وقد صار أضداد للمسيح كثيرون.
من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة” [18].
“هي الساعة الأخيرة“، إنها اللحظات الأخيرة للمعركة بين اللَّه والشيطان. يمد اللَّه أولاده بذاته ليعطيهم النصرة، والشيطان أيضًا إذ يرى أيامه قد اقتربت يصارع باثًا روحه في أضداد المسيح لكي يفسدوا إيمان أولاد اللَّه وحياتهم.
لكن أولاد اللَّه يحبون أباهم، مستتفهين الحياة الزمنية. يرون أيام غربتهم مهما امتدت هي “ساعة أخيرة” تنتهي حتمًا، ليحيوا في الفردوس، إلى أن يُكللوا في الأبدية. بهذا يطمئن الرسول أولاده ألا يخافوا من المقاومين لهم.
يقول القديس أغسطينوس:
[“منا خرجوا“: لا نحزن يا إخوتي لأنهم “لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا” [19].
كثيرون منهم نالوا معنا سرّ المعمودية، وكانوا يشتركون معنا في المقدسات، شركة قدس الأقداس، ومع ذلك فهم ليسوا منا…
أما الذين خرجوا منا لكنهم يعودون تائبين، فهؤلاء ليسوا أضداد المسيح، لأنهم لم يستطيعوا الحياة بدونه.
أضداد المسيح هم الذين خرجوا مصرين على خروجهم “ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا“.
هم لم يكونوا منا، لكنهم لم يكونوا ظاهرين هكذا.
“أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء” [20].
هذه المسحة هي الروح القدس الذي فيكم، وهو الذي يكشف أسرار اللَّه في القلب ويعلمنا ويذوقنا حلاوة العشرة معه، ويفتح أذهاننا فنتعلم كل شيء[18].]
“لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه.
وإن كل كذب ليس من الحق” [21].
لا نحتاج إلى تعاليم جديدة، بل إلى عمل الروح القدس الذي يذكرنا بالحق. ويهبنا تمييزًا لرفض كل تعليم غريب.
“من هو الكذاب، إلاَ الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟
هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب والابن.
كل من ينكر الابن، ليس له الآب أيضًا.
ومن يعترف بالابن، فله الآب أيضًا” [22-23].
الكذاب هو الذي يرفض الحق منكرًا أن يسوع هو المسيح. أي يرفض ربنا كمخلصٍ له، منكرًا تأنسه، أو يرفض عمل المسيح في حياته، فيسلك بروح الضلال رغم دعوته مسيحيًا، هؤلاء يعترفون أنهم يعرفون اللَّه لكنهم بالأعمال يفرضونه (تي 1: 16).
ومن يرفض المسيح لا يتمتع بالآب والابن، لأنه “لا أحد يعرف الآب إلاَ الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له” (مت ١١: ٢8).
د. ثباتنا في اللَّه
“وأما أنتم فما سمعتموه من البدء، فليثبت إذا فيكم.
إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء، فأنتم أيضًا تثبتون في الابن وفي الآب.
وهذا الوعد الذي وعدنا به، هو الحياة الأبدية” [24-25].
بالنسبة لنا نحن الذين لم ننشق عن الكنيسة، فلنثبت فيما سمعناه من البدء وتسلمناه جيلاً بعد جيل. وبثباتنا في الإيمان المستقيم والحياة نثبت في الابن وفي الآب، متطلعين إلى الوعد الذي نشتهيه، أي “الحياة الأبدية”.
“كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم” [26].
فغاية كتابته توجيه أنظار المؤمنين حتى لا يضلهم المبتدعون بأساليبهم المخادعة.
“وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم،
ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد،
كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء” [27].
وأما أنتم، أي المؤمنون؛ ففينا مسحة القدوس ثابتة، ولسنا محتاجين إلى تعاليم غريبة جديدة تلك الذي بلغت أحيانًا ما يقرب من ٦٠٠ طائفة جديدة. أما نحن فلنثبت على ما سلمه لنا الروح القدس، روح الحق الذي ليس فيه خداع “وهي حق وليست كذبًا“، حيث يختفي جميع المعلمين فلا يخدموا من عندهم، بل في المعلم الواحد وهو المسيح (مت 23: 10). إذًا لنثبت في هذا التعليم “كما علمتكم تبنون“.
4. محبو اللَّه وبنوتهم له
“والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه،
حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة،
ولا نخجل منه في مجيئه.
“إن علمتم أنه بار،
فاعلموا أن كل من يصنع البرّ مولود منه” [28-29].
إذ يثبت محبو اللَّه في كلامه بالمسحة الثابتة فيهم عندئذ:
أ. يصير لهم رجاء وشوق نحو مجيئه، كعروس تنتظر عريسها، لتعيش في حضنه، وتراه وجهًا لوجه في الأبدية.
ب. إذ يعلمون أنه بار فكأولاد له لا يقبلوا إلاَ أن يكونوا على مثال أبيهم، فيجاهدوا مثابرين لعمل البرّ بقوة المسحة التي فيهم.
[1] Origen: De Principiis 2: 7: 4.
[2] St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.
[3] مار افرام السرياني: ميامر الميلاد طبعة 6٧، ص ١٦.
[4] مار افرام السرياني: ميامر الميلاد طبعة 6٧، ص ٤٥.
[5] Theological Orations 30:14.
[6] On Jacob and the Happy Life 6:21.
[7] Sermon 213:5.
[8] Introductory Commentary on 1 John.
[9] Introductory Commentary on 1 John.
[10] الحب الإلهي، 1967، ص ٩٣ (راجع مفهوم الوصية ص ٨٥ – ٩٣).
[11] Catena.
[12] Introductory Commentary on 1 John.
[13] St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.
[14] Hom. On Levit. 13:4.
[15] Sermons 90:6.
[16] St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John .
[17] St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John .
[18] St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.