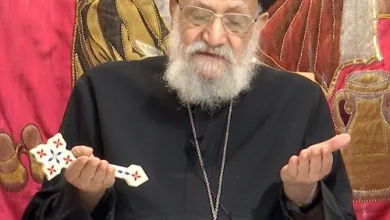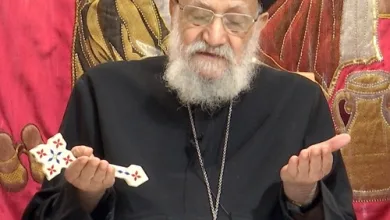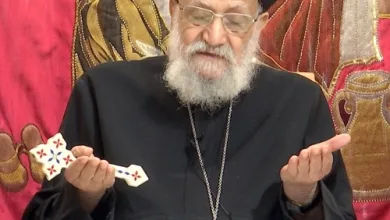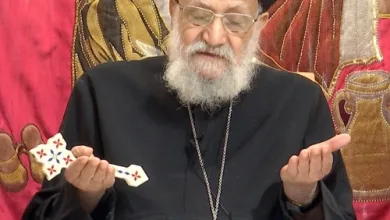تفسير سفر الرؤيا 18 الأصحاح الثامن عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير سفر الرؤيا 18 الأصحاح الثامن عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
تفسير سفر الرؤيا 18 الأصحاح الثامن عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي

تفسير سفر الرؤيا 18 الأصحاح الثامن عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي
الأصحاح الثامن عشر: سقوط بابل
يتحدث هذا الأصحاح عن سقوط بابل، عروس الوحش:
- إعلان سقوط بابل 1-3.
- دعوة المؤمنين لاعتزالها 4- 8.
- الراثون لها أ. ملوك الأرض 9-10.
ب. تجار الأرض 11-16.
ج. الوسطاء 17-20.
- تأكيد سقوطها 21-24.
- إعلان سقوط بابل
“ثم بعد هذا“، أي بعدما نظر المرأة الزانية، بابل، أي الشعب المنحرف وراء ضد المسيح مع رعاته الذئاب الخاطفة المعاندين لله، وما اتسمت به هذه المرأة الجالسة على الوحش من إغراءات وأضاليل يعود فيتحدث عن حالها.
وهنا الحديث أيضًا رمزي استعاري، يكشف عن فكر روحي معين، هو ملاك مملكة ضد المسيح وانحطاط عمله، لذلك يخطئ من يأخذ ما ورد بمعنى حرفي، إذ يفقد غاية السفر، ويشوه معانيه السامية.
“ورأيت ملاكًا آخر نازلاً من السماء
له سلطان عظيم،
واستنارت الأرض من بهائه” [1].
لا نستطيع القول بأنه في أيام ضد المسيح يظهر فعلاً ملاك وينادي بما سنسمعه فيما بعد، وإنما هو إشارة إلى اهتمام السماء، حتى أصحاب الدرجات السامية ذوي السلطان العظيم، أن يروا هلاك بابل الشريرة.
وربما يقصد بهذا الملاك إشعياء النبي الذي سبق فأعلن بروح النبوة السماوي قائلاً: “سقطت، سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة، كسرها إلى الأرض. يا دياستى وبني بيدري ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به” (إش 21: 9-10). فإن ما يعلنه إله الكنيسة رب الجنود سمعه إشعياء النبي، وها هو يسمعه الرائي صادرًا أيضًا عن ملاكٍ سماويٍ من طغمة عالية، وهو يصرخ بما قاله الرب نفسه:
“وصرخ بشدة بصوت عظيم، قائلاً:
سقطت، سقطت بابل العظيمة،
وصارت مسكنًا للشياطين،
ومحرسًا لكل روح نجس،
ومحرسًا لكل طائر نجس وممقوت.
لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم،
وملوك الأرض زنوا معها،
وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها” [2-3].
لقد صارت خرابًا… سقطت، سواء في هذه الحياة أو في الحياة الأخرى.
إنه يقدم لنا صورة مؤلمة لتلك المتعجرفة وما بلغت إليه، إذ صارت خرابًا لا يسكنها البشر بل الشياطين، ولا يقبلها روح مقدس بل تصير محرسًا لكل روح نجس وطائر نجس وممقوت. هذه هي نهاية كل شر، وهذه نهاية مملكة ضد المسيح.
وما يقوله هنا عن ضد المسيح وعروسه إنما هو حادث لكل إنسان يسلك متعجرفًا ويسكر من خمر غضب الزنا الروحي. لأنه كما يُدعى المؤمنون “أورشليم السماوية” ويتمتعون بالسماويات، وهم بعد على الأرض، هكذا يُدعى المعاندون في كل جيل “بابل” ويصيبهم الدمار، فيصيرون خرابًا، لا يسكنهم سوى إبليس الذي يستريح في هذه النفوس القفرة، مرسلاً كل آلاته الشيطانية إلى هناك. كما تصير هذه النفوس المجدبة التي بلا حياة ولا ثمر مأوى للطيور النجسة الممقوتة التي لا يسكنها الأحياء ولا تجد لها موضعًا بينهم.
وقد سبق أن تنبأ بذلك إشعياء النبي عن بابل (13: 21-22) كما قال بنفس المعنى عن آدوم (34: 10-15). إنها مجدبة بالرغم مما اتسمت به من أن تسكر الآخرين، وتلذذهم وتغنيهم من وفرة نعيمها.
- دعوة المؤمنين لاعتزالها
“ثم سمعت صوتًا آخر من السماء قائلاً:
اخرجوا منها يا شعبي،
لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا تأخذوا من ضرباتها.
لأن خطاياها لحقت السماء، وتذكَّر الله آثامها” [4-5].
بعدما كشف الله بطريق أو بآخر نهاية الأشرار بدأ يحذر شعبه ألا يشتركوا معهم في شرهم. وطالبهم بالخروج منها. هذا الخروج يحمل معنيين:
- خروج روحي، أي رفض مبادئهم وسلوكهم، مهما تكن الظروف، لهذا يقول الرب: “لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير” (يو 17: 15).
- والخروج المادي الفعلي ما أمكن، وذلك كما سيطلب النبيان من الكنيسة في العالم أن تهرب إلى الجبال والبراري، حتى لا يصطدم الضعفاء بضد المسيح وأتباعه ويتعثرون بهم.
“جازوها كما هي أيضًا جازتكم،
وضاعفوا لها ضعفًا نظير أعمالها.
في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفًا” [6].
لا يعني بقوله “جازوها” أن تحاربها الكنيسة حربًا ماديّة، لكن المقصود هو رفض المؤمنين لفكر الأشرار، ونبذ الكنيسة أفكار بابل بالهروب منها روحيًا وماديًا يجعل دينونتها مضاعفة، إذ تصير الكنيسة ديَّانة لها وشاهدة عليها يوم الدين. ولعل سر مجازاتها ضعفًا هو أن خطيتها مضاعفة.
- لأنها تطلب مجدها الذاتي، لا مجد الله.
- لأنها تطلب النعيم الأرضي واللذة الزمنية ،ولا تبحث عن السعادة الأبدية.
لهذا يقول الكتاب:
“بقدر ما مجَّدَت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابًا وحزنًا،
لأنها تقول في قلبها:
أنا جالسة ملكة، ولست أرملة، ولن أرى حزنًا.
من أجل ذلك في يومٍ واحدٍ ستأتي ضرباتها:
موت وحزن وجوع وتحترق بالنار،
لأن الرب الإله الذي يدينها قوي“[7-8].
كأنه يقول إن ما تناله من جزاء هو ثمرة طبيعية لعملها. بقدر ما تُمجِّد ذاتها يتخلى عنها الرب، فتعود إلى موتها وحزنها وجوعها وفسادها. وقد أدرك الآباء ذلك واختبروه، ففي الفترة التي عاش فيها القديس أغسطينوس ممجِدًا ذاته كان عدمًا، ميتًا، ليس فيه فرح ولا شبع ولا راحة إذ يقول:
[نعم… إنني في كل مرة ابتعد فيها عنكَ أسقط في العدم والفساد.
يا لشقائي، فإنه لم يكن لي معرفة أن فيك غناي، أنا الذي ليس له وجود[1].]
[أيها الطريق والحق والحياة… يا مبدد الظلمة والشر والضلال والموت…
أيها النور، الذي بدونك يصير الكل في ليل دامس.
أيها الطريق، الذي بدونك لا يوجد سوى الضلال.
أيها الحق الذي، بدونك يخيم الموت على الجميع[2].]
وكما يقول القديس أغسطينوس[3] في أكثر من موضع أن للاعتراف جانبين هما أن نعترف بخطايانا وضعفنا فيتمجد الله، وأن نعترف بمجد الله وعمله معنا فنعرف ضعفنا الذاتي. والاثنان متلازمان. أما من يمجد ذاته فهو يهين الله والعكس بالعكس.
هذه هي الخطية الأولى التي سقط فيها الشيطان، أي الكبرياء وتمجيد ذاته، والتي بها حارب آدم وأسقطه وأسقط معه أولاده، وحارب بها ربنا يسوع الذي له المجد الحقيقي، لكنه وهو والآب واحد، قبل الصليب والالآم متخليًا عن أمجاده ليأخذها من يد الآب فتأخذها البشرية في شخصه.
أمَّا الخطية الثانية فهي خطية التنعم، أو اللذة الجسدية أو الملذات الأرضية.
يليق بالنفس أن تعرف أنها أرملة، عريسها في السماء، فتبقى رافضة الملذات الأرضية من أجل السعادة الأبدية. أما من تقول أنها ملكة لها حق التنعم والتلذذ في العالم كيفما تريد، متجاهلة سعادة السماء فتموت وهى حيَّة. يقول الكتاب موبخًا “اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة، القائلة في قلبها: أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة، ولا أعرف الثكل. فيأتي عليك هذان الاثنان… يأتي عليك شر لا تعرفين فجره، وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها، وتأتي عليك بغتة تهلكة لا تعرفين بها” (إش 47: 8-11). ويقول “وأما المتنعمة فقد ماتت وهى حيَّة” (1 تي 5: 6).
- الراثون لها
أ. ملوك الأرض
“وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض،
الذين زنوا وتنعموا معها،
حينما ينظرون دخان حريقها.
واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها، قائلين:
ويل، ويل. المدينة العظيمة، بابل المدينة القوية،
لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك” [9-10].
صورة استعاريّة رمزيّة! لأنه بالحقيقة يوم هلاك بابل يهلك معها الذين تنعموا معها. لكنه هنا يتصور ماذا يكون عليه حال هؤلاء أيضًا. إنهم كانوا يظنونها قوية وراسخة، فإذ بها قد هوت في ساعة واحدة. كانت تعتمد عليهم، إذ جذبتهم بلذاتها وشهواتها لكي خلالهم تغلب وتنتصر. الآن وقفوا كأطفالٍ خائبين بلا سلطان ولا قوة. اتكل كلاهما على الآخر وهوى الاثنان معًا، لأن أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقطان في حفرة.
زمان الدينونة قريب، وسيقف كثيرون يتأملون من خدعوهم بملذات العالم قد ضعفوا جدًا أمامهم فينوحون ليس من أجلهم، بل لأنهم قد انجرفوا معهم في تيارهم وصاروا شركاءهم في النصيب المؤلم!
ب. تجار الأرض
“ويبكي تجار الأرض، وينوحون عليها،
لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد” [11].
هذه الفئة ليست كالأولى، فالأولى انخدعت بالشهوات والملذات، أما هؤلاء فخدعتهم بمحبة الفضة. إذ اغتنوا في هذا العالم باستخدام طرق الشر والتضليل. وكانوا يظنون أنهم يخلدون إلى الأبد على الأرض، يغتنون يومًا فيومًا، لكن في لحظة، في طرفة عين كسدت بضائعهم ولم يعد هناك من يشتريها.
وبكاء هؤلاء أيضًا هو من أجل أنفسهم وليس على أموالهم. إنهم ينوحون لأنهم خرجوا صفر اليدين.
ويعدد سفر الرؤيا التجارة التي كانت تروجها بابل أيام شرها. ولكن كما يقول القديس أغسطينوس[4] إن هذه الأمور (أي مواد التجارة) ليست في ذاتها شريرة ولا هي صالحة. إنما هي صالحة بالنسبة للصالحين الذين يحسنون استخدامها، وشريرة بالنسبة للأشرار الذين يسيئون استخدامها. لقد أساء التجار وبابل… أساءوا جميعًا استخدامها.
يبدأ بالذهب وينتهي بنفوس البشر كتجارة، معطيًا للذهب قيمة أكثر مما لنفوس البشر. أي شر أعظم من هذا؟
- أدوات للتجميل: “بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز والأرجوان والحرير والقرمز”. وقد رأينا أنها كانت متحلية بهذه الأمور ومتنعمة بها. لا تستخدمها فيما هو للخير، بل للخداع والتضليل.
- الأثاثات الفاخرة: “كل عود ثيني، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر” [12]. ويرى ابن العسال أن العود الثيني هو أنواع معينة ثمينة من الخشب مثل الأبنوس والعناب والصندل.
- مواد للتنعم في الأكل والشرب والشم: “وقرفه وبخورًا وطيبًا ولبانًا وخمرًا وزيتًا وسميذًا وحنطة وبهائم وغنمًا”.
- ما هو للأُبّهة والعظمة: “وخيلاً ومركبات”.
- وأخيرًا ما هو في نظرها بلا قيمة أي استعباد الناس: “وأجساد ونفوس الناس” [13].
هذه التجارة جميعها كسدت، ففقد التجار كل شيء، إذ يقفون يوم خرابها مندهشين كيف زالت هذه التجارة، وأين هي طاقة الأشرار الشرائية. ويصير هؤلاء التجار مبكتين لها عندما تراهم، وهم يُبكتون عندما يرونها. وهكذا يصير الكل في عذاب أبدي، إذ يقول:
“وذهب عنك جني شهوة نفسك،
وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، ولن تجديه فيما بعد” [14].
يتأمل التجار الأشرار الذين كانوا يتاجرون ليس بأمانة كأناس عاملين فيما للرب، بل يثيرون الأشرار لصنع الشر من أجل رواج تجارتهم، هؤلاء سيقفون مندهشين قائلين: “أين ذهب عنك جني شهوة نفسك؟ لقد قضيتي عمرك كله من أجل إشباع شهواتك، ولم تحرمي نفسكِ من أمر ما مهما بلغ ثمنه من أجل التنعم لكي تكوني في تخمة من جهة إشباع تنعمك. لكنني أراك الآن فارغة وخاوية من كل ما اشتريتيه!”
“تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها
سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها يبكون وينوحون.
ويقولون: ويل، ويل للمدينة العظيمة،
المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز،
المتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ.
لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا” [15-17].
يعيد إلينا هذا المنظر ما قد حدث في صورة مبسطة يوم التقى يهوذا الخائن مع الكهنة في الهيكل. هو لا يطيق أن يحمل الفضة في يديه، لأنه أدرك أنه قد خسر كل شيء، وهم لا يطيقون أن يلمسوها لأنها ثمن الرب البريء. الكل كانوا في عذاب ولكن بلا جدوى! هذه وقفة انتهت بانتحار يهوذا وزوال الكهنوت اليهودي. ولكن في يوم الهلاك الأبدي لا يستطيع الذي أثار الشر أو الذي قبله أن ينتحر أو يهرب بالموت من الموت الأبدي! إنه عذاب ما بعده عذاب، إذ يتأملون تصرفاتهم القديمة ويبكون وينوحون بلا رجاء ولا أمل!
ج. الوسطاء
“وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر
وقفوا من بعيد.
وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها، قائلين:
أية مدينة مثل المدينة العظيمة.
وألقوا ترابًا على رؤوسهم،
وصرخوا باكين ونائحين، قائلين:
ويل، ويل.
المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها،
لأنها في ساعة واحدة خربت.
أفرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء،
لأن الرب قد دانها دينونتكم” [17-20].
يكشف هذا المنظر المؤلم عن جماعة الوسطاء الذين يساعدون الناس على شرهم. هؤلاء يقفون يوم الهلاك الأبدي من بعيد، وكلما رأوهم ازداد حزنهم – وقد عبر عن ذلك بإلقاء التراب على رؤوسهم – ويصرخون نائحين كيف أن ما كانوا يحسبونه مصدر غنى لهم وسعادة صار موضوع شقاء وهلاك!
النتيجة:
ما يريد أن يؤكده الرب في هذا الإصحاح هو أنه بقدر ما يزداد اتحاد المؤمنين كأعضاء في جسد الرب، وقدر ما تكون الشركة غاية في القوة بين العريس وعروسه وبين العروس والسمائيين، وتكون السماء كلها في فرحٍ وبهجةٍ ووحدةٍ ما بعدها وحدة، نجد في البحيرة المتقدة نفورًا وضيقًا وهروبًا… المتنعمون يقفون من بعيد. الكل لا يطيق أحدهم الآخر!
وكما يرى الكل شخص ربما يسوع – البرّ الحقيقي – في كل عضو من أعضاء الكنيسة، هكذا يرى كل عضو من الأشرار خطيته في زميله في الهلاك الأبدي، فينفر منه ولا يطيقه.
وبالرغم مما اشترك فيه الكل من حزن ونحيب، لكن كل واحدٍ يقف منفردًا في بكائه، منقسمًا على زملائه، لاعنًا اليوم الذي فيه تعرف على بابل العنيدة. أما الأبرار فيفرحون معًا بروح واحد بلا انقسام “افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء“، مدركين أن الدينونة هي من عمل الله المحب الذي يهبهم الأبديّة ويدين بابل في شرها.
- تأكيد السقوط
وإذ أراد الرب أن يؤكد لنا أنه تم سقوطها قال الرسول:
“ورفع ملاك واحد قوي حجرًا كرحى عظيمة
ورماه في البحر قائلاً:
هكذا بدفع ستُرمى بابل المدينة العظيمة،
ولن توجد فيما بعد” [21].
هذا العمل الرمزي الذي قام به الملاك صنعه إرميا النبي قبلاً (51: 63-64)، وكما سقط الحجر هكذا سبق أن سقط فرعون وجنوده في البحر الأحمر (خر 15:10)، غير أنه يعلن أن سقوطها يكون بدَفعة قويّة مرة واحدة. هكذا تُلقى بابل العنيدة في نار جهنم. أما صورة الخراب فجاء به في صورة استعارية سبق أن استخدمها العهد القديم، فأظهر في خرابها:
- انتزاع أهل اللهو: “وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يُسمع فيك فيما بعد” (راجع إش 14: 11، حز 26: 13).
- انعدام أصحاب الصناعات: “وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد”.
- انعدام الأعمال الضرورية للحياة: “صوت رحى لن يُسمع فيك فيما بعد” [22] (راجع إر 25:
10).
- ظلمة تامة: “ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد”.
- انعدام الفرح والإنجاب: “وصوت عريس وعروس، لن يسمع فيك فيما بعد” (راجع إر 7: 34، 16: 9).
أما سبب خرابها فهو:
“لأن تجارك كانوا عظماء الأرض.
إذ بسحرك ضلَّت جميع الأمم.
وفيها وجد دم أنبياء وقديسين
وجميع من قُتل على الأرض” [23-24].
هذا يكشف لنا أنه لا يقصد ببابل بلد معين ولا فترة معينة، بل كل المعاندين الذين احتقروا دم الأنبياء والقديسين وسفكوا دم شهود الرب. إنه حديث يميل إلى التعميم أكثر منه تخصيص فترة ضد المسيح وحدها. وهذا ما أخذت به حتى الكنائس غير الرسوليّة[5].
[1] الحب الإلهي، 1967، ص 171.
[2] الحب الإلهي، 1967، ص 168.
[3] راجع عظاته على العهد الجديد وعلى المزامير.
[4] عظات على فصول منتخبة من العهد الجديد، قام بترجمتها المؤلف.
[5] أخذ بذلك ايردمان في كتابه: The Revelation of John, p.144.