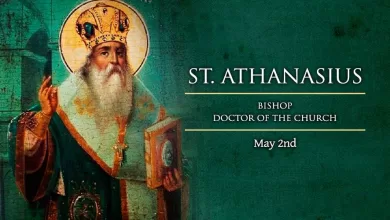الله خالق – الطريق الأرثوذكسي – د. نصحى عبد الشهيد
الله خالق - الطريق الأرثوذكسي - د. نصحى عبد الشهيد
الله خالق – الطريق الأرثوذكسي – د. نصحى عبد الشهيد

الطريق الأرثوذكسي للأسقف كاليستوس وير
الفصل الثالث
الله خالقٌ
جاء إلى القديس أنطونيوس فى البرية أحد الحكماء فى ذلك الزمان وقال له: ” يا أبى، كيف تحتمل العيش هنا محرومًا من كل تعزية من الكتب؟”.
فأجابه أنطونيوس ” كتابى، أيها الفيلسوف هو طبيعة الأشياء المخلوقة، وكلما أردت أقدر أن أقر فيها أعمال الله “. إفاجريوس البنطى
اعرف أن فى داخلك، على مستوى صغير، كونًا آخر: فى داخلك شمس وهناك قمر، وهناك أيضًا نجوم. أوريجينوس
تطلع إلى السموات:
تصف الممثلة ليللا مكارثى كيف أنها ذهبت مرة وهي تشعر بتعاسة شديدة لتقابل ” جورج برنارد شو “، بعد أن هجرها زوجها:
كنت أرتجف، كان شو يجلس ساكنًا جدًا. جلبت لى النيران الدفء.. لم أعرف كم مكثنا على هذا الحال، لكننى وجدت نفسى الآن أسير بخطى متثاقلة وشو يسير بجوارى.. نقطع “ممر أدلفى” صعودًا وهبوطًا. وتخفف الثقل الواقع على كاهلى رويدًا وأذرفت الدمع الذي لم يكن يفيض من قبل أبدًا.. وتركنى أصرخ. وسرعان ما سمعت صوتًا يتحدث إلىَّ اجتمعت فيه كل رقة العالم ولطفه. قال الصوت: ” تطلعى، يا عزيزتى، تطلعى إلى السموات. هناك فى الحياة ما هو أكثر من هذا. هناك المزيد والكثير”.
ومهما كان إيمان “شو” بالله أو عدمه، فإن “شو” يشير هنا إلى شئ أساسى فى الطريق الروحى. إنه لم يقدم كلمات ناعمة لتعزية ليللا مكارثى، أو تظاهر أن ألمها من السهل تحمله. ما فعله كان أكثر إدراكًا وتبصرًا. أخبرها أن تخرج لحظة من نفسها، من مأساتها الشخصية، وأن ترى العالم فى موضوعيته، وأن تتحسس جماله وتنوعه، أن تحس به “هكذا كما هو”. وتنطبق نصيحته على جميعنا. ورغم أن آلامى وآلام الآخرين تقهرنى، فينبغى ألا أنسى أنه يوجد فى العالم أكثر من هذا، هناك الكثير جدًا.
ويقول القديس يوحنا من كرونستادت “الصلاة حالة من الشكر الدائم”. فإن كنت لا أشعر بأى إحساس فرح بخليقة الله، وإن كنت أنسى أن أقدم العالم لله بالشكر، فلا أكون قد تقدمت سوى القليل على “الطريق”. ولم أتعلم بعد أن أكون إنسانًا بالحق. لأنه بالشكر فقط أقدر أن “أصبح أنا نفسى”. والشكر الممتزج بالفرح، البعيد جدًا عن كونه شكرًا مغرقًا فى الخيال أو شكرًا عاطفيًا، هو على النقيض شكر واقعى تمامًا ـ لكنها واقعية المرء الذي ” يرى العالم فى الله “، كخليقة إلهية.
جسر الماس:
” أتيت بنا إلى الوجود من العدم ” (قداس القديس يوحنا ذهبى الفم). كيف لنا أن نفهم علاقة الله بالعالم الذي خلقه ؟ ما معنى هذه العبارة “من العدم”، ولماذا، فى الحقيقة، يخلق الله أصلاً ؟
إن عبارة ” من العدم ” تدل أولاً وقبل كل شئ، على أن الله خلق العالم ” بفعل مشيئته الحرة”. ولا شئ أجبره على أن يخلق، هو اختار أن يفعل ذلك. لم يُخلق العالم بغير قصدٍ أو عن ضرورة، إنه ليس انبثاقًا آليًا أو فيضًا من الله، بل هو نتيجة الاختيار الإلهي.
فإن لم يكن شئ قد اضطر الله إلى الخلق، فلماذا إذن اختار أن يفعل هكذا ؟ وبقدر ما يسمح مثل هذا السؤال بإجابة، فإن ردنا يجب أن يكون: إن دافع الله فى الخلق هو محبته. وعوضًا عن القول إنه خلق العالم من عدم، يجب علينا القول بالأحرى إنه خلقه من ذاته هو، التي هي المحبة. علينا أن نفكر، لا فى “الله الصانع” ولا فى “الله الحرَفى” بل فى “الله المحب”. ليس الخلق بالأكثر فعل مشيئته الحرة بقدر ما هو فعل “محبته الحرة”. أن نحب معناه أن نشارك، كما أوضح لنا تعليم الثالوث بكل جلاء. ليس الله مجرد واحد، بل واحد فى ثلاثة، لأنه شركة أشخاص يتشاركون فى المحبة الواحد مع الآخر. إن دائرة الحب الإلهي، رغم ذلك، لم تبقَ مغلقة. إن محبة الله بكل ما تحمله الكلمة من معنى، محبة ” نشوة ودهش ” ـ محبة تجعل الله يخرج من ذاته وأن يخلق أشياء غير ذاته. وخلق الله العالم فى محبة ” دهشٍ ” باختيار إرادى، لتكون بجواره كائنات أخرى تشترك فى حياته ومحبته.
لم يكن الله تحت أى اضطرار لكى يخلق، لكن ذلك لا يعنى أن هناك أى شئ بمحض الصدفة أو غير منطقى حول فعله فى الخلق. الله هو “كل” ما يفعل، لهذا فإن فعله فى الخلق ليس شيئًا ما منفصلاً عن نفسه. إن كل واحد منا كان موجودًا دائمًا فى قلب الله وفى محبته. ومنذ الأزل رأى الله كل واحد منا كفكرة أو فكر فى عقله الإلهي، ومنذ الأزل كان عنده خطة خاصة ومتميزة لكل واحد منا. نحن كنا موجودين على الدوام بالنسبة له، ويعنى الخلق أنه فى نقطة ما معينة فى الزمن بدأنا نوجد نحن أيضًا بالنسبة لأنفسنا.
وكثمرة مشيئة الله الحرة، ومحبته الحرة، لم يكن العالم ضروريًا ولا مكتفيًا بذاته، بل هو عارض ومعتمد (على الله). وككائنات مخلوقة، لا يمكن أن نصبح نحن أنفسنا أبدًا وحدنا؛ فالله هو قلب كياننا، وإلاّ توقفنا عن الوجود. وفى كل لحظة نحن نعتمد فى وجودنا على مشيئة الله المُحِبة. الوجود هو دائمًا عطية أو هبة من الله ـ عطية مجانية من محبته، عطية لا تسترد أبدًا، لكنها على أى حال عطية، وليست شيئًا ما نمتلكه نحن بقدرتنا الذاتية. الله وحده هو الذي يملك سبب ومصدر كيانه فى ذاته، أما كل الكائنات المخلوقة فإن علتها ومصدرها، ليس فى أنفسها، بل فيه هو. الله وحده ذاتى المصدر، وكل الخلائق مصدرها الله، وجذرها فى الله، تجد أصلها وكمالها فيه. الله وحده ” اسم “، وكل المخلوقات ” صفات “.
وبقولنا إن الله خالق العالم، لا نعنى فقط أنه وضع الأشياء فى حالة حركة بفعل أولى “فى البدء”، بعده استمرت فى أداء أعمالها بذاتها. ليس الله مجرد صانع ساعات كونيًا، يملأ الآلة ويتركها تستمر فى الدق من نفسها. على النقيض، فالخلق “مستمر“. وإن توخينا الدقة فى الحديث عن الخلق، علينا ألاّ نستخدم صيغة الزمن الماضى، بل الحاضر المستمر.
علينا ألاّ نقول إن “الله خلق العالم، وخلقنى أنا فيه”، بل نقول إن ” الله يخلق العالم، ويخلقنى أنا فيه، هنا والآن، فى هذه اللحظة وباستمرار”. ليس الخلق حدثًا فى الماضى، بل هو علاقة فى الحاضر. لو لم يستمر الله فى أعمال مشيئته الخلاقة فى كل لحظة، لتهاوى الكون على الفور إلى عدم الوجود، لا شئ يمكنه أن يبقى موجودًا ثانيةً واحدةً لو لم يشأ الله له أن يكون. ومثلما يعبّر عنها المطران فيلاريت رئيس أساقفة موسكو، “كل المخلوقات تعتمد على كلمة الله الخالقة، كما فوق “جسر من ماس”، فوقها هاوية اللانهائية الإلهية، وتحتها هاوية عدميتها “. ويصدق هذا الأمر حتى على الشيطان والملائكة الساقطين فى الهاوية: إنهم هم أيضًا يعتمدون فى وجودهم على مشيئة الله.
إن غاية تعليم الخلق، إذن، ليس فى أن ننسب نقطة بداية زمنية للعالم، بل أن نؤكد على أنه فى هذه اللحظة الراهنة، كما فى كل اللحظات، يعتمد العالم فى وجوده على الله. وحينما يعلن سفر التكوين ” فى البدء خلق الله السموات والأرض ” (تك1:1)، فإن كلمة ” بدء ” لا تؤخذ هكذا ببساطة بمعنى زمنى (مؤقت)، بل ككلمة تدل على أن الله هو العلة الثابتة لكل الأشياء والحافظ لكل الأشياء.
وكخالق، إذن، فإن الله هو دائمًا فى قلب كل شئ، وهو يحفظه فى الوجود. وعلى مستوى الاستفسار العلمى، فإننا ندرك بعض العمليات أو العواقب الخاصة بالسبب والنتيجة. وعلى مستوى الرؤيا الروحية والتي لا تناقض العلم لكنها تتجاوزه، ندرك فى كل مكان قدرات الله الخالقة، التي تضبط كل ما هو موجود، والتي تشكل الجوهر العميق جدًا للأشياء كلها. ولكن رغم أن الله حاضر فى كل مكان فى العالم، فإن الله ليس متطابقًا مع العالم. ونحن كمسيحيين لا نؤكد على ألوهية الكون أو “وحدة الوجود”[1] بل على “عدم ألوهية الكون” (أو عدم وحدة الوجود). فالله موجود فى كل شئ ومع هذا فهو أيضًا يفوق ويتجاوز كل الأشياء. هو ” أعظم من كل عظيم ” وأيضًا ” أصغر من كل صغير “.
وحسب تعبير غريغوريوس بالاماس ” هو فى كل مكان وليس فى أى مكان، هو كل شئ ولا شئ”. ومثلما عبر راهب بندكتى من نيو كليرفو الجديدة ” الله فى القلب (قلب الأشياء Core ومركزها). والله شئ آخر خلاف القلب. الله فى داخل القلب، وهو خلال كل القلب، وهو ما وراء القلب، وهو أقرب إلى القلب من القلب. “.
” ورأى الله كل ما عمله، فإذ هو حسنٌ جدًا” (تك31:1). الخليقة بكاملها هي من صنع الله، وكل المخلوقات هي فى عمق جوهرها “حسنة جدًا”. وترفض المسيحية الأرثوذكسية الثنائية بكل أشكالها: الثنائية الجذرية الخاصة بالمانوية، والتي تعزى وجود الشر لقوة ثانية، شريكة فى الأزلية Coeternal مع إله المحبة؛ وترفض الثنائية الأقل جذرية للفالنتينيين الغنوسيين، الذين يرون النظام المادى، بما فيه الجسم البشرى، كنظام أتى إلى الوجود كنتيجة للسقوط ما قبل الكونى، كما ترفض الثنائية الأكثر حذقًا للأفلاطونيين، الذين لا يعتبرون المادة شرًا، لكنهم يعتبرونها غير حقيقية.
وتؤكد المسيحية، ضد الثنائية بكل أشكالها، أن هناك خيرًا فائقًا، “الخير الأسمى” ـ أعنى، الله نفسه ـ لكن لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك شر فائق، فالشر ليس شريكًا فى الأزلية مع الله. فى البدء كان الله فقط: وكل الأشياء التي توجد هي خليقته، سواء فى السماء أو على الأرض، سواء كانت روحية أم مادية، وهكذا فهي فى حالتها الأساسية التي خُلقت عليها، كلها حسنة.
ماذا نحن قائلون إذن عن الشر ؟ مادامت كل المخلوقات هي فى داخلها حسنة (صالحة)، والخطية أو الشر فى حد ذاته ليس ” شيئًا “، ولا هو بالكائن الموجود أو الجوهر الموجود. وتقول “يوليان” من نورويخ فى كتابها “كشوف”: “أنا لم أر الخطية لأننى أعتقد أنها ليست لها جوهر من نوع ما، ولا تشارك فى الكيان، ولا يمكن التعرف عليها إلاّ من خلال الألم الذي يتسبب عنها”. ويقول القديس أغسطينوس “الخطية عدم”. “ما هو شر بالمعنى الدقيق” ـ كما يلاحظ إفاجريوس ” ليس هو جوهر بل هو غياب الخير، مثلما أن الظلمة ليست سوى غياب النور”. يعلن القديس غريغوريوس النيصّى ” لا توجد الخطية فى الطبيعة بمعزل عن الإرادة الحرة، إنها ليست جوهرًا قائمًا بذاته “. ويقول مكسيموس المعترف “حتى الشياطين أنفسهم ليسوا أشرارًا بطبيعتهم، لكنهم أصبحوا هكذا لما أساءوا استخدام قدراتهم الطبيعية “. الشر دائمًا طفيلي. هو التواء وسوء استعمال ما هو حسن فى ذاته. ولا يكمن الشر فى الشيء نفسه بل فى موقفنا نحو الشيء ـ أى، يكمن فى إرادتنا.
وقد يبدو بتسمية الشر ” عدمًا “، أننا نقلل من بطشه وقوته. لكن كما لاحظ “س. إسس. لويس”، ” العدم” هو قوى جدًا. فالقول بأن الشر هو سوء استعمال الخير ـ ومن ثم فى التحليل الأخير، وهمًا وليس حقيقة ـ هذا لا يعنى أن ننكر قبضته القوية علينا. لأنه ما من قوة أعظم فى الخليقة من الإرادة الحرة للكائنات التي أُعطى لها وعى ذاتى وذهن روحى، لهذا فإن سوء استخدام هذه الإرادة الحرة يمكن أن تكون له عواقب مرعبة جدًا.
الإنسان كجسد، ونفس وروح:
وماذا عن مكان الإنسان فى خليقة الله ؟
“ وإله السلام يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم حتى مجيء ربنا يسوع المسيح ” (1تس23:5).
هنا يذكر القديس بولس العناصر أو الأوجه الثلاثة التي تكوّن الإنسان. وبينما تتمايز هذه العناصر إلاّ أنها معتمدة تمامًا الواحد على الآخر؛ فالإنسان وحدة متكاملة وليس المجموع الكلى لأجزاء منفصلة.
أولاً، هناك “الجسد” ” تراب من الأرض” (تك7:2)، وهو الجانب الفيزيفى أو المادى لطبيعة الإنسان.
ثانيًا، هناك النفس، قوة الحياة التي تحيى وتنشّط الجسد، فتجعله ليس مجرد كتلة أو عجينة من المادة، لكن شيئًا ينمو ويتحرك، ويشعر ويدرك. وللحيوانات أيضًا نفس، وربما النباتات لها أيضًا. لكن النفس فى حالة الإنسان منحها الله وعيًا، فهي نفس عاقلة، تملك القدرة على التفكير المجرد، والقدرة على التقدم بواسطة النقاش الاستطرادى من مقدمات منطقية إلى الاستنتاج.
ثالثًا، هناك ” الروح “، ” النسمة ” من الله (أنظر تك7:2)، والتي لا توجد فى الحيوانات. ومن المهم أن نميز ” الروح” (القدس) عن ” الروح” العادية. فالروح المخلوقة التي للإنسان ليست هي الروح غير المخلوق أى روح الله القدوس الأقنوم الثالث فى الثالوث؛ ومع ذلك فإن الروحيين مرتبطان ارتباطًا حميمًا، لأنه من خلال روحه يدرك الإنسان الله ويدخل فى شركة معه.
وبنفسه (psyche) يدخل الإنسان فى الاستفسارات العلمية أو الفلسفية، فيحلل بيانات خبرته الحسية بواسطة التفكير الاستطرادى. وبروحه (pneuma) والتي تُلقب أحيانًا بلفظة nous أى ذهن روحى، يفهم الحق الأبدى عن الله أو عن الجواهر الداخلية للمخلوقات (أو logoi)، ليس من خلال التفكير الاستنباطى، بل من خلال الإحساس المباشر أو الإدراك الروحى ـ بواسطة نوع من الحدس يسميه القديس مار اسحق السريانى “المعرفة البسيطة”. هكذا فإن الروح أو الذهن الروحى متميز عن قدرات الإنسان العقلية وعواطفه الجمالية، وتسمو على كليهما معًا.
ولأن للإنسان نفسًا عاقلة وذهنًا روحيًا، فهو يملك القدرة على تقرير مصير نفسه ويملك الحرية الأخلاقية، بمعنى إحساس الخير والشر، والقدرة على الاختيار بينهما. وبينما تتصرف الحيوانات بالفطرة أو الغريزة، فإن الإنسان قادر على اتخاذ قرار حر وواعٍ.
وفى بعض الأحيان، ينبئ “الآباء” نظامًا ثنائيًا لا ثلاثيًا، واصفين الإنسان ببساطة كوحدة من جسد ونفس؛ فى تلك الحالة يعتبرون الروح أو الذهن أنه الجانب الأعلى للنفس. لكن النظام الثلاثى للجسد والنفس والروح أكثر دقة وأكثر توضيحًا، خاصة فى عصرنا هذا حيث يحدث خلط بين النفس والروح، وحين لا يكون معظم الناس حتى على وعى بأنهم يملكون ذهنًا روحيًا. إن النظام الثقافى والتعليمى للغرب المعاصر قائم على وجه الحصر تقريبًا على تدريب الدماغ العقلانى، وبدرجة أقل، على العواطف الجمالية. وقد نسى معظمنا أننا لسنا فقط دماغًا وإرادة، وأحاسيس ومشاعر، إنما نحن أيضًا روح. لقد فقد الإنسان الحديث غالبًا التلامس مع أصدق وأعلى وجه من أوجه شخصيته، ويمكن رؤية أثر هذا الاغتراب الداخلى وبشكل جلى جدًا فى قلقه، وفقدان الهوية وضياع الرجاء.
الإنسان وسيط وكون صغير:
الجسد والنفس والروح هم ثلاثة فى واحد، ويشكل الإنسان وضعًا فريدًا فى النظام المخلوق.
ووفقًا للنظرة الأرثوذكسية للعالم، فقد جبل الله مستويين للمخلوقات: أولاً المستوى ” العقلى “، ” الروحى ” أو ” الذهنى “.
ثانيًا، المستوى المادى أو الجسدانى.
وعلى المستوى الأول خلق الله الملائكة الذين لا جسد مادى لهم. وعلى المستوى الثانى خلق الكون المادى ـ الأجرام السماوية، والنجوم والكواكب السيارة مع الأنواع المتعددة من المعادن والنباتات والحيوانات.
الإنسان، والإنسان وحده، هو الذي يوجد فى كلا المستويين فى آن واحد. فمن خلال روحه أو ذهنه الروحى يشارك فى المجال العقلى noetic وهو فى هذا رفيق الملائكة، ومن خلال جسده ونفسه، يتحرك ويشعر ويفكر وأيضًا يأكل ويشرب ويحول الطعام إلى طاقة ويشارك بشكل عضوى فى المجال المادى، الذي يسرى فى داخله من خلال إدراكاته الحسية.
هكذا فإن طبيعتنا البشرية أكثر تعقيدًا من الطبيعة الملائكية، وقد وُهبت إمكانيات أغنى. والإنسان من وجهة النظر هذه ليس أدنى بل أعلى من الملائكة؛ وكما يؤكد التلمود البابلى، “الأبرار أعظم من الملائكة الخادمين” (سنهدرين 93أ). يقف الإنسان فى قلب خليقة الله. ومن ثم يشارك فى كل من المجالين العقلى والمادى، وهو صورة أو مرآة للخليقة كلها، (أو بالتعبير اللاتينى imago mundi)، أى ” كون صغير ” (ميكروكوزم). وتتلاقى فيه كل المخلوقات. وقد يقول الإنسان عن نفسه، بكلمات كاثلين راين:
لأننى أحب
تسكب الشمس أشعتها من الذهب الخالص
تسكب ذهبها وفضتها على البحر..
لأننى أحب
ينمو نبات السرخس أخضر، ويخضر العشب،
وتخضر الأشجار المشمسة الشفافة.
لأننى أحب
يفيض النهرُ الليلَ كله فى نومى،
وتنام بين ذراعى عشرات الألوف من الأحياء
ويستيقظ النيام، والمتدفقون يجدون راحة.
ولأن الإنسان كون صغير ـ ميكروكوزم ـ فإنه وسيط أيضًا. ومهمته المعطاة له من الله أن يصالح ويوفق المجالين العقلى مع المادى، ليوحدهما معًا، وليروحن المادى، وليجعل كل القدرات الكامنة للنظام المخلوق تصير ظاهرة ومثلما عبّر الحاسيديم اليهودى، يُدعى الإنسان “ليتقدم من درجة إلى درجة، حتى يتحد كل شئ بواسطته “.
وككون صغير، فإن الإنسان إذن، هو ذلك الشخص الذي يتلخص العالم فيه. وكوسيط، هو الكائن الذي من خلاله يُقدَم العالم لله،.
والإنسان قادر على ممارسة دور الوساطة هذا فقط لأن طبيعته البشرية هي بالأساس والجوهر، وحدة واحدة. فلو كان الإنسان مجرد نفس تسكن جسدًا بشكل مؤقت، مثلما تصور كثير من فلاسفة الإغريق والهند ـ ولو كان جسده ليس جزءً من نفسه الحقيقية، بل مجرد قطعة من الملابس التي يخلعها يومًا ما، أو سجن يسعى أن يهرب منه ـ لما استطاع الإنسان بهذا الشكل أن يعمل كوسيط.
الإنسان يروحن الخليقة أولاً وقبل كل شئ، بروحنة جسده وتقديمه لله. ويكتب القديس بولس ” أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم؟.. فمجدوا الله فى أجسادكم.. فأطلب إليكم أيها الاخوة، برأفة الله، أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية، مقدسة، مرضية عند الله” (1كو19:6،20، رو1:12). لكن فى ” روحنة ” الجسد، لا يلغى الإنسان مادية هذا الجسد: على العكس، فإن الإنسان مدعو أساسًا أن يعلن أو يظهر الروحى “فى المادى ومن خلاله”. والمسيحيون بهذا المفهوم هم الوحيدون أصحاب المذهب المادى Materialists الحقيقيون.
الجسد إذن، هو جزء مكمِّل للشخصية الإنسانية. وانفصال النفس عن الجسد فى الموت هو أمر غير طبيعى، هو شئ ما مضاد لخطة الله الأصلية. وهذا الموت قد حدث نتيجة السقوط. الأكثر من ذلك، فإن هذا الانفصال مؤقت: ونحن ننظر إلى ما هو قدام، فيما بعد الموت، إلى القيامة النهائية فى اليوم الأخير، حينما تتحد النفس مع الجسد مرة أخرى.
الصورة والمثال:
” مجد الله هو الإنسان ” هكذا يؤكد التلمود (Derech Eretz Zutta 10,5)
ويعلن القديس إيريناوس نفس الشيء: ” مجد الله هو الإنسان الحى “. إن الإنسان يشكل محور خليقة الله وتاجها. ووضع الإنسان الفريد هذا فى الكون نعرفه من الحقيقة التي تؤكد أنه مخلوق ” على صورة الله ومثاله ” (تك26:1). الإنسان تعبير محدود للتعبير الذاتى غير المحدود لله.
وأحيانًا يربط الآباء الشرقيون الصورة الإلهية أو ” الأيقونة ” (Ikon) فى الإنسان بطبيعته كلها، معتبرًا كاتحاد ثلاثى للروح والنفس والجسد. وفى أحيان أخرى يربطون الصورة بنوع خاص بأعلى سمة من سمات الإنسان، أى بروحه أو ذهنه الروحى، الذي ينال بواسطته معرفة الله والاتحاد به. وبشكل أساسى، فإن صورة الله فى الإنسان تشير إلى كل شئ يميز الإنسان عن الحيوانات، والذي يجعله ” شخصًا ” بكل ما تحمله الكلمة من معنى ـ وهو كائن أخلاقى قادر على الصواب والخطأ، وكائن روحى وهبه الله حرية داخلية.
إن صفة ” الاختيار الحر” لها أهميتها الخاصة لفهم الإنسان كمخلوق على صورة الله. ومثلما الله حر، هكذا بالمثل الإنسان حر. وإذ أنه حر، فإن كل إنسان يحقق الصورة الإلهية فى داخل نفسه بأسلوبه الخاص المتميز. وليس البشر عملات نقدية يمكن استبدال الواحدة بأخرى، أو قطع غيار آلة يمكن استبدالها: فكل شخص، إذ هو حر، لا يمكن تكراره، وكل شخص، إذ هو غير قابل للتكرار، هو ثمين بغير حدود. ولا يُقاس البشر كمّيًا: فليس لنا الحق أن نفترض أن شخصًا ما بعينه أكثر قيمة من شخص آخر بعينه، أو أن عشرة أشخاص هم بالضرورة أكثر قيمة من شخص واحد. مثل هذه الحسابات تسيء إلى الشخصية الأصيلة. إن كل شخص لا يمكن استبداله بآخر، ولهذا ينبغى أن يعامل كل إنسان “كغاية” فى حد ذاته أو ذاتها، وألاّ يعامل أبدًا كوسيلة لغاية أبعد. ينبغى أن يُعتبر كل شخص لا كشيء بل كشخص. وإن كنا نجد الناس مملين ومن الصعب جدًا التكهن بما فى داخلهم، فذلك لأننا لم ننفذ إلى مستوى الشخصية الحقيقية فى الآخرين وفى أنفسنا، حيث لا توجد أنماط مكررة بل كل شخص هو فريد.
ويميز كثير من الآباء الشرقيين، وإن لم يكن كلهم، بين “صورة” الله و”مثال” الله. فالصورة بالنسبة لأولئك الذين يميزون اللفظتين، تدل على “إمكانية” الإنسان على الحياة فى الله، و”المثال” يدل على “تحقيقه” لهذه الإمكانية أو القدرة. الصورة هي ما يمتلكه الإنسان منذ البداية، والتي تمكنه من أن يضع خطاه فى المحل الأول على الطريق الروحى؛ أما الشبه فهو ما يرجو أن يصل إليه فى نهاية رحلته. وبتعبير أوريجينوس “أخذ الإنسان كرامة الصورة فى خلقه الأول، لكن كمال تحقيق مثال الله سيُمنح له فقط فى نهاية الدهور”. كل الناس مخلوقون على صورة الله، ورغم أن حياتهم قد تكون فاسدة، إلاّ أن الصورة الإلهية فى داخلهم قد بهتت فقط وتغطت بقشرة معتمة، ومع هذا فهي لم تفقد تمامًا. لكن الشبه (أو المثال) يتحقق بالكامل فقط بواسطة الطوباويين فى ملكوت السموات فى الدهر الآتى.
وبحسب القديس إيريناوس، فإن الإنسان فى بدء خلقته كان ” مثل طفل صغير”، واحتاج أن “ينمو” إلى كماله. بعبارة أخرى، فإن الإنسان فى بدء خلقته كان بريئًا وقادرًا على التطور روحيًا (الصورة)، لكن هذا التطور لم يكن حتميًا أو أوتوماتيكيًا. دُعى الإنسان للتعاون مع نعمة الله، وهكذا من خلال الاستخدام الصحيح لإرادته الحرة، فإنه ببطء وتدريجيًا يمكن أن يصير كاملاً فى الله (الشبه أو المثال). ويظهر هذا الأمر كيف يمكن لمفهوم الإنسان كمخلوق على صورة الله، أن يُفسر بالأحرى بمعنى ديناميكى متحرك لا استاتيكى ساكن. وهذا لا يعنى بالضرورة أن الإنسان قد وهبه (الله) منذ البداية كمالاً محققًا بالكامل، وأعلى قداسة ومعرفة ممكنة، بل أنه ببساطة قد أُعطى الفرصة لينمو إلى شركة كاملة مع الله.
إن التمييز بين “الصورة” و”المثال” لا يتضمن طبعًا فى ذاته قبول أية “نظرية للتطور” لكنه ليس متنافرًا مع مثل هذه النظرية.
إن الصورة والمثال يدلان على التوجّه والعلاقة. مثلما يعبر فيليب شيرارد ” إن عمق مفهوم الإنسان يتضمن علاقة، يتضمن اتصالاً مع الله. فحينما نؤكد على الإنسان، فإننا نؤكد أيضًا على الله”. ومعنى الإيمان بأن الإنسان مخلوق على صورة الله هو الإيمان بأن الإنسان مخلوق لأجل شركة واتحاد مع الله، وإن كان يرفض هذه الشركة يكف عن أن يكون إنسانًا بمعنى الكلمة. وليس هناك ما يسمى ” بإنسان طبيعى ” يوجد منفصلاً عن الله: الإنسان المنفصل عن الله هو فى حالة غير طبيعية تمامًا. لذلك فإن تعليم “الصورة” يعنى، أن الإنسان يجعل الله هو المركز العميق جدًا لكيانه. إن الله هو العنصر الحاسم فى بشريتنا، فإن فقدنا إحساسنا بالإلهي نفقد أيضًا إحساسنا بالإنسانى.
وقد تأكد ذلك بشكل ملفت بما حدث فى الغرب، منذ عصر النهضة، وعلى الأخص منذ الثورة الصناعية. فصاحب الدنيوية المتزايدة نمو فى تجريد المجتمع من إنسانيته. وأكبر مثال على ذلك نراه فى النسخة اللينينية ـ الستالينية للشيوعية، فى الاتحاد السوفيتى. حيث تزامن إنكار الله مع القهر القاسى لحرية الإنسان الشخصية. وهو الأمر الذي لا يثير أدنى دهشة. إن الأساس الآمن الوحيد للتعليم عن الحرية والكرامة البشرية هو الاعتقاد بأن كل إنسان مخلوق على صورة الله.
والإنسان مخلوق، ليس فقط على صورة الله، بل بوجه أخص على صورة الثالوث. وكل ما قيل مثلاً عن ” كيف نحيا الثالوث ” (أنظر الفصل الثانى ص53) يكتسب قوة إضافية حينما نعبر عن ذلك بتعليم “الصورة”. فلما كانت صورة الله فى الإنسان هي صورة ثالوثية، يتبع أن الإنسان، مثله مثل الله، يحقق طبيعته الحقيقية من خلال الحياة المشتركة المتبادلة. والصورة تشير إلى العلاقة لا مع الله فقط، بل مع الآخرين من الناس أيضًا. ومثلما تحيا الأقانيم الإلهية فى ولأجل بعضهم البعض، هكذا الإنسان، إذ هو مخلوق على الصورة الثالوثية ـ يصبح شخصًا حقيقيًا برؤيته العالم من خلال عيون الآخرين. بجعله أفراح وأحزان الآخرين أفراحه هو وأحزانه هو. كل إنسان هو شخص فريد، ومع هذا فكل واحد فى فرادته مخلوق للشركة مع الآخرين.
” نحن الذين من أهل الإيمان يجب أن نرى المؤمنين كلهم كشخص واحد.. وأن نكون مستعدين أن نبذل حياتنا لأجل قريبنا “.
(سمعان اللاهوتى الجديد)
” ما من طريق آخر به نخلص، سوى بواسطة قريبنا.. هذه هي نقاوة القلب: حينما ترون الخطاة أو السقماء، وتشعرون حيالهم بالرأفة وحنان القلب نحوهم ” (من عظات القديس مقاريوس)
” اعتاد الشيوخ أن يقولوا إننا يجب أن نهتم بخبرات جارنا، وكأنها خبراتنا نحن. وعلينا أن نعانى مع جارنا فى كل شئ وأن نبكى معه، وأن نسلك وكأننا فى داخل جسده هو، وإن ألم به أى ضيق، علينا أن نشعر بالضيق الذي نشعر به لأجل أنفسنا ” (أقوال آباء البرية)
كل هذا حقيقى، بالضبط لأن الإنسان مخلوق على صورة الله الثالوث.
كاهن وملك:
الإنسان إذ هو مخلوق على الصورة الإلهية ـ ككون صغير ووسيط ـ هو كاهن الخليقة وملكها. ويستطيع الإنسان ـ عن وعى وعن قصد، أن يعمل أمران، تعملها الحيوانات بدون وعى وبشكل غريزى. الأمر الأول، أن الإنسان يستطيع “أن يبارك الله ويسبحه لأجل العالم”. أفضل تعريف للإنسان ليس أنه “حيوان ناطق” أو “عاقل”، بل أنه حيوان “إفخارستى” (أى شاكر). فالإنسان ليس مجرد أنه يحيا فى العالم ويفكر فيه ويستعمله، بل هو يستطيع أن يرى العالم على أنه عطية الله، على أنه سر لحضور الله ووسيلة للشركة مع الله، وهكذا فهو يستطيع أن يقدّم العالم لله بالشكر: “نقدم لك من الذي لك، فى الكل ولأجل الكل ” (قداس القديس يوحنا ذهبى الفم).
والأمر الثانى، إلى جانب أنه يستطيع أن يبارك الله ويسبحه نيابة عن العالم، أن الإنسان يستطيع أن “يعيد تشكيل العالم وأن يغيره”؛ ومن ثم يعطيه معنى آخر وبتعبير “الأب ديمترى ستانيلو”، “يضع الإنسان ختم فهمه وعمله الذكى على الخليقة..” ليس العالم هبة فقط، بل مهمة للإنسان”.
إنها دعوتنا أن نتعاون مع الله، نحن، بعبارة القديس بولس، ” عاملون مع الله ” (1كو9:3). ليس الإنسان مجرد كائن حى عاقل وكائن حى إفخارستى Eucharistic animal، بل هو كائن حى خلاّق أيضًا Creative: وحقيقة أن الإنسان هو على صورة الله تعنى أن الإنسان خالق على صورة الله الخالق. وهو يتمم هذا الدور الخلاّق، ليس بواسطة قوة بهيمية غشيمة، لكن من خلال جلاء ووضوح رؤيته الروحية؛ وليس الإنسان مدعوًا ليسيطر على الطبيعة ويدمرها، بل أن يغير شكلها ويجلّيها وأن يقدّسها.
وبواسطة العديد من الطرق ـ من خلال استزراع الأرض، ومن خلال الحرف، ومن خلال كتابة الكتب ورسم الأيقونات ـ يستنطق الإنسان الأشياء المادية ويعطيها صوتًا ويجعل الخليقة تنطق بحمد الله وبتسبيحه. وجدير بالملاحظة أن المهمة الأولى لآدم بعد خلقه، كانت أن يعطى للحيوانات أسماءً (تك19:2،20). وإعطاء الأسماء هو فى حد ذاته فعل خلاّق: فمن دون أن نجد اسمًا لشيء ما أو خبرة ما، وأن نجد ” كلمة يتعذر اجتنابها “تدلل على صفة الشيء الحقيقية، لا نقدر أن نبدأ فى فهمه واستخدامه. وأمر ذو دلالة أيضًا، أننا حين نقدم باكورات الأرض لله فى الإفخارستيا، فإننا نقدمها لا فى شكلها الأصلى بل نقدمها وقد أعادت يد الإنسان تشكيلها: فنحن لا نأتى إلى المذبح بسنابل من قمح بل بأرغفة من خبز، ولا نأتى بعنب بل بنبيذ خمر.
الإنسان إذن هو كاهن الخليقة من خلال قدرته على أن يقدم الشكر وأن يقدم الخليقة لله؛ وهو ملك الخليقة من خلال قدرته على أن يصيغ ويشكّل، وأن يتصل وأن ينوّع. وهذه الوظيفة الكهنوتية والملوكية يصفها القديس لونيتوس القبرصى وصفًا جميلاً:
” من خلال السماء والأرض، والبحر، من خلال الخشب والحجر، من خلال الخليقة كلها المنظورة وغير المنظورة، أقدم التكريم للخالق والسيد وجابل كل شئ. لأن الخليقة لا تكرم الخالق بشكل مباشر ومن ذاتها، لكنها من خلالى أنا تعلن السموات مجد الله، من خلالى أنا يعبد القمر الله، من خلالى أنا تمجد النجوم الله، من خلالى أنا فإن المياه ورخات المطر والندى وكل الخليقة، تكرم الله وتعطيه مجدًا “.
ونفس الأفكار يعبر عنها المعلم اليهودى أبراهام ياكوف من سادا جورا:
كل المخلوقات والنباتات والحيوانات تأتى وتقدم نفسها للإنسان، لكنها من خلال الإنسان يؤتى بها كلها وتُقدم لله. وحينما يطهر الإنسان نفسه ويقدسها فى كل أعضائه كتقدمة لله، فإنه يطهر ويقدس كل الخليقة.
الملكوت الداخلى:
” طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله ” (مت8:5). الإنسان إذ خُلِق على صورة الله، فهو مرآة لله. هو يعرف الله بمعرفته لنفسه: حين يدخل إلى داخل نفسه، يرى الله منعكسًا فى نقاوة قلبه. إن تعليم خلقة الإنسان حسب الصورة يعنى أن فى داخل كل شخص ـ فى داخل ذاته أو ذاتها الأصدق والأعمق، والتي تسمى غالبًا ” بالقلب العميق ” أو ” قاعدة النفس ” ـ هناك التقاء واتحاد مباشر مع غير المخلوق. ” ها ملكوت الله داخلكم ” (لو21:17).
وهذا السعى للملكوت الداخلى هو أحد أهم الأفكار الرئيسية الموجودة فى كتابات الآباء. يقول القديس كليمندس الأسكندرى: ” إن أعظم الدروس كلها أن تعرف نفسك، لأنه إن عرف الإنسان نفسه ـ سوف يعرف الله، وإن عرف الله، سوف يصبح مثل الله “. ويكتب القديس باسيليوس الكبير: ” حينما لا يتبدد الذهن وسط أمور خارجية أو يشتت فى العالم من خلال الحواس، فإنه يعود إلى ذاته، وبواسطة ذاته يرتفع إلى التفكير فى الله “. ويقول مار اسحق السريانى ” من يعرف نفسه يعرف كل شئ “. ويكتب فى موضع آخر: ” كن فى سلام مع نفسك، حينئذ تسالمك السماء والأرض، أدخل بشوق إلى داخل الكنز الذي فيك، وهكذا ترى كل أمور السماء؛ إذ يوجد مدخل واحد إلى كليهما معًا. إن السُلم الذي يؤدى إلى الملكوت مخبأ فى داخل نفسك. أهرب من الخطية، غصّ داخل نفسك، وفى نفسك ستكتشف درجات السلم التي تصعد عليها “.
ونضيف إلى هذه النصوص شهادة شاهد غربى فى أيامنا هذه، هو توماس مِرتون:
” فى كياننا نقطة عَدم لا تلمسها الخطية والخداع، نقطة الحق الصافى. نقطة أو جذوة هي ملك الله بالكامل، ليست تحت تصرفنا أبدًا، منها يرتب الله حياتنا، هي نقطة لا تصل إليها خيالات عقلنا أو وحشية إرادتنا. هذه النقطة الضئيلة من العدم والفقر المطلق هي مجد الله الصافى داخلنا. إنها إن جاز التعبير، اسمه مكتوبًا فينا، كفقرنا، وعوزنا، واتكالنا، وبنوتنا. إنها مثل جوهرة نقية، تتلألأ بنور السماء الغير مرئى. هي فى كل إنسان، وإن استطعنا رؤيتها سوف نرى بلايين من نقاط النور تتجمع معًا فى وجه وضوء شمس تبدد تمامًا كل ظلمة وقسوة الحياة… إن باب السماء هو فى كل مكان “.
ويؤكد مار اسحق قائلاً: ” اهربوا من الخطية “، وعلينا أن ننتبه لهذه الكلمات الثلاث. فإن كنا نريد أن نرى وجه الله منعكسًا فينا، علينا أن ننظف المرآة. بدون توبة لن تكون هناك معرفة لذواتنا، ولا اكتشاف للملكوت الداخلى. حينما يُقال لى ” أرجع إلى نفسك: أعرف نفسك “، من الضرورى أن أسأل: أى “نفس” علىّ أن اكتشفها ؟ وما هي نفسى الحقيقية؟ إن التحليل النفسى، يكشف لنا عن نوع واحد من “الذات”، لكنها فى أغلب الأحيان، لا ترشدنا إلى “السُلّم الذي يؤدى بنا إلى الملكوت”، بل تقودنا إلى الدرج الذي يهوى بنا إلى قبو عفن ممتلئ بالثعابين. إن عبارة ” أعرف نفسك ” تعنى ” أعرف نفسك كإنسان أصله هو الله، جذره هو الله، أعرف نفسك فى الله “. ومن وجهة نظر التقليد الروحى الأرثوذكسى ينبغى التأكيد على أننا لن نكتشف هذه النفس الحقيقية “بحسب الصورة “، إلاّ بواسطة موت ذاتنا الزائفة والساقطة. ” من يضيّع نفسه من أجلى يجدها ” (مت25:16). الذي يرى ذاته الزائفة على ما هي عليه ويرذلها هو فقط الذي يصبح قادرًا على إدراك ذاته الحقيقية، الذات التي يراها الله. والقديس برصنوفيوس يؤكد هذا التمييز بين النفس الزائفة والنفس الحقيقية قائلاً:
” أنسَ نفسك واعرف نفسك “.
الشر والألم وسقوط الإنسان:
فى الرواية العظيمة للكاتب ديستوفسكى ” الاخوة كرامازوف “، يتحدى إيفان أخاه: ” افترض أنك تخلق نسيج القدر الإنسانى لغرض إسعاد الناس فى النهاية ومنحهم السلام والراحة، ولكن لكى تفعل هذا من الضرورى أن تعذب طفلاً واحدًا صغيرًا 000 وأن تشيد بناءك على دموعه ـ فهل توافق على إنجاز البناء على هذا الشرط؟ ويجيبه أليوشا: “لا، لن أوافق “. فإن كنا لا نوافق أن نفعل هذا، فمن الواضح إذن أن الله لا يفعله بالأولى.
يخبرنا الأديب سومرست موم، أنه بعد أن رأى طفلاً صغيرًا يحتضر ببطء من مرض الالتهاب السحائى، لم يقدر بعدها أن يؤمن بإله المحبة. وآخرون اضطروا أن يراقبوا زوجًا أو زوجة، طفلاً أو والدًا، تعصف بهم ضائقة شديدة: فإنه فى عمق الألم ربما لا يكون هناك شئ أكثر إزعاجًا لنا من إنسان مصاب باكتئاب سوداوى مزمن (ميلانخوليا). فما هي إجابتنا؟ كيف لنا أن نصالح الإيمان بإله محب ـ الذي خلق كل الأشياء ورأى أنها “حسنة جدًا” ـ مع وجود الألم والخطية والشر؟
أولاً يجب أن نقر أنه من غير الممكن تدبير إجابة سهلة أو مصالحة واضحة. إن الألم والشر يواجهاننا كشيء أصم مصمت. وآلامنا وألام الآخرين، هي خبرة علينا أن نحياها، وهي ليست مشكلة نظرية يمكننا أن نشرحها. وإن كان هناك شرح، فإنه يكون على مستوٍ أعمق من الكلمات. لا يمكن “تبرير” الألم، لكن يمكن استخدامه وقبوله ـ ومن خلال هذا القبول، تتغير هيئته ويتجلى. يقول نيكولاوس برداييف، ” إن مضادة الألم والشر، يمكن حلها فى خبرة التعاطف والحب”.
لكن، وبينما نكون نحن مرتابين من جهة أى حل سهل “لمشكلة الشر”، فإننا نجد فى حدث سقوط الإنسان، الوارد بالإصحاح الثالث من سفر التكوين ـ سواء تم تفسير ذلك حرفيًا أو رمزيًا ـ نجد علامتين حيويتين، يجب أن نقرأهما بعناية.
العلامة الأولى:
أولاً، تبدأ قصة التكوين بالكلام عن “الحية” (1:3)، أى، الشيطان ـ أول من تحول من الملائكة وابتعد عن الله إلى جحيم الإرادة الذاتية. لقد كان هناك سقوط مزدوج: أولاً سقوط الملائكة، ثم سقوط الإنسان. ويُعد سقوط الملائكة بالنسبة للأرثوذكسية حقيقة روحية وليس قصة أسطورية مثيرة للخيال. وقبيل خلق الإنسان، كان قد حدث فعلاً تفريق للطرق داخل المجال العقلى: فقد بقى بعض الملائكة ثابتين فى طاعة الله، ورفضه آخرون. وحول هذه “الحرب فى السماء” (رؤ7:12)، لدينا إشارات مقتضبة فقط فى الكتاب المقدس، فهو لم يخبرنا بتفاصيل ما حدث، بل إن لدينا معرفة أقل حول الخطط التي وضعها الله لمصالحة ممكنة داخل المجال العقلى.
وعلينا، أن نلاحظ ثلاث نقاط تهمنا فى جهودنا للتعرف على مشكلة الألم. أولاً، بجانب الشر الذي نعتبر نحن البشر مسئولين مسئولية شخصية عنه، هناك فى الكون قوى ذات بطش شديد إرادتها متجهة إلى الشر. هذه القوى، بينما تكون غير بشرية، فإنها رغم ذلك شخصية. إن وجود مثل هذه القوى الشيطانية ليس افتراضًا ولا أسطورة خيالية ـ لكنها هي مسألة خبرة مباشرة بالنسبة لكثيرين من، وللأسف!
ثانيًا وجود قوات روحية ساقطة يعيننا على فهم السبب فى وجود التشويق والضياع والقسوة فى عالم الطبيعة، وذلك فى نقطة ما من الزمن، من الواضح أنها قُبيل خلقة الإنسان.
ثالثًا: أوضح تمرد الملائكة وبشكل كبير أن الشر يستمد أصله لا من تحت بل من فوق، لا من المادة بل من الروح. والشر، كما سبق وأكدنا، هو “عدم”؛ ليس الشر كائنًا له وجود ولا مادة موجودة؛ لكنه موقف خطأ تجاه ما هو خير فى ذاته. وهكذا يكمن مصدر الشر فى “الإرادة الحرة” للكائنات الروحية التي منحها (الله) اختيارًا حرًا، والتي تستخدم قوة الاختيار بطريقة خاطئة.
العلامة الثانية:
نكتفى بهذا القدر للعلامة الأولى، حيث الإشارة إلى “الحية”. لكن ثمة علامة أخرى ثانية يوضحها سفر التكوين فى سرده للأحداث، فعلى الرغم من أن الإنسان جاء إلى الوجود فى عالم ملوث فعلاً بسقوط الملائكة، فإنه على الرغم من ذلك، لم يجبر شئ الإنسان على ارتكاب الخطيئة. حواء أغوتها “الحية”، لكنها كانت تملك حرية رفض اقتراحات الحية. إن خطيتها وخطية آدم “الأصلية” كانت عبارة عن فعل عصيان واعٍ، رفض متعمد لمحبة الله، انحراف عن الله إلى الذات تم بإرادة حرة (تك2:3،11:3).
وفى اقتناء الإنسان لحرية إرادته وممارستها لا نجد شرحًا كاملاً، لكن نجد على الأقل بدايات إجابة لمشكلتنا. لماذا سمح الله للملائكة والإنسان أن يقترفوا الخطية ؟ لماذا يسمح الله بالشر والألم ؟ نحن نجيب: لأنه إله محبة. فالمحبة تتضمن المشاركة، وتتضمن المحبة أيضًا الحرية.
وكثالوث محبة، أراد الله أن يشاركه فى حياته أشخاص مخلوقين مجبولين على صورته، أشخاص قادرين على الاستجابة له بحرية وطوعًا بإرادتهم فى علاقة محبة.
وحيث لا حرية، لا يمكن أن تكون محبة. إن الإجبار يطرد الحب، كما اعتاد “بول افدوكيموف” أن يقول، يقدر الله أن يفعل كل شئ ما عدا أن يجبرنا على محبته. وإذ يريد الله أن نشاركه محبته، خلقنا، لا كإنسان آلى نطيعه آليًا، بل خلق ملائكة وبشرًا ومنحهم الاختيار الحر. ولكى نضع الموضوع بصيغة بشرية وبألفاظ بشرية، فقد خاطر الله: لأنه مع هذه العطية، عطية الحرية، كان هناك أيضًا احتمال فعل الخطية. لكن الذي لا يجازف لا يحب.
بدون حرية لن تكون هناك خطية. لكن بدون حرية لن يصبح الإنسان على صورة الله، بدون حرية لن يصبح الإنسان قادرًا على الدخول فى شركة مع الله فى علاقة حب.
عواقب السقوط:
إذ خُلق الإنسان لشركة مع الثالوث القدوس، ودُعى ليتقدم بالحب من الصورة الإلهية إلى الشبه الإلهي، اختار الإنسان بدلاً من ذلك طريقًا أو مسارًا لا يرفعه بل يهوى به إلى أسفل. ورفض العلاقة مع الله التي هي جوهره الحقيقى. وبدلاً من أن يعمل كوسيط ومركز توحيد، فقد أحدث انقسامًا. انقسام فى داخل نفسه، وانقسام بين نفسه والآخرين، وانقسام بين نفسه والعالم الطبيعى. ورغم أن الله ائتمنه على هبة الحرية، فإنه راح ينكر على الآخرين حريتهم. وإذ باركه (الله) بقوة خاصة لإعادة صياغة العالم وإعطائه معنى جديدًا، فإنه أساء استخدام تلك القوة ليصنع أدوات للقبح والدمار. وكان من عواقب سوء الاستخدام هذا، وخاصة منذ الثورة الصناعية، أن أُصيبت البيئة بتلوث سريع تظهر آثاره البشعة من حولنا.
وكان للخطية الأصلية للإنسان، وانحرافه بعيدًا عن الله كمركز له، إلى التمركز حول ذاته، فى المقام الأول والأخير، معنى واحد، أنه لم يعد ينظر إلى العالم وبقية الكائنات البشرية بطريقة إفخارستية، كسّر شركة مع الله. وتوقف عن أن يعتبرهم عطية، يعود فيقدمها بشكر إلى المعطِى، وبدأ فى التعامل معهم كملكية أو اقتناء شخصى له، يتمسك بهم، يستغلهم، ويبددهم. لهذا لم يعد الإنسان يرى الأشخاص الآخرين والأشياء الأخرى كما هي فى حد ذاتها وفى الله، ورآهم فقط من منظور اللذة والشبع اللذين يمكن أن توفرها له، وكانت نتيجة ذلك، وقوعه فريسة دائرة خبيثة لشهوته ذاتها، التي كانت تزداد جوعًا كلما أشبعها وكافئها. وكف العالم عن أن يكون شفافًا ـ كف عن أن يكون نافذة يطل منها على الله ويراه ـ وازداد العالم عتامةً، وكف عن أن يكون واهبًا للحياة وأصبح عرضة للفساد والموت. ” لأنك من تراب، وإلى تراب تعود ” (تك19:3). ويصدق هذا القول على الإنسان الساقط وعلى كل شئ مخلوق، لمجرد أن أنقطع جذره عن المصدر الواحد الوحيد للحياة: الله نفسه.
وكانت آثار سقوط الإنسان مادية وأخلاقية. فعلى المستوى المادى أصبح البشر معرضين للألم والمرض، وللعجز والتحلل الجسدى فى الشيخوخة. وأصبحت فرحة المرأة بولادة مولود جديد مختلطة بمخاض وآلام الولادة (تك16:3). ولم يكن أى شئ من ذلك ضمن خطة الله الأولية للبشرية. ومن عواقب السقوط، أصبح الناس أيضًا معرضين لانفصال النفس عن الجسد فى الموت الجسدى. ومع ذلك، يجب أن نرى الموت الجسدى لا كعقاب بالدرجة الأولى، بل كأداة تحرير وراحة أمدنا بها إله محب. ففى رحمته، لم يرد الله أن يستمر الناس يحيون إلى ما لا نهاية فى عالم ساقط، مُمسَكين إلى الأبد فى الدائرة الخبيثة الشريرة، التي اخترعوها بأنفسهم: لهذا دبر الله طريقًا للهروب. لأن الموت ليس نهاية الحياة بل بداية تجديدها. ففيما وراء الموت المادى نتطلع إلى عودة اتحاد النفس بالجسد فى مستقبلها فى القيامة العامة فى اليوم الأخير. لهذا وعند انفصال جسدنا عن النفس فى الموت، يعمل الله كالفخارى: فحينما يصبح الوعاء فوق عجلته فاسدًا ومعوجًا يكسره إلى قطع ليعيد تشكيله من جديد (قارن إرميا1:18ـ6) وهذا ما تؤكده إحدى الصلوات الليتورجية الأرثوذكسية:
منذ القديم خلقتنى من عدم،
وكرمتنى بصورتك الإلهية،
لكننى حين عصيت وصيتك،
أعدتنى إلى الأرض التي أُخذتُ منها.
أعدنى من جديد إلى شبهك،
معيدًا تشكيل جمالى القديم.
وعلى المستوى الأخلاقى، وكعاقبة من عواقب السقوط، أصبح البشر معرضين للإحباط والملل والاكتئاب. والعمل الذي كان القصد منه أن يصبح مصدر فرح للإنسان وأداة شركة مع الله، صار الآن يتم إنجازه اضطراريًا فى معظم أحواله “بعرق الجبين” (تك19:3). ولم يكن هذا كل شئ. إذ أصبح الإنسان عرضةً لاغتراب داخلى: وقد وهنت إرادته، وانقسم على ذاته، وأصبح عدو نفسه وجلادها. ومثلما يعبّر القديس بولس: ” إنى أعلم أنه ليس ساكن فىَّ أى فى جسدى شئ صالح، لأن الإرادة حاضرة عندى، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. لأنى لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده، فإياه أفعل000 ويحى أنا الإنسان الشقى! من ينقذنى؟” (رو18:7،19،24).
والقديس بولس هنا لا يقول إن هناك مجرد صراع فى داخلنا بين الخير والشر. إنه يقول إننا فى أغلب الأحيان، نجد أنفسنا مشلولين أخلاقيًا: فنحن نريد بإخلاص أن نختار الخير، لكننا نجد أنفسنا أسرى وضع معين فيه “كل” اختياراتنا تنتهي بالشر. وكل واحد منا يعرف من خبرته الشخصية ما يعنيه القديس بولس تمامًا.
ورغم ذلك، فإن القديس بولس حريص أن يقول ” إنى أعلم أنه لا يسكن ’جسدى‘ شئ صالح “. إن جهادنا النُسكى هو ضد الجسد بمعنى الشهوات، وليس ضد الجسد فى حد ذاته. فتيار الشهوة الجسدانى (flesh) ليس هو نفسه الجسد (body). إن لفظة جسد (flesh)، كما ورد استخدامها فى النص المقتبس أعلاه، يشير إلى كل ما هو آثم ومضاد لله فينا؛ هكذا ليس الجسد وحده فى الإنسان الساقط هو الذي أصبح جسدانيًا وشهوانيًا، بل النفس أيضًا. وعلينا أن نمقت الشهوة الردية (flesh) وألاّ نمقت الجسد، الذي هو من صنع الله وهيكل الروح القدس. لهذا كان إنكار الذات النسكى جهادًا ضد شهوة الجسد، لكنه ليس جهادًا ضد الجسد بل لأجل الجسد. وكما تعود الأب “سيرجى بولجاكوف” أن يقول ” أقتل الشهوة الجسدانية، لكى تقتنى جسدًا “. وليس النسك استعبادًا للذات، بل هو الطريق إلى الحرية. والإنسان متورط فى فخ من المتناقضات النفسية: ومن خلال النسك (الحقيقى) فقط يمكن أن يقتنى العفوية (السلوك التلقائى).
وإذ نفهم النسك على هذا النحو، كجهاد ضد شهوات الجسد، وضد الوجه الخاطئ والساقط للنفس، فإنه أمر مطلوب من ” كل ” المسيحيين، وليس فقط من أولئك الذين تحت النذور الرهبانية. إن الدعوة الرهبانية ودعوة الزواج ـ طريق النفى وطريق الإيجاب ـ هما طريقان متوازيان ومكملان لبعضهما بعضًا. وليس الراهب أو الراهبة بشخص ثنائى النزعة duelist، بل هو وبنفس الدرجة مثل المسيحى المتزوج. يسعى أن يعلن الخير الكامن فى الخليقة المادية وفى الجسد البشرى، وبنفس القدر، فإن المسيحى المتزوج مدعو إلى النسك. ويكمن الفارق فقط فى الأحوال الخارجية التي يُمارس فيها الجهاد النسكى. كلاهما ناسك بنفس القدر، كلاهما يتعامل مع المادة وهما ماديان بنفس القدر (مادى بالمفهوم المسيحى الحقيقى الذي شرحناه قبلاً). وكلاهما منكر للخطية ويقبل العالم بنفس القدر.
إن التقليد الأرثوذكسى، بدون التقليل من آثار السقوط، لا يعتقد رغم ذلك، أن تلك الآثار نجم عنها “حرمان كامل”، مثلما يؤكد أتباع “كالفن” فى لحظاتهم الأكثر تشاؤمًا. فالصورة الإلهية فى الإنسان تشوهت لكنها لم تُمحَ تمامًا. والاختيار الحر للإنسان فى ممارسته صار محدودًا، لكنه لم يتلاش. حتى فى عالم ساقط، لا يزال الإنسان قادرًا على التضحية بالذات وإبداء عاطفة الحب فى سخاء. حتى فى عالم ساقط لا يزال الإنسان يحوز بعض المعرفة عن الله ويمكنه بالنعمة أن يدخل فى شركة معه. هناك العديد من القديسين فى صفحات العهد القديم، رجالاً ونساءً أمثال إبراهيم وسارة، ويوسف وموسى، وإيليا وإرميا، وخارج شعب الله القديم، هناك شخصيات مثل سقراط الذي لم يعلّم الحق فقط بل عاشه. ومع ذلك يبقى حقيقيًا أن الخطية البشرية ـ خطية آدم الأصلية ـ والتي تضخمت بالخطايا الشخصية لكل جيل لاحق ـ قد أقامت هوةً سحيقة بين الله والإنسان، لا يقوى الإنسان بجهوده الذاتية أن يعبرها.
لا أحد يسقط بمفرده:
بالنسبة للتقليد الأرثوذكسى، فإن خطية آدم الأصلية تؤثر فى الجنس البشرى بكامله، ولها عواقب على المستويين المادى والأخلاقى معًا: فهي لم تسبب فقط المرض والموت الطبيعى، بل تسببت أيضًا فى الضعف والشلل الأخلاقى. فهل هي تتضمن أيضًا ذنبًا guilt متوارثًا؟ هنا تتحفظ الأرثوذكسية جدًا. فالخطية الأصلية لا تُفسر بمفاهيم قضائية أو شبه بيولوجية، وكأنها كانت وصمة عار طبيعية للذنب، تنتقل بواسطة الاتصال الجنسى. فالأرثوذكسية ترفض تمامًا هذه الصورة التي نقلتها النظرة الأوغسطينية (نسبة إلى أغسطينوس). إن تعليم الخطية الأصلية يعنى بالأحرى أننا مولودون فى بيئة يسهل فيها فعل الشر ويصعب فيها عمل الصلاح، يسهل فيها إيذاء الآخرين ويصعب فيها شفاء جراحهم، من السهل أن نثير شكوك الناس ومن الصعب أن نربح ثقتهم. وهذا معناه أن كل واحد فينا أصبح محكومًا بتضامن الجنس البشرى كله فى تراكم ” فعل الخطأ”، “والتفكير الخطأ”، ومن ثم “الكيان الخطأ”. وقد أضفنا نحن أنفسنا بأفعالنا المتعمدة ـ إلى تراكم الخطأ هذا، فاتسعت الهوة أكثر فأكثر.
وفى تضامن الجنس البشرى (فى الخطية)، نجد هنا تفسيرًا لهذا الظلم الظاهرى فى تعليم الخطية الأصلية. ونحن نسأل، لماذا ينبغى أن يتألم الجنس البشرى بأكمله بسبب سقوط آدم؟ والإجابة أن البشر، المخلوقين على صورة الله الثالوث، هم معتمدون على بعضهم البعض ويجمعهم أصلهم الفطرى المشترك معًا. فالإنسان، أى إنسان ليس جزيرة منعزلة. ” لأننا بعضنا أعضاء بعض ” (أف25:4)، ولهذا فإن أى فعل، يقوم به أى عضو فى الجنس البشرى، يؤثر حتمًا فى كل الأعضاء الآخرين. حتى وإن كنا غير “مذنبين” بالمعنى الدقيق للكلمة وأبرياء من خطايا الآخرين، إلاّ أننا وبشكل ما مشتركون دائمًا معًا.
ويعلن “ألكسى خومياكوف”، ” حينما يسقط أى واحد، فإنه يسقط وحده، ولكن ما من أحد يخلص وحده ” أما كان ينبغى أن يقول أيضًا “إن لا أحد يسقط وحده؟”. وفى رواية ديستوفسكى ” الاخوة كرامازوف “، فإن المرشد الروحى زوسيما يقترب كثيرًا من الحقيقة حين يقول إن كل واحد فينا ” مسئول عن كل واحد وعن كل شئ “:
” لا يوجد سوى طريق واحد للخلاص، هو أن تجعل نفسك مسئولاً عن خطايا كل الناس. وبمجرد أن تجعل نفسك مسئولاً بكل إخلاص عن كل شئ وعن كل واحد، ستجد على الفور أن الأمر هو فى الحقيقة هكذا، وأنك فى الواقع تُلام عن كل واحد وعن كل شئ “.
إله متألم:
هل تتسبب خطيتنا فى إحزان قلب الله ؟
هل يتألم حينما نتألم ؟
هل لنا الحق أن نقول للرجل أو للمرأة التي تتألم: ” إن الله نفسه، فى هذه اللحظة بعينها، يتألم بالألم الذي تتألم أنت به وينتصر عليه؟ “
وإذ أراد الآباء الأوائل من الذين كتبوا باليونانية واللاتينية أن يحافظوا على التسامى الإلهي، فقد أصروا على “التأكيد على عدم التألم ” بالنسبة لله. تفسير هذا بدقة، يعنى أنه عندما يتألم الله الصائر إنسانًا (المتجسد)، فإن الله فى ذاته لا يتألم. ودون إنكار التعليم الآبائى، ألاّ يجب علينا أيضًا أن نقول شيئًا أكثر من هذا؟ ففى العهد القديم، ومنذ زمن أقدم من تجسد المسيح، نجد مكتوبًا عن الله ” حزنت نفسه بسبب مشقة إسرائيل ” (قض16:10). وفى موضع آخر فى العهد القديم هناك كلمات مثل هذه قيلت بفم الله “هل أفرايم ابن عزيز لدىّ ؟ هل هو ولد محبوب؟ لأننى رغم أنى تحولت عنه، لا أزال أذكره. من أجل ذلك اضطرب قلبى لأجله” (إر20:31س).
” كيف أرفضك يا أفرايم؟ كيف أهجرك يا إسرائيل؟… قد اضطرم قلبى فى داخلى ” (هو8:11س).
فإن كانت هذه النصوص تعنى شيئًا، فإنها يجب أن تعنى أنه حتى قبل التجسد الإلهي كان الله يشترك مباشرة فى آلام خليقته. إن شقاءنا يسبب الحزن لله، إن دموع الله مرتبطة بدموع الإنسان. إن التوقير اللائق لمنهج النفى سوف يجعلنا بالطبع حذرين من أن نعزى لله مشاعر بشرية بشكل فج وغير دقيق. لكننا على الأقل مسموح لنا أن نؤكد هذا: إن ” الحب يجعل آلام الآخرين هي آلامه”، هكذا نقرأ فى كتاب “المساكين بالروح”. فإن كان هذا يصدق بالنسبة للحب البشرى، فإنه يصدق بالأحرى على الحب الإلهي. ولما كان الله محبة، وخلق العالم كفعل محبة ـ حيث إن الله إله شخصى، والشخصانية personhood تعنى المشاركة ـ فإن الله لا يبقى غير مبالٍ بالنسبة لأحزان هذا العالم الساقط. وإن كنت كإنسان أظل غير متأثرًا بعذاب الآخر، فبأى معنى أكون محبًا له فعلاً وحقًا ؟ إذن فإن الله يقينًا يُوحِّد نفسه مع خليقته فى كربها anguish.
لقد قيل بحق، إنه كان هناك صليب فى قلب الله قبل أن يكون هناك صليب منتصب خارج أورشليم، ورغم أن الصليب الخشبى قد تم إنزاله، فإن الصليب الذي فى قلب الله لا يزال هناك. إنه صليب الألم والنصرة ـ كلاهما معًا. والذين يستطيعون أن يؤمنوا بهذا سيجدون أن الفرح ممتزج بكأس مرارتهم. سوف يشتركون على المستوى البشرى فى الخبرة الإلهية للمعاناة الغالبة.
CDCDCDCDCD
يا من تغطى مرتفعاتك بالمياه
يا من تقيم الرمال حدًا للبحر
وتضبط كل شئ:
الشمس ترنم بتسابيحك،
والقمر يعطيك مجدًا،
وكل خليقة تقدم لك تسبيحًا
أنت خالقها وصانعها، إلى الأبد
(من كتاب التريوديون)
ما أعظمك يارب، عجيبة هي أعمالك:
لا تكفى الكلمات أن ترنم بالسبح لعجائبك.
لأنك بمشيئتك أتيت بكل شئ من العدم إلى الوجود.
بقوتك تحفظ الخليقة وبعنايتك تضبط العالم
خلقت الخليقة من عناصر أربعة: وبأربعة فصول توجت مدار السنة.
كل القوات الروحانية ترتعد أمامك.
الشمس ترنم بتسابيحك،
القمر يمجدك؛
النجوم تتضرع إليك؛
النور يطيعك؛
الأعماق ترتعد أمام حضورك؛
الينابيع خدامك.
بسطت السموات كستارة ؛
على المياه ثبَّت الأرض؛
وسيجت حول البحر بالرمال.
سكبت الهواء ليتنفس الأحياء.
القوات الملائكية تخدمك، وجوقات رؤساء الملائكة تعبدك؛
الشارويبم الممتلئون أعينًا، والسيرافيم ذوو الستة أجنحة يقفون أمامك
ويطيرون حولك، يخفون وجوههم خوفًا من مجدك الذي لا يدنى منه..
العناصر، والملائكة، والبشر، والأشياء المنظورة، وغير المنظورة،
يمجدون أسمك القدوس، مع الآب والروح القدس،
الآن وإلى الأبد، وإلى دهر الدهور. آمين
(من صلاة بركة المياه الكبيرة فى عيد الظهور الإلهي ـ الإبيفانيا)
إن المخاطرة الإلهية، الكامنة فى قرار خلق كائنات على صورة الله ومثاله، هي ذروة القوة الإلهية الكلية القدرة، أو بالأحرى هي التي تفوق على تلك الذروة فى تنازل تلك القدرة إلى الضعف الذي اتخذه الله عن طواعية. لأن ” ضعف الله أقوى من الناس ” (1كو25:1).
فلاديمير لوسكى
الكون هو الكرم الذي أعطاه الله للناس.
يقول القديس يوحنا ذهبى الفم ” كل الأشياء هي لأجلنا، وليس نحن لأجلها”. كل شئ هو عطية من الله للإنسان، هو علامة لمحبته. كل الأشياء تشهد لفيض محبة الله، ومشيئته الصالحة ونعمته، وهي تنقلها إلينا. ومن ثم فإن كل شئ هو وعاء لعطية المحبة الإلهية هذه، تمامًا مثلما تكون كل هدية نقدمها لبعضنا بعضًا علامةً ووعاءً للمحبة نحو بعضنا بعضًا. لكن العطية تتطلب عطية مقابلة استجابة لها، وهكذا يتحقق تبادل المحبة. لكن الإنسان لا يستطيع أن يرد لله شيئًا سوى ما قد أُعطى له لسد أعوازه، لهذا فإن عطية لإنسان هي ذبيحة يقدمها بالشكر لله. إن تقدمة الإنسان لله هي ذبيحة وهي ” إفخارستيا ” (شكر) بأوسع معنى.
مع ذلك فإننا عند تقديم العالم لله كتقدمة أو ذبيحة، نضع عليها ختم عملنا الخاص، وختم فهمنا، وختم روح ذبيحتنا، ختم حركتنا الذاتية نحو الله. وكلما أدركنا بالأكثر قيمة وعظم هذه العطية الإلهية ونمينا إمكانياتها، ومن ثم نزيد الوزنات التي قد أُعطيت لنا، كلما سبحنا الله أكثر، وجعلناه فرحًا بنا، مبرهنين أننا شركاء نشيطون فى حوار الحب بينه وبيننا.
(الأب ديمترى ستانيلو)
فى الكاتدرائية الشاسعة التي هي عالم الله، فإن كل إنسان، سواء كان دارسًا أم عاملاً يدويًا، مدعو ليعمل ككاهن لحياته كلها ـ وليأخذ كل ما هو إنسانى، ويحوله إلى تقدمة وترنيمة مجد. (بول إفدوكيموف)
إن صار قليل من الناس صلاة ـ صلاة ” نقية ” قد تبدو بحسب ظاهرها عديمة الفائدة ـ فإنهم بمجرد حضورهم ووجودهم ذاته، إنما يغيرون الكون. (أوليفيه كليمنت)
أنت عالم داخل عالم: أنظر داخل نفسك، وهناك ترى الخليقة كلها. لا تنظر إلى الأشياء الخارجية بل حوّل انتباهك إلى ما يكمن فى داخلك. اجمع شتات عقلك كله إلى داخل كنز نفسك الذهنى، وهيأ للرب مقدسًا خاليًا من التخيلات. (القديس نيلوس من أنكيرا)
يبدو للروسى أن الإنسان يمكنه أن يعرف شيئًا ما، كإنسان، فقط من خلال المشاركة.
إن الخير والشر، على الأرض هنا، مرتبطان ببعضهما البعض بغير انفصال. وهذا بالنسبة لنا هو السر العظيم للحياة على الأرض. وحيث يكون الشر فى أشده، هناك ينبغى أن يكون أيضًا الخير الأعظم.
وبالنسبة لنا، ليس هذا فرضًا نظريًا، بل هو أمر بديهي.
لا ينبغى أن نتجنب الخطاة، بل أن نتشارك معهم أولاً ونتفهمهم من خلال المشاركة، ثم من خلال الفهم نفتديهم ونجعلهم يتغيرون ويتجلون.
(جوليادو بوسوبر)
يجب أن يقدم القديسون توبة لا عن أنفسهم فقط، بل عن قريبهم أيضًا، لأنه من دون الحب الفعّال لا يمكنهم أن يصيروا كاملين. هكذا يُحفظ الكون كله معًا، وبعناية الله يساعد كل منا الآخر. (القديس مرقس الراهب)
الله لا يريدنا أن نحزن بوجع القلب، بل بالأحرى، يريدنا لفرط حبه لنا أن نبتهج بفرح النفس. أطرح عنك الخطية، تصبح الدموع لا لزوم لها، فحيث لا يكون جرح، فلا حاجة هناك إلى مرهم. آدم قبل السقوط لم يكن يسكب الدمع، وهكذا لن تكون هناك دموع بعد القيامة من الأموات، حينما تكون الخطية قد أبيدت ويكون الألم والحزن والتنهد قد هربوا.
(القديس يوحنا الدرجى)
المجد المدعو له الإنسان، هو أنه ينبغى أن ينمو فى مشابهته لله، بأن ينمو دومًا أكثر، ليصير إنسانيًا أكثر. (الأب ديمترى ستانيلو)
[1] المذهب القائل بأن الله والوجود أو الكون شئ واحد (المعرب).