التفسير الأليجوري والتفسير التيبولوجي – د. أنطون جرجس عبد المسيح
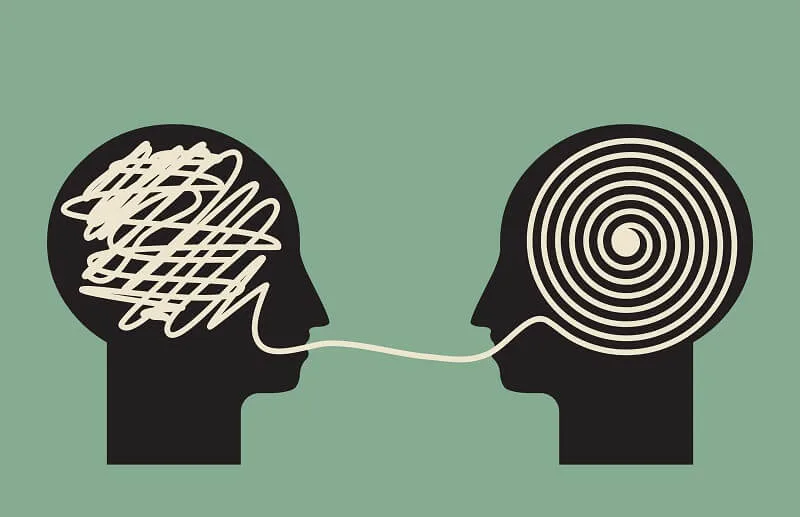
التفسير الأليجوري والتفسير التيبولوجي
عند آباء الكنيسة[1]
لقد أثرت ترجمة هذا الجزء من كتاب ”العقائد المسيحية المبكرة“ للتعرف على أهم ملامح التفسير الأليجوري (الرمزي) والتفسير التيبولوجي (النماذجي) عند آباء الكنيسة، وذلك للوقوف على أفضل تصور عن أساليب تفسير الكتاب المقدس في الكنيسة الأولى. حيث يبدأ نص الجزء المترجم كالتالي:
لقد أُعطي أسلوب التفسير المفترض مسبقًا في القسم السابق في الأزمنة الحديثة الاسم المناسب ألا وهو ”التفسير التيبولوجي“ Typology. لقد استخدم الآباء أنفسهم مصطلحات متنوعة لوصفه، ربما بشكل رئيس ”التفسير الأليجوري“ Allegory، الذي أقترحه لهم قول ق. بولس[2] بأن قصة ابني إبراهيم كانت ”أليجورية“ أي رمزية للعهدين.
ومع ذلك، إنه من الأفضل تجنب ”التفسير الأليجوري“ في هذه الصلة، حيث قادت الكلمة إلى التشويش حتى في العصر الآبائيّ، بينما يشير معناها المقبول الآن إلى نوع مختلف قليلاً من التفسير عن التفسير التيبولوجي (النماذجي)، حيث استخدم الآباء كل من التفسيرين الأليجوري والتيبولوجي (بمعناه الحديث)، وبالتالي هناك حاجة لإظهار التمييز بين الأسلوبين بشكل واضح.
حيث أنه في التفسير الأليجوري (الرمزي)، يتم معاملة النص المقدس على أنه رمز أو مجاز محض للحقائق الروحية. حيث يلعب المعنى الحرفي والتاريخي، إن تم آخذه في الاعتبار على الإطلاق، دور صغير نسبيًا، كما أن هدف المفسِّر هو استخراج واستنباط المعنى الأخلاقي، أو اللاهوتي، أو المستيكي (السري)، الذي من المفترض أن كل عبارة، وكل جملة في الواقع، بل وحتى كل كلمة تحتويه.
المثال الكلاسيكي هو تفسير أوغسطينوس الشهير[3] لمثل السامري الصالح؛ الذي وفقًا له، يرمز المسافر إلى آدم، وترمز أورشليم إلى المدينة السمائية التي نزل منها، وترمز أريحا إلى موته الناتج، ويرمز اللصوص إلى إبليس وملائكته، بينما ترمز الحالة البائسة التي تركوه فيها إلى الحالة التي أنحدر إليها بالخطية، ويرمز الكاهن واللاوي إلى الخدمات الباطلة في العهد القديم، ويرمز السامري إلى المسيح، ويرمز الفندق إلى الكنيسة، وهكذا.
تثبت التفسير الأليجوري (الرمزي) بقوة في اليهودية السكندرية، وكما قد رأينا، جعل فيلون الاستخدام النظامي له لملء الفجوة بين إعلان العهد القديم وفلسفته المتأثرة بالأفلاطونية. وهكذا بين يدي مثل هذا الكاتب المسيحي، مثل: ”برنابا“، كانت الأليجورية الفيلونية قادرة على الكشف عن إشارة مسيحية في العبارات الأقل احتمالاً من العهد القديم.
ولقد كان حتى الغنوسيون المسيحيون أكثر جرأة في تطبيق التفسير الأليجوري (الرمزي) على العهد الجديد؛ مفسِّرين أحداث ووقائع حياة يسوع الأرضية بأسلوب معقَّد من الرمزية يعكس دراما الأيونات. وهكذا عندما يقرر ق. يوحنا بأن الرب ”نزل إلى كفر ناحوم“، يستنتج المفسِّر الغنوسي هيراكليون[4] Heracleon من الفعل ’نزل‘، أن كفر ناحوم لا بد من أنها تشير إلى الطبقة الأدنى من الحقيقة، أي عالم المادة، وأن السبب من وراء أن المسيح بشكل واضح، لم ينجز أو يقل أي شيء هناك، لا بد أنه بسبب أن النظام المادي كان غير مناسب له.
لقد عمل التفسير التيبولوجي (النماذجي) على طول خطوط مختلفة جدًا. وبشكل أساسي، لقد كان أسلوبًا لإبراز التطابق بين العهدين، وأخذ كمبدأ إرشاديّ له، فكرة أن أحداث وشخصيات العهد القديم كانت ’نماذجًا‘؛ أي نماذج نبوية سابقة لأحداث وشخصيات العهد الجديد. كما أخذ المُفسِّر التيبولوجي (النماذجي) التاريخ بشكل جديّ؛ حيث كان عبارة عن مشهد للكشف المتقدم عن غاية الله الثابتة للفداء.
لذا أفترض أنه، من الخليقة إلى الدينونة، يمكن تمييز نفس الخطة الثابتة في الرواية المقدسة، وهكذا تكون المراحل السابقة عبارة عن ظلال، أو تتفاوت ما بين مجاز ومخططات أكثر تمهيدًا للمراحل التالية. فالمسيح وكنيسته كانا ذروة الأحداث، لأن الله في جميع تعاملاته مع الجنس البشريّ، كان يحرِّك الأحداث نحو الإعلان المسيحي، ولقد كان من المنطقي الكشف عن مؤشراته في الخبرات العظيمة لأناسه المختارين.
ولم يكن هذا المفهوم، الذي ينبغي ملاحظته، اختراعًا من اللاهوتيين المسيحيين. حيث أنه في العهد القديم نفسه، تم تفسير أحداث ماضي إسرائيل على أنها استعارات أو رموز للحقائق الآتية، حيث نظر سفر إشعياء الثاني[5] (إش51: 9-16) بشكل محدَّد للوراء إلى الخلاص من مصر، على أنه مُلخَّص، كما إن جاز التعبير، لانتصار الله الأصلي على الفوضى والتشويش، وتطلع إلى خروجٍ ثانٍ من العبودية والأسر في المستقبل وتجديد الخليقة.
بينما كانت النتيجة المباشرة له هي أن التفسير التيبولوجي (النماذجي)، بخلاف التفسير الأليجوري (الرمزي)، لم يكن لديه الميل إلى التقليل من قيمة والاستغناء قليلاً جدًا عن المعنى الحرفي للكتاب المقدس. وكان هذا على وجه التحديد لأن الأحداث المحدَّدة هناك قد حدثت بالفعل في خطة التاريخ، بحيث يمكن تفسيرها بعين الإيمان كمؤشرات موثوقة إلى تعاملات الله المستقبلية مع البشر.
ولقد كان من هذين الأسلوبين في التفسير، التفسير المسيحي المميَّز هو التفسير التيبولوجي (النماذجي)؛ الذي له جذوره المغروسة بقوة في المشهد الكتابي للتاريخ. حيث أنه في صراعها مع أتباع ماركيون، وجدت الكنيسة أنه سلاح ثمين في مواجهة محاولتهم لفصل العهدين. وبشكل طبيعي، واجهت صعوبات كبيرة، أهمها ربما في تحديد؛ في ضور المعايير المنطقية، أي ما هي السمات في العهد القديم التي يجب اعتبارها على أنها ”تيبولوجية“ (نماذجية) أصلية.
كما لم يكن الآباء على دراية دائمًا؛ أقل قدرة على الحل، حيث أن هذه، والعديد من مقالاتهم في التفسير التيبولوجي (النماذجي) تصدم المرء بأنها ساذجة واعتباطية، بالرغم من أن هذه كانت الصيغة، باستمرار على الرغم من التحسُّس في كثير من الأحيان (عادةً أيضًا، كما سنرى، بمساعدة مبادئ أخرى أقل تقنينًا)؛ التي طبَّقوها على تفسير الكتاب المقدس.
لقد كان من المألوف التمييز بين المدارس المختلفة للتفسير الآبائي، بشكل خاص المدرسة السكندرية بنزعتها نحو التفسير الأليجوري (الرمزي)، والمدرسة الأنطاكية بشغفها نحو الحرفية. على الرغم من أن هذا التباين هو -لا يجوز التعديل عليه لدرجة التغاضي عن الوحدة الأساسية- من نهج الآباء في تناول الإعلان الكتابي.
لقد كان ثمة اتفاق عام بشأن أمور جوهرية، مثل أن آدم، وموسى أيضًا معطي الناموس، قد أشارا بمعنى حقيقي إلى المسيح؛ كما أشار الطوفان إلى المعمودية، وإلى الدينونة أيضًا، جميع ذبائح الناموس القديم، ولكن بطريقة واضحة ذبيحة إسحاق، كانت إشارات مسبقة إلى ذبيحة الجلجثة؛ وأشار عبور البحر الأحمر وآكل المن إلى المعمودية والإفخارستيا؛ كما تنبأ سقوط أريحا عن نهاية العالم.
ويمكن التوسع في قائمة الأمور المشابهة تقريبًا إلى آجل غير مسمى، لأن الآباء لم يكونوا مهمومين أبدًا باكتشافهم والخوض فيهم -لقد كانوا مجمعين على الاعتقاد بأن ما دعاه أوريجينوس[6] بـ ”السر اليهوديّ (أو التدبير) في كماله“، كان، إن جاز التعبير، بروفة للسر المسيحيّ.
مع ذلك، الصعوبات الملازمة للتفسير التيبولوجي (النماذجي) جعلت التحول إلى التفسير الأليجوري (الرمزي) جذَّابًا للغاية، بشكل خاص حيث كانت البيئة الثقافية هي هيلينية ومخصَّبة بمثالية أفلاطونية، وبنظريتها حول أن النظام المرئي كله هو انعكاس رمزيّ للحقائق غير المرئية. لذا ليس من المستغرب أن أغلب الآباء أدخلوا نزعة التفسير الأليجوري (الرمزي)، وبعضهم أدخل نزعة قوية إلى تفسيرهم التيبولوجي (النماذجي).
لقد صارت مدينة الإسكندرية، المشهورة بمدرستها للموعوظين في القرنين الثاني والثالث اللاحقين، موطنًا للتفسير الأليجوري (الرمزي) مع الباحث الكتابي الكبير أوريجينوس، كمُمثِّله الرئيس. وكعاشقٍ[7] لفيلون، أعتبر[8] الكتاب المقدس كمحيطٍ واسعٍ، أو (مُستخدمًا صورة مختلفة) كغابةٍ فسيحةٍ من الأسرار، حيث كان من المستحيل سبر غوارهم أو حتى إدراكهم ككل، ولكن قد يكون المرء متأكدًا من أن كل سطر، وكل كلمة، كتبها الكُتَّاب القديسون مُشبَعة بمعنى ومغزى.
بشكل أساسي، ميَّز[9] بين ثلاث مستويات من الدلالة في الكتاب المقدس، متطابقة مع الأجزاء الثلاثة التي تتكوَّن منها الطبيعة البشرية: الجزء الجسدي، والجزء النفسي، والجزء الروحي. كان الجزء الأول هو المعنى التاريخي البسيط، وكان نافعًا للناس البسطاء، وكان الجزء الثاني هو المعنى الأخلاقي، أو العبرة من النص من أجل الإرادة؛ وكان الجزء الثالث هو المعنى المستيكي (السري) المتعلق بالمسيح، أو الكنيسة، أو حقائق الإيمان العظمى.
بالممارسة العملية، يبدو أن أوريجينوس قد استخدم تصنيفًا ثلاثيًا مختلفًا بعض الشيء يحتوي على: 1. المعنى التاريخي الصريح، 2. والمعنى التيبولوجي (النماذجي)،[10] 3. والمعنى الروحي، حيث يمكن تطبيق النص على النفس التقية. لذا عندما يصرخ مرنم المزمور (مز3: 4) ”أَيُهَا الرَّبُّ عَونِي، وَمَجْدِي، وَرَافِعُ رَأسِي“، يشرح[11] إنه في المقام الأول، داود هو المتحدث؛ ولكن ثانيًا، إنه المسيح الذي يعلم بأنه في آلامه، سوف يحفظه الله؛ ثالثًا، إنه كل نفس بارة تجد مجدها في الله عن طريق الاتحاد بالمسيح.
وهذا ليس إلا مثال واحد لأسلوب التفسير الذي كان قادرًا بين يدي أوريجينوس على تشعبات وتعقيدات تقريبًا لا حصر لها. هناك أسلوب آخر ربما في تفسيراته[12] للمحرقة والذبيحة التي حدَّدها الناموس كإشارة إلى: 1. ذبيحة المسيح، 2. الذبيحة التي ينبغي على كل مسيحي، من خلال إتباع المسيح، أن يعيد إنتاجها ويتممها في قلبه. لذا فإنه من الواضح أنه، من خلال العمل على هذه الخطوط، لن يكون هناك حدًا للرمزية التي كان قادرًا على الكشف عنها في الكتاب المقدس.
في الواقع، إنه يوضِّح[13] نقطة أنه، بفضل الأسلوب الأليجوري (الرمزي)، يمكن تفسيره (أي الكتاب المقدس) بطريقة تليق بما للروح القدس؛ لأنه ليس من اللائق آخذ رواية أو وصية بالمعنى الحرفي بما لا يليق بالله. ولم يكن حقيقة، كما يُدَّعى أحيانًا، بأنه أغفل المعنى الحرفي، بالرغم من أنه قد يكون راضيًا[14] بأنه، في عدد من الحالات، غير مقبول. مع ذلك، لقد كان ميَّالاً بلا شك إلى أن ينسب أيضًا دون تردد إلى وحي الروح الرمزية الروحية الخيالية، التي أكتشفها خياله الخصب تقريبًا في كل كلمة أو صورة من الكتاب المقدس.
كما بدا له كل اسم مناسب، وكل عدد، وكل الحيوانات، والنباتات، والمعادن المذكورة هناك إنها استعارات لحقائق لاهوتية أو روحية. أخيرًا، لم يسع[15] فقط إلى إيجاد معنى روحي، علاوة على المعنى الحقيقي الواضح في الأناجيل، بل هو على استعداد[16] أحيانًا لاستعارة الأسلوب الغنوسي في رؤية مراحل حياة المسيح كصورة أو مثال للأحداث المصنوعة في العالم الروحي.
بالرغم من أنه كان في البداية رجلاً كنسيًا مخلصًا وأرثوذكسيًا، إلا أن النزعة الأفلاطونية في افتراض أوريجينوس بأن الكتاب المقدس خليط من الرمزية لا يمكن إخفائها. بينما سلفه، كليمندس، لم يكن مُفسِّرًا على نحو دقيق، مُتوقعًا أسلوبه والعديد من أفكاره الرائدة عن التفسير. كما شرح[17] نظرية أن جميع الحقائق الأسمى يمكن التعبير عنها من خلال الرموز، حيث قد استخدمهم موسى والأنبياء تمامًا بقدر استخدام الحكماء في مصر واليونان، ولا بد على تلميذ الكتاب المقدس المتقدم بشكل ديني أن يكون على إطلاع دائمًا بالمعنى الأعمق.
كان وراء هذا التعليم مفهومًا أفلاطونيًا، شاركه فيه أوريجينوس أيضًا، بأن هناك هيراركية الكيانات، بحيث أن الفكر الأدنى يمكن التعامل معه كرموز للفكر الأعلى.
اللاهوتيون السكندريون الذين تبعهما، من ديونيسيوس إلى كيرلس، كانوا جميعًا بدرجة أكبر أو أقل متأثرين بنزعتهما إلى التفسير الأليجوري (الرمزي)، ويمكن قول نفس الشيء على الآباء الفلسطينيين (ولكن كان إبيفانيوس استثناءً ملحوظًا) والآباء الكبادوكيين. وهكذا من خلال تأثيرهم، عَبَرَ التقليد الأليجوري (الرمزي) إلى الغرب، فهو ظاهر في الكتابات التفسيرية، على سبيل المثال، لهيلاري وأمبروسيوس.
جيروم، المفسِّر اللاتيني الأكبر، بالرغم من أنه صار مُتشكِّكًا في التفسير الأليجوري (الرمزي) في أيامه الأخيرة، إلا أنه قَبِلَ[18] معاني أوريجينوس الثلاثة للكتاب المقدس، مُعتبرًا[19] أن اللجوء إلى المعنى الروحي صار ضروريًا من أجل الصور المُجسِّمة للاهوت، والتناقضات، والتضاربات، التي يذخر بها الكتاب المقدس. كما استخدم أوغسطينوس التفسير الأليجوري (الرمزي) بحرية أكبر، مولعًا على وجه التحديد بالدلالة السرية للأسماء والأعداد.
ويبدو أنه قد تمسك[20] بأن نفس العبارة في الكتاب المقدس يمكن أن تحوي معاني مختلفة عديدة، جميعهم أراده الروح القدس. وبمسحة تقليدية أكثر، عدَّد[21] (أي أوغسطينوس) أربعة معاني في الكتاب المقدس: المعنى التاريخي، والمعنى ’السببيّ‘ (مثال على ذلك هو تفسير المسيح في مت19: 8 لأسباب سماح موسى بكتاب طلاق)، والمعنى القياسي (التناظري) (الذي يبرز الانسجام الكامل بين العهدين القديم والجديد)، والمعنى الأليجوري (الرمزي) أو المجازي.
وقاعدته في تحديد سواء المعنى الحرفي أو المعنى المجازي كانت أكثر صحة، وكانت أنه أيا كان ما يبدو أنه متناقض، إنْ أؤخذ بالمعنى الحرفي، فلا بد من آخذه بالمعنى المجازي بحسب أدب واستقامة الحياة، أو نقاوة التعليم. بوجه عام، أعتقد[22] (أي أوغسطينوس) بأنه لا يمكن أن يكون التفسير صحيحًا، ما لم يدعم ويحض على محبة الله، أو محبة الإنسان.
رد الفعل الأنطاكي
هكذا كان تقليد التفسير الأليجوري (الرمزي) مؤسَّسًا بشكل آمن في الكنيسة، بالرغم من أن أغلب ممثليه اللاحقين، كانوا أكثر تحفظًا من أوريجينوس، مبتعدين عن غلوه الأكثر جموحًا. بالرغم من ذلك، هناك رد فعل عنيف ضد كل نوع من التفسير الأليجوري (الرمزي) صار ظاهرًا في القرنين الرابع والخامس. وكان مركزه هو أنطاكية، أي المطرانية (الميتروبوليتية) الكنسية في سوريا، حيث تم إنشاء تقليد دراسة الكتاب المقدس، باهتمام شديد الدقة للنص، منذ أيام لوكيان Lucian (استشهد عام 312م).
وكان اللاهوتيون الرئيسون المهتمون بذلك هم ديدور الطرسوسي (330- 390م)، وثيؤدور الموبسوستي (350-428م)، وثيؤدوريت (393-460م)، ولكن توجد الصورة التوضيحية العملية للمنهج الأنطاكي في عظات واعظ مثل: يوحنا ذهبي الفم (347- 407م)، بغض النظر عن الاختلافات في التشديد على ذلك، كانت المدرسة بأكملها متوحدة حول الاعتقاد بأن التفسير الأليجوري (الرمزي) كان أداة غير موثوق فيها وغير مُقنَّنة بالفعل لتفسير الكتاب المقدس.
كان المفتاح الحقيقي لرسالته الروحية الأعمق -لم يكن هذا واضحًا تمامًا، كما في النبوة الأصلية- هو ما يدعونه بـ ”الثيؤريا“ Insight أي الاستبصار Θεωρία. وقصدوا بهذا قوة إدراك حقيقة روحية، علاوة على الحقائق التاريخية الواردة في النص، التي تم تصميمها للإشارة إليها. وهكذا قَبِلوا تيبولوجية (نماذجية) ملائمة -في الحقيقة، التعريف الكلاسيكي للنموذج على أنه ”نبوة مُعبَّر عنها بمصطلحات الأشياء“ (ή διά πραγμάτων […] προφητεία) صاغه ذهبي الفم[23]– ولكنه حاول تخليصه من استخدامه اعتباطيًا.
لأنهم اعتبروا ممارسة الثيؤريا theoria (أي الاستبصار) ضروريًا: 1. فلا يجب إهمال المعنى الحرفي للرواية المقدسة، 2. يجب أن يكون ثمة تطابق حقيقي بين الحقيقة التاريخية والهدف الروحي المُلاحَظ إلى حد بعيد، 3. يجب أن يتم تدارك هذين الهدفين معًا، بالتأكيد بطريقتين مختلفتين على الرغم من ذلك.
يتضح التناقض الذي صنعه الأنطاكيون بين التفسير الأليجوري (الرمزي) والثيؤريا theoria (أي الاستبصار) في تعليق ساويريانوس أسقف جبله Severian of Gabbala (أزدهر عام 400م) مُعلِّلاً التوازي الذي رسمه بين الكائنات ”التي أخرجتها المياه“ (تك1: 21)، والمسيحيين الذين تم تجديدهم بالمعمودية، حيث يقول:[24] ”إجبار التفسير الأليجوري (الرمزي) على الخروج عن التاريخ شيء، والحفاظ على صحة التاريخ أثناء تمييز الثيؤريا theoria التي تفوقه شيء آخر تمامًا“.
كما يبرز ذهبي الفم نفس النقطة، عندما يُقسِّم[25] الأقوال الكتابية إلى: 1. تلك التي تسمح بالمعنى الثيؤري (الاستبصاري) علاوة على المعنى الحرفي، 2. وتلك التي يجب فهمها على حدة بالمعنى الحرفي، 3. وتلك التي تسمح فقط بمعنى غير المعنى الحرفي أي الأقوال الأليجورية (الرمزية). بصيغة ديدور،[26] ”نحن لا نمنع التفسير الأسمى والثيؤريا theoria (أي الاستبصار)؛ لأن الرواية التاريخية لم تستبعده، بل هو على العكس أساس وقاعدة التأملات العليا […]“.
مع ذلك، لا بد أن نكون على أهبة الاستعداد ضد السماح للثيؤريا (أي الاستبصار) بإلغاء الأساس التاريخيّ؛ لأن النتيجة لن تكون ثيؤريا (أي استبصار)، بل تفسير أليجوري (رمزي). بالانسجام مع ذلك، أعترف[27] (أي ديدور) صراحةً بصحة تناول قايين كنبوة عن مجمع السنهدريم، وهابيل كنبوة عن الكنيسة، والحمل الذي بلا عيب الذي أمر الناموس به كنبوة عن المسيح.
على نحو مماثل، لاحظ[28] ثيؤدور في رش الإسرائيليين أبوابهم بالدم عند الخروج إشارة أصيلة عن خلاصنا بدم المسيح، وفي الحية النحاسية نموذج لغلبة الرب على الموت؛ بينما وافق على أنه في تجارب يونان، أشار الله مسبقًا إلى دفن وقيامة المسيح، ودعواته إلى الحياة الأبدية للجنس البشريّ.
وكمُنظِّرين للحركة، كان ديدور وثيؤدور الأكثر تشددًا في تطبيق مبادئها. وكانت النتيجة هي إزالة جميع التفسيرات الأليجورية (الرمزية) أو الاستعارية المحضة من العهدين القديم والجديد، والتقيُّد الشديد بكل من العناصر النبوية والتيبولوجية (النماذجية) الدقيقة في العهد القديم.
حيث رفض ثيؤدور، على سبيل المثال، الاعتراف بمثل هذه النصوص المقبولة بشكل تقليديّ، مثل: (هو2: 1؛ مي4: 1-3؛ 5: 1؛ حج2: 9؛ زك2: 12-14، 12: 10؛ مل1: 2، 4: 5)، كنصوص مسيانية مباشرة؛ لأنهم لم يتطابقوا مع معاييره الدقيقة، حيث أعطت سياقاتهم (كما أَعتقد) تفسيرًا تاريخيًا كافيًا بشكل كامل. على نحو مماثل، أنقص[29] عدد المزامير؛ التي سمح بأن تكون مزامير نبوية بشكل مباشر عن التجسُّد والكنيسة، إلى أربعة مزامير (مز2؛ 8؛ 45؛ 110).
وفي حالة المزامير الأخرى (مثل: مز 21؛ 2؛ 69؛ 22)، التي قد تم تطبيقها على المخلص سواء بواسطة الكُتَّاب الرسوليين، أو بواسطته هو نفسه، حيث أوضَّح[30] أنهم أعاروا أنفسهم لهذا الاستخدام، وليس لأنهم نبويون، بل لأن مرنم المزمور قد كان في مآزق روحي مشابه.
ولكنه كان مستعدًا للقبول بأن بعض المزامير (مثل: مز16؛ 55؛ 89)، والنبوات (مثل: يوء 2: 28؛ عا9: 11؛ زك9: 9؛ مل3: 1)، على الرغم من ذلك، ليست مسيانية؛ إنْ أؤخذت بالمعنى الحرفي، بل يمكن تفسيرها بشكل جائز على هذا النحو بقدر ما هي كانت نماذجًا وصلت إلى إتمامها الحقيقي في الإعلان المسيحيّ. موقفه من سفر النشيد؛ الذي يتم اعتباره تقريبًا في كل مكان كرمز إلى الكنيسة، أو كرمز إلى علاقة محبة النفس للمسيح، كان متحفظًا على حد السواء.
حيث أصَّر على أنه لا بد من إعطاء الوزن الكامل لمعناه الحرفي الظاهر، حيث أنه كان في الواقع قصيدة ألَّفها سليمان للاحتفال بزواجه من الأميرة المصرية، ولكن لا يوجد سبب للتخمين، كما كان في انتقاداته الأخيرة، بأنه قد استبعد إمكانية تفسير روحي أيضًا. من ناحية أخرى، لا بد من الاعتراف بأن موقفه، مثل موقف ديدور، قد كان موقفًا متطرفًا. أنطاكيون آخرون مقنعون، مثل ذهبي الفم وثيؤدوريت، بينما كانوا مخلصين إلى مبادئ المدرسة، إلا أنهم شعروا في أنفسهم بأنهم أحرار في تطبيقها بطريقة أكثر مرونة.
السابق (أي ذهبي الفم) بينما يصرح بتفضيله الواضح للمعنى الحرفي، لم يكره[31] في بعض الأحيان التنويه إلى المعنى الرمزي أيضًا. أما الأخير (أي ثيؤدوريت) كان على استعداد أكثر من ثيؤدور للاعتراف[32] بالعنصر النبوي في المزامير، ويؤكد[33] على أن سفر النشيد هو ”عمل روحي“، أكثر من كونه قصيدة غرامية إنسانية واقعية.
مراجع هذا المقالة
—–G. Bandy, “Interpretation chez les pere”, (art. In Dict. De la Bible: Suppl.)
—–J. Danielou, Origen (Eng. Trans. London, 1955)
—–Sacramentum Futuri (Paris, 1950)
—–“the Fathers & the Scriptures”, (art. In Theology, 1954)
—–R. Devereese, Le Commentaire de Theodore de Mopsuesta sur les psames (Vatican city, 1939)
—–R. M. Grant, The letter & The Spirit, (London, 1957)
—–C. H. Dodd, According to the Scriptures, (London, 1952)
—–R. P. C. Hanson, Allegory & Event, (London, 1959)
—–G. W. H. Lampe & J. Woollcombe, Essays on Typology, (London, 1957)
—–H. de Lubac, “Typologie et allegorisme”, (art. In Rech. Sc. Relig., 1974)
—–A. Vaccari, “La Θεωρία antiochena nella Scoula esegetica di Antiochia, (art. In Biblica, 1920 & 1934)
—–M. Wiles, The Spiritual Gospel, esp. Chap. 3, (Cambridge, 1960)
[1] تمت ترجمة هذا الجزء من:
Kelly, J. N. D., Early Christian Doctrines, (London: Adam & Charles, 1968), p. 69-78.
[2] غلا4: 24.
[3]Quaest. Evang. 2, 19.
[4] Cf. Origen, in Ioh. 10, 48-59.
[5] مثل إش51: 9-16.
[6] Hom. In Ierem. 10, 4.
[7] Cf. comm. In Matt. 15, 3.
[8] Hom. In Ex. 9, 1; in Gen. 9, 1; in Ezech. 4, 1.
[9] De princ. 4, 2, 4; Cf. in Matt. 10, 14; hom. In Lev. 5, 5.
[10] E. g. hom. In Num. 8, 1, (Baehrens, 49).
[11] E. g. in Cant. 2 (Barhrens, 165).
[12] Sel. In ps. 3, 4.
[13] Hom. In Lev. 1, 4 f.
[14] De princ. 4, 2, 2; hom. In Num. 26, 3; hom. In Ierem. 12, 1. E. C. D. -3a.
[15] De princ. 4, 2, 5.
[16] E. g. c. Cels. 2, 69.
[17] E. g. in Ioh. 10, 9; 13, 59; etc.
[18] Cf. strom. 5 passim.
[19] Ep. 120, 12: cf. in Am. 4, 4; in Ezech. 16, 31.
[20] In Matt. 21, 5; in Gal. 5, 13.
[21] Confess. 12, 42; de doct. Christ. 3, 38.
[22] De util. cred. 5-8.
[23] E. g. de doct. Christ. 3: esp. 3, 14; 3, 23.
[24] De poenit. Hom. 6, 4: cf. in ps. 9, 4.
[25] De creat. 4, 2 (PG 56, 459).
[26] Praef. In pss. (ed. L. Maries, Recherches de science religieuse, 1919), p. 88.
[27] Art. Cit. p. 88.
[28] In Ion. Praef.; 8 ff. (PG 66, 320f.; 337-340).
[29] Cf. R. Devreesse, Esssai sur Theodore de Mopsuesta, (Studi e Testi, 141, 1948), pp. 70 ff.
[30] Cf. in Rom. 9, 14-21.
[31] Cf. in Is. 1, 22; 6, 6.
[32] In pss. Prol.
[33] In Cant. Prol.
