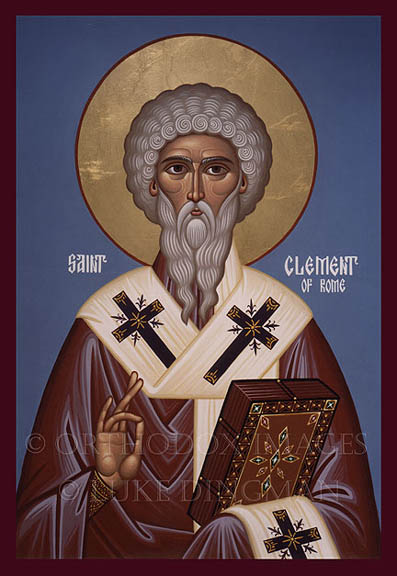العثرات والغفران للمخطئين – إنجيل لوقا 17 ج1 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
العثرات والغفران للمخطئين – إنجيل لوقا 17 ج1 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
العثرات والغفران للمخطئين – إنجيل لوقا 17 ج1 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد

(لو17: 1ـ3): ” وَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ: لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ الْعَثَرَاتُ وَلَكِنْ وَيْلٌ لِلَّذِي تَأْتِي بِوَاسِطَتِهِ!. خَيْرٌ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنُقُهُ بِحَجَرِ رَحىً وَطُرِحَ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنْ يُعْثِرَ أَحَدَ هَؤُلاَءِ الصِّغَارِ. اِحْتَرِزُوا لأَنْفُسِكُمْ. وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَبِّخْهُ وَإِنْ تَابَ فَاغْفِرْ لَهُ “.
ما هي العثرات التي يقول عنها المسيح إنها ستحدث بالتأكيد؟ العثرات نوعان: بعض العثرات هي ضد مجد الكائن الأعلى وتهاجم ذلك الجوهر المتعالي على الكّل، وذلك حسب غرض الذين يتسببّون فيها، بينما عثرات أخرى تحدث بين الحين والآخر ضد أنفسنا ولا تتعّدى أن تكون إيذاء لبعض الإخوة الذين هم شركاؤنا في الإيمان. لأنه أيًّا كانت الهرطقات التي اُبتدعت وكل مجادلة تقف ضد الحق، فهي في الحقيقة تقاوم مجد الألوهية الفائقة، باجتذابها أولئك الذين يسقطون فيها بعيدًا عن استقامة العقائد المقدَّسة وسلامتها. وهذه هي العثرات التي قال المخلّص نفسه عنها في موضع ما: ” الويل للعالم من العثرات، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة” (مت 7:18). فالعثرات من هذا النوع، التي يسببّها الهراطقة عديمّي التقوى ليست موجهة ضد فرد واحد، بل هي موجهة بالأكثر ضد العالم كله، أي ضد سكان الأرض كلها. وبولس المغبوط يوبّخ مخترعي مثل تلك العثرات بقوله: ” وهكذا إذ تخطئون إلى الاخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح ” (1كو 12:8). ولكي لا تسود مثل هذه العثرات على المؤمنين، تكلّم الله في موضع ما إلى الذين هم سفراء لكلمة الحق المستقيمة، الماهرين في تعليمها قائلاً: ” اعبروا بالأبواب، هيئوا طريقًا لشعبي، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة ” (إش 10:62). والمخلِّص قد جعل عقوبة مُرّة على من يضعون مثل هذه المعاثر في طريق الناس.
وربما لا تكون هذه هي العثرات التي يُشار إليها هنا، بل بالحرى هي تلك العثرات التي تحدث كثيرًا بسبب الضعف البشرى بين الأصدقاء والإخوة؛ وهذا الحديث الذي يتبع هذه الملاحظات الافتتاحية مباشرة، والذي يتحدّث عن غفراننا للإخوة عندما يخطئون إلينا، يقودنا إلى تلك الفكرة بأن هذه هي العثرات المقصودة هنا. إذن فما هي هذه العثرات؟ أنا أعتقد أنها أفعال خسيسة ومزعجة، مثل نوبات غضب سواء كانت لسبب ما أم كانت بلا مبرر، إهانات، اغتيابات كثيرة، وعثرات كثيرة أخرى قريبة لهذه ومشابهة لها. والرّب يقول إن مثل هذه العثرات لابد أن تأتي، فهل تأتي إذن، لأن الله، الذي يضبط الكلّ، يُجبر الناس على ارتكاب هذه العثرات؟ حاشا لله أن يصدر منه شيء شرير، بل بالأحرى فهو ينبوع كل فضيلة، فلماذا إذن يتحتّم أن تأتي؟ واضح أنها ـ بسبب عجزنا، كما هو مكتوب: ” لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا” (يع 2:3). وبالرغم من هذا فهو يقول: ويل للإنسان الذي يضع أحجار عَثْرة في الطريق، فالرّب لا يترك عدم المبالاة في هذه الأمور بدون توبيخ، بل هو بالأحرى يكبّحه بواسطة الخوف من العقوبة، ورغم ذلك فهو يوصينا أن نحتمل الذين يسببونها، بصبر.
(لو4:17 ): ” وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ قَائِلاً: أَنَا تَائِبٌ فَاغْفِرْ لَهُ “.
يقول الرّب إن كان الذي يخطئ ضدك، يتوب ويقّر بخطئه فاغفر له، وذلك ليس مرّة واحدة فقط، بل مرّات عديدة جدًّا، لأننا يجب ألاّ نُظهر أنفسنا ناقصين في المحبّة المتبادلة ونهمل الاحتمال. فكلنا ضعفاء ونخطئ مرارًا وتكرارًا، لذلك يجب بالأحرى أن نتشبّه بأولئك الذين يشتغلون بمعالجة أمراضنا الجسديّة، فهؤلاء لا يعتنون بالمريض مرّة واحدة فقط ولا مرتيّن، بل بعدد المرّات التي يمرض فيها. فلنذكر أننا نحن أيضًا عُرضّة للضعفات وأننا ننغلب من شهواتنا، وإن كان الأمر هكذا، فنحن نرجو أن أولئك الذين من واجبهم أن يوبّخونا والذين لهم السلطان أن يعاقبونا، يُظهِرون أنفسهم عطوفين علينا وغافرين لنا. لذلك فمن واجبنا ـ إذ لنا شعور عام فيما بيننا بضعفاتنا المشتركة ـ أن ” نحمل أثقال بعضنا البعض، وهكذا نتمّم ناموس المسيح” (غل 2:6). كما نلاحظ أيضًا أنه في الإنجيل بحسب متى، يسأل بطرس قائلاً: ” كم مرة يخطئ إليَّ أخي وأنا أغفر له”؟ ويخبر الرب الرسل عن هذا الأمر قائلاً: ” وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم “، أي يخطئ كثيرًا، فعلى قدر ما يقّر بخطئه اغفر له (انظر مت 21:18 و22).
(لو5:17 ): ” فَقَالَ الرُّسُلُ: زِدْ إِيمَانَنَا “.
إن ما يعطي فرحًا أكيدًا لأنفس القديسين ليس هو امتلاك الخيرات الأرضيّة الزائلة، فهي قابلة للفساد وتُفقد بسهولة؛ بل إن ما يعطيهم الفرح بالحري هو تلك الخيرات التي تجعل من ينالونها موقرين ومباركين، أي هي النعم الروحية التي هي عطية الله. والشيء الذي له قيمة خاصة بين هذه النعم هو الإيمان، وأعني به أن يكون لنا ثقة بالمسيح مخلّصنا كلنا، والذي يعتبره بولس الرسول أنه أساس كل بركاتنا؛ لأنه قال: ” بدون الإيمان لا يمكن إرضاؤه” (عب 6:11)، ” لأنه في كل هذا شُهِدَ للقدماء” (عب 2:11). لذلك انظروا الرسل القديسين في اقتدائهم بسلوك قديسّي العهد القديم، فما الذي يطلبونه من المسيح؟ ” زد إيماننا” هم لم يطلبوا مجرد الإيمان، لئلا تظنوا أنهم بلا إيمان، بل بالحرى طلبوا من المسيح زيادة لإيمانهم وأن يتقووا في الإيمان، لأن الإيمان يتوَقف علينا نحن من ناحية، وعلى هبة النعمة الإلهية من ناحية أخرى، لأن بداءته تعتمد علينا، وهكذا أيضًا استمرار الثقة والإيمان في الله بكل قوتنا؛ أما الثبات والقوة اللازمة لهذا (الثبات في الإيمان) فتأتي من النعمة الإلهية. ولهذا فلكون كل الأشياء ممكنة لدى الله. يقول الرب: ” كل شيء مستطاع للمؤمن” (مر 23:9). لأن القوة التي تأتي إلينا بالإيمان هي من الله. والطوباوي بولس إذ يعرف هذا، يقول أيضًا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: ” فإنه لواحد يُعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح” (1كو 8:12 و9). أنتم ترون أنه قد وضع الإيمان أيضًا في قائمة النعم الروحانية، وهذا ما طلب التلاميذ أن ينالوه من المخلّص، مساهمين من جهتهم أيضًا بأن يطلبوه؛ وهو من جهته قد منحهم إياه بعد اكتمال التدبير بحلول الروح القدس عليهم. فقبل القيامة كان إيمانهم ضعيفًا جدًّا لدرجة أنهم كانوا مُعرَّضين لأن يوصفوا بقلة الإيمان.
فعلى سبيل المثال، كان مخلّص الكّل يبحر ذات مرة في بحيرة طبرية مع الرسل الأطهار، وسمح لنفسه عن قصد بأن ينام، وعندما هبت ريح شديدة وصدمت الأمواج السفينة بعنف، اضطرب التلاميذ جدًّا، حتى أنهم أيقظوا الرب من النوم قائلين:” يا معلِّم نجنا فإننا نهلك” (لو 24:8)، فقام وانتهر الأمواج وحوَّل هياج العاصفة إلى هدوء، لكنه لاَمَ الرسل الأطهار جدًّا قائلاً لهم: ” أين إيمانكم؟” لأنه ما كان ينبغي لهم أن ينزعجوا بأي شكل كان طالما أن السيد المهيمّن على الكون والذي ترتعد وتتزلزل أمامه كل خلائقه ـ كان حاضرًا معهم. وإن كان يجب علينا أن نضيف مثلاً أخرً مشابهًا، فسأذكر واحدًا وهو الآتي: فقد أمر الرب الرسل القديسين أن يصعدوا إلى السفينة ويسبقوه إلى الجانب الآخر من البحيرة، وهم بالطبع فعلوا هكذا. وحينما كانوا قد جدّفوا نحو ثلاثين غلوة نظروا يسوع ماشيًا على البحر فخافوا جدًّا وظنوا أنهم رأوا خيالاً، لكن حينما ناداهم وقال لهم: ” أنا هو لا تخافوا”، قال له بطرس: ” إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال له تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشي على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلاً: ” يا رب نجني”، فأمسك به ونجاه من هذا الخطر، لكنه أيضًا وبخه قائلاً: ” يا قليل الإيمان لماذا شككت؟” (انظر مت 22:14ـ31، يو 19:6). ومن المعروف جيدًا أنه في أسبوع الآلام عندما جاء الجنود والخدام الأشرار ليقبضوا على يسوع، فإن الجميع تركوه وهربوا، وأن بطرس أيضًا أنكره لأنه ارتعد أمام جارية.
ها أنت قد رأيت التلاميذ بينما لم يكن لهم سوى قليل من الإيمان، والآن تعجَّب منهم بعدما حصلوا من المسيح مخلّصنا جميعًا على زيادة لإيمانهم: لقد أوصاهم أن ” لا يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب” (أع 4:1) إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي، ولكن حينما حلَّت عليهم القوة التي من الأعالي في شكل ألسنة نارية أي النعمة التي بواسطة الروح القدس، حينئذ صار التلاميذ بالحق شجعانًا وجسورين وحارين بالروح، حتى إنهم احتقروا الموت، بل وحسبوا الأخطار التي كانت تهدّدهم من غير المؤمنين، كلا شيء، بل وأيضًا صاروا قادرين على عمل المعجزات.