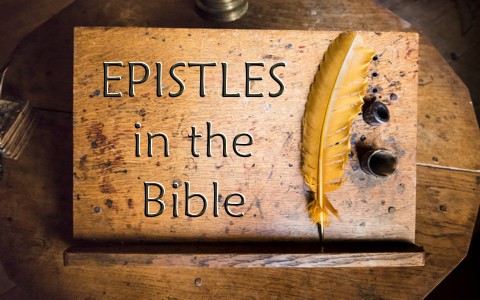عناية الله بمحبيه – إنجيل لوقا 12 ج2 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
عناية الله بمحبيه – إنجيل لوقا 12 ج2 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
عناية الله بمحبيه – إنجيل لوقا 12 ج2 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد

(لو12: 4ـ7): ” وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ يَا أَحِبَّائِي: لاَ تَخَافُوا مِنَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْثَرَ. بَلْ أُرِيكُمْ مِمَّنْ تَخَافُونَ: خَافُوا مِنَ الَّذِي بَعْدَمَا يَقْتُلُ لَهُ سُلْطَانٌ أَنْ يُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ. نَعَمْ أَقُولُ لَكُمْ: مِنْ هَذَا خَافُوا! أَلَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ وَوَاحِدٌ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ اللهِ؟. بَلْ شُعُورُ رُؤُوسِكُمْ أَيْضًا جَمِيعُهَا مُحْصَاةٌ! فَلاَ تَخَافُوا. أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ!“.
الذِّهن الصبور المحتمِل الشجاع، هو سلاح القديسين الذي لا يمكن اختراقه، لأنه يجعلهم مزكِّين ومتألِّقين بمدائح التقوى. أخبَرَنا أحد الرسل القديسين مرَّة قائلاً: ” بصبركم تقتنون أنفسكم ” (لو21: 19) وفى مرَّة أخرى: ” لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد” (عب10: 16). بمثل هذه الفضائل الرجولية نصير مشهورين وجديرين بالثناء، ولنا صيت بين الناس فى كل مكان، ومستحقين لكل الكرامات والبركات المعَدَّة للقديسين، وحتى تلك البركات التى ” لم ترها عين ولم تسمع بها أذن” (1كو2: 9) كما يقول الحكيم بولس، وكيف لا يجب أن تكون تلك الأشياء جديرة بالإعجاب والاقتناء، وهى تفوق كل فهم وكل عقل؟ لهذا كما قلت، فإن المسيح يهيئ[1] الذين يحبونه للثبات الروحى فيقول: ” أقول لكم يا أحبائي”.
إن حديث المسيح الحالى، كما يتبين، لا يخص كل أحد حتمًا بل على العكس إنه فقط لمن يحبونه بوضوح بكل قلبهم، ويستطيعون أن يقولوا بحق: ” من سيفصلني عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف ” (رو8: 35). لأن هؤلاء الذين ليست لهم محبة وثيقة للمسيح وأكيدة ومؤسسة جيدًا، من الممكن أن يحتفظوا بإيمانهم بالمسيح في الأوقات الهادئة، ولكن متى أزعجتهم الضيقة أو اضطهاد قليل فإنهم يَعرِضون عنه ويهجرونه ويفقدون إيمانهم كما يفقدون الدافع الذي حرَّكهم لمحبته. وكما أن النباتات الصغيرة التى أينعت حديثًا لا تقدر أن تحتمل عنف الريح العاصفة لأنها لم تكن قد ضربت جذورها في العمق، بينما تلك التى ثبتت بمتانة وتأصَّلت جذورها تظل آمنة فى الأرض حتى ولو هزَّتها عاصفة من الرياح الشديدة، هكذا أيضًا هؤلاء الذين لم تثبت عقولهم بمتانة في المسيح، فإنهم يتركونه بسهولة، ويهجرونه بسرعة. أما الذين يختزنون ويمتلكون في عقلهم وقلبهم حبًا متينًا ثابتًا غير متزعزَع للمسيح، هؤلاء يكونون غير متغيِّرين في عقلهم ولهم قلب ثابت غير متذبذب. إذ يصيرون أعلى من كل تراخٍ، وينظرون بازدراء إلى أعظم المخاطر التى لا تُحتمل، ويسخرون من الأهوال، كما لو كانوا يهزأون برعبة الموت. فالوصيَّة هنا إذن تخص هؤلاء الذين يحبونه.
ولكن مَن هم هؤلاء الذين يحبونه؟ إنهم المشابهون له في فكرهم وهم مشتاقون أن يقتفوا خطواته. ولهذا فإن رسوله يشجِّعنا بقوله: ” إذ قد تألم المسيح من أجلنا بالجسد، تسلحوا أنتم أيضًا بهذه النيَّة” (1بط4: 1) إنه وضع نفسه عنا ” وكان بين الأموات غير مقيَّد” (انظر مز87: 5 س)، لأن الموت لم يهاجمه مثلما هاجمنا بسبب الخطية، لأنه منفصل بعيدًا عن كل خطية، وهو بلا إثم، ولكن بإرادته وحده احتمل الموت لأجلنا، بسبب حبه غير المحدود لنا، فلننصت إليه وهو يقول بوضوح: ” ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ” (يو15: 13)، فكيف لا يكون إذن أمرًا رديئًا جدًا ألاَّ نرُد إلى المسيح ـ كدَيْن ضروري علينا ـ ما قد نلناه منه؟
ولكي أضع الموضوع في ضوء آخر، فإنه يجب علينا، كأحبائه، ألا نخاف الموت ولكن بالحري نتمثل بإيمان الآباء القديسين. فإن أب الآباء إبراهيم لما جُرِّب، فإنه قدَّم ابنه الوحيد إسحق ” حاسبًا أن الله قادر على الإقامة من الأموات” (عب11: 19). فلذلك أي رعبة من الموت هذه التى يمكن أن تهجم علينا؟ بعد أن ” أبطلت الحياة الموت” (انظر 2تي1: 10). فالمسيح هو ” القيامة والحياة” (يو11: 25).
ويجب أيضًا أن نضع فى ذهننا أن الأكاليل يُظفر بها بالجهاد. إنَّ بذل الجهد الشديد متحدًا مع المهارة هو الذي يُكمَّل أولئك المصارعين الأقوياء في المباريات. إنها الجرأة والذهن الشجاع هما النافعان جدًّا لهؤلاء الماهرين في المعارك، بينما الرجل الذي يلقي عنه ترسه، فحتى أعداؤه يسخرون منه، وإن عاش الهارب فإنه يعيش حياة ملؤها الخزي، ولكن الذي يصمد في المعركة ويقف بجرأة وشجاعة وبكل قوته ضد العدو، فإنه يُكرَم إذا نال النصرة، وإن سقط فإنه يُنظر إليه بإعجاب. وهذا ما يجب أن نحسبه لأنفسنا، لأنه عندما نحتمل بصبر ونواصل المعركة بشجاعة فهذا يجلب لنا مكافأة عظيمة. وهو أمر مرغوب فيه جدًا، وننال منه البركات الممنوحة من الله. أما إذا رفضنا مكابدة الموت فى الجسد من أجل محبة المسيح، فهذا سوف يجلب علينا عقابًا دائمًا أو بالحري لا نهاية له، لأن غضب الانسان إنما يصيب الجسد على الأكثر، وموت الجسد هو أقصى ما يمكن أن يدبِّروه ضدنا، ولكن عندما يعاقِب الله، فإن الخسارة لا تصيب الجسد فقط، ولكن النفس التعيسة أيضًا تُلقى معها في العذابات. ليت نصيبنا إذن يكون بالأحرى هو الموت المُكرَّم، لأنه يجعلنا نرتقي إلى بداءة حياة أبدية، والذي يلحق بها بالضرورة تلك البركات أيضًا التي تأتي من الجود الإلهي. وليتنا نهرب من حياة الخزى ونحتقرها، تلك الحياة الملعونة، قصيرة الأجل، والتي تهبط بنا إلى عذاب أبدى مرير.
ولكي يمنح وسيلة أخرى بها يسعف عقولنا، فإنه يضيف بقوة: ” أليست خمسة عصافير بالكاد ربما تساوى فلسين، ومع ذلك فحتى واحد منها ليس منسيًّا قدام الله“. ويقول فضلاً عن ذلك: ” أيضًا شعور رؤوسكم محصاة” تأمل إذن ما أعظم العناية التى يخلعها على هؤلاء الذين يحبونه. لأنه إن كان حافظ الكون يمدّ معونته إلى أشياء تافهة بهذا المقدار، ويتنازل ـ إن جاز القول ـ إلى أصغر الحيوانات، فكيف يمكنه أن ينسى هؤلاء الذين يحبونه، لاسيما إذا كان يعتني بهم عناية عظيمة، ويتنازل ليفتقدهم لكي يعرف بالضبط أصغر الأشياء عن حالتهم، بل وحتى كم عدد شعور رؤوسهم. أين إذن هو تفاخُر الوثنين وثرثرتهم الفارغة الحمقاء؟ ” أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر ألم يُجهِّل الله حكمة العالم؟” (1كو1: 20). لأن بعضًا منهم ينكر تمامًا العناية الإلهية، بينما آخرون يجعلونها تصل إلى القمر فقط، ويضعون عليها قيودًا كما لو كانت هذه السلطة قد خُوِّلَت لهم. لمثل هؤلاء نقول: ” هل عناية الله أضعف من أن تمتد إلى ما هو أسفل بل وحتى أن تبلغ إلينا، أم أنَّ خالق الكل مُتعَب لهذه الدرجة حتى أنه لا يرى ما نفعل؟ إن قالوا إذن إن العناية ضعيفة جدًّا، فهذا هو الغباء بعينه ليس إلا. أما إذا صوَّروا الطبيعة الإلهية أنها خاضعة للكسل، فإنهم يجعلونها أيضًا قابلة للحسد وهذا أيضًا هو تجديف وجرم لا يوجد أعظم منه. ولكنهم يجيبون أنه إزعاج للإرادة الإلهية والفائقة أن تثقَّل بالعناية بكل هذه الأمور الأرضية، لأنهم لا يعلمون كم هي عظيمة هذه الطبيعة الإلهية التي لا يمكن للعقل أن يفهمها أو للنطق أن يصفها، والتي تملك على الكل، لأنه بالنسبة لها فإن جميع الأشياء صغيرة، وهكذا يعلِّمنا النبي المبارك إشعياء حيث يقول: ” حقًّا إنما جميع الأمم كنقطة من دلو وتحسب كغبار الميزان، وتُعدّ كبصاق، فبمَّن تشبِّهون الرب؟” (إش40: 15، 18 س). فماذا تكون نقطة واحدة من دلو؟ وماذا يكون غبار الميزان؟ وماذا يكون البصاق؟ أي تفلة واحدة؟ فإن كان هذا هو وضع جميع الأشياء أمام الله، فكيف يكون أي أمر عظيمًا عليه، أو يكون أمرًا يسبِّب له إزعاجًا أن يعتني بكل الأشياء؟ إن مشاعر الوثنيين الضارة إنما هي عديمة العقل.
ليتنا إذن لا نشُك، بل نؤمن أنه بيد سخيَّة سوف يمنح نعمته لهؤلاء الذين يحبونه. لأنه إما أنه لن يسمح لنا أن نقع في تجربة، أو إذا سمح ـ بقصده الحكيم ـ أن نؤخذ فى الشرك لأجل أن نربح المجد بالآلام، فإنه بكل تأكيد سيمنحنا القوة أن نحتملها. وبولس المبارك هو الشاهد لنا ويقول: ” الله أمين، الذي لا يدعكم تجرَّبون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضًا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا” (1كو10: 13). لأن الذي هو المخلِّص وهو ربنا جميعًا هو رب القوات، الذي به ومعه لله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى أبد الآبدين آمين.
[1] حرفيًّا “يمسح”، وهى استعارة مأخوذة من معهد المصارعة (الجمنزيوم) حيث كان المصارع يُدهن بالزيت قبل أن تبدأ المعركة مباشرة، فصار معنى يمسح إذن هو الإعداد للجهاد المرتقب.