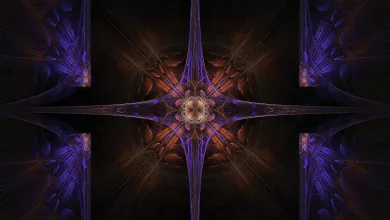آية يونان النبي – إنجيل لوقا 11 ج13 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
آية يونان النبي – إنجيل لوقا 11 ج13 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
آية يونان النبي – إنجيل لوقا 11 ج13 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد

(لو 11: 29ـ36) “ وَفِيمَا كَانَ الْجُمُوعُ مُزْدَحِمِينَ ابْتَدَأَ يَقُولُ: هَذَا الْجِيلُ شِرِّيرٌ. يَطْلُبُ آيَةً وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةُ يُونَانَ النَّبِيِّ. لأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ آيَةً لأَهْلِ نِينَوَى كَذَلِكَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضًا لِهَذَا الْجِيلِ. مَلِكَةُ التَّيْمَنِ سَتَقُومُ فِي الدِّينِ مَعَ رِجَالِ هَذَا الْجِيلِ وَتَدِينُهُمْ لأَنَّهَا أَتَتْ مِنْ أَقَاصِي الأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَانَ هَهُنَا. رِجَالُ نِينَوَى سَيَقُومُونَ فِي الدِّينِ مَعَ هَذَا الْجِيلِ وَيَدِينُونَهُ لأَنَّهُمْ تَابُوا بِمُنَادَاةِ يُونَانَ وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ هَهُنَا!“.
ليس أحدًا يوقد سراجًا ويضعه في خفية ولا تحت مكيال، بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون مملوءًا نورًا.. ومتى كانت عينك شريرة فجسدك يكون مملوءًا ظلامًا. فإن كان جسدك كله مملوءًا نورًا ليس فيه جزء مظلم، يكون كله مملوءًا بالنور كما حينما يضيء لك السراج بنوره “.
نتج الطلب من خبثهم، لذلك لم يمنح لهم كما هو مكتوب: “ الأشرار سيطلبونني ولا يجدونني” (هو5: 6 س)[1]… دعونا نرى الأقوال التي قالها الله لموسى وما هي الحقيقة التي تشير إليها؟ وهذا ما يلزم أن نفحصه بالتأكيد، لأني أقول إنه لا يوجد شيء من كل ما تحويه الكتب المقدسة، غير نافع للبنيان. فعندما أقام إسرائيل مدة طويلة في مصر ونشأ على عوائد سكانها (في ذلك الوقت)، فإنه ضلَّ بعيدًا عن الله، وصار كمن سقط من يد الله، وأصبح حيَّة. والحيَّة تشير إلى الشخص ذو النزعة الخبيثة جدًّا بطبعه، ولكن لما أمسك الله به ثانية فقد أعاده إلى حالته الأولى وأصبح عصا أي غرس الفردوس، لأنه دُعي إلى معرفة الله الحقيقية واغتنَى بالناموس كوسيلة لحياة فاضلة.
وصنع الله أيضًا أمرًا آخرًا له صفة معجزية مساوية. لأنه قال لموسى: ” ادخل يدك في عبِّك. فأدخل يده في عبِّه ثم أخرجها من عبه، وإذا يده صارت برصاء مثل الثلج؟ ثم قال له: رُد يدك إلى عبك فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل لون جسده” (خر4: 6ـ7س).
لأنه طالما كان إسرائيل متمسكًا بعادات آبائه، وكان يُظهِر في أخلاقه نموذج الحياة الفاضلة التي كانت له في إبراهيم وإسحق ويعقوب، فإنه كان كأنه في حضن الله، أي تحت رعايته وحمايته، ولكن بتخلِّيه عن فضيلة أجداده، فإنه صار كأنه أبرص، وسقط في النجاسة لأن الأبرص هو نجس بحسب ناموس موسى، ولكن عندما قبله الله ثانية، ووضعه تحت حمايته، فانه تخلَّص من برصه، وخلع عنه نجاسة الحياة المصرية (الوثنية). ولما حدثت هذه المعجزات أمامهم، فإنهم صدَّقوا موسى عندما قال: ” الرب إله آبائكم أرسلني إليكم” (خر3: 15).
لذلك لاحظوا، إنهم لم يتخذوا من إظهار المعجزات سببًا لتصيُّد الخطأ. فلم يشتموا موسى الإلهي، ولم يجمحوا بلسان متسيَّب ويقولوا إنه صنع المعجزات التي صنعها أمامهم بواسطة بعلزبول، ولم يطلبوا آية من السماء محتقِرِين أعماله المقتدرة. ولكن ها أنت تنسب إلى بعلزبول أعمالاً مكرَّمة ومعجزية، ولم تخجل من أن تأتى بآخرين وبنفسك أيضًا إلى الهلاك عن طريق تلك الأمور نفسها (المعجزات) التي كان ينبغي أن تجعلك تحصل على إيمان ثابت بالمسيح. ولكنه لن يعطيك آية آخرى لكي لا يعطي القدسات للكلاب ولا يطرح الدُرر أمام الخنازير. لأنه كيف يمكن لهؤلاء المفترين بشدة على المعجزات التي صنعها (المسيح) أمامهم للتو، أن يستحقوا معجزات أكثر؟ بل على العكس فنحن نلاحظ الكرَّامين المهرة حينما يجدون أن الأرض بطيئة في إعطاء الثمر، فإنهم يرفعون يدهم عنها، ويرفضون أن يحرثوها مرة أخرى، حتى لا يتكبدوا خسارتين معًا: خسارة تعبهم، وخسارة البذار.
ومع ذلك، فقد قال، إنه ستُعطَى لهم آية يونان فقط والتي يقصد بها الآلام على الصليب والقيامة من الأموات. لأنه يقول: ” كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة ليال” (مت12: 40). ولكن لو أنه كان ممكنًا أن المسيح لا يريد أن يقاسي الموت بالجسد على الصليب لما كانت قد أُعطِيَت هذه الآية لليهود، ولكن حيث إن الآلام التي احتملها لأجل خلاص العالم كانت لابد منها، فقد أُعطِيَت هذه الآية لأولئك العديمي الإيمان لأجل دينونتهم. وأيضًا عندما كان يكلِّم اليهود في مرَّة أخرى قال لهم: ” انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه” (يو2: 19). وكما أتصوره، فان إبطال الموت وملاشاة الفساد بالقيامة من الموت ـ التي هي آية عظيمة جدًّا تدل على قوة الكلمة المتجسد وسلطانه الإلهي ـ يتم البرهنة عليها بشكل كافٍ بالنسبة للناس الجادين، بواسطة جنود بيلاطس الذين عُيِّنوا لحراسة القبر، وقد رشوهم بأموال كثيرة ليقولوا إن تلاميذه أتوا ليلاً وسرقوه (مت28: 13). فهي إذن آية ليست بدون منفعة، بل هي كافية لإقناع كل سكان الأرض أن المسيح هو الله، وأنه قاسى الموت في الجسد بإرادته وحده. إذ أنه أمر رباطات الموت أن ترحل وأباد الفساد. أما اليهود فلم يؤمنوا أيضًا بالقيامة، ولهذا السبب قيل عنهم بحق، إن ” ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين ضد هذا الجيل“.
وهذه المرأة رغم أنها بربرية، فقد بحثت بشغف لتسمع سليمان، ولهذا الغرض سافرت مسافة طويلة جدًّا لتصغي إلى حكمته في طبيعة الأمور المنظورة والحيوانات والنباتات. أما أنتم فرغم أنكم حاضرون الآن وتستمعون إلى الحكمة ذاته، الذي أتى إليكم متحدثًا عن أمور غير منظورة وسماوية. وهو يؤكد ما يقوله بالأعمال والمعجزات، فإنكم تتحولون بعيدًا عن كلامه ولا تبالون بطبيعة كلامه العجيبة. فكيف إذن لا يكون هنا أعظم من سليمان، أي في شخصي أنا؟ وأرجوا أن تلاحظوا ثانية مهارة لغة الرب: فلماذا يقول “هنا” ولا يقول “فيَّ أنا” ؟ هو يقول ذلك لكي يحثنا أن نكون متضعين حتى لو كانت قد وُهِبت لنا مواهب روحية. وإلى جانب ذلك فإنه من المحتمل أن لو سمعه اليهود يقول: ” يوجد أعظم من سليمان في شخصي أنا”، لكانوا قد تجرّأوا أن يتكلموا عليه بطريقتهم المعتادة ويقولون: ” انظروا إنه يقول إنه أعظم من الملوك الذين تملكوا علينا بمجد”. لذلك، فالمخلِّص ـ لأجل التدبير ـ يستخدم لغة مناسبة ويقول “ها هنا” بدلاً من “فيَّ أنا”.
ويضيف الرب على ذلك قائلاً: إن رجال نينوى سيقومون يوم الدين ويدينون اليهود. لأنهم كانوا شرسين وأمميين ولا يعرفون الرب الذي هو الله بالطبيعة وبالحق، ولم يسمعوا قط أية نبوات من موسى، وكانوا يجهلون عظمة أخبار النبوة، ومع أن هذه كانت هي حالتهم الذهنية إلاَّ أنهم تابوا بمناداة يونان، كما يقول الرب. إذن فقد كان هؤلاء الرجال أفضل جدًّا من الإسرائيليين، وسوف يدينهم. ولكن انصتوا إلى الكلمات نفسها: ” رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان، وهوذا أعظم من يونان ههنا“.
” ليس أحدًا يوقد سراجًا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال، بل على المنارة، لكي ينظر الداخلون النور” (لو11: 33).
ماذا كان القصد بالنسبة لهذه الكلمات؟ إنه يقاوم اليهود باعتراض مأخوذ من غبائهم وجهلهم، لأنهم قالوا إنه يعمل معجزات لا ليؤمن به الناس أكثر، ولكن لكي يصير له أتباع كثيرون، ويحصل على ثناء وتصفيق أولئك الذين ينظرون أعماله الخارقة. والرب يدحض هذا الافتراض باستخدام السراج كمَثَل، فهو يقول إن السراج يكون دائمًا مرفوعًا وموضوعًا على المنارة، فيكون نافعًا لمن يبصرونه. ولنتأمل الآن النتيجة التي يشير إليها هذا الكلام. فقبل مجيء مخلصنا، كان الشيطان ـ أب الظلمة ـ قد أظلم العالم، وجعل كل الأشياء سوداء بقتام عقلي، ولكن وبينما العالم في هذه الحالة، فإن الآب أعطى ابنه ليكون نورًا للعالم، ليسطع علينا بنور إلهي، ولينقذنا من الظلمة الشيطانية. ولكن أيها اليهودي، إن كنت تلوم السراج لأنه غير مخفي، ولكن على العكس هو موضوع على منارة، وهو يعطى نوره لمن ينظرون؛ عندئذ يمكن أن تلوم المسيح لأنه لا يريد أن يكون مختفيًا، بل على العكس أن يراه الجميع، منيرًا أولئك الذين في الظلمة، وليفيض عليهم بنور معرفة الله الحقيقية. فهو يصنع معجزاته لا لكي يعجب به الناس، ولا يسعى بواسطتها إلى الشهرة، بل بالحري لكي نؤمن أنه بينما هو الله بالطبيعة، إلاَّ أنه صار إنسانًا لأجلنا، دون أن يكُف عن أن يكون كما كان (أي إلها)، ومن فوق الكنيسة المقدسة كمنارة تُشع بالتعاليم التي ينادي بها هو، فإنه يعطى نورًا لأذهان الجميع بأن يملأهم بالمعرفة الإلهية.
[1] أجزاء مفقودة فى المخطوط.