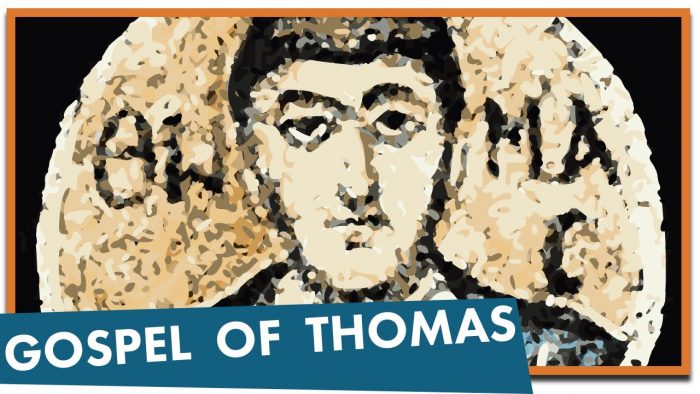تطويب التلاميذ – إنجيل لوقا 10 ج7 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
تطويب التلاميذ – إنجيل لوقا 10 ج7 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
تطويب التلاميذ – إنجيل لوقا 10 ج7 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد

(لو10: 23، 24) ” وَالْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ عَلَى انْفِرَادٍ وَقَالَ: طُوبَى لِلْعُيُونِ الَّتِي تَنْظُرُ مَا تَنْظُرُونَهُ! لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ أَنْبِيَاءَ كَثِيرِينَ وَمُلُوكًا أَرَادُوا أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَمْ يَنْظُرُوا، وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَمْ يَسْمَعُوا “.
إن المظاهر التي يُقدِّمها العالم (ممثَّلة في المسارح والمباريات) تُؤدِّى بالناس غالبًا إلى رؤية أشياء غير نافعة أو بالحري تُسبب لهم ضررًا كبيرًا. والمُتردِّدين على هذه الأمكنة إمَّا يسلمون أنفسهم للإعجاب بالراقصين، وإذ يستسلمون لما يتبع ذلك من استرخاء كسول فإنهم يذوبون في عواطف مخنَّثَة، أو أنهم يُمجِّدون الخطباء ذوى المشاعر الفاترة، أو يُلذِّذون أنفسهم بأصوات واهتزازات المزمار والقيثار. ولكن كل هذه الأشياء باطلة وغير نافعة، وتستطيع أن تذهب بعقل الإنسان بعيدًا عن كل صلاح. أما نحن الذين نسلك طريق الحياة الفاضلة والغيورون في الأعمال المستقيمة، فإن المسيح يجمعنا في كنائسه المقدسة، لكي إذ نبهج أنفسنا بالتسبيح له، فإننا نصير سعداء بكلماته المقدسة وتعاليمه التي تقودنا إلى الحياة الأبدية.
دعنا لذلك نرى هنا أيضًا أيَّة عطايا تفضَّل وأنعم بها علينا نحن الذين قد دُعينا بالإيمان به إلى معرفة مجده. يقول الإنجيل ” والتفت إلى تلاميذه وهم على انفراد وقال لهم، طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه“. والآن فرُبَّ معترض يقول: ” لماذا لم يخاطب كل المجتمعين هناك بكلماته التي تصف هذه البركات؟ وما الذي جعله يلتفت إلى تلاميذه وهم على انفراد ويقول لهم طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه؟”. ماذا إذن تكون إجابتنا؟ إنه ليس من اللائق أن نُوصِّل الأمور التي لها طبيعة سريَّة لكل من يصادفنا، ولكن للأصدقاء الحميمين فقط، فأولئك هم أصدقاؤه الذين حسبهم مستحقين للتلمذة له، الذين استنارت عيون قلوبهم، وصارت آذانهم مستعدَّة للطاعة. فإنه قال في إحدى المرَّات للرسل القديسين: ” لا أعود أُسمِّيكم عبيدًا بل أحباء، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، ولكنِّي دعوتكم أحباء لأنِّي أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي” (يو15:15). بلا شك كان هناك كثيرون مجتمعون وواقفون في حضرته إلى جوار أتباعه المختارين، ولكنهم لم يكونوا جميعهم مؤمنين، فكيف يمكنه أن يتكلم بالحق للجميع وبلا تمييز قائلاً: ” طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، وطوبى للذين يسمعون ما تسمعونه؟” لذلك فهناك سبب مناسب أن يلتفت إلى تلاميذه، أي أنه حوَّل وجهه عن هؤلاء الذين لن ينظروا ولن يسمعوا، بل هم غير مطيعين، وعقلهم مظلم، لذلك أعطى نفسه كلية لمن أحبوه، ونظر إليهم وقال: ” طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه“، أي بالحري التي تتفرس في الأشياء التي يجب رؤيتها أولاً قبل كل الأشياء الأخرى.
أمَّا عن التعبير المُستخدَم هنا، فهو مستمَد من عادات الناس الشائعة، وفى مثل هذه العبارات لا تشير الرؤية إلى عمل عيوننا الجسدية، ولكن بالحري إلى التمتع بالأمور التي يمنحها المسيح لخائفي الله. كما يقول أحدهم مثلاً: ” هؤلاء وأولئك رأوا أوقاتًا سعيدة” بدلاً من أن يقول ” استمتعوا بأوقات سعيدة”. وبنفس الطريقة يمكنك أن تفهم المكتوب في المزمور الموجَّه إلى الذين يُثبِّتون أفكارهم في الأشياء التي فوق: “وتبصر خيرات أورشليم” (مز128: 5) بدلاً من ” وتشترك في سعادة أورشليم“، أي الأشياء التي فوق في السماء، التي يدعوها الحكيم بولس ” أُم جميع القديسين” (غل4: 26). وأي شك يمكن أن يكون في أنَّ أولئك الذين نظروا المعجزات الإلهية التي صنعها المسيح، والأعمال العجيبة التي فعلها لم يكونوا مغبوطين في كل الأحوال، فجميع اليهود رأوا المسيح يعمل بجلال إلهي، ومع ذلك فليس من الصواب أن نحسبهم جميعًا مغبوطين، لأنهم لم يؤمنوا ولا رأوا مجده بعيون العقل. إنهم بالحق مذنبين بالأكثر ولا يليق أن يُعتَبَرُوا مُطوَّبِين، لأنهم رغم رؤيتهم ليسوع وهو مملوء بالمجد بواسطة الأعمال الفائقة الوصف التي عملها، إلاَّ أنهم لم يؤمنوا به.
ولكن تعالوا نسأل، ماذا رأت أعيننا؟ ولماذا نالت التطويب؟ ولأي سبب وصلت إلى هذه البركة؟ إنها رأت أنَّ الله الكلمة، الذي كان في صورة الله الآب قد صار جسدًا لأجلنا، إنها أبصرت ذلك الذي هو شريك عرش الآب، ساكنًا فيما بيننا، وفى شكلنا، لكي بالتبرير والتقديس يُشكِّلنا على شبهه، ويطبع علينا جمال ألوهيته بطريقة عقلية وروحية. وعن هذا يشهد بولس ويكتب: ” وكما لبسنا صورة الترابي هكذا نلبس صورة السمائي” (1كو15: 49)، والرسول يقصد بصورة الترابي آدم الذي خُلِق أولاً، ويقصد بالسماوي الكلمة الذي هو من فوق، الذي أشرق من جوهر الله الآب، ولكنه صار ـ كما قلت ـ مثلنا. فالذي هو بالطبيعة ابن، أخذ شكل العبد، ولكنه لم يأخذ حالتنا لكي يستمر في وضع العبوديَّة، بل لكي يعتقنا نحن الذين رُبِطنا بنير العبودية؛ لأن كل ما هو مخلوق هو بالطبيعة عبد ولكي يُغنينا بما له. لأننا به ومعه قد نلنا اسم البنين، إذ قد صرنا مُكرمين بسخائه ونعمته. وهو الذي كان غنيًا شاركنا فقرنا ليرفع طبيعة الإنسان إلى غناه، وذاق الموت على خشبة الصليب ليرفع من الوسط الإثم الذي ارتُكِب بسبب شجرة (المعرفة)، وليمحو الذنب الذي نتج عن ذلك، ولينزع من الموت طغيانه علينا. لقد رأينا الشيطان يسقط، رأينا ذلك القاسي ينكسر، ذلك المتكبِّر يُوضَع، رأينا ذلك الذي جعل العالم يخضع لنير مُلكه، يُجرَّد من تسلُّطه علينا، وجعل المزدَرِى والمحتَقِر والذي كان يُعبد يومًا يصير هو مزدَرَى ومحتَقَرًا، والذي جعل نفسه إلهًا تطأه أقدام القدِّيسين، والذي تمرَّد على مجد المسيح صار مدوسًا بواسطة الذين يحبُّون المسيح: ” لأنهم أخذوا سلطانًا لينتهروا الأرواح الشريرة ويخرجوها“. وهذه القوة هي كرامة عظيمة وعالية جدًّا بالنسبة للطبيعة البشرية، لكنها لائقة فقط بالإله العلي.
والكلمة الذي ظهر في شكل بشري كان هو أول من وضع لنا المثال، لأنه هو أيضًا انتهر الأرواح الشريرة. أما اليهود الأشقياء، فإنهم تقيأوا ضد افتراءات حسدهم قائلين: ” هذا الإنسان لا يُخرج الشيطان إلا ببعلزبول رئيس الشياطين” (مت12: 24). ولكن الرب فنَّد هذه الكلمات الشريرة بقوله: ” إن كنت أنا ببعلزبول أُخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يُخرِجون؟ ولكن إن كنتُ بروح الله أُخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله“. فإن كنتُ ـ يقول الرب ـ ” وأنا إنسان مثلكم أُمارس القوة الإلهية، فقد أقبَلَت عليكم البركة العظيمة لأن الطبيعة البشرية قد تمجدت فيَّ لأنِّي وطأتُ الشيطان”. إذن فقد أقبل علينا ملكوت الله، بواسطة الكلمة الذي صار مثلنا والذي مارَسَ في الجسد الأعمال اللائقة بالله.
وأعطى الرسل القديسين أيضًا قوة وسلطانًا على إقامة الأموات وتطهير البرص وشفاء المرضى، وكذلك أن يستدعوا الروح القدس من السماء على من يريدون بوضع الأيدي. كما أعطاهم سلطانًا أن يحلُّوا ويربطوا خطايا الناس، كما قال: ” لأني أقول لكم ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطًا في السماء وما حللتموه على الأرض يكون محلولاً في السماء” (مت18:18). هذه هي الأشياء التي نرى أنفسنا الآن نملكها، فطوبى لأعيننا وأعين جميع من يحبُّونه. إننا سمعنا تعليمه الذي لا يُنطق به، فأعطانا معرفة الآب، وأرانا إياه في طبيعته الخاصة، والأشياء التي كانت بواسطة موسى لم تكن سوى مثالاً ورمزًا، أمَّا المسيح فقد أعلن لنا الحق… وعلَّمنا أنه ليس بالدم والدخان، بل بالذبائح الروحية، يجب أن ُنكرِّم ذلك الذي هو غير جسدي وغير مادي[1]وهو فوق كل إدراك. إنَّ أنبياء قديسين كثيرين اشتهوا أن يروا هذه الأشياء، وملوكًا كثيرين أيضًا. اسمعهم مرة يقولون: ” أرني يا رب رحمتك وأعطني خلاصك” (مز85: 7)، لأنهم يدعون الابن ” رحمة وخلاصًا“. وفى وقت آخر أيضًا: ” اذكرني برضا شعبك وتعهَّدني بخلاصك، لنرى سعادة مختاريك، ونفرح بفرح شعبك” (مز105: 4 س). من هو الشعب المختار في المسيح بواسطة الله الآب ؟ يقول لنا بطرس الحكيم، وهو يتكلم إلى الذين تشرَّفوا بالإيمان: ” أما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمَّة مقدَّسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب” (1بط2: 1).
ونحن إنما قد دُعينا إلى هذا بواسطة المسيح، الذي به ومعه لله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى دهر الدهور آمين.
[1] يقصد الله الآب، الذي علَّمنا المسيح أنه روح، والسجود له ينبغي أن يكون بالروح والحق (يو24:4).