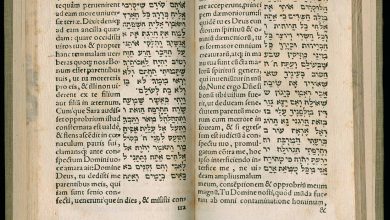خدمة المسيح في كفر ناحوم – عظة 12 ج2 – إنجيل لوقا 4 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
خدمة المسيح في كفر ناحوم - عظة 12 ج2 – إنجيل لوقا 4 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد
خدمة المسيح في كفر ناحوم – عظة 12 ج2 – إنجيل لوقا 4 – ق. كيرلس الإسكندري – د. نصحى عبد الشهيد

(لو4: 14، 15) ” وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُوَّةِ الرُّوحِ إِلَى الْجَلِيلِ، وَخَرَجَ خَبَرٌ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ. وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ مُمَجَّدًا مِنَ الْجَمِيعِ “.
حينما ترك المسيح سكنى المدن، فإنه سكن في البراري، وهناك صام وجُرِّب من الشيطان، وهناك حقق النصرة لحسابنا، هناك سحق رؤوس التنانين، هناك سقطت سيوف العدو تمامًا، وهُدِمَت مدنًا كما يقول داود (مز9: 6)، وأعني بالمدن أولئك الذين كانوا كالأبراج والمدن. لذلك فهو إذ قد تسلط باقتدار على الشيطان، وإذ قد تَوَّج طبيعة الإنسان بالغنائم التي غنمها بالانتصار على الشيطان، رجع إلى الجليل بقوة الروح عاملاً بقوة وسلطان وأجرى عجائب كثيرة مما أثار دهشة عظيمة جدًّا عند الجموع. وهو قد أجرى المعجزات ليس كمن يقبل نعمة الروح من خارجه أو يناله كموهبة مثل جماعة القديسين، بل بالحرى كمن هو بالطبيعة وبالحق ابن الله الآب، فإنه يأخذ كل ما هو له باعتباره ميراثه الخاص. لأنه قال لأبيه: ” كل ما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم” (يو17: 10). إذًا فهو يتمجد بممارسة قوة الروح المساوي باعتبارها قوته الخاصة واقتداره.
(لو4: 16و17) “ وَجَاءَ إِلَى النَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ تَرَبَّى. وَدَخَلَ الْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَامَ لِيَقْرَأَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ السِّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ“.
حيث إنه كان ضروريًّا وواجبًا أن يُظهِر نفسه الآن للإسرائيليين، وأن يضئ سر تجسده على أولئك الذين لم يعرفوه، ولأنه الآن قد مُسح من الله الآب لأجل خلاص العالم، فأنه بحكمة يُرتب هذا أيضًا أن تنتشر شهرته في كل مكان، وقد منح هذا الإحسان أولاً لشعب الناصرة، لأنه من الناحية البشرية قد تربى بينهم. وإذ دخل المجمع وقد أخذ السفر ليقرأ، ولما فتحه اختار فقرة من الأنبياء تُعلن عن سر مجيئه. وبهذه الكلمات يخبرنا هو نفسه بوضوح تام بصوت النبي أنه يصير إنسانًا، وأنه يأتي ليخلِّص العالم، فنحن نؤكد أن الابن قد مُسح عن طريق مجيئه في الجسد واتخاذه طبيعتنا، فهو لكونه إله وإنسان في نفس الوقت، فهو يعطي الروح للخليقة بطبيعته الإلهية، كما أنه ينال الروح من الله الآب في طبيعته البشرية. وهو نفسه الذي يُقدِّس الخليقة كلها بإشراقه من الآب القدوس، وهو الذي يمنح الروح الذي يسكبه على القوات العلوية كروحه الخاص ويسكبه أيضًا على أولئك الذين يؤمنون بظهوره.
(لو 4: 18ـ 21) ” رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَنَّهُ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ، أَرْسَلَنِي لأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ، لأُنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ ولِلْعُمْيِ بِالْبَصَرِ، وَأُرْسِلَ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ. ثُمَّ طَوَى السِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْخَادِمِ، وَجَلَسَ. وَجَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ. فَابْتَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ: إِنَّهُ الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هذَا الْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ “.
إنه بهذه الكلمات يبين بوضوح أنه أخذ على نفسه الانسحاق والخضوع للإخلاء من مجده. وقد اتخذ اسم “المسيا” وحقيقته من أجلنا، لأنه يقول إنَّ الروح الذي هو بالطبيعة موجود فيَّ، وأنا وهو من نفس الجوهر والألوهية، هذا الروح نفسه نزل عليَّ أيضًا من الخارج، وهكذا فإنه أتى عليَّ أيضًا في الأردن على شكل حمامة، ليس لأنه لم يكن موجودًا فيَّ، ولكن لأجل السبب الذي من أجله مسحني. وما هو السبب الذي من أجله اختار المسيح أن يُمسح؟ السبب هو لأننا نحن صرنا مقفرين من الروح بذلك الحُكم القديم “ لا يسكن روحي في الإنسان. لأنه بَشَر” (تك6: 3).
هذه الكلمات يقولها كلمة الله المتجسد، فلكونه الإله الذي من الله الآب، ولأنه صار إنسانًا لأجلنا دون أن يلحقه تغيير، فإنَّه يُمسح معنا بزيت البهجة، إذ نزل عليه الروح في الأردن على شكل حمامة. لأنه قديمًا كان الملوك والكهنة يُمسحون رمزيًا، وبهذا يحصلون على درجة مُعيَّنة من التقديس، أما هذا الذي تجسد من أجلنا، فقد مُسح بالزيت الروحاني زيت التقديس، ونزل عليه الروح القدس بالحق، وهو قد قبل الروح لا لأجل نفسه، بل لأجلنا، كما أن الروح غادرنا ولم يسكن فينا لكوننا جسد، لذلك امتلأت الأرض من الحزن، لأنها قد حُرمت من المشاركة في الله.
وهو بشَّر المأسورين بالإطلاق، الذي تممه حينما رَبَط القوى، الشيطان الذي بطغيانه ساد على جنسنا، وانتزعنا من الرب جاعلاً إيانَا غنائم له.
وهكذا فإن عبارة “مسحني” تناسب ناسوته، فليست الطبيعة الإلهية هي التي مُسِحت بل تلك الطبيعة التي هي منَّا، هكذا أيضًا عبارة “أرسلني” إنما تشير إلى ما هو بشرى.
وأولئك الذين أعتمت قلوبهم منذ القديم بظلمة إبليس، قد أنار لهم بإشراقه كشمس للبر، وجعلهم أبناء لا لليل والظلمة فيما بعد، بل أبناء للنور والنهار كقول بولس الرسول (1تس5:5). وأولئك الذين كانوا عميانًا “لأن المُضِل أعمى قلوبهم” قد استعادوا بصرهم وعرفوا الحق، وكما يقول إشعياء ” صارت ظلمتهم نورًا” (إش42: 16)، أي صار الجُهال حكماء، وأولئك الذين كانوا في الخطية عرفوا مسالك البر، والآب أيضًا يقول للابن في موضع ما ” أجعلك عهدًا للشعب، لتفتح عيون العمي، لتُخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة” (إش42: 6، 7)، لأن الابن الوحيد جاء إلى هذا العالم وأعطى عهدًا جديدًا لشعبه، الإسرائيليين، الذين منهم وُلد حسب الجسد، وهو العهد الذي أُعلن عنه سابقًا جدًّا بصوت الأنبياء. ولكن النور الإلهي السماوي أضاء أيضًا على الأمم، وذهب وبشَّر الأرواح في الجحيم، وأظهر نفسه لأولئك الذين كان مغلقًا عليهم في بيت السجن، وفك قيود الجميع وحررهم من العنف، فكيف لا تبرهن كل الأشياء أن المسيح هو إله وابن الإله بالطبيعة؟
وما معنى إرسال المنسحقين في الحرية؟ معناه إطلاق الذين سحقهم الشيطان بقضيب العنف الروحي، ليذهبوا في طريقهم أحرارًا. وما معنى الكرازة بسنة الرب المقبولة؟ إنَّها تشير إلى الأخبار المفرحة عن مجيئه، أي أن الابن قد جاء، فتلك كانت هي السنة المقبولة التي فيها صُلب المسيح لأجلنا، لأننا عندئذ صرنا مقبولين عند الله الآب كثمار حملها المسيح. لذلك فقد قال هو نفسه ” وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض سأجذب إلىَّ الجميع” (يو12: 32)، وحقًّا فقد عاد إلى الحياة في اليوم الثالث حينما داس على قوة الموت، وبعد ذلك قال لتلاميذه ” دُفع إليَّ كل سلطان” (مت28: 18). أيضًا من كل ناحية هي سنة مقبولة التي فيها إذ قد انضممنا إلى عائلته، فقد دخلنا إليه بعد أن اغتسلنا من الخطية بالمعمودية المقدسة، وصرنا شركاء طبيعته الإلهية بواسطة شركة الروح القدس. تلك أيضًا هي سنة مقبولة إذ أظهر فيها مجده بمعجزات تفوق الوصف، ونحن قد استقبلنا زمن خلاصه بفرح عظيم، وهو الزمن الذي يشير إليه بولس الحكيم قائلاً: ” هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن وقت خلاص” (2كو6: 2)، وهو اليوم الذي فيه، صار أولئك المساكين الذين كانوا سابقًا مرضى بسبب انعدام كل بركة، والذين لم يكن لهم رجاء وكانوا بلا إله في العالم ـ أى شعوب الأمم ـ هؤلاء المساكين صاروا أغنياء بالإيمان به، إذ حصلوا على الكنز الإلهي السماوي، كنز رسالة إنجيل الخلاص، الذي به جُعلوا شركاء في ملكوت السموات، وصاروا مشارِكين مع القديسين، ووارثين للبركات التي لا يستطيع عقل أن يدركها ولا لسان أن يخبر عنها. لأنه مكتوب ” ما لم تره عين وما لم تسمع به آذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه” (1كو2: 9). وهذا الكلام يمكن أن ينطبق أيضًا على فيض النعم السخية المعطاة من المسيح والمنسكبة منه على المساكين بالروح.
ويعني “بالمنكسري القلوب” أولئك الذين لهم ذهن ضعيف مستسلم، ولا يستطيعون مقاومة هجمات الشهوة. وهكذا تجرفهم الشهوات ويصبحون أسرى لها، هؤلاء يعطي لهم الوعد بالشفاء والغفران.
وللعمي يعطي استعادة البصر. لأن أولئك الذين يعبدون المخلوق بدل الخالق، “ويقولون للخشب أنت أبي وللحجر أنت ولدتني” (إر2: 27)، دون أن يعرفوا ذلك الذي هو الإله بالطبيعة وبالحق، مثل هؤلاء هل يمكن أن يُعتبروا سوى عميان يبصرون بعيونهم ولكن قلبهم محروم من النور الإلهي الروحاني. هؤلاء يُنعم عليهم الآب بنور معرفة الله الحقيقية، لأنه يدعوهم بواسطة الإيمان فيعرفونه، أو بالحري يصيرون معروفين منه، وبينما كانوا سابقًا أبناء الليل والظلمة، فقد صاروا أبناء النور، لأن النهار قد أشرق عليهم، وشمس البر قد أنارت وكوكب الصبح اللامع قد ظهر.
ومع ذلك ليس هناك اعتراض على من يُطبِّق هذه الإعلانات على الإسرائيليين لأن هؤلاء أيضًا كانوا مساكين ومسحوقي القلوب ومأسورين وسجناء في الظلمة. ” فلم يكن على الأرض من يعمل صلاحًا، ليس ولا واحد. الكل قد زاغوا معًا وفسدوا” (مز14: 3). ولكن جاء المسيح مبشرًا بأمجاد ظهوره للإسرائيليين قبل غيرهم وكانت أمراضهم مثل أمراض الشعوب الوثنية. ولكن هؤلاء الوثنيين افتدوا بواسطته إذ صاروا أغنياء بحكمته وتوشَّحوا بالفهم، ولم يعودوا ضعفاء ومسحوقين في قلوبهم، بل صاروا أصحاء وأقوياء ومهيئين لقبول وممارسة كل عمل صالح للخلاص. لأنهم حينما كانوا في ضلالهم كانوا في حاجة للحكمة والفهم، أولئك الذين في حماقتهم الشنيعة عبدوا المخلوق بدل الخالق، وأطلقوا أسماء الآلهة على الأخشاب والأحجار، ولكن أولئك الذين عاشوا منذ القديم في الغم والظلمة بسبب عدم معرفتهم للمسيح، فإنهم الآن يؤمنون ويعترفون به إلهًا لهم.
وحينما قرأ الرب هذه الكلمات للشعب المجتمِع، فإنه جذب أنظارهم إليه إذ كانوا ربما مندهشين كيف يعرف الكتب وهو لم يتعلم، لأنه كان من عادة الإسرائيليين أن يقولوا إن النبوات الخاصة بالمسيا قد تحققت، إما في أشخاص بعض ملوكهم أو في أشخاص أنبيائهم القديسين، ولأنهم لم يفهموا ما كان مكتوبًا عنه فهمًا صحيحًا لذلك فقدوا الاتجاه الحقيقي وساروا في طريق آخر. ولكن لكي لا يسيئوا فهم هذه النبوة أيضًا لذلك نراه يحرص على تنبيههم للخطأ بقوله: ” إنه اليوم قد تمَّت هذه النبوة المكتوبة في مسامعكم“. واضعًا نفسه أمامهم بوضوح بهذه الكلمات، باعتباره الشخص الذي تتكلم عنه النبوة، لأنه هو الذي كرز بملكوت السموات للأمم، الذين كانوا مساكين، إذ لم يكن لهم شيء، ليس لهم إله ولا شريعة ولا أنبياء. أو بالحري لقد كرز بالملكوت لكل الذين كانوا محرومين من كنوز الغنى الروحي، وأطلق المأسورين أحرارًا إذ قد طرح خارجًا الطاغية المرتد الشيطان، وقد أفاض النور الإلهي الروحي على الذين كانوا مظلمي القلب. ولأجل هذا قال: ” أنا قد جئت نورًا إلى هذا العالم” (يو12: 46)، إنه هو نفسه الذي حلَّ سلاسل الخطية عن أولئك الذين سحقتهم الخطية، والذي أظهر بوضوح أن هناك حياة آتية.
وأخيرًا إنَّه هو الذي كرز بسنة الرب المقبولة، تلك التي فيها جاء المخلص كارزًا، فإني أظن أن المقصود بالسنة المقبولة هو مجيئه الأول، أما المقصود بيوم العودة فمقصود به يوم الدينونة.
(لو4: 22) “ وَكَانَ الْجَمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلِمَاتِ النِّعْمَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ فَمِهِ، وَيَقُولُونَ: أَلَيْسَ هذَا ابْنَ يُوسُفَ؟“
ولأنهم لم يفهموا أنه هو الذي مُسِحَ وأُرسِلَ، وأنه هو صانع العجائب، فقد رجعوا إلى طرقهم المعتادة وتكلموا عنه كلامًا غبيًّا وباطلاً، فرغم أنهم تعجبوا من كلمات النعمة الخارجة من فمه إلا أنهم اعتبروا هذه الكلمات كأنها بلا قيمة لأنهم قالوا ” أليس هذا هو ابن يوسف“؟ ولكن هل هذا ينقص شيئًا من مجد صانع المعجزات؟ فما الذي يمنع أن يُكرم ويُعجب به حتى لو كان هو ابن يوسف كما ظنوا؟ ألا ترى المعجزات؟ فالشيطان سقط، وقطيع الشياطين أُبيد، وجموع كثيرة تحررت من مختلف أنواع الأمراض. أنت تمدح النعمة التي كانت في تعاليمه، ولكنك بطريقة يهودية تُقلِّل من قدره في نظرك، لأنك حسبت يوسف أبًا له، يا للحماقة العظيمة! حق هو أن يُقال عنهم ” الشعب الجاهل، والعديم الفهم، الذين لهم أعين ولا يبصرون ولهم آذان ولا يسمعون” (إر5: 21).
(لو 4: 23ـ24) ” فَقَالَ لَهُمْ: عَلَى كُلِّ حَال تَقُولُونَ لِي هذَا الْمَثَلَ: أَيُّهَا الطَّبِيبُ اشْفِ نَفْسَكَ! كَمْ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَى فِي كَفْرِنَاحُومَ، فَافْعَلْ ذلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَنِكَ وَقَالَ: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ مَقْبُولاً فِي وَطَنِهِ “.
كان هذا قولاً شائعًا بين اليهود، فحينما يكون الأطباء أنفسهم مرضى، حينئذ يقول الناس أيها الطبيب اشفِ نفسك، لذلك فالمسيح بوضعه هذا المثل أمامهم فكأنه يقول لهم أنتم لا تريدون أن تجرى آيات كثيرة بينكم أنتم بنوع خاص، أنتم الذين تربيت في بلدتكم، ولكني أعرف الشعور السائد بالنسبة لكل الناس، لأن ما يحدث دائمًا هو أن أفضل الأشياء وأندرها تصير حقيرة عندما توجد بكثرة حينما يحصل عليها الناس بوفرة. وهكذا أيضًا نفس الحال مع البشر فإن الأصدقاء أحيانًا يرفضون الشخص المألوف لديهم والذي يكون موجودًا بينهم على الدوام برغم أنه يكون مستحقًّا للكرامة، ولذلك وبخهم بسبب تساؤلهم بغباوة قائلين ” أليس هذا هو ابن يوسف“، ثم أكد موضوع تعليمه فقال لهم “ الحق أقول لكم إنه ليس نبي مقبولاً في وطنه“.
(لو 4: 25ـ27) ” وَبِالْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ أَرَامِلَ كَثِيرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِ إِيلِيَّا حِينَ أُغْلِقَتِ السَّمَاءُ مُدَّةَ ثَلاَثِ سِنِينَ وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ، لَمَّا كَانَ جُوعٌ عَظِيمٌ فِي الأَرْضِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُرْسَلْ إِيلِيَّا إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا، إِلاَّ إِلَى امْرَأَةٍ أَرْمَلَةٍ، إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَاءَ. وَبُرْصٌ كَثِيرُونَ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ أَلِيشَعَ النَّبِيِّ، وَلَمْ يُطَهَّرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ نُعْمَانُ السُّرْيَانِيُّ “.
حيث إنه ـ كما ذكرتُ ـ بعض اليهود أكدوا أن النبوات المتعلقة بالمسيح قد تحققت إما في أنبيائهم القديسين أو في بعض رجالهم البارزين، لذلك فإنه يجتذبهم بعيدًا عن هذا الافتراض، لأجل منفعتهم، وذلك بقوله إن إيليا أُرسِل إلى أرملة واحدة، وإن أليشع النبي قد شفى أبرصًا واحدًا هو نعمان السرياني وكلاهما يشيران إلى كنيسة الأمم الذين كانوا عتيدين أن يقبلوه ويشفوا من مرضهم، في الوقت الذي بقى شعب إسرائيل غير تائب.
(لو4: 28ـ30) ” فَامْتَلأَ غَضَبًا جَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ حِينَ سَمِعُوا هذَا، فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَجَاءُوا بِهِ إِلَى حَافَّةَِ الْجَبَلِ الَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلٍ. أَمَّا هُوَ فَجَازَ فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى “.
وبعد ذلك اشتعلوا غضبًا لأنه وبَّخ فكرهم الرديء، وأيضًا لأنه قال، اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم أي ” روح الرب علىَّ“، وأنه بذلك جعل نفسه مساويًا للأنبياء. وأكثر من ذلك فقد أخرجوه من مدينتهم وبذلك حكموا بالدينونة على أنفسهم وأثبتوا ما قاله المخلص، لأنهم هم أنفسهم طُردوا من المدينة التي فوق بسبب عدم قبولهم للمسيح. ولكي لا يكون توبيخه لهم على عدم تقواهم بالكلام فقط، لذلك سمح لوقاحتهم ضده أن تمتد لتصل إلى أفعال، فقد كان عنفهم غير معقول وحقدهم بلا رادع. ولذلك اقتادوه إلى حافة الجبل وحاولوا أن يلقوا به فوق الصخور، ولكنه اجتاز في وسطهم بدون ملاحظة، ليس لأنه يرفض أن يتألم ـ فهو لأجل هذا السبب قد جاء ـ بل لأنه كان ينتظر الوقت المناسب إذ أنه كان الآن في بداية كرازته، ولم يكن مناسبًا أن يتألم ويعاني الموت قبل أن يكرز بكلمة الحق. فإن قبول الآلام أو عدم قبولها هو أمر متوقف عليه، لأنه هو رب الأزمنة كما أنه رب كل الأشياء، وهذا برهان يبين أنه حينما تألم فقد تألم بإرادته. وأنه حتى في ذلك الوقت الذي تألم فيه فإنه لم يكن غير ممكن أن يتألم لو كان يسلم نفسه للآلام بإرادته.
(لو4: 31ـ 33) ” وَانْحَدَرَ إِلَى كَفْرِنَاحُومَ، مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيلِ، وَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ فِي السُّبُوتِ. فَبُهِتُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ، لأَنَّ كَلاَمَهُ كَانَ بِسُلْطَانٍ. وَكَانَ فِي الْمَجْمَعِ رَجُلٌ بِهِ رُوحُ شَيْطَانٍ نَجِسٍ، فَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قِائِلاً: آهِ! مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ؟ أَتَيْتَ لِتُهْلِكَنَا! أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ: قُدُّوسُ اللهِ! “.
أولئك الذين لا يستطيع الجدل أن يجتذبهم إلى معرفة ذلك الذي هو إله ورب بالطبيعة وبالحق، معرفة يقينية. هؤلاء رُبما يربحون بواسطة المعجزات إلى الطاعة والإذعان ولذلك كان من النافع أو الضروري في أحيان كثيرة أن يكمل تعاليمه بإجراء بعض المعجزات. لأن سكان اليهودية كانوا غير مستعدين أن يؤمنوا، وكانوا يستخفون بكلمات الذين يدعونهم إلى الخلاص. وكان أهل كفر ناحوم خاصة يتَّصفون بهذه الصفة، ولهذا السبب فقد وبخهم المخلص قائلاً: “وأنتِ يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية” (لو10: 15). ورغم أنه يعرف أنهم عصاة وقساة القلب، فإنه يزورهم كما يزور الطبيب البارع أولئك الذين يعانون من مرض خطير جدًّا ويحاول أن ينقذهم من مرضهم، فهو نفسه يقول: “إنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى” (لو5: 31). لذلك فقد علَّم في مجامعهم بحرية كبيرة في الكلام، فهذا ما سبق أن تنبأ به بصوت إشعياء قائلاً: ” لم أتكلم في الخفاء، ولا في مكان مظلم من الأرض” (إش45: 19)، بل إنه أمر الرسل القديسين أن يعلنوا كلماتهم عنه بكل جرأة في الكلام، إذ قال لهم ” الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح” (مت10: 27). وأيضًا في السبت، حينما يكونون في فراغ من العمل كان يتحدث إليهم. وكانوا يتعجبون من قوة تعليمه ومن عظمة سلطانه. فالإنجيل يقول إنه كان يتكلم بسلطان فهو لم يكن يداهن في الكلام، بل كان يستحثهم على الخلاص، كان اليهود يظنون أن المسيح لم يكن أكثر من أحد القديسين، وأنه قد ظهر بينهم كواحد من رُتبة الأنبياء فقط، ولذلك فلكي يجعلهم يرتفعون بفكرهم عنه، فإنه يتجاوز مستوى الأنبياء إذ أنه لم يقل أبدًا “هكذا يقول الرب”، كما كانت عادة الأنبياء طبعًا، ولكن إذ هو رب الناموس فإنه تكلم بأمور تعلو على الناموس.
بل إن الله قال بواسطة إشعياء: ” وأقطع لكم عهدًا أبديًّا مراحم داود الصادقة. هوذا قد جعلته شارعًا للشعوب، رئيسًا وموصيًا للشعوب” (إش55: 3و4)، لأنه كان من الملائم أن موسى كعبد يصير خادمًا للظل الذي لا يستمر، ولكني أؤكد أن المسيح، كان هو المعلِن الأبدي لعبادة باقية لا تزول. وما هو العهد الأبدي؟ إنه يعني كلمات المسيح المقدسة، الذي هو من نسل داود حسب الجسد، وكلماته تنشئ فينا قداسة وثقة، وكما أن مخافة الله نقية لأنها تجعلنا أنقياء وكلمة الإنجيل هي حياة لأنها تنشئ حياة. لأنه هو نفسه يقول “ الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة” (يو6: 63)، أي أنه روحاني ومعطي للحياة. ولكن لاحظوا حسنًا دقة النبوة، فإن إشعياء يتكلم باسم الله الآب بخصوص المسيح ويقول ” هوذا قد جعلته شارعًا للشعب“، أي أن يشهد لهم، أن هذه الأمور مقبولة، ولكي لا يتصور أحد أنه واحد من الأنبياء القديسين، بل لكي يعلم كل البشر بالحرى أنه يضئ بمجد الربوبية إذ لكونه الله فقد ظهر لنا، وهكذا يواصل القول، ليس فقط أنه جعل شارعًا أو شاهدًا، بل أيضًا رئيسًا وموصيًا للشعب. لأن الأنبياء المبارَكين وموسى أيضًا قبلهم إذ كانوا في منزله العبيد الخُدام فإنهم كانوا يقولون لسامعيهم: ” هكذا يقول الرب” لا كمن يعطون وصايا أو أوامر، بل كخدام للكلمات الإلهية. أما ربنا يسوع المسيح فإنه تكلم كلمات تليق بالله جدًّا. ولذلك كان اليهود أنفسهم يدهشون ويتعجبون منه، لأن كلمته كانت بسلطان ولأنه كان يُعلِّمهم كواحد له سلطان، وليس مثل كتبتهم، لأن كلمته لم تكن عن ظل الناموس، بل لكونه هو معطي الناموس فقد حوَّل الحرف إلى الحق، والرموز حوَّلها إلى معانيها الروحية، لأنه كان رئيسًا وحاكمًا وكان يملك سلطان الحاكم أن يأمر ويوصى.
(لو4: 35، 36) “فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلاً:اخْرَسْ! وَاخْرُجْ مِنْهُ!. فَصَرَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي الْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا. فَوَقَعَتْ دَهْشَةٌ عَلَى الْجَمِيعِ، وَكَانُوا يُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ: مَا هذِهِ الْكَلِمَةُ؟ لأَنَّهُ بِسُلْطَانٍ وَقُوَّةٍ يَأْمُرُ الأَرْوَاحَ النَّجِسَةَ فَتَخْرُجُ! “.
بقوة إلهية انتهر الأرواح النجسة، فجعل المعجزة تحدث بعد كلماته مباشرة وذلك حتى لا نسقط في عدم الإيمان، لقد رأينا الشيطان المجرم ينهزم وينغلب منه في البرية، وينكسر بثلاث سقطات، ولقد رأينا قوته تهتز ثانية، والقوة التي كانت ضدنا تسقط، لقد رأينا أنفسنا ننتهر الأرواح الشريرة في المسيح كباكورة لنا، ويمكنك أن تتعلم أن هذا أيضًا يشير إلى تشريف الطبيعة البشرية وذلك من كلمات المخلص نفسها. فإن اليهود افتروا على مجده وقالوا ” هذا الإنسان لا يُخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين” (مت12: 2)، ولكنه هو إذ تحدث كثيرًا أولاً في رده عليهم فإنه أنهى حديثه بقوله: ” ولكن إن كنت أنا بروح الله أُخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت الله“، لأنه إن كان يقول “أنا” وهو الذي صار إنسانًا مثلك، وهو ينتهر الأرواح النجسة بقوة إلهية وجلال عظيم، فإن طبيعتك هي التي تُكلَّل بهذا المجد العظيم، وكأنه يقول لك: لأنك أنت تُرى من خلالي وفيَّ، وقد حصلتَ على ملكوت الله.
لذلك فالشياطين الأشرار قد طُردوا وصاروا يشعرون بقوته التي لا تُغلب، ولأنهم لم يستطيعوا أن يحتملوا الصراع مع الله، لذلك صرخوا بعبارات متعجرفة وخبيثة، دعنا وحدنا، مالنا ولك، وهم يقصدون بذلك لماذا لا تدعنا نحتفظ بمكاننا وأنت تقوم بتحطيم ضلال عدم التقوى؟ ولكنهم بعد ذلك لبسوا مظهرًا كاذبًا من كلمات صحيحة، إذ دعوه “قدوس الله” لأنهم ظنوا أنه بهذا النوع الخادع من الكلام يستطيعون أن يستثيروا الرغبة في المجد الباطل، وبذلك يمنعون انتهاره لهم، ولكن رغم أن الروح خبيث فإنه سيترك فريسته، لأن الله لا يسخر به، وهكذا فإن الرب يوقف كلماتهم النجسة، ويأمرهم أن يخرجوا من أولئك الذين كانوا يتسلطون عليهم. والواقفون إذ قد صاروا شهودًا لهذه الأعمال العظيمة دُهشوا لقوة كلمته. لأنه صنع معجزاته دون أن يقدم صلاة ولم يسأل من أي أحد آخر أي قوة لتتميم هذه المعجزات، ولكن إذ هو نفسه كلمة الله الآب، الكلمة الحي الفعال الذي به توجَد كل الأشياء والذي فيه توجَد كل الأشياء، فإنه بشخصه سحق الشيطان وأغلق الفم الدنس للشياطين النجسين.
(لو4: 38ـ40) ” وَلَمَّا قَامَ مِنَ الْمَجْمَعِ دَخَلَ بَيْتَ سِمْعَانَ. وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ قَدْ أَخَذَتْهَا حُمَّى شَدِيدَةٌ. فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلِهَا. فَوَقَفَ فَوْقَهَا وَانْتَهَرَ الْحُمَّى فَتَرَكَتْهَا! وَفِي الْحَالِ قَامَتْ وَصَارَتْ تَخْدُمُهُمْ. وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، جَمِيعُ الَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُقَمَاءُ بِأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ قَدَّمُوهُمْ إِلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَشَفَاهُمْ “.
لاحظوا كيف أن ذلك الذي احتمل الفقر الإرادي من أجلنا لكي نستغني نحن بفقره، دخل إلى بيت أحد تلاميذه وهو إنسان فقير وليس من المعروفين، وذلك لكي نتعلم أن نسعى لمصاحبة المتضعين، ولا نتفاخر أو نرتفع على أولئك الذين في حاجة أو ضنك.
يصل يسوع إلى بيت سمعان ويجد حماته مريضة بالحمى، ويقف وينتهر الحمى، فتتركها الحمى. وما ورد في رواية متى ورواية مرقس عن ترك الحمى لها، ليس فيه إشارة إلى أي شيء باعتباره السبب الفعال للحمى، ولكن في عبارة لوقا: “ وقف فوقًا منها وانتهر الحمى فتركتها“. لا أعرف هل نحن مضطرين أن نقول إن ذلك الذي انتهره الرب كان شيئًا حيًّا لم يستطيع أن يقاوم تأثير ذلك الذي انتهره، لأنه من غير المعقول انتهار شيء لا حياة فيه ولا يعي الانتهار. وهذا ليس بالأمر الغريب لأنه توجد بعض قوات تصيب الجسد البشري بالأذى، ولا ينبغي أن نفكر عن نفوس أولئك الذين يعانون من أذى هذه القوات أنها نفوس شريرة، وحينما أخذ الشيطان إذنًا أن يُجرِّب أيوب بأمراض جسدية وضربه بقروح مؤلمة فإن أيوب لم يكن بذلك شريرًا. بل إنه واجه التجربة برجولة واحتمل الضربة بنُبل، ولكن الله على أي حال وفي أي وقت نُجرَّب فيه بالآم جسدية يمنحنا هذه النعمة بقوله: ” ولكن لا تمس نفسه” (أي2: 6)، فالرب إذًا بانتهاره يشفي أولئك الذين تمتلكهم أرواح شريرة.
وقد وضع يديه أيضًا على كل واحد من المرضى فشفاهم من أمراضهم موضحًا بذلك أن جسد بشريتنا المقدس الذي جعله جسدًا له وملأه بالقوة الإلهية، كان يمتلك الحضور الفعَّال لقدرة الكلمة، قاصدًا بذلك أن يُعلِّمنا أنه رغم أن كلمة الله الوحيد قد صار مثلنا، إلا أنه بالرغم من ذلك لا يزال إلهًا ويستطيع بسهولة بواسطة جسده الخاص أن يتمم كل الأشياء. لأنه استخدم هذا الجسد كأداة لعمل المعجزات. ولا يوجد أي سبب للتعجب من هذا بل على العكس فيمكنكم أن تلاحظوا كيف أن النار عندما توضع في إناء نحاس فإنها تنقل إلى الإناء قوة إنتاج تأثيرات الحرارة، هكذا أيضًا فإن كلمة الله الكلي القدرة، إذ قد وَحَّدَ الهيكل الحي العاقل المأخوذ من العذراء القديسة مع نفسه اتحادًا حقيقيًا فإنه ملأه بالقوة التي تُظهر قدرته الإلهية بصورة فعالة. لذلك فلكي يخجل اليهود فهو يقول: “ إن كنتُ لستُ أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال” (يو10: 38). وبشهادة الحق نفسه هذه يمكننا أن نرى أن الابن الوحيد لم يُعطِ مجده “لإنسان”[1] منفصل عنه وغيره هو نفسه ويُعتبَر مولود المرأة، بل بالحري إذ هو الابن الوحيد مع الجسد المُقدَّس المُتَّحِد به، فإنه قد صنع المعجزات وهو يُعبَد أيضًا من خليقة الله.
لقد دخل الرب إلى بيت بطرس وهناك كانت امرأة ممدَّدة على فراش مرهَقَة من حمى شديدة، وبدلاً من أن يقول كإله: “اتركي المرض وقومي” فإنه يسلك طريقًا آخر، فإنه لكي يبين أن جسده يملك قوة الشفاء لكونه جسد الله “ لمس يدها” (لو8: 15). ولذلك تركتها الحمى.
لذلك هيا بنا نحن أيضًا لنقبل يسوع، لأنه حينما يدخل إلينا ونقبله في عقلنا وقلبنا، فإنه عندئذ يُطفئ حمى اللَّذات غير اللائقة، ويقيمنا ويجعلنا أقوياء، حتى في الأمور الروحية. وبذلك نخدمه بأن نعمل الأمور التي ترضيه.
ولكن أرجو أن تلاحظوا أيضًا ما أعظم فاعلية لمسة جسده المقدس، فإنها تطرد الأمراض من كل نوع، وتطرد جمعًا من الشياطين وتطرح قوة إبليس عنا، وتشفي جمعًا كبيرًا من الناس في لحظة من الزمان، ورغم أنه يستطيع أن يعمل المعجزات بكلمة وبمجرد ميل إرادته، إلا أنه لكي يعلمنا شيئًا نافعًا لنا فهو يضع يديه على المرضى أيضًا، لأنه كان لازمًا، بل ولازمًا جدًّا لنا أن نتعلم أن الجسد المقدس الذي جعله جسده الخاص كان مزودًا بفاعلية قوة الكلمة بأن زرع فيه قوة إلهية. لذلك فلندعه يمسك بنا، أو بالحري فلنمسك نحن به بواسطة الإفخارستيا السرية لكي يحررنا من أمراض النفس ومن هجمات الشياطين وعنفهم.
(لو4: 41) ” وَكَانَتْ شَيَاطِينُ أَيْضًا تَخْرُجُ مِنْ كَثِيرِينَ وَهِيَ تَصْرُخُ وَتَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ! فَانْتَهَرَهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ، لأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ الْمَسِيحُ “.
لم يسمح الرب للشياطين النجسين أن يعترفوا به، لأنه لم يكن مناسبًا أن يتجنوا على مجد الوظيفة الرسولية، ولم يسمح للسان النجس أن يتكلم عن سر المسيح. ولأنهم لا يتكلمون أي كلام صادق، فلا ينبغي لأحد أن يضع ثقته فيهم لأن النور لا يُعرف بمساعدة الظلمة كما يُعلمنا تلميذ المسيح حينما يقول “ لأنه أية شركة للنور مع الظلمة، أو أي اتفاق للمسيح مع بليعال” (2كو6: 10).
[1] يشير القديس كيرلس بهذه الكلمات إلى تعاليم نسطوريوس الذي كان يُعلِّم بأن المولود من العذراء إنسان حل فيه كلمة الله، وكان يعمل فيه كشخص آخر غير الكلمة.