ضد الأريوسيين المقالة الرابعة – أثناسيوس الرسولي
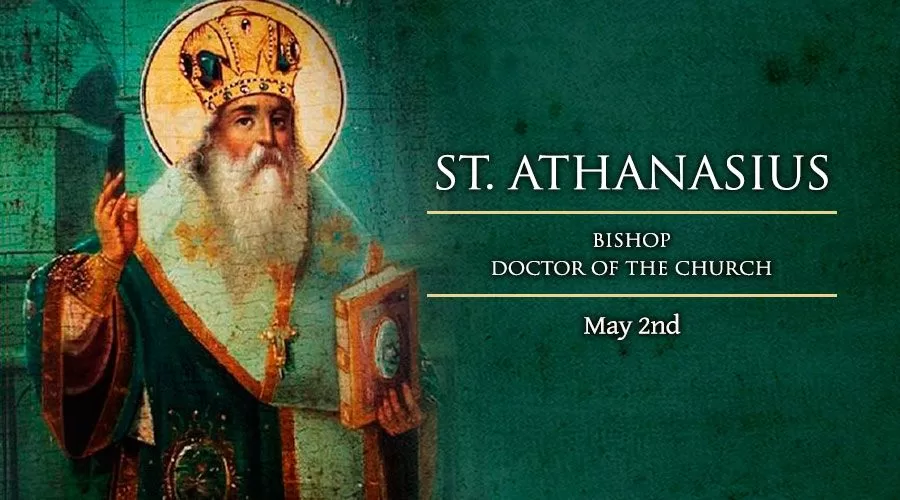
مقدمة
سبق أن نشرنا المقالة الأولى ضد الآريوسيين سنة 1984، والمقالة الثانية سنة 1987، والمقالة الثالثة سنة 1994. وها نحن الآن ننشر المقالة الرابعة ضد الآريوسيين.
يلاحظ أن هذه المقالة التي ننشرها هنا ـ هى مقالة قائمة بذاتها، غير المقالات الثلاث ضد الآريوسيين للقديس أثناسيوس، إذ لم يرد ذكرها أو الاقتباس منها في المخطوطات القديمة على أنها من كتابات القديس أثناسيوس، مثل المقالات الثلاث الأولى. ويؤكد الكاردينال نيومان على عدم انسجام هذه المقالة مع محتويات المقالات الثلاث الأخرى، وخاصة بالنسبة لاستخدامها مصطلح “المساوي في الجوهر” (هوموأوسيوس Ómoousioj) الذي ورد بالفصلين[1] 12،9 دون باقى المقالات، مما يلقى بظلال من الشك على أصالة نسبة هذه المقالة للقديس أثناسيوس. وإن كان من المرجح أنها كُتبت بواسطة شخص كان وثيق الصلة بالقديس أثناسيوس أو من تلاميذه، وذلك لما تحويه المقالة من دفاع عن لاهوت المسيح ضد الهرطقات التي ظهرت في ذلك الوقت، وهو الدفاع الذي يتفق مع خط المقالات الثلاث الأولى، بالإضافة إلى كثرة استشهادها بهذه المقالات، وبباقى أعمال القديس أثناسيوس، كما أشرنا في هوامش الرسالة.
ويبنى كاتب المقالة أساس بحثه، على أن كلمة الله وحكمته موجود، وأنه واحد مع الآب في الجوهر، ثم يبدأ في تفنيد الزعم القائل بأن الكلمة ليس أقنومًا متميزًا عن الآب، وبعد أن يدحض الأخطاء التي وقع فيها كل من سابيليوس[2] وآريوس، فإنه يرفض النتائج المترتبة على وجود بدءين أو أصلين للاهوت، ويؤكد على أصل واحد، وان الكلمة مولود من الله الآب بالطبيعة، كما يوضح أن المسيح أزلي وملكوته أزلى أيضًا، وذلك ضد المقاومين لأزلية شخص المسيح، مفندًا زعم القائلين بأن الكلمة لم يكن له وجود سابق على تجسده.
ويستند كاتب الرسالة إلى نص يوحنا30: 10 لتفنيد مزاعمهم، فيسأل هؤلاء المقاومين: بأي معنى يكون الآب والمسيح ” واحدًا “. ويقدم إجابته التي تختلف عن إجابة سابيليوس فصول (10،9)، وإجابة مارسيللوس[3] فصول (12،11)، مستندًا إلى شرحه القائم على الميلاد الإلهي الأزلي للابن الكلمة.
ثم يفحص تعليم مارسيللوس الذي نتج عن حدوث تغير في الطبيعة الإلهية، هذا التغير يُسمى التمدد Dilatation متهمًا إياه بالسابليانية. ويتحول الكاتب بعد ذلك إلى دحض أفكار مارسيللوس، طارحًا تساؤله: ما الذي يعنيه أتباعه بكلمة ” الابن”؟ وهل يقصدون 1 ـ مجرد المسيح الإنسان؟ أو 2ـ اتحاد الكلمة بالإنسان؟ أو 3ـ الله الكلمة متجسدًا؟ وكانت الإجابة الأخيرة هى الصحيحة بالطبع، وهذه النقطة هى التي قادت إلى مناقشة نصوص العهد القديم (فصل24).
أما الجزء الختامى من هذه المقالة فهو نقطة تحول في المناقشة، ويوضح أن الكتاب المقدس يعلن أن الابن هو هو الله ” الكلمة “.
وفيما عدا الفصلين (7،6) وربما الفصل (25)، فإن هذه المقالة الرابعة تشكل عملاً متجانسًا وكاملاً، إن لم يكن قطعة متماسكة من الجدل اللاهوتى الرصين.
وفيما يلى موجز لمحتويات فصول المقالة:
فصل (1) مقدمة المقالة، ومحتواها الأساسى، حول الشخصية الأزلية الواحدة لابن الله ” الكلمة “.
(2ـ5) في أنه يجب على الذين يرفضون الآريوسية، وهم يتجنبون السابليانية، أن يقبلوا الميلاد الأزلى للابن.
(7،6) شرح اتضاع الله ” الكلمة ” بعكس فكر الآريوسيين.
(8) عن أزلية ملكوت المسيح وشخصه: إذ أن الواحد مُتضمن في الآخر.
(9ـ12) بأى معنى يكون المسيح والآب واحدًا أو لا يكونان؟ ومعنى عبارة الميلاد الأزلى للابن.
(14،13) بيان أن تعليم التمدد والانكماش في الله يُسقط التمايز بين الأقانيم.
(15ـ24) الابن والكلمة شخص واحد. تفنيد الافتراضات الثلاثة حولها. ودحض المناقشة المستمدة من العهد القديم تدعيمًا لهذه الافتراضات.
(25) دحض أخير لتعليم التمدد في الله.
(26ـ36) في تأكيد الكتاب المقدس على أن الابن هو الكلمة، وتفنيد القول بأن لقب الابن قاصر فقط على الإنسان يسوع.
مصدر الترجمة:
لقد ظهر الأصل اليونانى لهذه المقالة مع باقى المقالات في المجلد 26 من مجموعة الآباء اليونانية مينى Migne، PG26: 12-526. وتمت الترجمة العربية عن النص اليونانى المنشور في ” سلسلة آباء الكنيسة ” EPE، ” كتابات أثناسيوس الأسكندرى الكبير مجلد 3″، إصدار مكتبة “غريغوريوس بالاماس” بتسالونيكى باليونان سنة 1975، والمجلد يحوى النص اليونانى القديم في الصفحة اليسرى ويقابله ترجمته إلى اليونانية الحديثة في الصفحة اليمنى. كما تمت مقارنة الترجمة بتلك التي أنجزها العالم الكاردينال نيومان Newman بالإنجليزية سنة 1884، والمنشورة بالمجلد الرابع من المجموعة الثانية من ” سلسلة آباء نيقية وما بعد نيقية ” N.P.N. 2nd series.
بركة صلوات شهود الإيمان القديسين وصلوات قداسة البابا شنودة الثالث تكون معنا؛ وللإله القدوس المحب الثالوث المحيى كل مجد وسجود وتسبيح، الآن وإلى الأبد. آمين.
مؤسسة القديس أنطونيوس
المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية
المقالة الرابعة ضد الأريوسيين
1 ـ لأن “ الكلمة كان الله ” (يو1: 1)، فإن ” الكلمة ” هو إله من إله، وكما كُتب: “ لهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلهًا مباركًا إلي الأبد آمين “(رو5: 9). وبما أن المسيح هو إله من إله، “وكلمة” الله وحكمته وابنه وقوته، الآن فليس هناك سوى إله واحد يستعلن في الكتب الإلهية. لأن ” الكلمة “، إذ هو ابن الإله الواحد، فإنه يُنسب إلي ذاك الذي هو منه، فالآب والابن هما اثنان، ولكن ألوهيتهما واحدة وغير منقسمة وغير منفصلة. وهكذا يكون هناك بدء واحد للاهوت وليس بدءين[4]، من ثم فإن هناك أصلاً واحدًا. و” الكلمة ” هو ابن بالطبيعة لهذا الأصل الواحد (الآب)، ليس كأنه أصل آخر بذاته كائن معه، ولا هو قد أتي (إلى الوجود) من خارج هذا الأصل الواحد. وإلاّ صار من هذا الاختلاف (في الأصل) أصلان وأصول متعددة. ولكن الابن (الذي هو) من ذلك الأصل الواحد، هو ابن ذاتي، وحكمة ذاتي وكلمة ذاتي. لأنه كما يقول يوحنا في ذلك: ” في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله “، لأن الله كان البدء (قبل الدهور)، وحيث إن الكلمة هو منه، فلهذا أيضا “ كان الكلمة الله“. وإذ هناك بدء ومن ثم إله واحد، فالجوهر والكيان واحد؛ الذي هو كائن بالحقيقة، والذي قال: “ أنا هو الذي أنا هو ” (خر14: 3)، وهو ليس اثنين حتى لا يكون هناك بدءان. ومن البدء الواحد هناك ابن بالطبيعة، ابن حقيقي هو كلمته وحكمته وقوته، وغير منفصل عنه. وإذ ليس هناك جوهر آخر، لئلا يكون هناك بدءان، فإن الكلمة الذي هو من الجوهر ” الواحد ” لا ينحل، وهو ليس مجرد صوت ظاهري، بل هو كلمة جوهري وحكمة جوهري، الذي هو الابن الحقيقي. لأنه إن لم يكن (الابن ابنًا) جوهريًا، لكان الله يتكلم في الهواء (أنظر1كو9: 14)، ولصار هو لا يختلف عن بقية الناس؛ ولكن حيث إن (الله) ليس إنسانًا، فإن كلمته أيضًا ليس بحسب الضعف البشرى[5] (أى ليست ككلمة البشر)، لأنه حيث إن البدء هو جوهر واحد، هكذا كلمته وحكمته واحد، وجوهرى وكائن. ولأنه هو إله من إله، وحكمة من الحكيم، وكلمة من العاقل، وابن من الآب، هكذا هو من الأقنوم متأقنم، ومن الجوهر جوهرى وحقيقى، وكائن (بذاته) من الكائن.
2 ـ فإن لم يكن (الابن) هو الحكمة الجوهرى والكلمة الحقيقى، والابن الكائن بذاته، بل كان مجرد حكمة وكلمة وابنًا في الآب، لكان الآب نفسه ذا طبيعة مركبة من حكمة وكلمة. وإن كان الأمر هكذا، لتوالت سخافات كثيرة ولصار (الآب) هو والد نفسه، والابن يلد ذاته، ومولودًا من نفسه، أو لكان لقب الكلمة والحكمة والابن مجرد اسم فقط، بدون وجود حقيقى لمن له هذه الألقاب.
فلو لم يكن الابن موجودًا، فإن الأسماء تكون خاملة فارغة، إلاّ إذا قيل إن الله هو ذاته الحكمة[6] وهو ذاته الكلمة. لكن إن كان الأمر هكذا، فإنه يكون أب نفسه، وابن نفسه، يكون أبًا حين يكون حكيمًا، ويكون ابنًا حين يكون حكمةً، ولا تكون تلك الأشياء في الله كصفة معينة، حاشا لمثل هذا الفكر المخزى؛ إذ ينجم عنه أن يكون الله مركبًا من جوهر وصفة. وإذ يحوى الجوهر كل الصفات فإن اللاهوت الواحد، الذي هو غير منقسم، وبينما تكون كل الصفات موجودة في الجوهر، (ففي هذه الحالة) فإن اللاهوت الواحد غير المنقسم يلزم أن يكون مركبًا، لأنه منقسم إلى جوهر وعارض. لهذا ينبغى لنا أن نسأل هؤلاء الرجال غير الأتقياء: وإذا كان الابن قد استعلن كحكمة الله وكلمته، فكيف يكون هو هكذا؟ فإن كان (قد استعلن) كصفة، فهنا تظهر الحماقة، ولكن إن كان الله هو الحكمة ذاتها، فهذه هى حماقة سابيليوس[7]. لكن الابن هو وليد الآب ذاته بمعنى صحيح، كما في تشبيه النور. لأنه كما أن هناك نورًا من النار، هكذا الكلمة من الله، والحكمة من الحكيم، والابن من الآب. لأنه بهذه الطريقة يبقى (الله) “الواحد” كاملاً بغير انقسام، وابنه وكلمته ليس غير جوهرى وغير حقيقى، بل جوهرى بالحق.
لأنه إن لم يكن الأمر كذلك، فإن كل ما قيل يكون كلامًا نظريًا وساذجًا. لكن إن كان علينا أن نتجنب سخفهم هذا، فإن الكلمة يكون جوهريًا حقًا. لأنه كما أن هناك أبًا حقًا، فإن هناك حكمة حقًا. ولهذا فإنهما اثنان، وليس الشخص نفسه هو أب وابن، كما زعم سابيليوس. بل إن الآب آب والابن ابن، وهما واحد، لأن الابن من جوهر الآب بالطبيعة، موجودًا ككلمته الذاتى. هذا ما قاله الرب ” أنا والآب واحد ” (يو30: 10). لأن الكلمة غير منفصل عن الآب، كما أن الآب لم يكن ولا يكون بدون كلمة أبدًا، لذا قال الابن: ” أنا في الآب والآب في ” (يو10: 14).
3 ـ وأيضًا، إن المسيح هو ” كلمة ” الله. فهل هو قائم بذاته؟، وإذ هو قائم، هل هو متحد بالآب؟ أم أن الله خلقه ودعاه كلمته؟. فإن كان هو قائمًا بذاته حسب الافتراض الأول، وأنه إله، لصار هناك إذن بدءان؛ وبالتإلى فإن الابن لن يكون من طبيعة الآب، ولم يأتِ من الآب ذاته، بل كائن من نفسه. لكن بالعكس، إن كان (الابن) قد وُجد من خارج (الآب)، فهو إذن مخلوق. يبقى إذن أن نقول إن الابن هو من الله ذاته، لأن الذي من آخر هو واحد، والذي هو منه واحد آخر. ووفقًا لذلك يكون هناك اثنان إذن. لكن إن لم يكونا اثنين بل تخص الأسماء الشخص نفسه، فإن العلة والمعلول يكونان نفس الشخص، وكذلك أيضًا المولود والوالد يكونان نفس الشخص، وهذه هى بدعة سابيليوس. لكن إن كان (الابن) من (الآب)، ومع ذلك ليس آخر، لصار (الآب) هو الذي يلد والذي لا يلد في آن واحد: الذي يلد لأنه يلد من نفسه، والذي لا يلد لأنه ليس إلاّ ذاته. فإن كان الأمر كذلك فإن نفس الشخص سيُدعى آبًا وابنًا بشكل نظرى. لكن إن كان من غير اللائق أن نقول بهذا، فإن الآب والابن يجب أن يكونا اثنين، وهما واحد لأن الابن ليس من خارج (الله)، بل هو مولود من الله. لكن إن أحجم أى شخص عن القول إنه مولود، وقال فقط بأن “الكلمة” موجود مع الله، فليحذر هذا الشخص لئلا بامتناعه عن ذكر ما قيل في الكتاب يقع في حماقة جاعلاً الله كائنًا ذا طبيعة مزدوجة. لأن من لا يسلّم بأن “الكلمة” هو من (الله) “الواحد”، بل كما لو كان فقط مرتبطًا بالآب إنما يقدم جوهرًا ثنائيًا، لا يكون أي منهما أبًا للآخر. ويقال نفس الشيء عن القوة. وقد نستجلى هذا الأمر أكثر، إن نظرنا إليه من جانب الآب؛ لأن هناك آبًا واحدًا وليس اثنين، والابن هو من هذا (الآب) الواحد. وبما أنه ليس هناك أبوان، بل آب واحد، فليس هناك بدءان بل بدء واحد، ومن هذا “الواحد” الابن كائن جوهريًا. لكن ينبغى أن نسأل الآريوسيين بطريقة عكسية. (لأنه ينبغى أن ندحض تعاليم أتباع سابيليوس من خلال حقيقة الابن، وأن نُفند تعاليم الآريوسيين من خلال حقيقة الآب).
4 ـ فلنتساءل إذن، هل الله حكيم وليس بدون “كلمة”، أم أنه بلا حكمة وبلا “كلمة”؟[8] فإن كان بلا “كلمة” ولا حكمة حسب الافتراض الثانى، فهذا حماقة وهذيان. وإن كان الله حكيمًا وناطقًا، فعلينا أن نسأل: كيف هو حكيم وناطق؟ هل يمتلك الكلمة والحكمة من خارج، أم من ذاته؟ إن كان من خارج، لابد أن يكون هناك شخص آخر قد أعطاها له، وقبل أن يأخذ كان بلا حكمة وبلا “كلمة”. أما إن كان ذا حكمة و”كلمة” من نفسه، فواضح أن الكلمة ليس من العدم، ولم يكن هناك وقت كان فيه غير موجود، بل كان موجودًا على الدوام. لأن ذاك الذي هو صورة له كائن على الدوام. لكنهم إن كانوا يقولون إنه حكيم بالحق، وليس بغير “كلمة”، بل إن له في ذاته حكمته الذاتى و”كلمته” الذاتى، وإن ذلك ليس هو المسيح، بل ذاك الذي بواسطته قد خُلق المسيح، فعلينا أن نجيب قائلين: إن كان المسيح قد خُلق بواسطة ذلك “الكلمة”، فإنه سيتضح أن جميع الأشياء قد خُلقت بواسطته، ولكن هذا هو الذي يقول عنه يوحنا: ” كل شيء به كان ” (يو3: 1)، والذي يقول عنه المرنم: ” كلها (الأعمال) بحكمة صنعت ” (مز24: 103)، وبذلك يكون المسيح غير صادق عندما يقول: ” أنا في الآب “، لأنه يوجد آخر سواه في الآب. وتصبح الآية: ” والكلمة صار جسدًا ” (يو14: 1) غير صادقة حسب زعمهم. لأنه إن كان هذا الذي بواسطته خُلقت كل الأشياء، هو نفسه قد صار جسدًا، بينما المسيح ليس هو “كلمة” الآب ” الذي به كان كل شيء “، فالمسيح إذن لم يصر جسدًا، وربما أخذ المسيح اسم “كلمة” (كمجرد لقب). لكن إن كان الأمر هكذا، فإنه أولاً: يوجد هناك آخر له نفس الاسم، وثانيًا: لم تكن به كل الأشياء، بل بذلك الآخر الذي به خُلق المسيح أيضًا. لكن إن كانوا يقولون إن الحكمة موجود في الآب كصفة، أو إنه هو ذاته الحكمة [9]، فسينتج عن هذا تلك الأمور غير المعقولة السالفة الذكر. إذ سيصبح (الله) مركبًا، لكونه ابنًا وآبًا لنفسه! فعلينا إذن أن نفحمهم ونسكتهم، على أساس أن الكلمة الذي هو في الله لا يمكن أن يكون مخلوقًا، أو جاء من العدم. لكن إن كان ثمة “كلمة” قد وُجد في الله، لوجب أن يكون هو المسيح الذي يقول: ” أنا في الآب والآب في ” (يو10: 14)، والذي هو الابن الوحيد أيضًا لهذا السبب، طالما أن شخصًا آخر لم يُولد من الآب. هذا هو الابن الواحد، الذي هو الكلمة والحكمة والقوة، لأن الله ليس مركبًا من هذه كلها، بل هو مصدرها. لأنه كما يخلق المخلوقات بالكلمة، فإنه بحسب طبيعة جوهره الذاتى، له الكلمة مولودًا منه؛ والذي بواسطته يخلق كل الأشياء ويدبرها. لأن سائر المخلوقات قد خُلقت “بالكلمة” والحكمة، وهو بحسب أحكامه يحفظ كل الأشياء (أنظر مز91: 118). ويُقال نفس الشيء بخصوص الابن، فإن كان الله بدون ابن إذن، فهو بدون عمل. لأن الابن هو مولوده الذي به يعمل[10]. لكن إن لم يكن الأمر هكذا، لنجم عن ذلك نفس المناقشات والسخافات الناتجة عن وقاحتهم.
5 ـ جاء في سفر التثنية: “ وأما أنتم الملتصقون بالرب إلهكم، فجميعكم أحياء اليوم ” (تث4: 4). ومن هذا يمكننا أن نرى الفرق، ونعرف أن ابن الله ليس مخلوقًا. لأن الابن يقول: ” أنا والآب واحد ” (يو30: 10) و” أنا في الآب والآب في ” (يو10: 14)، لكن المخلوقات حين تنمو (في الفضيلة) فإنها تكون ملتصقة بالرب، لأن الكلمة هو في الآب باعتباره من ذاته، لكن المخلوقات كائنات خارجة (عن الآب)، فإنها تلتصق به باختيارها، إذ هى بالطبيعة غريبة عنه. لأن أى ابن طبيعى هو واحد مع من ولده، أما الذي هو من خارج، وقد جُعل ابنًا (بالتبنى) فإنه يصير متصلاً بالعائلة.
لهذا يضيف على الفور: ” أى شعب عظيم له إله قريب منه؟ ” (تث7: 4س)، وفي موضع آخر يقول: ” أنا إله قريب ” (إر23: 23). لأنه يقترب من المخلوقات إذ هى غريبة عنه. لكن لا يقترب من الابن، أما بالنسبة للابن ـ إذ هو ابنه الذاتى ـ فهو لا يقترب منه بل هو كائن فيه. وليس الابن ملتصقًا بالآب بل هو كائن معه وفيه. ولهذا يقول موسى أيضًا في سفر التثنية نفسه: ” صوته (الرب إلهكم) تسمعون،… وبه تلتصقون ” (تث4: 13). فمن يلتصق (بالرب) فإنما يلتصق به من خارج.
6 ـ أما بالنسبة للرد على مفهوم الآريوسيين الضعيف والبشرى، إذ يفترضون أن الرب كان محتاجًا حين قال: ” دُفع إلى ” و” أخذت ” (مت18: 28، يو18: 10)، وإن كان بولس الرسول يقول: ” لذلك رفعَّه ” و” أجلسه عن يمينه” (في9: 2، أف2: 1، أنظر كو1: 3، والآيات المشابهة)، فإننا نجاوبهم أن ربنا بينما هو ” كلمة ” الله وابن الله فإنه قد لبس جسدًا، وصار ابن الإنسان لكي بصيرورته وسيطًا بين الله والناس، فإنه يخدم أمور الله من نحونا ويخدم أمورنا من نحو الله. وعندما قيل عنه إنه يجوع ويبكي ويتعب، ويصرخ إلوي إلوي، وهى آلامنا البشرية، فإنه يأخذها، ويقدمها للآب، متشفعًا عنا، لكى بواسطته وفيه تبطل هذه الآلام[11]. وحينما قال: ” دُفع إلى كل سلطان” (مت18: 28) و” آخذها” (أنظر يو18: 10) و” لذلك رفعّه الله ” (في9: 2). فإن هذه هى الهبات الممنوحة لنا من الله بواسطته. لأن “الكلمة” لم يكن في احتياج إلى أى شيء في أى وقت[12]، كما أنه لم يُخلق[13]. ولم يكن البشر قادرين (بذواتهم) أن يعطوا هذه (الهبات) لأنفسهم، ولكنها أُعطيت لنا بواسطة “الكلمة”. لذا وكأنها معطاة له فهى تنتقل إلينا. ولهذا السبب تجسد، حتى بإعطائها له تنتقل إلينا[14]. لأن الإنسان وحده (بدون وسيط) لم يكن مستحقًا أن يأخذ تلك الهبات، و”الكلمة” في ذاته لم يكن محتاجًا إليها. لذا اتحد “الكلمة” بنا ونقل إلينا السلطان ومجدّنا مجدًا عاليًا[15].
لأن “الكلمة” إذ تأنس، فقد رفَّع الإنسان نفسه، ولأن “الكلمة” كان في الإنسان فالإنسان نفسه قد نال (الهبات). لأن الإنسان قد مُجد ونال سلطانًا، عندما صار الكلمة جسدًا، لهذا تُنسب تلك الأمور “للكلمة”، لأنها قد أُعطيت لنا بسببه. لأن تلك الهبات قد أُعطيت بسبب مجيء “الكلمة” في الجسد. وكما أن “الكلمة” صار جسدًا هكذا أيضًا نال الإنسان نفسه الهبات التي أتت بواسطة “الكلمة”. لأن كل ما ناله الإنسان، قيل إن “الكلمة” نفسه قد ناله[16]؛ لكى يظهر أن الإنسان إذ كان غير مستحق أن ينال الهبات بسبب طبيعته، فإنه مع ذلك قد نالها بسبب “الكلمة” الذي صار جسدًا. لهذا عندما يُقال إن شيئًا ما قد أُعطى للرب، يجب أن نعرف أنه لم يُعطَ له كمحتاج إليه، بل أُعطى للإنسان نفسه بواسطة “الكلمة”. لأن كل من يتشفع من أجل آخر ينال هو نفسه الهبة، ليس كمحتاج إليها، بل لحساب من يتشفع لأجله.
7 ـ وكما أن الرب يأخذ ضعفاتنا، دون أن يكون ضعيفًا[17]، ويجوع دون أن يكون محتاجًا للأكل. وهو يأخذ ضعفاتنا لكى يلاشيها. كما أنه ـ في مقابل ضعفاتنا ـ يقبل أيضًا الهبات التي من الله، حتى أن الإنسان الذي يتحد به، يمكنه أن يشترك في هذه الهبات. ولذلك يقول الرب” كل ما أعطيتنى.. قد أعطيتهم“. وأيضًا ” من أجلهم أنا أسأل ” (يو7: 17ـ9) لأنه كان يسأل لأجلنا، أخذًا لنفسه ما هو لنا، ومعطيًا لنا ما أخذه. لأنه عندما اتحد الكلمة بالإنسان نفسه، فإن الآب من أجل ابنه قد أنعم على الإنسان بأن يُمجد، وأن يُدفع له كل سلطان، وما شابه ذلك. لذا نُسبت كل هذه الأمور “للكلمة” نفسه، لكى ننال بواسطته كل هذه الأمور التي أُعطيت له.
فكما أن “الكلمة” صار إنسانًا لأجلنا، هكذا نحن نُرفَّع لأجله. فإن كان لأجلنا قد وضع نفسه (اتضع)، فليس من غير المعقول إذن أن يُقال إنه قد مُجد ورُفع لأجلنا، لهذا ” أعطاه ” (الآب) أى ” أعطانا من أجله هو”، وقد “رفَّعه” أى ” رفَّعنا نحن فيه “. “والكلمة” نفسه، حينما نتمجد ونأخذ وننال معونة، كأنه هو نفسه الذي مُجِّدَ وأخذ ونال معونة، يقدم الشكر للآب، ناسبًا ما لنا لنفسه قائلاً: “ كل ما أعطيتنى.. قد أعطيتهم ” (يو8،7: 17).
8 ـ إن يوسابيوس ورفاقه، أى مجانين الآريوسية، ينسبون للابن بداية وجود، ومع ذلك يزعمون أنهم لا يريدون أن تكون له بداية لملكه. لكن هذا هراء، لأن من ينسب للابن بداية وجود، فمن الواضح جدًا أنه ينسب له بداية لملكه. لقد صاروا عميان لدرجة أنهم يعترفون بما ينكرونه. وأيضًا الذين يقولون إن الابن هو مجرد اسم فقط، وإن ابن الله، أى “كلمة” الآب ليس له جوهر ولا أقنوم، يتظاهرون بالغضب من الذين يقولون: كان هناك وقت لم يكن (الابن) موجودًا، هذا أمر مضحك أيضًا. لأن أولئك الذين ينكرون وجوده على الإطلاق، غضبى من أولئك الذين يقبلون على الأقل بوجوده في الزمان. وبينما هم يلومون الآخرين، فإنهم يعترفون بما ينكرونه. وإذ يعترف يوسابيوس ورفاقه بالابن،فإنهم ينكرون أنه “الكلمة” بالطبيعة، زاعمين أن الابن يدعي كلمة بشكل نظري، ويعترف الآخرون به أنه الكلمة، وينكرون عليه أن يكون ابنًا، معتبرين أن “الكلمة” يُدعي بالابن بشكل نظري، وذلك بدون سند كالسابقين تمامًا.
9 ـ ” أنا والآب واحد ” (يو30: 10). أنتم تقولون إن الاثنين واحد، وإن للواحد اسمين، أو إن الواحد منقسم إلى اثنين. فإن كان الواحد منقسمًا إلى اثنين، فإن ذاك الذي ينقسم لابد أن يكون جسدًا، ولا يكون أى جزء منهما كاملاً، لأن كلاً منهما هو جزء وليس كلاً. لكن إن كان للواحد اسمان، فإن تلك هى هرطقة سابيليوس، الذي قال إن الابن والآب هما نفس الشخص، وبذلك أنكرهما كليهما، إذ أنكر الآب حينما يكون هناك ابن، كما أنكر الابن حينما يكون هناك آب. لكن إن كان الاثنان واحدًا، فإنه من المحتم أن يكونا اثنين، لكنهما واحد حسب الألوهية، وحسب وحدانية الابن مع الآب في الجوهر[18]، ولكون “الكلمة” هو من الآب ذاته. لهذا فإن هناك اثنين، لأن هناك آبًا، وابنًا هو الكلمة. ومن الجهة الأخرى هما واحد لأن الله واحد. لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، لكان قد قال: ” أنا الآب “، أو ” أنا والآب أكون “. لكنه في الحقيقة يشير إلى الابن في لفظة ” أنا “، ويشير إلى الذي وَلَده ” الآب”، وفي قوله ” واحد” يشير إلى اللاهوت الواحد، ووحدانيته مع الآب في الجوهر. لأنه لا يمكن أن يكون نفس الشخص هو الحكيم والحكمة معًا. كما لا يمكن أن يكون الآب هو نفسه “الكلمة”، لأنه من غير المعقول أن يكون الشخص أبًا لذاته، لكن التعليم الإلهى يعرف الآب والابن، والحكيم والحكمة، والله “والكلمة”، ويحافظ على (الجوهر) بغير انقسام ولا انفصال ولا انحلال من كل الوجوه.
10 ـ لكن إن كان أى شخص يسيء فهمنا ويظن أننا نكرز بإلهين عند سماعه أن الآب والابن اثنان، (وهو ما يختلقه البعض لأنفسهم، ومن ثم يهزأون بنا قائلين: أنتم تعتقدون بإلهين)، فعلينا أن نجيبهم على ذلك ونقول: إن كان الاعتراف بآب وابن هو اعتقاد بإلهين، يتبع ذلك على الفور أنه إن اعترفنا بواحد فقط فيلزم أن ننكر الابن ونتبع سابيليوس. لأنه إن كان الحديث عن اثنين معناه السقوط في الوثنية، فإن الحديث عن واحد يجعلنا نسقط في بدعة سابيليوس. لكن ليس الأمر كذلك، حاشا! ولكن كما أنه حين نقول إن الآب والابن اثنان، فإننا لا نزال نعترف بإله واحد، هكذا أيضًا عندما نقول إن هناك إلهًا واحدًا فإننا نؤمن بأن الآب والابن اثنان، بينما هما واحد في اللاهوت، وأن كلمة الآب لا ينحل ولا ينقسم ولا ينفصل عن الآب. ولتكن النار والشعاع الخارج منها مثالاً أمامنا، فهما (أى النار وشعاعها) اثنان في الوجود والمظهر، لكنهما واحد في أن شعاع النار هو من النار بدون انقسام.
11 ـ لقد سقط مارسيللوس[19] وتلاميذه في نفس حماقة الآريوسيين. لأن الآريوسيين أيضًا يقولون إن الابن خُلق لأجلنا، لكى يخلصنا. وكأن الله انتظر حتى يوجد “الكلمة” لكى نخُلق نحن، كما تقول طائفة منهم، أو انتظر لكى يُخلق (الكلمة) كما تزعم طائفة أخرى. فالآريوسيون إذن أكثر تعاطفًا مع الناس مما مع الابن، لأنهم يزعمون أننا لم نُخلق لأجله، بل هو الذي صار لأجلنا، حتى أنه لذلك قد خُلق ووُجد، لكى يخلقنا الله بواسطته. ولأنهم عديمى التقوى، فهم يعطون الله أقل مما يعطون لنا. لأننا حتى ونحن صامتون، غالبًا نكون نشيطين في التفكير، فنصيغ نتائج تفكيرنا في شكل صور. لكنهم يجعلون الله خاملاً في صمته، وحين يتكلم فحينئذ تكون له قوة؛ كأنه وهو صامت لا يقدر على الخلق، وحينما يتكلم يبدأ في الخلق.
لأنه من العدل أن نسألهم، ما إذا كان “الكلمة” كاملاً حين كان في الله، حتى يصبح قادرًا على الخلق. فإن كان ناقصًا حين كان في الله، لكنه صار كاملاً عندما وُلِدَ، فنكون نحن إذن سبب كماله إن كان قد وُلِدَ لأجلنا ونال القدرة على الخلق لأجلنا. لكنه إن كان كاملاً في الله حتى يستطيع أن يخلق، فإن ميلاده يكون بلا لزوم، لأنه كان يمكنه أن يخلق العالم حتى وهو في الآب. لهذا فسواء وُلِدَ أو لم يُولد فإن ذلك ليس لأجلنا، بل لأنه هو منذ الأزل من الآب. لأن ميلاده لا يثبت أننا مخلوقون، بل يثبت أنه من الله، لأنه كائن حتى قبل خلقتنا.
12 ـ إنهم يتجاسرون على ترديد نفس الأمور غير المعقولة بخصوص الآب، لأنه إن كان وهو صامت، لم يقدر أن يخلق، فبالضرورة يكون قد نال قوة على الكلام عندما وَلَدَ (الكلمة) كما يزعمون. ومن أين نال هذه القوة؟ ولماذا؟ وإن كان الآب قادرًا على الخلق ” والكلمة ” فيه، فإنه لم يكن محتاجًا إلى الولادة، طالما كان قادرًا على الخلق حتى وهو صامت. ثم إن كان “الكلمة” (كائنًا) في الله قبل ولادته، إذن فإن ميلاده يعنى أنه خارج الله. فإن كان الأمر كذلك، فكيف يقول “الكلمة”: ” أنا في الآب والآب في ” (يو10: 14)؟ وقوله إنه في الآب الآن، يعنى أنه كان فيه دائمًا كما هو الآن. ولا حاجة بعد لما يقولونه ” إنه لأجلنا قد وُلِدَ، وأنه بعد أن خَلَقنا يعود كما كان “. لأنه لم يكن هو في أى حال ليس هو عليه الآن، وليس هو الآن ما لم يكن عليه قبل الآن، بل هو هو كما كان دائمًا، وفي نفس الحال، وبنفس الصفات، وإلاّ فسيبدو أنه ناقص ومتغيّر. لأنه إن كان (الحال) الذي كان عليه، هو ما سوف يكون عليه بعد ذلك ـ وكأنه لم يكن هكذا الآن ـ فمن الواضح أنه الآن هو غير ما كان عليه، وما سوف يكون عليه. أعنى إن كان هو قبلاً في الله، وأنه فيما بعد سوف يكون أيضًا في الله، فيتبع ذلك أن “الكلمة” ليس في الله الآن. لكن الرب يدحض زعم هؤلاء الأشخاص حينما يقول: ” أنا في الآب والآب في “، وهكذا فهو يكون الآن، كما كان منذ الأزل. ليس أنه كان في وقت ما مولودًا، ولم يكن هكذا في وقتٍ آخر، وليس أن الله كان صامتًا مرة، ثم صار ناطقًا، بل هناك آب كائن منذ الأزل[20]، وهناك ابن الذي هو “كلمته”، ليس “كلمة” بالاسم فقط[21]، ولا بشكل نظرى بل هو في وجوده مساوٍ للآب في الجوهر[22]، وليس مولودًا لأجلنا بل نحن الذين خُلقنا لأجله هو.
لأنه إن كان الابن قد وُلِدَ لأجلنا، وعند ميلاده نحن خُلقنا، وبميلاده تكونت الخليقة، ثم يعود لكي يكون ما كان عليه قبلاً، فإن ذاك الذي وُلد، يعود لكي يكون غير مولود. لأنه إن كان تقدمه هو بميلاده، فإن عودته تعني توقف هذا الميلاد، لأنه حينما يعود ليكون في الله ثانية فإن الله يصبح صامتًا مرة أخري. لكن إن كان (الله) سيصير صامتًا، كما كان ويعود إلي السكون وليس الخلق، لأن الخليقة ستتوقف عن الوجود. لأنه كما أنه في خروج الكلمة قد خلقت الخليقة وأصبحت موجودة، هكذا في كف الكلمة عن الفعل فلن تكون الخليقة موجودة، وإن كانت الخليقة سوف تتوقف، فما النفع إذن من وجودها؟ أو لماذا تكلم الله، إن كان سيصمت من جديد؟، ولماذا يُخرج (من ذاته) واحدًا ثم يسحبه؟ ولماذا يلد واحدً، وهو يريد أن يتوقف ميلاده؟ وسوف يصبح من غير المؤكد ماذا سيكون (هذا الواحد). لأنه إما أن يظل (الله) صامتًا إلي الأبد، أو أنه سوف يلد مرة أخري، ويصنع خليقة مختلفة، (لأنه لن يخلق نفس ما خلقه، وإلاّ كان قد أبقى عليه)، بل سوف يخلق خليقة أخرى، وسوف يُوقف هذه الخليقة أيضًا في وقت ما، وسوف يصنع خليقة أخرى، وهكذا بلا نهاية.
13 ـ ربما استعار مارسيللوس هذا من الرواقيين، الذين يزعمون أن الله يتقلص ويتمدد Dilatation مع الخليقة، ثم يستريح بدون نهاية. لأن ما تمدد قد أصبح متسعًا بعدما كان ضيقًا، وما تمدد قد تمدد بعدما كان متقلصًا، أى أنه تعرض للتغيير. فإن كان ” الواحد” قد تمدد وصار ثالوثًا، وكان ” الواحد” هو الآب، والثالوث هو الآب والابن والروح القدس، فإن “الواحد ” يكون قد تمدد، إذ اعتراه تغيير وأصبح ما لم يكنه؛ فقد تمدد بينما لم يكن متمددًا قبلاً.
ثم إن كان هذا ” الواحد ” ذاته قد تمدد إلى ثالوث؛ وهذا الثالوث هو الآب والابن والروح القدس، إذن صار الآب نفسه ابنًا وروحًا قدسًا أيضًا، كما زعم سابيليوس إلاّ إذا كان هذا ” الواحد ” الذي يتكلم عنه هو شخص آخر غير الآب، فما كان ينبغى عليه أن يتكلم عن التمدد، طالما أن “الواحد” يصير منه ثلاثة، وهكذا كان هناك ” واحد ” في الأول ثم أصبح آبًا وابنًا وروحًا. لأنه إن كان ” الواحد ” قد تمدد ووسع نفسه، لوجب أن يكون هو نفسه الذي اتسع. فالثالوث حينما يتمدد لا يصير بعد واحدًا، وحينما يكون واحدًا فلا يكون ثالوثًا بعد. ولهذا فإن الذي كان آبًا لم يكن بعد ابنًا وروحًا، بل عندما أصبح ابنًا وروحًا، لم يعد بعد آبًا فقط. والإنسان الذي يتكلم هكذا، لابد أن ينسب لله جسدًا، ويجعله قابلاً للضعف. لأنه ما هو التمدد سوى تغيير يعترى ذاك الذي تمدد؟ أو ماذا يكون الذي تمدد إلاّ ذاك الذي لم يكن هكذا قبلاً، بل كان في الواقع ضيقًا؟ لأنه هو نفس الشيء، لكنه يختلف عن ذاته من جهة الزمن فقط.
14 ـ وهذا ما يعرفه الرسول الإلهى حين يكتب إلى أهل كورنثوس قائلاً: “ فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا.. كونوا أنتم أيضًا مُتسعين ” (2كو11: 6ـ13). لأنه ينصح هؤلاء بأن يتغيروا من الضيق إلى الاتساع. وكما أن الكورنثيين عندما تغيروا من الضيق إلى الاتساع، لم يصيروا أُناسًا آخرين، بل ظل الكورنثيون أنفسهم هكذا إن كان الآب قد أتسع إلي ثالوث (حسب زعمهم) فإن الثالوث لا يزال هو الآب وحده. ويقول الرسول نفس الشيء: ” قلبنا متسع ” (2كو11: 6)، ويقول نوح: ” ويوسِّع الله يافث ” (تك27: 9س)، ولكن رغم هذا الاتساع بقي نفس القلب، وبقي يافث كما هو.
فإن كان ” الواحد ” قد اتسع إذن، فإنه يكون قد اتسع لأجل آخرين، لكن إن كان قد اتسع لأجل ذاته، يكون هو نفس الذي اتسع. ومن يكون هذا (الذي اتسع لأجله) سوي الابن و الروح القدس؟ وحسنًا أن نسأله حين يتكلم هكذا، وما هو عمل هذا الاتساع؟ وفي الواقع، لماذا قد تم هذا الاتساع أصلاً؟ لأن الذي لا يبقى كما هو، بل يتسع بمرور الزمن، فلابد أن يكون هناك بالضرورة سبب لاتساعه. فإن كان هذا الاتساع من أجل أن يكون الابن والروح معه، فإنه لا داعى للقول بوجود ” الواحد ” الذي يتسع بعد ذلك. لأن “الكلمة” والروح القدس لم يُوجدا بعد (الآب)، بل منذ الأزل، وإلاّ كان الله بلا “كلمة”[23]، كما يزعم الآريوسيون. لهذا فإن كان الكلمة والروح القدس موجودين منذ الأزل، فإن الله كان متسعًا منذ الأزل، ولم يكن ” واحدًا ” أولاً. لكن إن كان قد اتسع بعد ذلك، إذن وُجد “الكلمة” فيما بعد. وإن كان قد اتسع من أجل التجسد، وصار ثالوثًا عندئذٍ؛ إذن قبل التجسد لم يكن هناك ثالوثًا بعد. وسوف يبدو أن الآب قد صار جسدًا، فإن كان الأمر كذلك، وكان هو ذاك ” الواحد “، وقد اتسع في الإنسان؛ فربما كان هناك ” واحد ” فقط ثم جسد، ثم ثالثًا روح. وإن كان الأمر كذلك فقد اتسع هو نفسه، وسوف يكون هناك ثالوث بالاسم فقط. ومن غير المعقول أيضًا القول إنه قد اتسع لأجل الخلق، لأنه كان يمكنه أن يخلق الكل، وهو باق ” واحدًا ” لأن ” الواحد ” لم يكن محتاجًا إلي الاتساع، كما أنه لم يكن ناقصًا في القوة قبل أن يتسع. لأنه من السخف وعدم التقوى أن نفكر أو نتحدث هكذا عن الله. كما سينجم سخف أخر أيضًا لأنه إن كان قد اتسع لأجل الخلق فعندما كان ” واحدًا ” لم يكن هناك خلق، لكنه عند انقضاء الدهور سوف يرجع ” واحدًا ” مره أخري بعد الاتساع، وسوف تصير الخليقة أيضًا إلي العدم. لأنه كما اتسع لغرض الخلق، هكذا عندما يتوقف الاتساع، تتوقف الخليقة أيضًا.
15 ـ مثل تلك الأمور غير المعقولة تترتب علي القول بأن ” الواحد ” قد اتسع إلي ثالوث. ولما كان أولئك الذين يزعمون ذلك يتجاسرون أن يفصلوا “الكلمة” عن الابن، وأن يقولوا إن “الكلمة” شخص والابن شخص آخر، وأن “الكلمة” كان أولاً ثم الابن. فلنفحص هذا التعليم أيضًا، إذ أن افتراضهم يأخذ عدة أشكال، فالبعض يقولون إن الإنسان الذي أخذه المخلص هو الابن، وآخرون يزعمون أن الإنسان “والكلمة” قد صارا الابن فيما بعد حينما اتحدا. وآخرون يقولون إن “الكلمة” ذاته قد صار ابنًا حينما تأنس، هكذا يقولون إنه قد صار ابنًا بعد أن كان “الكلمة”، ولم يكن ابنًا من قبل، بل كان “الكلمة” فقط.
وهذه كلها تعاليم الرواقيين، سواء القائلة بأن الله قد اتسع أو التي تنكر الابن. لكن من غير المعقول على الإطلاق أنهم بينما يسمّون “الكلمة”، ينكرون أنه الابن! لأنه لو لم يكن “الكلمة” من الله، لكان من المعقول أن ينكروا أنه ابن. لكنه إن كان من الله، فكيف لا يدركون أن من يُولد من شخص هو ابن لهذا الذي جاء منه؟ ثم إن كان الله أبًا “للكلمة”، فلماذا لا يكون “الكلمة” ابن لأبيه الذاتى؟ لأن واحدًا كائن ويدعى أبًا، له ابنه، وواحدًا كائن ويُدعى ابن لآخر، الذي هو أبوه. فإن لم يكن الله هو أب المسيح، فلا يكون “الكلمة” ابنًا؛ ولكن إن كان الله هو أب، فمن المعقول أيضًا أن يكون “الكلمة” هو ابن. لكن إن كان الله موجودًا أولاً ثم صار أبًا فيما بعد، فهذا هو فكر الآريوسيين. ثم أنه من السخف القول بأن الله يتغير، لأن تلك هى سمة الأجسام. لكن إن كانوا يجادلون أن الله صار خالقًا فيما بعد لكى يخلق العالم، فليعلموا أن التغيير هو خاصية المخلوقات [24] التي أتت إلى الوجود فيما بعد، وليس خاصية في الله.
16 ـ فإن كان الابن أيضًا مخلوقًا فيكون الله قد بدأ يصير أبًا للابن كما هو بالنسبة للمخلوقات؛ لكن إن لم يكن الابن مخلوقًا، فإن الآب يكون آبًا منذ الأزل، والابن ابنًا منذ الأزل[25]. وإن كان الابن كائنًا منذ الأزل، فيجب أن يكون هو “الكلمة”. لأنه إن لم يكن “الكلمة” هو الابن منذ الأزل، وهو ما يتجاسر البعض علي قوله، فإنهم بذلك يعتقدون إما أن “الكلمة” هو الآب، أو أن الابن أعظم من “الكلمة”. وإذ الابن هو ” في حضن الآب “ (يو18: 1)، فبالضرورة إما أن يكون “الكلمة” بعد الابن (إذ لا يوجد من هو قبل ذاك الكائن في الآب)، أو إن كان “الكلمة” غير الابن، ” فالكلمة” لابد أن يكون هو الآب الذي فيه الابن كائن. لكن إن لم يكن “الكلمة” هو الآب بل هو ” الكلمة”، فلا بد أن يكون “الكلمة”، خارج الآب، طالما أن الابن هو الذي ” في حضن الآب “. لأنه لا يمكن أن يكون كل من “الكلمة” والابن في حضن الآب، إذ يجب أن يكون واحدٌ فقط فيه، وهو الابن الذي هو “ الابن الوحيد“. وإن كان “الكلمة” شخصًا والابن شخصًا آخر، فإن الابن يكون أعظم من “الكلمة”، لأنه “ لا أحد يعرف الآب إلا الابن “. ونفس الآمر ينطبق علي قول المسيح: ” الذي رآني فقد رأي الآب ” (يو9: 14)، و” أنا والآب واحد ” (يو30: 10). لأن هذه أقوال الابن، وليست أقوال “الكلمة” كما يزعمون، وكما هو واضح في الأناجيل. لأنه بحسب إنجيل يوحنا، حين قال الرب: ” أنا والآب واحد ” أخذ اليهود حجارة ليرجموه، فأجابهم يسوع قائلاً: ” أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ فأجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهًا. أجابهم يسوع: أليس مكتوبًا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة. إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن يُنقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلي العالم، أتقولون له: إنك تجدف، لأنى قلت إني ابن الله؟ وإن كنت لست أعمل أعمال أبي، فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي، فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيّ وأنا فيه ” (يو32: 10-38). وكما يظهر من هذه الكلمات فهو لم يقل أنا الله، ولا قال أنا ابن الله بل قال: “ أنا و الآب واحد “.
17 ـ فحينما سمع اليهود (لفظة) ” واحد ” ظنوا مثل سابليوس، أنه قال إنه هو الآب. لكن مُخلصنا يبين خطأهم بقوله: رغم إنى قد قلت ” إله “، كان عليكم أن تتذكروا المكتوب، ” أنا قلت إنكم آلهة ” (يو34: 10)، ولكي يوضح عبارة ” أنا والآب واحد “، شرح وحدانية الابن مع الآب قائلاً: لأنني قلت إنى ابن الله، لأنه حتى لو لم يكن قد قالها بالألفاظ، لكنه أوضح معني ” الابن ” بقوله ” نحن واحد “. لأنه لا يوجد من هو واحد مع الآب، سوي الذي هو منه. ومن هو هذا الذي هو من الآب إلا الابن؟ لهذا فهو يضيف قائلاً: ” لتعرفوا إنني في الآب والآب فيّ “. لأنه حينما شرح لفظة “واحد ” قال إن الاتحاد (بين الآب والابن) وعدم انفصالهما إنما يكمن ليس في كون “هذا” هو “ذاك” الذي هو واحد معه بل في كون الابن في الآب والآب في الابن.لأنه هكذا يدحض تعليم سابليوس، فهو لم يقل ” أنا الآب “، بل قال أنا ” ابن الله “. ويدحض تعليم آريوس أيضًا بقوله ” أنا والآب نحن واحد “. فإن كان الابن ليس هو نفسه الكلمة، فإن الابن وليس “الكلمة” يكون واحدًا مع الآب، ولا يكون “الكلمة” هو الذي رأي الآب بل الابن هو الذي قد رأي الآب. ويترتب علي هذا: إما أن الابن أعظم من “الكلمة”، أو أن “الكلمة” ليس له ما هو أكثر مما للابن. لأنه لن يكون من هو أعظم وأكمل من ” الذي هو واحد مع الآب ” والذي يقول: ” أنا في الآب والآب فيّ “، و” الذي رآني فقد رأي الآب ” لأن تلك العبارات قالها الابن عن نفسه إذ يقول في إنجيل يوحنا: “ من رآني فقد رأي الذي أرسلني “، و” أنا قد جئت نورًا إلي العالم، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة… وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتِ لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير ” (يو45: 12، مت 40: 10، يو46: 12-48). ويقول الابن إن كلامه هو الذي يدين من لم يحفظ الوصية، إذ يقول ” لو لم أكن قد جئت وكلمتهم، لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم ” (يو22: 15). وهو يقصد: أن من يسمعون كلامي ويحفظونه يحصدون خلاصًا.
18 ـ ربما يقولون بلا خجل، إن هذا الكلام لا يخص الابن بل “الكلمة”. لكن يتضح مما سبق أن المتكلم هو الابن. لأن الذي يقول هنا ” ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العلم ” (يو47: 12)، يثبت أنه ليس آخر سوى ابن الله الوحيد الجنس. لأن يوحنا نفسه يقول قبل ذلك: ” لأنه هكذا أحب الله العلم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلي العالم، ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يُدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلي العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة ” (يو16: 3-19). فإن كان الذي يقول: ” ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم” هو نفس الذي يقول ” من رآني فقد رأي الذي أرسلني ” (يو45: 12). وإن كان الذي جاء ليخلص العالم، لا ليدينه، هو ابن الله الوحيد الجنس، فمن الواضح أنه هو نفسه الابن الذي يقول: ” من رآني فقد رأي الذي أرسلني“، لأن الذي يقول: ” من يؤمن بي…” و” إن سمع أحد كلامي… ” هو الابن نفسه؛ الذي يقول الكتاب عنه ” من يؤمن به لا يُدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد “. وأيضًا هذه هي الدينونة (دينونة الذي لا يؤمن بالابن) لأن النور جاء إلي العالم ولم يؤمنوا به، أي بالابن ” لأن هذا هو النور الذي يضيء لكل إنسان آتٍ إلي العالم ” (يو9: 1). ولقد كان هو نور العالم طوال زمن تجسده علي الأرض، كما قال هو نفسه: “ ما دام لكم النور، آمنوا بالنور، لتصيروا أبناء النور… ” لأنه يقول ” أنا قد جئت نورًا إلي العالم ” (يو36: 12، 46).
19 ـ وإذ قد أوضحنا هذا يتضح بذلك أن “الكلمة” هو الابن. فإن كان الابن هو النور، الذي جاء إلي العالم فهو أمر لا يقبل الجدل أن الابن هو الذي خلق العالم. لأنه في بداية الإنجيل، إذ يتحدث الإنجيلي عن يوحنا المعمدان، يقول: “ لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور ” (يو8: 1)0 لأن المسيح كما قلنا قبلاً هو: ” النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آت إلي العالم ” (يو9: 1). لأنه إن ” كان في العالم و كُوّن العالم به ” فبالضرورة يكون هو “كلمة” الله، الذي قال عنه الإنجيلي أيضًا إن ” كل شيء به كان “. لأنه إما سيضطرون للحديث عن عالمين: واحد منهما قد خلق بواسطة الابن، والآخر بواسطة “الكلمة”؛ وأما أن كان هناك عالم واحد وخليقة واحدة، فإن الابن و”الكلمة” يكونان واحدًا ونفس الشخص قبل كل خليقة، لأن الخليقة قد أتت إلي الوجود بواسطته. لهذا فإن كانت كل الخلائق قد خُلقت بواسطة “الكلمة”، الذي هو الابن أيضًا، ولن يكون هناك تناقض أن نقول: ” في البدء كان الكلمة ” أو ” في البدء كان الابن “، بل يكون القولان متماثلان. لكن لأن يوحنا لم يقل في البدء كان الابن، فإنهم يزعمون أن خصائص الكلمة لا تُناسب الابن فيتبع ذلك إذن أن خصائص الابن لا تُناسب “الكلمة” أيضًا.
لكن لأنه قد ثبت أن ما يرد ذكره يخص الابن: ” أنا والآب واحد “، و” الذي هو في حضن الآب ” (يو30: 10،18: 1). و” من يراني يري الذي أرسلني ” (يو45: 12). وأن القول: ” أن العالم خلق بواسطته يشير إلي الابن و”الكلمة” معًا، واتضح أن الابن موجود قبل كون العالم؛ لأنه يلزم بالضرورة أن يكون الخالق موجودًا قبل المخلوقات. وهم يزعمون أن ما قيل لفيلبس يجب أن يُنسب للابن وليس “للكلمة”، لأن يسوع قال لفيلبس: ” أنا معكم زمانًا هذا مدته، ولم تعرفني يا فيلبس! الذي رآني فقد رأي الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن إني أنا في الآب والآب فيّ؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيّ هو يعمل الأعمال. صدقوني إني في الآب والآب فيّ، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضًا، ويعمل أعظم منها، لأني ماضٍ إلي أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن ” (يو9: 14-13). لهذا فإن كان الآب يتمجد بالابن فإن الابن هو القائل: ” أنا في الآب والآب في “، والذي قال أيضًا: ” من رآني فقد رأي الآب “، لأن نفس الذي تكلم هو الذي يُظهر نفسه أنه هو الابن بقوله: ” ليتمجد الآب بالابن “.
20 ـ فإن كانوا إذن يزعمون أن الإنسان الذي لبسه “الكلمة” وليس “الكلمة” هو نفسه ابن الله الوحيد، لترتب علي ذلك أن يكون هذا الإنسان هو الذي في الآب، والذي فيه الآب أيضًا. ولكان يجب أن يكون هذا الإنسان هو الواحد مع الآب، وهو الذي في حضن الآب، والنور الحقيقى. ولأضطروا أن يقولوا إن العالم قد خُلق بواسطة هذا الإنسان نفسه، وإن هذا الإنسان هو الذي جاء لا ليدين العالم بل ليخلصه، وإنه هو الذي كان كائنًا قبل أن يكون إبراهيم لأن الكتاب يقول إن يسوع قال لهم: ” الحق الحق أقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم، أنا كائن ” (يو58: 8).
وهم يقولون أمن المعقول أن الذي جاء من نسل إبراهيم بعد اثنين وأربعين جيلاً (قابل مت17: 1) يكون موجودًا قبل أن يكون إبراهيم؟ فنقول لهم أمن المعقول أيضًا أن يكون الجسد الذي لبسه “الكلمة”، هو نفسه الابن، وأن يقال إن الجسد الذي من مريم هو الذي بواسطته قد خُلق العالم؟ وكيف لهم أن يبقوا علي عبارة أنه ” كان في العالم ” (يو10: 1)؟ لأن الإنجيلى إذ يبرهن على أسبقية وجود الابن على ميلاده بحسب الجسد، يستمر قائلاً إنه: ” كان في العالم “. فإن لم يكن “الكلمة” هو الابن بل الإنسان، فكيف يمكنه أن يخلص العالم، وهو نفسه واحد من العالم؟ وإن كان ذلك لا يخزيهم، فأين سيكون “الكلمة”، إن كان ذلك الإنسان موجود في الآب؟ وما هى علاقة “الكلمة” بالآب، إن كان ذلك الإنسان هو والآب واحد؟ وإن كان ذلك الإنسان هو الابن الوحيد، فما هو مكان “الكلمة”؟ إمّا أن يقول المرء إن “الكلمة” يأتى في المرتبة الثانية، أو إن كان “الكلمة” أعلى من الابن الوحيد، فيجب أن يكون “الكلمة” هو الآب ذاته. لأنه كما أن الآب واحد، كذلك أيضًا الابن الوحيد الذي منه هو واحد؛ وماذا بقى “للكلمة” من رفعة فوق الإنسان، إن لم يكن “الكلمة” هو الابن؟ لأنه مكتوب أن العالم خُلق بواسطة الابن و”الكلمة”، وأن خلقة العالم هى عمل مشترك “للكلمة” والابن، ولكن الكتاب بعد ذلك يشير إلى أن الآب يرى في الابن وليس في “الكلمة”، كما ينسب خلاص العالم للابن الوحيد الجنس، وليس “للكلمة”. لأن الكتاب يذكر أن يسوع قال: ” أنا معكم زمانًا هذا مدته ولم تعرفنى يا فيلبس؟ من رآنى فقد رأى الآب ” (يو9: 14). ولم يُكتب أن “الكلمة” يعرف الآب، بل الابن، كما لم يُكتب أن ” الكلمة ” يرى الآب بل الابن الوحيد الجنس الذي هو في حضن الآب.
21 ـ وبماذا يُساهم “الكلمة” في خلاصنا أكثر من الابن، إن كان الابن شخص و”الكلمة” شخص آخر، كما يزعمون؟ لأن الوصية هى أننا يجب أن نؤمن بالابن، وليس “بالكلمة”. لأن يوحنا يقول: ” الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة ” (يو36: 3). والمعمودية المقدسة التي تحوى أساس الإيمان كله لا تتم “بالكلمة”، بل بالآب والابن والروح القدس.
فإن كان “الكلمة” شخصًا، والابن شخصًا آخر كما يزعمون، وليس “الكلمة” هو الابن. فليس للمعمودية أية علاقة “بالكلمة”. فكيف يكون “الكلمة” موجودًا مع الآب، إن لم يكن معه في منح المعمودية؟ لكنهم ربما يقولون إن “الكلمة” مُتضمن في اسم الآب وفي هذه الحالة، لماذا لا يكون الروح مُتضمنًا فيه أيضًا؟ أم أن الروح خارج عن الآب؟ ويكون ” الإنسان ” مدعوًا بعد الآب ـ (إن لم يكن “الكلمة” هو الابن) ـ أما الروح فيُدعى بعد ” الإنسان “. وبدلاً من أن يتمدد ” الواحد” إلى الثالوث حسب زعمهم، فإنه يتمدد إلى رابوع (Tetrad): آب و”كلمة” وابن وروح قدس! وإذ يعتريهم الخزى بسبب قولهم هذا، فإنهم يلجأون إلى مخرج آخر، ويزعمون أنه ليس بذاته هو الذي أخذه (لبسه) الرب، بل “الكلمة” والإنسان معًا، هما الابن، لأنهما بارتباطهما معًا يُدعيان الابن، حسب قولهم. وفي هذه الحالة مَنْ منهما يكون علة الآخر؟ ومَنْ منهما قد خلق الآخر؟ أو دعنا نتحدث بوضوح أكثر، هل “الكلمة” دُعىّ ابنًا بسبب الجسد؟ أم أن الجسد هو الذي دُعيّ ابنًا بسبب “الكلمة”؟ أم ليس بسبب أى منهما، بل بسبب إنجماع الاثنين معًا؟ فإن كان “الكلمة” ابنًا بسبب الجسد، فبالضرورة يكون الجسد ابنًا، ويترتب على ذلك أمور غير معقولة والتي تنجم من قولهم إن الإنسان هو ابن. لكن إن كان الجسد قد دُعى ابنًا بسبب “الكلمة”، لكان “الكلمة” ابنًا بالتأكيد حتى قبل الجسد. إذ كيف لكائن أن يجعل الآخرين أبناءً مع كونه هو نفسه ليس ابنًا، خاصة حين يكون هناك أب[26]؟ فإن كان يلد أبناءً لنفسه، إذن سيكون هو نفسه آبًا. لكن إن كان يلد للآب، لوجب أن يكون ابنًا، أو بالحرى سيكون هو ذلك الابن، الذي بسببه جُعل الباقون أبناءً أيضًا.
22 ـ لأنه إن لم يكن هو ابنًا، بينما نحن أبناء، فإن الله يكون أبانا نحن وليس أباه هو. فكيف إذن ينتحل البنوة له قائلاً: ” أبي ” و ” أنا من الآب “؟ (يو17: 5، يو28: 16)، لأنه إن كان أبًا عامًا للكل، فلا يكون أباه هو فقط، ولا يكون هو وحده قد وُلد من الآب. لكن الكتاب يقول إن الآب يُدعي في بعض الأحيان أب لنا نحن أيضًا، بسبب أن (الابن) نفسه صار شريكًا في جسدنا. لأنه لهذا السبب صار ” الكلمة ” جسدًا، إذ حيث إن ” الكلمة ” هو الابن، فإن الآب يُدعى أبانا أيضًا، بسبب الابن الساكن فينا[27]، لأن الكتاب يقول: ” أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم، صارخًا يا أبا الآب ” (غل6: 4). لهذا فالابن الذي فينا، إذ يدعو أباه الذاتى فإنه يجعل أباه يُدعى أبانا نحن أيضًا. وبالتأكيد فإن الله لا يمكن أن يُدعى أبًا لأولئك الذين ليس لهم الابن في قلوبهم. لكن إن كان الإنسان يُدعى ابنًا بسبب “الكلمة”، فإنه يلزم (أن يكون “الكلمة” ابنًا) حتى قبل حلوله في وسطنا حيث إن القدماء[28] دُعوا أبناء حتى قبل التجسد، إذ يقول الكتاب: ” لأنى ولدت بنينًا ” (إش2: 1)، وفي أيام نوح يقول: ” حين رأى أبناء الله ” (تك2: 6س). وفي نشيد موسى النبى: ” أليس هو أباك ” (تث6: 32)؟ لهذا كان أيضًا هناك ذلك الابن الحقيقى، الذي لأجله صار أولئك أيضًا بنينًا… لكن إن لم يكن أي من الاثنين ابنًا، كما يزعمون أيضًا، بل إن (الأمر) يعتمد على إنجماع الاثنين معًا وبذلك لا يكون أيًا منهما ابنًا، أقول، لا “الكلمة” ولا الإنسان ـ بل علة ما ـ تكون هى سبب اتحادهما. ومن ثم فإن تلك العلة التي تصنع الابن سوف تكون سابقة علي الاتحاد. وبهذه الطريقة يكون الابن موجودًا قبل التجسد. وعندما تُثار هذه المسألة، فإنهم يلجأون إلي حجة أخري، قائلين إن الإنسان ليس ابنًا، ولا هما معًا ابن، لكن “الكلمة” هو الذي كان “كلمة” في البدء فقط، لكنه عندما صار إنسانًا، فحينئذٍ دُعي ابنًا،[29] لأنه لم يكن ابنًا قبل التجسد بل “كلمة” فقط؛ وكما صار “الكلمة” جسدًا، إذ لم يكن جسدًا من قبل، هكذا صار “الكلمة” ابنًا، إذ لم يكن ابنًا من قبل. تلك هي كلماتهم البطالة، وهكذا يبدو خزيهم واضحًا.
23 ـ إن كان (الابن) قد صار ابنًا حينما صار إنسانًا، فتكون صيرورته إنسانًا هى علة بنوته. وإن كان الإنسان هو علة صيرورته ابنًا، أو كان السببان معًا، لترتبت نفس النتائج غير المعقولة. ثم إنه لو كان أولاً “كلمة” وبعد ذلك صار ابنًا، فسوف ينتج أنه قد عرف الآب فيما بعد، وليس قبلاً، في حين أنه لا يعرفه بكونه “كلمة”، بل بكونه ابنًا. لأنه ” لا أحد يعرف الآب إلاّ الابن ” (مت27: 11). وسوف يترتب عليه، أنه صار فيما بعد أيضًا ” في حضن الآب ” وفيما بعد أنه صار هو ” والآب واحد ” وفيما بعد أيضًا: ” من رآنى فقد رأى الآب ” (يو9: 14)، لأن كل تلك الأشياء قيلت عن الابن. ومن ثم سيضطرون إلى القول، إن “الكلمة” لم يكن إلاّ مجرد اسم فقط؛ لأنه لم يكن هو (الأقنوم) الكائن هو والآب فينا، ولا يكون من رأى “الكلمة” قد رأى الآب، كما أن الآب لم يكن معروفًا لأى أحد على الإطلاق، لأن الآب يُعرف بواسطة الابن، لأنه مكتوب ” ومن أراد الابن أن يعلن له ” (مت27: 11)، لأنه إن لم يكن “الكلمة” ابنًا بعد، ولم يكن أحد قد عرف الآب بعد، فكيف إذن استعلن لموسى، وللآباء؟ إذ يقول هو نفسه في سفر الملوك: ” لقد تجليت بوضوح لبيت أبيك ” (1صم27: 2س). لكن إن كان الله قد استعلن فإن الابن لابد أن يكون موجودًا لكى يعلنه، كما يقول هو نفسه: “ ومن أراد الابن أن يعلن له“.
إنه من غير التقوى إذن ومن الحماقة القول إن “الكلمة” كان شخصًا والابن آخر. ويحق لنا أن نسألهم من أين أتوا بهذه الفكرة؟ هم يجيبون زاعمين أن العهد القديم لا يذكر أى شيء عن الابن، بل يذكر؛ لذا فهم يؤكدون أن الابن جاء متأخرًا عن “الكلمة”، لأن الابن لم يذكر “الكلمة” في العهد القديم، بل في العهد الجديد فقط. هذا ما يزعمونه في عدم تقوى؛ فأولاً: إذ هم يفصلون بين العهدين؛ حتى أن الواحد منهما لا يوافق لآخر، فهذه هي حيلة المانويين واليهود؛ الذين يقاوم أحدهما العهد القديم ولآخر العهد الجديد[30]. وثانيًا: إن كان ما هو وارد في العهد القديم ذا تاريخ أقدم، وما هو في الجديد ذا تاريخ أحدث، وتعتمد الأوقات علي أساس الكتابة، فإن الشواهد: “ أنا والآب واحد ” (يو30: 10)، و” الوحيد ” (يو18: 1)، و” الذي رآني فقد رأي الآب ” (يو9: 14) تكون أحدث بسبب أن تلك الشواهد مأخوذة من العهد الجديد وليس من القديم.
24 ـ لكن الأمر ليس كذلك، لأنه في الحقيقة قد قيل الكثير أيضًا عن الابن في العهد القديم، مثلما جاء في المزمور الثاني: ” أنت ابني وأنا اليوم وَلدتُكَ ” (مز7: 2). وفي المزمور التاسع، الذي عنوانه ” علي نهاية مزمور لداود بخصوص الأسرار الخاصة بالابن ” (مز1: 9) وفي المزمور الرابع والأربعين ” علي النهاية بخصوص الأمور التي ستتغير عن بني قورح للفهم، ترنيمة عن المحبوب ” (مز1: 44)، وفي إشعياء: ” لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم ” (إش1: 5). فمن هو هذا المحبوب سوى الابن الوحيد الجنس؟ مثلما نجد أيضًا في المزمور التاسع بعد المائة ” من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك ” (مز3: 109س)، والذي سنتناول الحديث عنه فيما بعد ، وفي الأمثال: ” قبل الجبال ولدني ” (أم25: 8س)، وفي دانيال: “ ومنظر الرابع شبيه بابن الله ” (دا 25: 3). وغيرها كثير.
فإن كان القِدَم هو بسبب أنه ذُكر في القديم؛ لكان الابن عتيق الأيام، أيضًا، والذي يظهر بوضوح في مواضع عديدة في العهد القديم. وهم يقولون: نعم هذا صحيح، لكننا يجب أن نأخذ الكلام نبويًا. ولهذا أيضًا يأتي الحديث عن “الكلمة” بشكل نبوي، أى لا يجب أن يؤخذ من جانب واحد، بل من الجانب الآخر أيضًا. لأنه إن كانت الآية: ” أنت ابني ” تشير إلي المستقبل، فإنه هكذا يكون الأمر بالنسبة للآية: ” بكلمة الرب تأسست السموات ” (مز6: 32) لأنه لم يقل: ” صارت” ولا ” خلقت” لأن لفظة ” تأسست ” إنما تشير إلي المستقبل، وهو ما نجده مكتوبًا في مواضع أخري مثل ” الرب قد ملك ” تتبعه علي الفور ” لأنه ثبّت المسكونة التي سوف لا تتزعزع ” (مز1: 92س). وإن كانت الكلمات في المزمور الرابع والأربعين ” لأجل حبيبي ” تشير إلي المستقبل فهكذا تشير الكلمات التي تليها ” فاض قلبي بكلمة صالحة ” (مز2،1: 44س). وإن كانت عبارة ” من البطن ” (مز3: 109) تتعلق بالإنسان، هكذا أيضًا عبارة ” من القلب “. لأنه إن كانت البطن بشرية فكذلك يكون القلب جسديًا أيضًا. لكن إن كان الذي من القلب أبديًا فإن الذي ” من البطن ” هو أبدي أيضًا، وإن كان ” الابن الوحيد الجنس ” هو في ” الحضن“، فإن ” المحبوب” يكون ” في الحضن” لأن ” الابن الوحيد” هو نفسه ” المحبوب“، كما في العبارة “هذا هو ابني الحبيب” (مت17: 3) لأنه لم يقل ” الحبيب” ليعبر عن أنه يريده، أى عن محبته نحوه ، لئلا يظهر أنه يكره الآخرين ، بل قد أوضح بذلك أنه الوحيد الجنس، ليظهر أن هذا هو الوحيد الذي هو منه. ولهذا فإن “الكلمة”، إذ أراد أن يوضح لإبراهيم فكرة ” الابن الوحيد” يقول له: ” قدم ابنك حبيبك” (تك2: 22س)؛ لكنه واضح للجميع أن أسحق كان الابن الوحيد من سارة. إذن “الكلمة” هو الابن، ولم يصر هكذا لاحقًا، أو دُعي ابنًا، بل هو ابن علي الدوام. لأنه لو لم يكن ابنًا، ما كان “كلمة”، ولو لم يكن “كلمة”، ما كان ابنًا. لأن الذي من الآب هو ابن. وماذا يكون الذي من الآب، إن لم يكن “الكلمة” الذي خرج من القلب وولد من البطن؟ لأن الآب ليس “كلمة” ولا “الكلمة” آبًا، لكن الواحد آب، والآخر ابن، واحد يلد والآخر مولود.
25 ـ فآريوس إذن، يهذي بقوله إن الابن مخلوق من العدم، وإنه مر وقت لم يكن فيه موجودًا. أما سابليوس فيهذى بقوله إن الآب هو ابن والابن هو آب، أى أقنوم واحد له اسمان. ويهذي أيضًا مارسيللوس إذ يستخدم نعمة الروح القدس كمثال، قائلاً كما أن هناك ” أنواع مواهب موجودة، لكن الروح واحد” (1كو4: 12)، هكذا أيضًا الآب، فإنه هو نفسه الآب ولكنه يتمدد إلي الابن والروح. لكن هذا الأمر مملوء سخافة. لأنه إن كان الأمر بالنسبة لله مثلما هو بالنسبة للروح، فسيكون الآب هو “الكلمة” والروح القدس؛ إذ يصير آبًا بالنسبة لشخص ما، ولآخر يصير ابنًا، ولآخر يصير روحًا، مكيفًا نفسه مع حاجة كل واحد. فيكون بالاسم ابنًا وروحًا، ولكنه في الواقع هو آب فقط، وبصيرورته ابنًا تكون له بداية، وعندئذٍ يكف عن أن يُدعى آبًا أو يُقال أنه صار إنسانًا بالاسم، لكنه في الحقيقة لم يأتِ حتى في وسطنا، ولم يكن صادقًا في قوله: ” أنا والآب واحد” إذ في الحقيقة هو نفسه الآب. بالإضافة للأمور الأخرى غير المعقولة التي تنتج في حالة سابليوس. ويتوقف بالضرورة اسم الابن والروح، حينما تنتهي الحاجة إليهما. لذا فالأمر سينتهي بالضرورة إلي ما يشبه عبث الأطفال، لأنه قد أُظِهر بالاسم وليس بالحق. وإذ يتوقف اسم الابن كما يزعمون تتوقف نعمة المعمودية أيضًا، لأنها منحت بالابن[31]. وماذا سيتبع ذلك سوي فناء الخليقة؟ لأنه إن كان “الكلمة” قد وُجد لكي نُخلق نحن، ولما وجُد صرنا نحن، فالواقع أنه حينما يعود إلى الآب، كما يزعمون فنحن لن نكون، لأن “الكلمة” يرجع مثلما كان؛ هكذا نحن أيضًا لن نوجد بعد وسنعود كما كنا. لأنه حينما لا يعود “الكلمة” موجودًا، فلن تكون هناك خليقة بعد.
26 ـ هذه كلها إذن، أمور غير معقولة. أما كون الابن ليس له بداية وجود، وأنه قبل التجسد كان مع الآب منذ الأزل، فهذا ما يوضحه يوحنا في رسالته الأولى، إذ يقول: ” الذي كان منذ البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أُظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية، التي كانت عند الآب وأُظهرت لنا ” (1يو2،1: 1). وبينما يقول هنا إن ” الحياة كانت عند الآب“، ولم يذكر أنها ” خُلقت “، فإنه في نهاية رسالته يقول إن الابن هو الحياة، كاتبًا هكذا: ” ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية ” (1يو20: 5). فإن كان الابن هو الحياة، والحياة كانت عند الآب، وإن كان الابن عند الآب، والإنجيلى نفسه يقول: ” والكلمة كان عند الله ” (يو1: 1)، فلابد أن يكون الابن هو “الكلمة” الذي هو عند الآب منذ الأزل.
وكما أن الابن هو “الكلمة”، فلابد أن يكون الله هو الآب. كما أن الابن بحسب يوحنا ليس هو مجرد إله، بل الإله الحق، لأنه بحسب نفس الإنجيلى: ” والكلمة كان الله ” (يو1: 1). وقال الابن: ” أنا هو الحياة ” (أنظر يو6: 14). لهذا فالابن هو “الكلمة” والحياة، الكائن عند الآب. وأيضًا ما قيل في إنجيل يوحنا نفسه: ” الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب ” (يو18: 1)، يوضح أن الابن موجود منذ الأزل. لأنه هذا الذي يدعوه يوحنا بالابن، يدعوه داود يد الله في المزمور قائلاً: ” لماذا ترد يدك ويمينك من وسط حضنك؟ ” (مز11: 73س). لهذا إن كانت ” اليد ” في الحضن، والابن في الحضن، فإن الابن سيكون هو اليد، واليد ستكون هى الابن، الذي به خلق الآب كل شيء: ” يدك صنعت كل شيء ” (إش2: 66)، ” أخرج (الرب) الشعب بيده (من مصر) ” (أنظر تث8: 7)، أى بواسطة الابن. وإن كانت عبارة: ” هذا هو تغيير يمين العلى ” (مز11: 76س) وأيضًا: ” حتى النهاية، بخصوص الأمور التي سوف تتغير، ترنيمة لحبيبى ” (مز1: 44س) فإن الحبيب لابد أن يكون هو اليد التي غيّرت. الذي يقول عنه الصوت الإلهى أيضًا: ” هذا هو ابنى الحبيب ” (مت17: 3) إذن فعبارة ” هذه يدى ” تساوى ” هذا ابنى “.
27 ـ وحيث إن هناك أُناس غير فاهمين، الذين ينكرون التعليم عن الابن، يستخفون بالآية: ” من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك ” (مز3: 110س)، وكأنها تشير إلى علاقته بالعذراء مريم، زاعمين أنه وُلد من مريم قبل كوكب الصبح، وأنه من غير المناسب أن يكون الكلام عن بطن الله، لذلك يجب أن نذكر هنا بضع كلمات… فإن كان بسبب أن ” البطن ” بشرية، فإنها لذلك تكون غريبة عن الله، فمن الواضح أن لفظة ” قلب ” أيضًا تعبر عن شيء بشرى[32]، لأن الذي له قلب، له بطن أيضًا. ولأن الاثنين هما بشريان، فإننا إمّا أن نرفض الاثنين أو أن نشرح معنيهما. فكما تأتى الكلمة من القلب، فإن الوليد يكون من البطن، وكما أنه حينما يكون الكلام عن قلب الله، فإننا لا نقصد بذلك المعنى البشرى، هكذا أيضًا عندما يذكر الكتاب ” من البطن ” لا يجب أن نعتبر أن هذا الكلام بمعناه الجسدى. لأنه من عادة الكتاب الإلهى أن يتحدث ويعبّر عن ما هو أسمى من الإنسان بأسلوب بشرى. لهذا حين يتكلم الكتاب عن الخلق يقول: ” يداك صنعتانى وجبلتانى ” (مز73: 118)، و” يدى صنعت كل هذا ” (إش2: 66)، ” هو أمر وكلها خُلقت ” (مز5: 148). ولغته إذن مناسبة للحديث عن كل شيء، إذ يُعْزى إلى الابن ما هو ذاتى وأصيل، وينسب إلى الخليقة بداية وجود، لأن الإله الواحد هو يخلق ويجبل، وهو الذي يلد من ذاته: “الكلمة” والحكمة. إذن: ” البطن ” و” القلب ” يعلنان عما هو ذاتى وأصيل، لأننا نحن أيضًا لنا أصلنا (أى نُولد) من البطن(البشرى)، لكننا نصنع أعمالنا بواسطة اليد.
28 ـ وهم يسألون ماذا يعنى ” قبل كوكب الصبح “؟ وأنا أجيب: إنه إن كانت عبارة ” قبل كوكب الصبح ” توضح أن ميلاده (من العذراء مريم) كان عجيبًا، فإن كثيرين آخرين غيره قد وُلدوا قبل بزوغ هذا الكوكب. فما هو الأمر الذي قيل عنه إنه هكذا عجيب في حالته، حتى يذكره كامتياز[33] (عن الباقين)، بينما هو أمر شائع لدى كثيرين؟
ثم أن الميلاد يختلف عن الإثمار، لأن الميلاد هو الأصيل، أمّا الإثمار فليس سوى ناتج مما هو موجود. فإن كان القول يناسب الجسد، فلنلاحظ أنه لم تكن بداية تكوينه حينما بُشر الرعاة بولادته ليلاً، لكن عندما بشر الملاك العذراء فذلك (التبشير) لم يكن ليلاً، لأن هذا الوقت، لم يُذكر، لكننا نجد أن الوقت كان ليلا حينما خرج من البطن. هذا الفارق يضعه الكتاب فيقول من جهة، إنه وُلد قبل كوكب الصبح، ومن جهة أخرى يتحدث عن خروجه من البطن كما ورد في المزمور الواحد والعشرين ” أنت الذي قد اجتذبتنى من البطن ” (مز10: 21)، كما أنه لم يقل ” قبل بزوغ كوكب الصبح ” بل قال ببساطة ” قبل كوكب الصبح “.
فإن كانت العبارة يقصد بها الجسد، فإما أن الجسد كان قبل آدم لأن الكواكب كانت قبل آدم. أو علينا أن ندرس معنى النص، وهذا ما يساعدنا يوحنا على عمله إذ يقول في سفر الرؤيا: ” أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية، طوبى للذين يصنعون وصاياه. لكى يكون سلطانهم على شجرة الحياة، ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. لأن خارجًا الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحيا ويصنع كذبًا. أنا يسوع أرسلت ملاكى لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال. ومن يعطش فليأتِ ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانًا ” (رؤ13: 22ـ17). فإن كان ” ذرية داود” إذن هو ” كوكب الصبح المنير“، فمن الواضح أن جسد المخلص يُدعى ” كوكب الصبح “، وسبق هذا، الولادة من الله. لهذا فإن معنى المزمور، يكون هكذا: أنا ولدتك من ذاتى قبل ظهورك في الجسد لأن ” قبل كوكب الصبح ” يساوى ” قبل تجسد الكلمة “.
29 ـ هكذا توجد نصوص واضحة بخصوص الابن في العهد القديم أيضًا، وفي نفس الوقت أنه من نافلة القول أن يجادل أحد في هذه النقطة: لأنه إن كان ما لم ينص عليه العهد القديم يكون من زمن لاحق، فليقل الذين يحبون الجدل أين ذُكر الروح القدس باسم الباراقليط في العهد القديم؟ لأنه قد ذُكر الروح القدس، ولكن لم يرد ذكر الباراقليط إطلاقا. فهل الروح القدس إذن واحد، والباراقليط آخر. والباراقليط هو اللاحق، لأنه لم يرد ذكره في العهد القديم؟ لكن حاشا أن نقول إن الروح القدس لاحق أو أن نميز ونقول إن الروح القدس واحد والباراقليط آخر، لأن الروح القدس واحد وهو نفسه الذي يقدس ويعزى فيما مضى والآن، أولئك الذين يقبلونه.
كما أن الابن هو نفسه “الكلمة” وهو الذي قاد عندئذ أولئك الذين كانوا مستحقين إلى تبنى البنين[34]. والذين كانوا أبناء في العهد القديم قد صاروا أبناء بواسطة الابن وحده، وليس بواسطة آخر. لأنه إن لم يكن ابن الله موجودًا قبل مريم فكيف يكون هو قبل الجميع، إن كان هناك أبناء قبله؟ وكيف يكون ” الابن البكر ” إن كان قد جاء ثانيًا بعد أبناء كثيرين؟ كما أن الباراقليط ليس ثانيًا لأنه كان قبل الجميع، ولا الابن أيضًا حديث الوجود لأنه: ” في البدء كان الكلمة ” (يو1: 1). وكما أن الروح والباراقليط هما نفس الشخص، هكذا الابن “والكلمة” هما الشخص ذاته. ومثلما يقول المخلص بخصوص الروح القدس: ” وأما المعزى (الباراقليط) الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي ” (يو26: 14) متحدثًا عن شخص واحد بعينه، دون أى تمييز بينهما، هكذا يصف يوحنا بمثل مشابه، حين يقول ” والكلمة صار جسدًا، وحل بيننا ورأينا مجده مجدًا كما لابن وحيد من الآب” (يو14: 1). لأنه يشهد هنا أيضًا بوحدة الشخصية ولا يفرق. وحيث إن الباراقليط ليس واحدًا والروح القدس آخر، بل هما شخص واحد بعينه، هكذا ليس “الكلمة” واحدًا والابن آخر، بل “الكلمة” هو الابن الوحيد. لأنه لم يُنسب المجد إلى الجسد، بل إلى “الكلمة” ذاته، فمن يتجاسر إذن ويفرق بين “الكلمة” والابن، فليفرق بين الروح والباراقليط. لكن إن كان الروح لا يمكن تقسيمه، فإن “الكلمة” أيضًا لا يمكن تقسيمه، إذ هو ذاته ابن وحكمة وقوة. بالإضافة إلى أن تعبير ” المحبوب ” مساوٍ لتعبير الابن الوحيد، وهو ما يعرفه اليونانيون الماهرون في التعبير، إذ يتحدث هوميروس هكذا عن تليماخوس الذي كان الابن الوحيد لأوديسيوس، في الكتاب الثانى من الأوديسا:
” أى فكر عبر بذهنك، أيها الابن المحبوب؟ وإلى أين تريد أن تهرب،
مع أنك وحيد ومحبوب وتملك حقولاً شاسعة؟
إن الذي تبكيه يا أوديسيوس؛ يا من نسل الإله زفس،
قد سقط بعيدًا عن وطنه، وسط الشعوب الغريبة “.
إذن فإن الابن الذي هو ابن وحيد لأبيه يُدعى محبوبًا.
30 ـ يميّز بعض أتباع بولس الساموساطى بين “الكلمة” والابن، زاعمين أن الابن هو المسيح وأن “الكلمة” آخر، وهم يؤسسون ذلك على كلمات بطرس في سفر الأعمال، والتي نطق بها حسنًا، ولكنهم فسروها تفسيرًا رديًا. وهى: ” الكلمة التي أرسلها إلى بنى إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل ” (أع36: 10)، لأنهم يزعمون أنه مادام “الكلمة ” تكلم بالمسيح، كما يُقال في حالة الأنبياء ” يقول الرب ” (أع36: 10) فإن النبى كان واحدًا والرب آخر. لكن هذا النص يضاد كلمات الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس: ” وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضًا إلى النهاية بلا لوم، في يوم ربنا يسوع المسيح ” (1كو8،7: 1).
لأنه كما أن مسيحًا واحدًا لا يثبّت يوم مسيح آخر، بل هو نفسه الذي يُثبِّت في يومه الخاص أولئك الذين ينتظرونه، هكذا أرسل الآب “الكلمة” الذي صار جسدًا حتى أنه حال كونه قد صار إنسانًا، يكرز بواسطة نفسه. ولهذا يضيف مباشرة: ” هذا هو رب الكل ” لأن رب الكل هو “الكلمة”.
31 ـ ” ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح وأعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك، وكفر عن نفسك وعن شعبك، وأعمل قربان الشعب وكفر عنه، كما أمر الرب موسى ” (لا7: 9).
تأملوا الآن هنا، أن موسى رغم أنه واحد، فإن موسى نفسه، وكأنه يتحدث عن موسى آخر يقول: ” كما أمر الرب موسى “. وبنفس الأسلوب إن كان الطوباوى بطرس يتكلم عن “الكلمة” الإلهى أيضًا، والمُرسل إلى بنى إسرائيل بواسطة يسوع المسيح، فلا يجب أن نفهم بالضرورة أن “الكلمة” واحد والمسيح آخر، بل إنهما واحد ونفس الشخص بسبب الوحدة التي حدثت في تنازله الإلهى وحبته للبشر وتجسده. وحتى إن فُهم بطريقتين[35]، فإن “الكلمة” لا يزال غير منقسم، كما يقول المُلهم يوحنا: “والكلمة صار جسدًا وحل بيننا ” (يو14: 1).
إذن، فما قاله الطوباوى بطرس هو حسن وصواب[36]، لكن أتباع السموساطى يفهمونه رديًا وخطأ ويبعدون عن الحق (أنظر يو44: 8). لأن المسيح يُفهم بطريقتين في الكتاب الإلهى، كما يقول الكتاب إن: ” المسيح قوة الله وحكمة الله ” (أنظر 1كو24: 1). فإن كان بطرس يقول إن “الكلمة” أُرسل إلى بنى إسرائيل بيسوع المسيح، فلنفهم أنه يعنى أن “الكلمة” إذ تجسد ظهر لبنى إسرائيل، ليتوافق هذا مع آية: ” والكلمة صار جسدًا” (يو14: 1). لكن إن كانوا يفهمون الأمر بشكل آخر، وبينما يعترفون أن “الكلمة” هو الله، كما هو كذلك (فعلاً) فإنهم يفصلون عنه الإنسان الذي أخذه ـ والذي نؤمن نحن أنه واحد معه ـ زاعمين أنه أُرسل بواسطة يسوع المسيح، وهم بذلك يناقضون أنفسهم دون أن يعلموا، فأولئك الذين يفصلون “الكلمة” الإلهى عن التجسد الإلهى يبدون أن لديهم مفهومًا متدنيًا عن تعليم كونه صار جسدًا، ويعتنقون الأفكار الوثنية، متصورين أن التجسد الإلهى هو تغيير ” للكلمة “.
32 ـ لكن الأمر ليس كذلك، حاشا. لأنه بالطريقة التي يكرز بها يوحنا عن هذا الاتحاد الذي لا يُعبّر عنه، والذي بواسطته ” يُبتلع المائت من الحياة ” (2كو4: 5)، بل الذي هو الحياة ذاتها كما قال الرب لمرثا: ” أنا هو الحياة ” (يو25: 11). هكذا أيضًا حينما يقول الطوباوى بطرس إن “الكلمة” قد أُرسل بواسطة يسوع المسيح، فإنه يعنى الاتحاد الإلهى، لأنه مثلما يسمع إنسان أن ” الكلمة صار جسدًا ” فإنه لا يعتقد أن “الكلمة” لم يعد “كلمة” بعد، فهذا أمر غير معقول، كما سبق أن قلنا، هكذا أيضا عندما يُسمع أن “الكلمة” اتحد بالجسد، فليُفهم أن سر التجسد الإلهى واحد وبسيط. والأكثر وضوحًا، والذي لا يقبل الجدل من أى عاقل هو ما قاله رئيس الملائكة في بشارته لوالدة الإله نفسها، إذ يبين وحدانية “الكلمة” الإلهى والإنسان. لأنه يقول: ” الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك، فلذلك أيضًا القدوس المولود منك يُدعى ابن الله ” (لو35: 1). إذن فأتباع الساموساطى بلا تعقل، يقسمون “الكلمة” الذي أعلن عنه بوضوح أنه صار واحدًا مع الإنسان المولود من مريم. لهذا “فالكلمة” لم يُرسل بواسطة ذلك الإنسان، بل بالأحرى أُرسل فيه قائلاً: ” أذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ” (مت19: 28).
33 ـ وهذه عادة الكتاب المقدس أن يكون التعبير بالكلمات بسيطًا ودون تكلف. فنجد مثلاً في سفر العدد: ” قال موسى لرعوئيل المديانى حمى موسى ” (عد29: 10). لأنه لم يكن هناك موسى يتكلم، وموسى آخر حماه هو رعوئيل، بل كان هناك موسى واحد، لأنه إن كان “كلمة” الله وحكمته ـ بنفس الطريقة ـ يُدعى أيضًا حكمة وقوة ويمين وذراع وما شابه ذلك، وإن كان لمحبته للبشر قد اتحد بنا، لابسًا باكورتنا ومتحدًا بها، لهذا أيضًا كان من الطبيعي أن تصبح الألقاب الأخرى من نصيب “الكلمة”. لأن هذا ما قاله يوحنا، إن “الكلمة” كائن منذ البدء وإنه عند الله وهو نفسه الله، وإن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان (أنظر يو1: 1ـ3)، مما يوضح جليًا إن الإنسان نفسه مخلوق بواسطة الله “الكلمة”. فإذا كان قد اتخذه لنفسه ـ بعد أن كان قد ضعف ـ وجدده ثانية بهذا التجديد الأكيد لكى يدوم إلى الأبد، ولهذا اتحد به لكى يرفعه إلى نصيب إلهي أكثر سموًا، فكيف يمكن القول إن “الكلمة” أُرسل بواسطة الإنسان المولود من مريم، ويدعونه رب الرسل ويعدونه مع الرسل الآخرين أعنى الأنبياء، الذين أُرسلوا بواسطته؟ وكيف يمكن أن يُدعى المسيح ” مجرد إنسان”؟ بينما إذ صار متحدًا مع “الكلمة”، فإنه يُدعى المسيح وابن الله، وقد أعلن النبى منذ زمن بعيد وصرخ بوضوح ناسبًا جوهر الآب له قائلاً: ” سأرسل أبني مسيحي ” (عزرا28: 7، 29 مع أع20: 3). وفي نهر الأردن قال: ” هذا هو أبني الحبيب ” لأنه حينما حقق وعده، أظهر حسبما كان لائقًا به، أنه كان هو ذاك الذي قال إنه قد أرسله.
34 ـ فلنفهم المسيح بطريقتين: (أولاً) ” الكلمة ” الإلهي الذي صار واحدًا مع الذي من مريم، لأن “الكلمة” قد شكل لنفسه بيتًا في بطنها، مثلما خلق آدم في البدء من الأرض، ولكن بصورة سماوية إلهية، وهو ما تحدث عنه سليمان بصراحة، عالمًا أن الكلمة تُدعى حكمة أيضًا قائلاً: ” الحكمة بَنْت لنفسها بيتًا ” (أم1: 9س) التي يفسرها الرسول حين يقول ” وبيته نحن” (عب6: 3). (ثانيًا) وفي موضع آخر يدعونا هيكلاً بقدر ما يليق بالله أن يسكن هيكلاً، والذي صورته التي من حجارة، قد أُمِرَ الشعب القديم أن يبنيها بواسطة سليمان، وعندما ظهر الحق توقفت الصورة. لأنه حينما حاول الجاحدون أن يثبتوا أن الصورة هى الحق، وأن ينقضوا سكناه الحقيقية تلك التي نؤمن نحن يقينًا أنها بمثابة اتحاده معنا، لم يهددهم، لكنه إذ يعلم أنهم يجرمون في حق أنفسهم، يقول لهم: ” انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام ” (يو19: 2).
ويُظهر مخلصنا هكذا حقًا أن الأمور التي يشغل الناس بها أنفسهم، إنما تحمل معها فناءهم، لأنه ” إن لم يبن الرب البيت فباطلاً يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلاً يسهر الحراس ” (أنظر مز1: 127). وهكذا انحلت أعمال اليهود؛ لأنها كانت ظلاً، أما الكنيسة فهى مؤسسة بثبات لأنها مبنية على الصخر، و” أبواب الجحيم لن تقوى عليها ” (أنظر مت18: 16). وأما أولئك فيقولون له ” كيف وأنت إنسان تجعل نفسك إلهًا؟” (أنظر يو33: 10)[37]. ومن ثم فإنه من الطبيعى أن يُعلِّم تلميذهم الساموساطى هرطقته لأتباعه. ” وأما نحن فلم نتعلم المسيح هكذا، إن كنا قد سمعنا وعُلِّمنا فيه… خالعين الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور… ولابسين الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق ” (أنظر20: 4ـ24). فلنتأمل المسيح إذن بتقوى، بكلا الطريقتين.
35 ـ إن كان الكتاب كثيرًا ما يطلق اسم المسيح على الجسد مثلما تكلم الطوباوي بطرس مع كرنيليوس معلمًا عن ” يسوع الناصري الذي مسحه الله بالروح القدس “، ومع اليهود أيضًا: ” يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قِبل الله ” (أع38: 10، 22: 2). ويقول الطوباوي بولس أيضًا لأهل أثينا: ” أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدمًا للجميع إيمانًا، إذ أقامه من الأموات ” (أع31: 17). لأننا نجد التعيين و الإرسالية مرادفين للمسحة في مرات كثيرة ؛ لكى يعرف الجميع أنه لا تناقض في كلمات (الكُتَّاب) القديسين، لكنهم يطلقون تسميات مختلفة على اتحاد الله “الكلمة” بالإنسان الذي من العذراء مريم؛ مرة باعتباره مسحة، ومرة باعتباره إرسالية ومرة باعتباره تعيينًا.
ولهذا فإن ما يقوله الطوباوي بطرس صواب [38]، فهو يكرز بلاهوت الابن الوحيد الجنس، دون أن يفصل أقنوم الله “الكلمة” عن الإنسان الذي من مريم، حاشا! لأنه كيف يفعل ذلك وهو الذي سمع عدة مرات أقوال المسيح: ” أنا والآب واحد “، و” من رآنى فقد رأى الآب “. وهو (المسيح) الذي نعلم أنه جاء إلى جماعة الرسل كلهم بعد القيامة أيضًا، والأبواب مُغلّقة، وبكلماته بدد كل ما عَسُر على الإيمان قائلاً: ” جسونى وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لى ” (لو39: 24). ولم يقل ” هذا الإنسان ” الذي أخذته لى، بل قال: ” لى”.
لهذا فإن رأى الساموساطى لن ينال أى قبول، إذ تم دحض رأيه بالنسبة لاتحاد الله “الكلمة” (بالجسد) بردود من الكتاب، وبواسطة الله “الكلمة” نفسه، والذي يعطى الآن المعرفة للجميع، ويسمح لهم أن يعرفوه عن طريق الأكل، وبلمسهم إياه والتأكد منه. لأن هذا الذي يعطى الطعام لآخرين وأولئك الذين يقدمون له الطعام تتلامس أيديهم معًا. لأن الكتاب يقول إنهم: ” ناولوه جزءًا من سمك مشوى، وشيئًا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم ” (لو32: 24).
ورغم أنه لم يسمح لهم بمثلما سمح لتوما، لكن ها هو هنا قد سمح لهم بطريقة أخرى أن يتأكدوا منه بلمسهم إياه. ولكن إن أردت أن ترى جراحه فلتتعلم من توما: ” هات أصبعك إلى هنا وأبصر يدى، وهات يدك وضعها في جنبى ” (يو27: 20) هكذا يتحدث الله “الكلمة”، مشيرًا إلى جنبه[39] ويديه بالذات، وعن نفسه بالكامل كإنسان وإله معًا. معطيًا أولاً للتلاميذ القديسين أن يدركوا ” الكلمة ” بواسطة الجسد بدخوله والأبواب مُغلّقة (أنظريو19: 20)، ثم اقترابه منهم بجسده يوفر لهم اليقين الكامل. كل هذه نقولها لتثبيت المؤمنين، وتصحيح أخطاء الذين لا يؤمنون.
36 ـ فليصحح بولس الساموساطى موقفه إذ يسمع الصوت الإلهى القائل ” جسدى” ولم يقل المسيح إن: ” المسيح ” شخص آخر غيرى أنا “الكلمة” بل قال: “هو معى وأنا معه ” (أنظر مت26: 26). لأنى أنا “الكلمة”، والمسحة، والإنسان الذي نال المسحة منى هو [40]، وهو بدونى لا يمكن أن يُدعى المسيح، لأنه (يُدعى هكذا) لكونه متحد بى وأنا فيه. لهذا، فإن ذِكْر إرسالية “الكلمة” يوضح الاتحاد الذي تم مع يسوع المولود من مريم، والذي يعنى اسمه مخلص، بسبب اتحاده بالله “الكلمة”، وليس لأى سبب آخر. وهذا النص (السابق) له نفس معنى قوله: ” الآب الذي أرسلنى “، ” ولم آتِ من نفسى، لكن الآب أرسلنى ” (أنظر يو44: 6، 42: 8). لأنه أطلق اسم الإرسالية على الاتحاد مع الإنسان، والذي معه يمكن أن يُعرِّف الناس الطبيعة غير المنظورة من خلال طبيعته المنظورة. لأن الله لا ينتقل من مكان إلى آخر مثلنا نحن، حينما يُظهر نفسه في شكل تواضعنا أثناء وجوده في الجسد. لأنه كيف يسكن منحصرًا في مكان ذلك الذي يملأ السموات والأرض؟ ولكن بسبب حضوره في الجسد، فإن الأبرار قد تكلموا عن إرساليته.
لهذا فإن الله “الكلمة” هو نفسه المسيح الذي من العذراء مريم، إله قد صار إنسانًا، وليس مسيحًا آخر بل هو ذاته، فهو الذي من الآب منذ الأزل، وهو نفسه الذي جاء من العذراء في أواخر الدهور، والذي كان غير منظور قبلاً حتى للقوات المقدسة بالسماء، وقد صار منظورًا الآن بسبب اتحاده مع الإنسان المنظور. أقول منظورًا، ليس في لاهوته غير المنظور، بل بفعل اللاهوت خلال الجسد البشرى والإنسان كله، الذي جدده باتخاذه إياه لنفسه.
له الكرامة والسجود، ذاك الذي كان والكائن الآن
والكائن على الدوام إلى دهر الدهور. آمين.
1 قُسم النص إلى فصول تحمل الأرقام من 1 ـ 36.
2 أنظر الملاحظة رقم 4 عن سابيليوس ص 10.
3 أنظر ملاحظة رقم 16 عن مارسيلوس ص 19.
1 تمثل هذه العقيدة أساس الرد على القائلين بانبثاق الروح القدس من الآب والابن معًا، وهو ما يُعرف باسم تعليم الفليوكا Filioque أى ” ومن الابن ” والذي ظهر في الغرب في القرن الـ11.
2 القديس أثناسيوس: المقالة الثانية ضد الآريوسيين7: 2، مركز دراسات الآباء، القاهرة 1987.
3 المرجع السابق: 19: 2، أنظر أيضًا الفصل الرابع من هذه المقالة.
4 سابيليوس كان كاهنًا في برقة (الخمس مدن الغربية) وجاء إلى روما وبدأ ينشر بدعته في أوائل القرن الثالث (حوإلى سنة 210م) وكان سابيليوس يعلّم بأنه لا يوجد تمييز بين الأقانيم الإلهية، فهو يعتبر أن الله أقنوم واحد عُرف في العهد القديم باسم الله، ثم ظهر هو نفسه باسم الابن أو المسيح في التجسد، وبعد صعود المسيح، ظهر هو نفسه باسم الروح القدس.
5 القديس أثناسيوس: المقالة الأولى ضد الآريوسيين19، مركز دراسات الآباء، القاهرة1984.
6 أنظر الفصل الثانى من هذا المقال.
7 المقالة الثانية ضد الآريوسيين 41؛ والمقالة الثالثة 11، مركز دراسات الآباء القاهرة 1993.
8 المرجع السابق: المرجع السابق ضد الآريوسيين8: 2، 34،33: 3.
9 المرجع السابق: ضد الآريوسيين43: 1.
10 المرجع السابق: ضد الآريوسيين43: 1، 65: 2، 67.
11 المرجع السابق: ضد الآريوسيين42: 1، 45.
12 المرجع السابق: ضد الآريوسيين41: 1، 42.
13 المرجع السابق: ضد الآريوسيين38: 3.
14 المرجع السابق: ضد الآريوسيين60: 2؛ 37: 3.
15 أنظر ضد الآريوسيين 4: 3، راجع د. وهيب قزمان: النعمة عند القديس أثناسيوس، ج2، إصدار مركز دراسات الآباء بالقاهرة سنة 1994، ص89ـ103.
16 مارسيللوس كان أسقفًا على أنكيرا بمقاطعة غلاطية وكان من المدافعين عن إيمان نيقيا، ولكنه فيما بعد سقط في ما يشبه عقيدة الآريوسيين، من جهة عدم أزلية الابن، ويقول إن الابن ليس هو الكلمة.
17 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 21: 1.
18 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 19: 2.
19 أنظر الفصل التاسع من هذا المقال.
20 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 19: 1.
21 المرجع السابق: أنظر ضد الآريوسيين29: 1.
22 المرجع السابق: ضد الآريوسيين1: 14
23 المرجع السابق: أنظر ضد الآريوسيين 11: 3
24 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 60: 2.
25 أنظر الفصل التاسع والعشرين من هذا المقال.
26 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 19: 2.
27 المرجع السابق: أنظر ضد الآريوسيين 53: 1؛35: 3.
28 أنظر الفصل الواحد والعشرين من هذا المقال.
29 أنظر الفصل الرابع والعشرين من هذا المقال.
30 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 19: 2.
31 المرجع السابق: أنظر ضد الآريوسيين39: 1.
32 المرجع السابق: أنظر ضد الآريوسيين29: 3.
33 المرجع السابق أنظر ضد الآريوسيين44: 2.
34 المرجع السابق: ضد الآريوسيين4: 1، 27: 3.
35 المرجع السابق: ضد الآريوسيين44: 2.
36 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 33: 3.
37 المرجع السابق: ضد الآريوسيين 47: 1.



