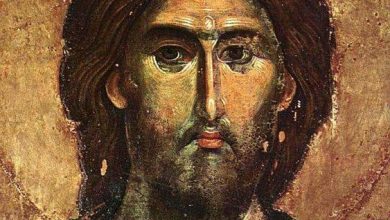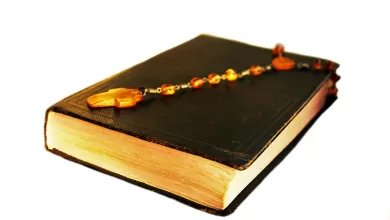نتائج هامة بعد دراسة ما يخص مجمع خلقيدونية

1. نتائج هذه الدراسة:
في ضوء الحقائق التي ناقشناها طوال هذه الدراسة، نستطيع أن نقدم الملاحظات التالية المتعلقة بالجدال الخريستولوجي:
-
عندما كان الفكر اللاهوتي المسيحي يشير إلى ما أسماه بـ ’النسطورية‘، فإنه كان دائماً يعني ذلك الموقف المتطرف الذي فُهم أن التفسير الأنطاكي لشخص يسوع المسيح يؤكده. ولكن لا نسطوريوس نفسه ولا أي من الرجال المعتبرين قادة في المدرسة الأنطاكية كان يتمسك بالصورة المتطرفة التي ذاعت عن تلك الهرطقة.*
وعلى نفس المنوال كانت ’الأوطيخية‘ أو ’المونوفيزيتيزم‘ هي تشويه معيب للتعليم الخريستولوجي السكندري. وبالفعل لا تُعد كل الأدلة المتوفرة لدينا كافية للإصرار على أن أوطيخا كان يتمسك بما سُمي بالهرطقة الأوطيخية.
ولذلك ـ ومع أن أوطيخا لم يكن قادراً على التعبير عن وجهة نظره بشكل واضح ـ فإننا لا نجد ضرورة لتقديم أي دفاع عن الرجل. ولكننا في نفس الوقت ينبغي أن نؤكد أنه لا كيرلس السكندري ولا أيّ من اللاهوتيين المعروفين أو آباء الكنيسة في الجانب غير الخلقيدوني بما فيهم البطريرك ديسقوروس كان مداناً بتمسكه بتلك الأفكار (التي نُسبت لأوطيخا) على الأطلاق.
-
في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة في حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط متحدة بشكل ما، كان هناك شعور بالرغبة في وجود ’صيغة‘ أو ’تركيب‘ لاهوتي (synthesis) من كلا التقليدين السكندري والأنطاكي (أي من المفاهيم اللاهوتية المتضمّنة فيهما). ولكن الحقيقة أن ذلك لم يكن من الممكن تحقيقه حتى في تلك العصور القديمة، بسبب أن كل موقف (أو تقليد) كان قد صار مترسخاً بعمق في مناطق محددة بعينها، لدرجة أن كلا الجانبين لم يكن يريد أن يسعى لذلك ’التقارب‘.
وعلى سبيل المثال، كانت إعادة الوحدة عام 433م حادثة يمكن أن يأخذها الطرفان المعنيان كأساس يعتمدان عليه للوصول إلى ذلك ’التركيب‘ المشترك، ولكن كل جانب أخذها فقط كحجر يخطو عليه (أو وسيلة) لكي يدفع بكل مفاهيمه تجاه استبعاد مفاهيم الآخر. وفي هذا الصدد كان الجانب السكندري، بدون شك، أكثر قوة من الجانب الأنطاكي، ولكن مجمع خلقيدونية قام بدوره في قلب هذا الموقف حين ذهب إلى أبعد مما تم التسليم به في إعادة الوحدة عام 433م وأصر على عبارة ’في طبيعتين‘.
وبعد خلقيدونية حدث نفس الأمر ـ الذي رأيناه من الجانبين تجاه حادثة إعادة الوحدة ـ بشأن مرسوم الاتحاد الخاص بالإمبراطور زينو ’الهينوتيكون‘، فبالرغم من أن هذا المرسوم قد صدر كأداة يمكن أن يصل بواسطتها الطرفان المتنازعان إلى الوحدة، فإن أولئك الذين قبلوا تلك الوثيقة من كلا الطرفين قد أخذوها فقط كخطوة ينطلقون منها لتأكيد وجهة نظرهم دون أن يعيروا أي التفات لرأي المعارضين لهم.
-
بينما كان كل اهتمام روما في خلقيدونية منصباً على جعل المجمع يقبل طومس ليو بدون مناقشة، وأن يقبل الفكر اللاهوتي الذي تضمَّنه الطومس بكونه مقياس الكنيسة العقائدي، كانت السلطة الإمبراطورية على الجانب الآخر مهتمة بأن تحصل على صيغة للإيمان تضعها لجنة من رجال ينتمون إلى التقاليد المتنوعة في الكنيسة، ومن ثم تحقق الوحدة للإمبراطورية. وهنا كانت الاعتبارات السياسية وليست الفائدة اللاهوتية ـ بالإضافة إلى النفوذ البشري ـ هي التي توجه القيادة الحكومية.
-
وفي إصرارها العنيد على مسألة قبول طومس ليو، كانت روما منقادة بفكرة فرض مزاعمها الباباوية (على الكنيسة) كما كانت منقادة أيضاً وبنفس الدرجة برغبتها في أن يشاركها الجميع في طريقة فهمها للإيمان المحفوظة في التقليد اللاهوتي للكنيسة في الغرب. ولكن البابا ليو في محاولته تلك، لم يُظهر أي فهم للجدال الخريستولوجي القائم في الشرق، ولا أسَّس تفسيره اللاهوتي (في الطومس) على قرارات المجامع السابقة التي تم اعتبارها مجامعاً مسكونية.
وعلى نفس هذا النحو، لم تكن لدى السلطة الإمبراطورية في القسطنطينية أي تعاطف لا مع مجمع أفسس عام 431م ولا مع التقليد اللاهوتي لآباء الإسكندرية. وكانت خطة الإمبراطور والإمبراطورة هي تأييد ومناصرة روما ضد الإسكندرية، بالإضافة إلى الترتيب لرفع مكانة (كرسي) القسطنطينية ـ عاصمة الإمبراطورية ـ لموقع القيادة في الكنيسة والذي يأتي تالياً فقط لكرسي روما.
وحيث إن كل من الكرسي الغربي (في روما) والسلطة الإمبراطورية في القسطنطينية، اللذان سيطرا على مجمع خلقيدونية، كانت له خطته الخاصة التي يريد تحقيقها من خلال ذلك المجمع ـ وهي خطة لم تكن بالتأكيد لها أية صلة بالمسألة الخريستولوجية ـ فإنهما لم يجدا كليهما أية صعوبة في تخطي وجهة نظر المعارضين للمجمع بإسلوب يدعو إلى غاية الذهول وبدون حتى أي أثر من دليل يؤيدهم على ذلك.
-
وقامت اللجنة المجمعية في خلقيدونية بإصدار تعريف للإيمان تحت ضغط الجانب الروماني من جهة والسلطة الإمبراطورية من الجهة الأخرى. وكان هذا التعريف هو نوع من صيغة تسوية (أو حل وسط)، تجنبت اللجنة فيه المشكلة المركزية التي كانت تواجه الكنيسة في ذلك الوقت. وبالرغم من أن تلك الصيغة أرضت روما ورجال الجانب الأنطاكي، إلا أن السكندريين الذين لم يكن لهم دور في مجمع عام 451م عارضوها ورفضوها.
وبالقطع أخطأت كل من روما والسلطة الإمبراطورية في تقدير حجم التأييد الذي يملكه التراث اللاهوتي السكندري في الشرق. وكانت المعارضة لمجمع خلقيدونية عنيفة جداً وشديدة العزم لدرجة أنه تحتم أن يتم الدفاع عن الموقف الخلقيدوني من خلال: أولاً، إطلاق العنان لسلسلة من الإضطهادات القاسية ضد المعارضين للمجمع قام بها الأباطرة في القسطنطينية، وثانياً، من خلال اتهام المعارضين للمجمع بهرطقة ’المونوفيزيتيزم‘ (عقيدة الطبيعة الوحيدة) بالرغم من إنكار غير الخلقيدونيين المتكرر لتلك العقيدة بعبارات قاطعة. ولم تساعد أي من هذه الممارسات الجانب الخلقيدوني في فرض موالاة الشرق المسيحي كله له.
كما لم تنجح مجهودات جوستنيان وبعض خلفائه من أجل إعادة الوحدة وذلك لسبب بسيط وهو أن الجانب الخلقيدوني لم يكن ليتخلى عن المجمع، ولم يكن للجانب غير الخلقيدوني شيئاً ليفعله أمام ذلك الإصرار.
-
وأمام اعتراض وتحدي المعارضين للمجمع، شرع الجانب الخلقيدوني في الشرق في بناء موقف خريستولوجي (مختلف) منذ بداية القرن السادس، وكان هذا الموقف ـ من حيث الجوهر ـ هو تقريباً نفس الموقف الذي يتبناه المنتقدون للمجمع والمؤسس على التقليد اللاهوتي لآباء الإسكندرية ولكن مع وجود اختلاف هام وهو استمراره (أي الجانب الخلقيدوني) في الدفاع عن مجمع عام 451م وعبارة ’في طبيعتين‘ وهما الأمران اللذان رفضهما المعارضون للمجمع.
وفي سماحه بحدوث هذا التطور، يكون الجانب الخلقيدوني ـ بالرغم من احتفاظه بعبارة ’في طبيعتين‘ ـ قد تحرك بعيداً عن موقف خلقيدونية الذي أراد الوصول إلى تسوية تميل إلى المفاهيم اللاهوتية الأنطاكية. وفي الحقيقة لو كان الجانب الخلقيدوني، باتخاذه هذه الخطوة، يتبنى فهماً لشخص المسيح يتجاهل الحالة الهيبوستاسية لناسوته أو يتسع للأفكار اليوليانية، فإنه بذلك يكون أكثر تضاداً للنسطورية وللأنطاكية* من التعليم الخريستولوجي لقادة الجانب غير الخلقيدوني أمثال البطريرك ساويروس الأنطاكي.
-
والاستنتاج الواضح هو أن الجانب الخلقيدوني بدفاعه عن مجمع خلقيدونية لم يحقق أي شيء لصالح الأرثوذكسية لم يكن الجانب غير الخلقيدوني نفسه، وهو يرفض المجمع، يتمسك به بثبات. ولذلك فإن الأمر الوحيد بين الجانبين كان تحفظ كل طرف على اللغة التي يدافع بها الآخر عن فكره. فلو كان الجانبان يرغبان حقاً في المضي إلى أبعد من المصطلحات، فما كان من المستحيل لهما أن يقبلا صيغة مشتركة، يعملان على أساسها من أجل استعادة وحدتهما المفقودة.
-
ومع ذلك، كان هناك تعليم أصر عليه يوحنا الدمشقي ـ متتبعاً في ذلك تقليد اللاهوتيين الخلقيدونيين الأوائل ـ ولم يكن هذا التعليم يُشرح في الجانب غير الخلقيدوني بنفس الأسلوب. ويتعلق هذا التعليم بالتأكيد على أن ناسوت المسيح قد تأله منذ لحظة تكوينه في الاتحاد مع الله الابن.
ومن خلال ارتباطه الحميم مع نظرية ’التأقنم‘ كان هذا التعليم يأخذ الناسوت كطبيعة عامة مجردة وليس كحقيقة أقنومية، وحيث إن هيبوستاسيس الله الابن عند الدمشقي كان هو شخص الناسوت، فإن الله الابن نفسه كان هو الذي يقوم بكل ما هو بشري بالإضافة لكل ما هو إلهي.
وهذا هو السبب وراء تأله ناسوت المسيح. ولم يكن تأله ناسوت المسيح بهذا الشكل هو تعليم الجانب غير الخلقيدوني، فبالنسبة لهم كان الناسوت الذي تخصخص وبالتالي أصبح في الحالة الهيبوستاسية، هو الذي صار ناسوت الله الابن ولهذا السبب امتلأ بالمجد الإلهي وتأله.*
-
ويقف التعليم الخريستولوجي للجانب غير الخلقيدوني بين الموقف الخلقيدوني الذي تم بناؤه في الشرق منذ القرن السادس، والتقليد الذي يحفظه الجانب الأنطاكي.
فإذا كان الجانبان غير الخلقيدوني والأنطاكي يستطيعان أن يتغلبا على المآسي القديمة، فسيكون من الممكن لها أن يصلا إلى اتفاق لاهوتي حول مسألة شخص المسيح، بشكل أسهل من أمكانية وصول الجانبين الخلقيدوني والأنطاكي لهذا الاتفاق. وفي الحقيقة إذا لم يقم الجانب الخلقيدوني بإدراك قيمة التأكيد على الحالة الهيبوستاسية (الأقنومية) لناسوت المسيح، فلن يستطيع أن يتفهم المساهمة اللاهوتية للمدرسة الأنطاكية.
2. صلة هذه الدراسة بالسياق المعاصر:
إن الجدال الخريستولوجي الدائر في زمننا الحاضر ينتمي بشكل لا يمكن إنكاره إلى تاريخ الكنيسة القديم.
ولذلك فإن دراستنا المتعمقة لتلك الفترة من التاريخ الكنسي ينبغي أن تكون ذات مدلول وثيق الصلة بالسياق المعاصر بثلاثة طرق على الأقل.
(أ) من المنظور المسكوني:
كان الجدال الخريستولوجي ـ كما ذكرنا ـ هو السبب الظاهر لانقسام المسيحية في الشرق إلى ثلاثة كيانات (الأنطاكي، والخلقيدوني ’الجديد‘، وغير الخلقيدوني). وبعد الشقاق الذي حدث في القرن الخامس، صار كل كيان منهم ينظر إلى الكيانين الآخريّن كهراطقة وقام بقطع الشركة معهما. فهل كان هذا التصرف مبرراً؟
ولهذا السؤال في الحقيقة أهمية قصوى، لأن نسب الهرطقة إلى أحد إنما يعني افتراض أنه في وقت الانقسام كان في الكنيسة معيار عمومي معترف به للأرثوذكسية، فهل كان هناك مثل هذا المعيار في الكنيسة في القرن الخامس؟.
والحقيقة كما رأينا، أنه بعد مجمع أفسس عام 431م نشأ موقفان لهما صلة بهذا السؤال، فالسكندريون تمسكوا بأن الأرثوذكسية تتطلب التواصل مع قانون مجمع نيقية بالطريقة التي فهمه وأكده بها مجمع عام 431م، أما الأنطاكيون فلم يكونوا راغبين في تأييد مجمع عام 431م في مجمله، إذ اعترفوا بهذا المجمع بالقدر الذي تم قبوله فقط في صيغة إعادة الوحدة عام 433م. وفي هذا الموقف لم يعر مجمع خلقيدونية أي اهتمام لوجهتي النظر المتضاربتين، ولكنه قدَّم طومس ليو واعتراف الإيمان الخاص بالمجمع كمعيار للأرثوذكسية.
وكانت هذه الأمور بالتحديد هي التي قام الجانب غير الخلقيدوني بانتقادها ورفضها. وبالنسبة للكنيسة المشرقية التي تخلد ذكرى نسطوريوس واللاهوتيين الأنطاكيين الآخرين، فإنها لم تأخذ مجمع عام 451م بعين الاعتبار تماماً. فإذا وضعنا هذه الحقائق نصب أعيننا، سنجد أنه عندما نسب أي من الثلاثة كيانات تهمة الهرطقة للإثنين الآخرين، فإنه لم يكن هناك افتراض وجود معيار موحد للأرثوذكسية ـ سابق على الانقسام ـ معترف به منهم جميعاً. وبكلمات أخرى نقول أنه لم يكن لأي من هذه التقاليد الكنسية أي أساس شرعي لكي ينظر إلى الآخرين كهراطقة.*
ومع ذلك انفصلت الكنائس، وأصبحت هناك بالفعل حاجة ملحة لوسيلة فعالة تساعدهم لاستعادة وحدتهم المفقودة. وفي الحقيقة حاولت روما ـ اعتماداً على ادعائها السيادة العالمية على الكنيسة ـ أن تحل تلك المشكلة من خلال توحيد الكنائس بجعلها تتحول من انتماءاتها التاريخية إلى الالتصاق بكنيسة روما مباشرة ولكن هذه الوسيلة لم تحقق إلا نجاحاً محدوداً جداً في مناطق قليلة في الشرق المسيحي.
ولذلك فإن المشكلة في الحقيقة تحتاج إلى حل مرضي يُبنى على أساس تقييم إيجابي وموضوعي لتاريخ الانشقاق وللموقف اللاهوتي الذي تحتفظ به كل من تلك الكنائس. وقد أردنا من خلال تلك الدراسة أن نقدم محاولة في هذا الاتجاه نفسه.
(ب) من منظور السلطة الكنسية:
وإذا لم يكن هناك معيار متفق عليه للأرثوذكسية في وقت الانقسام، فهل لم يكن هناك أيضاً ’سلطة كنسية‘ يُعمل حسابها؟. لقد كان البابا ليو، على سبيل المثال، يزعم وجود إلهام إلهي في الطومس الخاص به من خلال التعاقب البطرسي (الذي لكرسيه)، كما أن الكيان الخلقيدوني في الشرق كان يتمسك هو الآخر بأن الروح القدس هو الذي قاد مجمع خلقيدونية ـ وبقية المجامع المسكونية الأخرى ـ لكي يحفظ الإيمان في نقاوته.
وفي كلتا الحالتين تتصل القضية محل التساؤل بـ ’السلطة الكنسية‘، وهذا الأمر في الواقع كان ذو أهمية حقيقية للكنيسة في كل العصور بما في ذلك العصر الذي نتحدث عنه.
وهنا يمكننا أن نلاحظ موقفين متنوعين. الموقف الأول يتعلق بأن أسقف روما بكونه خليفة بطرس الرسول، فإن له مدخل شخصي مباشر لأسرار رئيس الرسل، ومن خلاله إلى فكر الله المتجسد نفسه، وأنه لهذا السبب قد تقلد بسلطة خاصة تجعله يفسِّر الإيمان بطريقة معصومة بنفسه وبدون أي مساعدة خارجية. أما الموقف الثاني فيصر على أن مجمع خلقيدونية بكونه مجمعاً مسكونياً فإنه قدم إعلاناً للإيمان ينبغي أن يعتبر ملزماً للكنسية كلها.
ولا يوجد في الحقيقة اتفاق عام على مسألة السلطة المجمعية، إذ بينما تحاول بعض التقاليد الكنسية أن تؤكد أن المجامع المسكونية حين تقوم بتقرير أي شيء فإنها تتحدث من واقع سلطتها، فإن بعض التقاليد الأخرى تؤمن فقط أن سلطة القرار المجمعي تتوقف على المحتوى الذي يحفظه من الحق. وقد يستند أولئك الذين يؤمنون بالرأي الثاني إلى أن كل المجامع المسكونية المعترف بها كانت قد اتخذت قرارات عقائدية تم التصديق عليها باعتبارها تحفظ الحق المسيحي.
وليس ما يعنينا هنا هو مناقشة مسألة ’السلطة الكنسية‘ من خلال الدفاع عن أو معارضة أي من الموقفين السابقين، ولكننا نريد فقط أن نوجه النظر إلى أنه في ضوء الحقائق التي قدمناها عن مجمع خلقيدونية وبقية المجامع (التي تتعلق بنفس الموضوع) فليس من الممكن تأييد أي من هذين الادعاءين السابقين (أي السيادة الباباوية والسلطة المجمعية) بصورة قاطعة.
ولذلك فلا الجدال الخريستولوجي ولا المجامع التي ناقشت ذلك الأمر في العصور القديمة، يمكن الاعتداد بها شرعياً، كحوادث سابقة جديرة بالاستشهاد، لتدلنا على الطريقة الملائمة التي ينبغي أن تُمارس بها ’السلطة الكنسية‘.
ونحن لا نعني بقولنا هذا أن موضوع مجمع خلقيدونية قد أثبت في حد ذاته (أو بنفسه) بطلان المزاعم الباباوية لروما أو مزاعم الشرق في السلطة المجمعية، ولكن الحقيقة مع ذلك هي أنه مثلما كان الحال بالنسبة لمعيار الأرثوذكسية، فإنه لم يكن هناك أيضاً تقليد متفق عليه في الكنيسة بالنسبة للكيفية التي ينبغي أن تُمارس بها ’السلطة الكنسية‘.
فبينما كان الشرق بصفة عامة يتبنى فكرة اعتبار أن ’السلطة المجمعية‘ هي الحكم النهائي في الشئون الكنسية، فإن روما كانت تضيف إلى ذلك فكرة ’السيادة الباباوية‘ على الكنيسة. ولم يكن كلا الموقفين واضحين بالنسبة لعدد من النقاط. فنظرية ’السيادة الباباوية‘، على سبيل المثال، كان عليها أن تقيم الدليل على زعمها بأن بطرس الرسول كانت لدية معرفة بفكر المسيح بالنسبة لأي جدل عقائدي قد يظهر في الكنيسة وأن هذه المعرفة يتم توريثها لأساقفة روما.
ولم تكن ’السلطة المجمعية‘ أيضاً قد أوضحت أمرها بالنسبة لتكوينها وطبيعة سلطتها، فهل ينبغي على سبيل المثال أن يكون للأساقفة وحدهم الحق في عضوية المجمع؟ والحقيقة أن العرف الخاص بأن الأساقفة وحدهم هم الذين يشكّلون المجمع لم يكن متعارفاً عليه قبل مجمع خلقيدونية، وحتى في خلقيدونية كان الموظفون الذين رأسوا المجمع موظفين حكوميين وليسوا حتى رجالاً ذوي رتبة كهنوتية، كما كان هناك أيضاً رجال كنسيون ليست لهم رتبة الأسقفية مشاركين بصورة فعالة في أحداث وإجراءات المجمع.
وينبغي علينا أن نتذكر أيضاً أن المجامع القديمة لم تصل إلى قراراتها من خلال التصويت بواسطة الأساقفة فقط. وفي ضوء تلك الحقائق، نستطيع أن نقول إن الكنيسة كانت لديها تقاليد مختلفة فيما يتعلق بممارسة السلطة الكنسية، ولذا ينبغي في الإطار المعاصر للكنيسة أن تُجمع هذه التقاليد معاً مع ضرورة حدوث تعديلات ملائمة في كل منها، والحقيقة أن مجمع خلقيدونية والمجامع الكنسية الأخرى في الأزمنة القديمة كانت قد أشارت إلى وجود هذا الاحتياج في الكنيسة.
ويتعين علينا بالنسبة لمسألة ممارسة السلطة الكنسية، أن نضع في اعتبارنا عدداً من الحقائق:
أولاً، إن كل من أسقف روما نفسه والأساقفة الذين يشتركون في المجامع سواء كأفراد أو ككيان هم صغار بالنسبة لعصرهم، ونحن ليس لدينا أساس لكي نعتقد أنهم من خلال التتويج الباباوي أو السيامة الأسقفية يتمكنون من تجاوز قيودهم البشرية في المعرفة أو التحيز أو ظروف الحياة.
ثانياً، إن السلطة في معناها الحقيقي تنتمي بطبيعتها إلى الله وحده، وأي سلطة في الكنيسة تصدر منه ومن المفترض أن تكون من أجل تحقيق خطته وقصده، ولذلك فإن كل السلطة الكنسية ينبغي أن تكون وفق الخطة الإلهية والأمر الإلهي في ممارستها.
ثالثاً، يتحتم أن يٌنظر إلى القرارات الكنسية سواء العقائدية منها أو التنظيمية بصورة نسبية (غير مطلقة) تتصل بالأوقات والظروف التي صدرت فيها، فبالرغم من أنه ينبغي الاعتراف بقيمة الأساس الذي بُنيت عليه هذه القرارات ـ كلما أمكن وعلى حسب الضرورة ـ إلا إنه لا يمكن الإصرار على قبول الكنيسة للقرارات نفسها في جميع الأزمنة وفي كل مكان.
ولكي نؤكد هذه النقطة يجب علينا أن نتذكر أن الجانب الخلقيدوني قد عدَّل وضعه بالنسبة لثلاثة مواقف على الأقل، كان يتبناهم مجمع عام 451م:
(أ) القرار الخاص بثيؤدوريت أسقف قورش وإيباس أسقف الرها.
(ب) وبينما تجاهل مجمع خلقيدونية عملياً الحروم الإثني عشر للبابا كيرلس، تعامل مجمع عام 553م معها على افتراض أن مجمع عام 451م كان يعترف بتلك الوثيقة وبسلطتها الشرعية الكاملة.
(ج) على الرغم من أن مجمع خلقيدونية كان قد استبعد عبارتي ’من طبيعتين‘ و’طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة‘، فإن الجانب الخلقيدوني اعترف بأرثوذكسيتهما وبقبولهما في القرن السادس.
رابعاً، لقد رأينا أنه بالنسبة لمجمع عام 553م ومجمع عام 680 – 681م فإن كليهما مع بالغ الأسى قد أهمل تمثيل الموقف الخريستولوجي للجانب غير الخلقيدوني.
وأمام الزعم بأن هذين المجمعين وغيرهما من المجامع المماثلة هي مجامع مسكونية وذات سلطان، لا يمكننا أن نهمل تلك الحقائق الخاصة بها. وهي تظهر أنه لم يكن أي من تلك المجامع معصوماً في ذاته، وأنه من غير الممكن أن ننسب لها السلطة بصورة مطلقة. وكانت هذه المجامع هي اجتماعات كنسية عُقدت في سياق محدد وتخضع لقيود خاصة بها. والشيء الذي له قيمة في تلك المجامع كان يكمن في أسس الإيمان التي قد تكون قد سعت للحفاظ عليها.
وهي سواء بإسهاماتها الإيجابية أو بإخفاقاتها إنما تنتمي للتاريخ المسيحي، ونحن بحفظنا للمبادئ القيمة الموجودة بها وبرفضنا للأخطاء التي من الممكن أن تكون قد ارتكبتها، يمكننا أن نحاول أن نواجه مسئولياتنا في إطار ظروفنا المعاصرة. ومن أجل هذا لسنا في حاجة للإصرار على أن يقبل أحد التقاليد الكنسية أي من المجامع التي كان قد رفضها في الماضي.
ويمكننا أن نوضح تلك النقطة على النحو التالي: بينما لم تعترف كنيسة فارس القديمة بمجامع القرن الخامس وكذلك أيضاً المجامع التي عُقدت في الأزمنة المتأخرة، وبينما أيضاً لم يقبل الجانب غير الخلقيدوني مجمع عام 451م ومجمع عام 553م ومجمع عام 680 – 681م ، فإن الجانب الخلقيدوني يزعم بأنه يأخذ وضعه في التقليد الذي كونته هذه المجامع التي تعتبر امتداد لمجمع عام 431م.
والنقطة الأساسية في هذا الإدعاء ليس في أن الجانب الخلقيدوني يجعلهم ضمن قائمة المجامع المقبولة الخاصة به، لأن القبول القانوني لأي مجمع لا يعني أي شيء سوى أنه يحمل تأييد الأساس العقائدي الذي أكده المجمع، كما أن المعنى الشرعي الوحيد الذي يمكن أن يُقال على مجمع أنه مقبول هو الإقرار بالإيمان الذي يُعتقد أن هذا المجمع قد حفظه.
وإذا نظرنا إلى المسألة بهذا الشكل سنجد أن الاختلاف بين التقاليد الثلاثة التي انقسمت إليها الكنيسة ـ على أساس الجدال الخريستولوجي ـ ليس هو في الواقع بالأمر الذي لا يمكن تخطيه. وحتى بالنسبة لمجمع أفسس الثاني عام 449م الذي يعتبره الجانب غير الخلقيدوني مقبولاً، فبالرغم من أن مجمع خلقيدونية حاول أن يجعل استبعاده يتم بسرعة، لكن الحقيقة أن كل قراراته تقريباً التي تتصل بإيمان الكنيسة قد تم التصديق عليها صراحة بواسطة مجمع عام 553م، وهذه القرارات مازالت حية حتى الآن في كلا الجانبين الخلقيدوني وغير الخلقيدوني.
(ج) في ضوء إيمان الكنيسة:
وهكذا نرى أن الأمر الرئيس في إيمان الكنيسة كان هو شخص يسوع المسيح، وكان هذا في الحقيقة أمراً قديماً قدم المسيحية ذاتها. وتسجل لنا الأناجيل الإزائية كيف سأل ربنا تلاميذه عمن يكون هو في وجهة نظرهم، وكيف قدَّم بطرس الاعتراف الشهير أنه هو المسيح ابن الله الحي. وقد تضمنت كتابات العهد الجديد تلك الإجابة نفسها بمعناها الحقيقي.
وبعد عصر كتابة العهد الجديد، استمر آباء الكنيسة في التمسك بنفس الحقيقة من خلال شرح أعمق للإيمان، واعتمدوا في عملهم هذا على قاعدة الإيمان التي كانت تعني بالنسبة لهم وديعة إيمان الكنيسة.
وينبغي أن يُنظر لهذا العمل الذي قام به أولئك الآباء في أجيالهم المختلفة ـ والذي كان يقود الكنيسة أكثر من أي شيء آخر ـ من جهة الطريقة التي استخدموها ومن جهة المحتوى الذي سعوا لكي يحفظوه. وتعتبر كلتا الوجهتين (الطريقة والمحتوى) هامتين بالنسبة لذلك العمل نفسه.
أولاً: الطريقة
كانت الشروحات اللاهوتية للكنيسة الأولى قد تمت في إطار الظروف الفكرية والثقافية لتلك العصور. وهم في تفسيرهم للإيمان أخذوا ـ بدرجات متفاوتة ـ أفكاراً ومفاهيماً كانت سائدة في العالم الديني والثقافي اليوناني – الروماني.
وهم لم يفعلوا ذلك من خلال تبنيهم لموقف توفيقي (أي محاولة التوفيق بين المعتقدات المختلفة) بالنسبة لاعترافهم بالمسيحية، ولكنهم على الجانب الآخر حاولوا أن يظلوا أمناء لقاعدة الإيمان التي اعتبروها مؤسسة على الكرازة الرسولية، وبكونها أيضاً (أي قاعدة الإيمان) جوهر حياة العبادة والنظام الذي نما على أساسها. ومن هنا اتبع الآباء في شرحهم اللاهوتي طريقة تهدف إلى الحفاظ على التميز الجوهري للمسيحية.
ولذلك كانت عملية استنباط طريقة تساعد على حفظ الإيمان من جهة وتمكن من توصيله بشكل مبتكر من الجهة الأخرى، هي أمر لا غنى عنه بالنسبة للكنيسة في كل زمان. وبالقطع ليست الظروف الثقافية والفكرية في القرن العشرين هي نفس الظروف الخاصة بالعصور التي عاش وعمل فيها اللاهوتيون القدامى وآباء الكنيسة، بل وحتى في أيامنا هذه ليست تلك الظروف هي نفسها بالنسبة للأوروبيين والهنود، أو بالنسبة للأمريكيين والأفريقيين. وتبعاً للاختلاف في الثقافة والظروف الأخرى، ينبغي أن يكون هناك تعبيرات مختلفة للحديث عن المسيحية.
وفي الحقيقة، يجب أن تكون الكنيسة في كل عصر وفي كل منطقة جغرافية، قادرة أن تكوِّن طريقتها الخاصة في توصيل الإيمان وأنماط الحياة، ولكن بدون أن يكون هناك أي إضعاف أو تشويه للإيمان نفسه. وأمام هذه المهمة يمكن للكنيسة أن ترى في الطريقة التي تبناها اللاهوتيون القدامى دروس جديرة ذات مدلول لوقتنا المعاصر.
ثانياً: المحتوى
تتفق كل الكيانات الثلاثة (الأنطاكي والخلقيدوني وغير الخلقيدوني)، التي انفصلت بسبب الجدال الخريستولوجي، على الاعتراف أن يسوع المسيح هو مخلص العالم الوحيد، وبالتالي فقد ظل كل منهم أميناً لقاعدة الإيمان، ولكن اختلافهم كان ينصب فقط على شرح الكيفية التي ينبغي أن يتم بها هذا الاعتراف.
ويمكننا أن نوضح تلك الحقيقة من خلال الرجوع إلى المواقف الثلاثة: فالموقف الخلقيدوني يؤكد ـ في كل من تقليده البيزنطي الشرقي وتقليده التوماوي* الغربي ـ أن يسوع المسيح هو مخلص العالم لأنه هو الله الابن الذي وحد الطبيعة البشرية بذاته بأن صار هو شخصها. وقد جعل الله الابن، الواحد من الثالوث القدوس، نفسه هو العامل الفاعل للطبيعة البشرية في يسوع المسيح.
ولذلك فالحقيقة التي هي أساس كل الرجال والنساء الذين يشكلون الجنس البشري كله (أي الأوسيا البشري أو الطبيعة البشرية) قد اتحدت بالله الابن. وكان التجسد عند الجانب الخلقيدوني يعني أن شخص المخلص هو الشخص الأزلي لله الابن. وكان الجانب الأنطاكي يقر أن الله الابن، الواحد من الثالوث القدوس، قد رفع الطبيعة البشرية من خلال عضو واحد من الجنس البشري بالاتحاد مع نفسه، ولكن بدون أن يجتاز أي تنازل من جانبه، ولذلك فهو مخلص العالم.
أما الجانب غير الخلقيدوني فقد أكد أن الله الابن، الواحد من الثالوث المبارك، وحد ناسوتاً بذاته. وفي الاتحاد لم يكن ذلك الناسوت غير اقنومي (أي غير محدد أو مخصخص)، على الرغم من أنه لم يكن شخصاً موازياً لشخص الله الابن. وبكونه هيبوستاسيس مركب، فإن الله الابن قد وحَّد في نفسه الحقيقة الهيبوستاسية للناسوت، ولذلك فيسوع المسيح هو الله الابن في حالته المتجسدة وهو بذلك مخلص العالم.
وفي الختام نستطيع أن نقول إن الأمر يحتاج بالفعل إلى إعادة تقييم. والاعتراف بحقيقة وجود تلك التقاليد الثلاثة يدفعنا إلى التأكيد أنه يتعين علينا البدء من الأسس الخاصة بهم، لكي ما نستطيع أن نصل للتعبير عن الإيمان بطريقة ذات دلالة لجيلنا المعاصر.
* ارجع إلى ملخص التعليم الخريستولوجي الأنطاكي في الفصل السابق
* أي موقفاً يأخذ التطرف العكسي المقابل للنسطورية وللأنطاكية
* كان التأله عند غير الخلقيدونيين بسبب أن الناسوت المخصخص قد اتحد هيبوستاسياً بالله الابن وصار جسده الخاص بالتالي كان هناك تبادل للخواص بين اللاهوت والناسوت، أما التأله عند يوحنا الدمشقي فكان بسبب أن الناسوت لم يكن في الحالة الأقنومية وبالتالي صار شخص الله الابن هو شخص الناسوت وهو الذي يقوم فيه بكل ما هو بشري.
* قد نختلف مع الكاتب عند تلك النقطة، لأن رؤية السكندريين بأن الأرثوذكسية تتطلب التواصل مع قانون مجمع نيقية بالطريقة التي فهمه وأكده بها مجمع عام 431م، كانت هي المعيار العمومي للكنيسة كلها في ذلك الوقت، حتى أن إعادة الوحدة نفسها قد تضمنت الاعتراف الكامل بمجمع أفسس، كما أكد نفس الشيء أيضاً مجمع القسطنطينية المكاني عام 448م والذي يعتبر البداية الحقيقية لما حدث في مجمع خلقيدونية عام 451م.
أما كون الأنطاكيين كانوا يبطنون عدم التأييد الكامل لمجمع عام 431م فهذا هو الخروج عن الإجماع الكنسي العام. هذا بالإضافة إلى أن عدم اتفاق الكنيسة المشرقية التي تكرم نسطوريوس مع مجمع أفسس عام 431م كان يعتبر هو الآخر خروج عن الإجماع الكنسي العام.
* نسبة إلى توما الأكويني