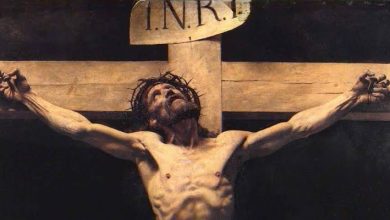شرح أمثال 8: 22 “الرب قناني أول طريقه” ج7 – أثناسيوس الرسولي
شرح أمثال 8: 22 “الرب قناني أول طريقه” ج7 – أثناسيوس الرسولي
شرح أمثال 8: 22 “الرب قناني أول طريقه” ج7 – أثناسيوس الرسولي
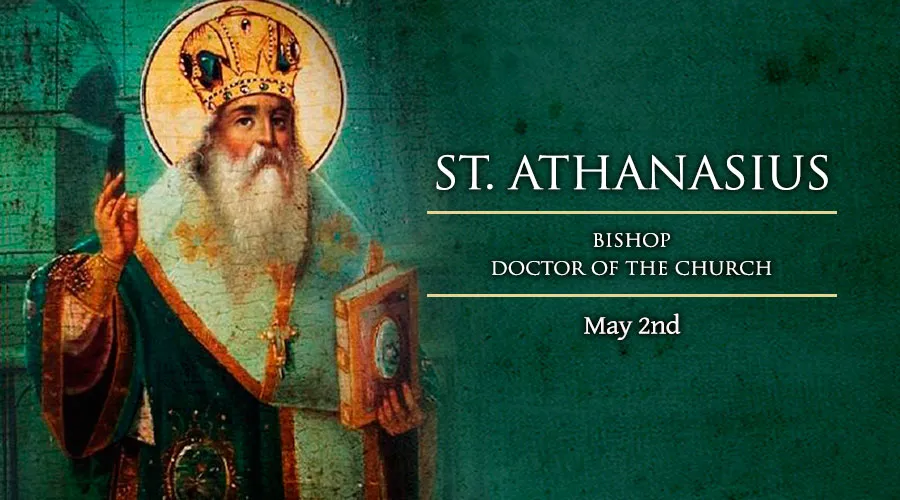
شرح أمثال 8: 22 “الرب قناني أول طريقه” ج7 – أثناسيوس الرسولي
73- مكتوب “بالحكمة أسس الله الأرض”(1). فإن كانت الأرض إذن قد تأسست بالحكمة فكيف تأسس هذا الذي أسسها؟. ولكن هذا النص قد قيل بأسلوب الأمثال. ويجب أن نبحث عن المقصود من هذا لكى نعرف أن الله خلق الأرض واسسها بالحكمة لكى تكون ثابتة وطيدة وتظل باقية. والحكمة نفسها تأسست لأجلنا لكى تصير بداية وأساس خليقتنا الجديدة وتجديدنا. وهنا أيضاً لا يقول في هذه النصوص أنه “قبل الدهر (العالم) قد صنعنى كلمة أو إباً لكى لا يبدو أن له بداية صنع، فقبل كل شئ يجب أن نبحث إن كان هو إبناً وأن نفتش الكتب بخصوص هذا الأمر. فهذا ما أجاب به بطرس حينما سئل الرسل، قائلاً: “أنت هو المسيح إبن الله الحى”(2). فإن أب الهرطقة الأريوسية(3) سأل هذا السؤال أيضاً في البداية: “إن كنت ابن الله؟”(4) لأنه عرف أن هذا هو الحق وأساس إيماننا، وأنه ان كان هو الإبن فيكون هذا هو نهاية حكم الشيطان الاستبدادى، أما إن كان مخلوقاً فإنه يكون واحداً من ذري أدم الذي خدعه الشيطان، وبذلك فلا يكون لديه داعٍ لأى اكتراث.
وكان يهود ذلك الزمان ساخطين لأنه دعا نفسه إبن الله وكان يقول أن الله أبوه. لأنه لو كان قد دعا نفسه واحداً من بين المخلوقات أو لو كان قد قال “إنى مصنوع” لما اندهشوا وهم يسمعون ولما ظنوا أن هذه الأقوال تجديف، ما داموا يعرفون أن الملائكة كانت تظهر لآبائهم أيضاً. ولكن حينما دعا نفسه إبناً بدأوا يعتبرون أن هذا اللقب لم يكن يميز المخلوق بل يميز الألوهية والطبيعة الأبوية.
74- وكان ينبغى على الأريوسيين – محاكاة لأبيهم الشيطان – أن يبحثوا هذا الأمر بدقة، لو كان قد قال “أسسنى كلمة أو إبناً”، وأن يفكروا كما يفكرون. ولكن إن لم يكن قد قال هكذا فلا ينبغى أن يبتدعو لأنفسهم أموراً لا وجود لها. لأنه لم يقل “قبل الدهر أسسنى كلمة أو ابناً” بل قال ببساطة “أسسنى” لكى يوضح – كما قلت – أنه يقول هذا بأمثال ليس عن نفسه بل عن هؤلاء الذين يُبنون فوقه. ولان الرسول قد عرف هذا لذا فإنه يكتب “لا يستطيع أحد أن يصنع أساساً آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح”(5) وأيضاً “فلينظر كل واحد كيف يبنى عليه”(6). ومن الضرورى أن يكون الأساس مماثلاً لتلك الأشياء التي تبنى عليه حتى يمكنها أن تلتئم معه وتتحد به. ولكونه الكلمة، فإنه من حيث كونه كلمة حقاً فلا يوجد هناك من يماثلونه حتى يمكن أن يتحدوا معه – وذلك لأنه وحيد الجنس، ولكن بصيرورته إنساناً فقد صار له مماثلون وهم الذين إرتدى جسدهم المماثل لجسده. وتبعاً لذلك فإنه “تأسس” بحسب بشريته لكى يمكننا نحن أيضاً أن نُنبنى فوقه كحجارة كريمة ونصير هكيلاً للروح القدس الساكن فينا. وكما أنه هو أساس حقاً، فنكون نحن الحجارة التي تبنى عليه وأيضاً يكون هو الكرمة ونصير نحن أغصانه ليس بحسب جوهر اللاهوت – لأن هذا مستحيل حقاً – بل بحسب بشريته، لأن الأغصان يلزم أن تكون مشابهة للكرمة، حيث أننا نحن مشابهون له بحسب الجسد.
وأيضاً حيث أن الهراطقة يفكرون بطريقة بشرية فمن الملائم أن ندحض أقوالهم بأمثلة بشرية. فهو لم يقل “قد جعلنى أساساً” لكى لا يجدوا في هذا القول حجة وقحة للكفر زاعمين أنه منوع وأن له بداية وجود، بل قال أنه “أسسنى”. فالذى يُؤسس إنما يُؤسس بسبب الحجارة التي توضع فوقه وهذا يحدث ليس كيفما إتفق، بل بنقل الحجارة من جبل أولاً ثم بعد ذلك توضع في عمق الأرض. وطالما كانت الحجارة موجودة في الجبل فهى لا تكون قد تأسست بعد، إلا عندما تستدعى الحاجة فيتم نقلها وتوضع في عمق الأرض. وعندئذ لو كانت تستطيع أن تتكلم لقالت “الآن أسسنى هذا الذي نقلنى من الجبل إلى هنا”. إذن فالرب عندما “أسس” لم يكن هذا هو بداية وجوده (لأنه قبل التأسيس كان كلمة)، لكن عندما لبس جسدنا الذي أخذه كقطعة من جسد مريم عندئذ يقول “أسسنى” كما لو كان قد قال: “لكونى كلمة فقد ألبسنى جسداً ترابياً”. لأنه هكذا تأسس من أجلنا، آخذاً ما يخصنا على عاتقه. لكى بإتحادنا معه في الجسد، وارتباطنا به بسبب مشابهة الجسد نبقى غير مائتين وغير قابلين للفساد وبه نصل إلى إنسان كامل(7).
75- أما الكلمات: “قبل الدهر” و”قبل أن يصنع الأرض” و”قبل أن تُرسى الجبال”(8) فلا ينبغى لأحد أن ينزعج بسببها، لأنه ربطها بتناسق تام مع لفظ “أسس” ولفظ “خلق”. لأن هذا ينسجم أيضاً مع التدبير بحسب الجسد. لأنه رغم أن النعمة التي صارت نحونا من المخلص قد ظهرت كما قال الرسول(9) وقد حدث هذا عندما أقام بيننا، إلا أن هذه النعمة كانت قد أعدت قبل أن يخلقنا بل حتى من قبل أن يخلق العالم. والسبب في هذا صالح ومذهل. فلم يكن من اللائق أن يفكر الله بخصوصنا بعد أن خلقنا لكى لا يظهر أنه يجهل الأمور التي تتعلق بنا. فإله الجميع إذن – عندما خلنا بكلمته الذاتى ولأنه كان يعرف أمورنا أكثر منا ويعرف مقدماً أننا رغم أنه قد خلقنا صالحين إلا أننا سنكون فيما بعد مخالفين للوصية، وأننا سنطرد من الجنة بسبب العصيان – ولأنه هو محب البشر وصالح فقد آعد من قبل تدبير خلاصنا بكلمته الذاتى – الذي به أيضاً خلقنا. لأننا حتى إن كنا قد خدعنا بواسطة الحية وسقطنا فلا نبقى أمواتاً كلية بل يصير لنا بالكلمة الفداء والخلاص الذي سبق إعداده لنا لكى نقوم من جديد ونظل غير مائتين، وذلك عندما “خُلِقَ” هو من أجلنا “بدء الطرق” وصار “بكر الخليقة” و “بكر إخوة” وقام “باكورة الأموات”.
ان بولس الرسول المغبوط يعلّم بهذا – كتفسير للنص الذي جاء في الأمثال: “قبل الدهر” و”قبل أن تكون الأرض”، وذلك عندما كتب إلى تيموثاوس قائلاً: “إشترك في إحتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح قبل الأزمة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة”(10). بل وقال إلى أهل أفسس “مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. كما إختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدامه في المحبة قديسين وبلا لوم. إذ سبق فعيننا للتبنى بيسوع المسيح لنفسه”(11).
76- وكيف اختارنا قبل أن نُخلَق، إن لم نكن مُمَثلين فيه من قبل كما قال هو نفسه؟ وعموما، كيف سبق فعيننا للتبنى قبل أن يخلق البشر إن لم يكن الإبن نفسه قد “تأسس قبل الدهر” أخذاً على عاتقه تدبير خلاصنا؟ أو كيف يصيف الرسول قائلاً: “نلنا نصيباً معينين سابقاً”(12) لو لم يكن الرب نفسه قد تأسس قبل الدهر”، حتى يكون له قصد من أجلنا أن يأخذ على عاتقه نصيب الدينونة الكامل من أجلنا عن طريق الجسد وبهذا نكون نحن مُتبنُون فيه؟ وكيف حصلنا على النعمة “قبل الأزمنة الأزلية” بينما لم نكن قد خُلقنا بعد، بل خلقنا في الزمن، لو أن النعمة التي وصلت إلينا لم تكن مودعة في المسيح؟ لهذا ففى الدينونة عندما ينال كل واحد بحسب عمله، يقول: “تعالوا يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم”(13). كيف إذن أو بواسطة من أُعد الملكوت قبل أن يخلقنا، إن لم يكن بواسطة الرب الذي “تأسس قبل الدهر” لأجل هذا الغرض، لكى ببنياننا عليه كحجارة ملتئمة، نشترك في الحياة والنعمة الممنوحتين معه؟ ولقد حدث هذا مثلما يحدث عموماً بإستقامة لمن يفكر بتقوى. وذلك لكى نستطيع أن نحيا إلى الأبد – كما سبق أن قلت – ما دمنا قد قمنا من الموت المؤقت. وهذا لم يكن في إمكاننا أصلاً حيث أننا بشر من تراب، لو لم يكن رجاء الحياة والخلاص قد أعد في المسيح من “قبل الدهر”. إذن فمن الإنصاف، إذ إنحدر الكلمة إلى جسدنا و “وخٌلق فيه أول الطرق من أجل أعماله” فإنه تأسس تماماً حسب مشيئة الآب التي كانت فيه كما قيل: “قبل الدهر” “وقبل أن تكون الأرض” و “قبل أن ترسى الجبال” و”قبل تدفق الينابيع”(14) لكى عندما تزول الأرض والجبال والطبيعة المنظورة فنحن لا نعتق ونبلو مثل هذه المخلوقات، بل سنتمكن أن نحيا بعدها، إذ قبل أن توجد هذه الأشياء قد أُعد لنا حياة وبركة روحية بواسطة الكلمة نفسه حسب الإختيار. لأنه هكذا سيكون لنا ليس حياة مؤقتة بل نبقى أحياء في المسيح بعد هذه الأشياء، إذ أن حياتنا كانت قد تأسست وأعدت بالمسيح يسوع قبل هذه الأشياء.
77- ولم يكن من اللائق إذن أن نؤسس حياتنا بأى طريقة أخرى سوى أن تؤسس في الرب الذي هو كائن منذ الأزل، والذى به قد خُلقت العالمين، لكى نستطيع نحن أيضاً أن نرث حياة أبدية إذ أن هذه الحياة كائنة فيه. ولأن الله صالح، وهو صالح على الدوام وهو يعرف طبيعتنا الضعيفة التي تحتاج إلى معونته وخلاصه، لذا فقد خطط هذا. وذلك مثلما لو كان مهندس حكيماً يريد أن يبنى منزلاً فإنه يخطط في نفس الوقت كيفيه تجديده مرة أخرى لو تدمر يوماً ما بعد أن يتم بناؤه، وهو يعد لهذا من قبل عندما يخطط، ويعطى للقائم على العمل الإستعدادات اللازمة للتجديد، وهكذا يكون هناك استعداد مسبق للتجديد قبل بناء المنزل. وبنفس الطريقة فإن تجديد خلاصنا قد تأسس في المسيح قبلنا، لكى يمكن إعادة خلقنا من جديد فيه، فالإرادة والتخطيط قد أعداً منذ الأزل، أما العمل فقد تحقق عندما إستدعت الحاجة وجاء المخلص إلى العالم. لأن الرب نفسه سيكون في السماء من أجلنا أجمعين وسيأخذنا معه إلى الحياة الأبدية.
هذا إذن يكفى لكى يوضح أن كلمة الله ليس بمخلوق، بل إن العبارة لها معنى مستقيم، وبما أنه عند إستقصاء معنى هذه العبارة يتضح أن لها معنى مستقيماً من جميع وجهات النظر إذن يلزم أن نتحدث بتوسع في هذا المعنى، لعل الأغبياء يخجلون من كثرة كلامنا. فهم في حاجة من جديد لما سبق أن قيل لأن جوهر الموضوع يدور حول نفس المثل ونفس الحكمة، فالكلمة لم يقل أنه هو نفسه مخلوق بالطبيعة بل قال في الأمثال: “الرب خلقنى” ومن الواضح أن هذا القول له معنى غير صريح ولكنه يشير إلى أمر مستتر يمكننا أن نكشف عنه بإزاحة الغطاء عن المثل. لأنه من ذا الذي عندما يسمع الحكمة الخالقة تقول: “الرب خلقنى أول طرقه”، ولا يبحث في الحال عن مغزى هذا القول، لأنه يفكر متمعناً كيف يمكن أن الخالق يُخلق؟ ومن عندما يسمع ابن الله الوحيد الجنس يقول أنه “قد خُلِقَ أول الطرق”، لا يفتش عن معنى هذا، لأنه يعجب كيف أن الإبن الوحيد الجنس يمكن أن يكون الأول لآخرين كثيرين؟ أنه لحقاً لغز. “الرجل ذو الفهم” “سيفهم المثل والحديث الغامض وأقوال الحكماء وألغازهم”(15).
78- والآن فإن ابن الله الوحيد وحكمته المطلقة هو خالق وبارئ جميع الكائنات لأنه مكتوب “بحكمة صنعت كل الأشياء”، “ملآنة الأرض بخليقتك”(16) حتى أن المخلوقات لا توجد فقط بل يكون وجودها صالحاً. ولهذا سُرَّ الله أن تنحدر حكمته إلى مستوى الخليقة حتى تطبع صورتها بشكل ما على الجميع معاً وعلى كل منها على حدة، حتى يتضح أن المخلوقات متصفة بالحكمة وهي أعمال الله الجديرة به. لأنه كما أن كلمتنا هي صورة الكلمة الذي هو إبن الله، هكذا أيضاً فإن الحكمة الموجودة فينا هي صورة الابن الذي هو الحكمة التي بها ينبغى أن يكون لنا المعرفة والفهم ونصير قابلين للحكمة الخالقة، وبواسطة هذه الحكمة نستطيع أن نعرف أباها. لأنه مكتوب: “من له الإبن له الآب ايضاً”(17) و “من يقبلنى يقبل الذي أرسلنى”(18) وحيث أنه قد خلق فينا نموذجاً مثل هذا للحكمة، وهو موجود أيضاً في جميع “الأعمال”، فمن الطبيعى أن يأخذ الحكمة الحقيقى والخالق ما يختص بنموذجه ويقول: “الرب خلقنى لأجل أعماله”.
لأن الأشياء التي تقولها الحكمة التي في داخلنا، هي التي يقولها الرب نفسه كأنها من ذاته هو. وليس لكونه هو غير مخلوق – إذ أنه هو الخالق – ولكن بسبب صورته المخلوقة في “الأعمال” فإنه يقول هذا كما لو كان قد قيل عنه. وكما قال الرب نفسه “من يقبلكم يقبلنى” وبسبب أن صورته موجودة فينا – فرغم أنه ليس من بين المخلوقات، إلا أنه بسبب ن صورته ونموذجه قد خلقا في “الأعمال”، فإنه يقول كأنه يتكلم عن نفسه: “الرب خلقنى أول طرقه لأجل أعماله”. ولهذا فقد صار نموذج الحكمة هذا في “الأعمال”، لكى بواسطتها يعرف العالم الكلمة خالقه وبواسطته يعرف الآب كما سبق أن قلت. وهذا ما قاله بولس “لأن معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى بوضوح منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات”(19). لذلك فإن الكلمة ليس مخلوقاً بالجوهر ولكن القول الذي فىالأمثال إنما يشير إلى ما هو موجود بداخلنا نحن والذى يسمى حكمة.
79- وان كانوا يرفضون الإيمان، حتى بعد هذا الكلام، فليقولوا لنا إن كانت هناك أية حكمة موجودة في المخلوقات أم أن المخلوقات ليس فيها أية حكمة وإن لم تكن هناك حكمة فكيف يلوم الرسول قائلاً: “لأنه إذ كان بحكمة الله لم يعرف العالم الله بالحكمة”(20). وإن لم تكن هناك حكمة فكيف توجد حكمات كثيرة في الكتاب المقدس(21)؟ لأن “الحكيم يخشى ويحيد عن الشر”(22) و “بالحكمة يبنى البيت”(23) وجاء في سفر الجامعة: “حكمة الانسان تنير وجهه”(24) وهو يوبخ المتهورين قائلاً: “لا تقل، ماذا حدث، لماذا كانت الأيام السابقة خيراً من هذه، لأنك لا تسأل بحكمة عن هذا”(25). وإن كانت الحكمة موجودة كما قال ابن سيراخ: “وسكبها على جميع أعماله فهى مع كل ذى جسد على حسب عطيته وقد منحها للذين أحبوه”(26)، فإن مثل هذا الانسكاب لا يكون سمة خاصة لجوهر الحكمة المطلقة والوحيدة الجنس بل هو سمة لتلك الحكمة التي صُورت في العالم بدقة. فلماذا يكون غير مُصَدّق ان كانت الحكمة الخالقة الحقيقية – التي هي نموذج الحكمة والمعرفة المنسكبة في العالم – تتحدث عن نفسها وتقول: “الرب خلقنى من أجل أعماله”؟ لأن الحكمة الموجودة في العالم ليست خالقة بل هي الحكمة المخلوقة داخل الأعمال، تلك الحكمة التي بها: “السموات تحدّث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه”(27). أما الناس فإن كانوا يحملون هذه الحكمة بداخلهم فإنهم سيدركون حكمة الله الحقيقية، ويعرفون أنهم قد تشكّلوا بحق على صورة الله.
ومثلما لو كان ابن أحد الملوك ينشئ مدينة – بإرادة والده – فإنه ينقش إسمه على كل الأعمال التي يجرى إنشاؤها، وذلك من أجل الأمن لكى تحفظ الأعمال بسبب ظهور إسمه في كل عمل ولكى يستطيعوا أن يتذكروه من إسمه. وعندما يفرغون من إنشاء المدينة، فإذا سأل أحد عن المدينة وكيف أنشئت فإنه سيجيب: “لقد أنشئت بإمان وفقاً لإرادة أبى، وخُطِطَ لها بدقة في كل عمل، وإسمى قد خُلِقَ في الأعمال”. وعندما يقول هذا فإنه لا يعنى ان جوهره قد خلق بل إنطباع صورته من خلال إسمه.
وعلى نفس المنوال إذ نطبق على المثال، فإن الحكمة الحقيقية تجيب على المندهشين من الحكمة الموجودة داخل الخليقة قائلة: “الرب خلقنى من أجل أعماله” لأن “إنطباع الصورة الموجودة فيها هو إنطباع صورتى، ولأجل ذلك فأنا قد تنازلت إلى الخليقة”.
80- ومرة أخرى لا ينبغى أن يدهش أحد لو أن الابن تحدث عن النموذج المطبوع فينا كما لو كان يتحدث عن نفسه (لأن تكرار نفس الكلام لا يجب أن يبعث على الضجر والملل)، حيث أن شاول حينما كان يضطهد الكنيسة التي كان يوجد فيها نموذجه وصورته فإن (الكلمة) تحدث كما لو كان هو المضطَّهد قائلاً: “شاول لماذا تضطهدنى”(28). لذلك (كما سبق القول)، لو كان نموذج الحكمة ذاته الموجود في الأعمال هو الذي قال “الرب خلقنى لأجل الأعمال” لما اندهش أحد. وهكذا فإن كان الحكمة الحقيقى الخالق وكلمة الله الوحيد يتحدث عن صورته كما لو كان يتحدث عن ذاته بقوله “الرب خلقنى لأجل الأعمال”، فلا يجب أن يجهل أحد أن المقصود هو الحكمة المخلوقة في العالم وفى الأعمال، ويظن أن لفظ “خلق” قد قيل عن جوهر الحكمة المطلق كى لا يبدو بمزجه الخمر بالماء(29) أنه يسلب الحقيقة. فالحكمة نفسها جابلة وخالقة، ولكن نموذجها مخلوق بداخل الأعمال كنموذج للصورة نفسها تماماً، وهو يقول “أول الطرق” حيث أن مثل هذه الحكمة صارت كنوع من البداية وكمرشد إلى معرفة الله. فلو أن أحداً سار في أول هذا الطريق حافظاً إياه بخوف الله (كما قال سليمان: “بدء الحكمة مخافة الرب”(30)) فإنه عندما يتقدم بالفكر مدركاً عمل الحكمة الخالقة الذي في الخلق، سيدرك بها أباها أيضاً كما قال الرب نفسه: “الذى رآنى فقد رأى الآب”(31) وكما كتب يوحنا: “من يعترف بالإبن فله الآب أيضاً”(32). والأبن يقول “قبل الدهر أسسنى”(33)، حيث أن الأعمال تبقى في نموذجها راسخة دائماً. ولئلا عندما يسمع أحد عن الحكمة المخلوقة في الأعمال يظن أن الحكمة الحقيقية إبن الله هو مخلوق بالطبيعة، فإنه يضيف بالضرورة “قبل أن تكون الجبال” و “قبل أن تكون الأرض” و “قبل المياه” و “قبل كل الجبال ولدنى”(34) وإذ يشير بهذه إلى كل الخليقة فإنه يوضح بقوله “قبل كل خليقة” أنه لم يُخلق بحسب الجوهر مع الأعمال. لأنه لو كان قد خُلق من أجل الأعمال وهو الموجود قبل الأعمال، فواضح أنه موجود قبل أن يُخلق فهو إذن ليس مخلوقاً بحسب الطبيعة والجوهر، بل كما أضاف هو نفسه أنه مولود. أما فيما يختلف “المخلوق” عن “المولود” وكيف يتميز عنه بحسب الطبيعة فهذا قد سبق بيانه من قبل.
81- وحيث أنه أضاف قائلاً: “عندما أعد السموات كنت أنا في نفس الوقت معه”(35) ينبغى أن نعرف أنه لم يقل هذا كما لو أن الآب أعد السماء أو السحب العليا بدون الحكمة، لأنه لا ريب أن جميع الأشياء قد خلقت بالحكمة، وبغيرها لم يكن شئ ما. وما قاله يعنى هذا أن “كل الأشياء قد صارت بى وبواسطتى، وعندما صار هناك إحتياج أن تُخلق الحكمة لأجل الأعمال، فإنى وأنا موجود مع الآب حسب الجوهر، لكن بالتنازل إلى المخلوقات قد طبعت صورتى على الأعمال، حتى يكون العالم كأنه في جسد واحد غير متمرد بل يكون متوافقاً مع نفسه”. فكل الذين يتأملون المخلوقات بفكر مستقيم بحسب الحكمة المعطاه لهم يستطيعون أن يقولوا: “كل الأشياء تثبت بتدبيرك”(36). أما الذين يستهينون بهذا الأمر فيلزم أن يسمعوا: “وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء”(37) لأن: “معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى بوضوح منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه كإله”(38) بل “عبدو المخلوق دون خالق الكل الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين”(39). وهم بالتأكيد سيخجلون عندما يسمعون: “لأنه إذ كان (العالم) في حكمة الله (وفقا لما شرحناه سابقاً) لم يعرف الله بالحكمة، إستحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة”(40) لأن الله لا يريد بعد – مثلما حدث في العصور السابقة – أن يُعرف عن طريق صورة وظل الحكمة الموجودة في المخلوقات بل جعل الحكمة الحقيقية ذاتها تتخذ جسداً وتصير إنساناً وتعانى موت الصليب، لكى يتمكن جميع الذين يؤمنون أن يخلصوا بالإيمان به. وطبعاً فإن الحكمة ذاتها هي التي أظهرت نفسها من قبل في صورتها الموجودة في المخلوقات، والتى يقال أنها قد خُلِقت، وهكذا فقد أظهرت أباها أيضاً بواسطة ذاتها. وفيما بعد فإن نفس الحكمة التي هي الكلمة “قد صار جسداً” كما قال يوحنا(41).وبعد إبطال الموت وتخليص جنسنا فإنه أكثر من ذلك أظهر نفسه وأظهر أباه أيضاً من خلال نفسه بقوله: “اعط هؤلاء لكى يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته”(42).
82- إذن فكل الأرض إمتلأت بمعرفته، لأن معرفة الآب من خلال الإبن ومعرفة الإبن من الآب هي معرفة واحدة. والآب يفرح بالإبن وبهذا الفرح عينه يبتهج الإبن بالآب قائلاً: “كنت أنا موضع فرح، وكنت أفرح كل يوم قدامه”(43). وهذا يبرهن مرة أخرى أن الإبن هو من ذات جوهر الآب وليس غريباً عنه. فهو إذن لم يوجد من أجلنا كما يدعى الكافرون، وهو ليس من العدم، لأن الله لم يتخذ لنفسه موضوعاً للفرح من خارجه، بل من الواضح أن هذه الكلمات هي عن ذاك الذي هو خاص به ومماثل له. فمتى إذن لم يكن الآب يفرح؟ لأنه إن كان يفرح دائماً إذن فلابد أن ذلك الذي كان يفرح به كان موجوداً دائماً. فبماذا يفرح الآب إلا بأن يرى نفسه في صورته التي هي كلمته؟ وحتى إن كان يبتهج ببنى البشر عندما أكمل خلق المسكونة كما كتب في الأمثال(44) نفسها، ولكن هذا أيضا له معنى مناسب، لأنه إبتهج ليس لأن الفرح أضيف إليه، بل أيضاً لأنه رأى الأعمال صائرة حسب صورته، ولهذا يكون فرح الله هو بسبب صورته. وايضاً كيف يبتهج الإبن إلا وهو يرى نفسه في الآب؟ فهذا مماثل لقوله: “من رآنى فقد رأى الآب”(45)، “أنا في الآب والآب فىّ”(46).
إذن يا أعداء المسيح، لقد ظهر أن مجادلتكم باطلة من جميع النواحى، وعبثاً عرضتم في تباه أراء غير مستقيمة وأذعتموها في كل مكان عن القول “الرب خلقنى أول طرقه” وأسأتم فهم معناه، وبدلاً من فكر سليمان أعلنتم بدعتكم. وها هو رأيكم يتضح أنه خيال فقط أما قول سفر الأمثال وكل ما سبق أن شرنا إليه من أقوال، فهو يبرهن أن الإبن ليس مخلوقاً بحسب الطبيعة والجوهر، بل هو مولود الآب الذاتى وهو حكمته كلمته الحقيقى، و “كل شئ به كان، وبغيره لم يكن شئ مما كان”(47).
(1) ام 19:3.
(2) مت 16:16.
(3) ابو الهرطقة الأريوسية هو الشيطان.
(4) مت 6:4.
(5) 1كو 11:3.
(6) 1كو 10:3.
(7) انظر اف 13:4.
(8) أم 23:8،25.
(9) انظر تيطس 11:2.
(10) 2 تيمو 8:1-10.
(11) افسس 3:1-5.
(12) أفسس 11:1.
(13) مت 34:25.
(14) انظر ام 22:8 – 25.
(15) أم 5:1،6.
(16) مز 24:104 (سبعينية).
(17) 1يو 23:2.
(18) متى 40:10.
(19) رو 19:1،20.
(20) 1كو 21:1.
(21) سفر الحكمة 24:6 (سبعينية).
(22) أم 16:14.
(23) أم 3:24.
(24) جا 1:8.
(25) جا 10:7.
(26) إبن سيراخ 9:1،10.
(27) مز 1:19.
(28) أع 4:9.
(29) انظر اش 22:1.
(30) أم 7:1.
(31) يو 9:14.
(32) 1يو 23:2.
(33) أم 23:8 سبعينية.
(34) انظر امثال 23:8-25.
(35) أم 27:8 سبعينية.
(36) مز 91:119 سبعينية.
(37) رو 22:1.
(38) رو 19:1-21.
(39) رو 25:1.
(40) 1كو 21:1.
(41) انظر يو 14:1.
(42) انظر يو 3:17.
(43) أم 30:8 سبعينية.
(44) أم 31:8.
(45) يو 6:14.
(46) يو 10:14.
(47) يو 3:1.