شرح أمثال 8: 22 “الرب قناني أول طريقه” ج6 – أثناسيوس الرسولي
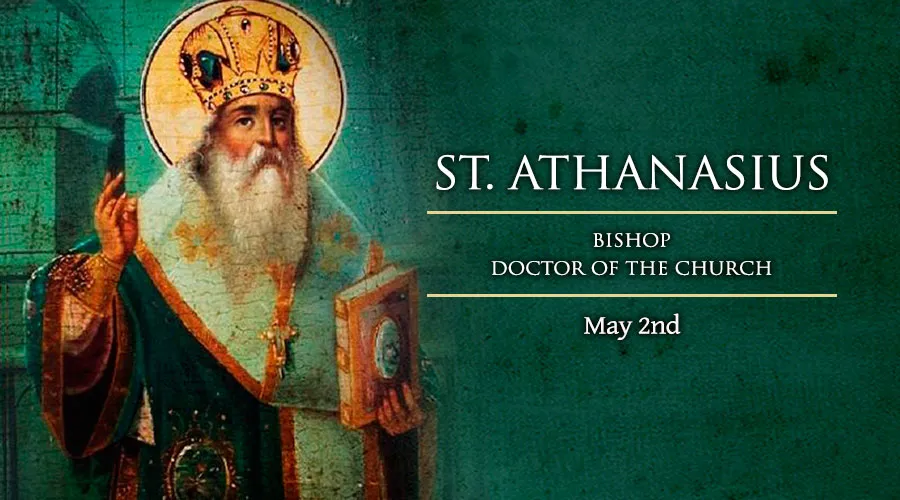
شرح أمثال 8: 22 “الرب قناني أول طريقه” ج6 – أثناسيوس الرسولي
57- إن موسى عندما تكلم عن الخليقة لم يقل “فى البدء ولد” ولا “فى البدء كان” بل قال: “فى البدء خلق الله السماء والأرض”(1) وداود لم يترنم بالقول يداك ولدتانى، بل “يداك صنعتانى وأنشأتانى”(2). فهو يقول في كل مكان “صنع” عن المخلوقات. في حين يتكلم عن الابن عكس ذلك. فهو لم يقل عن الابن “صَنَعتُ”، بل “وَلدتُ”(3). و “وَلَدَنى” و “فاض قلبى بكلام صالح”(4). فبينما يقول عن الخليقة في البدء خلق” يقول عن الابن “فى البدء كان الكلمة”. وهذا الاختلاف راجع إلى أن المخلوقات قد صُنعت ولها بداية وجود في مرحلة زمنية محددة. ولذا فإن ما قيل عنها “فى البدء خلق” مساوٍ للقول “منذ البدء خلق” – كما أن الرب إذ قد عرف ما صنع علّم الفريسيين موبخاً إياهم قائلاً “إن الذي خلقهما منذ البدء خلقهما ذكراً وأنثى”(5). لأن المخلوقات أتت إلى الوجود وخلقت من بداية ما، قبل أن يكون هناك أى وجود. وهذا هو ما قصده الروح القدس أيضاً بقوله في المزامير “وأنت يا رب منذ البدء أسست الأرض”(6). ويقول أيضاً “أذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم”(7). وواضح أن الذي يكون منذ البدء له بداية خلق، وأن الله اقتنى الجماعة في وقت معين. فإن القصد من القول “خلقَ” في عبارة “فى البدء خَلَقَ”، أنه بدأ يخلق. وموسى نفسه أوضح هذا بعد تمام عمل كل الأشياء قائلاً: “وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه في هذا اليوم استراح من أعماله التي بدأ الله أن يخلقها”(8). إذن فإن المخلوقات قد بدأت أن تُخلق، أما كلمة الله فحيث أنه ليس له بداية وجود فإنه لم يبدأ أن يوجد ولا بدأ أن يصير، بل كان موجوداً دائماً. والأعمال لها بداية لصنعها، وبايتها تسبق صيرورتها في الوجود أما الكلمة فإنه ليس من بين الأشياء التي تصير، بل بالأحرى هو خالق هذه الأشياء التي لها بداية. ووجود المخلوقات يرجع إلى صيرورتها. ومن بداية ما، يبدأ الله يصنع هذه الأشياء بواسطة الكلمة، لكى يكون معروفاً أن هذه الأشياء ليس لها وجود قبل أن تصير. أما الكلمة فإن وجوده ليس له بداية أخرى سوى في الآب الذي هو بلا بداية كما يعترنون هم، فالابن أيضاً موجود بلا بداية في الآب، إذ أنه في الواقع هو مولوده وليس مخلوقه.
58- هكذا فإن الكتاب الإلهى يفرق بين “المولود” وبين “المصنوعات”، ويوضح أن المولود هو ابن ليس مبتدئاً من أية بداية، بل هو أزلى. أما الشئ المصنوع فلأنه من عمل الذي صنعه من الخارج، فهذا يشير إلى أن له بداية خلق. ويوحنا عندما كان يعلّم عن ألوهية الابن وهو يعرف الفرق بين اللفظين لم يقل “فى البدء قد صار” أو “فى البدء قد صُنع”، بل قال “فى البدء كان الكلمة”، فكلمة “كان” تتضمن “المولود” لكى لا يظن أحد أن هناك فرقاً زمنياً، بل ليؤمنوا أن الابن أزلى وموجود دائماً.
ومع كل هذه البراهين، فكيف لم تستوعبوا أيها الآريوسيون الأقوال التي جاءت في سفر التثنية وتتجاسرون أن تكفروا بالرب مرة أخرى بقولكم أنه “مصنوع” أو “مخلوق” بينما هو “مولود”؟ وأنتم تزعمون أن “المولود” و”المصنوع” لهما نفس المعنى. ومن هنا – مع ذلك – سيتضح أنكم غير عارفين كما أنكم عديمى التقوى. لأن القول الأول هو هذا: “اليس هذا هو أبوك الذي أوجدك وصنعك وخلقك”(8). ويقول بعد قليل في نفس الأنشودة: “تركت الله الذي ولدك ونست الله الذي أطعمك”(9). وهذه الفكرة غريبة للغاية، فهو لم يقل أولاً ولَدَ لئلا يبدو القول غير مختلف عن “صنع””، ولوجد هؤلاء مبرراً أن يقولوا أن موسى منذ البدء ذكر أن الله قد قال “لنصنع انساناً”(10)، وبعد ذلك قال “تركت الله الذي ولدك” كما لو أن الألفاظ غير مختلفة. أى أن “المولود” و “المصنوع” هما نفس الشئ. ولكن بعد أن ذكر لفظى “أوجد” و “صنع” أضاف أخيراً لفظ “ولد” لكى يظهر أن العبارة تحمل تفسيرها فيها. لأن اللفظ “صنع” يشير في الحقيقة إلى طبيعة البشر. أى أنهم أعمال ومصنوعات. أما لفظ “ولد” فيوضح مبة الله للبشر التي صارت للناس بعد أن خلقهم. ولأن الناس أظهروا جحوداً لمحبة الله للبشر هذه، لهذا وبخهم موسة وقال أولاً: “هل تكافئون الرب بهذه الأمور؟” ثم أضاف “أليس هذا هو أبوك الذي أوجدك وصنعك وخلقك”(11). وقال ثانياً: “قدموا الذبائح للشياطين وليس لله لآلهة لم يعرفوها، ودخلت آلهة جديدة وحديثة ولم يعرفها آباؤهم، تركت الله الذي ولدك”(12).
59- فإن الله لم يخلقهم بشراً فقط بل دعاهم أيضاً أبناء لأنه ولدهم. لأن لفظ “ولد” له معنى هام. لأنه يشير إلى أبن كما قال بواسطة النبى “ولدت بنيناً ونشأتهم”(13). وعموماً فإن الكتاب عندما يريد أن يشير إلى “ابن” يعبر عنه ليس بواسطة لفظ “خُلقتُ”، بل حتماً بواسطة اللفظ “وُلدتُ”. ويتضح هذا من قول يوحنا “أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون بأسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله”(14). وهذا النص واضح لأنه حين يذكر عبارة “أن يصيروا” يقول إن هؤلاء أبناء ليس بحسب الطبيعة بل بحسب التبنى. ثم يقول “وُلِدوا” لأن هؤلاء قد حصلوا على لقب ابن بالكامل ولكن الشعب كما يقول النبى تمرد على الذي فعل معه “الخير”(15). فهذه هي محبة الله للبشر أنه بالنسبة لأولئك الذين صنعهم فقد صار لهم أباً أيضاً بعد ذلك بحسب النعمة. وقد صار لهم أباً أيضاً بعد ذلك بحسب النعمة، وقد صار لهم أباً – كما قال الرسول – عندما حصل الناس المخلوقون على “روح ابنه في قلوبهم صارخاً: أبانا أيها الآب”(16). فهؤلاء هم الذين قبلوا “الكلمة” ونالوا منه سلطاناً أن يصيروا أولاد الله. لأنه لم يكن في إمكانهم – حيث أنهم مخلوقات بالطبيعة – أن يصيروا أبناء بأية طريقة أخرى إلا بأن يتقبلوا روح الابن الحق بالطبيعة. لذا فلكى يحدث هذا فقد “صار الكلمة جسداً” لكى يجعل الانسان قادراً على تقبل الألوهية، ويمكن أن نتعلم هذه الفكرة أيضاً من ملاخى النبى الذي قال “ألم يخلقكم إله واحد؟ أليس لكم أب واحد”(17). وهنا أيضاً وضع أولاً “خلق” وثانياً لفظ “أب” لكى يثبت هو أيضاً أننا كنا منذ البدء مخلوقات بحسب الطبيعة وأن الله هو خالقنا بواسطة الكلمة وبعد ذلك جعلنا أبناء، وهكذا صار الله الخالق هو أبونا أيضاً.
إذن فإن “الآب” هو خاص “بالابن”(18) وليس بالخليقة، كما أن “الابن” خاص بالآب. ويضتح من هذا أننا لسنا أبناء بالطبيعة. أما الذي جاء وسطنا فهو ابن بالطبيعة. وأيضاً فإن الله ليس أبانا بالطبيعة، بل هو أب الكلمة الموجود فينا والذى به نصرخ: “أبانا أيها الآب”. وبنفس الطريقة فإنه يدعو أولئك الذين يرى ابنه فيهم، أبناءً له ويقول: “وَلدتُ”، حيث أن الولادة تدل على الابن حقاً، أما “الصنع” فهو لفظ يدل على “الأعمال”. لهذا فإننا نحن لم “نُولد أولاً” بل “صُنعنا” كما هو مكتوب “لنصنع انساناً”، وبعد ذلك بواسطة قبولنا نعمة الروح قال: إننا “نُولَد”. لهذا فإن موسى العظيم قال بمعنى جيد في أنشودته، أولاً: “أوجد” وبعد ذلك “وَلد”، لئلا عند سماع لفظ “وَلد” ينسون طبيعتهم من البداية، وبهذا يعرفون أنهم من البدء مخلوقات. وعندما يقال أن الناس يولدون كأبناء بالنعمة فإنهم مع ذلك هم أيضاً مصنوعات بالطبيعة.
60- إن “المخلوق” ليس في الواقع هو “المولود”، بل هما يختلفان أحدهما عن الآخر في الطبيعة وفى معنى الألفاظ نفسها. والرب نفسه أوضح هذا في الأمثال. لأنه عندما قال: “الرب خلقنى أول طرقه”(19)، أضاف: “لكنه قبل كل الجبال ولدنى”(20). فإن كان الكلمة مخلوقاً بالطبيعة وبالجوهر، والمولد يختلف عن المخلوق فما كان له أن يضيف “ولدنى” بل لكان قد اكتفى بلفظ “خلق” ما دام هذا اللفظ يعنى أيضاً “ولد”. ولكنه هنا يقول “خلقنى أول طرقه لأجل أعماله”. وأضاف عبارة “ولدنى” ليس عن غير قصد، بل بعد ربطها بأداة الربط “لكن”، وبذلك بعطى حماية كافية للفظ “خلق” قائلاً “لكنه قبل كل الجبال ولدنى”، لأن عبارة “ولدنى” إذ تأتى مع لفظ خلق فإنها تضفى عليها معنّى معيناً. وهو يوضح أن لفظ “خلق” إنما قيل لأجل غرض معين. أما عبارة “ولدنى” فهى تتخذ وضعاً قبل “خَلَقَ”. لأنه لو كان قد قيل بالعكس تماماً: “الرب ولدنى” ثم أردف بالقول “ولكن قبل كل الجبال خلقنى”، لكان لفظ “خلق” يعتبر سابقاً على لفظ “ولد”. وهكذا بقوله أولاً “خلق”. وبقوله “ولدنى قبل الكل” يشير إى أن ذاته هي شئ آخر غير الكل. وقد أتضحت الحقيقة فيما سبق من أقوال، أنه فيما يتعلق بالمخلوقات لم يصر أى واحد منها قبل غيره، بل إن جميع المخلوقات خُلقت معاً في نفس الوقت وبنفس الأمر الواحد. ولهذا فإن لفظ “ولدنى” لا يرتبط به ألفاظ مثل التي ترتبد بلفظ “خلق”، ولكن لفظ خلق يرتبط به “أول طرقه”، أما لفظ ولدنى فلم يقل معه “فى البدء ولدنى”، بل “قبل الكل ولدنى”، فهذا هو الذي قبل الكل لا يكون أول الكل، بل هو شئ آخر غير الكل. فإن كان مختلفاً عن كل الأشياء، التي من بينها يعتبر هو أول الجميع، فيتضح من ذلك أنه مختلف عن المخلوقات، ويظهر بوضوح أنه بما أن الكلمة مختلف عن الكل وموجود قبل الكل، فإنه بعد ذلك يُخْلقَ “أول طرقه من أجل أعماله” بسبب التجسد. كما قال الرسول “الذى هو البداية، البكر من الأموات لكى يكون هو متقدماً في كل شئ”(21).
61- وإن كان يوجد مثل هذا الفرق بين “خَلقَ” و “ولدنى”، وبين “أول الطرق” و “قبل الكل”، فإن الله أولاً هو خالق البشر وقد صار فيما بعد أباً لهم بسبب كلمته الساكن فيهم. والعكس بالنسبة للكلمة، إذ أن الله هو أبوه بالطبيعة، لكنه صار فيما بعد خالقه وصانعه عندما لبس الكلمة الجسد الذي خُلِقَ وصُنِعَ، وصار انساناً. لأنه كما أن البشر الذين حصلوا على روح الابن صاروا به أولاداً، هكذا كلمة الله عندما لبس هو أيضاً جسد البشر، فيقال حينئذ أنه خُلق وصُنع. إذن فلو كنا نحن أبناء بالطبيعة يكون هو أيضاً مخلوقاً ومصنوعاً بالطبيعة. ولكن إن كنا نحن أبناء بالتبنى وبالنعمة فمن الواضح أن الكلمة حينما صار انساناً بسبب النعمة من نحونا، قال: “الرب خلقنى”. وبعد ذلك حينما لبس ما هو مخلوق فإنه صار مشابهاً لنا بحسب الجسد، ولهذا فمن الصواب أن يدعى أيضاً “أخانا” و “بكرنا”. ورغم أنه صار إنساناً بعدنا ومن أجلنا وهو أخونا بسبب مشابهة الجسد، إلا أنه بهذا يدعى أيضاً “بكرنا”. لأنه بما أن كل البشر قد هلكوا بسبب مخالفة آدم، فإن جسده كان هو أول ما تم تخليصه وتحريره إذ أن هذا الجسد هو جسد الكلمة نفسه. وهكذا إذ قد صرنا متحدين بجسده قد خلصنا على مثال جسده. وبهذا الجسد صار الرب هو قائدنا إلى ملكوت السموات وإلى أبيه نفسه لأنه يقول “أنا هو الطريق”(22)، “وأنا هو الباب”(23)، ويجب على الجميع “أن يدخلوا بى”. من أجل ذلك يدعى أيضاً “بكر من بين الأموات” لا لأنه مات أولنا – إذ أننا قد متنا قبله – بل لأنه قد أخذ على عاتقه أن يموت لأجلنا – وقد أبطل هذا الموت، فإنه هو الأول الذي قام كإنسان، إذ قد أقام جسده من أجلنا. وتبعاً لذلك حيث أن ذلك الجسد قد أقيم، هكذا نحن أيضاً نقوم من بين الأموات منه وبه.
62- وإن سُمى أيضاً “بكر الخليقة”(24)، لكنه لم يلقب بكراً كمساوٍ للمخلوقات، أو أولهم زمنياً (لأنه كيف يكون هذا وهو نفسه الوحيد الجنس بحق؟). لأنه بسبب تنازل الكلمة إلى المخلوقات فإنه قد صار أخاً لكثيرين. وهو يعتبر “وحيد الجنس” قطعاً إذ أنه وحيد وليس له إخوة آخرون والبكر يسمى بكراً بسبب وجود إخوة آخرين. لذلك فلم يُذكر في أى موضع في الكتب “بكر الله” ولا “مخلوق الله”، بل ذُكر “الوحيد الجنس”، و”الابن” و”الكلمة” و”الحكمة”. وهذه تشير إلى علاقته الخاصة المتميزة بالآب. وهكذا كُتب “رأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب”(25) و “أرسل الله ابنه الوحيد”(26) و “كلمتك يا رب ثابت إلى الأبد”(27) و “فى البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله”(28) و “المسيح قوة الله وحكمة الله”(29) و “هذا هو ابنى الحبيب”(30) و “أنت هو المسيح ابن الله الحى”(31).
أما لفظ “البكر” فيشير إلى التنازل إلى الخليقة، لأنه بسببها سُمى بكرا. ولفظ “خَلَق” يشير إلى النعمة “من أجل الأعمال”، فإنه يُخلَق من أجلها فإن كان هو “الابن الوحيد” تماماً مثلما هو في الحقيقة، فإن كلمة بكر تحتاج إلى تفسير، لأنه لو كان “بكراً” لما كان “وحيداً” لأنه غير ممكن أن يكون هو نفسه “وحيداً” و “بكراًُ” إلا إذا كان يشير إلى أمرين مختلفين. فهو “الابن الوحيد” بسبب الولادة من الآب، ولكنه يسمى “بكراً” لسبب التنازل للخليقة ومؤاخاته للكثيرين. فإن كان اللفظان متعارضين أحدهما مع الآخر، فإنه سيكون في إمكان أى شخص أن يقول أن اصطلاح “الوحيد الجنس” متعلق “بالكلمة” وذلك بسبب عدم وجود “كلمة” آخر أو “حكمة” آخر، بل إنه هو وحده ابن الآب الحقيقى. لأنه كما قيل سابقاً فإن اصطلاح “وحيد الجنس” لم يُذكر مرتبطاً بأى سبب، بل ذُكر بصورة مطلقة أنه: “الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب”(32). أما اصطلاح “البكر” فهو مرتبط بالخليقة التي أشار إليها بولس عندما قال: “لأنه فيه خُلق الكل”(33). فإن كانت كل المخلوقات قد خلقت بواسطته فإنه يكون مختلفاً عن المخلوقات، ولا يكون مخلوقاً بل هو خالق المخلوقات.
63- إذن فهو لم يُدعَ “بكراً” بسبب كونه من الآب، بل بسبب أن الخليقة قد صارت به. وكما كان الابن نفسه موجوداً قبل الخليقة وهو الذي به قد صارت الخليقة، هكذا أيضاً فإنه قبل أن يُسمى “بكر كل الخليقة” كان هو الكلمة ذاته عند الله. ولكن حيث أن الكافرين لم يفهموا هذا صارون يجولون قائلين: “إن كان هو بكر كل خليقة فمن الواضح أنه هو نفسه أيضاً واحد من الخليقة”. يا لهم من حمقى! فإن كان هو بكر كل الخليقة جمعاء فهو إذن مغاير لكل الخليقة، لأنه لم يقل أنه كان بكر بقية الخلائق لكى لا يظن أنه مثل واحد من الخلائق، بل قد كُتب “بكر كل خليقة” كى يتضح أنه مختلف عن الخليقة. فرأوبين مثلاً لم يُدعَ بكر جميع أولاد يعقوب، بل بكر يعقوب وبكر إخوته، لكى لا يظن أنه شخص آخر ولا ينتمى إلى أولاد يعقوب(34). أما بخصوص الرب نفسه فلم يقل الرسول: “لكى يصير بكر الجميع”، لكى لا يُظن أنه يلبس جسداً مختلفاً عن جسدنا، بل قال: “إنه بكر بين إخوة كثيرين”(35) وذلك بسبب مشابهة الجسد. فلو كان الكلمة واحداً من بين الخلائق، لكان الكتاب قد قال عنه أنه بكر المخلوقات الأخرى. أما الآن حيث يقول القديسون أنه “بكر كل الخليقة” فإنه يتضح العكس تماماً لأنه غير كل الخليقة، وأن ابن الله ليس بمخلوق. لأنه إن كان مخلوقاً فسيكون هو بكراً بالنسبة لنفسه.
فكيف يكون ممكناً أيها الآريوسيون أن يكون هو الأول لذاته والثانى بالنسبة لنفسه؟ وبعد ذلك، فإن كان هو مخلوقاً، وكل الخليقة قد صارت به وتتكون فيه، فكيف يستطيع أيضاً أن يخلق الخليقة وأن يكون هو في نفس الوقت واحداً من أولئك الذين خُلِقوا فيه؟ فبدعتهم هذه تظهر منافي للعقل وسقيمة، فهم يحيدون عن الحق، لأنه قد دُعى “بكراً بين إخوة كثيرين” بسبب علاقة الجسد. وسُمى “البكر من بين الأموات” لأن قيامة الموتى قد صارت منه ومن بعده. وقد دعى “بكر كل الخليقة” من أجل محبة الآب للبشر التي بسببها، ليس أن الكل فقط قد تكون بكلمته، بل إن الخليقة نفسها – التي تحدث عنها الرسول أنها “تنتظر ظهور أبناء الله”(36)، هي أيضاً سوف “تعتق يوماً من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله”(37). وهكذا فبعد أن تتحرر الخليقة فسيكون الرب أيضاً هو بكرها وبكر كل الأولاد المولودين، لكى بتسميته “الأول” فإن الذين يتبعونه يظلون مرتبطين به كبداية لهم.
64- وأعتقد أن الكافرين أنفسهم سيخجلون من مثل هذه الفكرة، لأنه لو أن الأمر لم يكن هكذا مثلما قلنا، بل هم يريدونه أن يكون – بحسب الجوهر – مخلوقاً بين الخلائق. وبهذا المعنى يفهمون “بكر كل الخليقة”، فدعهم إذن يعترفون أنهم – في هذه الحالة – سيفهمونه أنه أخ ومشابه للكائنات غير الناطقة والتى بلا نفس. لأن هذه الأشياء هي أيضاً أجزاء من كل الخليقة، ولذلك يكون البكر بالضرورة هو الأول من الناحية الزمنية فقط، أما من ناحية النوع والتشابه فيكون هو والجميع شئ واحد. فكيف إذن لا يفوقون كل كفر عندما يقولون هذا؟ ومن سيحتملهم عندما يتكلمون هكذا؟ وكيف يستطيع أحد ألا يشمئز منهم بسبب أنهم يتفكرون في مثل هذه الأمور؟
لأن واضح للجميع أنه دُعى “بكر الخليقة” ليس بسبب نفسه كما لو كان مخلوقاً، ولا بسبب أن له علاقة ما من جهة الجوهر مع كل الخليقة، بل لأن الكلمة – منذ البدء – عندما خلق المخلوقات، تنازل إلى مستوانا حتى يتيسر لها أن تأتى إلى الوجود. لأن المخلوقات ما كان ممكناً لها أن تحتمل طبيعته – التي هي بها الآب الخالص – لو لم يتنازل بحب الآب للبشر ويعضدها ويمسك بها ويحضرها إلى الوجود. ونكرر أيضاً أنه بنزول الكلمة، قد صار تبنى الخليقة نفسها به، لكى يصير هو بكرها في كل شئ كما سبق أن قيل، سواء في الخلق أم في دخوله إلى العالم نفسه من أجل الكل لأنه مكتوب “ومتى أدخل البكر إلى العالم، يقول ولتسجد له كل ملائكة الله”(38). فليسمع أعداء المسيح وليمزقوا أنفسهم بشدة. لأن إدخاله إلى العالم ساهم في تسميته “بكر” الكل، حتى يكون هو ابن الآب الوحيد الجنس بسبب أنه هو الوحيد الذي من الآب، كما أنه “بكر” الخليقة من أجل تبنى الجميع. ولأنه هو بكر بين الإخوة، وقد قام من بين الأموات ليكون هو باكورة الراقدين(39)، لذلك كان من الواجب أن يكون متقدماً في كل شئ، لهذا فقد “خُلِقَ أول الطرق”. لكى إذ نتبعه وندخل بواسطته هو القائل “أنا هو الطريق” و”الباب” ونشترك في معرفة الآب، فإننا نسمع الكلمات: “طوباهم الذين بلا عيب في الطريق”(40) وايضاً “طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله”(41).
65- وهكذا إذ قد ظهر الحق وإتضح أن الكلمة ليس مخلوقاً بالطبيعة، فمن المناسب الآن أن نوضح كيف قيل عنه “أول الطرق”. لأنه حيث أن الطريق الأول الذي كان من خلال آدم، قد ضاع وانحرفنا إلى الموت بدل الفردوس وسمعنا القول: “إنك تراب وإلى التراب تعود”(42)، لذا فإن كلمة الله المحب للبشر ليس الجسد المخلوق بمشيئة الآب لكى يحيى بدم نفسه هذا الجسد الذي أماته الانسان الأول بسبب تعديه، كما قال الرسول: “وكرس لنا طريقا حياً حديثاً بالحجاب أى جسده”(43). وهو ما أشار إليه في موضع آخر حينما قال: “إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً”(44). فإن كان كل شئ قد صار خليقة جديدة فإنه من الضرورى أن يكون هناك شخص هو أول هذه الخليقة. ولا يمكن أن يكون هو الانسان الضعيف الترابى، وهي حالتنا نحن بسبب التعدى. لأنه في الخليقة الأولى قد صار البشر عديمى الايمان وهلكت الخليقة الأولى بسببهم، ولذا صارت هناك حاجة إلى آخر وهو الذي يقوم بتجديد الخليقة الأولى والذى يحفظ الخليقة الجديدة التي ستصير. لذلك فمن محبته للبشر لم يخلق أى شخص غير الرب ليكون أول طريق الخليقة الجديدة. ومن الصواب أن يقول: “الرب خلقنى أول طرقه لأجل أعماله” لكى لا يحيا الانسان فيما بعد بحسب الخليقة الأولى. وإذ توجد بداية خليقة جديدة والمسيح هو بدء طرقها، إذن فلنقتف أثره هو القائل لنا “أنا هو الطريق”. وأيضاً يعلَّم الرسول المغبوط في رسالته إلى أهل كولوسى قائلاً: “هو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداية، البكر من بين الأموات لكى يكون متقدماً في كل شئ”(45).
66- لأنه إن كان المسيح – كما قيل – يعتبر بداية بسبب القيامة من الأموات، إذ قد حدثت قيامة عندما لبس جسدنا وبعد أن سلَّم ذاته للموت من أجلنا، فإنه يكون واضحاً أن ما قاله هو: “خلقنى أول طرقه” يشير ليس إلى جوهره بل إلى وجوده الجسدى. لأن الموت خاص بالجسد. وكما أن الموت صفة خاصة للجسد، هكذا أيضاً فإن الوجود الجسدى يكون خاصاً بالقول “الرب خلقنى أول طرقه”. لأنه هكذا خُلق المخلص بحسب الجسد وصار أول الذين خُلقوا من جديد واتخذ باكورتنا التي هي الجسد البشرى الذي لبسه، وبعده يأتى الشعب الآتى الذي خُلق كما قال داود “يُكتب هذا لجيل آخر، وشعب سيُخلق يسبح الرب”(46). ويقول في المزمور الحادى والعشرين: “الجبل الآتى سيُخبَّر عن الرب. وسيعُلنون بره للشعب الذي سيُولد الذي صنعه الرب”(47). لأننا لن نسمع بعد: “لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت”(48)، بل نسمع: “حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضاً”(49). وهكذا نستطيع أن نقول: “لأننا نحن عمله مخلوقين لأعمال صالحة”(50). ومرة أخرى حيث أن عمل الله – أى الانسان – الذي خُلِق كاملاً، قد صار ناقصاً بسبب المخالفة، وصار ميتاً بالخطيئة، فلم يكن لائقاً أن يظل عمل الله ناقصاً. ولأجل هذا توسل جميع القديسين قائلين في المزمور 137 “يا رب جازهم بسببى.. يا رب لا تتخل عن أعمال يديك”(51). لأجل ذلك فإن كلمة الله الكامل قد لبس الجسد الناقص. ولهذا يُقال أنه “خُلق من أجل الأعمال”، لكى بعد أن يوفى الدين بدلاً منا يكمّل بنفسه ما هو ناقص عند الانسان. فالانسان ينقصه الخلود والطريق إلى الفردوس. وهذا يتضح مما قاله المخلص: “انا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتنى لأعمل قد أكملته”(52) وأيضاً “الأعمال التي أعطانى الآب إياها لأكملها. هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لى”(53). إن الأعمال التي يتحدث عنها هنا أن الآب قد أعطاها له ليكملها، هي تلك التي خُلق من أجلها كما يقول في الأمثال “الرب خلقنى أول طرقه لأجل أعماله”. وهذا كأنه يقول “الآب أعطانى الأعمال” و”الرب خلقنى لأجل الأعمال”.
67- إذن يا محاربى الله، متى أخذ الأعمال لكى يكملها؟ فمن هذا أيضاً سيتضح معنى اللفظ “خلق”. فإن قلتم أن هذا قد حدث في البدء عندما صنع الأشياء من العدم، يكون هذا كذباً وغير حقيقى، ذلك لأن الأعمال لم تكن قد وجدت بعد. وواضح أنه يقول أنه أخذ “أعمالاً” كانت موجودة عندئذ. وليس من التقوى أن نقول أن هذا حدث قبل الزمن الذي صار فيه الكلمة جسداً، لكى لا يبدو أن مجيئه إلى العالم كان عديم النفع، لأن مجيئه كان من أجل هذ “الاعمال”. إذن عينا أن نداوم القول انه عندما صار إنساناً، فإنه عندئذ فقط أخذ “الأعمال”. لأنه عندئذ أكملها أيضاً شافياً جراحنا ومانحاً إيانا القيامة من الأموات. لأنه إن كانت “الأعمال” قد أعطيت عندئذ للكلمة أى عندما صار جسداً، فإنه يكون واضحاً أنه عندما صار إنساناً فإنه حينئذ أيضاً “خُلِقَ لأجل الأعمال”. إذن فلفظ “خَلَقَ” لا يشير إلى جوهره – كما قلنا مراراً – بل إلى تكوينه الجسدى. ولأن الأعمال صارت ناقصة ومشوهة بسبب التعدى، لذا يقال عنه أنه “خُلِقَ” من جهة الجسد، لكى بعد أن يكمل هذه الأعمال ويتمم صنعها يحضر الكنيسة إلى الآب كما قال الرسول “لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب”(54).
إذن فقد كمل فيه الجنس البشرى وأعيد تأسيسه كما كان في البدء، بل بالأحرى بنعمة أعظم من الأول. لأننا بعد القيامة من بين الأموات لن نخاف الموت بعد، بل سنملك في السموات مع المسيح على الدوام. وهذا لأن نفس كلمة الله الذاتى الذي من الآب، قد لبس الجسد وصار إنساناً، لأنه لو كان مخلوقاً ثم صار إنساناً فإن الإنسان يبقى كما كان دون أن يتحد بالله. لأنه كيف يمكن لمخلوق أن يتحد بالخالق بواسطة مخلوق؟ لأن أية معونة يمكن أن يحصل عليها متماثلون من مماثليهم ما داموا هم أيضاً محتاجين إلى نفس المعونة؟ وإن كان الكلمة مخلوقاً فكيف يمكنه أن يبطل حكم الله ويصفح عن الخطيئة وهو أمر كتب عنه الأنبياء أنه خاص بالله؟ لأن “من هو إله مثلك غافر للإثم ومتغاضٍ عن الخطايا”(55). فإن الله قال “إنك تراب وإلى التراب تعود”(56)، والبشر قد صاروا مائتين. إذن فكيف يكون في إمكان المخلوقين أن يبطلوا الخطية؟ فإن الرب نفسه هو الذي أبطلها كما قال هو نفسه: “إن لم يحرركم الابن”(57)، وأوضح حقاً أن الابن الذي حرر ليس مخلوقاً وليس من بين المخلوقات، بل هو الكلمة الذاتى وصورة جوهر الآب، وهو الذي “أصدر الحكم”(58)، في البداية، وهو الذي صفح عن الخطايا. وإذ قيل بواسطة الكلمة “أنت تراب وإلى التراب تعود” هكذا أيضاً قد تحققت الحرية بالكلمة نفسه وفيه، وبه قد صار إبطال الدينونة.
68- ولكنهم يقولون أنه كان فىاستطاعة الله أن يقول كلمة واحدة يبطل بها اللعنة حتى لو كان المخلص مخلوقاً. ومن المحتمل أن يسمعوا نفس الشئ من آخر يقول: “كان فىالإمكان ألا يأتى الابن إلى العالم على الإطلاق، وأن يتكلم الله فقط ويبطل اللعنة”. ولكن يلزم التفكير في تحديد ما هو ملائم للبشر وليس في ما يكون في استطاعة الله. لأنه كان قادراً أن يهلك البشر المخالفين قبل فلك نوح، ولكنه فعل هذا بعد الفلك. وكان يستطيع بدون موسى أن يخرج الشعب من مصر بكلمة فقط، ولكن كان من المفيد أن يفعل هذا بواسطة موسى. وكان الله يستطيع أيضاً أن يخلص الشعب بغير القضاة ولكن كان من مصلحة الناس أن يقيم لهم قاضياً في كل عصر. وكان من الممكن أن يقيم المخلص بيننا منذ البداية، أو بعد أن جاء كان يمكنه ألا يستسلم لبيلاطس. لكنه جاء عند إنقضاء الدهر. فعندما سألوه قال “أنا هو”(59). لأن ما صنعه كان هو بعينه النافع للبشر. ولم يكن من المناسب أن يكون هناك شئ آخر. وبرعايته قد صنع أيضاً ما هو نافع ولازم.
إذن فهو قد “جاء لا لكى يُخدَم”، بل لكى يَخدم وأن يصنع لنا خلاصاً”(60). وبالتأكيد كان يستطيع أن يُملى الشريعة من السماء غير أنه رأى أنه لصالح البشر أن يمليها من سيناء. وهذا ما قد صنعه بالفعل حتى يستطيع موسى أن يرتقى الجبل ويتمكن أولئك الذين يسمعون الكلام عن قرب أن يؤمنوا أكثر.
ويمكن أيضاً أن ندرك صواب ما قد فعله من الآتى:
لو أن الله قال كلمة واحد – لسبب قدرته – وأبطل بها اللعنة، لظهرت قوة الذي أعطى الأمر ولكن الانسان كان سيظل كما كان آدم قبل العصيان، لأنه كان سيحصل على النعمة من الخارج دون أن تكون متحدة مع الجسد (فهذه كانت الحالة عندما وُضِع في الجنة) بل ربما صارت حالته الآن أسوأ مما كان في الجنة بسبب أنه قد تعلَّم كيف يعصى. فلو كانت حالته هكذا وأُغوِىَ مرة أخرى بواسطة الحية لصارت هناك حاجة مرة أخرى أن الله يأمر ويبطل اللعنة وهكذا تستمر الحاجة إلى مالا نهاية، ولظل البشر تحت الذنب بسبب استعبادهم للخطية – إذ هم يقترفون الإثم، ولظلوا على الدوام في حاجة لمن يعفو عنهم ولما خلصوا قط. ولكونهم أجساداً بحسب طبيعتهم فإنهم يظلون مقهورين دائماً بواسطة الناموس لسبب ضعف الجسد.
69- ومرة أخرى، لو كان الابن مخلوقاً لظل الانسان مائتاً كما كان قبلاً، حيث أنه لم يتحد بالله. فإنه لا يستطيع مخلوق أن يوّحد المخلوقات مع الله، إذ أنه هو نفسه في حاجة لمن يوَّحده بالله. وليس في وسع جزء من الخليقة أن يكون خلاصاً للخليقة إذ هو نفسه في حاجة إلى الخلاص. ولكى لا يحدث هذا أرسل الله ابنه وصار ابن الانسان بإتخاذه الجسد المخلوق. وحيث أن الجميع كانوا خاضعين للموت، وكان هو مختلفاً عن الجميع فقد قدم جسده الخاص للموت من أجل الجميع. إذن حيث أن الجميع ماتوا بواسطته هكذا قد تم الحكم (إذ أن الجميع ماتوا في المسيح). وهكذا فإن الجميع يصيرون بواسطته أحراراً من الخطية ومن اللعنة الناتجة عنها، ويبقى الجميع على الدوام قائمين من الأموات ولابسين عدم موت وعدم فساد. وكما قلنا مراراً وتكراراً فإن الكلمة بلبسه للجسد بدأ يبطل منه كلية كل لدغة من لدغات الحية، ويقطع منه أى شئ ينبع من حركات الجسد، ويبطل معها أيضاً الموت الذي يتبع الخطية كما قال الرب نفسه: “رئيس هذا العالم يأتى وليس له في شئ”(61). وحيث أن أعمال إبليس(62) قد نُقِضت من الجسد فقد تحررنا جميعاً بسبب علاقتنا بجسده، وصرنا متحدين مع الكلمة “ولأننا متحدون مع الله فلن نمكث كثيراً بعد على الأرض، بل كما قال هو نفسه: “حيث يكون هو هناك نكون نحن أيضاً”(63). وعندئذ لن نخاف الحية بعد لأنها أُبطلت بواسطة الجسد بعد أن طردها المخلص عندما سمعتْ “اذهب عنى يا شيطان”(64). و”هكذا طُرد خارج الفردوس وأُلقى في النار الأبدية. ولن تحترس بعد من المرأة التي خدعتنا لأنه في “القيامة لا يُزوجون ولا يَتَزَوجون بل يكونون كالملائكة(65). وستكون خليقة جديدة في المسيح يسوع “حيث ليس ذكر وأنثى”(66). بل سيكون المسيح الكل في الكل(67)، وحيث يكون المسيح فأى خوف أو خطر يكون هناك؟
70- ولكن كل هذا لم يكن ممكناً أن يحدث لو أن الكلمة كان مخلوقاً فالشيطان إذ هو مخلوق فإنه يواصل الحرب دئماً ضد المخلوق، وحيث أن الانسان موجود في وسط هذا الصراع فهو خاضع للموت، إذ ليس له من بواسطته وعن طريقه يتحد بالله لكى يتحرر من كل خوف. ولذلك فإن الحق يوضح أن الكلمة لا ينتمى إلى المخلوقات، بل بالحرى هو نفسه خالقهم. ولذلك فقد لبس الجسد البشرى المخلوق، لكى بعد أن يجدده كخالق فإنه يُؤلَّهه في نفسه، وهكذا يدخلنا جميعاً إلى ملكوت السموات على مثال صورته. لأنه ما كان للإنسان أن يتأله لو أنه اتحد بمخلوق أو لو أن الابن لم يكن إلهاً حقيقياً. وما كان للإنسان أن يقف في حضرة الآب لو لم يكن الذي لبس الجسد هو بالطبيعة كلمته الحقيقى.
وكما أنه لو لم يكن الجسد الذي لبسه الكلمة جسداً بشرياً لما كنا قد تحررنا من الخطيئة واللعنة (حيث أنه في هذه الحالة لا يكون هناك شئ مشترك بيننا وبين ما هو غريب)، هكذا لم يكن للانسان أن يُؤَله لو لم يكن الكلمة الذي صار جسداً هو ابن طبيعى حقيقى وذاتى من الآب. لهذا إذن صار الاتحاد هكذا: أن يتحد ما هو بشرى بالطبيعة بهذا الذي له طبيعة الألوهية، ويصير خلاص الانسان وتأليهه مؤكداً. ولذلك فإن الذين ينكرون أن الابن هو بالطبيعة من الآب وأنه مولوده الذاتى من جوهره، فلينكروا أيضاً أنه قد حصل على جسده البشرى الحقيقى من مريم الدائمة البتولية. لأنه لن يكون لنا نحن البشر أى ربح بعد، إن لم يكن الكلمة هو ابن الله الحقيقى بالطبيعة، وإن لم يكن الجسد الذي إتخذه هو جسد حقيقى. ولكنه بالتأكيد قد إتخذ جسداً حقيقياً برغم ما يهذى به فالنتينوس(68)، ذلك لأن الكلمة هو إله حق بالطبيعة رغم هذيان مجانين الآريوسية. فهو بهذا الجسد قد صار بدء خليقتنا الجديدة لأنه قد خُلِقَ كإنسان لأجلنا وقد كرس لنا ذلك الطريق كما قد كُتب.
71- إذن فالكلمة ليس مخلوقاً، لأن ألفاظ “المخلوق” و”المصنوع” و”العمل” تعنى نفس الشئ. فلو كان “مخلوقاً” لكان أيضاً “مصنوعاً” و”عملاً” لهذا فإنه لم يقل “خلقنى عملاً”، و”صنعنى مع الأعمال” لكى لا يظن من الناحية الأخرى حسب نية الكافرين أنه صار أداة من أجلنا. وأيضاً لم يعلن: “خلقنى قبل الأعمال”، لئلا وهو موجود قبل الكل “كمولود”، وهكذا قيل أيضاً أنه “مخلوق قبل الأعمال”، فإن اللفظ “مولود” واللفظ “خلق” يظهران كأن لهما نفس المعنى. ولكنه قال بتمييز دقيق “من أجل الأعمال” كأنه يقول “الآب صنعنى جسداً لكى أصير إنساناً، حتى يظهر من هذا أيضاً أنه ليس “عملاً”، بل هو “مولود”. لأنه كما أن من يدخل إلى المنزل لا يعتبر جزءاً من المنزل، بل هو مختلف عن المنزل، هكذا من يُخلَق من أجل الأعمال فإنه بالطبيعة مغاير للأعمال.
لأنه لو كان كلمة الله “عملاً” – وفقاً لمعتقداتكم أيها الآريوسيون فبأية “حكمة” إذن وبأية “يد” قد وُجد هو أيضاً؟ لأن كل الكائنات قد وُجدت بيد الله وحكمته. فإن الله نفسه يقول “كل هذه صنعتها يدى”(69). وداود يرتل قائلاً: “منذ البدء يارب أسست الأرض والسموات هي عمل يديك”(70). ويقول ايضاً في المزمور المئة والثانى والأربعين: “تذكرت أياماً قديمة، تأملت في جميع أعمالك، بصنائع يديك كنت أتأمل”(71). إذن فإن كانت يد الله هي التي صنعت الصنائع، وقد كُتِب: “كل الأشياء قد صارت بالكلمة وبغيره لم يكن شئ مما كان”(72)، وأيضاً “رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء”(73)، وأيضاً “فيه يقول الكل”(74)، فإنه من الواضح أن الابن لا يمكن أن يكون “عملاً” ولكنه هو يد الله وحكمته. وقد عرف هذا الذين صاروا شهوداً في بابل أى حنانيا وعزاريا وميصائيل، وهم يدحضون الكفر الآريوسى لأنهم قالوا: “باركى الرب يا جميع أعمال الرب”(75). وقد أعتبروا كل ما في السماء وعلى الأرض والخليقة جمعاء أنها “أعمال” أما الابن فلم يذكروه بين الأعمال لأنهم لم يقولوا “بارك أيها الكلمة وسبحى أيتها الحكمة”. وهذا يوضح أن كل الأشياء غيرهما تسبح وهي “أعمال” أما الابن فلم يذكروه بين الأعمال لأنهم لم يقولوا “بارك أيها الكلمة وسبحى أيتها الحكمة”. وهذا يوضح أن كل الأشياء غيرهما تسبح وهي “أعمال”، أما الكلمة فهو ليس “عملاً” ولا ينتمى إلى الأشياء التي تسبح، بل هو مُسبَّح مع الآب ومعبود ويُعترف به إلهاً لأنه هو كلمة الآب وحكمته وهو خالق “الأعمال”. وقد قال الروح هذا أيضاً في المزامير بتمييز بديع للغاية: “لأن كلمة الرب مستقيمة وكل أعماله موثوق بها”(76)، كما يقول أيضاً في مزمور آخر “ما أعظم أعمالك يارب، كلها صنعتها بحكمة”(77).
72- فلو كان الكلمة “عملاً” فإنه يكون قد وُجد بواسطة الحكمة، ولما ميزه الكتاب عن “الأعمال”، ولما سمى الكتاب تلك “أعمالاً” بينما يبشر به هو أنه كلمة الله وحكمته الذاتية. أما الآن فإن الكتاب إذ يميزه عن “الأعمال” فإنه يوضح أن “الحكمة” هي خالقة “الأعمال” وهي ليست “عملاً”. ونفس هذا التمييز قد استخدمه بولس عندما كتب إلى العبرانيين: “لأن كلمة الله حّى وفعَّال، وأمضى من كل سيف ذى حدين، وخارق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميز لأفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة أمامه، بل كل شئ عريان ومكشوف أمام عينىّ ذاك الذي تقدم له الحساب”(78). لأنه ها هو يدعو الكائنات “خليقة” أماالابن فيعرفه أنه “كلمة الله” الذي هو مختلف عن المخلوقات. وهو يقول أيضاً: “كل شئ عريان ومكشوف أما عينّى ذاك الذي نقدم له الحساب”، وهذا يعنى أنه غير الكائنات.
لهذا إذن فهو الذي يدين، أما كل واحد من الكائنات فهو مسئول أن يقدم حساباً أمامه. وهكذا فإن كل الخليقة تئن معاً من أجل أن تتحرر من عبودية الفساد(79)، وبهذا يظهر أن الابن هو غير المخلوقات لأنه لو كان مخلوقاً لكان واحداً من أولئك الذين يئنون ويحتاج إلى من يعطيه التبنى ويحرره أيضاً مع الكائنات الأخرى. فإن كانت كل الخليقة تئن معاً من أجل التحررمن عبودية الفساد، إلا أن الابن ليس من بين الذين يئنون ولا من بين الذين يحتاجون إلى الحرية، بل هو الذي يعطى التبنى والحرية للجميع كما قال لليهود في تلك الأيام: “العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً”(80). فمن ذلك يصير واضحاً أكثر من النور أن كلمة الله ليس مخلوقاً، بل هو ابن الآب الحقيقى الأصيل بالطبيعة.
إذن فيما يتعلق بالعبارة “الرب خلقنى أول الطرق”، وإن كنا تناولناها بإيجاز فإن هذا يكفى كما أعتقد ليعطى مادة للعارفين لكى يعدوا ردوداص على البدعة الآريوسية. ولكن عندما قرأ الهراطقة الآية المكتوب بعدها: “أسسنى قبل أن يكون الدهر”(81)، أسأوا التفكير بصوصها وظنوا أنه يشير بها إلى ألوهية الكلمة، وليس إلى حضوره الجسدى لذا فمن الضرورى أن نشرح هذه الآية لكى نثبت ضلالهم.
(1) تك 1:1.
(2) مز 73:119.
(3) مز 7:2و 3:101.
(4) مز 2:45.
(5) مت 4:19.
(6) مز 25:102.
(7) مز 2:74.
(8) تك 3: سبعينية.
(8) تث 6:32.
(9) تك 18:32.
(10) تك 26:1.
(11) تك 6:32.
(12) تك 17:32، 18.
(13) اش 2:1.
(14) يو 12:1،13.
(15) انظر اش 3:1.
(16) غل 6:4.
(17) مل 10:2 سبعينية.
(18) أى أن الآب هو أب للابن وليس للخليقة.
(19) أم 22:8.
(20) أم 25:8.
(21) كو 18:1.
(22) يو 6:14.
(23) يو 7:10.
(24) كو 15:1.
(25) يو 14:1.
(26) 1 يو 9:4.
(27) مز 89:119.
(28) يو 1:1.
(29) 1 كو 24:1.
(30) مت 17:3.
(31) مت 16:6.
(32) يو 18:1.
(33) كو 16:1.
(34) أنظر تك 23:35.
(35) رو 29:8.
(36) رو 19:8.
(37) أنظر رو 21:8.
(38) عب 6:1.
(39) انظر 1كو 20:15.
(40) مز 1:119.
(41) مت 8:5.
(42) تك 19:3.
(43) عب 20:10.
(44) 2 كو 17:5.
(45) كو 18:1.
(46) مز 18:102.
(47) أنظر 30:22،31 (رمز 21 بالسبعينية).
(48) تك 17:2.
(49) يو 3:14.
(50) أنظر أف 10:2.
(51) مز 8:138 (مز 137 بالسبعينية).
(52) يو 4:17.
(53) يو 36:5.
(54) أف 27:5.
(55) ميخا 18:7.
(56) تك 19:3.
(57) انظر يو 36:8.
(58) يقصد أن الكلمة هو الذي أصدر حكم الموت “لأنك تراب وإلى التراب تعود”.
(59) يو 5:18.
(60) مت 28:20.
(61) يو 30:14.
(62) 1يو 8:3.
(63) انظر يو 13:14.
(64) مت 10:4.
(65) مت 30:22.
(66) أنظر 28:3.
(67) انظر 1 كو 28:15.
(68) انظر المقالة الأولى ضد الآريوسيين صفحة 104 هامش 75.
(69) اش 2:66.
(70) مز 25:102.
(71) مز 5:143 (142 سبعينية).
(72) أنظر يو 3:1.
(73) 1 كو 6:8.
(74) كو 17:1.
(75) دا 57:3 (سبعينية).
(76) مز 4:33 (سبعينية).
(77) مز 24:104.
(78) عب 12:4،13.
(79) انظر رو 21:8،22.
(80) يو 35:8،36.
(81) أم 23:8.
