تصحيح مفاهيم في البدلية العقابية – ملمح العقوبة – د. أنطون جرجس
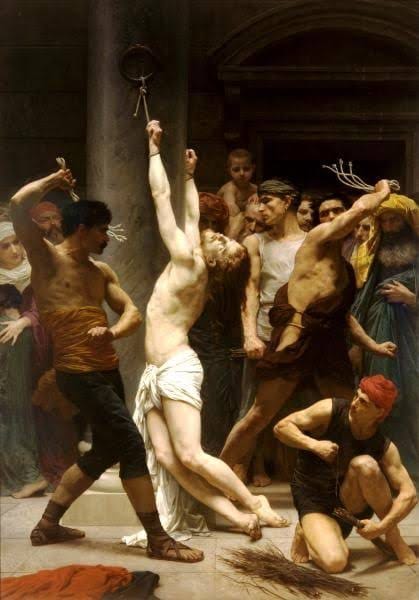
سوف نورد بعض التفسيرات والشروحات الآبائية التي تفسِّر مفهوم العقوبة الإلهية في الكتاب المقدس، وكما فهمها آباء الكنيسة الجامعة كالتالي:
يتحدث العلامة أوريجينوس عن قيمة العقوبة التربوية من الله، وإنها لتقويم وتصحيح الخطاة، وليس المقصود إهلاكهم وفنائهم، حيث يرد على ادعاءات الغنوسيين بقسوة إله العهد القديم وبصلاح ورأفة إله العهد الجديد بحسب زعمهم الباطل بوجود إلهين في الكتاب المقدس بعهديه، يقول:
”ليتهم يخبرون عن فضيلة ففضيلة منكبين على فحص الكتب، فلا يسعوا إلى التملص بقولهم: إنّ الله الذي يجازي كل أحد بحسب أعماله يجازي على السوء بسوءٍ حنقًا منه على الأشرار؛ وإنه لا يبادر الذين أخطئوا وهم في احتياج إلى العناية بهم بأدوية ناجعة، بعلاجٍ يبدو أنه يحمل الألم إليهم في الآن الحاضر لأجل إصلاحهم.
فهم لم يقرأوا ما كُتِبَ عن رجاء الذين لقوا حتفهم في أثناء الطوفان، الرجاء الذي قال عنه بطرس في رسالته الأولى: لقد مات المسيح بحسب الجسد، ولكنه محيي بحسب الروح، وبهذا الروح مضى وبشّر الأرواح المضبوطة في السجن، تلك التي عصت قديمًا إذ كان حلم الله يتأنى، أيام كان نوح يبني الفلك الذي نجا فيه، بالماء، عدد يسير من الناس -ثمانية أنفس بالضبط. وأنتم أيضًا يخلصكم اليوم بالعماد على النحو نفسه.
ويا ليتهم يقولون لنا، في موضوع سدوم وعمورة، هل يعتقدون بصدور الأقوال النبوية عن الله، الذي نُقِلَ عنه أنه أمطر عليهم وابلاً من نار وكبريت! ماذا يقول حزقيال عن هاتين المدينتين؟ ستعود سدوم إلى قديم حالها. فإذ إنه اقتصّ من الذين استحقوا القصاص، ألم يفعل ذلك لمنفعتهم؟ فقد قال مخاطبًا بنت الكلدانيين: عندك حجر، فاقعدي عليه يُثبِك خيرًا.
وفي شأن الذين سقطوا في البرية، ليصغي الزنادقة إلى ما جاء خبره في المزمور 77، منسوبًا بعنوانه إلى آساف: إذ كان يقتلهم كانوا يلتمسونه. لم يق إنّ بعضًا منهم إذ قُتِلوا، كان آخرون يلتمسونه، بل إنّ الذين قُتِلوا قد لقوا حتفهم، بحيث إنهم كانوا يلتمسون الله عندما قضوا نحبهم. فهذا كله يُظهِر أنّ الله العادل والصالح، إله الناموس والأناجيل، إله واحد هو هو نفسه، وأنه يعمل الخير بعدلٍ، ويعاقب بصلاحٍ، إذ ليس الصلاح دون العدل، ولا العدل دون الصلاح، علامة منزلة الطبيعة الإلهية“.
(في المبادئ 2: 5: 3).
يستمر العلامة أوريجينوس بالرد على الغنوسيين وادعاءاتهم الفاسدة بإلهين في الكتاب المقدس في سياق تفسيره لشفاعة موسى وهارون أمام الله أثناء حادثة تمرد قورح وداثان وأبيرام وانتشار الوباء بين العبرانيين (عد16: 46). حيث يُذكِّر العلامة أوريجينوس بلطف الله الذي تمتع به تلاميذ المسيح، لكيلا يتزعزع أحد بتأثير الهراطقة فهم يقولون إنّ رب الشريعة ليس محبًا لكنه عادل، وإن شريعة موسى لا تُعلِّم المحبة بل العدل.
فلينظروا هؤلاء المحاربون لله، والمحاربون للشريعة كيف أنّ موسى نفسه وهارون هذان الرجلان في العهد القديم قد خضعا مقدمًا لتعاليم الإنجيل. موسى “أحب أعداءه وصلى لأجل مضطهديه”. هذا ما علّمته بكل دقة تعاليم المسيح في الأناجيل. لنتعلم حقًا كيف سجدا ووجههما للأرض، وصليا لأجل الثائرين الذين أرادوا أنْ يقتلوهما. إذًا، نجد قوة الإنجيل في الشريعة، ولا تُفهم الأناجيل إلا على أساس الشريعة.
(عظات على سفر العدد 9: 4).
*كما أن هناك مغالطة كبيرة جدًا تقول إن أوريجينوس هو الوحيد الذي تحدث عن العقوبات التأديبية الشفائية وهذا عكس ما سنرى من كتابات أباء الكنيسة كالتالي:
يرى ق. كيرلس الأورشليمي إن الخطية هي شر مرعب للغاية، لكنها ليست بالمرض المستعصي شفائه، هي مرعبة لمَّنْ يلتصق بها، لكن مَنْ يتركها بالتوبة يُشفى منها بسهولة.
(مقالات الموعوظين 2: 1)
ثم يؤكد ق. كيرلس الأورشليمي على عظم محبة الله للبشر، وترفقه وطول أناته الشديدة عليهم من أجل توبتهم، ويُعدِّد أمثلة رحمة ورأفة الله بالخطاة، وتعامله معهم كما يتعامل الطبيب الماهر مع مرضاه، فيذكر طول أناته على جبابرة الأرض الخطاة خمسمائة عامًا يهدّدهم بالطوفان لكي يهبهم مهلة للتوبة، فلو أنهم تابوا لما أخفقوا في التمتع بمحبة الله المترفقة.
ونفس الشيء صنعه الله مع راحاب الزانية الوثنية، ومع هارون عندما أخطأ في حق أخيه موسى، وترفقه بداود الساقط، ورحمته بسليمان وآخاب ملك السامرة، ويربعام الملك عابد الأوثان، ومع منسى الملك الشرير، ومع حزقيا الملك، ومع نبوخذ نصر الملك وغيرهم الكثيرين.
(مقالات الموعوظين 2: 6- 20)
كما يواجه الأورشليميّ هرطقة الغنوسيين القائلين بإلهين في الكتاب المقدس، واحد للعهد القديم والآخر للعهد الجديد، أنَّ الأسفار المقدسة وتعاليم الحق تعرفنا بإله واحد وحده، مدبر كل الأمور بقدرته، يتحمل كثيرًا بإرادته. إنه صاحب سلطان على الوثنيين، وبطول أناته يحتملهم. له سلطان على الهراطقة الذين لا يقيمونه عليهم إلهًا، وبطول أناته يحتملهم.
له سلطان على الشياطين وبطول أناته يحتملهم، ليس لأنه محتاج إلى سلطان كمَّن هو ضعيف، لقد سمح للشياطين أن تعيش لغرضين: لكي تخزي نفسها بنفسها بالأكثر في حربها، ولكي يتكلل البشر بالنصرة. يا لعناية الله الحكيمة! التي تستخدم نية الشرير كأساس لخلاص المؤمنين! لا شيء يفلت من سلطان الله الذي يحكم الكل وبطول أناته يحتمل حتى المجرمين واللصوص والزناة محدّدَا وقتًا معينًا لمجازاة كل أحد، لكن إنْ أصّر مَن يحذّرهم على عدم التوبة من القلب ينالون دينونة عظيمة.
(مقالات الموعوظين 8: 4، 5).
يوضّح ق. غريغوريوس النيسي مفهوم العقوبات الإلهية في سياق تفسيره للضربات العشرة التي حلت بالمصريين إنه يجب ألا نستنتج أنَّ هذه الضربات التي حلت بمَّن يستحقونها جاءت مباشرةً من الله، بل يجب أن نلاحظ أنّ كل إنسان يجلب على نفسه الضربات بإرادته الحرة بسبب ميوله، ويخاطب بولس الرسول مذلة هذا الشخص، قائلاً: “ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبًا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة، الذي يجازي كل واحد حسب أعماله” (رو2: 5)، ويؤكد أيضًا أننا عندما نقول أنّ الانتقام المباشر يحل من الله على مَّن يسيئون استخدام إرادتهم الحرة، فمِن المنطقيّ أنْ نلاحظ أنّ أصل هذه المعاناة وسببها هو في أنفسنا، حيث لا يمكن أنْ يحلّ بنا شر إلا باختيارنا الحر.
(حياة موسى 2: 85- 88).
ينتقد ق. كيرلس عمود الدين القدرية والجبرية وإنزال العقوبات من قِبل الله في سياق حديثه عن ادعاء الشعراء الوثنيين الذين ينسبون المتاعب والشرور والانفعالات لآلهتهم الوثنية، حيث يقول هوميروس في أشعاره إن الإله “ذياس” يتحدث مع آلهة أخرى عن زنى “إيجيستوس” وعن الجزاء الذي يستحقه. ويا للأسف، كيف يتهم البشر الزائلون الآلهة باتهامات ثقيلة، ويقولون إن الشرور تأتي من الآلهة، وهكذا فإن أولئك يتألمون بعصيانهم، وليس من القَدَرَ.
فلأي سبب ينسب البعض للآلهة متاعبهم، ولا ينسبونها إلى أخطائهم التي تسبب لهم النكبات؟ فإذا اختار المرء أنْ يعيش حياة مستقيمة، وتكون حياته مملوءة بالحكمة واللياقة، فإن عليه أن يسلك بثباتٍ متخطيًا الصعاب، وذلك بناءً على قراره الصحيح والمشورة المستقيمة، ولا يترك نفسه أسيرةً للأعمال الشريرة. لأن في مقدورنا أن نرى الاتجاهين، أقصد الخير والشرير.
والذين يقدِّرون الطريق الصحيح سوف يصلون إلى جمال الفضيلة، أما الذين يحبسون أنفسهم في الشر ويفضِّلون الظلم، هؤلاء يفسدون الحياة نفسها، ويكونون هم سبب هلاكٍ لأنفسهم.
(السجود والعبادة بالروح والحق: المقالة 6).
يتحدث ق. كيرلس أيضًا في سياق تفسيره لشريعة القتل في الناموس الموسويّ عن مفهوم العقوبة الإلهية الممزوجة بالمحبة، حيث إذا حدث وقتل شخص أحد عن غير عمد، فإن الناموس يحاكمه بعقوبة الهروب المستمر، إذ يمزج الله هنا العقوبة بمحبته للبشر؛ حيث لا يجعل عقوبة الجريمة التي هي عن غير قصد، في نفس مستوى جرائم العمد، لذلك أمر الناموس أن تُحدَّد ثلاثة مدن اسماها مدن الملجأ لكي يلجأ إليها الذين يرتكبون أخطاءً غير مقصودة.
ويعقد مقارنة بين تلك الشريعة وبين الخطاة الذين أُسِروا بخطاياهم، كأنهم قاتلون لأنفسهم، بالرغم من أنهم انجرفوا إلى هذا الوضع السيء دون إرادتهم، وصاروا مخالفين لله، كما يقول الكتاب: “لأنَّ تصوّر قلب الإنسان شرير منذ حداثته” (تك8: 21). فكما ساد ناموس الشهوة الجسدية غير الملجمة على أعضاء الجسد، هكذا تُعاقب نفس الإنسان التعيسة، بالهرب من العالم ومن الجسد في منفى، كما لو كان في مدينةٍ بعيدةٍ.
وهذا يشير إلى أقسام الأرض السفلى، أي الهاوية التي تنزل إليها النفس بالموت، كما حدث قديمًا، وقضت النفوس أزمنةً هناك، ولكن عندما جاء رئيس الكهنة المسيح ومات من أجل الجميع، ونزل إلى الجحيم، فتح أبوابه، وحرّر النفوس من القيود.
(المرجع السابق: المقالة )
كما يرى ق. كيرلس ضلال عبادة الأوثان عند اليونانيين الذين يختارون الأشجار التي تحمل فروعًا جيدة، وكل غابة كثيفة الظلال ليبنوا فيها هياكل من أجل تقديم ذبائح للشياطين فيها، ويرتّبون بعض المتع العالمية التي تشغل الذهن بسبب الضعف؛ الذي هو المرض الطبيعيّ للمزيفين، الذي يحتاج للعلاج. (المرجع السابق: المقالة 10).
يوضّح القديس إيسيذوروس الفرمي مفهوم العقوبة الإلهية، ويرى أنَّ تقويم وتصحيح الخطايا الذي يقوم به الله لأجل تحسيننا، لا يجب أنْ نسميه غضبًا ولا سخطًا، بل بالحري نُصحًا وموعظةً. لكن لو اعتبره البعض غضبًا، قاصدين بذلك الإعلان عن محبة الله للبشر، فذلك لأنهم يؤمنون بأنَّ الله يتنازل إلى مستوى الأهواء والعواطف بسبب البشر، وصار إنسانًا لأجلهم. (رسالة إلى سلوانس 344)
ويؤكد نفس المفهوم الشفائيّ والتربويّ عن العقوبة الإلهية في موضع آخر، حيث يرى أن الطبيعة الإلهية وغير الدنسة قد أعطتنا كل أمثلة العقوبات مكتوبةً؛ حيث فُرِضَت عن حقٍ للخطايا، حتى بالخوف من الجحيم ذاته، نتجنب الشركة في الأعمال الخاطئة. إذًا، إنْ خاف أحد التأديبات، ليته يحافظ على احترام العقائد. (رسالة إلى الدياكون إيسيذوروس 467).
كما يناقش ق. باسيليوس موضوع الدينونة الإلهية والعقاب، ويفسرها وكأنه يتحدث بلسان حال أيامنا الحاضرة كالتالي:
” الحديث عن الدينونة تكرر في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس، باعتباره أمر ملزم، وقادر أن يحفظ أولئك الذين آمنوا بالله في المسيح يسوع في تعليم التقوى. ولأن الكلام عن الدينونة قد كُتب بطرق مختلفة، فمن الواضح أنه أحدث التباسًا لدى أولئك الذين لا يميزون المعنى بدقة. […] ولكن من الواضح أن كلمة “أدان” نتقابل معها في الكتاب المقدس، تارة بمعنى “أُجرب”، وتارة أخرى بمعنى “أحكم على نفسي” […]
وقيل أيضًا إن الرب سيدين أو سيجازي كل إنسان، أو يحاسب كل إنسان، أي عندما يفحص الله كل إنسان، سيضع ذلك الإنسان نفسه في مواجهة الدينونة أو القضاء، وسيضع الله مقابل وصاياه أعمال أولئك الذين أخطأوا. وسيبين في دفاعه أن كل ما كان منوط به عمله لأجل خلاص جميع المدانين، فهذا قد عمله وتممه، حتى يقتنع ويثق الخطاة أنهم مذنبين، بسبب ما ارتكبوه من خطايا، وبعدما يقبلون بالقضاء الإلهي، سيقبلون العقوبة المفروضة عليهم بإرادتهم“
(عظات على المزامير 2: 4).
ويستطرد ق. باسيليوس في نفس السياق موضحًا معنى العقوبة الإلهية كالتالي:
” فالمجاعات والسيول هي نكبات مشتركة تأتي على المدن والأمم لكي توقف وتحجّم فعل الشر المتفاقم. إذًا مثلما نصف الطبيب دائمًا بأنه محسن وكريم حتى لو تسبب في إيلام الجسد أو النفس (لأنه يحارب المرض وليس المريض) هكذا الله هو صالح يدبر الخلاص من خلال محصلة بعض الإجراءات“ (عظة الله ليس علة الشر).
كما يشرح ق. غريغوريوس اللاهوتي النزينزي معنى العقاب والدينونة الإلهية كظلمة وعمى روحيين وانفصال عن التنعم بمعاينة الله كالتالي:
” فآمن أنت يا هذا بالقيامة والدينونة والمجازاة العادلة من عند الله. وافهم هذه المجازاة على أنها نور للمطهرين في أذهانهم أعني أنهم سيرون الله وسيعرفونه كل واحد على قدر الطهارة التي هو فيها، وهو ما نسميه “الملكوت السماوي”. وافهم أيضًا أن العقاب إنما هو ظلمة للذين عموا وضلوا عن جادة الحق والصواب. أي تغرب عن الله هو بنسبة ما عندنا هنا من العمى“ (عظة المعمودية والمعمدون).
كما ينقل ق. يوحنا كاسيان رأي الأب ثيؤدور عن مفهوم العقوبة الإلهية كعقوبة تأديبية شفائية كالتالي:
” اعتاد الكتاب المقدس أن يستخدم بعض التعبيرات في غير معناها الأصلي. فيستخدم كلمة “الشرور” عن “الأحزان والضيقات” ليس لأنها شر، أو طبيعتها شريرة، بل لأن مَن تحل بهم هذه الأمور لأجل صالحهم يعتبرونها شرًا. فحينما يتحدث الحكم الإلهي مع البشر، يتكلم معهم حسب لغتهم ومشاعرهم البشرية.
فالطبيب يقوم بقطع أو كي الذين يعانون من القروح لأجل سلامة صحتهم، ومع هذا يراه مَن لا يقدرون على احتماله أنه شر. والمنخاس أو السوط يكون مفيدًا للحصان الجموح. والتأديب يُعتبر مرًا بالنسبة للمؤدبين، إذ يقول الرسول: “ولكن كل تأديب في الحاضر لا يُرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرًا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر السلام” (عب12: 11)، “الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟!” (عب12: 6، 7)“
(المناظرات 6: 6).
