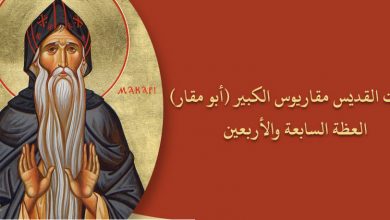ضد الأريوسين م1 – أثناسيوس الرسولي
ضد الأريوسين م1 – أثناسيوس الرسولي
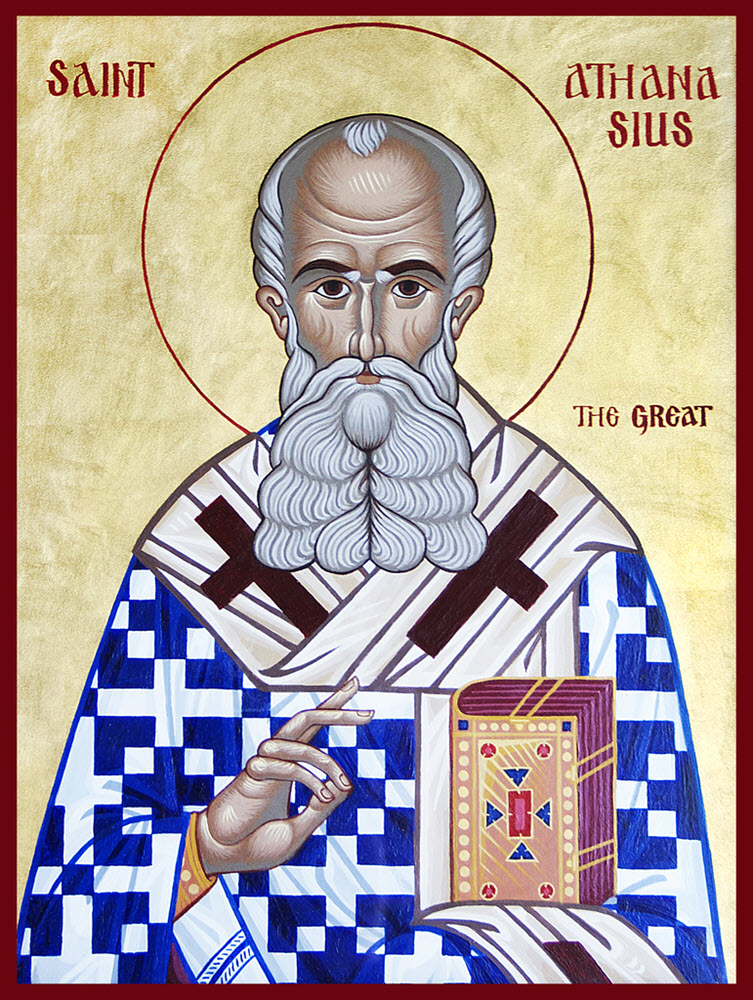
الفصل الأول: مقدمة
سبب الكتابة:
1ـ بقدر ما نأت وابتعدت الهرطقات عن الحقيقة، بقدر ذلك ابتدعت واستنبطت لنفسها جنونا وخبلاً بات جليًا واضحًا. وصار كفر وتجديف هؤلاء الناس ظاهرًا بينا للجميع منذ القدم. لأن خروج الذين ابتدعوا أمور الخداع هذه، عنا ـ من الممكن أن نثبته ونوضّحه كما كتب المغبوط يوحنا (1يو19:2)، فان فكر مثل هؤلاء القوم لم يكن له وجود قط قبل ذلك، كما أنه لا يتفق مع ما نعتقده نحن الآن ونؤمن به. ولذلك أيضًا فكما يقول المخلّص، فإن الذين لا يجمعون معنا هم يفرقون مع الشيطان (لو23:11)، متعقبين النائمين، حتى إذا نفثوا فيهم سمهم المهلك يضمنون أنه يشركونهم معهم في الموت.
وحيث إن واحدة من الهرطقات، وهي الهرطقة الأخيرة ـ التي ظهرت الآن كتمهيد لضد المسيح (المسيح الدجال) ـ وهي التي ـ تسمى الآريوسية، وإذ هي باطلة وخبيثة وماكرة، فقد لاحظت أن اخواتها من الهرطقات الأخرى الأقدم منها، قد فُضِحت جهارًا، ولذلك فإنها ـ مثل أبيها ـ الشيطان ـ تظاهرت بلبس كلمات الكتاب المقدس، لتحاول الدخول مرة أخرى إلى فردوس الكنيسة لكي تظهر كأنها تعاليم مسيحيّة بغير وجه حق، وأن تخدع البعض لكي يفكروا ضد المسيح، معتمدة على أباطيلها الزائفة. إذ ليس فيها شيء من الصواب.
وها هي قد أغرت بعض الحمقى من هؤلاء الذين لم يهلكوا فقط بالسماع بل أيضًا ـ مثل حواء ـ أخذوا وتذوقوا، حتى أنهم ـ بسبب جهلهم وعدم درايتهم صاروا يعتبرون المر حلوا (إش2:5) وأخذوا يطلقون على هرطقتهم الشنيعة أنها حسنة. ولهذا أعتقدت ـ بعد أن طلبتم منى ـ أنه صار ضروريًا أن أحطم قوّة درع هذه الهرطقة الدنسة، وأن اكشف عن نتانة حماقتها، وعفن وقاحتها، لكي يتجنبها الذين ما زالوا بعيدين عن هذه البدعة، وأيضًا لكي يندم الذين خدعوا بها، فيتوبوا. ولكي يدركوا بعيون قلوبهم المفتوحة أنه كما أن الظلام لي نورا، والكذب ليس حقيقة، هكذا فليست الآريوسية بدعة حسنة، لكن بعض هؤلاء أيضًا الذين يسمون مسيحيين، كثيرًا ما يُخد\عون لأنهم لا يقرأون الكتب المقدسة، ولا يعرفون المسيحية قط، ولا يدركون الإيمان بها.
الآريوسية مختلفة تمامًا عن الإيمان الحقيقى:
2ـ أى شبه رآه هؤلاء إذن، بين هذه البدعة وبين الإيمان الحقيقى. حتى أنهم يقولون بأنه لا يوجد شيء رديء فيما يعلّمه أولئك (المبتدعون)؟ ومعنى هذا في الحقيقة، أنهم يعتبرون قيافا مسيحيًا. وأيضًا لا يزالون يحسبون يهوذا الخائن بين الرسل، ويقولون عن أولئك الذين طالبوا بإطلاق سراح باراباس بدلاً من المخلص، أنهم ما اقترفوا أى أثم، وهم يمدحون هيمينايس والاسكندر(1) على أن اعتقادهما قويم، ويعتبرون أن الرسول يكذب بخصوصهما.
إلا أن هذه الأشياء لا يستطيع أن يحتمل المسيحى سماعها، كما أن ذلك الذي يجرؤ أن يتحدّث بمثل هذه الأقوال، لا يمكن إعتباره سليم العقل والإدراك.
فبالنسبة للآريوسيين يُعتبر آريوس لديهم بدلاً من المسيح، مثل مانى عند المانويين، وفى مقابل موسى والقديسين الأخرين عندهم سوتيادس(2) الذي كان يهزأ بالامميين (الوثنيين). وكذلك ابنة هيروديا(3). لأن آريوس وهو يكتب الثاليا(4). كان يقلّد الأسلوب النسائى المنسوب إلى سوتيادس. وكما أبهرت ابنة هيروديا هيرودس برقصها، كذلك أريوس سخّر الرقص واللهو في التشهير والافتراء على المخلّص.. وهو قد فعل هذا. من ناحية لكي يموّه ويضلّل عقول هؤلاء الذين انغمسوا في الهرطقة لدرجة الجنون. ومن ناحية أخرى لكي يبدّل اسم رب المجد إلى شبه صورة إنسان زائل (رو23:1). وهكذا يتخذ مشايعوه اسم الآريوسيين بدلاً من لقب المسيحيين ويكون هذا دليلاً قاطعًا على كفرهم.
الآريوسيون ليسو مسيحيين:
فلا تدعهم إذن يجدون لأنفسهم عذرًا. ولا تدعهم يتهكّمون مفترين على هؤلاء الذين هم ليسوا في الحقيقى مثلهم. فيسمون المسيحيين بأسماء معلّميهم، لكي يظهروا هم أيضًا بهذه الطريقة أنهم مسيحيون(5). ومرّة أخرى لا تدعهم يمزحون، وهم يستحون من اسمهم الذي جلب عليهم مثل هذا العار والخزى، فلو كانوا حقًا يخجلون فليغطوا عريهم. أو فليتنحوا عن ضلالهم. لأنه لم يحدث قط في أى وقت، أن أتخذ الشعب المسيح أسماء أساقفتهم ليكونوا تابعين لهم، بل اتخذوا اسم الرب وحده الذي به نؤمن. ولذلك فنحن أيضًا الذين اتخذنا تعاليمنا من الرسل المغبوطين الذين خدموا انجيل المخلّص، فإننا لم ننتسب إلى أسمهم ولم نُدَعَ به، بل نُسمى فقط باسم المسيح، لذلك فنحن مسيحيون وهذا هو لقبنا.
أما أولئك الذين ينتمون إلى آخرين ويأخذون منهم العقيدة التي يعترفون بها، فإنهم من الطبيعى بالنسبة لهم أن يحملوا أسماءهم أيضًا، لأنهم قد صاروا مِلكًا لهؤلاء المعلّمين.
3ـ وحيث إن لنا الإيمان اليقيني بالمسيح، لذلك فأننا ندعى مسيحيين. وقديمًا عندما طُرِدَ ماركيون وألقى بعيدًا لأنه ابتدع الهرطقة، فإن هؤلاء الذين كانوا معه ورفضوه عندما حرم من الكنيسة ظلوا مسيحيين، في حين أن الذين تبعوا مركيون وشايعوه لم يسموا بعد مسيحيين بل لقبوا ماركيونيين. وهكذا أيضًا فالنتينوس وباسيليدس ومانى وسيمون الساحر، فأنهم نقلوا وأعطوا لأتباعهم أسماءهم الخاصة، ولذلك صار البعض يلقبون فالنتينيين والبعض الآخر باسيليديين وآخرين سيمونيين، والبعض الآخر الذين هم من فريجيا لقبوا فريجيين، والذين من نوفاتيس نوفاتيين.
وهكذا أيضًا ميليتيوس عندما طرده وحَرَمَه بطرس الأسقف والشهيد، لم يعد يطلق على أتباعه اسم مسيحيين بل ميليتيين. وهكذا فقد حدث نفس الشئ أيضًا حينما حَرَمَ ألكسندروس المطوّب الذكر آريوس، فإن الذين ظلوا مع الكسندروس بقوا مسيحيين أما الذين خرجوا منشقين مع آريوس، فإنهم تخلّوا ـ لنا نحن الذين بقينا مع الكسندروس ـ عن اسم المسيح ومن ثم أُطلِقَ على أولئك اسم الآريوسيين. وها هو الآن بعد موت الكسندروس، فإن الذين لهم شركة مع خليفته أثناسيوس، وأولئك الذين ارتبط أثناسيوس نفسه معهم في الشركة الكنسيّة لهم نفس الميزة.
فإن أحدًا من أولئك لم يطلق عليه اسم أثناسيوس، كما أن أثناسيوس لم يطلق عليه اسم أى واحد من أولئك المرتبطين به، ولكنهم ـ وفقًا للوضع المألوف ـ يسمون جميعًا مسيحيين. لأنه وإن كان لدينا سلسلة متتابعة من خلفاء المعلّمين … وقد صرنا نحن تلاميذ هؤلاء، ولكن حيث إننا نتعلّم منهم أمور المسيح وكل ما يختص به، لذلك فمما لا شك فيه، فأننا مسيحيون وهكذا ندعى. أما أولئك الذين يتبعون الهراطقة، فحتى لو كان لديهم آلاف الخلفاء، فأنهم حتمًا يتخذون لهم اسم مَنْ ابتدع الهرطقة، وهكذا فإنه حتى بعد أن مات آريوس، رغم أن عددًا كبيرًا خلفه في هرطقته، إلاّ أن هؤلاء الذين اعتقدوا بتعاليم ذلك الرجل والمعروفين بمشايعتهم لآريوس، فإنهم يسمون آريوسيون.
والبرهان العجيب على هذا، أن أولئك الوثنيين الذين دخلوا الى الكنيسة ـ ولا يزالون يدخلون فيها حتى الآن، فإذ يهجرون ضلالة الأوثان، فأنهم لا يدعون بأسماء الذين علّموهم أصول الإيمان، بل يدعون باسم المخلّص، وصاروا يدعون باسم المخلص، وصاروا مسيحيين بدلاً من وثنيين، بينما أولئك الذين ينضمون إلى الهراطقة. والذين يتركون الكنيسة ويتبعون الهراطقة، فإنهم يهجرون اسم المسيح، وتبعًا لذلك يتخذون اسم الآريوسيين، إذ لم يعد لهم إيمان بالمسيح قد، بل صاروا خلفاء لجنون آريوس وخَبَله.
4ـ كيف يمكن إذن أن يكونوا مسيحيين أولئك الذين هم ليسوا بمسيحيين بل هم مجانين الآريوسية؟ أو كيف ينتمي هؤلاء الى الكنيسة الجامعة، وهم قد انفضّوا عن الإيمان الرسولى ونبذوه وصاروا مبتدعين شرورًا جديدة، وبعد أن نبذوا أقوال الكتابات الالهية، فأنهم يسمون ثاليا آريوس حكمة جديدة؟ وما يقولونه يُثبت حقًا أنهم يبشرون بهرطقة جديدة. ولهذا السبب أيضًا فإن الانسان ليدهش، أنه في حين أن كثيرين كتبوا مؤلفات كثيرة وعظات أكثر عددًا حول العهدين القديم والجديد، فليس في أى منها شيء مما ابتدعته كتاب الثاليا، بل حتى لا يوجد شيء منه عند كبار الأمميين وعظمائهم… ولكنها موجودة فقط بين أولئك الذين ينشدون ويتغنّون وهم ثمالى وسكارى بين قرقعة الكؤوس والصخب والسخريّة أثناء عبثهم ولهوهم ليثيروا ضحك الآخرين.
إن آريوس الغريب، في الواقع لم يقلّد أحدًا وقورًا، وإذ كان يجهل كتابات الرجال الوقورين من عظماء القوم، فإنه كان يختلس كثيرًا من الهرطقات الأخرى. ولا يوجد له منافس في مجال الهزل والسخرية غير سوتيادس وحده. لأنه ماذا كان في وسعه أن يعمل سوى أن يرغب في التحوّل ضد المخلّص، بأناشيده الراقصة، معبرًا بثرثرته المموقتة وطنطنته البغيضة عن كفره وإلحاده، مستخدمًا في ذلك رخامة ألحانه المنحرفة الفاسقة؟ وهذا كي يتأكد ويتضح فساد ما كتبه من تلك الأقوال التي تتضح بعد نضح الروح وفساد الذهن، وذلك كما تقول الحكمة تمامًا “يُعرف المرء من الكلمة الصادرة عنه” (انظر ابن سيراخ 29:19) ولأن الضلال لم يكن سهوا، بل هو متعدّد الوجوه، ومُتَعمَد أيضًا، فهو مثل الثعبان الذي يلتف حول نفسه صاعدًا هابطًا، ولكنه ـ (أى آريوس) قد سقط في ضلال الفريسيين عندما أرادوا مخالفة الشريعة، فأنهم تظاهروا بأنهم غيورون على أقوال الناموس، وعندما أرادوا إنكار ألوهية الرب المنتظر، بينما كان هو نفسه حاضرًا بينهم… فإنهم إدعوا بأنهم يستشهدون بالله، ولكنه أثبتوا بذلك أنهم يجدّفون بقولهم: ” لماذا وأنت إنسان تجعل نفسك إلهًا” (يو33:10)، وتقول “أنا والآب معا واحد”. هكذا أيضًا آريوس المزيّف والذي حذا حذو سوتيادس، فإنه يزعم أنه يتحدّث عن الله، مستخدمًا كلمات الكتاب المقدس، ولكنه أثبت من كل النواحى أنه كافر وذلك بإنكاره الابن، معتبرًا أياه من بين المخلوقات.
الفصل الثانى: مقتطفات من ثاليا أريوس
5ـ إن بدء ثاليا آريوس عبارة عن أقوال ركيكة جوفاء. وقد أتخذت لها أسلوبًا أنثويا وهي هكذا: حسب إيمان مختاري الله الذين لهم أدراك ووعى بالله من الرجال القديسين الذين يتصّفون بالعقائد المستقيمة، هؤلاء الذين حصلوا على روح الله القدوس. وأنا على الأقل تعلّمت هذه الأمور من أناس لهم نصيب كبير من الحكمة، أناس مدهشون من المعلّمين لأمور الله، وعمومًا فإنهم يعتبرون من الحكماء. وقد أقتفيت أنا آثار هؤلاء وسرت على دربهم.
وها أنا أسير في نفس الطريق، معلّمًا لنفس هذه المبادئ، أنا الذائع الصيت، ولقد عانيت الكثير لأجل مجد الله، وعرفت الحكمة والمعرفة، وهي التعاليم المستقاه من الله، أن مثل هذه الثرثرة الجوفاء التي يتشدّق بها في ثاليا، والتي ينبغى تجنبها والابتعاد عنها، إذ هي مليئة بالكفر والضلال، إذ قد جاء فيها ” لم يكن الله أبًا في كل حين ” بل كان هناك وقت حين كان الله وحده، ولم يكن أبًا بعد، بل قد صار أبًا فيما بعد… والابن لم يكن موجودًا دائمًا. لأن كل الأشياء قد خلقت من العدم، وكان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجودًا، ولم يكن له وجود قبل أن يصير، بل هو نفسه كان له بداية تكوين وخلقة ويقول: ” لأن الله كان وحده؛ ولم يكن هناك الكلمة والحكمة بعد..
من ثم فعندما أراد الله أن يخلقنا، فإنه عندئذ قام بصنع كائن ما وسماه اللوغوس والحكمة والابن، كي يخلقنا بواسطته ” ولذلك فهو يقول إن هناك حكمتان: الأولى مستقلة وموجودة مع الله. أما الابن فقد جاء من خلال هذه الحكمة الأولى، وقد سمى الحكمة والكلمة بسبب اشتراكه فقد في هذه الحكمة الأولى، لأنه يقول ” إن الحكمة جاء إلى الوجود بواسطة الحكمة بمشيئة الله الحكيم “.
وهكذا يقول أيضًا: ” إنه توجد كلمة أخرى في الله غير الابن. وأيضًا إن الابن قد سمى كلمة وابنًا بسبب مشاركته للكلمة حسب النعمة “.
وهذا التعليم أيضًا إنما هو أحد الأفكار الخاصة بهرطقتهم كما يتضح من مؤلفاتهم الأخرى. ” أنه توجد قوات كثيرة، أحداها هي قوّة الله ذاته بحسب طبيعته الذاتية الأبدية. أما المسيح فليس هو قوّة الله الحقيقية، بل أنه هو أيضًا قوة من تلك التي تدعى قوات. والتى تعتبر احداها هي قوّة الله ذاته بحسب طبيعته الذاتية الأبدية، أما المسيح فليس هو قوّة الله الحقيقية، بل أنه هو أيضًا قوّة من تلك التي تدعى قوّات، والتى تعتبر احداها أيضًا “الجرادة” و “الدودة”. وهي ليست قوّة وحسب بل أعلن عنها أيضًا أنها قوّة عظيمة(6). أما القوات الأخرى المتعددة فهى مثل الابن.
وأن داود أنشد عنها بقوله: “ربّ القوات” (مز10:24). والكلمة نفسه أيضًا، مثل كل القوات، متغيّر بحسب طبيعته، ويبقى صالحًا بإرادته الحرّة ـ الى أى وقت يريده، ولكنه حينما يريد، فإنه يستطيع أن يتحوّل مثلنا، إذ أنه ذو طبيعة متغيّرة. ويقول أيضًا “بما أن الله عرف بسبق علمه. بأن الكلمة سيكون صالحًا فقد منحه هذا المجد، مقدما والذي حصل عليه بعد ذلك. كإنسان، بسبب الفضيلة، ولهذا فإن الله ـ بسبب أعماله التي كان يعرفها بسبق علمه أنها سَتُعمَل ـ خلقه بمثل هذه الصورة التي صار عليها الآن”.
6ـ بل أنه تجاسر مرّة أخرى أن يقول ” الكلمة ليس إلهًا حقيقيًا، وحتى إن كان يدعى إلهًا لكنه ليس إلهًا حقيقيًا. وإنما هو إله بمشاركة النعمة مثل جميع الآخرين، وهكذا فإنه يسمى إلهًا بالاسم فقط. وكما أن جميع الكائنات غريبة عن طبيعة الله ومختلفة عنه في الجوهر. هكذا الكلمة أيضًا يعتبر غريبًا عن جوهر الآب وذاتيته ومختلفًا عنه، بل هو ينتمي إلى الأشاء المخلوقة والمصنوعة. وهو نفسه أحد هذه المخلوقات “.
وفضلاً عن ذلك، فإنه كما لو كان قد صار خليقة للشيطان ووارثًا لتهوّره ووقاحته، فقد ذكر في “الثاليا” ما يلي: “وحتى الابن فإنه لا يرى الآب” وأن “الكلمة لا يستطيع أن يرى أو أن يعرف أباه تمامًا بصورة كاملة. ولكن ما يعرفه وما يراه، فإنه يعرفه ويراه بقدر طاقته الذاتية، مثلما نعرف نحن أيضًا بقدر طاقتنا الذاتية”. كما يقول “إن الابن ليس فقط لا يعرف تمام المعرفة، إذ هو يعجز عن هذا الإدراك، بل أن الابن نفسه لا يعرف حتى جوهره الخاص به. وأن كل من الآب والابن والروح القدس، جوهره منفصل عن الآخر حسب الطبيعة. وأنهم مقسمون ومتباعدون وغرباء عن بعضهم البعض، وليس لهم شركة أحدهم مع الآخر، إذ يدّعى هو نفسه “أنهم غير متشابهين تمامًا في الجوهر والمجد بلا نهاية”. ويقول ” إنه فيما يتعلق بتشابه المجد والجوهر. فإن الكلمة يعتبر مختلفًا تمامًا عن كل من الآب والروح القدس “.
وهكذا بمثل هذه الكلمات يزعم ذلك العديم التقوى أن ” الابن منفصل بذاته وليس له شركة مع الآب إطلاقًا “. هذه مقتطفات من النصوص الأسطورية كما جاءت في كتابات آريوس الهزلية.
7ـ فمن هو الذي يسمع مثل هذه الأقوال، ومثل هذا النغم في الثاليا، ولا يبغض آريوس وهو يقوم بتمثيليته هذه؟ وبينما هو يدعو باسم الله ويتحدث عنه، فمن لا يعتبر هذا الرجل مثل الحيّة التي قدّمت المشورة للمرأة؟ ومن لا يرى ـ وهو يقرأ ما كتبه ـ تجديفه وتضليله، مثلما فعلت الحيّة وهي تحاول إغواء المرأة؟ فمن لا يفزع من هول هذه التجاديف؟ فكما يقول النبى ” السماء تنذهل، والأرض تقشعر ” (إر12:2) من جراء التعدى على الشريعة. أما الشمس فإذ لم تحتمل تلك الاهانات المثيرة التي وقعت على جسد الرب المشترك لنا جميعًا. والتى احتملها هو نفسه من أجلنا بإرادته. فإنها أستدارت وحجبت أشعتها. وصار ذلك اليوم بلا شمس وأزاء تجديفات آريوس، كيف لا تتمرد حياة البشريّة فتصاب بعدم النطق، فيصمون آذانهم، ويغلقون عيونهم، هربًا من سماع هذه التجديفات. ومن رؤية وجه كاتبها؟
وبالأحرى كيف لا يصرخ الرّب ذاته ضد هؤلاء العديمى التقوى، بل والجاحدين أيضًا. بتلك الكلمات التي سبق ونطق بها على لسان هوشع النبى ” ويل لهؤلاء لأنهم هربوا عنى. بالشقاوتهم لأنهم إذنبوا إليّ. أنا افتديتهم لكنهم تكلموا على بالكذب ” (هو13:7). وبعد ذلك بقليل ” وهم يفكرون عليّ بالشر “. ” وعادوا الى العدم ” (هو16:7س)؟
لأنهم بعد أن أبتعدوا عن كلمة الله الذي هو كائن، ابتكروا لأنفسهم ما هو غير كائن. فسقطوا في العدم. ومن أجل ذلك السبب أيضًا، فإن المجمع المسكونى(7). طرد، أريوس الذي علّم بهذه الأمور، من الكنيسة وحَرَمَه، إذ لم يحتمل المجمع كفره وجحوده. ومنذ ذلك الحين، فقد أعتبر ضلال آريوس، هرطقة تفوق سائر الهرطقات، حيث لُقِبض بعدو المسيح، وممهدًا للمسيح الدجال.
ولكن رغم أن هذا الحكم ضد الآريوسية، يعتبر في ذاته كاف جدًا لأن يجعل الناس يهربون بعيدًا عن هذه الهرطقة الكافرة، إلاّ أنه، كما سبق أن قلت، يوجد البعض من الذين يُدعَون مسيحيين، يعتبرون ـ عن جهل أو عن تظاهر بالجهل ـ أن هذه الهرطقة لا تختلف إلا قليلاً عن الحق، ولذلك يسمون الذين يعترفون بها، مسيحيين.
لذلك هيا بنا إذن بكل ما عندنا من جهد. لنكشف القناع عن حيل الأريوسية وخداعها. بأن نضع أمامهم بعض أسئلة، فبعد أن تدحض آراؤها، فأنهم سينفضّون من حولها ويهربون كما لو كانوا يهربون من وجه أفعى.
الفصل الثالث: خطورة الموضوع
8ـ فلو أن استعمالهم لبعض كلمات من الكتاب الإلهى، في الثاليا، يحوّل ـ بحسب ظنهم ـ التجديف والكفر الذي في الثاليا الى كلمات مديح وثناء، فإنهم حينما يرون يهود هذه الأيام وهم يقرأون الشريعة والأنبياء. فبلا شك ـ يلزمهم على هذا الأساس أن ينكروا المسيح مثل أولئك اليهود. وربما لو استمعوا إلى المانويين وهم يترنّمون ببعض مقتطفات من الإنجيل، فإنه سينكرون مثلهم الشريعة والأنبياء.
فإن كانوا يتململون ويثرثرون هكذا، بسبب جهلهم.. إذن فليعلموا من الكتب المقدسة، أن الشيطان ـ وهو مبتكر الهرطقات ومؤلفها ـ يستعير أقوال الكتب المقدسة كغطاء يتستر من ورائه لكي ينفث سمومه الخاصة به ليخدع البسطاء. وذلك ليخفى الرائحة العفنة الكريهة الكامنة في شرّه الخاص. وهكذا خدع حواء، وهكذا حاك الهرطقات الأخرى، وهكذا الآن أيضًا فإنه حث أريوس لكي يدعى أنه يحتج ضد الهراطقة ويقاومهم. وبهذه الطريقة فإنه يدخل هرطقته هو في غفلة من الجميع.
ومع ذلك فإن هذا الداهية الخبيث لم يتمكن من الإفلات. فلأنه كفر بالله الكلمة. فإنه أفرغ كل من لديه في الحال، وانكشف أمام الجميع جهله بالهرطقات الأخرى أيضًا، وأنه لم يكن في عقيدته أى شيء مستقيم، ولذلك كان ينافق ويراءى.
لأنه كيف يمكن أن يتكلّم بإستقامة عن الآب، وهو ينكر الابن الذي يكشف الآب ويعلنه؟ أو كيف يمكن أن يعتقد اعتقادًا قويما فيما يخص الروح القدس، بينما هو يفترى على الكلمة الذي يهب الروح ويعطيه؟ ومن سيثق به عندما يتحدّث عن القيامة، ما دام هو شخصيًا ينكر المسيح، الذي صار البكر من الأموات، من أجلنا (كو19:1)؟ وكيف لن ينخدع فيما يخص حضوره بالجسد، وهو يجهل كليّة الميلاد الحقيقى للابن من الآب؟ فإنه هكذا أيضًا حدث مع اليهود حينما أنكروا الكلمة وقالوا ” ليس لنا ملك إلاّ قيصر ” (يو15:19)، فإنهم فقدوا كل شيء دفعة واحدة وبقوا بدون نور المصباح.
وبدون رائحة الطيب، وبدون معرفة النبوّة، وبدون الحق ذاته، وهم حتى الآن، لا يفهمون شيئًا، كمن يسيرون في الظلام. لأنه مَنْ سمع بمثل هذه التعاليم في أى عصر من العصور حتى الآن. أو من أين أو ممن سمع هؤلاء هذه الأمور، أولئك المنافقون والمأجورون لنشر الهرطقة؟ ومَنْ علّم هؤلاء مثل هذه العقيدة حينما كانوا يلقنونهم دروس الدين؟ ومَنْ قال لهم بعد أن انصرفوا عن عبادة الخليقة، أن تعالوا من جديد لتعبدوا المخلوق والمصنوع؟ وإن كان هؤلاء أنفسهم يعترفون بأنهم قد سمعوا بمثل هذه التعاليم لأول مرّة الآن، فليكفوا إذن عن عن إنكارهم بأن هذه الهرطقة إنما هي غريبة، ولم يتسلّموها عن الآباء.
والذي لم يأت من الآباء بل أبتدع الآن، فأى شيء آخر يمكن أن يكون، سوى ما تنبأ به المغبوط بولس ” في الأزمنة الأخيرة ينحرف البعض عن الايمان القويم تابعين أرواحًا مضلّة وتعاليم شياطين في نفاق الكذابين الموسومة ضمائرهم الذاتية “. (1تى1:4، 2،14) وأيضًا “مرتدين عن الحق”.
الإيمان الصحيح عن الابن:
9ـ ها نحن إذن نتحدّث بحريّة عن الإيمان الصحيح النابع من الكتب الإلهية، ونضع هذا الإيمان كسراج على المنارة فنقول: ابن حقيقي حسب الطبيعة للآب ومن نفس جوهره، وهو الحكمة وحيد الجنس وهو الكلمة الحقيقى الوحيد لله. وهو ليس مخلوقًا ولا مصنوعًا، ولكنه مولود حقيقي من ذات جوهر الآب، ولهذا فهو إله حق إذ أنه واحد في الجوهر ὁμοόυσιος مع الآب الحقيقى.
أما بالنسبة للكائنات الآخرى. التي قال لها: ” أنا قلت: أنتم آلهة ” (مز6:8)، فإنها حصلت على هذه النعمة من الآب وذلك فقط بمشاركتها للكلمة عن طريق الروح القدس. لأنه هو رسم جوهر الآب هو نور من نور، وهو قوّة وصورة حقيقية لجوهر الآب. لأن هذا ما قاله الرب أيضًا: ” من رآنى فقد رآى الآب ” (يو9:14). فهو كان موجودًا دائما، وهو كائن كل حين، ولم يكن قط غير موجود، وكما أن الآب أزلى، هكذا أيضًا فإن كلمته وحكمته يجب أن يكون أزليًا.
ثم فلنر إذن ما يتشدّق به هؤلاء مما يقدّمونه لنا من مزاعم مما جاء في الثاليا الذميمة؟
دعهم أولاً يقرأونها مقلّدين أسلوب كاتبها، كي يتعلّموا ـ حتى وإن كانوا يسخرون من الآخرين ـ إلى أى ضلال قد انحدروا. وبعد ذلك فليقولوا، ولكن ماذا في وسعهم أن يقولوا منه سوى: ” إن الله لم يكن دائمًا أبًا. ولكنه صار أبًا فيما بعد. والابن لم يكن موجودًا دائمًا، لأنه لم يكن موجودًا قبل أن يولد، وأنه ليس من الآب، ولكنه هو أيضًا خُلِقَ من العدم، وهو ليس من نفس جوهر الآب لأنه مخلوق ومصنوع “؟ وأن ” المسيح لم يكن إلهًا حقيقيًا، بل هو نفسه صار الهًا بالمشاركة.
والابن لم يعرف الآب معرفة تامة، والكلمة لم ير أباه بصورة كاملة. والكلمة لم يفهم ولم يعرف أباه على وجه الدقة. ولم يكن هو نفسه. الكلمة الحقيقى الوحيد للآب، ولكن بالأسم فقط يدعى كلمة وحكمة، وهو بالنعمة فقط يدعى ابنًا وقوة. وهو ليس غير قابل للتغير مثل الآب، ولكنه متغيّر بالطبيعة كالمخلوقات. وهو قاصر عن إدراك معرفة الآب إدراكًا كاملاً “.
غريب أمر هذه الهرطقة حقًا، إذ ليس هناك أى احتمال في استقامة تعاليمها، بل هي تتخيّل أنه لا وجود لذلك الذي له وجود في الواقع، بل تنشر على الملأ مهاترات كفرية تمامًا بدلاً من الأقوال الورعة التقيّة. إذن، إن قام أحد الناس بالتصدى لبحث تعاليم الفريقين وتساءل إلى إيمان أى منهما ينحاز وأى منهما يتكلّم الكلام اللائق عن الله.
أو بالأحرى دع هؤلاء الذين يحرضون على الكفر بنفاق يقولون، بماذا يجب أن يجاب عندما يسأل إنسان عن الله، (لأن “الكلمة كان الله”)، فإنه من الاجابة على هذه السؤال سيعرف كل ما يتعلق بكلتا المسألتين، أى ماذا يجب أن يقوله الشخص: هل “كان” أم “لم يكن”؟ هل هو “دائم” أم “صار من قبل” هل هو “أزلى” أم “منذ متى، وحتى متى”. هو هو “اله حق” أم “بالوضع والمشاركة والاختلاق” هل هناك من يقبل القول بأنه (أى الكلمة) “واحد من بين المخلوقات” أم أنه “مشابه الآب”. وأنه “غير مشابه للآب حسب الجوهر”. أم أنه “مشابه للآب وخاص به” وأنه “مخلوق” أم أن “به قد خلقت المخلوقات”.
إنه “هو ذاته كلمة الآب“، أم أن هناك “كلمة آخر” بالاضافة إليه، وأنه تكوّن عن طريق هذه الكلمة الآخر. وعن طريق حكمة أخرى.. وأنه إنما لُقِبَ حكمة وكلمة بالاسم فقط، وأنه صار شريكًا لتلك الحكمة وتاليا لها.
10ـ فأقوال مَنْ أذن، هي التي تعتبر لاهوتية وتوضح أن ربنا يسوع المسيح هو إله وابن الآب؟ هل هي تلك الأقوال التي تقيأتموها أنتم، أم تلك التي قلناها نحن ولا نزال نقولها من الكتب المقدسة.
إذن فإن كان المخلّص ليس إله وليس كلمة وليس ابنًا. فأنه يكون من الجائز لكم (فى هذه الحالة) أن تقولوا ما تريدون كما هو جائز للوثنيين واليهود في أيامنا.
أما إن كان هو كلمة الآب والابن الحقيقى. وإله من إله، و” فوق الكل مبارك إلى الأبد ” (رو5:9)، فكيف لا يكون لائقًا أن نزيل ونمحو الأقوال المغايرة والثاليا الآريوسية، كصورة للشرور. تلك المليئة بكل أنواع الألحاد والكفر؟ والتى عندما يسقط فيها أحد، ” فإنه لا يعرف أن الاشباح سيهلكون بواسطتها، وأنه سيلتقون بها في عمق الهاوية ” (أم18:9س).
أنهم يعرفون هذا الأمر، وهم أنفسهم في الواقع كمخادعين يخفون هذه الامور لأنهم لا يملكون الشجاعة أن ينطقوا بها علنًا، ولكنهم يقولون أشياء أخرى قريبة منها، لأنهم أن تكلّموا علنا فسوف يلامون، وإن تعرّضوا للشبهة (بسبب الإنحراف) فإن الجميع سيتصّدون لهم ببراهين من الكتب المقدسة. ولذلك، فبما أنهم أبناء هذا الجيل، فإنهم بدهاء، قد أوقدوا المصباح الذي أعتبروه خاصًا بهم، بزيت خام، ولكنهم خوفًا من أن ينطفئ بسرعة لأنه قد قيل ” نور الأشرار ينطفئ ” (أيوب5:18)، فإنهم أخفوه تحت مكيال النفاق والرياء.
ويدلون بأقوال مغايرة، مستعينين بحماية الأصدقاء مهددين بقسطنديوس(8) وذلك حتى لا يرى، أولئك الذين ينضمون إليهم، نجاسة الآريوسية ونتانتها. وذلك بواسطة دهائهم وأقوالهم التي ينطقون بها. كيف إذن لا تكون هذه الهرطقة مستحقة للكراهية مرة أخرى، بحسب هذا أيضًا، وهي في الواقع تُخفى بواسطة مشايعيها أنفسهم ـ إذ أنها لا تتجاسر أن تظهر علنًا وتتكلم بحرية ـ بل هي تتربى ويعتنى بها كالحيّة؟
لأنهم من أين جمعوا لأنفسهم تلك الترهات؟ أو ممن حصلوا إذن على مثل هذه الأقوال التي يتجاسرون على التشدّق بها؟ أنهم ليس في وسعهم أن يحددوا الشخص الذي سبق أن تسلّموا منه هذه الأقوال. لأنه مَنْ من الناس، سواء كان يونانيًا أو بربريًا يجسر أن يقول عن ذلك الذي يُقر ويُعتَرف به أنه إله، بأنه واحد من المخلوقات، وأنه لم يكون موجودًا قبل أن يُخلق؟ ومَنْ هو ذلك الذي يؤمن بالله، ولا يصدق الله القائل ” هذا هو ابني الحبيب ” (مت5:17) ويزعم بأن الابن ليس ابنًا بل مخلوقا؟ بل أن مثل هذه التعاليم سوف تثير سخط الجميع أكثر ضدهم.
فإنهم حتى لم يتخذوا براهينهم من الكتب المقدسة، لأنه سبق أن كشفنا مرارًا، كما سنكشف الآن أيضًا بأن هذه التعاليم مخالفة وغريبة عن الأقوال الإلهية، إذن، إذ لم يتبق إلاّ أن نقول بأنهم قد أصابهم الجنون بعد أن تلقوا هذه التعاليم من الشيطان (لأنه هو وحده الذي يزرع مثل هذه التعاليم). لذلك هيا بنا لنقاومه، لأنه سيكون لنا صراع ضده عن طريقهم. وبمشيئة الرب، بعد أن يعجز كالمعتاد بواسطة البراهين، فإنهم سيصابون بالخزى عندما يرون ذلك الذي زرع هذه الهرطقة فيهم. خاليًا من أية قوة. فيتعلّمون، ولو متأخرًا، أنه بما أنهم آريوسيون، فهم ليسوا مسيحيين.
الفصل الرابع: الابن أزليّ وغير مخلوق
11ـ قد قلتم واعتقدتم حسب اقتراح (الشيطان) عليكم، بأنه ” كان وقت لم يكن فيه الابن موجودًا “، لأن ثوب أفكار بدعتكم هذا، هو الذي يجب أن ينزع أولاً.
قولوا لنا أيها المهاترون عديمي التقوى، ما المقصود بالوقت الذي لم يكن فيه الابن موجودًا؟ فإن كنتم تشيرون بهذا إلى الآب. فإن تجديفكم يكون أعظم. لأنه من غير اللائق أن يقال عنه ” كان في وقت ما ” أو أن يشار إليه بكلمة “وقت”، لأنه كائن دائمًا وهو موجود الآن. وحيث إن الابن أيضًا موجود فهو (الآب) أيضًا موجود، وهو نفسه الكائن، وأبو الابن. فإن كنتم تقولون إن الابن كان موجودًا مرّة، حينما لم يكن موجودًا، فالجواب هو أن هذا كلام صبيانى أحمق. إذ كيف يكون هو نفسه موجودًا وغير موجود؟ وإذ تجدون أنفسكم في حيرة أمام هذا التضارب في الأقوال، فإنكم يمكن أن تقولوا، إنه كان هناك “وقتًا ما “حينما لم يكن الكلمة موجودًا، لأن هذا هو المعنى الطبيعى لظرف الزمان “وقتًا ما” ποτέالذى تستخدمونه.
والقول الذي سجلتموه بعد ذلك هو ” الابن لم يكن موجودًا قبل أن يولد “، هو مساو تمامًا لقولكم ” كان هناك وقت ما لم يكن موجودًا ” فسواء هذا القول أو القول الآخر، فكلاهما يعنى أنه كان هناك زمن سابق على الكلمة. إذن من أين أتيتم بهذه الأقوال؟ لماذا تزمجرون كالأمم وتقولون كلمات فارغة زائفة ضد الرب وضد مسيحه(9)؟ لأنه لم يسبق لأي سفر من الكتب المقدسة أن استخدم تعبيرًا مثل هذه التعبيرات عن المخلّص، بل بالأحرى تقول عنه “الدائم”، “الأزلى” والمشارك دائمًا مع الآب في الوجود لأنه ” في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله.
وكان الكلمة الله “(10) ويقول عنه في الرؤيا ما يلي ” الكائن والذي كان والآتى “(11) فمَن يستطيع إذن أن ينتزع الأزلية من ذلك “الكائن”. “والذى كان” ولأجل هذا الأمر عينه كتب بولس وهو يتكلّم عن اليهود في الرسالة الى أهل رومية قائلاً “ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن فوق الكل الهًا مباركًا الى الأبد”. وحين كان يتكلّم مع الأمميين قال ” لأن أموره غير المنظورة ترى بوضوح منذ خلق العالم مدركة بواسطة المصنوعات قدرته السرمدية وألوهيته“(12) وما هي قدرة الله؟ هو نفسه يعلّم في مرّة أخرى قائلاً ” المسيح هو قوة الله وحكمة الله “(13) أنه بالتأكيد لم يكن يقصد الآب بهذه الكلمات، كما كنتم تتهامسون كثيرًا فيما بينكم قائلين إن “الآب إنما هو قوته الأزليّة” ولكن الأمر ليس هكذا.
لأنه لم يقل إن الله ذاته هو القوة” بل إن “القوة هي قوّته”. فمن الواضح الجلي للجميع أنه استخدم الهاء في “قوته” (ضمير الاضافة في الغائب المفرد) ولم يستخدم “هو” (ضمير الغائب المفرد في حالة الفاعل) ولكنه ليس غريبا (عن الاب) بل هو (الابن) خاص به ذاته(14). إقرأوا أيضًا سياق الكلام “وأرجعوا إلى الرب”، ” وأما الرب فهو الروح “(15)، وسترون أن هذا النص يشير إلى الابن.
12ـ لأنه (بولس) وهو يتحدث عن الخليقة، فإنه يستمر أيضًا في الكتابة عن قوة الخالق في خليقته، تلك القوة التي هي “كلمة الله”، والذي من خلاله (بواسطته) قد خَلَقَ كل شئ. فلو أن الخليقة تقدر بذاتها وحدها أن تعرف الله بدون الابن، فالتفتوا لئلا تسقطوا في الغواية، فتظنوا أنه بدون الابن أيضًا قد خُلِقَت الخليقة. ولكن إن كانت الخليقة قد خُلِقَت عن طريق الابن، وأنه “فيه تثبت (تقوم) كل الأشياء في الوجود”(16)، فإن الذي يتأمل الخليقة بطريقة مستقيمة، فلابد أن يرى أيضًا بالضرورة الكلمة الذي خلقها، ومن خلال الكلمة يبدأ أن يدرك الآب وإن كان حسب قول المخلّص ” لا أحد يعرف الآب إلاّ الابن ولِمَن سيعلن له الابن عنه “(17) وحينما سأل فيلبس “أرنا الآب” لم يقل له، انظر الخليقة، بل قال له ” من رآنى فقد رآى الآب “.
فإن بولس بصواب وأدراك، يتهم اليونانيين بأنهم، بينما يرون تناسق الخليقة ونظامها فإنهم لا يدركون الكلمة خالقها. (لأن المخلوقات تُعلن عن خالقها)، لكي يدركوا الإله الحقيقي من خلال المخلوقات، ويكفوا عن عبادة المخلوقات، ولذلك قال بولس ” قدرته السرمدية ولاهوته ” لكي يشير بذلك إلى الابن. وحينما يقول القديسون “الكائن قبل الدهور”، “والذي به صنع الدهور” فإنهم بذلك يبشرون بخلود الابن وأزليّته، وهم حينما يقولون الابن فهم يقصدون الله نفسه.
ولذلك يقول إشعياء ” الله الأبدى، خالق أطراف الأرض “(18) وقالت سوسنه ” أيها الاله الأزلى “(19). أما باروخ فكتب ” قد صرخت إلى الأبدى مدى أيامى “(20) وبعد قليل يقول ” لأني أنا أعتمدت في رجائى على الأبدى، لأجل خلاصكم، وغمرنى فرح من لدن القدوس “(21). لذلك يقول الرسول أيضًا وهو يكتب للعبرانيين، ” الذي (الابن) وهو بهاء مجده وصورة جوهره “(22) وداود ينشد في المزمور التاسع والثمانين قائلاً ” فليكن بهاء الرب الهنا علينا “(23)، وأيضًا “بنورك سنرى النور(24) فمَن يكن حَمقًا لدرجة أنه يشك في أن الابن كائن على الدوام؟ لأنه مَنْ رأى نورًا قط بدون بريق وميضه، حتى يقول عن الابن إنه ” كان هناك وقت ما لم يكن فيه موجودًا “، أو ” أن الابن لم يكن موجودًا قبل أن يولد “؟ وما قيل في المزمور الرابع والأربعين بعد المائة، موجهًا قوله للابن ” مملكتك مملكة كل الدهور “(25)
فلا يجوز لأي شخص، أن يتخيّل أى فترة ـ مهما كانت وجيزة ـ لم يكن فيها الكلمة موجودًا. لأنه إن كانت كل فترة زمنية تقاس من خلال الدهور، والكلمة هو ملك وصانع كل الدهور، لذلك فبالضرورة. حيث إنه لا توجد قبله أية فترة زمنية من أى نوع، فإنه يعتبر ضربًا من الجنون أن يقال “كان هناك وقت عندما لم يكن الأزلى موجودًا. وأن “الابن هو من عدم” حيث إن الرب نفسه يقول ” أنا هو الحق “(26) ولم يقل ” صرت الحق “، بل هو يكرّر دائمًا ” أنا هو ” فيقول ” أنا هو الراعى “(27) و” أنا هو النور “(28) ومرة أخرى يقول ” ألستم أنتم تقولون أنى أنا الرب والمعلّم وحسنًا تقولون، لأني أنا هو “(29). ومَن عندما يسمع مثل هذا القول، من الله، والحكمة وكلمة الآب، متحدثًا عن ذاته، يظل حائرًا بخصوص الحقيقة، ولا يؤمن في الحال، بأن عبارة “أنا هو” تعنى أن الابن أبدى، وأزلي قبل كل الدهور.
13ـ مما سبق ذكره يتضّح أن ما تقوله الكتب المقدسة عن الابن يبرهن أنه أزلي. أما ما يتفوّه به الآريوسيون متشدقين بالألفاظ: “لم يكن”، “من قبل”، “متى؟” فإن الكتب المقدسة تشير بهذه الألفاظ الى المخلوقات، وهذا سيتضح مرّة أخرى مما سنذكره فيما يلي: فمثلاً، عندما تحدث موسى عن الأمور المختصة بتكوين الخليقة، قال ” كل خضرة الحقل لم تكن بعد في الأرض وكل عشب الحقل لم يكن قد نبت بعد لأن الله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل في الأرض “(30) وجاء في التثنية ” حين قسم العلى، الشعوب “(31). وكان الرب يقول عن نفسه ” لو كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأني قلت أنى ماض إلى الآب، لأن أبى أعظم منى، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون “(32).
أما عن الخليقة فيقول على فم سليمان ” قبل خلق الأرض، قبل صنع الأعماق، وقبل تدفق ينابيع المياه، وقبل أن ترسخ الجبال، وقبل جميع التلال، ولدنى “(33) وأيضًا ” قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن “(34) ويقول عن أرميا ” قبل أن أصورك في الرحم عرفتك “(35) وداود يرنم قائلاً ” يارب صرت لنا ملاذًا من جيل إلى جيل، قبل تكوين الجبال، أو قبل خلق الأرض والمسكونة منذ الأزل وإلى الأبد أنت هو“(36). وفى سفر دانيال ” وصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت: أيها الإله الأزلى العارف بالخبايا، والعالم بكل الأشياء قبل حدوثها“(37).
وهكذا إذن يظهر أن الألفاظ ” لم يكن في وقت ما “. و” قبل أن يصير “، و”عندما” ومثل هذه التعبيرات انما تنطبق على الكلام بخصوص المنشآت والمخلوقات التي جُبِلَت من العدم. ولكنها غريبة تمامًا بالنسبة للكلمة. فإن كانت الكتب المقدسة تستخدم هذه التعبيرات عن المخلوقات، بينما تقول عن الابن إنه “الدائم”، إذن فيا محاربى الله، إن الابن لم يصر من العدم، ولا يحسب في عداد المخلوقات اطلاقًا، بل هو صورة الآب وهو الكلمة، ولم يكن قط غير موجود، بل هو موجود على الدوام، وهو الشعاع الأزلى لنور هو أزلى. لماذا إذن تتخيلون أن هناك أزمنة سابقة على الابن؟ أو لماذا تجدّفون على الكلمة بأنه لاحق وتالى للدهور وهو الذي به قد صارت الدهور؟
لأنه كيف يوجد زمن أو دهر بالمرّة. بينما لم يكن الكلمة قد ظهر بعد حسبما تقولون أنتم، وهو الذي به قد ” كان كل شئ، وبغيره لم يكن شيء واحد “(38)، أو إن كنتم تقصدون زمنًا ما، فلماذا لا تقولون جهارًا إنه “كان هناك زمن لم يكن فيه الكلمة موجودًا. ولكن بينما أنتم تسكتون عن اسم “الزمن” لكي تخدعوا البسطاء ولكنكم من ناحية أخرى لا تخفون شعوركم الخاص على وجه الاطلاق، ولكن ـ حتى لو أخفيتموه. فإنكم لا تستطيعون أن تفلتوا من إنكشاف أمركم، لأنكم لا تزالون تقصدون الأزمنة عندما تقولون ” كان مرة حينما لم يكن موجودًا “، وأيضًا ” لم يكن موجودًا قبل أن يولد “.
الفصل الخامس: البنوّة الالهية غير البنوة البشرية
14ـ وهكذا بعد برهنا هذه الامور وأثبتناها، فإنهم لا يزالون يجدّفون أكثر قائلين: ” إن لم يكن هناك وقت ما، لم يكن فيه الابن موجودًا، بل هو أزلى في وجوده مع الآب، إذن فلا يعود يسمى بعد ابنًا بل أخًا للآب “. يا لكم من حمقى، مغرمين بالتشاحن والمخاصمة! لأنه ان كنا نقول إنه هو وحده كائن أزليًا مع الآب، دون أن نقول ـ في نفس الوقت ـ إنه ابن، لكان هناك بعض العذر لتوقيرهم ولتدقيقهم المصطنع هذا، ولكن إن كنا في نفس الوقت الذي نقول فيه إنه أزلى، فإننا نعترف إيضًا أنه ابن من آب فكيف يكون ممكنًا أن يعتبر المولود أخًا للذى ولده؟ فإن كان إيماننا هو بالآب والابن، فأى رابطة أخوية توجد بينهما؟ إذ كيف يمكن أن يدعى الكلمة أخًا لذلك الذي (أى الآب) هو أيضًا كلمة له؟ وان هذا الاعتراض ليس من قوم يجهلون حقيقة الأمور، لأنهم هم أنفسهم يعرفون الحقيقة. ولكن هذه الحجة إنما هي حجة يهودية، آتية من قوم ” بمشيئتهم يعتزلون الحقيقة” كما يقول سليمان(39). فالآب والابن لم يولدا من أصل سابق عليهما في الوجود، حتى يمكن أعتبارهما أخوين، ولكن الآب هو أصل الابن وهو والده. والآب هو آب، وهو لم يكن ابنًا لأحد، والابن هو ابن وليس بأخ.
فإن كان هو يُدعى ابنًا أزليًا للآب، فحسنًا يقال. لأن جوهر الآب لم يكن ناقصًا أبدًا، حتى يضاف إليه (ابنه) الخاص به فيما بعد. وأيضًا فإن الابن لم يولد (من الآب) كما يولد انسان من انسان، حتى يعتبر انه قد جاء الى الوجود بعد وجود الآب، بل هو مولود الله، ولكونه ابن الله الذي هو من ذاته (من ذات الله) الموجود من الأزل، لذلك فإنه هو نفسه (أى الابن) موجود من الازل. فبينما خاصية طبيعة البشر أنهم يلدون في زمن معين، بسبب أن طبيعتهم غير كاملة، أما مولود الله فهو أزلى، بسبب الكمال الدائم لطبيعته، فإذا لم يكن ابنًا، بل مخلوقًا وُجِد من العدم، فعليهم أن يثبتوا ذلك أولاً، وبعد ذلك إذ يتصورونه مخلوقًا، يمكنهم أن يصيحوا قائلين “كان هناك وقت عندما لم يكن الابن موجودًا، لأن المخلوقات لم تكن موجودة قبل أن تخلق” أما أن يكن هو ابنًا ـ كما يقول الآب وكما تنادى به الكتب المقدسة ـ فإن “الابن” ليس شيئًا آخر سوى أنه المولود من الآب. والمولود من الآب هو كلمته وحكمته وبهاؤه وما يجب أن نقوله، هو أن الذين يعتقدون أنه “كان هناك وقت عندما لم يكن الابن موجودًا “أنهم يسلبون الله كلمته، ويعلّمون بمذاهب معادية كلية لله معتبرين أن الله كان في وقت ما بدون الكلمة الذاتى وبدون الحكمة. وكان النور في وقت ما بدون بهاء، وكان النبع جافًا مجدبًا.
حقًا أنه يتظاهرون أنهم يخشون ذكر اسم الزمن، بسبب أولئك الذين يعيرونهم، ويقولون، بأن (الابن) كان قبل الأزمنة إلاّ أنهم يحددون أوقاتًا معينة، فيها يتخيلون عدم وجوده، مبتدعين أزمنة ويا لسوء ما ابتدعوا ـ فإنهم بذلك ينسبون لله نقص الكلمة (أى عدم العقل) وبذلك فإنهم يكفرون كفرًا شنيعًا.
15ـ وحتى أن اعترفوا معنا، باسم “الابن” وذلك لأنهم لا يريدون أن يدانوا علنًا من الجميع، إلاّ أنهم ينكرون أن الابن هو المولود الذاتى لجوهر الآب. ويبنون انكارهم على أساس أن الابن ـ بحسب كلامهم ـ يوجد، بلا شك، من جوهر يتجزأ وينقسم الى أقسام. وهذا الكلام لا يقل بالمرّة عن إنكارهم أنه ابن حقيقى، وإنما هم يلقبونه بلقب ابن، بالاسم فقط. أفلا يرتكبون خطأ جسيمًا حينما يتصورون أفكارًا جسديّة. وينسبونها لغير الجسدى (اللاجسدى). وحينما بسبب ضعف طبيعتهم الخاصة. فإنهم ينكرون طبيعة الآب وذاتيته؟ لقد حان الوقت لهؤلاء الذين لا يفهمون كيفيّة وجود الله ولا ما هي هيئة الآب، أن ينكروه أيضًا، لأن هؤلاء الناس الأغبياء يقيسون مولود الآب بمقاييسهم البشرية الذاتية. وأن أناسًا يفكرون بمثل هذه الطريقة أنه لا يمكن أن يكون هناك ابن لله، فإن هذا أمر يستحق العطف والرثاء. ولكن يلزم أن نستمر في سؤالهم وفضح أفكارهم.
إذن فإن كان الابن ـ كما تقولون ـ تكوّن من العدم، ولم يكن موجودًا قبل أن يولد، فإنه ـ على ذلك ـ يدعى ابنًا وإلهًا وحكمة بحسب المشاركة فقط مثله مثل كل الأشياء الأخرى، فإن كل هذه الأشياء الأخرى (أى المخلوقات) قد تكوّنت وتقدّست وتمجّدت بالمشاركة أيضًا. إذن فهناك حاجة ملّحة أن تقولوا لنا، مَنْ هو الذي يشاركه (الابن)، ما دامت كل الأشياء الأخرى لها شركة في الروح (القدس)، أما هو ـ فبحسب قولكم ـ لمن يستطيع أن يكون (الابن) مشاركًا؟ هل للروح؟ بل كما قال هو ذاته حقًا بالأحرى إن الروح نفسه يأخذ من الابن(40) ومن غير المعقول القول بأن هذا (الابن) يُقدَّس من ذلك (الروح)، ولا يتقبى بعد ذلك بالضرورة إلاّ أن نقول إن الآب هو الذي يشاركه الابن. إذن من هو الذي يشاركه (الابن). ومن أين هو؟ فلو أن هذا (المشارك فيه) كان شيئًا من الخارج، مدبرًا من الآب، فلن يكون في الامكان أن يشارك الابن الآب، بل يشارك ذاك الذي هو من خارج الآب. ولن يكون الابن بعد ذلك، ثانيًا بعد الآب، إذ أن ذاك الذي من خارج سيكون سابقًا على (الابن) ذاته، ولن يكون ممكنًا أن يدعى ابن الآب، بل ابنًا لذلك الذي باشتراكه فيه دُعيّ ابنًا وإلهًا.
وإن كان هذا أمر غير لائق وكفرى، إذ أن الآب يقول ” هذا هو ابنى الحبيب “(41) وأيضًا يقول الابن إن الله أبوه(42)، فيكون واضحًا إذن، أن ما يشترك فيه ليس من الخارج، وإنما هو من جوهر الآب، ومرة أخرى، إن كانت هذه المشاركة، شيئًا آخر، غير جوهر الابن، سيحدث نفس الخطأ، إذ في هذه الحالة ـ سيكون هناك شيء في الوسط بين ما هو من الآب وبين جوهر الابن أيًا كان هذا الشئ.
16ـ وإذ يتضح أن مثل هذه الأفكار غير اللائقة إنما هي بعيدة عن الحقيقة، لذلك فمن الضرورى أن نقول إن ما هو من جوهر الآب الذاتى كليّة، إنما هو الابن. لأن القول بأن الله يشترك فيه كليّة هو نفس القول بأن الله يلد، وأن الله يلد، ماذا يعنى هذا القول سوى أنه يلد ابنًا؟
وكل الأشياء تشترك في الابن بحسب النعمة النابعة من الروح. ويتضح من هذ أن الابن نفسه ليس مشاركًا لشئ ما، وأما ما يشترك فيه من الآب، فهذا هو الابن ـ لأنه بإشتراكنا في الابن، يقال عنا أننا نشارك في الله، وهذا ما قاله بطرس: ” لكي تصيروا مشاركين في الطبيعة الالهية “(43) وكما يقول الرسول أيضًا ” أما تعلمون أنكم هيكل الله “(44) وأيضًا ” لأننا نحن هيكل الله الحيّ “.
وعندما نرى الابن فإننا نرى الآب، لأن فكر الابن وإدراكه، إنما هي معرفة تدور حول الآب، لأن الابن هو مولود ذاتى من جوهره. وكما أن الله يُشتَرَك فيه. فلا يستطيع أحد أن يقول أن هذا (الاشتراك فيه) هو تغيير وتقسيم لجوهر الآب [ (لأنه قد صار أمرًا واضحًا ومعترفًا به أن الله يشترك فيه، والاشتراك في الله هو نفسه الولادة (هو نفسه أن الله يلد) ]. وهكذا يتضح أن المولود ليس بألم (بتغيير) ولا بتقسيم لذلك الجوهر المبارك. وليس كفرًا (أى من عدم الإيمان) أن يكون لله ولد، مولود من ذات جوهره وحينما نقول إنه “ابن” و “مولود” فلا يعني هذا تغيرًا ولا تقسيمًا لجوهر الله. بل بالاحرى، نحن نعرف أنه ابن الله الوحيد الجنس، الأصيل والحقيقى، وهذا هو ما نؤمن به.
فإن كان المولود من جوهر الآب. إنما هو الابن ـ كما أوضحنا وأثبتنا ـ فليس هناك أدنى شك، بل هو أمر ظاهر جلى للكل أن هذا المولود هو نفسه، حكمة الله وكلمته والذي به ومن خلاله خَلَقَ (الآب) كل الأشياء وصنعها. وهذا المولود هو بهاء الآب الذي ينير به كل الأشياء، والذي به يُعلن نفسه لأولئك الذين يريد أن يُعلن لهم. وهذا المولود هو أيضًا شكله (المعبر عنه) وصورته التي فيها يُرى ويُعرف، لذا فإنه “هو والآب واحد”، ولآن من يرى الابن فإنه يرى الآب أيضًا.
وهذا (المولود) أيضًا هو المسيح، الذي به قد أفتديت كل الأشياء، وبه أيضًا خُلِقَت الخليقة الجديدة(46). وأيضًا فإذا كان الابن هكذا، فلا يكون ملائمًا ـ بل أن هذا يكون خطرًا جسيمًا ـ أن يقال إنه “مخلوق من العدم”. أو إنه ” لم يكن موجودًا قبل أن يولد “. لأن من يتكلم هكذا عن المولود الذاتى من جوهر الآب، يكون قد جدّف مسبقًا على ذات الآب، إذ أنه يعتقد عن الآب بمثل هذه التعاليم التي يخادع بها في تخيلاته عن المولود منه.
الفصل السادس: الابن الوحيد والثالوث
17ـ إذن، فإن هذا وحده كاف لدحض وهدم الهرطقة الآريوسية، ولكن عدم أرثوذكسيتها يمكن أن يظهر أيضًا مما يأتى:
إن كان الله خالقًا وصانعًا، وهو يخلق مخلوقاته بواسطة الابن، ولا يستطيع أحد أن يرى الأشياء المخلوقة بأية طريقة أخرى، سوى بإعتبارها مخلوقة بواسطة الكلمة، أفلا يكون تجديفًا ـ إذ بينما أن الله هو الخالق ـ أن يأتى أحد فيقول إن كلمته الخالقة وحكمته، لم تكن موجودة في يوم ما؟ فإن هذا مشابه للقول، بأنه حتى الله لم يكن خالقًا، إذ أنه لا يملك كلمته الخالق الذاتى، الذي هو منه، بل ما يخلق به، إنما يكون (فى هذه الحالة) قد جُلِبَ إليه من خارجة، ويكون غريبًا عنه، ويكون غير مماثل له حسب الجوهر.
وبعد ذلك، فليقولوا لنا ـ أو بالأحرى ليتهم يرون من هذا، مقدار ضلالهم وعدم تقواهم في قولهم “كان وقت عندما لم يكن موجودًا” وأيضًا “لم يكن موجودًا قبل أن يولد” ـ لأنه إن لم يكن الكلمة دائمًا أزليًا مع الآب، فلا يكون الثالوث أزليًا، بل واحد مفرد هكذا كان من قبل، وفيما بعد صار ثالوثًا بالإضافة، وهكذا بمرور الزمن ـ حسب رأيهم ـ فقد تزايدت المعرفة عن الله وتشكلّت. وأيضًا ان لم يكن الابن مولودًا ذاتيًا لجوهر الآب، بل قد خلق من العدم، إذن يكون الثالوث قد تكوّن من العدم، وكان هناك وقت ما عندما لم يكن هناك ثالوث، بل واحد مفرد. وهكذا يكون الثالوث في وقت ما ناقصًا، ثم في مرة أخرى يكون كاملاً، فيكون ناقصًا قبل صيرورة الابن، ويكون كاملاً حينما صار الابن، وهكذا (على أساس هذا الكلام)، تُحسَب الخليقة مع الخالق، والذي لم يكن موجودًا في وقت ما يُحسَب مساويًا مع الله الذي هو كائن على الدوام، ويمجّد معه. وما هو أردا من هذا حقًا، أن الثالوث يوجد غير متماثل مع ذاته. إذ يكون مكونًا من طبائع وجواهر غريبة ومختلفة عن بعضها.
وهذا القول ليس شيئًا آخر سوى أن الثالوث أصله مخلوق. إذن ما كنه هذه العقيدة عن الله، التي لا تتماثل حتى مع ذاتها بل تسير الى الاكتمال عن طريق الاضافات. مع مرور الأيام، ففى وقت ما لا يكون موجودًا هكذا، وفى وقت آخر يكون موجودًا هكذا.
وهكذا يكون طبيعيًا أنه يمكن أن ينال اضافة جديدة، ويستمر (فى نوال الاضافة) بلا نهاية، كما حدث مرة في البدء وأتخذ أصله بطريق الاضافة. فلا يكون هناك إذن شك أنه يمكن أن يحدث فيه تناقص، لأن الأشياء التي تضاف وتزاد، من الواضح، أنها يمكن أيضًا أن تُطرَح وتُنقَص.
18ـ ولكن، حاشا لله، أن يكون الأمر هكذا، فالثالوث ليس مخلوقًا، بل هو أزلى، بل يوجد لاهوت واحد في ثالوث، وهناك مجد واحد للثالوث القدوس. وأنتم تتجاسرون على تمزيقه إلى طبائع مختلفة، ومع أن الآب أزلى، فإنكم، تقولون عن الكلمة الجالس معه إنه “كان هناك وقت ما لم يكن فيه موجودًا، ومع أن الابن جالس مع الآب، إلاّ أنكم أنتم تريدون أن تبعدوه عنه. فالثالوث منشئ وخالق. وأنتم لا تتورعون أن تحطوا من قدره إلى مستوى المخلوقات التي وجدت من العدم. أنكم لا تخجلون أن تساووا بين الكائنات التي في حالة العبودية، وبين رفعة الثالوث، وأن تضعوا الملك رب الصباؤوت في مرتبة واحدة مع رعاياه. كفوا عن التفكير في خلط الأشياء التي لا يمكن أن تتحد معًا، أو بالاحرى كفوا عن التفكير في مزج الأشياء غير الموجودة مع ذلك الذي هو الكائن.
ليس ممكنًا أن تقولوا هذه الأقوال على زعم أنكم تقدّموا مجدًا وكرامة للرب، بل العكس، فأنتم تقدّمون له عارًا وهوانًا، لأن من لا يكرم الابن فأنه لا يكرم الآب أيضًا. فان كان التعليم اللاهوتى كاملاً الآن على أساس فهمه كثالوث، فهذه هي الديانة (العبادة) الحقيقية والوحيدة، وهذا هو الصلاح والحق، وهذا هو الواجب أن يكون هكذا دائمًا، إلاّ إذا كان الصلاح والحق هي أشياء صارت فيما بعد، ويكون كمال اللاهوت يحدث من طريق الاضافة. فمن اللازم، أن يكون هذا التعليم هكذا منذ الأزل، لأنه إن لم يكن أزليًا (كثالوث)، فليس من الواجب أن يكون هكذا الآن (ليس من الواجب أن يكون ثالوثًا الآن حسب افتراضهم). ولكن ما هو خلاف ذلك ـ كما تدعون أنتم أنه هكذا من البدء ـ فإنه حتى الآن لا يكون ثالوثًا.
ولا يستطيع أحد من المسيحيين أن يحتمل مثل هؤلاء الهراطقة لأنه يناسب الأمميين أن يتحدّثوا عن ثالوث مخلوق، ويضعونه في مساواة مع المخلوقات، إذ من خصائص المخلوقات أنها تقبل النقص والزيادة.
أما إيمان المسيحيين فإنه يعرف الثالوث المبارك على أنه غير قابل للتغيّر، وأنه كامل. وإنه هو هكذا أزليًا وعلى الدوام، فإيمانهم لم يضف شيئًا أكثر إلى الثالوث، ولم يعتبر أنه كان في وقت ما، ناقصًا، لأن أيًا من هذه الأمرين إنما هو ضلال، ولذلك فإن ايمانهم يعرف الثالوث بصورة نقيّة ولا يخلطونه مع المخلوقات، مقدمًا السجود للثالوث غير المنقسم، وحافظًا له وحدته اللاهوتية وايمانهم يتجنب تجديفات الآريوسيين، ويعترف ويعرف أن الابن موجود الدوام لأنه أزلى كالآب الذي هو كلمته الأزلى أيضًا. لذا فلنفحص هذا الأمر مرة ثانية الآن.
19ـ إن كان يقال عن الله إنه ينبوع حكمة وحياة، كما جاء في سفر إرميا، ” تركونى أنا ينبوع المياه الحيّة “(47) وأيضًا ” إن عرش المجد ذو المكانة الرفيعة هو موضع مقدسنا، أيها الرب رجاء إسرائيل كل الذين يتركونك يخزون. والمتمردون عليك في تراب الأرض يكتبون لأنهم تركوا الرب ينبوع الحياة “(48) وقد كُتب في باروخ، ” أنكم قد هجرتم ينبوع الحكمة “(49). وهذا يتضمّن أن الحياة والحكمة لم يكونا غريبين عن جوهر الينبوع، بل هما خاصة له، ولم يكونا أبدًا غير موجودين، بل كانا دائمًا موجودين. والآن فإن الابن هو كل هذه الأشياء. وهو الذي يقول ” أنا هو الحياة “(50)، وأيضًا ” أنا الحكمة ساكن الفطنة “(51).
كيف إذن لا يكون كافرًا من يقول “كان وقت ما عندما لم يكن الابن فيه موجودًا؟ لأن هذا مثل الذي يقول تمامًا “كان هناك وقت كان فيه الينبوع جافًا خاليًا من الحياة ومن الحكمة”. ولكن مثل هذا الينبوع لا يكون ينبوعًا، لأن الذي لا يَلِد من ذاته لا يكون ينبوعًا. يا لكثرة السخافات التي في هذا القول لأن الله يَعْدُ الذين يصنعون مشيئته أنهم سيكونون كينبوع لا تنضب مياهه اطلاقًا، كما يقول إشعياء النبى ” وسيشبعك (الرب) كما تشتهى نفسك، وتتشدّد عظامك، وتكون كحديقة مروية جيدًا، وكينبوع مياه لا تنضب مياهه “(52) فبينما أن الذي يقال عنه، والذي هو في الحقيقة ينبوع الحكمة، يتجاسر هؤلاء ويجدّفون عليه قائلين أنه عقيم ومجدب من حكمته الذاتية.
إلاّ أن أقوالهم هذه الصادرة عنهم، إنما أقوال زائفة، أما الحقيقة فتشهد بأن الله هو الينبوع الأزلى لحكمته الذاتية، ولما كان الينبوع أزليًا، فبالضرورة يجب أن تكون الحكمة أزلية أيضًا، لأنه من خلال هذه الحكمة خُلِقَت كل الأشياء، كما يرتل (يزمر) داود في المزامير ” كلها (أى الأعمال) بحكمة صنعت “(53) ويقول سليمان ” أسس الله الأرض بالحكمة وبالفهم هيأ السموات “(54).
ونفس هذه الحكمة هي الكلمة، “وبه” كما يقول يوحنا ” خلقت كل الأشياء. وبغيره لم يخلق شيء واحد “(55).
وهذا الكلمة هو المسيح، لأنه يوجد ” إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح. الذي به جميع الأشياء ونحن به “(56). فان كانت كل الأشياء قد خُلِقَت به. فهو لا يمكن أن يكون بين جميع هذه الاشياء. فالذى يتجاسر أن يقول عن (ذلك) “الذى به خُلِقَت جميع الأشياء”، إنه واحد من بين جميع هذه الأشياء، فبالتأكيد أنه يفكر نفس هذه الأفكار عن الله نفسه “الذى منه جميع الأشياء” وإن كان أحد يتحاشى هذا القول كأمر شنيع، ويستبعد الله عن جميع الأشياء حاسبًا إياه، آخر، فإنه يواصل نفس القول أيضًا بأن “الابن” الوحيد الجنس الذاتى من جوهر “الآب”، هو آخر مختلف عن جميع الأشياء.
ولكونه ليس واحدًا من بين الجميع، فليس من الصواب أن نقول عنه “كان وقت ما لم يكن فيه موجودًا”، و “لم يكن موجودًا قبل أن يولد”. لأن مثل هذه الأدعاءات تليق أن تقال عن المخلوقات أما “الابن” نفسه فمثله مثل “الآب”، وهذا الابن هو مولود الآب الذاتى من جوهره. وهو “كلمته” الذاتى وهو “حكمته” الذاتية. وهذه هي علاقة “الابن” الذاتية نحو “الآب” وهذا عينه يدل على أن “الآب” هو “أب “الابن”. لكي لا يقول أحد عن الله أنه كان “بدون كلمة: (أى غير عاقل) في وقت ما. ولا يقول عن “الابن” أنه لم يكن له وجود في وقت ما، لأنه ماذا يكون “الابن” بالنسبة لله إن لم يكن منه؟ أو ماذا يكون “الكلمة” و”الحكمة” إن لم يكونا من ذاته على الدوام؟
20ـ متى إذن، كان الله موجودًا بدون ما هو خاص به ذاتيًا؟ أو كيف يظن أحد أن ما هو خاص به ذاتيًا إنما هو غريب عنه ومن جوهر مختلف؟ لأن الأشياء الأخرى كمخلوقات ليس لها مشابهة قط مع الخالق حسب الجوهر، بل هي من خارجة، قد خُلِقَت بنعمته ومشيئته بالكلمة ولأجل الكلمة. ولذلك فإنها يمكن أيضًا أن تتوقف (عن الوجود) يومًا ما، إن أراد الخالق ذلك، لأنه هكذا هي الطبيعة الخاصة بالمخلوقات.
أما ما هو من ذات جوهر الآب (وهذا هو الذي سبق أن اعترفنا به أنه هو الابن)، فكيف لا يكون من الجسارة والكفر أن يقول أحد عنه إنه جاء من عدم، وإنه “لم يكن موجودًا قبل أن يولد” بل أُضيف عرضًا، ويمكن ألاّ يكون موجودًا في وقت ما في المستقبل؟
فالشخص الذي يفكر بإمعان في هذا الأمر، فإنه سيميّز أنه يحدث أنقاص لكمال وملء جوهر الآب، وهو سيرى أيضًا بوضوح أكثر شناعة وعدم معقولية هذه الهرطقة، إذا فكر بأن الابن هو صورة وبهاء الآب، وهو شكله (المُعبِر عنه) وهو حقيقته.
لأنه بما أن النور موجود هكذا صورته أيضًا، أى بهاؤه وكيانه الحقيقى وهو رسمه الذي يُعبِر عن تعبيرًا كاملاً.
وأيضًا بما أن الآب كائن هكذا تكون حقيقته (أى الابن)، فأولئك الذين يقيسون صورة اللاهوت وهيئته بمقياس الزمن فليعتبروا مدى هوة الضلال التي ينحدرون إليها.
لأنه أن لم يكن الابن موجودًا قبل أن يولد، فلا يكون الحق موجودًا في الله دائمًا، وليس من الصواب أن نقول مثل هذا القول لأنه بما أن الآب كائن فالحق موجود فيه دائمًا، الذي هو الابن الذي قال ” أنا هو الحق “(57)، والكيان الموجود يجب أن يكون في نفس الوقت هو الشكل المُعبِر والصورة، لأن صورة الله ليست مرسومة من الخارج، بل أن الله نفسه هو والدها، والتى فيها ينظر هو ذاته ويبتهج بسببها، كما يقول الابن نفسه ” كنت أنا بهجته “(58).
فمتى إذن، لم يكن الآب يرى نفسه في صورته؟ أو متى لم يكن يبتهج، حتى يتجاسر أحد ويقول أن “الصورة هي من عدم”. و”لم يكن الآب مبتهجًا قبل أن تخلق الصورة”؟ وكيف يستطيع الخالق والصانع أن يرى نفسه في جوهر مخلوق وصائر؟ فمثلما يكون الآب هكذا يجب أن تكون صورته.
21ـ هلم بنا إذن لنرى خصائص الآب بتدقيق لكي ندرك أن الصورة هي صورته الذاتية. فالآب هو أزلى، غير مائت، قدير، نور، ملك، ضابط الكل، إله، رب، خالق، وصانع.
فإن لم تكن هذه الخصائص موجودة (فى الصورة) ـ كما يظن الآريوسيون ـ إن الابن مخلوق وليس أزليًا (ففى هذه الحالة) لن تكون هذه هي صورة الآب الحقيقية، ولن يكون أمامهم سوى أنهم يرفعون برقع الحياء، ويقولون، إن كلمة الصورة التي تطلق على الابن ليست علامة مميّزة لجوهر مماثل، إنما هي فقط مجرد اسم له.
ولكن، مرة أخرى، فان هذا، يا أعداء المسيح، ليس بصورة وليس رسما، لأنه أى شبه بين المخلوقات التي هي من عدم وبين ذلك الذي أحضر الأشياء من العدم الى الوجود؟
لأنه كيف يمكن أن يكون ما هو غير كائن، شبيهًا بذاك الذي هو الكائن حقيقة، إذ أنه كان في وقت ما ناقصًا عنه لكونه لم يكن موجودًا، ولأنه كان له مكان داخل نظام الأشياء المخلوقة؟
لأن الآريوسيين، وهم يرغبون أن يكون الابن هكذا، يستحسنون تعليلات ابتكروها لأنفسهم قائلين: إن كان الابن هو مولود الآب وصورته، وإنه شبيه بالآب في كل شئ، يلزم إنه كما أن الابن قد وُلِدَ منه. هكذا لابد أن يَلِدُ هو أيضًا، ويصير هو أيضًا أبًا لابن.
وأيضًا فإن الذي يولد (من الابن) يلزم أن يَلِدُ هو أيضًا وهكذا إلى ما لا نهاية، فهذا هو ما يشعر أن المولود شبيه بالذى ولده.
حقًا أن أعداء الله هؤلاء، إنما يخترعون تشنيعات وافتراءات إذ أنهم لكي لا يعترفوا بأن الابن هو صورة الآب، فإنهم يتصورون صفات جسديّة وأرضيّة فيما يخص الآب ذاته، ناسبين إليه التقسيمات والتوالد، والحمل. إذن فإن كان الله مثل الانسان، فإنه يكون والدًا كالانسان، لكي يكون الابن أيضًا والدًا لابن أخر، وهكذا على التوالى وهكذا يصير الواحد من الآخر ـ حتى يزداد عدد الآلهة بالتعاقب، كما يظنون.
فلو أن الله ليس مثل الانسان (وهو في الحقيقة ليس مثله)، فإنه لا ينبغى أن تطبق الخصائص الانسانية عليه (على الله).
لأن الحيوانات غير الناطقة، وكذلك البشر، إنما يتوالدون على التوالى الواحد من الآخر، منذ بدء الخليقة، والمولود الذي وُلِدَ من أب، هذا الأب هو وُلِدَ (من أب) ومن الطبيعى أن يصير هذا المولود أيضًا والدًا لغيره، متخذًا خاصية الولادة في داخله من أبيه، تلك الخاصية التي تكون هو نفسه بها. ولهذا من الممكن أن يطلق على مثل هؤلاء الناس اسم أب أو اسم ابن بالصفة الخصوصية. إذ لا يكمن فيهم اطلاقًا ما هو خاص “بالاب” (أى صفة الأبوة)، وما هو خاص “بالابن” (أى صفة البنوة). لأنه (أى الابن) هو نفسه ابن لوالده، وفى نفس الوقت هو أب للمولود منه.
ولكن الأمر ليس كذلك فيما يخص الألوهية لأن الله ليس مثل الإنسان، لأن الآب هو ليس من أب، ولذلك فهو لا يلد آخر يصير أبًا فيما بعد، والابن أيضًا لا يخرج من الآب بالتوالد. وهو (أى الأبن) ليس مولودًا من أب سبق له أن وُلِدَ لذلك فهو (أى الابن) لم يُولَد لكي يلد.
لذلك ففيما يخص اللاهوت وحده، فان الآب هو اب بصفة مطلقة، والأبن هو ابن بصفة مطلقة، وفى هذين وحدهما، وحدهما فقط، يظل: الآب أب دائمًا، والابن ابن دائمًا.
الفصل السابع: اعتراضات الآريوسيين والرد عليها
22ـ إذن فالذى يبحث متسائلاً، لماذا لا يكون الابن والدًا لابن؟ فليبحث أولاً، لماذا لم يكن للآب والد. ولكن كلا هذين الأمرين بعيد عن الصواب، وملئ بكل أنواع الكفر والجحود. لأنه كما أن الآب هو دائمًا أب، وأنه لا يستطيع أن يصير أبنًا في يوم من الأيام، هكذا بنفس الطريقة، فان الابن هو دائمًا ابن، ولن يصبح أبًا في يوم من الأيام. لأنه في هذا بالأحرى يثبت ويتضّح أنه رسم الآب وصورته، ويظل باقيًا كما هو بدون تغيير، لكنه قد حصل على ذاتيته من الآب ومماثلته له.
أما أن كان الآب يتغيّر، فان الصورة أيضًا ستتغيّر في هذه الحالة. فإنه هكذا تظل الصورة والبهاء ثابتة تجاه ذاك الذي ولدها.
فإن كان الآب غير متغيّر ويبقى هكذا دائمًا كما هو، فمن الضرورى أيضًا أن تبقى صورته كما هي ولن تتغيّر.
إذن فالابن هو ابن من الآب، ولذلك فهو لن يصير شيئًا أخر سوى ذاك الذي هو من جوهر الآب الذاتى.
إذن فمن العبث أن يخترع الحمقى هذا (الاعتراض) أيضًا. وهم الذين يرغبون في فصل وأبعاد الصورة عن الآب، لكي يساووا الابن بالمخلوقات.
وبناء على ذلك، فإن مشايعى آريوس ـ وضعوا الابن بين مصاف المخلوقات ـ بحسب تعليم يوسابيوس ـ(59) معتبرين كأنه مثل الأشياء التي خُلِقَت بواسطته، وبذلك فانهم ابتعدوا عن الحقيقة.
وهم في بداية اختراعهم لهذه الهرطقة، كانوا يجولون معبأين بكليمات خداع ماكرة، جمعوها معًا، بل وهم إلى الآن، عندما يلتقى بعضهم مع الصبية، ويسألونهم، ليس من الكتب المقدسة طبعًا، بل من “فضلة قلوبهم” يتقيأون قائلين: “مَن هو ذاك الذي خَلَقَه الكائن من الكائن هل هو ذلك الغير كائن أم هو الكائن؟ “فهل إذن قد خلقه (الابن) وهو كائن أم وهو غير كائن؟. “وهل يوجد واحد فقط غير مخلوق ἀγένητον أم اثنان غير مخلوقين؟ “. ” وهل هو ذو أرادة حرّة، ولا يتغيّر بإختياره الذاتى، رغم أنه من طبيعة متغيّرة؟ لأنه ليس كالحجر يظل ثابتًا بلا حركة من ذاته، ثم يتقدّمون بعد ذلك الى النسوة الغريرات، ويخاطبوهن أيضًا، بكليمات مخنّثة قائلين: “هل كان لك ولد قبل أن تلديه”؟ فكما أنه لم يكن لك ولد هكذا أيضًا ابن الله لم يكن موجودًا قبل أن يولد” وهكذا فان عديمى الشرف يتلاعبون بمثل هذه الأقوال وهم يسخرون مشبّهين الله بالبشر، زاعمين أنهم مسيحيون ويبدلون مجد الله “بشبه صور الانسان الذي يفنى”(60).
23ـ ومثل هذه الأقوال المفرطة في الغباء والحماقة كان يجب ألاّ يرد أحد عليها، إلاّ أنه، لكي لا تبدو هرطقتهم وكأنها أمر أكيد، فإنه يكون من الواجب أن نفندها، خاصة من أجل النساء الغريرات اللاتى أنخدعن منهم بسهولة.
وما داموا يقولون هذه الأقوال، فينبغى عليهم أن يسألوا المهندس أيضًا هكذا “هل تستطيع أن تبنى بدون استخدام المواد الضرورية؟” فكما أنك أنت لا تستطيع فهكذا الله أيضًا لم يكن ليستطيع أن يخلق كل شيء بدون استخدام المواد الضرورية.
أو كان من الواجب أن يسألوا كل إنسان ” هل يمكنك أن تكون موجودًا بغير مكان؟ فكما أنك لا تستطيع هكذا فان الله أيضًا يوجد في كل مكان “. ليتهم يواجهون السامعين، وعندئذ سيخجلون منهم.
أو فلماذا عندما يسمعون أن لله ابنًا، ينكرون هذا الأمر، مفسرين هذا الإنكار بما يحدث بينهم؟
فى حين أنهم إن سمعوا أن الله يخلق ويصنع، لا يعودوا يعارضون ذلك؟ وكان يجب عليهم في حالة الخلق أيضًا أن يفهموها بحسب ما يحدث بين البشر، وأن يزودوا الله مقدمًا بالمادة اللازمة، وبذلك فإنهم ينكرون أن الله هو الخالق، وتبعًا لذلك فإنهم يصلون إلى التمرغ في الوحل مع المانويين.
فإن كانت الفكرة عن الله تسمو فوق هذه الأفكار فإن من يسمعها يؤمن ويعرف أن الله موجود ليس كما نوجد نحن، بل أنه موجود كإله، وإنه يخلق لا كما يخلق الناس، بل هو يخلق كإله. ومن هذا يتضح أنه يلد ليس كما يلد الناس، بل هو يلد كإله. لأن الله لا يقتدى بالبشر، بل الأحرى البشر (هم الذين يقتدون بالله) لأن الله ـ على وجه الخصوص ـ هو وحده حقًا الآب لابنه الذاتى، أما الآباء (البشريون) فقد دعوا كذلك آباء لأولادهم، من الله ” الذي منه تسمى كل أبوة في السموات وعلى الأرض “(61) وإن كان ما يقولونه يبقى بدون تحقيق أو مراجعة، فإنه سيظنون أن كلامهم معقول، وأما عند مراجعة كلامهم بفهم واع، فسنجد أن كلامهم هذا يستدعى الضحك والسخرية الشديدة.
24ـ أول كل شئ، فإن أول سؤال من أسئلتهم هذه، يعتبر لا معنى له بل هو غامض، لأنهم لا يوضحون، مَن هو الذي يسألون عنه، حتى يجيب عليه مَنْ وجّه إليه السؤال، فهم يقولون بسذاجة “الكائن، هو ذلك الذي لا يكون موجودًا”.
إذن، فمَنْ هو الكائن، وما هي الأشياء غير الكائنة أيها الآريوسيون؟ أو مَنْ هو “الكائن” ومن هو “غير الكائن”؟ ومن الذي يقال عنه “كائن” أو “غير كائن”؟ إذ أنه في وسع ذلك الذي هو الكائن أن يصنع الأشياء غير الكائنة، والأشياء الكائنة، والأشياء التي كانت من قبل.
إذن فالنجار والصائغ والفخارى، كل منهم بحسب فنه الخاص، يشكّل المادة الموجودة قبلاً، صانعًا منها الشكل الذي يريده.
والله ذاته، إله الكل، إذ قد أخذ من تراب الأرض الذي كان موجودًا، جعل منه الانسان في الحال، وهذه الأرض نفسها التي خلق منها الانسان لم تكن موجودة من قبل، ومن ثم أتى هو بها الى الوجود بواسطة كلمته الذاتى.
فإن كانوا يتساءلون هكذا عن الأمور، فإنه يتضح أن الخليقة لم تكن موجودة قبل أن تخلق، في حين أن البشر (أى النجار والصائغ والفخارى)، يشكّلون المادة الموجودة قبلاً، وهكذا يظهر كلامهم مفككًا غير مترابط. ولذا فإن كلاً من الكائنات وغير الكائنات يمكن أن تُخلَق كما سبق أن قلنا.
ولكن إن كانوا يتحدثون عن الله وعن كلمته، فليضيفوا على سؤالهم ما ينقصه، ودعهم يسألون هكذا: “هل كان الله، الذي هو كائن، موجودًا في وقت ما، بدون كلمة؟” وكونه هو نور، فهل كان بلا ضياء (هل كان مظلمًا)؟ أم أنه كان هو دائمًا أبا الكلمة؟
أو بمعنى آخر: “هل خَلَق الآب الذي هو كائن، الكلمة غير الكائن، أم أن الكلمة الذي هو مولود من جوهره الذاتى، كان دائمًا موجودًا عنده في داخله؟
وهذه الأسئلة تجعلهم يعرفون أنهم إنما يتجاسرون ويقحمون أنفسهم في اختراعات ومغالطات عن الله وعن ذلك الذي هو منه. فمن يستطيع أن يحتمل سماعهم وهم يقولون إن الله كان في وقت ما بدون كلمة؟ لأنهم يسقطون ثانية ويهوون فيما هم عليه من ضلالات سابقة، بالرغم من محاولاتهم للتهرب من هذا وإخفائه بمغالطاتهم ودهائهم المضلّل، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك.
فلا يرغب أحد إطلاقًا أن يسمعهم وهم يشكّكون قائلين إن الله لم يكن أبًا دائمًا، بل صار أبًا فيما بعد، لكي يتخيّلوا أن كلمته أيضًا، لم يكن موجودًا في وقت ما.
إذ أنه توجد براهين كثيرة سبق ذكرها، تدحض وتكذّب أقوالهم، فها هو يوحنا يقول “كان الكلمة”(62) وهذا بولس يكتب أيضًا ” الذي هو بهاء مجده “(63) وأيضًا ” الكائن فوق الكل الهًا مباركًا إلى الأبد. آمين “(64).
25ـ كان من الأفضل لهم أن يهدأوا ويصمتوا، ولكن بما أنهم لا يصمتون، فلا يتبقى إلاّ أن يقوم أحد بالرد بجرأة على سؤالهم الوقح. فربما عندما يرون أنفسهم وهم مقيدون بنفس هذه السخافات والضلالات، فقد يتوقفون عن الصراع ضد الحق.
وإننا ندعو الله بشدة أن يترآف علينا، ويأتى لمعونتنا لكي نتمكن من الرد عليهم عندما يتساءلون ويقولون: ” هل الله الكائن قد صار إلى الوجود في حين أنه لم يكن موجودًا؟ أم أنه كان موجودًا قبل أن يصير إلى الوجود؟ فإن كان هو كائن، فهل هو صنع نفسه أم أنه جاء من العدم وأظهر نفسه بغتة؟ “. أن مثل هذا التساؤل لهو سخيف ومنافٍ للعقل، بل أكثر من ذلك فهو ليس منافيًا للعقل فقط بل هو ملئ بالتجديف أيضًا، إلاّ أنه في الواقع لا يختلف عما هو عندهم. لأن أقوالهم الأخرى (أى جوابهم على السؤال) مليئة بكل أنواع الكفر وعدم التقوى. لأنه إن كان أحد يتساءل عن الله بهذا الأسلوب، فيُعتبر هذا تجديفًا وكفرًا شنيعًا، فإنه يُعتَبر أيضًا تجديفًا أن يسأل أحد نفس هذه الأسئلة عن كلمته. فلأجل دحض مثل تساؤلهم الأحمق وغير المعقول هذا، فمن الضرورى إذن أن نجيب هكذا: إن الله كائن وهو كائن منذ الأزل، وحيث إن الآب كائن دائمًا، فإن بهاءه أيضًا الذي هو كلمته، هو أزلى كذلك، وأيضًا فإن الله الكائن، عنده الكلمة من ذاته وهو أيضًا كائن.
فلا الكلمة أتى الى الوجود فيما بعد، أى بعد أن لم يكن موجودًا من قبل، ولا الآب كان في وقت ما بدون كلمة. لأن التجاسر المتهور على الأبن يؤدى إلى التجديف على الآب، كما لو كان قد ابتدع لنفسه من خارجه حكمة وكلمة وأبنًا. لأنك أن استخدمت واحدة من هذه ا(الأوصاف الثلاثة)، فإنما هي تعنى المولود من الآب كما سبق أن قيل.
ولذلك فإن سؤالهم هذا يعتبر متناقضًا، ولأنهم ينكرون الكلمة (مصدر العقل)، فمن الطبيعى أن يكون سؤالهم مناقضًا للعقل والمنطق.
وكما أنه عندما يرى أحدهم الشمس، فيأخذ في التساؤل عن بهائها ويقول: “هل ما هو كائن (أى الشمس)، قد صَنَع ما هو غير موجود أم ما هو موجود” فمثل هذا الشخص الذي يسأل هكذا يُعتَبر أنه لا يفكر تفكيرًا سليمًا، بل يُعتَبر خَرقًا فاقد الّلب، لأنه يتصور أن ما هو صادر بكليته عن النور، أنه من خارج النور، ويتساءل عنه قائلاً متى؟ وأين؟ وعندما؟ فإن كانت (الشمس) قد صُنِعَت، فإنه يتصور مثل هذه الأشياء عن الابن وعن الآب، ويأخذ في التساؤل عنهما بنفس الطريقة ولكن تساؤله يكون بجنون أعظم بكثير، متصورًا أن الآب جلب إليه الكلمة من خارج ذاته، ويقول عن الذي هو بطبيعته مولود، إنه مخلوق، وهو يجادل بذهن مبلبل قائلاً “إنه لم يكن موجودًا قبل أن يولد” فليسمعوا الجواب على سؤالهم، فإن الآب الكائن قد صنع الابن الكائن، لأن ” الكلمة صار جسدًا ” (يو14:1). وبينما هو ابن الله فقد جعله ابن الانسان أيضًا عند انقضاء الدهور، إلاّ إذا قالوا حسب تعليم الساموساطى(65)، أنه لم يكن موجودًا قبل أن يصير انسانًا، ويكفيهم هذا ردًا منا على سؤالهم الأول.
26ـ يا معشر الآريوسيين، وأنتم تذكرون نفس أقوالكم، خبّرونا: “هل الذي هو كائن، في حاجة إلى مَنْ هو غير كائن، أم إلى من هو كائن، لأجل خلقة كل الأشياء؟” لأنكم قلتم أنه صاغ لنفسه الابن كأداة لكي يخلق بواسطته كل الأشياء. أيهما أفضل، أذن هل الذي يحتاج أم الذي يسد الاحتياج؟
أم أن كلاً منهما يستكمل احتياج الواحد للآخر؟ لأنه بقولكم مثل هذا الكلام فإنكم تثبتون ضعف الخالق، إن كان لا يقوى وحده على أن يخلق كل الأشياء بل يبتكر لنفسه أداة من الخارج، كما لو أن نجارًا أو صانع سفينة لا يستطيع أن يعمل أى شيء بدون مطرقة أو منشار. هل هناك، إذن، ما هو أكثر كفرًا من هذا؟ أو ما الذي يدعو عمومًا للانشغال بمثل هذه الأمور المخيفة، إذا كان ما سبق أن قيل يكفى لاثبات أن اقوالهم ما هي إلاّ محض وهم وخيال.
الفصل الثامن: الاعتراضات والرد عليها (بقية)
وأما من جهة تساؤلهم الآخر الشديد في سخافته وحماقته وهو التساؤل الذي وجّهوه الى النسوة الغريرات. وحتى بخصوص هذا التساؤل، فلم يكن ينبغى أن يجاب عليه من أحد بما سبق أن قلناه فقط، فإنه لا يجب مقارنة الولادة التي من الله بالولادة في طبيعة البشر.
ولكن جدير بنا أن نرد عليهم بهذا الأسلوب. لكي يدينوا أنفسهم بخصوص هذا الأمر: ولذلك نقول: إنه من المؤكد، لو أنهم سألوا الوالدين عن أبنهم، دعهم يفكرون من أين جاء الطفل المولود. لأنه إن لم يكن للوالد ولد قبل أن ينجبه، فإنه حتى بعد الحصول عليه لم يكن حصوله عليه طبعًا من خارجه ولا غريبًا عنه بل هو من ذات جوهره ومطابق لصورته، حتى أن هذا (الآب) يُرى في ذاك (الولد) وذاك (الولد) يُرى في هذا (الآب).
فإن كانوا ينتقون عنصر الزمن من الأمثلة البشرية عن الولادة فلما لا يأخذون بالمِثل من هذه الأمثلة البشرية، أن الأبناء يولدون بحسب طبيعة آبائهم ومن ذاتهم، بدلاً من أن يعملوا (أى الآريوسيين) كالحيّات التي تنتقى من الأرض فقط، ما يلائم أن يصير سمًّا.
فكان إذن من الواجب، أنهم حينما يتباحثون مع الوالدين قائلين لهم: “هل كان لك ولد قبل أن تنجبه؟” كان ينبغى أن يضيفوا ويقولوا: “إن كنت قد حصلت على ولد، فهل أنت اشتريته من الخارج كما تشترى بيتًا أو أى ممتلكات أخرى؟” وحينئذ فإنهم يجيبونك قائلين “إنه ليس من خارجى، بل هو من ذاتى، لأن الممتلكات هي من خارج وتنتقل من واحد إلى أخر، أما الابن فهو منى من ذات جوهرى ومطابق له، حيث إنه لم يأت إلى من آخر، بل هو قد وُلِدَ منى، ولهذا السبب فانى بكل كيانى موجود فيه. بينما أظل أنا نفسى كما أنا”.
لأن هذا هو واقع الحال، حتى إن اختلف الوالد (عن الله الآب) من ناحية الزمن، لأنه كإنسان قد أتى الوجود فىالزمن، ولكنه هو أيضًا كان يمكن أن يكون عنده ابنه موجود معه دائمًا، لو لم تمنعه طبيعته من ذلك، أى لو كانت القدرة الإنجابية لا تعوقه عن ذلك.
حقًا أن لاوى كان لا يزال في صلب جده الأكبر (إبراهيم) (اظر عب5:7 –10) قبل أن يُولَد هو، وقبل أن يُولَد جده (اسحق). إذن حينما يبلغ الإنسان هذه السن الملائمة، التي تمكّنه فيها الطبيعة من الإنجاب، فإن المرء يصير حالاً، أبا لابن يولد منه، ما دامت الطبيعة لا تعوقه.
27ـ ك إن كانوا عندما يسألون الوالدين عن الأولاد، ويعرفون منهم بأن الأولاد الذين بالطبيعة ليسوا من خارج، بل هم من والديهم، دعهم إذن يعترفون أيضًا بخصوص كلمة الله بأنه من الآب كليّة.
وعندما يجادلون بخصوص الزمن، دعهم يقولون ما الذي يمنع الله من أن يكون هو أبو الابن على الدوام ـدعهم يقولون ما الذي يمنعه من ذلك (لأنه ينبغى البرهنة على أنهم كافرين مما يسألون عنه وهم ساخرون)، لأنه قد تم الاقرار والاعتراف بأن كل ما هو مولود إنما يأتى من أب.
إذن فهُم مثلما سألوا النساء عن الأزمنة، دعهم أيضًا يسألون عن الشمس بخصوص اشعاعها، وعن اليبنوع بخصوص الماء الذي يتدفق منه، وذلك لكي يحكموا كلية على أنفسهم، عندما يفكرون شيئًا من هذا القبيل عن الله، وذلك حتى يتعلّموا أنه بالرغم من أن كل هذه الأشياء مولودة، إلاّ أنها كائنة دائمًا مع تلك الأشياء التي خرجت منها.
فإن كان مثل هؤلاء الوالدين لهم مع أبنائهم، قرابة بالطبيعة، وأيضًا “وجود دائم” معهم، فإذا كانوا يظنون أن الله أقل من المخلوقات. فلماذا لا يصرحون بكفرهم علانية؟ ولكن إن كانوا لا يتجاسرون أن يقولوا هذا علانية، بينما أن الابن يُعتَرف به بأنه ليس من خارج (الآب)، بل هو مولود بالطبيعة من الآب، وأنه لا يوجد أى شيء يعوق الله (لأن الله ليس مثل الإنسان، بل هو أعظم من الشمس، بل بالحرى فإنه إله الشمس)، فيتضح من ذلك أن الكلمة هو من الآب وأنه موجود معه دائمًا، والذي بواسطته قد أبرز الآب إلى الوجود كل الأشياء التي لم تكن موجودة من قبل. ولأن الابن إذن لم يأت من العدم بل هو أزلى ومن الآب، فإن هذا يثبت الأمر نفسه.
أما سؤال الهراطقة الموجّه للوالدين. فإنه يكشف خبثهم وسوء نيتهم. فأنهم عرفوا ما هو بحسب الطبيعة، والآن قد تم فضحهم بخصوص موضوع الزمن.
28ـ لادة الله لا يجب أن تقارن بولادة البشر، وكذلك لا يجب إعتبار ابن (الله) جزءًا من الله، أو إعتبار أن الولادة تعنى أى ضعف أو تقسيم على الإطلاق. وإذ نحن نكتفى بما سبق لنا قوله، فإننا الآن نعيد نفس الكلام وهو أن وجود الله ليس كوجود الإنسان.
فإن البشر يَلِدون بالشهوة، حيث أن لهم طبيعة متغيرة، وهم ينتظرون إلى الوقت (للولادة)، نظرًا لضعف طبيعتهم ذاتها، ولكن لا يمكن أن نقول هذا الكلام بالنسبة لله. لأن الله غير مركب من أجزاء، بل بسبب كونه غير منقسم أو متغير. كما أنه بسيط غير مركّب[1]. لذلك فهو أبو الابن دون حدوث تغيير فيه ودون انفصال. وهذا الأمر يوجد بشأنه دليل وبرهان قاطع من الكتب الإلهية.
لأن كلمة الله هو ابنه، والابن هو كلمة الآب وحكمته، فإن الكلمة والحكمة ليس مخلوقًا، وليس هو جزءًا من ذلك الذي له كلمته (أى الآب)، ولا هو مولود تقسيم أو انفصال. فكلا (اللقبان) وحّدهما الكتاب وأعطاهما لقب “ابن” بصورة مؤكدة، لكي يُبشّر به أنه المولود الطبيعى والحقيقى للجوهر، وذلك حتى لا يظن أحد أن المولود هو بشرى. بينما هو (الكتاب) يقصد جوهره، ولهذا يقول الكتاب أيضًا أنه الكلمة والحكمة والبهاء، وذلك لكي ندرك من هذا أن الولادة بلا تقسيم أو انفصال، وأنها أزلية ولائقة بالله. إذن فأى تغيير أو انفصال هناك، أو أى جزء من الآب أيضًا يجب أن يسألوا الرجال عن الكلمة. وذلك لكي يعرفوا أن القول الذي ينطقون به ليس تغييرًا لهم. ولا هو جزءًا من عقلهم. فإن كانت أيضًا يجب أن يسألوه الرجال عن الكلمة. وذلك لكي يعرفوا أن القول ينطقون به ليس تغييرًا لهم. ولا هو جزءًا من عقلهم. فإن كانت كلمة البشر بمثل هذه الكيفية. رغم أنهم يخضعون للتغيير والشهوة. ورغم كونهم متجزئين، فلماذا يفكرون في التغيير والإنقسام بالنسبة لله غير الجسدى وغير المنقسم. لكي عن طريق التظاهر بتوقير الله، ينكرون ولادة الابن الحقيقية والطبيعية؟
إن المولود الذي هو من الله ليس نتيجة انقسام أو تغيير. ويكفى ما سبق لإثبات هذا، خاصة وقد تم الآن إثبات أن الكلمة ليس مولودًا بحسب الضعف أو التقسيم. فليسمعوا أيضًا نفس الكلام عن الحكمة. فإن الله ليس مثل الإنسان، ولا يتخيلوا عنه شيئًا بشريًا. لأن البشر خلقوا لتقبّل الحكمة، أما الله، فهو لا يشترك في شئ، بل هو نفسه أب لحكمته الخاصة، التي يلقب المشتركون فيها عادة بلقب حكماء. والحكمة نفسها أيضًا ليست تقسيم أو تغييرًا، وهي ليست جزءًا ولكنها المولود الذاتى للآب، لذلك فهو دائمًا أب، وخاصية الآب ليست خاصية أضيفت لله فيما بعد، وذلك لكي لا يعتبر أنه خاضع للتحول، لأنه إن كان من الصلاح أن يكون الله أبًا، ولكنه لم يكن دائمًا أبًا إذن، فواعجبى ألاّ يكون الصلاح موجودًا في الله دائمًا!.
29ـ يقولون “ها هو الله كان على الدوام خالقًا، وإن قدرته على الخلق ليست إضافية بالنسبة له، فهل إذن لأن الله خالق، تكون مخلوقاته أزلية، وهل يكون من الصواب أن نقول عن هذه المخلوقات أنها كانت موجودة قبل أن توجد؟” يا لجنون الآيوسيين، فأى مشابهة هناك بين الابن والخليقة، حتى يقولوا عن مَنْ هو خاص بالآب نفس ما يقولونه عما يخص المخلوقات؟! وكيف يُصّر هؤلاء على جهلهم بعد ما تبيّن مما سبق الفرق العظيم بين المولود والمخلوق؟ لذلك فمن الضرورى أن نعيد نفس الكلام ونقول إن الخليقة هي من خارج الخالق، كما سبق القول، في حين إن الابن هو المولود الذاتى من الجوهر، لذلك فليس هناك حاجة لوجود الخليقة دائمًا، لأن الخالق يصنعها حينما يشاء، أما المولود فلا يخضع في وجوده للمشيئة، بل هو خاص بذات الجوهر، فالصانع يُلقّب صانعًا ويكون كذلك، حتى لو لم تكن له مصنوعات بعد، أما الأب فلا يلقب أبًا ولا يكون كذلك ما لم يكن له ابن موجود.
أما إن كانوا يبحثون الأمر بفضول وحب استطلاع قائلين، لماذا لا يخلق الله على الدوام، وهو القادر أن يخلق دائمًا، فإن جسارتهم هذه جسارة المجانين، لأن ” من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرًا ” (رو34:11) أو ” كيف تقول الجبلة للخزاف، لماذا صنعتنى هكذا؟ ” (رو20:9) ولكن لكي لا نصمت عن الرد على منطقهم الضعيف هذا، فليسمعوا: أنه بالرغم من أن الله له القدرة على الدوام أن يخلق، إلاّ أنه ليس في استطاعة المخلوقات أن تكون أزلية، لأن هذه المخلوقات وُجِدَت من العدم ولم تكن موجودة قبل أن تُخلَق. فكيف يمكن إذن لهذه المخلوقات التي لم تكن موجود قبل أن تُخلَق، أن تكون موجودة مع الله الموجود دائمًا؟
ولذلك فإن الله وهو يهتم بما فيه منفعة الخلائق، فإنه قد خَلَقَ كل الأشياء، عندما رأى أن هذه الأشياء يمكنها أن تبقى بعد أن تُخلَق.
وكما أنه قادرًا من البدء، أن يُرسِل كلمته في أيام آدم أو في أيام نوح، أو في أيام موسى. ولكنه لم يرسله إلاّ في آخر الدهور، لأنه رأى أن هذا نافع لكل الخليقة، هكذا أيضًا فإنه خَلَقَ المخلوقات عندما أراد، وعندما كان هذا نافعًا لهم.
أما الابن ـ فلكونه غير مخلوق، بل هو من ذات جوهر الآب، فإنه موجود دائمًا.
ولأن الآب موجود دائمًا، فلابد أن يكون الذي هو من ذات جوهره، موجود دائمًا أيضًا، والذي هو حقًا كلمته وحكمته.
أما الخلائق، وإن لم تكن قد وُجِدَت بعد، فإن هذا لا يُنقِص من شأن الخالق، لأن له القدرة أن يَخلِقُ عندما يشاء، أما المولود فإن كان لا يكون موجودًا على الدوام مع الآب، فإن هذا يُنقِص من كمال جوهره. ولأجل هذا فإن المخلوقات قد خُلِقَت عندما شاء هو من خلال كلمته. أما الإبن فهو ـ على الدوام ـ المولود الذاتى لجوهر الآب.
الفصل التاسع: عبارة “غير المخلوق”
30ـ إن أقوالنا هذه تبهج المؤمنين، ولكنها تحزن الهراطقة الذين يرون هرطقتهم وقد دُحِضَت وأُبطِلَتْ، بهذه الأقوال.
وأيضًا فإن سؤالهم ذلك الذي يقولون فيه “هل هناك واحد فقط غير مخلوق (ἀγένητον) أم أثنان؟” يثبت أن تفكيرهم ليس مستقيمًا، بل هو مريب وملئ بالغش والخداع. فإنهم لا يسألون هذا السؤال من أجل أكرام الآب، بل من أجل أهانة الكلمة. فلو أن أحد الناس وهو يجهل خبثهم ودهاءهم أجابهم بأن غير المخلوق هو واحد، ففى الحال ينفثون سمومهم قائلين: ” إذن فالابن ينتمي إلى المخلوقات، وحسنًا ما قلناه بأنه لم يكن موجودًا قبل أن يولد “، وهكذا فإنهم يخلطون كل الأشياء وبهذا يثيرون الإضطرابات، وذلك لكي يفصلوا الكلمة عن الآب، ويحسبوا الذي هو خالق الكل، أنه من بين المخلوقات.
إنهم يستحقون الإدان والتنديد بهم، أولاً، لأنهم بينما يلومون الأساقفة الذين اجتمعوا في نيقية(66) بسبب استخدامهم لعبارات ليست من الكتاب المقدس ـ رغم أنها ليس عبارات مضادة للإيمان بل قد وضعت بهدف فضح كفرهم، فقد وقعوا هم أنفسهم في نفس الأمر، أى أنهم نطقوا بعبارات ليست من الكتاب المقدس وابتدعوا إهانات ضد الرب، ” وهم لا يعرفون ما يقولونه ولا ما يقررونه ” (1تيمو7:1).
لذلك فليسألوا إذن، اليونانيين، الذين سبق أن سمعوا منهم ما قالوه (لأنه ليس من الكتب المقدسة بل من اختراعهم) وذلك لكي يسمعوا منهم أيضًا، كم للفظ (غير المخلوق ـ غير الصائر) من معان عديدة، وعندئذ سيتعلمون أنهم لا يعرفوا حتى أن يسألوا السؤال الصائب، ولا حتى بخصوص الأشياء التي يتحدّثون عنها.
لأنى أنا أيضًا ـ بسببهم ـ قد سألت وعَرِفت أن (عبارة)، “غير المخلوق” (غير الصائر) يقصد بها ذلك الذي لم يصر له وجود، ولكنه من الممكن أن يصير. وذلك مثل الخشبة التي لم تكن قد صارت سفينة بعد ولكنها من الممكن أن تصير كذلك. وأيضًا فإن “غير المخلوق” (أو غير الصائر)، هو ذاك الشئ الذي لم يصر بعد، وليس من الممكن أن يصير أبدًا، مثل المثلث الذي لا يمكن أن يصير مربعًا أو العدد الزوجى أن يصير فرديًا. ذلك لأن المثلث لم يصر قط مربعًا ولا يمكن أن يكونه أبدًا، كما لم يحدث قط أن صار العدد الزوجى فرديًا ولا يمكن أن يكونه.
وأيضًا يُقصَد بكلمة “غير الصائر – (غير المخلوق)” ما هو موجود، دون أن يصير من أحد، وليس له والد بالمرّة.
وقد أضاف أيضًا أستيريوس(67)السفسطى الخبيث، وهو المدافع عن هذه الهرطقة في مقالته قائلاً: بأن غير المخلوق ـ (غير الصائر)، هو الذي لم يُخلق ولكنه كائن دائمًا.
فكان ينبغى إذن حينما يسألون السؤال، أن يضيفوا ما المعنى الذي يفهمون به كلمة “غير المخلوق ـ (غير الصائر)، حتى أن الذي يسألونه يستطيع أن يجيب الإجابة الصائبة.
31ـ إن كانوا يحسبون أنهم يسألون السؤال الصائب، بقولهم “هل هناك واحد فقط غير مخلوق (غير صائر) أم اثنان؟” فإنهم أولاً سيسمعون الجواب ـ بإعتبارهم جهلة ـ أن الأشياء غير المخلوقة (غير الصائرة) كثيرة، وليس لها وجود، كما أن الأشياء التي يمكن أن تُخلق (أن تصير) هي أكثر جدًا، وغير الكائن ليس في إمكانه أن يصير كما سبق أن قيل.
أما إن كانوا يسألون عن نفس الموضوع، على غرار أستيريوس بأن غير المخلوق (غير الصائر) هو الذي لم يُخلَق ولكنه كائن دائمًا، فليسمعوا لا مرّة واحدة بل مرّات كثيرة، بأنه من الممكن أيضًا أن يقال عن الابن، إنه غير مخلوق (غير صائر) بحسب هذا المعنى المقبول عندهم، لأنه لا يُحسَب بين الأشياء المخلوقة، ولا هو مخلوق بل بالعكس فإنه كائن منذ الأزل مع الآب، كما سبق أن أتضح. وذلك رغم تقلباتهم (أى تقلبات الآريوسيين) الكثيرة، والتى ليس لها من هدف سوى أن يتكلّموا ضد الرب قائلين “أنه وُجِدَ من العدم”، وأنه “لم يكن موجودًا قبل أن يُولَد”.
وهكذا فبعد أن خُذِلوا من كل ناحية، فإنهم أخذوا يسألون أيضًا بخصوص ذلك المعنى الذي يكون بمقتضاه “غير المخلوق (غير الصائر) هو ذلك الذي يكون موجودًا، بدون أن يكون مولودًا من أحد، وليس له أب خاص به” فأنهم سيسمعون منا أيضًا أن المقصود “بغير المخلوق” (غير الصائر) هو بهذا المعنى واحد فقط وهو الآب ولن يحصلوا على أى شيء أكثر مما سمعوه.
لأن القول بأن الله “غير مخلوق” (غير صائر) بهذا المعنى، لن يبرهن القول بأن الابن مخلوق (صائر)، وفقًا للبراهين السابقة. إذ يتضّح أن الكلمة هو مثل ذاك الذي وَلَدَه. وتبعًا لذلك، فإن كان الله غير مخلوق (غير صائر)، فصورته ـ أى كلمته وحكمته ليس بمخلوق بل هو مولود. لأنه أى مشابهة هناك بين المخلوق (الصائر). وغير المخلوق (غير الصائر)؟ (لأنه ينبغى ألاّ نكل من تكرار نفس الكلام).
فإن كانوا يريدون أن يجعلوا المخلوق مشابهًا لغير المخلوق فيكون أن مَنْ يرى هذا كمَنْ يرى ذاك، فليس بعيدًا عليهم إذن أن يقولوا، إن غير المخلوق هو صورة خلائقه، وبذلك تكون كل الأشياء قد اختلطت في أذهانهم، وبذلك يساوون بين المخلوقات وغير المخلوق، وهذا يعتبر إلغاء لغير المخلوق وقياسه بقياس المخلوقات. وكل هذا إنما يفعلونه فقط لكي يحطوا من قدر الابن ويحسبونه في عداد المخلوقات.
32ـ ولكنى أظن أنهم لا يرغبون أن يستمروا مداومين على مثل هذه الأقوال، إن كانوا حقًا يشايعون أستيريوس السفسطائى. فإنه رغم اهتمامه بالدفاع عن الهرطقة الأريوسية بقوله إن غير المخلوق (غير الصائر) هو واحد، فإنه يناقضها مؤكدًا أن حكمة الله أيضًا غير مخلوق وليس له بداية وهاك بعض المقاطع مما كتبه: ” لم يقل المغبوط بولس إنه كرز بالمسيح على أنه القوّة التي لله والحكمة التي لله(68) ولكنه بدون استعمال أداة تعريف قال، قوّة الله وحكمة الله، وهكذا كرز بأن قوّة الله الذاتية، التي هي من طبيعته، والكائنة معه أزليًا، إنما هي قوّة أخرى “.
وبعد قليل أيضًا يقول ” ولكن قوّته الأزلية وحكمته التي يوضح منطق الحق إنها حقًا بلا بداية وغير مخلوقة (غير صائرة)، إنما هي واحدة بالتأكيد “. لأنه وإن كان لم يفهم كلمات الرسول فهمًا سليمًا بظنه أن هناك حكمتان، ولكنه مع ذلك بقبوله القول بحكمة مشاركة معه في الوجود دائمًا، فهو يقول إن غير المخلوق (غير الصائر) ليس واحدًا بعد، بل إن هناك غير مخلوق (غير صائر) آخر معه لأن المُشارِك في الوجود لا يتشارك في الوجود مع نفسه بل مع آخر. ولذلك فليكف أولئك المشايعون لاستيريوس عن التساؤل: “هل غير المخلوق (غير الصائر) واحدًا أم اثنان وإلاّ فإنهم سيصطدمون به في هذا الأمر ويرتابون فيه. ومن الناحية الأخرى، فإن كانوا يقاومونه في ذلك أيضًا فليكفوا عن الأعتماد على كتابه، لئلا ينهشوا بعضهم بعضًا ويفنوا بعضهم بعضًا. هذا هو ما قالوه بسبب جهالتهم، وماذا يستطيع أى شخص أن يقول أزاء مكرهم هذا؟ ومن هو الذي لن يكره بحق أولئك المتهوسين إلى هذه الدرجة؟
فما داموا لا يتجاسرون أن يقولوا صراحة “إنه من العدم”. وإنه “لم يكن موجودًا قبل أن يولد”. لذلك أخترعوا لأنفسهم عبارة “غير مخلوق” (غير صائر)، لكي بقولهم عن الابن إنه “مخلوق” (صائر)، وسط السذج البسطاء، فإنهم يقصدون نفس تعبيراتهم السابقة تلك وهي “إنه من العدم” وإنه “لم يكن موجودًا قط قبل أن يولد”. لانهم يعنون بهذه العبارات “الأشياء الصائرة والمخلوقة”.
33ـ فلو كانت لديهم الثقة في ما يقولونه، لكان من الواجب عليهم أن يظلوا ثابتين على موقفهم، ولا يتغيّرون بطرق متنوعة، ولكنهم يرفضون ذلك، ظانين أنه يمكنهم أن ينجحوا بسهولة، إذا هم أخفوا هرطقتهم تحت ستار كلمة “غير المخلوق” (غير الصائر) وفى الواقع فإن لفظة “غير المخلوق” هذه، لا تستعمل (عن الله) بالنسبة إلى الابن[2] ـ ولو أنهم يتذمرون ـ بل بالنسبة إلى المخلوقات، وهكذا يمكن أن نرى نفس الشئ في كلمة “ضابط الكل”، وكلمة “رب القوات” فلو أن الآب يضبط ويسود كل الأشياء من خلال الكلمة، والابن يملك مملكة الآب وتكون له السيادة على الكل، حيث إنه هو كلمة الآب وصورته.
فيكون واضحاُ إذن أن الابن لا يُحسَب من بين الكل، ولا يسمى الله “ضابط الكل”، “والرب” بالنسبة إلى الابن، بل بالنسبة إلى المخلوقات التي (تكوّنت) عن طريق الابن، وهي تلك التي يضبطها ويسودها بواسطة الكلمة. وهكذا فإن لفظة “غير مخلوق” لا تستعمل (عن الله) بالنسبة إلى الإبن ولكن بالنسبة إلى المخلوقات التي خُلقت عن طريق الابن، وإن هذا لصواب، حيث إنه ليس مثل المخلوقات. بل هو خالقها وصانعها بواسطة (من خلال) الإبن. كما أن لفظة “غير مخلوق” تستعمل (عن الله) بالنسبة إلى المخلوقات، هكذا أيضًا فإن كلمة “الآب” تعلن عن الابن. فإن مَنْ يسمي الله صانعًا وخالقًا وغير مخلوق، فإنه يرى ويفهم الأشياء المخلوقة والمصنوعة، أما الذي يسمى الله أبًا فإنه في الحال يُدرك الابن ويعرفه.
ولذلك فقد يدهش البعض من حبهم للجدال مع عدم تقواهم، لأنه بالرغم من أن لكلمة “غير المخلوق” معنى حسن ـ سبق أن أشرنا إليه ـ بحيث يمكن أن نذكر هذه الكلمة بورع وتقوى، أما هم فيتكلّمون بها لأجل إهانة الإبن بحسب هرطقتهم، وهم لم يقرأوا، أن الذي يُكرِم الابن، إنما هو يُكرِم الآب والذي لا يُكرم الابن، إنما هو لا يُكرِم الآب (يو23:5) لأنهم لو كان لديهم أى أهتمام – على وجه العموم – بتمجيد وتكريم الآب، لكان من واجبهم بالأحرى، أن يعترفوا بأن الله أب ويلقبونه كذلك، بدلاً من أن يسمونه بهذه الطريقة (أى يدعونه غير المخلوق)، وكان هذا سيكون أفضل وأعظم.
أما أن يسموا الله “غير المخلوق”. متخذين هذه التسمية من أعماله المخلوقة، كما سبق أن قلنا – وهكذا يلقبونه خالقًا وصانعًا فقط، ظانين أنهم بهذا يستطيعون أن يعتبروا الكلمة مخلوقًا حسب أهوائهم. أما الذي يدعو الله أبًا، فإنه يسميه هكذا نسبة إلى الإبن بدون أن ينكر أنه ما دام يوجد ابن، فبالضرورة فإن كل المخلوقات قد خُلقت عن طريق الإبن. وأولئك عندما يسمون الله “غير المخلوق” فإنما يشيرون إليه فقط من جهة نسبته إلى المخلوقات، وهم بذلك لا يعرفون الابن مثلهم مثل الامميين. أما الذي يدعو الله أبًا، فإنه يسميه هكذا نسبة إلى الكلمة. والذي يعرف الكلمة، فإنه في نفس الوقت يعرف أنه الخالق، ويفهم أنه كل شيء به قد كان (قد صار) (يو3:1).
34ـ لذلك فإنه بالحق سيكون أكثر تقوى، لو أنهم أشاروا إلى الله (الآب) مبتدئين من الابن، وهكذا يلقبونه أبًا، بدلاً من أن يسمونه نسبة إلى أعماله فقط فيلقبونه “غير المخلوق”. لأن هذا اللقب نسبة إلى أعماله فقط فيلقبونه “غير المخلوق”. لأن هذا اللقب (الأخير) يشير فقط إلى كل خليقة ـ كما سبق أن قلت ـ وعموما فإن هذا اللقب يشير إلى كل الأعمال التي خُلِقَت بإرادة الله من خلال الكلمة. في حين أن لقب الآب يفهم وله دلالته فقط بالنسب إلى الابن. وبقدر ما يختلف الكلمة عن سائر الموجودات، فبمثل هذا القدر بل وأكثر. يكون الاختلاف بين أن يدعى الله “أبًا”، وبين أن يدعى “غير المخلوق”.
لأن هذا اللقب (الأخير) غير مستقى من الكتب المقدسة بل ويثير الريبة والشك، لأنه يحوى في الواقع معانٍ متعدّدة، لدرجة أنه في حالة التساؤل عن هذا اللقب، فإن الفكر ينتابه الحيرة والإضطراب، أما لقب “الآب” فهو لقب بسيط مستقى من الكتاب المقدس، وهو لقب أكثر صوابًا وحقًا، وهو يشير إلى “الابن” فقط.
أما لقب “غير المخلوق” فهو كلمة موجودة عند اليونانيين (الامميين) الذين لم يكونوا يعرفون “الابن”. أما لقب “الآب” فقد صار معروفًا إذ قد أنعم به الرب (يسوع) علينا. لأنه قد عَرِفَ ـ في الواقع ـ ابن من هو، عندما قال “أنا في الآب والآب فى” (يو10:14) وأيضًا ” مَنْ رآنى فقد رأى الآب ” (يو9:14) وأيضًا “أنا والآب واحد” (يو30:10)، ولا يوجد في أحد هذه الشواهد أى إشارة بتلقيب الآب بلقب “غير المخلوق” بل حين علّمنا أن نصلى، لم يقل حينما تصلون قولوا: أيها الإله غير المخلوق، بل بالحرى قال ” حينما تصلون قولوا أبانا الذي في السموات ” (مت9:6) وهو بهذا قد أراد أن يركّز على أساس إيماننا عندما أمرنا أن تكون معموديتنا ليس باسم “غير المخلوق” والمخلوق ولا باسم “الخالق” و “المخلوق” بل باسم ” الآب والابن والروح القدس ” (مت19:28) لأننا وإذ نحن من بين المخلوقات، نصير هكذا مكتملين وبهذا نصير أبناء، وإذ ندعو اسم الآب، فإننا من هذا (الاسم) نعرف أيضًا الكلمة الذي هو من ذات الآب. إذن فما يجادلون به بخصوص لفظة “غير المخلوق”، إنما يدل على عبث، وليس هو أكثر مما هو في خيالهم وحده.
الفصل العاشر: عدم تغيّر الابن
35ـ أما بخصوص قولهم إن الكلمة متغيّر، فان مناقشة هذا الأمر غير ذات نفع، لأنه يكفى فقط أن أسجل ما يقولونه لتوضيح مدى جسارتهم وعدم تقواهم. فها هي الأقوال التي يهذون ويثرثرون بها متسائلين: ” هل هو حر (في ذاته) أم هو ليس كذلك؟ هل هو صالح من تلقاء نفسه بحسب هذه الحريّة الذاتية وهل يستطيع بذلك أن يتغيّر ـ إن أراد ـ لكونه من طبيعة متغيّرة أم أنه مثل الحجر والخشب، لا يملك حرية الحركة والإتجاه إلى هذه الناحية أو تلك؟ “فليس غريبًا على هرطقتهم أن يتكلّموا ويفكروا بمثل هذه الأمور. ففى احدى المرات اخترعوا لأنفسهم مثل هذه الأقوال التي تناسب المخلوقات، وحيث إنهم في مجادلتهم مع رجال الكنيسة يستمعون منهم عن كلمة الآب الوحيد الحقيقى. ومع ذلك يتجاسرون أن يتفوّهوا عنه بمثل تلك الأقوال، فمَن يستطيع اذن أن يرى أدنس من هذه العقيدة؟
ومَن هو الذي بمجرد استماعه لهؤلاء، لا ينزعج ويصم آذانه ـ حتى إن لم يكن في وسعه أن يدحض أقوالهم ـ ويقف مشدوهًا من تلك الأقوال التي يرددها هؤلاء، وهو يستمع إلى كلماتهم المبتدعة التي يعتبر مجرّد النطق بها كفرًا وتجديفًا؟ لأنه إن كان الكلمة متغيرًا وقابلاً للتحوّل، ففى أى نقطة إذن سيتوقف (عن التغيير)، وماذا ستكون نهاية عملية تطوره هذه؟ وكيف يمكن أن يكون المتغيّر مشابهًا لغير المتغير؟ وكيف يمكن أن يُعتَبر الذي رأى المتغيّر أنه قد رأى غير المتغيّر؟ وما هي الحالة التي يجب أن يصير إليها حتى يستطيع الواحد منا أن يرى الآب فيه؟
إذ يكون من الجلى (حسب أفكارهم) أننا لن نرى الآب فيه في كل الأوقات، إذ يكون الابن دائم التغيّر، ويكون من طبيعة متغيّرة دائمًا. ولأن الآب غير متغيّر وغير متحوّل، وهو دائمًا هو نفسه كذلك (أى بدون تغيّر)، أما الابن فإن يكن بحسب أفكارهم متغيرًا. وهو ليس دائمًا هو ذاته، بل تكون له طبيعة دائمة التغيّر، كيف يمكن أن يكون مثل هذا هو صورة الآب، وهو ليس مثله في عدم التغيّر؟ وكيف يمكن أن يكون (الابن) في الآب كلية، إن كان هدفه وقصده مشكوكًا فيه؟ بل ربما بسبب كونه متغيّرًا، ودائم التقدّم، فلا يكون كاملاً بعد.
ولكن فليتلاشى مثل هذا الجنون الذي للآريوسيين، أما الحق فليلمع ويبرق ليكشف أنهم مجانين.
لأنه كيف لا يكون كاملاً هذا الذي هو مساوٍ لله؟ أو كيف لا يكون غير متغيّر هذا الذي هو واحد مع الآب، وهو نفسه ابنه من ذات جوهره؟ ولأن جوهر الآب غير متغيّر، فبالضرورة يكون نتاجه الذاتى أيضًا غير متغيّر.
فإن كانوا يفترون هكذا بنسبتهم التغيّر للكلمة. فليتعلموا مدى الخطورة الكامنة في فكرهم، لأن ” الشجرة تعرف من ثمرها ” (مت33:12)، ولهذا أيضًا ” فإن من رأى الابن فقد رأى الآب ” (يو9:14)، ولهذا أيضًا فإن معرفة الابن هي أيضًا معرفة الآب.
36ـ ولذلك فإن صورة الله غير المتغيّرة ينبغى أن تكون ثابتة غير متغيّرة، لأن ” يسوع المسيح هو هو أمس واليوم والى الأبد ” (عب8:13) وداود يقول مترنمًا به: ” أنت يا رب منذ البدء أسست الأرض، والسموات هي عمل يديك. هي ستتلاشى وأنت ستبقى، وكلها كثوب ستبلى وكرداء تطويها فتتغيّر ولكن أنت أنت وسنوك لن تنتهى ” (مز26:102ـ28، و2عب10:1ـ12).
والرب نفسه يقول عن نفسه بواسطة النبى ” انظروا إليّ فترون أنى أنا هو ” (تث39:32) وأيضًا ” لا أتغيّر ” (ملاخى6:3) وربما يقول أحد أن المقصود هنا هو الآب، ولكنه يناسب أن يُطلَق هذا على الابن أيضًا، وخاصة لأنه حينما يصير إنسانًا، فإنه يظهر شخصيته كما هي ويُظهر عدم تغيّره، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يتصوّرون أنه بما أنه أتخذ جسدًا فإنه قد تغيّر وصار آخرًا.
إن القديسين أصدق عهدًا وأمانة من سوء نية عديمي التقوى فكم بالاحرى يكون الرب. فإن الكتاب ـ كما جاء في قراءة المزمور سالف الذكر ـ عن طريق اشارته إلى السماء والأرض، يذكر أن طبيعة كل المخلوقات وكل الكائنات، هي متغيّرة ومتحوّلة وبإستبعاده الابن عنها (أى عن المخلوقات)، فإنه يبيّن بأنه (أى الابن) ليس مخلوقًا على الإطلاق بل هو بالاحرى يغيّر الأشياء، بينما هو نفسه لا يتغيّر. كما يعلّم (الكتاب) بقوله “أنت أنت وسنوك لن تنتهى” (عب12:1) أنه (أى الابن) لا يتبدّل ولا يتغيّر. وهذا حقًا أمر طبيعى، لأن الأشياء المخلوقة بما أنها نشأت من العدم، ولكونها لم تكن كائنة قبل أن تخلق، لذلك فإن لها طبيعة متغيّرة حيث إنها عمومًا قد خُلِقَت من العدم. أما الابن فإنه كائن في الآب وهو من ذات جوهر الآب، لذلك فه غير متغيّر أو متبدّل مثل الآب نفسه.
لأنه ليس من العدل أن يقول أحد أن من جوهر غير المتغيّر يولد كلمة متغيّر، وحكمة قابلة للتحوّل. إذ كيف يمكن أن يكون هو الكلمة أن يكن قابلاً للتغيّر؟ أو كيف يمكن أن تكون حكمة تلك التي تكون قابلة للتحول؟ إلاّ إذا كان عرضًا في الجوهر ـ كما ربما يريدون أن يبيّنوا أنه هكذا: أى أنه في حالة جوهر ما، تكون هناك نعمة ما أو ممارسة فضيلة بشكل عارض، وهكذا يسمون هذا أنه كلمة وابن وحكمة بحيث يكون قابلاً للانتقاص منها أو الاضافة عليه. لأنه يعتقدون بمثل هذه الأمور. وكثيرًا ما تحدّثوا عنها. إلاّ أن عقيدتهم هذه ليست من الإيمان المسيحى لأنهم لا يظهرون أنه الكلمة وابن الله بالحقيقة، ولا (يُظهرون) أن الحكمة هي حكمة حقيقية.
لأن ما يتحوّل ويتبدّل وليس ثابتًا على نفس الحال الواحد كيف يمكن أن يكون حقيقيا؟.
بينما يقول الرب ” أنا هو الحق ” (يو6:14)، فإن كان الرب نفسه يقول هذا القول عن ذاته وهو يشير بهذا الى وجوب عدم قابليته الذاتية للتغيّر. والقديسون تعلّموا نفس هذه الحقيقة وشهدوا بها. فان كانت الأفكار عن الله تعرف هذا الأمر بورع وتقوى فمن أين إذن
ابتدع هؤلاء الناس عديمو التقوى، هذه الآراء؟ نعم. أنهم من قلوبهم، يتقيأون هذا الفساد.
الفصل الحادى عشر: شرح نصوص: أولاً: فيلبى 9:2، 10 “لذلك رفّعه الله أيضًا”
37ـ لكن بما أنهم يتعلّلون بالأقوال الإلهية، ويفرضون عليها تفسيرًا منحرفًا محرّفين أياها بحسب فكرهم الخاص. لذلك صار من الضرورى أن نرد عليهم من أجل أن تثبت صحة الأقوال الآلهية، ونوضح أنها تحوى الفكر المستقيم، بينما أولئك يفكرون تفكيرا ضالاً.
فهم إذن يقولون أن الرسول كتب يقول ” لذلك مجده الله مجدًا عاليًا. وأعطاه اسمًا فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ” (فى9:2،10). كما يقول داود ” من أجل ذلك مسحك الله ألهك، بزيت الإبتهاج أكثر من شركائك ” (مز7:45، عب9:1). ويضيفون كما لو كانوا يقولون شيئًا حكيمًا ـ هكذا “لو أنه “لذلك” مُجَّد وحصل على نعمة، “ومن أجل ذلك” قد مُسِحَ وحصل على أجر اختياره الحر. وبما أنه أنجز الأمر بمشيئته الحرة، فإنه يكون بلا شك ذا طبيعة متغيّرة. وهذا ما تجاسر يوسابيوس وآريوس ليس فقط على قوله بل على كتابته أيضًا. أما مَنْ يشايعونهما فإنهم لا يجفلون عن ترديد ذلك وسط السوق وهم لا يرون قدر الجنون الذي يحويه قولهم.
لأنه إن حصل على ما كان لديه كأجر لاختياره الحر، فأنه لم يكن ليحصل عليه لو لم يكن عمله هذا عن احتياج وعوز، إذن بما أنه قد حصل على ما كان لديه بسبب فضيلته وتقدمه وتحسنه، وبسبب هذا فمن الانصاف أن يلقب بلقب ابن ولقب إله، دون أن يكون ابنا حقيقيًا لأن الذي يكون من شخص ما بحسب الطبيعة، فإنه يكون مولودًا حقيقيًا، مثلما كان اسحق بالنسبة لابراهيم، ويوسف بالنسبة ليعقوب، والشعاع بالنسبة الى الشمس، أما الذين يدعون (أبناء) بالنسبة للفضيلة والنعمة، فإنهم يحصلون على النعمة التي يكتسبونها بدلاً من الولادة الطبيعية، وهم شى آخر غير ما أُعطى لهم.
وذلك مثل الناس الذين نالوا الروح بحسب المشاركة والذين قال عنهم ” ولدت بنين ونشأتهم. أما هم فتمردوا عليّ ” (إش2:1 س) ولكن بما أنهم ليسوا أبناء بحسب الطبيعة، لذلك، فإنهم بمجرد أن يتغيروا ينزع منهم الروح، ويتبرأ منهم. ولكنهم مرة أخرى ـ عندما يتوبون فإنه الله الذي كان قد أعطاهم النعمة في الأول، فأنه بنفس الطريقة، يعطيهم النور مرة أخرى ويدعوهم أبناء ثانية.
38ـ فإن كانوا يقولون هكذا أيضًا عن المخلّص، فيتبع هذا أنه لا يكون (مخلّصًا) حقيقيًا، وأنه ليس إلهًا. وليس ابنًا ولا هو مثل الأب، ولا يكون له علاقة على الإطلاق مع الله الآب بحسب الجوهر بل بمجرد إعطاء نعمة له. أى أن يكون الله هو خالق له بحسب الجوهر مشابهًا في ذلك كل المخلوقات. فإن كان هو هكذا، كما يقول هؤلاء، فيتضّح أنه لم يكن له اسم “ابن” منذ البدء، إن كان قد حصل على هذا الاسم كمكافأة على أعماله وتقدمه، أى أنه حصل على هذه المكافأة ليس بسبب تقدم آخر، بل بسبب ما أظهره عندما صار انسانًا، وأتخذ صورة عبد، لأنه عندئذ، حينما صار “مطيعًا حتى الموت” فإنه كما يقول النص “مجده مجدًا عاليًا، وحصل على الاسم كنعمة، “لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة”.
فماذا إذن كان قبل هذا (أى قبل أن يصير إنسانًا)، إن كان الآن يرتفع، وقد بدأ الآن أن يُعبَد، والآن دعى ابنًا عندما صار انسانا؟ لأنه (بهذا) يبدو أن الجسد لم يَترَقَ قط، بل بالأحرى أنه هو الذي ترقى بواسطة الجسد، فإن كان قد مُجّد مجدًا عاليًا وسمى ابنًا عندما صار إنسانًا ـ وذلك بحسب سوء نيتهم ـ فماذا كان إذن قبل هذا؟ ـ فهناك حاجة ملّحة أن نسألهم مرة أخرى ـ وذلك لكي تتضح النتيجة التي يصل إليها كفرهم، لأنه أن كان الرب هو الله وهو الابن وهو الكلمة، ولكنه لم يكن هكذا قبل أن يصير إنسانًا، عندئذ كما قلنا – إما أنه كان شيئًا آخر غير هذه (الصفات). ثم اشترك فيها بعد ذلك بسبب فضيلته. وإلاّ فأنهم مضطرون أن يقولوا البديل ـ (الأمر الآخر) الذي سيرتد على روؤسهم وهو أنه لم يكن موجودًا قبل هذا، ولكنه كان إنسانًا بالتمام حسب الطبيعة وليس أكثر. ولكن هذا الفكر ليس من الكنيسة. ولكنه فكر الساموساطى واليهود المعاصرين.
لماذا إذن، وهم يعتقدون مثل اليهود، لا يختتنون مثلهم، بل يتظاهرون بالمسيحية، بينما هم يحاربونها، لأنه لو كان غير موجود، أو لو كان موجودًا ثم رقى فيما بعد، فكيف خُلِقَت كل الأشياء بواسطته، وكيف يفرح به الآب لو لم يكن كاملاً (أم30:9)؟ ومن الناحية الأخرى، ان كان هو قد ترقى الآن، فكيف كان يبتهج أمام الآب قبل أن يترقى؟ وان كان قد حصل على العبادة بعد موته، فكيف يظهر أن ابراهيم يسجد له في الخيمة، وموسى يسجد له في العليقة وكما رأى دانيال ” ربوات ربوات وألوف ألوف، يخدمونه ” (دانيال 10:7).
وان كان ـ كما يقولون ـ قد حصل علي الترقى الآن، فكيف يشير الابن نفسه إلى مجده الذاتى الذي يفوق الطبيعة والذي كان له قبل إنشاء العالم عندما قال ” مجدنى أنت أيها الآب بالمجد الذي كان لى عندك قبل كون العالم ” (يو5:17)، وإن كان ـ حسبما يقولون ـ قد مُجّد الآن مجدًا عاليًا، فكيف ” طأطأ السموات ” ونزل قبل ذلك، وأيضًا ” أعطى العلى صوته ” (مز9:18،13) لذلك فإن كان للأبن ذلك المجد حتى قبل خلقه العالم، وكان هو رب المجد وهو العلى، ونزل من السماء وهو معبود على الدوام، فينتج من ذلك أنه لم يَترَقَ بنزوله، بل بالأحرى هو نفسه الذي رقى الأشياء التي يعوزها الترقى. وإن كان قد نزل من أجل ترقيتها، لذلك فإنه لم يحصل على اسم ابن وإله كمكافأة، بل بالأحرى فإنه هو نفسه جعلنا أبناء للآب وإله الناس بكونه صار إنسانًا.
39ـ لذلك، فهو لم يكن إنسانًا ثم صار فيما بعد إلهًا، بل كان إلهًا وفيما بعد صار إنسانًا بالأحرى كي يؤلهنا. لأنه إن كان عندما صار انسانًا قد سمى عندئذ ابنًا وإلهًا، وإن كان الله قد دعا الشعوب قديما، أبناء، وذلك قبل أن يصير هو إنسانًا، وجعل الله موسى إلهًا لفرعون. والكتاب المقدس يقول في مواضع كثيرة ” الله قائم في مجمع الآلهة ” (مز1:82)، فمن الواضح أذن أنه قد دُعيّ ابنًا وإلهًا بعدهم. فكيف إذن خُلِقَت كل الأشياء عن طريقه، وكيف أنه هو موجود قبل كل الأشياء؟ أو كيف يكون هو ” بكر كل خليقة ” (كو15:1)، ما دام هناك آخرون قبله يطلق عليهم أبناء وآلهة؟.
وهؤلاء المشاركون الأولون كيف لا يشاركون اللوغوس؟ وهذا التعليم ليس حقيقيًا، بل هو بدعة المتهودين المعاصرين. فكيف إذن في هذه الحالة ـ يمكن لأي أحد على الإطلاق، أن يتعرف على الله كأب؟ لأن من غير المستطاع أن يحدث التبني بغير الابن الحقيقى، وهو نفسه القائل: ” لا يعرف أحد الآب إلاّ الابن، ومن سيُعلن له الابن ” (مت27:11).
وكيف يحدث التأليه بدون اللوغوس، وقبله؟ هذا بالرغم أنه هو نفسه القائل لليهود أخوة هؤلاء المبتدعين. ” إن قال، آلهة، لاولئك الذين صارت إليهم كلمة الله “[3].
فإن كان كل الذين دعوا أبناء وإلهة سواء على الأرض أم في السموات قد نالوا التبنى وصاروا متألهين من خلال اللوغوس، وإن كان الابن نفسه هو اللوغوس، فمن الجلى أن الجميع قد صاروا أبناء من خلاله، وكان هو قبل الجميع، وبالحرى فقد كان هو الابن الحقيقى وحده، وهو وحده إله حق من إله حق ـ ولم يحصل على هذه (الصفات) كمكافأة لفضيلته، وليس هو أخر غير هذه (الصفات) بل هو كل هذه (الصفات) بحسب الطبيعة وبحسب الجوهر، لأنه مولود من جوهر الآب حتى لا يشك أحد أنه وبحسب صورة الآب غير المتغير، يكون اللوغوس أيضًا غير متغيّر.
40ـ ونحن إلى الآن، قد استعملنا أفكارًا حقيقية عن الابن للاجابة على ابتداعاتهم غير المعقولة، ولكن يجمل بنا الآن إذن أن نستشهد بالأقوال الإلهية لكي نبرهن أيضًا بدرجة أكثر كثيرًا على عدم تغيّر الابن وعدم تغيّر طبيعته الأبوية(69) الثابتة، كما يتبرهن أيضًا مدى انحرافهم وضلالهم.
وإذن عندما كتب الرسول إلى أهل فيلبى يقول: “فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو أيضًا في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون مساويًا لله، لكنه أخلى نفسه، آخذًا صورة عبد. صائرًا في شبه الناس. وهو إذ وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفّعه، وأعطاه اسمًا فوق كل اسم. لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب (فيلبى5:2ـ11). أية أقوال أوضح وأكثر بيانًا من هذه الأقوال؟ إن الرب لم يكن أصلاً في حالة وضيعة ثم رقى، بل بالأحرى إذ كان إلهًا فقد اتخذ صورة عبد، وبإتخاذه صورة العبد.
لم يرتقِ بل أذل (وضع) نفسه. إذن فأين هو أجر الفضيلة في هذه الأمور؟ أو أى تقدّم أو ترقى يمكن أن يكون في الإذلال؟ لأنه إن كان وهو الإله، قد صار إنسانًا، وبتنازله من علوه لا يزال يقال إنه يُرّفع (أى يمجد مجدًا عاليًا). فمن أين يُرّفع وهو الله؟ ويتضح من هذا أيضًا، أنه بما أن الله هو الأعلى والأكثر رفعة من الكل، فبالضرورة أيضًا، أن يكون كلمته هو الأعلى والأكثر رفعة فوق الكل، وهذا الذي هو في الآب ومثل الآب في كل شئ. من أين إذن يمكنه أن يُرّفع عاليًا أكثر من ذلك؟ إذن فهو ليس في حاجة إلى أى ازدياد، وليس الأمر كما يفهمه الآريوسيون.
لأنه وإن كان اللوغوس قد نزل من أجل أن يرفع عاليًا ـ وهكذا هو مكتوب ـ فأية حاجة كانت هناك على الإطلاق تدفعه لأن يذل نفسه، أى لكي يسعى للحصول على ذلك الشئ الذي كان لديه أصلاً؟ وما هي النعمة التي ينالها واهب النعمة؟ أو كيف نال هو الاسم للعبادة وهو الذي كان دائمًا معبودًا باسمه؟ ومن قبل أن يصير هو إنسانًا، كان القديسون حينئذ يتوسلون إليه قائلين ” خلّصنى يا الله باسمك ” (مز1:54) وأيضًا ” البعض يفتخر بالمركبات، والبعض الآخر بالخيل وأما نحن فباسم الرب إلهنا سنتمجد ” (مز7:20). وهو الذي كان يسجد له البطاركة (رؤساء الآباء)، إذ قد كُتِبَ عن الملائكة، ولتسجد له كل ملائكة الله” (مز7:97، عب6:1).
41ـ فإن كان داود ينشد في المزمور الحادى والسبعين قائلاً: “اسمه دائم قبل الشمس”، وأيضًا: “وقبل القمر الى أبد الآبدين(70). فكيف إذن ينال ما كان له دائمًا حتى قبل أن يحصل عليه الآن (أى في الجسد)؟ أو كيف يُرّفع مع كونه قبل ترفيعه (أو تمجيده) كان هو العالى (فوق الكل)؟ أو كيف حصل على (حق) العبادة، وهو الذي كان دائمًا معبودًا من قبل أن يحصل على هذا الحق الآن؟ إذن فهذا ليس بلغز بل هو سر إلهى.
” في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. وكان الكلمة الله ” (يو1:1) وهو لأجلنا فيما بعد ” الكلمة صار جسدًا ” (يو14:1) وعبارة “رفّعه” (مجده مجدًا عاليًا) التي نتحدّث عنها الآن، لا تَعنِ أن جوهر الكلمة قد ارتفع، لأنه كان دائمًا وهو لا يزال كائن في الله، ولكنها تعنى ارتفاع (أو ترفّع) بشريته. إذن فهذه الأقوال لم تكن تقال من قبل إلاّ عندما صار الكلمة جسدًا، لكي يصير واضحًا أن “أذل نفسه”، “وتمجد مجدًا عاليًا” إنما تشير إلى إنسانيته، لأنه حيثما تكون هناك حالة الاذلال تكون هناك الرفعة أيضًا. فإن كان بسبب اتخاذه للجسد قد كتب “الإذلال” عنه، فمن الواضح أن التمجيد (أو الرفعة) تقال عنه بسبب الجسد، لأن الانسان كان في مسيس الحاجة إلى هذا (التمجيد)، بسبب وضاعة الجسد. وبسبب الموت.
وبما أن الكلمة وهو صورة الآب، وهو غير مائت، قد أتخذ صورة عبد، وكإنسان عانى الموت بجسده من أجلنا. لكي بذلك يبذل نفسه للآب بالموت من أجلنا، لأجل هذا السبب يقال عنه إنه كإنسان مُجّد أيضًا نيابة عنا ومن أجلنا، لكي كما بموته قد متنا جميعًا في المسيح، وعلى نفس المنوال أيضًا، فإننا في المسيح نفسه أيضًا قد مُجّدنا مجدًا عاليًا، مقامين من بين الأموات وصاعدين إلى السموات ” حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا ” (عب20:6)، ” لا إلى أقداس أشباه الحقيقة، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا ” (عب34:9). فإن كان المسيح قد دخل الآن إلى السماء عينها لأجلنا، رغم أنه من قبل هذا الحدث، كان هو دائمًا الرب وخالق السموات، فتبعًا لذلك تكون هذه الرفعة الحالية قد كُتِبَت أيضًا من أجلنا نحن.
وكما أنه وهو الذي يقدّس الجميع، يقول أيضًا أنه يقدس نفسه للآب من أجلنا ـ ليس بالطبع لكي يكون اللوغوس مقدّسًا ـ بل لكي بتقديس ذاته يقدسنا جميعًا في ذاته. وهكذا بنفس المعنى ينبغى أن نفهم ما يقال الآن أنه “تمجد”. ليس لكي يمجّد هو (أى اللوغوس) نفسه ـ إذ أنه هو الأعلى ـ بل لكي هو ذاته “يصير برا” من أجلنا، أما نحن فلكى نتمجّد (نُرفّع) فيه ولندخل إلى أبواب السماء، التي قد فتحها هو ذاته من أجلنا، حيث يقول السابقون ” ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، وارتفعى أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد ” (مز7:34). وهنا أيضًا لم تكن الأبواب مغلقة أمامه هو إذ هو رب وخالق كل الأشياء، بل بسببنا كُتِبَ هذا الكلام، نحن الذين أُغلقت أمامنا أبواب الفردوس.
لذلك يقال عنه من الناحية البشرية، بسبب الجسد الذي كان قد لبسه: “إرفعوا الأبواب”، كما يقال أيضًا: “ليدخل” كما لو كان إنسانًا سيدخل. ولكن من الناحية الإلهية ـ حيث إن “اللوغوس هو الله” ـ يقال عنه أيضًا إنه “الرب” و “ملك المجد” وقد سبق الروح فقال في المزمور التاسع والثمانين عن مثل هذه الرفعة التي صارت إلينا ” وببرّك يرتفعون، لأنك أنت هو فخر قوتهم ” (مز17:89،18)، فإن كان الابن هو البر، إذن فهو لم يرتفع بذاته كما لو كان في حاجة إلى الرفعة، بل نحن الذين أرتفعنا (تمجدنا) بسبب البر الذي هو (المسيح) ذاته.
42ـ وهكذا أيضًا فإن عبارة “أعطاه اسمًا” لم تكتب لأجل اللوغوس ذاته ـ فإنه حتى قبل أن يصير إنسانًا فقد كان معبودًا أيضًا من الملائكة ومن كل الخليقة، بحسب ذاتيته الأبوية(71) بل كُتبت هذه العبارة عنه بسببنا ولأجلنا. لأنه كما مات المسيح ثم رُفّع كإنسان، فبالمثل قيل عنه إنه أخذ كإنسان ما كان له دائمًا كإله. وذلك لكي تصل إلينا عطية مثل هذه النعمة، فإن اللوغوس لم يحط قدره بإتخاذه جسدًا حتى يسعى للحصول على نعمة أيضًا، بل بالأحرى فإن الجسد الذي لبسه قد تألّه، بل وأكثر من ذلك، فقد أنعم بهذه النعمة على جنس البشر، بدرجة أكثر.
فكما أنه كان يُعبَد دائمًا لكونه اللوغوس “الكائن في صورة الله” ـ هكذا ظل هو نفسه كما هو وصار إنسانًا ودعى يسوع ـ فليس أقل من أن كل الخليقة ـ تظل كما كانت دائمًا ـ تحت قدميه، وهي التي تجثو بركبها له بهذا الاسم (يسوع). وتعترف أن اللوغوس صار جسدًا، وأنه احتمل الموت بجسده. ولم يحدث له كل هذا كإهانة لمجد ألوهيته بل “لمجد الله الآب”.
لأن مجد الله الآب هو: أن يوجد الانسان الذي كان قد خلق ثم هلك، وهو: أن يحيا الذي مات، وهو: أن يصير الانسان هيكل الله. ولأن القوات السمائية من ملائكة ورؤساء ملائكة كانت تعبده دائمًا، فإنهم الآن أيضًا يسجدون للرب باسم يسوع، فهذه النعمة وهذا التمجيد العالى إنما هو لنا، وإنه بالرغم من أنه صار إنسانًا وهو ابن الله فإنه يُعبَد. لذلك لن تُدهَش القوات السمائية حينما ترانا نحن جميعًا ـ المتحدين معه في نفس الجسد ـ داخلين إلى مناطقهم (السمائية)، وهذا قطعًا ـ لم يكن ممكنًا أن يحدث بأية طريقة أخرى، اللهم إلاّ إذ كان هذا الذي كان موجودًا في صورة الله، قد أتخذ لنفسه صورة العبد، وأذل ذاته، راضيًا بأن يصل جسده حتى إلى الموت.
43ـ انظروا إذن، كيف أن ذلك الذي يعتبر عند الناس، جهالة الله بسبب تحقير الصليب، قد صار أكثر الأشياء كرامة، ذلك أن قيامتنا به معتمدة عليه، وليس اسرائيل وحده الذي يعتمد عليه بل كل الأمم ـ كما سبق وأنبأ النبى: يتركون أصنامهم ويتعرّفون على الإله الحقيقى أبى المسيح، وابتداعات الشياطين قد أُبطِلَت، والإله الحقيقى وحده هو الذي يُعبَد باسم ربنا يسوع المسيح.
أما عبادة الرب الذي صار في الجسد البشرى، ودعى يسوع، والإيمان به كابن الله ـ والتعرّف على الآب بواسطته، فهو أمر جلى، كما قلنا، أنه ليس اللوغوس بسبب كونه لوغوس هو الذي حصل على مثل هذه النعمة، بل نحن. لأنه بسبب علاقتنا بجسده فقد صرنا نحن أيضًا هيكل الله – وتبعًا لذلك قد جُعِلنا أبناء الله. وذلك حتى يعبد الرب فينا أيضًا. والذين يبصروننا يعلنون ـ كما قال الرسول “أن الله بالحقيقة فيكم” (1كو25:14). وكما قال يوحنا أيضًا في إنجيله ” وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله ” (يو12:1). وكما كتب في رسالته ” بهذا نعرف أنه يسكن فينا من روحه الذي أعطاه لنا ” (1يو24:3).
إن ما يميز الصلاح الصائر منه إلينا، هو أننا نُمجّد بسبب وجود الرب العالى فينا، وأن النعمة أقد أعطيت له من خلالنا ـ بسبب أن الرب الذي هو مانح النعمة قد صار إنسانًا مثلنا. والمخلّص نفسه أذل نفسه بإتخاذه “جسد تواضعنا” ـ وأتخذ صورة عبد، لابسًا ذلك الجسد الذي كان مستعبدًا للخطيئة.
وهو في الحقيقة لم يحصل على شيء منا يرتقى به لأن كلمة الله هو ليس في احتياج إلى شئ، لأنه كامل، بل بالأحرى نحن الذين نلنا منه الارتقاء. لأنه هو ” النور الذي ينير كل انسان يأتى إلى العالم ” (يو9:1). إن الآريوسيين يركّزون بلا جدوى على أداة الربط: “لذلك” لأن بولس قال ” لذلك مجده الله مجدًا عاليًا ” (فى8:2). فهو بهذا القول لم يكن يعنى مكافأة لفضيلة ولا أرتقاء نتيجة تقدم أخلى، ولكنه يقصد السبب في العلو والتمجيد والارتفاع الذي صار فينا. وما هو هذا السبب إلاّ أن يكون أن الذي كان في صورة الله وهو ابن لآب نبيل، قد أذل نفسه وصار بدلاً منّا ومن أجلنا؟ فلو لم يكن الرب قد صار أنسانًا، لما كان في وسعنا أن نُفتَدى (نتحرّر) من الخطيئة وأن نقوم من بين الأموات، بل لبقينا أمواتًا تحت الأرض. ولما كنا لنُرفع (لنمجّد) إلى السماء، بل لرقدنا في الجحيم.
إذن، فمن أجلنا، ولمصلحتنا، كتبت هذه الكلمات” مجّده مجدًا عاليًا”، “وأعطاه اسما”.
44ـ أعتقد إذن أن هذا هو قصد النص الكتابى، وهو قصد كنسى تمامًا. ولكن ربما كانت هناك طريقة أخرى لشرح النص لأعطاء معنى مطابق تمامًا.
أى أن النص لا يعنى تمجيد اللوغوس ذاته بإعتباره لوغوس (لأنه كما سبق أن قيل منذ قليل، أنه عال وأنه مثل الآب)، ولكن النص يشير إلى قيامته من بين الأموات بسبب تأنسه. فقوله ” أذل نفسه حتى الموت” ثم أضاف “لذلك مجّده مجدًا عاليًا ” راغبًا أن يبيّن أنه كإنسان كان يقال عنه أنه قد مات، ولكن لكونه الحياة رُفِعَ بالقيامة ” فإن الذي نزل هو نفسه أيضًا الذي قام ” (أف10:4). لأنه نزل بالجسد، إلاّ أنه قام لأنه هو نفسه كان إلهًا في الجسد. وهذا أيضا هو السبب الذي من أجله قد مهد السبيل الى هذا المعنى باستخدام أداة الربط “لذلك”، والذي لا يعنى أجر فضيلة ولا ترقى، ولكنه يكشف السبب الذي بواسطته قد صارت القيامة.
ولهذا السبب نفسه مات سائر البشر منذ آدم وحتى الآن، وظلوا أمواتًا، أما هذا وحده فهو الذي قام من بين الأموات كاملاً متكاملاً. وهذا هو السبب الذي من أجله سبق الرسول نفسه وقال: إنه بالرغم من كونه الهًا فقد صار إنسانًا. أما سائر البشر فقد ماتوا لأنهم من نسل آدم. وقد كان للموت سيادة عليهم (رو14:5). أما هذا فهو ” الإنسان الثانى من السماء ” (1كو47:15)، وذلك لأن ” الكلمة قد صار جسدًا ” (يو14:1) ويقول إن مثل هذا الإنسان “من السماء” و “سماوى” (1كو47:15،48) ذلك لأن الكلمة ” قد نزل من السماء ” (يو38:6) ولهذا فلم يُقهَر (يمسك) من الموت.
فرغم أنه أذل نفسه، مسلّمًا جسده الخاص به حتى الموت، وذلك بسبب قبوله الموت، إلاّ أنه رُفِعَ رفعة عظيمة من الأرض، ذلك لأنه هو ابن الله في الجسد. لذلك فإن ما يقال هنا “لذلك رفّعه الله أيضًا” مساو أيضًا لما قاله بطرس في سفر الأعمال ” الذي أقامه مبطلاً أوجاع الموت، لأنه لم يكن ممكنًا أن يسيطر عليه سلطان الموت ” (انظر أع24:2). فكما كتب بولس ” الذي إذ كان في صورة الله ” قد صار إنسانًا، و ” وأذل نفسه حتى الموت ولذلك مجّده الله مجدًا عاليًا “. وبالمثل يقول بطرس. وحيث إنه إذ كان إلهًا قد صار إنسانًا، فإن الآيات والعجائب كشفت أيضًا للناظرين أنه الله، ولذلك ” فلم يكن ممكنًا أن يمسكه الموت ” (انظر أع24:2).
والإنسان لم يكن يستطيع أن ينجح في تحقيق هذا، لأن الموت هو خاص بالإنسان. ولهذا فإن الكلمة الله صار جسدًا، لكي يحيينا بقوّته بعد أن مات بالجسد.
45ـ وبما أنه يقال إنه “مجّده ورفّعه”، وأن الله “أعطاه” فالهراطقة يظنون أن هذا نقيصة، أو عيبًا خاصًا بجوهر اللوغوس. فمن الضرورى أن نقول، بأى معنى تقال هذه الكلمات. إذ يقول إنه رُفِعَ وأُصعِدَ من أقسام الأرض السفلى[4]. لأن الموت صار خاصًا به أيضًا. وكلا الأمران يقالان عنه حيث إنهما خاصان به وليس بآخر غيره. إذن فالجسد الذي أقيم من بين الأموات هو الذي رُفِعَ إلى السموات. وحيث إن الجسد كان يخصه ولا يوجد للجسد كيان إلاّ باللوغوس نفسه، لذى فمن الطبيعى أنه بتمجيد وترفيع الجسد يقال أيضًا إنه كإنسان قد إرتفع بسبب الجسد.
إذن فلو لم يكن قد صار إنسانًا، لما كانت لتقال عنه هذه الأقوال. أما عبارة “الكلمة صار جسدًا” فإنه كانت هناك ضرورة، أن يقال عنه إنه قام وتمجّد كما يقال عن إنسان، لكي يكون هذا الموت الذي يشار به إليه، فداءًا لخطية البشر، وأبطالاً للموت، أما القيامة والتمجيد فإنهما يدومان فينا بالضرورة بسببه.
وفى كلتا الحالتين قال عنه “مجده الله مجدًا عاليًا”، و “الله أعطاه” كي يبين بهذا أنه ليس الآب هو الذي صار بل كلمته هو الذي صار إنسانًا، فإنه بحسب النمط البشرى، يأخذ من الآب ويتمجد منه. كما سبق أن قال.
فيكون واضحًا ـ ولا يستطيع أحد أن يشكّك في ذلك ـ أن تلك الأشياء التي يعطيها الآب، إنما يعطيها عن طريق الابن، ويكون عجيبًا، وأمرًا مثيرًا للاستغراب حقًا أن النعمة التي يعطيها الابن من لدن الآب، نفس هذه النعمة، يقال أن الابن ذاته قد قبلها. والرفعة التي حققها الابن من لدن الآب، بهذه الرفعة نفسها يُرفّع الابن نفسه.
إذن فإذ هو ابن الله نفسه قد صار ابن الإنسان أيضًا، ولأنه هو اللوغوس فهو يعطى الأشياء من لدن الآب، لأن كل من يصنعه ويعطيه الآب، إنما يصنعه ويعطيه من خلاله.
وكابن الإنسان فيقال إنه بحسب بشريته ينال ما يخصه من ذاته، بسبب أن جسده ليس سوى جسده الخاص به الذي هو بطبيعته أن يتقبل النعمة كما قد قيل.
وبحسب هذه الرفعة إذن، أخذ الإنسان في داخله. وكانت هذه الرفعة من أجل تأليه الانسان أما اللوغوس فله خاصية (التأليه) هذه بحسب الالوهية والكمال الأبوى الخاصين به.
الفصل الثانى عشر: شرح نصوص: ثانيًا: مزمور 7:45،8 “من أجل ذلك مسحك الله إلهك”
46ـ إن هذا الشرح كما كتبه الرسول، إنما يدحض هؤلاء العديمى التقوى. وما قاله المرنم له أيضًا نفس المعنى المستقيم الذي أساء هؤلاء فهمه. في حين أن منشد المزامير يوضح التقوى لأنه هو أيضًا يقول ” عرشك يا الله إلى الدهور، صولجان استقامه هو صولجان ملكك أحببت البر وأبغضت الأثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الإبتهاج أكثر من شركائك ” (مز7:45ـ8).
انظروا أيها الآريوسيون وميزوا الحقيقة هنا أيضًا. فالمرنم يقول، إننا جميعًا “شركاء” الرب. فلو كان اللوغوس من العدم. وكان هو واحدًا من المخلوقات، لكان هو أيضًا واحدًا من الشركاء، فماذا يجب أن يفهمه الواحد منا، غير أنه آخر غير المخلوقات (مختلف عن المخلوقات). وأنه هو وحده كلمة الله الحق، وهو البهاء والحكمة التي تشارك فيه جميع المخلوقات، وهي تتقدس منه بالروح؟ ولذلك فهو هنا “يُمسح” لا لكي يصير إلهًا، لأنه كان إلهًا حتى قبل أن يُمسح، ولا لكي يصير ملكًا، لأنه قد كان هو المالك على الدوام، إذ أنه صورة الله كما يقول الوحى (انظر 2كو4:4، كو15:1).
بل إن هذا أيضًا (أى أنه مسح) قد كتب من أجلنا. لأنه عندما كان الملوك ـ أيام أسرائيل ـ يُمسحون، فعندئذ فقط كانوا يصيرون ملوكًا، حيث أنهم لم يكونوا ملوكًا قبل مسحهم، وذلك مثل داود وحزقيا ويوشيا وغيرهم. أما المخلص فهو على العكس، حيث إنه إذ هو الله، يزاول دائمًا حكم مملكة الآب هو نفسه مانح الروح القدس، إلا أنه يقال الآن إنه يُمسَح. فهو كإنسان يقال عنه إنه يُمسَح بالروح وذلك حتى يبنى فينا نحن البشر سكنى الروح وألفته تمامًا مثلما وهبنا الرفعة والقيامة. وهذا ما عناه هو نفسه عندما أكد الرب عن نفسه في الإنجيل بحسب يوحنا ” أنا قد أرسلتهم إلى العالم ولأجلهم أقدس أنا ذاتى ليكونوا هم أيضًا مقدسين في الحق ” (يو18:17ـ19).
وقد أوضح بقوله هذا إنه ليس هو المقدَّس بل المقدِّس. لأنه لم يُقدَّس من آخر بل هو يقدَّس ذاته. حتى نتقدّس نحن في الحق. وهذا الذي يقدَّس ذاته إنما هو رب التقديس. كيف إذن حدث هذا؟ وماذا يريد أن يقول بهذا سوى إنه: ” كونى أنا كلمة الآب، فأنا نفسى أعطى ذاتى الروح حينما أصير إنسانًا. وأنا الصائر إنسانًا أقدّس نفسي (في الآب) لكي يتقدّس الجميع فيّ. وأنا الذي هو الحق. لأن (كلمتك أنت هي الحق) ” (يو17:17).
47ـ إذن فإن كان يقدّس ذاته من أجلنا. وهو يفعل هذا لأنه قد صار إنسانًا، فمن الواضح جدًا أن نزول الروح عليه في الأردن، إنما كان نزولاً علينا نحن، بسبب لبسه جسدنا. وهذا لم يصر من أجل ترقية اللوغوس، بل من أجل تقديسنا من جديد، ولكي نشترك في مسحته، ولكي يقال عنا ” ألستم تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله يسكن فيكم ” (1كو16:3) فحينما أغتسل الرب في الأردن كإنسان، كنا نحن الذين نغتسل فيه وبواستطه.
وحينما أقتبل الروح، كنا نحن الذين صرنا مقتبلين للروح بواسطته. ولهذا السبب، فهو ليس كهارون. أو داود أو الباقين ـ قد مسح بالزيت هكذا ـ بل بطريقة مغايرة لجميع الذين هم شركاؤه ـ أى “بزيت الإبتهاج” ـ التي فسر أنه يعنى الروح ـ قائلاً بالنبى ” روح الرب على لأنه مسحنى ” (إش1:61). كما قال الرسول أيضًا ” كيف مسحه الله بالروح القدس ” (أع38:10). متى قيلت عنه هذه الأشياء – إلا عندما صار في الجسد وأعتمد في الأردن. “ونزل عليه الروح”؟ (مت16:3). وحقًا يقول الرب لتلاميذه إن ” الروح سيأخذ مما لى ” (يو16:14). و” أنا أرسله ” (يو7:16). و ” اقبلوا الروح القدس ” (يو22:20). إلاّ أنه في الواقع هذا الذي يعطى للآخرين ككلمة وبهاء الآب، يقال الآن إنه يتقدّس وهذا من حيث إنه قد صار إنسانًا، والذي يتقدس هو جسده ذاته.
إذن فمن ذلك (الجسد) قد بدأنا نحن الحصول على المسحة والختم، مثلما يقول يوحنا ” أنتم لكم مسحة من القدوس ” (1يو20:2). والرسول يقول ” أنتم ختمتم بروح الموعد القدوس ” (أف13:1). ومن ثم فإن هذه الأقوال هي بسببنا ومن أجلنا. فأى تقدم في الإرتقاء، وأى أجر فضيلة أو عمومًا أى أجر عمل للرب، يتضح من هذا؟
فلو أنه لم يكن إلهًا، ثم صار إلهًا، ولو كان قد رُقيّ إلى ملك وهو لم يكن ملكًا، فإنه يكون لقولكم بعض الظل من الإحتمال.
أما إن كان هو الله، ويكون “عرش ملكه أبدى” فإلى أى مدى يمكن أن يرتقى الله؟ أو ماذا ينقص هذا الذي هو جالس على عرش الآب؟ وكما قال الرب نفسه، إن كان الروح هو روحه. والروح أخذ منه، وهو نفسه أرسل الروح (انظر يو14:16، يو7:16)، إذن، فلا يكون اللوغوس بإعتباره اللوغوس والحكمة هو الذي يُمسح من الروح، الذي يعطيه هو ذاته، بل الجسد الذي قد أتخذه، هو الذي يُمسح فيه ومنه، وذلك لكي يصير التقديس الصائر إلى الرب كإنسان، يصير (هذا التقديس) إلى جميع البشر به. لأن يقول: ” إن الروح لا يتكلم من نفسه ” (انظر يو13:16). بل اللوغوس هو الذي يعطى هذا (الروح) للمستحقين.
فإن هذا يشبه ما سبق من قول، لأنه كما كتب الرسول ” الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون مساويًا لله، ولكنه اخلى نفسه آخذًا صورة عبد ” (في6:2،7). وبالمثل يرنم داود للرب. إنه إله وملك أبدى، مرسل إلينا ومتخذًا جسدنا الذي هو مائت. لأن هذا هو المقصود في المزمور بالقول ” مر وعود وقرفة تفوح من ثيابك ” (مز8:45). ويتضح نفس الشئ مما فعله نيقوديموس والنسوة اللائى مع مريم حينما جاء نيقوديموس حاملاً ” مزيج مر وعود نحو مئة رطل ” (يو39:19). وكانت النسوة قد أعددن الحنوط لجسد الرب (لو1:24).
48ـ فأى تقدم هو إذن بالنسبة لغير المائت عندما يتخذ ما هو مائت؟ وأى أرتقاء هو للأزلى عندما يلبس ما هو وقتى وأى أجر يمكن أن يكون بالنسبة لله والملك الأبدى الذي هو في حضن الآب؟ ألا تدركون أن هذا قد صار وكتب بسببنا ومن أجلنا، لأنه إذ قد صار الرب إنسانًا، لكي يصوغنا نحن المائتين والوقتيين ويجعلنا غير مائتين. ولكي يدخلنا إلى ملكوت السموات الأبدى؟ ألا تستحون وأنتم تزيفون الأقوال الإلهية؟ لأنه بنزول ربنا يسوع المسيح وأقامته بيننا، فإننا بالحقيقة قد أرتقينا لأننا تحررنا من الخطيئة، أما هو فهو باقٍ هو هو ولا يتغير بصيرورته إنسانًا (لأنه يلزم أن نكرر نفس القول)، بل كما هو مكتوب فإن ” كلمة الله يبقى إلى الأبد ” (إش8:40).
إذن، مثلما كان قبل تأنسه ـ إذ أنه كان اللوغوس، فإنه منح الروح للقديسين بإعتباره خاصًا به ـ وهكذا عندما صار إنسانًا فإنه قدس الجميع بالروح وقال لتلاميذه، ” اقبلوا الروح القدس ” (يو22:20)، وقد أعطى (الروح) لموسى وللسبعين الآخرين (انظر عدد16:11). والذي به صلى داود للآب قائلاً: ” روحك القدوس لا تنزعه منى ” (مز11:51).
أما عندما صار إنسانًا فقد قال ” سأرسل لكم المعزى روح الحق ” (يو26:15)، وبالفعل أرسله، لأن كلمة الله منزه عن الكذب. إذن فإن ” يسوع المسيح هو هو بالأمس واليوم وإلى الأبد ” (عب8:13) وحيث إنه يظل غير متغير وهو ذاته العاطى والآخذ: فهو يعطى ككلمة الله، ويأخذ كإنسان، وتبعًا لذلك فليس اللوغوس ـ بإعتباره بالحقيقة لوغوس ـ هو الذي إرتقى، إذ كانت له دائمًا، وله على الدوام ـ كل الأشياء. أما البشر ـ الذين يأخذون البداية منه وبسببه ـ فهؤلاء هم الذين يرتقون.
لأنه حينما يقال بحسب الوجهة البشرية إنه الآن يُمسح ـ نكون نحن، الذين نمسح في شخصه، حيث إنه حينما اعتمد، نكون نحن الذين نعتمد في شخصه. ويوضح المخلص بالأحرى كل هذه الأمور حينما يقول للآب: ” وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتنى ليكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد ” (يو22:17). وتبعًا لذلك فإنه كان يطلب المجد أيضًا من أجلنا. وبسببنا أيضًا أستخدم كلمة “أخذ” وكلمة “أعطى” وكلمة “مجد مجدًا عاليًا. وذلك لكي نأخذ نحن أيضًا، ولكي يعطى لنا، ولكي نمجد نحن فيه مجدًا عاليًا. وذلك كما يقدس ذاته من أجلنا، لكي نتقدس نحن في شخصه.
49ـ وإن كان هؤلاء ـ بسبب ما جاء في المزمور ” من أجل هذا مسحك الله إلهك ” (مز8:45) يستخدمون التعبير “من أجل هذا” من أجل رغباتهم الخاصة، فليعرف هؤلاء الذين يجهلون الكتب المقدسة، والذين انكشف عدم تقواهم، أن تعبير “من أجل هذا” هنا أيضًا، لا يعنى أجر فضيلة أو سلوكًا خاصًا باللوغوس، بل يعنى السبب الذي من أجله نزل إلينا، ويعنى السبب في مسحة الروح التي مسح بها من أجلنا. لأنه لم يقل “من أجل هذا مسحك” لكي يصير هو إله أو ملك أو ابن أو لوغوس، لأنه كان هكذا وهو دائمًا هكذا من قبل أن يُمسح، كما سبق أن أظهرنا، بل بالأحرى، بما أنك أنت إله وملك، من أجل ذلك أيضًا مُسِحَت.
حيث إنه لم يكن في وسع أحد أخر أن يوحّد الإنسان بالروح القدس، سواك أنت الذي هو صورة الله، تلك الصورة التي بحسبها خلقنا منذ البدء، لأن الروح هو روحك أنت. وكل هذا حدث لأن طبيعة المخلوقات لا يركن إليها بخصوص هذا الأمر. ففى حين تمرد الملائكة، فإن البشر كانوا عصاة. لذلك كان الأمر يحتاج بالضرورة إلى تدخل الله ـ ” لأن اللوغوس هو الله ” (يو1:1)، وذلك لكي يحرر الذين صاروا تحت عبء اللعنة. فلو كان هو من العدم لكان واحدًا بين الجميع وشريكًا لهم، ولما كان هو المسيح.
ولكن بما أنه إله لكونه ابن الله، فهو ملك أبدى، نظرًا لأنه بهاء الآب وصورته. من أجل ذلك فمن اللائق أن يكون هذا هو المسيح المنتظر، الذي وعد الآب البشر به، كما كشف عنه لأنبيائه القديسين، لكي كما خلقنا به، يصير به هكذا أيضًا خلاص الجميع من خطاياهم، ولكي تكون كل الأشياء تحت حكمه. وهذا هو سبب المسحة التي صارت له، وسبب “الحضور المتجسد للوغوس”. وهذا السبب هو الذي تنبأ به مرنم المزامير مسبحًا بألوهيته وملكوته الأبوى، عندما هتف قائلاً ” عرشك يا الله إلى دهر الدهور، صولجان استقامه هو صولجان ملكك ” (مز6:45)، ثم يعلن نزوله إلينا بقوله: ” من أجل ذلك، مسحك الله، الهك، بزيت الابتهاج أكثر من شركائك ” (مز7:45).
50ـ لماذا يكون مثيرًا للدهشة، أو بعيدًا عن الإعتقاد، إن كان الرب، وهو واهب الروح، يقال عنه الآن إنه مسح بالروح حينما تستلزم الحاجة ذلك، فإنه لا يرفض القول عن نفسه أنه هو أدنى شأنًا من الروح ـ بسبب طبيعته البشرية ـ لأنه عندما قال اليهود إنه ” يخرج الشياطين بيعلزبول ” (مت24:12) فإنه لكي يكشف تجديفهم، أجاب وقال لهم ” إنى بروح الله أخرج الشياطين ” (مت28:12). فها هوذا واهب الروح يقول الآن إنه يخرج الشياطين بالروح، وهذا القول لم يكن ليقال لأي سبب آخر، سوى من ناحية الجسد. لأنه كما أن طبيعة الإنسان لم تكن كافية من ذاتها أن تطرد الشياطين بدون قوة الروح، من أجل هذا كان كإنسان يقول “إنى بروح الله أخرج الشياطين”.
وطبيعى أن التجديف الذي صار ضد الروح القدس، أعظم من التجديف الذي يكون ضد طبيعة البشرية، ولذلك قال: ” كل مَن قال كلمة تجديف ضد ابن الإنسان يُغفر له ” مثل من قالوا: ” أليس هذا هو ابن النجار ” (مت55:13). أما الذين يجدفون على الروح القدس، وينسبون أعمال اللوغوس للشيطان فهؤلاء سيكون لهم عقاب لا مناص منه. إذن فإن الرب قال مثل هذه الأقوال لليهود كإنسان، أما التلاميذ فقد بين لهم ألوهيته وجلاله، مشيرًا إلى ذاته أنه ليس أقل إطلاقًا من الروح بل مساوٍ له.
وأعطاهم الروح وقال: ” اقبلوا الروح القدس ” (يو22:20) وأيضًا ” أنا أرسله ” (يو7:16)، و” ذاك يمجدني ” (يو14:16)، و ” كل ما يسمع يتكلم به ” (يو13:16). وبالمثل إذن فإن الرب مانح الروح نفسه، لا يكف عن القول إنه بالروح يخرج الشياطين كإنسان، وبنفس الطريقة، حيث أنه هو ذاته واهب الروح، فإنه لا يتوقف عن القول: ” روح الرب على لأنه مسحنى ” (إش1:61)، وذلك بسبب أنه قد صار جسدًا (يو14:1) كما قال يوحنا، لكي يتضح في هذين الأمرين، أننا نحن الذين نكون محتاجين لنعمة الروح لكي نتمجد، وأنه ليس في وسعنا أن نخرج الشياطين بدون قوة الروح.
بواسطة من إذن، وممن كان يجب أن يُمنح الروح إلاّ بواسطة الابن. وهو الذي يعتبر الروح أيضًا روحه؟ ومتى كان في استطاعتنا نحن الحصول على الروح إلاّ عندما صار اللوغوس إنسانا؟ (انظر يو16:1). وهذا ما يتضح تمامًا من قول الرسول، أننا لم نحصل على الفداء ولا على التمجيد مجدًا عاليًا، لو لم ” يتخذ صورة عبد، ذاك الذي كان في صورة الله ” (فى6:2ـ7).
هكذا يرينا داود أيضًا أنه ليست هناك طريقة أخرى، لكي نشارك الروح، ونتقدس لو لم يقل اللوغوس ذاته، واهب الروح بأنه هو ذاته، مُسِحَ بالروح من أجلنا، ولهذا السبب طبعًا أخذنا الروح، إذ أنه هو الذي قيل فيه إنه قد مسح بالجسد. حيث إن جسده الخاص هو الذي تقدس أولاً. وإذ قيل عنه كإنسان أن جسده قد أتخذ هذا (الروح)، فلأجل هذا، فنحن نمتلك نتيجة لذلك، نعمة الروح، آخذين أياها ” من ملئه ” (انظر يو16:1).
51ـ وأما الآية الواردة في المزمور: ” أحببت البر، وأبغضت الإثم ” (مز7:45)، فهى ليست مثلما تفهمونها أنتم أنها تبين أن طبيعة اللوغوس متغيرة، بل بالأحرى فإنها تعنى أن اللوغوس غير متغير. لأنه بما أن طبيعة المخلوقات متغيرة والبعض تعدوا الوصية، والبعض الآخر قد تمردوا، كما سبق أن قيل فإن أعمالهم ليست أكيدة، بل يحدث كثيرًا أن ذلك الذي هو صالح الآن، يتحول بعد ذلك ويصير شيئًا آخر. فمثلاً هذا الذي يكون الآن عادلاً، وبعد قليل يكون ظالمًا، لذا أيضًا، كان هناك احتياج إلى واحد غير متغير، لكي يحصل البشر على عدم تغير بر اللوغوس، كصورة ومثال لأجل تحقيق الفضيلة.
أما مثل هذا التفكير فله أيضًا سبب معقول للذين يفكرون بإستقامة، لأنه بما أن الإنسان الأول آدم (1كو45:15) تعرض للتغير، وبسبب الخطية دخل الموت إلى العالم (رو12:5)، من أجل هذا وجب أن يكون آدم الثانى غير متغير، حتى ولو استمرت الحية تزاول عملها، فإن خداعها يضعف، أما الرب، فلكونه غير متغير وثابت، تصير الحية عاجزة عن مساعيها ضد الجميع. لأنه مثلما سقط أدم في العصيان، فإن الخطية ” قد إجتازت إلى جميع الناس ” (رو12:5)، وهكذا حينما صار الرب إنسانا، وحطم الحية، فإن قوته العظيمة هذه قد إنتقلت إلى جميع الناس، حتى يقول كل واحد منا ” لأننا لا نجهل أفكاره ” (2كو11:2).
ومن الصواب إذن، فإن الرب، الذي هو دائمًا بحسب طبيعته غير متغير. وهو الذي يحب البر، ويبغض الأثم، مُسِحَ وأُرسِل هو ذاته، لكونه هو ذاته وهو باق هو هو، بإتخاذه جسدًا متغيرًا، لكي يدين الخطية في الجسد (انظر رو3:8)، ولكي يجعل ذات هذا الجسد حرًا، ولكي يستطيع من الآن فصاعدًا أن يتمم به حكم الشريعة، ولكي نستطيع أن نقول ” نحن لسنا في الجسد في الروح، إن كان حقًا روح الله ساكنًا في داخلنا ” (رو9:8).
52ـ أيها الآريوسيون، قد صار عبثًا مثل هذا الشك الذي صار فيكم، وعبثًا ما تدعونه وما تتعللون به من أقوال الإنجيل، لأن اللوغوس الذي هو كلمة الله إنما هو غير متغير، وهو مستمر دائمًا في حالة واحدة، ليس كيفما أتفق، بل هو مثل الآب. لأنه كيف يكون مثله، أن لم يكن هو نفسه كذلك؟
أو كيف يكون كل ما هو للآب، هو للابن أيضًا (انظر يو15:16) ان لم يكن للإبن صفة عدم تغير الآب ودوامه؟ وبما أنه غير خاضع للقوانين الطبيعية بأن ينحاز لواحد ضد آخر، فإنه إذن لا يحب الواحد ويكره الآخر.
فلو أنه بسبب الخوف من السقوط ينحاز إلى واحد، فإنه حينئذ سينكشف من الجهة الآخرى، أنه متغير. ولكنه لكونه إله وكلمة الآب، فهو قاض عادل ومحب للفضيلة، وبالأحرى هو مانح الفضيلة. إذن فهو عادل وقدوس بطبيعته. فلهذا يقال إنه يحب البر ويبغض الإثم (انظر إش8:61). وهذا يعادل القول القائل إنه يحب الصالحين ويعنهم. أما الظالمون فإنه ينفر منهم ويبغضهم لأن الكتب المقدسة تقول نفس القول عن الآب: ” الرب عادل ويحب العدل ” (مز7:11). و” يبغض كل فعلة الإثم ” (مز6:5)، و ” أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب ” (مز2:87)، و ” أحب يعقوب وأبغض عيسو ” (ملاخى2:1،3).
وفى إشعياء كان صوت الرب أيضًا قائلاً ” أنا هو الرب محب العدل ومبغض الاختلاس الناتج عن الظلم ” (إش8:61) فينبغى إذن عليهم، إما أن يفسروا تلك الأقوال بنفس المعاني التي تعنيها هذه الأقوال أيضًا ـ لأن تلك الأقوال قد كتبت عن صورة الله ـ وإما فإنهم بإساءتهم تفسير هذه الأقوال كتلك، أيضًا، فإنهم سيضطرون إلى القول أن الآب هو متغير أيضًا.
ولكن بما أن مجرد سماع الآخرين يقولون هذا القول، هو أمر له أخطار كثيرة، لهذا فإننا نفكر بالصواب بقولنا إن “الله يحب العدل ويبغض الاختلاس والظلم”. وهذا لا يعنى أنه له ميل تجاه الواحد أو تجاه الآخر، ويقبل ما هو مضاد، لدرجة أنه يفضل هذا ولا يفضل ذاك، فهذه هي سمة المخلوقات، بل يعنى أنه كقاض، يحب الأبرار ويعينهم ويعزف عن الأشرار. وتبعًا لهذا إذن، ينبغى أن نفكر بمثل هذه الأفكار عن “صورة الله” أيضًا بأنه هكذا يحب ويكره، لأن هذا ما يجب أن تكون عليه طبيعة “الصورة” مثل طبيعة الآب، حتى ولو كان الآريوسيون ـ لأنهم عميان ـ لا يرونها ولا يرون شيئًا آخر من الأقوال الإلهية.
وبسبب تناقص الأفكار في قلوبهم أو بالأحرى سوء أفكارهم وخبلهم. فإنهم يلوذون مرة أخرى بنصوص الكتب المقدسة، التي عادة لا يشعرون بها، فلا يدركون معناها الصحيح ـ ولكنهم جعلوا من عدم تقواهم الذاتى قاعدة طابقوا عليها كل هذه الأقوال الإلهية وحرفوها. وعند مجرد ذكر مثل هذا التعليم فإنهم لا يستحقون سماع شيء آخر سوى ” تضلون لأنكم لا تعرفون الكتب ولا قوة الله ” (مت29:22). وأن تشبثوا بكلامهم فمن الواجب أن نسكتهم بالقول “أعطوا ما للناس للناس. وما لله لله” (انظر متى21:22).
الفصل الثالث عشر: شرح نصوص: ثالثًا: عبرانيين 4:1 “صائرًا أعظم من الملائكة”
53ـ ولكنهم يقولون إنه مكتوب في الأمثال ” الرب أقامنى أول طرقه لأجل أعماله ” (أم22:8). وإنه في الرسالة الى العبرانيين يقول الرسول ” صائرًا أفضل من الملائكة بمقدار ما قد ورث اسمًا أكثر تميزًا عنهم ” (عب4:1). ويقول بعد قليل ” من ثم أيها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، ركزوا انتباهكم جيدًا على رسول ورئيس كهنته اعترافنا يسوع، حال كونه أمينا للذى أقامه ” (عب1:3ـ2). وفى سفر الأعمال ” فليعلم يقينا جميع بيت أسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربًا ومسيحًا ” (أع36:2).
هذه الأقوال يتفوهون بها في كل مكان، ولديهم أفكار معوجة عنها ومحرفين معناها، مدعين بها أن كلمة الله مخلوق ومصنوع، وواحد من المخلوقات وهكذا يخدعون الجهلاء، متسترين تحت ستار هذه الأقوال التي يطرحونها.
ولكنهم بدلاً من المعنى الحقيقي، فإنهم يلقون بذور سم هرطقتهم الخاصة. لأنهم ” لو كانوا يعرفون، لما كانوا يجدفون على هذا الذي هو رب المجد ” (1كو8:2)، ولما كانوا يحرفون معاني أقوال الكتاب الحسنة. إذن، فإن كانوا يتبنون أسلوب قيافا صراحة، فإنهم يكونون تبعًا لذلك قد قرروا أن يتهودوا، حتى أنهم يجهلون المكتوب بأنه ” حقًا سيسكن الله على الأرض ” (انظر زكريا10:2). دعهم لا يفحصون الأقوال الرسولية، لأن هذا ليس من سمة اليهود.
ولكن من الناحية الأخرى، إن كانوا يمزجون أنفسهم بالمانويين(72) الملحدين، وينكرون أن ” الكلمة صار جسدًا ” (يو14:1)، وينكرون “حضوره المتجسد”، إذن فلا يكون من حقهم أن يستعملوا الأمثال، لأن هذا كان غريبًا بالنسبة للمانويين. ولكن أن كان بسبب إثارة المشكلة، والربح الناتج من جشعهم، وبسبب طموحهم وحبهم للشهرة، لا يجسرون على إنكار أن “الكلمة قد صار جسدًا” لأن هذا مكتوب حقًا، عندئذ، فإما أنهم من واجبهم أن يفسروا تلك الكلمات المكتوبة بخصوص “الحضور التجسدى للمخلص”، تفسيرًا صائبًا، وإما إن كانوا ينكرون القصد السليم، إذن، فلينكروا أن الرب قد صار إنسانًا. لأنه لا يليق بهم أن يعترفوا بأن “الكلمة قد صار جسدًا”. ومن ناحية أخرى يستحون من المكتوب عنه، ولذلك فإنهم يحرفون معناه.
54ـ لأنه مكتوب ” بهذا المقدار صار أعظم من الملائكة ” (عب4:1)، لذلك فمن الواجب أن نفحص هذا أولاً. والآن من الملائم كما نعمل في كل الأسفار الإلهية، هكذا من الضرورى أن نعمل هنا أيضًا. فيجب أن نفهم بأمانة: الوقت الذي كتب عنه الرسول، والشخص والموضوع اللذين كتب عنهما، لكي لا يجد القارئ نفسه ـ وهو يجهل هذه الأقوال أو غيرها، بعيدًا عن المعنى الحقيقى. ولذلك فإن ذلك الخصى المحب للمعرفة ـ حينما عرف هذا توسل إلى فيلبس قائلاً: ” إنى أسألك، عمن يقول النبى هذا، عن نفسه أم عن شخص آخر؟ ” (أع34:8) لأنه كان يخشى أن يحيد عن المعنى المستقيم، ويفهم الكلام عن شخص آخر من خلال قراءته.
وأيضًا التلاميذ بسبب رغبتهم أن يعرفوا وقت حدوث ما قاله الرب توسلوا إليه قائلين ” قل لنا متى ستكون هذه الأمور؟ وما هي علامة مجيئك ” (مت3:24). وأيضًا عندما سمعوا من المخلص ما قاله عن النهاية، أرادوا أيضًا أن يعرفوا زمنها (انظر مت36:24). وذلك لكي لا يضلوا هم، وأيضًا لكي يتمكنوا من تعليم الآخرين. فإنهم بعد أن عرفوا فقد صححوا (أفكار) الذين كانوا على وشك الضلال من أهل تسالونيكى(73).
لذا فعندما يكون لدى واحد من مثل هؤلاء معرفة كثيرة، عندئذ سيكون له فكر إيمان صحى ومستقيم. أما إذا أساء أحد فهم شيء من هذه، فإنه سينزلق في الحال إلى الهرطقة. وهكذا ضل الذين يتبعون هيمنايس والأسكندر (1تيمو20:1). لأنه برغم أن الوقت لم يكن قد صار بعد. كانوا يقولون إن القيامة قد صارت بالفعل. (انظر2تيمو18:2). في حين أن الغلاطيين ـ بعد أن أكتمل الزمان ـ قد مالوا الآن إلى الختان(74). أما من جهة الشخص، فقد كابد اليهود ولا يزالون يقاسون حتى الآن، لأنهم يظنون أن هذه الآية ” هوذا العذراء تحمل وستلد ابنًا، وتدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا ” (إش14:7، مت23:1) تقال بخصوص واحد منهم (لا يزالون ينتظرونه) وأنه عندما قيل ” سيقيم لكم الرب نبيًا من وسطكم ” (تث15:18، اع22:3) فإنهم يظنون أنه يتكلم عن واحد من أنبيائهم. أما القول ” كشاه قد سيقت إلى الذبح ” (إش7:53)، فإنهم لم يتعلموا من فيلبس إلى من يشير، بل ظنوا أنه يتكلم عن إشعياء أو عن نبى آخر من بين أنبياءهم
55ـ لذا فإن أعداء المسيح أنزلقوا إلى الهرطقة البغيضة بسبب معاناتهم من مثل هذه الأمور. فإنهم لو كانوا قد عرفوا تمامًا الشخص والموضوع والوقت المتعلق بالكلمة الرسولية، لما جدف أولئك الحمقى إلى هذا الحد ـ ناسبين الأمور الناسوتية إلى ألوهيته.
وفى استطاعة أى شخص أن يرى هذا، لو أنه فسر بداية الفصل تفسيرًا جيدًا فإن الرسول يقول ” الله بعد ما كلم الآباء بواسطة الأنبياء قديمًا. مرات كثيرة وبطرق متنوعة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة بواسطه ابنه ” (عب1:1ـ2). وبعد قليل يقول ” بعد ما صنع بنفسه تطهيرًا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالى. صائرًا أعظم من الملائكة بمقدار ما قد ورث اسمًا أفضل منهم ” (عب3:1ـ4).
إن القول الرسولى إذن يشير إلى الزمن الذي فيه ” كلمنا بواسطة ابنه”. عندما قد صار تطهير خطايانا أيضًا. فمتى “تحدث إلينا في شخص ابنه”. ومتى قد صار “تطهير الخطايا”. ومتى قد صار إنسانًا إلا بعد الأنبياء في الأيام الأخيرة؟ وبما أنه كان يقص قصة التدبير الخاص بكل منا، وكان يتكلم عن الأزمنة الأخيرة. فإنه لا ينقطع عن ذكر أن الله لم يكف عن التحدث إلى الناس خلال الأزمنة الماضية، لأنه تحدث إليهم بواسطة الأنبياء. ولأن الأنبياء قد خدموا، والشريعة أعلنت بواسطة الملائكة (عب2:2)، والابن أيضًا نزل وجاء لكي يخدم (مت28:20)، لذا كان من الضرورى أن يضيف. “صائرًا أعظم من الملائكة بمثل هذا المقدار” رغبة منه أن يوضح أن الابن بقدر ما يختلف عن العبد بقدر ذلك صارت خدمة الابن أفضل من الخدمة التي يقدمها العبيد.
إذن، بعد أن ميز الرسول بين الخدمة قديما وبينها حديثًا فإنه يقدم لليهود كاتبًا وقائلاً ” صائرًا أعظم من الملائكة بمثل هذا المقدار “، لهذا فإنه لم يعقد مقارنة بينه وبين الكل (أى المخلوقات)، بقوله إنه قد صار “أعظم”، أو “أكثر كرامة”، وذلك لكي لا يظن أحد بخصوصه وخصوصهم ـ أنهم أبناء جنس واحد. بل قد قال إنه “أفضل” وذلك لكي يكون معروفًا، إختلاف طبيعة الابن عن طبيعة المخلوقات. ولدينا الدليل على هذا من الكتب المقدسة. إذ يترنم داود قائلاً ” يوم واحد في ديارك خير من ألف ” (مز10:84). أما سليمان فيهتف قائلاً: ” خذوا تأديبى لا الفضة. والمعرفة أكثر من الذهب المختار. لأن الحكمة خير من الأحجار الكريمة، وكل مادة ثمينة لا تساويها ” (أم10:8ـ11).
لأنه كيف لا تكون الحكمة والأحجار المستخرجة من الأرض، مختلفة في جوهرها، وهي بطبيعتها شيء آخر؟ وأية علاقة توجد بين الديار السماوية، وبين المساكن التي على الأرض؟ أم ما وجه التشابه بين الابديات والروحيات، وبين الأمور الوقتية والفانية؟ لأن هذا هو المعنى الذي يقوله إشعياء ” هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبوتى ويختارون ما يسرنى ويتمسكون بعهدى. أنى أعطيهم في بيتى وفى أسوارى موضعًا ذائع الصيت، أفضل من البنين والبنات، وسأعطيهم اسمًا أبديًا، ولن ينقطع ” (إش4:56ـ5).
إذن، فلذلك فليست هناك علاقة قرابة بين الابن والملائكة وما دامت ليست هناك علاقة ـ فلهذا فإن كلمة “أفضل” لا تذكر للمقارنة، بل بحصافة وفطنة بسبب اختلاف طبيعة الابن عن طبيعة الملائكة. ونفس الرسول هو الذي فسر كلمة “أفضل” قائلاً إن هذا لا يكمن في شيء آخر بل في الفرق بين الابن والمخلوقات، كمن يقول إن هذا هو الابن، بينما المخلوقات هم العبيد. وكما أن الابن هو مع الآب “جالس عن يمينه”، هكذا فإن العبيد يظهرون أمامه، “ويُرسَلون ويخدمون”.
56ـ وبما أن هذه الأقوال مكتوبة هكذا، أيها الآريوسيون فإنه يستدل منها أن الابن ليس مخلوقًا، بل بالأحرى هو كائن آخر غير كل المخلوقات. فهو ابن ذاتى للآب كائن في أحضانه. لأن ما هو مكتوب أيضًا: “صائرًا” لا يعنى أن الابن مخلوق مثلما تظنون أنتم. لأنه لو كان قد قيل ببساطة “صائرًا”، وسكت، لكان لدى الآريوسيين عذر، حيث إنه قد تكلم من قبل عن الابن موضحاُ من خلال كل الفقرة أنه كائن آخر غير المخلوقات. لهذا لم يدون “صائرًا” بمعنى مطلق، بل ربط “أعظم” بـ “صائرًا” لأنه أعتبر أن هذا القول ليس مختلفًا. عالمًا أن من يقول “صائرًا” عن من يُعتَرف به أنه ابن ذاتى، كمن يقول عنه إنه قد صنع، وإنه “أعظم”، ذلك لأن المولود لا يتغير، حتى وإن قيل عنه إنه قد صار، أو أنه قد وُجِدَ.
أما المخلوقات فلأنها مخلوقة، فمن المستحيل أن يقال عنها إنها مولودة، إلاّ فيما بعد، أى بعد خلقتها، حينما تشترك في الابن المولود. وفى هذه الحالة يقولون عنها أيضًا إنها قد ولدت، ليس بسبب طبيعتها الذاتية، بل بسبب مشاركتها للابن، في الروح. وهذا أيضًا تعترف به الكتب الإلهية، التي تقول عن المخلوقات ” كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء ” (يو3:1). ” وكل أعمالك بحكمة صنعت ” (مز24:104). أما عن الأبناء المولودين فيقول: ” ولد لأيوب سبعة بنين وثلاث بنات ” (أيوب2:1) ” وكان لأبراهيم مئة سنة عندما ولد له اسحق ابنه ” (تك5:21) أما موسى فقال: ” إن ولد بنون لأي شخص ” (انظر خر4:21)، لذلك فإن كان مختلفًا عن المخلوقات، وهو المولود الوحيد الذاتى لجوهر الآب، فقد أحبط إدعاء الأريوسيين بخصوص لفظة “صائرًا”.
لأنه، وإن كان على الرغم من خجلهم بسبب إحباطهم فإنهم يضطرون أن يقولوا، إن الكلمات قد قيلت على سبيل المقارنة. ولهذا فإن الأقوال المقارنة هي من نفس النوع، حتى أن الابن يكون من نفس طبيعة الملائكة، فهم سيقعون في العار مقدمًا لأنهم يحاكون ويؤكدون تعاليم فالنتينوس وكاربوكراتوس(75) وغيرهما من الهراطقة.
فالأول منهما قال إن الملائكة من نفس طبيعة المسيح، أما كاربوكراتوس فيقول إن الملائكة هم الذين خلقوا العالم، فربما تعلموا منهم أيضًا أن يقارنوا “كلمة الله” بالملائكة.
57ـ ولكنهم بتخيلهم مثل هذه الأمور، فإن المرنم يخجلهم بقوله ” من يكون شبيهًا بالرب من بين أبناء الله ” (مز1:89). ” من يشبهك بين الآلهة يا رب؟ ” (مز8:86). إلا أنهم ـ إن كانوا يريدون أن يعرفوا ـ سيسمعون الجواب، بأن الأمور المتعلقة بالمقارنة إنما تكون بين المتماثلين في الجنس، وليس بين غير المتجانسين.
إذن، فليس في وسع أحد، أن يقارن الله بالإنسان. كما أنه لا يمكنه مقارنة الإنسان بالخيل، ولا الأخشاب بالأحجار نظرًا لعدم تشابه طبيعتهما. لكن الله هو جوهر لا نظير له ولا يقاس بغيره. أما الإنسان فإنه يقارن بإنسان، كما يقارن الخشب بالخشب، والحجارة بالحجارة. وليس في وسع أحد أن يستخدم قط عن هذه الأشياء كلمة “أعظم” بل يستعمل كلمات مثل “نوعًا ما” و “أكثر”. فمثلاً كان يوسف جميلاً نوعًا ما بين أخوته. وراحيل أكثر جمالاً من ليئه. وليس نجم “أفضل” من نجم. ولكنه يختلف نوعًا ما في المجد (انظر 1كو41:15). أما في حالة الأشياء غير المتشابهة. فعند مقارنة هذه الأشياء بعضها ببعض، فعندئذ يقال “أفضل” عن الأشياء التي لها نوعية مغايرة. مثلما سبق أن قيل عن الحكمة والأحجار الكريمة.
إذن فإن كان الرسول قد قال ” إن الابن أرقى بكثير من الملائكة ” أو هو “أعظم بدرجة أكبر” لكان لكم العذر أن تقارنوا الابن بالملائكة. أما الآن فبقوله إنه “أفضل” وإنه يختلف بدرجة كبيرة بقدر ما يختلف الابن عن العبيد، فإنه يبين أنه مختلف عن طبيعة الملائكة.
ومرة أخرى، عندما يقول إنه هو “الذى أسس جميع الأشياء” (انظر عب10:1). يبين أنه مختلف عن جميع المخلوقات. وبما أنه مختلف تمامًا في جوهره عن طبيعة المخلوقات. فأى مقارنة أو مضاهاة لجوهرة يمكن أن توجد بالمقارنة مع المخلوقات؟ لأنهم إن استعادوا – إلى ذاكرتهم من جديد شيئًا من هذا. فلا شك أن بولس سيفندها لهم عندما يقول: ” لأنه لمن من الملائكة قال قط. أنت أبنى وأنا اليوم ولدتك ” (عب5:1). ويقول عن الملائكة ” الصانع ملائكته أرواحًا وخدامه لهيب نار ” (عب7:1).
58ـ فها هو ذا إذن يستخدم فعل “يصنع” عن المخلوقات وهو يقول عنها إنها مصنوعة. أما بخصوص الابن فلم يستخدم كلمة “صنع” ولا “صيرورة” بل يقول عنه إنه “الأبدى” و “الملك” “وكونه الخالق”، عندما تكلم قائلاً: ” عرشك يا الله إلى دهر الدهور ” (عب8:1). ” وأنت يا رب في البدء أسست الأرض. والسموات هي عمل يديك. وهي ستبيد ولكنك أنت ستبقى ” (عب10:1ـ11).
ومن هذه الكلمات يمكنهم أن يفهموا ـ إن كانوا يريدون ـ أن الخالق هو آخر غير المخلوقات، أما المخلوقات فهى شيء آخر غيره، وأنه هو الله. أما تلك المخلوقات فقد صنعت من العدم. لأن ما يقوله هنا “هذه ستبيد”، لم يقله لأن الخليقة ستصير الى زوال. بل لكي يبين طبيعة المخلوقات. من النهاية التي ستؤول إليها. لأن تلك التي لها قابلية الهلاك، حتى وإن لم تكن هلكت بعد ـ بسبب فضل ذاك الذي خلقها ـ إلا أنها قد خلقت من العدم ـ مما يشهد بأن هذه الأشياء لم تكن موجودة يومًا ما. من أجل هذا إذن، حيث إن مثل هذه الأشياء لها مثل هذه الطبيعة فإنه يقال عن الابن القول “أنت ستبقى”. لكي تتضح أبديته.
لأنه حيث إنه ليس فيه إمكانية الفناء، كما يحدث للمخلوقات ـ بل له الدوام إلى الأبد، فليس ملائمًا أن يقال عنه: “لم يكن موجودًا قبل أن يولد”. فإنه هو نفسه الموجود دائمًا، والدائم مع أبيه. وحتى لو لم يكن الرسول قد كتب هذا في الرسالة إلى العبرانيين إلا أنه في رسائله الأخرى، بل كل الكتاب المقدس يحول دون تخيل مثل هذه التصورات عن “اللوغوس”. وحيث إن الرسول كتب هذا، وكما قد اتضح من قبل، أن الابن هو مولود جوهر الآب، وأنه هو الخالق، وأن المخلوقات خلقت بواسطته، وأنه هو أيضًا “البهاء”، و”اللوغوس” و”الصورة”. و”حكمة الآب”.
في حين أن المخلوقات أحط من الثالوث، وهم يساعدون ويخدمون. ولذلك فإن الابن مختلف في النوع، ومختلف في الجوهر بالنسبة إلى المخلوقات. وبالأحرى فإنه هو من ذات جوهر الآب ومن نفس طبيعته
لذلك فإن الابن نفسه لم يقل “أبى أفضل منى” حتى لا يظن أحد أنه غريب عن طبيعة الآب. بل قال “أعظم منى” (يو28:14)، ليس من جهة الحجم ولا من جهة الزمن، بل بسبب ميلاده من أبيه ذاته، فأنه حتى عندما يقال “أعظم منى” أظهر مرة أخرى أنه من ذاتية جوهره (الذاتى)(*).
59ـ والرسول نفسه عندما قال ” صائرًا أفضل من الملائكة بمثل هذا المقدار “. لم يقل هذا ليس لأنه أراد أولاً أن يقارن جوهر اللوغوس بالمخلوقات ـ لأنه لا يوجد وجه للمقارنة، أو بالأحرى فإن الواحد منهما غير الآخر تمامًا. ولأنه وهو يرى “حضور اللوغوس التجسدى” إلينا، والتدبير الصائر منه عندئذ، فإنه يوضح أن اللوغوس ليس مشابها للذين سبقوا أن جاءوا قبله. وهذا لكي يوضح أنه بقدر ما يختلف هو (اللوغوس) بحسب الطبيعة عن الذين أرسلهم قبله، بقدر ما كانت النعمة الصائرة منه وبه أفضل من خدمة الملائكة. لأن العبيد كانوا مختصين فقط بالمطالبة بالثمار وليس أكثر (مت34:21). أما الابن والسيد فكان يحق له أن يصفح عن ديونهم وأن يسلّم الكرم إلى آخرين.
هذا إذن الذي يذكره الرسول بعد ذلك، يوضح اختلاف الابن عن المخلوقات قائلاً: ” لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعناه حتى لا نبتعد عنه. لأنه إن كانت الكلمة التي نطق بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال جزاء عادلاً. فكيف ننجو إن أهملنا خلاصًا هذا مقداره؟ هذا الخلاص الذي بدأ الرب التحدث به، ثم تثبت من الذين سمعوه ” (عب1:2ـ2). فإن كان الابن معدودًا واحدًا من المخلوقات، لما كان أفضل منهم، ولما أختص من يعصاه بأعظم قدر من العقاب بسببه. لأنه في خدمة الملائكة لم يكن مسموحًا لأي واحد منهم أن يتمكن من معاقبة المخالفين سواء بأكثر أو بأقل، بل كانت الشريعة واحدة، وكان الحكم واحدًا بالنسبة إلى المخالفين.
ولكن حيث إن اللوغوس ليس معدودًا بين المخلوقات بل هو ابن الآب، لذلك فبقدر ما كان هو أفضل، كلما كانت الأعمال الخارجة منه، أفضل ومغايرة، وكلما وجب أن تكون العقوبة أشد. إذن دعهم ينتظرون النعمة الممنوحة عن طريق الابن. وليدركوا هذا المشهود له بواسطة الأعمال أنه مختلف عن المخلوقات وأنه وحده الإبن الحقيقى الذي في الآب، والآب فيه.
والشريعة نطق بها بواسطة ملائكة، وهي لم تكمل أحدًا، بسبب إحتياجنا إلى مجئ اللوغوس إلينا مثلما قال بولس (انظر عب19:7). أما مجئ اللوغوس فقد أكمل عمل الآب. (يو4:17) وفى ذلك الوقت كان ” الموت قد ملك من آدم إلى موسى ” (رو14:5) أما حضور اللوغوس فقد ” أبطل الموت ” (2تى10:1) ولم نعد بعد ” نموت جميعًا في آدم، بل في المسيح سيُحيا الجميع ” (1كو22:15). عندئذ كان ينادى بالشريعة من دان إلى بئر سبع، ” وكان الله معروفًا في اليهودية ” (مز1:76) وحدها. أما الآن فقد ” خرج صوتهم إلى كل الأرض ” (مز4:19). ” وقد أمتلأت الأرض من معرفة الله ” (إش9:11). ” والتلاميذ تلمذوا كل الأمم ” (مت19:28). واليوم تم المكتوب ” ويكون الجميع متعلمين من الله ” (يو45:6، إش13:54).
وفى ذلك الوقت كانت تلك الشواهد مجرد مثال، أما الآن فقد ظهرت الحقيقة نفسها. وهذا يفسره الرسول مرة أخرى بعد ذلك بشكل أوضح عندما يقول: ” على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنًا لعهد أفضل ” (عب22:7). ومرة أخرى يقول ” ولكن يسوع الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط لعهد أفضل قد تثبت على تعهدات أفضل ” (عب6:8)، و ” لأن الناموس لم يكمّل شيئًا. ولكن يصير إدخال رجاء أفضل ” (عب19:7).
ويقول مرة أخرى ” فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السموات تطهر بهذه الأساليب، أما السماويات عينها فإنها تطهر بذبائح أفضل من هذه ” (عب23:9). والآن إذن، فإن كلمة “أفضل” تشير كلية إلى الرب، الذي هو أفضل من سائر المخلوقات. ومميزًا عنها. ذلك لأن ذبيحته أفضل، والرجاء فيه أفضل. والوعود المعطاة بواسطته. ليست لمجرد مقارنتها كعظيمة أمام أخرى صغيرة، بل لكونها مختلفة عن الأخرى بحسب طبيعتها. لأن مدبر هذه الأمور هو “أفضل” من المخلوقات.
60ـ وأيضًا قوله “قد صار ضامنًا”، أى الضمانة المعطاة منه لأجلنا. لأن اللوغوس قد “صار جسدًا”، فإننا نعتبر “الصيرورة” أنها تشير إلى الجسد، لأن “الجسد مخلوق وهو مصنوع”. وهكذا أيضًا كلمة “قد صار” فإننا نفسرها بحسب مدلوها الثانى. وذلك بسبب صيرورته إنسانًا. وعلى المعارضين أن يعرفوا أنهم ينزلقون بسبب سوء نيتهم هذه.
وليعرفوا إذن أن بولس الذي عرفه “كإبن” و”حكمة” و”بهاء” و”صورة” الآب، لم يقصد أن جوهر “اللوغوس” قد “صار” بل تعتبر “الصيرورة” هنا لخدمة ذلك العهد الذي كان فيه الموت سائدًا يومًا، وهو قد أبطل هذا الموت.
وبحسب هذا فإن الخدمة من خلاله قد صارت أفضل، إذ أيضًا ” لأن ما كان الناموس عاجزًا عنه حينما كان ضعيفًا من ناحية الجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ولأجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد ” (رو3:8) نازعًا الخطيئة من الجسد، الذي كان أسيرًا لها على الدوام لدرجة أنه لم يستوعب الفكر الإلهى. وإذ جعل الجسد قادرًا على تقبل “اللوغوس” فإنه خلقنا حتى ” لا نسلك بعد بحسب الجسد بل بحسب الروح “.
ونقول ونكرر نحن ” لسنا في الجسد بل في الروح ” (رو9:8)، وأن ابن الله جاء ” إلى العالم لا لكي يدين العالم” بل لكي يفدى الجميع “ويخلص به العالم ” (يو17:3). لأنه سابقًا إذ كان العالم ـ كمسئول ـ وكان يدان بواسطة الناموس، أما الآن فإن اللوغوس أخذ الدينونة على نفسه، وبتألمه لأجل الجميع بالجسد. وهب الخلاص للجميع. هذا ما رآه يوحنا فصاح قائلاً ” الناموس بموسى أعطى. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا ” (يو17:1). فالنعمة أفضل من الناموس، والحقيقة أفضل من الظل.
61ـ إذن. فإن “الأفضل” ـ كما سبق أن قيل، لم يكن ممكنا أن يصير بواسطة أى شخص آخر بل بواسطة الإبن “الجالس عن يمين أبيه”. وما الذي يعنيه هذا سوى أصالة الابن وأن ألوهية الآب هذه إنما هي ألوهية الابن؟
فإن الإبن وهو مالك ملكوت الآب، فإنه يجلس في ذات العرش مع الآب، ونراه مرتبطًا بألوهية الآب. إذن فاللوغوس هو الله، و” الذي يرى الابن يرى الآب ” (يو9:14). وهكذا فهو إله واحد.
إذن فبجلوس الابن عن اليمين، لا يعنى بذلك أن الآب على يساره بل يعنى أن ما يكون يمينًا وكريمًا في الآب، فهذا أيضًا يكون للابن. وهو يقول ” كل ما هو للآب فهو لى ” (يو15:16). ولذا فإن الابن وهو جالس على اليمين يرى الآب نفسه على اليمين، بالرغم من أنه بصيرورته إنسانًا يقول ” إنى أرى الرب أمامى في كل حين، أنه عن يمينى لكي لا أتزعزع ” (مز8:16). وهذا يوضح أيضًا أن الإبن في الآب، والآب في الابن (انظر يو10:14) ولكون الآب على اليمين يكون الإبن على اليمين. ومثلما يجلس الابن على اليمين يكون الآب في الإبن. والملائكة يخدمون صاعدين ونازلين.
أما عن الابن فيقول ” ولتسجد له كل ملائكة الله ” (عب6:1). عندما تقوم الملائكة بالخدمة يقولون ” أُرسلت إليك ” (لو19:1). ” الرب قد أوصى ملائكته ” (انظر مز11:91).
أما الابن فإنه يقول وهو في الصورة البشرية: ” الآب قد أرسلنى” (يو36:5) وإنه ” أتى لكي يعمل ” (يو36:5) ولكي “يخدم” (يو36:5) إلاّ أنه لكونه “اللوغوس” و”الصورة” يقول ” أنا في الآب والآب في ” (يو10:14)، ” ومن رآنى فقد رأى الآب ” (يو9:14) ” والآب الحال في هو الذي يعمل الأعمال ” (يو10:14). لأن الأشياء التي نراها في تلك الصورة، فهذه هي أعمال الآب.
إن ما سبق أن قيل كان ينبغى أن يخجل الذي يصارعون ضد الحق. ولكن إن كانوا بسبب ما كتب “صائرًا أفضل” يرفضون أن يفهموا أن “صائرًا” إنما تقال عن الإبن في حالة صيرورته إنسانًا. أو تقال عنه بسبب الخدمة الأفضل التي صارت بالتجسد، كما قلنا، بل يفهمون بهذه العبارة أن اللوغوس مخلوق، فليسمعوا مرة أخرى بإيجاز هذه الأقوال لأنهم قد نسوا ما كان قد قيل.
62ـ لأنه لو كان الابن يحسب من بين الملائكة، واستعملت كلمة “صائرًا” عنه كما عن الملائكة، وإن كان لا يختلف عنهم في شيء بحسب الطبيعة: ففى هذه الحالة، أما أن يكون الملائكة جميعًا أبناء، أو يكون هو ملاكًا. وهكذا فإما أن الجميع يجلسون عن يمين الآب، أو أن يقف الابن مع الملائكة ” كأحد الأرواح الخادمة المرسلة للخدمة ” (عب14:1) مثله مثل الملائكة.
ولكن من الجهة الأخرى. إن كان بولس قد ميز بين الابن والمخلوقات قائلاً ” لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابنى ” (عب5:1). لأن الابن قد خلق السماء والأرض، أما الملائكة فإنهم قد خُلِقوا بواسطته، هو يجلس مع الآب، أم هم فيقفون ويخدمون، فلمن لا يكون واضحًا أنه لم يستعمل “صائرًا” عن جوهر اللوغوس، بل عن الخدمة الصائرة منه؟.
فكما أنه لأنه “اللوغوس” قد “صار جسدًا”، فإنه حينما صار إنسانًا، فإنه في خدمته “قد صار أفضل بمثل هذا القدر” من الخدمة الصائرة من الملائكة. وبقدر ما يختلف الابن عن العبيد، والخالق عن المخلوقات هكذا فليكفوا عن إعتبار كلمة “صائرًا” أنها عن جوهر الابن، لأن الابن ليس من بين المخلوقات، وليعلموا أن “صائرًا” إنما تشير إلى خدمته، والتدبير الذي صار فعلاً.
أما كيف قد صار أفضل في الخدمة، إذ هو أفضل بالطبيعة عن المخلوقات فهذا يثبت مما سبق أن قلناه، وأعتقد أنه يكفى لتخجيلهم. ولكنهم إن استمروا في إنكارهم، ففى هذه الحالة يكون من المناسب أن نقاوم جسارتهم المتهورة، ونعارض أولئك بنفس الأقوال التي قيلت عن الآب ذاته. وهذا يؤدى أما إلى تخجيلهم لكي يكفوا ألسنتهم عن الشر، وأما أن يعرفوا إلى أى مدى سحيق وصل جنونهم.
إنه مكتوب ” لتكن لى إله معين. وبيت أحتمي به لكي تخلصنى ” (مز2:31) وأيضًا ” صار الرب ملجأ للمعدم ” (مز9:9). وغيرها كثير مثلها في الكتب المقدسة. فإن كانوا يقولون إن هذه الأقوال قد كتبت عن الابن وهو المحتمل أن يكون هكذا حقًا، فيجب عليهم أن يعرفوا بأن القديسين يطلبون اليه بإلحاح أن يكون معينًا لهم وبيت إحتماء. لأنه ليس بمخلوق. ولذلك فإن “صائرًا” و”صنع” ولفظ “قنى” من الواجب فهمها أنها تشير إلى حضوره المتجسد، لأنه بتجسده قد “صار معينًا”، “وبيت حماية” عندما ” حمل خطايانا في جسده على الخشبة ” (1بط24:2)، وهو الذي قال ” تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال، وأنا أريحكم ” (مت28:11).
63ـ إلاّ أنهم إن قالوا إن هذه الأقوال إنما هي عن الآب، فهل سيحاولون أن يقولوا إن الله مخلوق بسبب ما جاء في هذه الأقوال من عبارات “لتكن لى” أو “صار الرب”، نعم أنهم سيتجاسرون على ذلك مثلما يفكرون بنفس الأفكار عن اللوغوس. لكن حاشا أن يأتى قط مثل هذا التفكير إلى فكر أى واحد من المؤمنين، فالابن ليس من بين المخلوقات، كما أن المكتوب هنا “لتكن” “وصار” لا يعنى بداية الوجود، بل يعنى المعونة التي تعطى للمحتاجين إليها.
لأن الله هو هو دائمًا، أما الناس فقد صاروا بعد ذلك بواسطة اللوغوس، حينما أراد الآب ذاته. فإن الله لا يُرى. ولا يمكن الدنو منه بالنسبة إلى المخلوقات. وخاصة بالنسبة للناس. إذن فعندما يتوسل الناس في ضعفهم. ويطلبون العون وهم مطاردون، وعندما يصلون وهم مظلومون، فإن غير المنظور ـ لكونه محبًا للبشر ـ يظهر لهم بوجوده وإحسانه الذي يقدمه بواسطة وفى شخص “كلمته” الذاتى. وحينئذ تكون علامات الظهور بحسب حاجة كل واحد فيظهر قويًا للضعفاء، ويظهر “ملجأ” للمطرودين. “وبيت حماية” للمظلومين ويقول ” بينما أنت تستغيث، أقول هأنذا إنى حاضر بجوارك ” (إش9:58).
فإن معونة تأتى لأي واحد بواسطة الإبن، فإن ذلك الواحد يقول إن الله قد “صار” له، حيث إن المساعدة من الله قد صارت بواسطة اللوغوس وإن عادة استعمال الناس تعرف هذا الأمر، والجميع يعترفون بهذا ويتكلمون بالحق.
وكثيرًا ما أعطى البشر معونة لبشر مثلهم، فهناك من يتعاطف مع المصاب مثلما فعل إبراهيم مع لوط (انظر تك13:14ـ16). وهناك من فتح داره للمطرود، كما فعل عوبديا لبنى الأنبياء (1ملوك4:18). وهناك من أراح الغريب، ملما أراح لوط الملائكة (انظر تك3:19)، وهناك من أعطى للمحتاجين، مثلما أعطى أيوب للذين سألوه (انظر أيوب15:29ـ16). فلو قال واحد من هؤلاء الذين نالوا المعونة: ” مثل هذا المعين قد صار لى “، ولو قال آخر “صار لى ملجأ”.
ويقول آخر “قد صار واهب”. فإنهم عندما يقولون لا يقصدون بداية وجود المحسنين إليهم. ولا جوهرهم، بل يقصدون الإحسان الصائر إليهم من أولئك المحسنين. هكذا عندما يقول القديسون، عن الله أنه “قد صار” “ولتكن لى” فإنهم لا يعنون أى بدء للوجود، لأن الله ليس له بداية، وليس مخلوقًا، بل يقصدون الخلاص الذي صنعه هو للبشر.
64ـ فإن كانت الأمور تفهم هكذا، فإنهم سيفهمون هكذا عن الابن أيضًا، حينما يقال “قد صار” و “لتكن” حتى أنه حينما نسمع القول ” صائرًا أفضل من الملائكة ” (عب4:1)، “وقد صار”، فحاشا أن نفكر في أية بداية لوجود اللوغوس، ولا أن نتخيل أبدًا من مثل هذه الأفكار أنه مخلوق. بل يجب أن نفهم ما يقوله بولس أنه يشير إلى الخدمة والتدبير الخاص بصيرورته إنسانًا. لأنه عندما ” صار الكلمة جسدًا وسكن فينا ” (يو14:1)، ” جاء لكي يخدم ” (مت28:20)، ولكي يهب للجميع خلاصًا، وعندئذ صار لنا خلاصًا، وصار لنا حياة. وصار فداء. عندئذ فإن تدبيره من أجلنا ” قد صار أفضل من الملائكة “. وصار طريقًا. وصار قيامة.
وكما أن القول ” لتكن لى إله معين ” (مز2:31) لا يشير إلى صيرورة جوهر الله ذاته، بل تشير إلى محبته للبشر، كما قيل، هكذا الآن: ” صائرًا أفضل من الملائكة ” و”صار”. و” بقدر هذا قد صار يسوع ضامنًا أفضل ” (عب22:7)، لا تعنى أن جوهر اللوغوس مخلوق (حاشا)، بل يقصد الإحسان الصائر لنا بتأنسه، رغم جحود الهراطقة. ومشاغبتهم بسبب عدم تقواهم.
تمت المقالة الأولى وتليها الثانية هنا: ضد الأريوسين م1 – أثناسيوس الرسولي
(1) قارن 1 تيمو20:1 و 2 تيمو 17:2 هيمينايس والاسكندر هما اثنان من المعلّمين المبتدعين في المسيحية الأولى، اللذين حرمهما بولس الرسول من الخدمة في الكنيسة لأنهما آمنا وعلّما بأن قيامة الأموات العامة قد صارت.
(2) سوتيادس شاعر يونانى قديم من مارونيا، ذاع صيته أيام حكم بطليموس فيلاديفوس. وكان موضوع أشعاره من الميثولوجيا اليونانية ذات الأسلوب الفاضح الوقح، ولذلك سمى بالشاعر الداعر.
(3) ابنة هيروديا، كانت قد ابهجت صدر هيرودس برقصاتها المغرية لدرجة أنها طلبت منه أن يقدّم لها رأس يوحنا السابق على طبق أنظر متى 1:14 – 12، مر17:6 – 29.
(4) الثاليا هي أشعار وقصائد ألفها أريوس بهدف نشر هرطقته بما فيها من تعاليم خاصة.
(5) يبدو أن القديس أثناسيوس يشير إلى أن البعض كان يطلق على المؤمنين المستقيمى الرأى اسم أثناسيوس، لكي يجدوا بهذا مبررًا لأنفسهم وهم يسمون أتباعهم بأسمائهم، وأن يعتبروا أنفسهم مسيحيين.
(6) انظر (يوئيل 25:2) حيث يشير الى الجراد والطيار بلقب “جيش الله العظيم”.
(7) يقصد مجمع نيقية المسكونى الأول الذي أنعقد سنة 325م.
(8)) كان الإمبراطور قسطنديوس يحمى الآريوسيين ولذلك فإنه نفى أثناسيوس مرتين في عامى 340، 356
(9) مز 1:2.
(10) يو 1:1.
(11) رؤ 4:1.
(12) يو 20:1.
(13) 1كو24:1.
(14) أى أن القوة منسوبة للآب وخاصة به. ولكنه لم يقل أن الاب نفسه هو القوة ذاتها. بل أن الابن هو قوة الاب (المعرب).
(15) 2 كو17:3.
(16) كو 17:1.
(17) مت 27:11.
(18) أش 28:40.
(19) دانيال (سوسنة 42).
(20) باروخ 20:4.
(21) باروخ 22:4.
(22) عب 3:1.
(23) مز 17:89.
(24) مز 10:35 (فى ترجمة جمعية الكتاب المقدس مز 9:36).
(25) مز 13:144 (أى مز 13:145).
(26) يوحنا 12:8.
(27) يو 14:10.
(28) يو 12:8.
(29) يو 13:13.
(30) تكوين 5:2 (الترجمة السبعينية).
(31) تث 8:22.
(32) يو 28:14،29.
(33) أم 23:8 – 25 (السبعينية).
(34) يو 58:8.
(35) أرميا 5:1.
(36) مز 89 (90): 1 – 2.
(37) دانيال (سوسنة42).
(38) يو 3:1.
(39) أمثال 1:18.
(40) يوحنا 14:16.
(41) متى 5:17.
(42) يوحنا 18:5.
(43) 2بط 4:1.
(44) 1 كو 16:3.
(46) انظر 2كو7:5.
(47) ارميا 13:2.
(48) ارميا 12:17،13.
(49) باروخ 12:3.
(50) يو 6:14.
(51) ام 12:8.
(52) اش 11:58.
(53) مز24:103 (السبعينية) مز24:104 في الطبعة الشائعة.
(54) أم 10:3.
(55) يو 3:1.
(56) 1 كو6:8.
(57) يو 6:14.
(58) أم 30:8 (السبعينية).
(59) كان يوسابيوس أسقفًا لنيقوميدية وكان زميلاً لأريوس في مدرسة لوسيان بأنطاكية وظل صديقًا له على الدوام. وأخذ على عتقه أن يقوم بتأييد آريوس تأييدًا مطلقًا بعد أدانته بواسطة المجمع المسكونى الأول (نيقية 325) وعمل بجد عملاً متواصلاً لأجل قبول آريوس من جديد في الكنيسة وعلى الرغم من عدم نجاحه في ذلك، فان الأريوسية تدين له بأنها لم تتلاشى وتختف فورًا بل ظلت كخطر داهم جسيم لفترة طويلة على الكنيسة.
(60) انظر رو23:1.
(61) أفسس 15:3.
(62) يو 1:1.
(63) عب 3:1.
(64) رو 5.
(65) كان بولس الساموساطى أسقفًا لانطاكية (260 – 268) وأدين في عام 268م بعد سلسلة من المجامع التي من خلالها ظهر ضلال عقائده. وحسب تعليم هرطقته اعتبر أن المسيح كان مجرد انسانًا عاديًا ثم صار الها بسبب جدارة عظمة شخصيته التي استحقها بسبب التبنى (ولذلك) سمّى مشايعوه باسم أصحاب التبنى وهكذا أنكر الساموساطى تعليم الثالوث القدوس وتعليم التجسد ولكنه اعترف فقط أن المسيح أفضل من موسى والأنبياء.
[1] تعبير أن طبيعة الله هي طبيعة بسيطة غير مركبة تعني أنه غير منقسم إذ أن التركيب هو بداية الإنقسام.
(66) الآباء الأساقفة الـ 318 الذين اجتمعوا في المجمع المسكونى الأول في نيقية، والذي أدان الهرطقة الأريوسية.
(67) كان أستيريوس مثل أريوس وأوسابيوس النيقوميدى، تلاميذ لوكيانوس الأنطاكى. وقد تبع استيريوس التعاليم الأريوسية وكتب لهم دستور عقيدتهم، وقد لعب دورًا هامًا في نشر الأريوسية بواسطة رحلاته المستمرة التي كان يقوم فيها بالدعاية للآريوسية.
(68) اللغة اليونانية تستعمل أداة التعريف قبل المضاف وقبل المضاف إليه والمقصود “قوة الله وحكمة الله” (المعرب).
[2] حيث إن الابن أيضًا هو “مخلوق”.
(69) أى التي من الآب (المعرب)
(70) مز71 في الترجمة السبعينية ويقابل مز17:72، مز5:72.
(71) أى بحسب كونه الابن الذي من ذات الآب (المعرب).
[4] ” الذي نزل هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل ” (أف9:4).
(72) كانت المانوية مماثلة لمذهب الغنوسية (أى مذهب العارفين. وهم المسيحيون الذين يعتقدون أن الخلاص بالمعرفة دون الإيمان). وكانت المانوية تؤمن بالمبدأ الثنائى: فالعالم تحكمه قوتان مضادتان: النور والظلام، والخير والشر. الله والمادة وبحسب أعتقادهم أن المسيح قد صلب لأن لديه في داخله عنصر خاضع للألم والمعاناة.
(73) أساء أهل تسالونيكى فهم محتويات رسالة الرسول بولس الأولى الموجهة إليهم بخصوص مجئ المسيح الفجائى، وتركوا أعمالهم في انتظار المجئ الثانى، لذلك أضطر الرسول أن يكتب إليهم الرسالة الثانية كي يهدئ خواطرهم، معلنا لهم العلامات التي ستسبق هذا المجئ.
(74) كان المسيحيون المتهودون يعملون على غواية الغلاطيين، وكان هؤلاء المتهودون يعتبرون الاحتفاظ بشريعة موسى والختان ضرورة ملحة للمسيحية وكتب بولس رسالته إليهم – خاصة لأجل دحض وجهة النظر هذه.
(75) فالنتينوس هو المثل الرئيسى للغنوسية في القرن الثانى وبحسب مذهبه أن العالم نشأ من الإله الأعلى بواسطة سلسلة لا نهائية من الآلهة الوسطاء ـ أى الدهور. وقد وصلت إلينا أخبار هذه الهرطقة أساسًا من إيريناؤس وهيبوليتوس.
أما كاربوكراتوس: فقد كان فيلسوفًا من الأسكندرية تأثر كثيرًا بأفلاطون أكثر من غيره من الغنوسيين، وكان يعلم بأن الله غير المولود هو أبو الملائكة والأرواح، وبعض من هؤلاء الملائكة هم خالقوا العالم ـ وبحسب مذهبه ولد يسوع ابنًا طبيعيًا من مريم ويوسف رغم أنه أكثر برًا من كل البشر.
(*) في مواضع أخرى من المقالات الأربعة فسر القديس أثناسيوس هذه الآية وآيات أخرى مشابهة بمعنى أن الآب أعظم من جسد الأبن. (المقالة 7:3) (المعرب).