تغيير وتجديد الإنسان بالمسيح – العظة 44 للقديس مقاريوس الكبير – د. نصحى عبد الشهيد
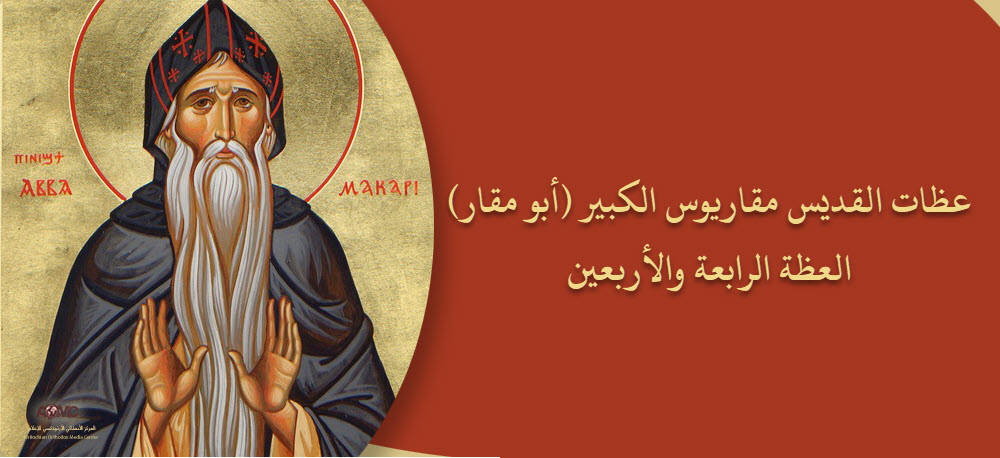
تغيير وتجديد الإنسان بالمسيح – العظة 44 للقديس مقاريوس الكبير – د. نصحى عبد الشهيد
التغيير والتجديد الذي يعمله المسيح في الإنسان المسيحي، وأن المسيح هو
الذي يشفي أوجاع النفس وأمراضها.
ضرورة التغيير:
إن من يأتي إلى الله، ويرغب أن يكون بالحق شريكًا للمسيح ينبغي أن يأتي واضعًا في نفسه هذا الغرض: ألا وهو أن يتغير ويتحوّل من حالته القديمة وسلوكه السابق، ويصير إنسانًا صالحًا جديدًا ولا يتمسك بشيء من الإنسان العتيق. لأن الرسول يقول “إن كان أحدٌ في المسيح فهو خليقة جديدة” (2 كو 5: 17) وهذا هو نفس الغرض الذي من أجله جاء ربنا يسوع، أن يغيّر الطبيعة البشريّة ويحوّلها ويجدّدها ويخلق النفس خلقة جديدة، النفس التي كانت قد انتكست بالشهوات بواسطة التعدي.
وقد جاء المسيح لكي يوحّد الطبيعة البشرية بروحه الخاص، أي روح الله، وهو قد أتى لكي يصنع عقلاً جديدًا، ونفسًا جديدة، وعيونًا جديدة، وآذانًا جديدة، ولسانًا جديدًا روحيًا، وبالاختصار أناسًا جددّا كلية- هذا هو ما جاء لكي يعمله في أولئك الذين يؤمنون به. إنه يصيرهم أواني جديدة، إذ يمسحهم بنور معرفته الإلهي، لكي يصب فيهم الخمر الجديد، الذي هي روحه، لأنه يقول إن “الخمر الجديدة ينبغي أن تُوضع في زقاق جديدة” (مت 9: 17).
قوة المسيح على تغيير الإنسان وشفائه:
وكما أن العدو لما أخضع الإنسان لسيادته غيّره لحسابه الخاص إذ ألبسه الشهوات الشريرة وغطاه بها، ومسحه بروح الخطية، وصب فيه خمر الإثم والتعليم الشرير، هكذا فإن الرب أيضًا إذ قد افتدى الإنسان وأنقذه من العدو، فقد جعله جديدًا، ومسحه بروحه، وسكب فيه خمر الحياة، والتعليم الجديد: تعليم الروح، لأن الذي غيّر طبيعة الخمس خبزات وصيرها إلى خبزات تكفي لجمع كثير، والذي أعطى نطقًا لطبيعة الحمار غير العاقل، والذي غيّر الزانية إلى العفة والطهارة، وجعل طبيعة النار المحرقة بردًا على أولئك الذين كانوا في الأتون، والذي غيّر طبيعة الأسد الكاسرة لأجل دانيال، فإنه يستطيع أيضًا أن يغيّر النفس التي كانت مقفرة وشرسة، من الخطية إلى صلاحه الخاص ومحبته الشفوقة وسلامه، وذلك ” بالروح القدس الصالح (روح الموعد)” (أف 1: 13).
وكما أن راعي الخراف يستطيع أن يشفي الخروف الأجرب ويحميه من الذئاب، كذلك المسيح الراعى الحقيقي فإنه لما أتى استطاع هو وحده أن يغيّر ويشفي الخروف الضال الأجرب، أي الإنسان من جرب الخطية وبرصها، لأن الكهنة واللاويين ومعلمي الناموس السابقين كانوا غير قادرين أن يشفوا النفس بواسطة تقديم القرابين والذبائح ورش دماء الحيوانات، بل لم يستطيعوا بواسطتها أن يشفوا حتى نفوسهم. فإنهم كانوا محاطين بالضعف. وكما هو مكتوب “لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا” (عب 10: 4).
الطبيب الحقيقي والراعي الصالح:
ولكن الرب يقول مُظهرًا ضعف وعقم أطباء ذلك العهد فقال لهم “على كل حال تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشفِ نفسك” (لو 4: 23)، فكأنه يقول لهم- أنا لست مثل هؤلاء الأطباء الذين لا يستطيعون أن يُشفوا نفوسهم.
بل “أنا هو الطبيب الحقيقي والراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف” (يو 10: 11)، وأنا أقدر أن أشفي “كل مرض وكل ضعف في النفس” (مت 4: 23). أنا هو الحمل الذي بلا عيب، الذي قُدم مرة، وأنا أستطيع أن أشفي أولئك الذين يأتون إليَّ، إن شفاء النفس الحقيقي إنما هو من الرب وحده كما قال يوحنا المعمدان “هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم” (يو 1: 29)، أي خطية الشخص الذي يؤمن به ويضع رجاءه فيه ويحبه من كل قلبه.
فالراعي الصالح إذن، يشفي الخروف الأجرب. وأما الخروف فلا يستطيع أن يشفي خروفًا مثله. والإنسان- أي الخروف العاقل- إن لم يحصل على الشفاء، فلا يكون له دخول إلى كنيسة الرب السماويّة. وهذا ما قد قيل حتى في الناموس كظل ومثال (لعهد النعمة) بخصوص الأبرص، والرجل الذي فيه عيب. وبهذا المعنى يتكلم الروح رمزيًا أن كل أبرص وكل رجل فيه عيب لا يدخل في جماعة الرب (لا 21: 17-23، عد 5: 2).
ولكنه أمر الأبرص أن يذهب إلى الكاهن، ويطلب إليه بإلحاح كثير أن يأخذه إلى الخيمة، وأن يضع يديه على البرص، موضحًا البقعة المُصابة بالمرض، وأن يشفيه.
الشفاء من الخطية ودخول الكنيسة السماويّة:
وهكذا بنفس الطريقة فإن المسيح “رئيس الكهنة الحقيقي للخيرات العتيدة” (عب 9: 11) تواضع وانحنى على النفوس المصابة ببرص الخطية وهو يدخل إلى خيمة جسدها ويشفيها ويبرءها من أمراضها. وهكذا بهذه الطريقة يتمكن الشخص من الدخول إلى كنيسة القديسين السماويّة أي إسرائيل الحقيقي.
فإن كل نفس مصابة ببرص خطية الشهوات، ولم تأتِ إلى رئيس الكهنة الحقيقي، ولم تشفِ الآن في خيمة القديسين ومجمعهم، فإنها لا تستطيع أن تدخل إلى الكنيسة السماويّة. لأن تلك الكنيسة إذ هي طاهرة وبلا عيب فإنها تطلب النفوس الطاهرة والتي بلا عيب. كما يقول الكتاب “طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله” (مت 5: 9).
فينبغي على الشخص الذي يؤمن بالمسيح حقيقة، أن يتغيّر من حالته الفاسدة الحاضرة إلى حالة جديدة، حالة الصلاح، ويتحوّل من طبيعته الوضيعة الحاضرة إلى طبيعة أخرى، أي طبيعة القداسة الإلهيّة، ويتجدد بقوة الروح القدس. وهكذا يكون لائقًا للملكوت السماوي. ويمكننا الحصول على هذه الأشياء إن كنا نؤمن به ونحبه بالحق ونحيا سالكين بحسب جميع وصاياه.
فإن كان الخشب- وهو من طبيعة خفيفة عندما أُلقي في الماء في زمن أليشع قد أخرج الحديد الثقيل، فكم بالحري جدًا عندما يرسل الرب نوره اللطيف الصالح، وروحه السماوي، فإنه بهذا يُخرج النفس التي غرقت في مياه الشر ويجعلها خفيفة ويعطيها جناحين لتطير إلى أعالي السماء، ويحوّلها ويغيّرها عن طبيعتها الخاصة.
وفي العالم المنظور لا يستطيع أحد أن يعبر البحر بنفسه دون أن تكون له سفينة خفيفة مصنوعة من الخشب، وهي التي تستطيع أن تسير على المياه- فإن أي إنسان يحاول أن يمشي على البحر بقدميه فإنه يغرق ويهلك.
وبنفس الطريقة لا تستطيع أي نفس أن تعبر بذاتها بحر الخطية المُرّ والهاوية الخطرة، هاوية قوات الظلمة وأهواء الشر، إن لم تحصل على روح المسيح الخفيف السماوي الذي يعلو ويسير فوق كل شر ويعبر عليه، فبواسطة هذا الروح يستطيع الإنسان أن يصل بطريق مباشر ومستقيم إلى ميناء الراحة السماويّة، إلى مدينة الملكوت.
وكما أن أولئك الذين يكونون في السفينة لا يأخذون مياهًا للشرب من البحر، ولا يحصلون منه على ملابس، وطعام لهم، بل يُحضرون كل هذه الأشياء معهم إلى السفينة، هكذا فإن نفوس المسيحيين لا تستمد طعامها من هذا العالم بل من فوق، من السماء. إذ تنال قوتًا سماويًا ولباسًا روحيًا وهكذا إذ ينالون الحياة من فوق وهم في سفينة الروح الصالح، معطي الحياة، فإنهم يرتفعون فوق قوات الشر المعادية أي الرياسات والسلاطين.
وكما أن جميع السفن تُبنى من مادة واحدة، هي مادة الخشب التي بواسطتها يستطيع الناس أن يعبروا البحر، هكذا فمن النور الإلهي السماوي الواحد يحصل المسيحيون على القوة التي بها يرتفعون فوق كل الشرور.
المسيح قائد النفس ومعينها:
ولكن كما أن السفينة تحتاج إلى ربان، وإلى ريح حسنة معتدلة أيضًا لكي تمخر البحر بنجاح، هكذا فإن الرب نفسه يسد كل هذه الاحتياجات للنفس الأمينة. ويحملها فوق العواصف العميقة وأمواج الشر المفترسة وقوات رياح الخطية العاتية.
وهو يفعل هذا باقتدار ومهارة وحكمة إذ يعرف كيف يُهديء العواصف. لأنه بدون المسيح القائد السماوي لا يستطيع أحد أن يعبر البحر الشرير، بحر قوات الظلمة وأمواج التجارب المرة. كما هو مكتوب “يصعدون إلى السموات ويهبطون إلى الأعماق” (مز 107: 26). ولكن المسيح له معرفة كاملة كقائد سواء من جهة الحروب أو التجارب. وهو يعبر بالنفس فوق الأمواج الشديدة، كما هو مكتوب “لأنه فيما قد تألم يقدر أن يعين المجربين” (عب 2: 18).
صلاح الرب وقدرته على التغيير:
لذلك ينبغي أن تتغير نفوسنا وتتحوّل من حالتها الحاضرة إلى حالة أخرى- إلى حالة قداسة إلهيّة وتصير خليقة جديدة بدلاً من العتيقة أي تصير صالحة شفوقة وأمينة بدلاً من كونها في المرارة وعدم الإيمان. وهكذا إذ تصير مناسبة ولائقة فإنها تعود وتسكن في الملكوت السماوي. لأن بولس المغبوط يكتب هكذا عن تغييره الذي به أدركه المسيح قائلاً: “ولكنى أسعى لكي أدرك الذي لأجله أدركني أيضًا المسيح يسوع” (في 3: 12).
فكيف أدركه الله إذن؟ إن ذلك يحدث مثلاً حينما يمسك طاغية بمجموعة من الأسرى ويسوقهم قدامه ثم بعد ذلك يدركهم الملك الحقيقي ويخلّصهم منه، وهكذا حينما كان بولس تحت سيادة وتأثير روح الخطية الظالم، فإنه كان يضطهد الكنيسة ويتلفها. ولكن لأنه كان يفعل هذا عن غيرة لله ولكن بجهل، فإنه كان يظن أنه يجاهد لأجل الحق، ولهذا فإن الله لم يهمله بل أدركه، إذ أضاء حوله الملك السماوي الحقيقي بصورة تفوق الوصف وأنعم عليه بأن يسمع صوته، ولطمه كعبد[1] وأطلقه حرًا.
فانظر إلى صلاح السيد وقدرته على التغيير، وكيف يستطيع أن يغير النفوس التي كانت مُغلّفة ومقيدة بالخطية والتي تحولت إلى حالة متوحشة وفي لحظة من الزمان يحوّلها إلى صلاحه وسلامه.
تغيير وتجديد نفوسنا هو الغرض من مجيء المسيح في الجسد:
إن كل شيء مستطاع لدى الله! كما حدث في حالة اللص على الصليب. ففي لحظة تغيّر بالإيمان وتحوّل وأُعطي أن يدخل إلى الفردوس. وأن الغرض والهدف من مجيء الرب إلينا في الجسد، هو أن يغيّر نفوسنا ويخلقها خلقة جديدة، ويجعلنا “شركاء الطبيعة الإلهيّة” كما هو مكتوب (2 بط 1: 4) وأن يعطي لأرواحنا روحًا سماويّة، أي الروح الإلهي، قائدًا إيانا إلى كل فضيلة لنستطيع أن نحيا الحياة الأبديّة.
نوال تقديس الروح:
لذلك فلنؤمن بكل قلوبنا بمواعيده الفائقة الوصف لأن “الذي وعد هو أمين” (عب 10: 23). لذلك، ينبغي أن نحب الرب ونجتهد أن نحيا في كل فضلية ونطلب بلا انقطاع ونصلي باستمرار لكي ننال موعد روحه تمامًا وبصورة كاملة، لكيما تدخل نفوسنا إلى الحياة وتوجد فيها ونحن لا نزال في الجسد.
لأنه إن لم ينل الإنسان وهو في هذا العالم، تقديس الروح بكثرة الإيمان والصلاة، ويصير “مشتركًا” في الطبيعة الإلهيّة، ويتشرّب النعمة، التي بها يستطيع أن يتمم كل وصية بنقاوة وبلا لوم فإنه لا يكون مُعدًا ولائقًا لملكوت السموات. لأن كل صلاح يحصل عليه الإنسان هنا في هذا العالم هو نفسه سيكون له حياة يحيا بها، في ذلك اليوم بنعمة الآب والابن والروح القدس إلى الأبد آمين.
[1] لعل في هذا إشارة إلى العادة التي كانت عند اليهود إذ كانوا يضربون العبد على وجهه كعلامة على إعطائه الحريّة.
