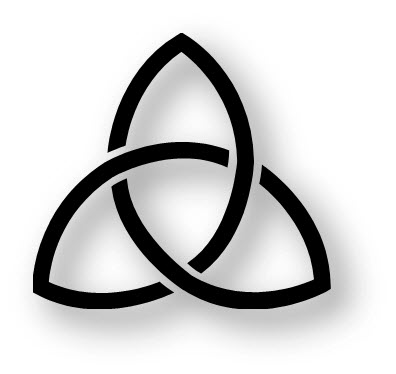أحجية الألم!! – مشكلة الشر

أحجية الألم!! – مشكلة الشر
يا قرص شمس ما لهش قبة سما
يا زرع من غير أرض شب ونما
يا أي معنى جميل سمعنا عليه
الخلق ليه عايشين حياة مؤلمة!
(صلاح جاهين)
الألم لغز. الألم لغز لا يملك أحد حله. ولا يتجاسر أحد ويدعي أنه يملك الإجابة لمسألة الألم.
ولكن، يظل الإنسان يكافح ويكافح محاولاً الفهم وساعياً لإيجاد إجابة لسؤال “لماذا الألم؟” فالألم قاس جداً، يعذب الإنسان طوال حياته، بل ربما لا توجد لغة منطوقة كافية للتعبير عن فظاعة الألم. فكثير من الآلام النفسية، والتي لا ترى، تعذب وتمزق صاحبها أكثر جداً من آلامه المرئية التي تعذبه بالفعل. ووجودي في علاقات مشورية لأكثر من عشرين عاماً، علاوة على حياتي الشخصية، كان كفيلاً بجعلي ألمس مقدار بشاعة وجود الألم. لعل كل منا قادر أن يعطي من حياته براهين كافية لذلك.
ولكن، ورغم كل ذلك، يستمر الألم موجوداً في الحياة، ويستمر الله يسمح به بطريقة قد تجعله يبدو، أي الله، وكأنه منسحب من المشهد الإنساني، غير مبال وتارك الإنسان يتألم بمفرده.
وبالتأكيد لن أزعم أني سأستطيع هنا، من خلال مجرد عرض الأفكار الواردة في هذا الكتاب، أن أعطي المتألم التفسير والتبرير الكافي لوجود الألم، ولا ربما التعزية الشخصية له وسط الألم. إلا أنه، ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أحاول وأحاول جاهداً أن أشرح كل ما أستطيع أن أشرحه في هذه القضية الصعبة المعقدة؛ “الألم” وبالأخص في كيفية تناولنا له، لعل الفهم يعطي البعض نوراً مُلطفاً.
أول كل شيء، لا بد أن أقول إن الألم جزء لا يتجزأ من الحياة.
لا بد وأن نتأكد من أن الإنسان بعد السقوط – حتى وإن كان مؤمناً – لا يستطيع تلافي أو حذف الألم تماماً من الحياة، إذ أن الألم صار جزءًا لا يتجزأ من نسيج الحياة بسبب الفساد والتلوث العامل في هذه الحياة بعد السقوط. إن اشتراك البشر جميعاً في السقوط جعلهم أيضاً مشتركين جميعاً في الألم، كأحد نتائج هذا السقوط، وهذا ما يسمى بـ “الوضع التضامني human solidarity” للبشر، وهي أن المعاناة والألم لم يدخلوا إلى حياتنا البشرية إلا بعد وبسبب السقوط (تك 3: 16، 17)، ومن ثم صارت المعاناة أمراً مستديماً على ظهر هذا الكوكب فيما بعد «فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً إلى الآن.» (رو 8: 22).
هذا الوضع التضامني وشمول الشر في الحياة البشرية جعل الله يفشل، للأسف (أسفه هو قبل أن يكون أسفنا نحن)، في التواجد مع الإنسان في محنته كما يرغب ويتمنى، ذلك لاستحالة توافق الله كلي القداسة مع الشر، بل أن هذا الوضع التضامني أيضاً جعل الله أحياناً كثيرة يحجب وجهه عن خليقته، لمحبته لهم، حتى لا يفنيهم مرة أخرى بغضبه، كما فعل في الطوفان وتعهد بعد تكرار ذلك! وفي هذا الحجب نفسه مزيد من الألم!
قد يفسر لنا هذا فكرياً، بعض الشيء، كيف أن الله الكلي المحبة والصلاح يترك الإنسان، صنيعته الذي يحبه، يتألم رغم أنه كلي القدرة أيضاً، فهو لا يستطيع أن يناقض قداسته ويعيش مع شمول الشر في الإنسانية الساقطة. وربما كان لنا بالأولى أن نقول إن الله نفسه يتألم جداً لهذا الوضع المؤقت الذي وضع الإنسان نفسه والله فيه. ومع ذلك، أعرف أن التفسير الفكري قد لا يكفي، للأسف، لتقديم الراحة والسلوى للفرد المتألم، إلا أنه كان من الهام جداً توضيح هذه النقاط الفكرية اللاهوتية في مستهل حديثنا عن الألم.
ولكن لماذا كان “السقوط” الذي جلب إلينا هذا كله؟! ما كان السقوط لسبب إلا لوجود ما يسمى بـ “الإرادة الحرة” لدى الإنسان! فأن يمنع الله سقوط شخص ما في خطأ ما، لكي ما يمنع الشر والألم، هذا معناه بالضبط أن يمنع الله هذا الشخص من أن يكون حراً ليمارس حرية إرادته، أو بكلمات أخرى أن يتنكر الله لنفسه ولما خلق الإنسان عليه من كينونة حرة مستقلة.
ولكن لماذا خلق الله الإنسان حراً وهو يعرف – لكونه كلي المعرفة – إلى ماذا ستقود حرية هذا الإنسان؟! هذا بالتأكيد تمييز وتكريم الله للإنسان، تاج خليقته، فأي كرامة وأي قيمة لكائن لا يملك الاختيار بأن يحب أو أن يرفض أن يحب؟! وأي إله ذاك الذي يريد ويستمتع بعلاقة مع كائن لم يختر بإرادته الحرة أن يحبه؟!
إذن، بعد السقوط، لا يستطيع أي منا أن يتجنب الألم في الحياة. بالتأكيد يتمكن الفرد من تجنب الألم الناتج عن اختياراته الشخصية الخاصة الخاطئة؛ مثل أن يعتني شخص بأسنانه ولا يهملها وهذا يتجنب معاناة ألم إصابتها بالتسوس فيما بعد. ولكن هذا لا يلغي وجود تيار المعاناة العامة، المستمرة بعد السقوط، في خلفية حياة أي إنسان.
وعلى أي حال، إن تمكن شخص ما جزئياً ووقتياً من الهروب من تيار الألم الإنساني، فقد يكتشف أن ذلك لم يكن في صالحه، وخير دليل على ذلك هو وقوع الإنسان في إدمان الخمر أو المخدرات أو العقاقير أو الجنس أو الأكل بينما يحاول أن يتفادى الألم.
إذن يقول الكتاب للإنسان:
«بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك.» (تك 3: 17). لاحظت تعبير «كل أيام حياتك»، بلا استثناء، وليس بعض الأيام.
«فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض… وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن….» (رو 8: 22-23).
أي أن الإنسان المؤمن لا بد وأنه هو أيضاً يعاني من الألم في الحياة وبالأكثر بسبب مسيحيته التي تتسم بالتهذيب والانضباط. وعن هذا الألم يقول كاتب العبرانيين «صار الجميع شركاء فيه» (عب 12: 8). وبالطبع فإن لفظة “الجميع” هنا ليست صيغة مبالغة تفيد الأغلبية، ولكنها تعني حرفياً “الجميع” بلا استثناء.
يقول القديس توما الكمبيسي، في كتابه التراثي الشهير الملقب بـ “الإنجيل الخامس”: «إنه يستحيل على الإنسان أن يعيش بلا محنة – لا بشر بلا محنة أو شدة.» (الاقتداء بالمسيح 1: 21، 22).
«أما أن لا يشعر الإنسان باضطراب في قلبه، أو أن لا يتألم من ضيق في جسمه أو في روحه، فهذا ليس من خواص هذا الزمن، بل من خواص النعيم الأبدي.» (الاقتداء بالمسيح 3: 25).
ما الذي نخلص إليه هنا؟ ما نخلص إليه هو أنه لا يوجد إنسان واحد معفي من الألم، ولا حتى الإنسان المؤمن!
«نحن أيضاً بشرٌ تحت آلام مثلكم.» (أع 14: 15).
فبولس قد ذكر هذا التعبير القوي ليؤكد لأهل لسترة أنه وبرنابا هما بشر وليسا آلهة كما اعتقد أهل المدينة. أي أنه يقول إن القاسم المشترك بين كل البشر والذي يميزهم عن الآلهة هو أن البشر يتألمون ويعانون!
للأسف، قد أعطانا التعليم “المسيحي” الشعبي، السطحي غير المنهجي والهوائي وغير الصحيح، أعطانا فكرة خاطئة عن أن الإنسان يتوقف عن المعاناة حالما يقبل المسيح، وأن الإنسان المؤمن معفي من الألم، وكأن الإيمان يعفي الشخص من الألم! وذلك عن طريق لي بعض الأجزاء الكتابية وتسطيحها وإساءة تفسيرها كيما تتناسب مع هذه الفكرة الخاطئة. تلك الفكرة التي ليست فقط غير صحيحة لاهوتياً وإنما هي أيضاً غير صحيحة علمياً بكل تأكيد.
فإن أمور شديدة الإيلام مثل فقد الحب وضياع القيمة والمعنى، تلك الأمور التي شكلت طبيعة الحياة بعد السقوط، قد يتعرض لها البعض بدرجات عنيفة وزائدة بسبب تنشئتهم المبكرة إلى درجة أنهم قد يظلوا يعانون طوال حياتهم من إعاقات نفسية مؤلمة جراء ذلك، أمور مثل هذه لا تختف عملياً من عالمنا الداخلي بصورة تامة وكاملة لحظة التجديد! بل أكثر من هذا أيضاً، فإن الطبيعة التي صار عليها الإنسان بعد السقوط حتمت عليه أن يكون طريق عودته للسماء متسماً بالألم. «.. وإنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله» (أع 14: 22).
وعند هذه النقطة يجدر بنا أن نستمع إلى الاقتباسين التاليين، أما الأول فللفيلسوف اللاهوتي “الليبرالي” بول تيلك إذ يقول في تعليقه على قول المسيح «تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم»: «إن يسوع لا يقول لنا أنه سوف يخفف الأعمال وأحمال الحياة والجهد.
سواء جئنا إليه أم لم نجيء لن تتناقص تهديدات المرض أو البطالة، وثقل عملنا لن يصبح أسهل، ولن تتوقف أشكال الرعب والدمار والجروح والموت الذي ينزل من السماء؛ ولن يتم قهر الأسى لرحيل الأصدقاء أو الآباء أو الأطفال. ويسوع لا يستطيع أن يعد ولا يعد بمزيد من اللذة وبتقليل الألم لأولئك الذين يطلب منهم أن يجيئوا. بل بالعكس، أحياناُ ما يعدهم بمزيد من الألم ومزيد من الاضطهاد ومزيد من التهديد بالموت – أي (الصلب) كما يسمي الأمر.
كل هذا ليس هو الحمل الذي يشير إليه.»[1] فالحمل هنا الذي يشير إليه المسيح في قوله، لم يكن واحدة مما شرحه وفسره بول تيلك ولكنه يشير إلى حمل الخطية والدينونة الأبدية.
أما الاقتباس الثاني فهو للمفسر الكتابي مايكل وليكوك، في تفسيره لإنجيل لوقا أصحاح 8 والأعداد من 22-56، إذ يقول:
«إنه لخطأ فادح أن نتصور أن الحياة المسيحية تحررنا من الضيق فحين يقول يسوع “إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً”، فإنه بكل تأكيد لا يعدنا بأن نستثنى من المواقف المؤلمة المعتادة في الحياة. إن من يتصور أنه منذ قبول المسيح فصاعداً، فإن الضيق لن يواجهه، فهذه هي بداية الكارثة لأن الضيق لا بد أن يأتي، وحين يأتي فإننا سنقاد إلى الشك أو اليأس. كلا، إن يسوع لا يعدنا بحياة خالية من الضيق، فالواقع ليس هو أن الضيق قد يأتي، أو حتى أنه سوف يأتي، بل أنه لا بد أن يأتي.»[2]
فمن الواضح بالطبع أن المسيح إنما يبشر من يتبعونه بباب ضيق وطريق كرب “مملوء بالضغوط” (متى 7: 14). وهذا هو الواقع الذي يجب أن نقبله إن كنا لا نريد أن نحيا في الوهم.
إلا أن طبيعة الإنسان الساقطة للأسف وفي أغلب الأحيان لا تسول له أن يتحمل الألم، وخصيصاً الألم النفسي والمعنوي الذي كثيراً ما يكون أصعب وأقسى من الألم الجسدي. فالإنسان قد يفعل أي شيء من أجل تخفيف آلامه والعمل على تجنبها، حتى وإن كان ذلك ضد خلاصه الأبدي.
فسؤالنا الآن هو: ما هي الطرق التي يسلكها الإنسان لكي يخفف من آلامه النفسية؟
الهروب
ماذا يفعل الإنسان أول شيء حين يتألم؟ ماذا يفعل مثلاً حينما يشعر بالرفض أو بأنه غير محبوب أو غير مرغوب، ماذا يفعل حينما يشعر بالضيق وبأنه بلا قيمة أو أن حياته عديمة المعنى؟ هل يذهب الإنسان إلى خالقه طالباً العون؟ الواقع يقول لا.
يقول الأخصائي النفسي د. بيير داكو:
«إن الجنس والطعام شكلان من أشكال الإشباع الجسدي، فمتى تحققت احتياجاتنا نشعر بالامتلاء. ومن ناحية أخرى، متى افتقرت حياتنا إلى الحب والحنان – أو متى شعرنا أننا غير مرغوبين – فقد نتحول إلى الطعام أو الجنس كمشبع بديل.»
من الواضح أن هناك دافع فطري – كما أشار فرويد – يجعل الإنسان يعمل على تحاشي الألم عن طريق إغراقه في اللذة. بل أن فرويد يبالغ ويقول بأن الدافع والمقود الوحيد الذي يحرك الإنسان هو اللذة. قد لا نتفق معه في هذه المبالغة إلا أنه من الواضح ومن الحقيقي أن الإنسان الطبيعي عادة ما يلجأ إلى أنواع من اللذة والمتع ليُسكن (وليس يعالج) ويخدر بها آلامه النفسية ويغطي بها فقره وفراغه الداخلي (تماماً كما هو الحال مع تعاطي المخدرات).
وهذا ما يسمى “بالهروب إلى اللذة” أو “إرضاء أو إبهاج وتهنين النفس Self-gratification”، وهو أشهر أسلوب يلجأ إليه الإنسان للتعامل مع ألمه الداخلي، حيث يبتكر الإنسان أي شيء يشغل أو يلهي distract – حسب تعبير الفيلسوف الفرنسي باسكال – به نفسه، أي يحول به انتباهه أو إحساسه عن أن يشعر بألمه الداخلي أو أن يتلامس ويتواجه معه. فيصير الإنسان مخدراً من جهة إحساسه أو إدراكه للأمور المؤلمة أو القضايا الفكرية غير المحلولة التي تؤرقه والتي لا تقل إيلاماً (تماماً كإلهاء الطفل عن شيء ما بلعبة براقة ملونة ذات أصوات جذابة، تأخذ حواسه).
فيقول الفيلسوف الفرنسي باسكال في خواطره الشهيرة Pensees: «إن حياة الإلهاء والانشغال Distraction هي الشيء الوحيد الذي يعزينا عن الإحساس الناتج عن مواجهة نفوسنا ورؤية حقيقتها وشعورها بالتعاسة.» فاللذة والانشغال أو الإلهاء في الواقع هما شيء واحد من جهة هذا الأمر.
يقول جان كريستوف أرنولد، وهو راهب كاثوليكي معاصر، في كتابه (البحث عن السلام) نقلاً عن إحدى الصديقات: «عندما لا يكون الإنسان في سلام مع نفسه، يجد صعوبة في التعامل مع المساحات الفارغة، إما بصرياً (لا شيء تقرأه أو تراقبه)، أو سمعياً (لا شيء تنصت أو تستمع إليه) أو جسمياً (لا شيء تقوم به). إنك تحاول إشغال نفسك عن المشاكل الداخلية – الألم، والأفكار المتصارعة، والخوف والاتهامات، وما شابه ذلك – ولكن دون جدوى، فإنك تشعر بانفعال (إثارة) أكثر».[3]
أيضاً يقول الكاتب المسيحي الراحل الأب هنري نووين، في كتابه “هل تقدر أن تشرب الكأس؟”: «ولكننا بالتحديد في الصمت نأتي إلى المواجهة مع ذواتنا الحقيقية. إن أوجاع حياتنا عادة ما تغلبنا للدرجة التي تجعلنا نفعل أي شيء حتى لا نتواجه معها. إن الراديو والتليفزيون والصحف والكتب والأفلام وحتى العمل الشاق والحياة الاجتماعية المشغولة، كلها من الممكن أن تكون طرق نهرب بها من ذواتنا ونحول بها الحياة إلى أوقات ممتدة من التسلية والترفيه في قضاء الوقت.»[4]
وهكذا ترينا الاقتباسات السابقة كيف يبتكر الإنسان وسائل تسكين للألم عن طريق إلهاء النفس والانشغال أو الإغراق في المتع، التي أشهرها الجنس والطعام كما قال بيير داكو، كيما تساعده على تجنب مواجهة هذا الألم بل والهروب منه.
وفي الاقتباس التالي نرى ثاني أشهر وسيلة هروبية يتعامل بها الإنسان مع الألم، حيث يشرح ذلك التفسير التطبيقي في تعليقه على (فيليبي 4: 12، 13):
«إن اشتهاء امتلاك المزيد أو الأحسن، هو في الحقيقة اشتياق إلى ملء فراغ في حياة الإنسان. فإلى من تذهب عندما تحس بفراغ داخلك؟ كيف تجد الشبع الحقيقي؟»
وهذه الوسيلة هي “امتلاك الأشياء”. وهذه الطرق هي ما نسميها بطرق الهروب من مواجهة واقعية الألم في الحياة.
والآن ترى ما هي طريقة وأسلوب كل منا في الهروب من الألم؟ ما هو نوع اللذة أو الإلهاء الذي قد نبتكره لكي نخدر آلامنا؟ اعتدت أن أسأل الحضور، حين أقدم هذا التعليم، هذا السؤال. ووجدت:
الأكل، والجنس، والنوم، واللهو والسمر، والعلاقات، والشراء، واقتناء الأشياء، والمشي، وأحلام اليقظة، وتغيير تصفيفة الشعر، ومشاهدة التلفزيون والسينما (وبالطبع الآن الكمبيوتر والإنترنت)، والمكالمات التليفونية (وارتياد غرف الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت)، وتغيير نظام أثاث المنزل، والأنشطة المسيحية، والمخدرات، والعمل، والاستحمام، والسفر، وحتى الترانيم المعزية والانتعاشية، وجدت خلال خدمتي في المشورة هذه كلها وغيرها من نماذج شائعة لطرق يستخدمها البشر كمسكنات للألم، حيث تلعب هنا دوراً ملهياً ومشتتاً للإنسان تماماً كالخمور والمخدرات فتُفقد الفرد يقظته وتلامسه مع الواقع مما يجعل إحساسه بالألم يغيب عنه ولن جزئياً.
ولربما نحن هنا بفقدان الألم، مؤقتاً، نفقد الشيء الذي من شأنه أن يخبرنا بفقرنا واحتياجنا إلى الله. فمن الطريف أن نجد الرسول بولس حين يناشد أهل تسالونيكي بأن يظلوا صاحين “ساهرين روحياً” يستخدم الكلمة التي تصف الشخص غير الثمل (غير السكران) Sober ويستخدم تشبيه السكر ليصف الحالة التي قد يُغيب الإنسان فيها يقظته سعياً وراء راحة أو تمتع وقتي؛ فيقول: «بل لنسهر ونصح Sober. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وأما نحن الذين من نهار فلنصح» (1تس 5: 6-8).
فهل كان بولس يتحدث هنا عن تعاطي الخمور والمخدرات؟ كلا، بل إنه يتحدث عن كل ما يستخدمه الإنسان لتغييب يقظته وتعامله مع واقع الحياة ولو كانت الترانيم الانتعاشية والخدمة الكنسية وهو يعلم أن الإنسان يمكنه أن يحصل على الإحساس بالثمالة والإلهاء والتغييب بغير الخمر والمخدرات، إنه يتحدث عن هروب الإنسان من واقعية الألم والعناء في الحياة.
ومن الشائق جداً أيضاً أن نجد المسيح يساوي الشراهة في الأكل بالسُكر في قوله في (لو 21: 34): «احترسوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسُكر وهموم الحياة.» حيث أن الخمار هو تخمة الأكل، والانغماس في الملذات.
ونستأنف الحديث عن الهروب لنقول؛ حيث أن البشر مختلفون فإنه لمن الطبيعي أن نجد طرقاً ووسائل عديدة ومتنوعة يبتكرها البشر للهروب من مواجهة آلامهم، أي إن كانت هذه الوسائل طالما أنها تصنع مفعولها. فالإنسان قد يستخدم، أو بمعنى أصح يسيء استخدام abuse، أي شيء بطريقة تعطيه هو لذة خاصة (حتى لو كان هذا الشيء صحيح في حد ذاته، كالعمل أو الخدمة الكنسية) ذلك أن ما يعطي الشي صحته أو خطأه هو الدافع الذي يقع وراء القيام بالفعل قبل الفعل ذاته.
ويوماً فيوم يعتاد الإنسان هذه الوسيلة (خاصة وإن كانت مشروعة) وتزداد اعتماديته عليها أكثر فأكثر حتى تصير نمطاً واعتياداً إدمانياً. وهكذا يجد الإنسان نفسه وهو حبيس في فخ مطالبه واحتياجاته وأسلوب تناوله لمشاكله وآلامه، يجد أنه قد أصبح فريسة اعتياد وإدمان إرضاء وإسعاد وتهنين الذات ولا يستطيع الفرار من مصيدة الشهوة الإدمانية هذه، بينما يظل الألم الأساسي بداخل الإنسان والذي كان يهرب منه تماماً كما هو، فقط زاد عليه الوقوع في فخ الإدمان (وهذا تماماً ما يشرح سيكولوجية الإدمان).
لماذا نستخدم لفظة “شهوة” لوصف هذه المصيدة، أي لماذا نصفها على أنها خطية؟
ذلك لأن قاموس الكتاب المقدس يعرف الشهوة على أنها: «رغبة قوية لامتلاك أي شخص أو شيء لنغطي به الإحساس بالرفض.» وهنا تصبح طريقة معالجتنا هذه للألم (خطية) وأيضاً مصدراً آخر للألم في حد ذاتها!
وهكذا يثبت الهروب فشله في معالجة الألم بل أنه يزيد من الأمر سوءًا. فالإنسان في محاولته للبحث عن علاج لآلام الوحدة والرفض ونقص الحب وضياع المعنى والقيمة، وهي الآلام الأساسية التي يحاول أن يهرب منها الإنسان، نجده يقع في مشكلتين، أو بلغة الكتاب المقدس شرين (إر 2: 13):
1 – أنه يضل الطريق ولا يجد علاجاً حقيقياً (تركوني أنا الإله الحي)، حيث أن مجرد تحولنا عن الله في البحث عن حل لمتاعبنا هو مشكلة في حد ذاته، علاوة على أنه خطية.
2 – يورط نفسه في طرق فاشلة تقوده لمزيد من الجوع والألم «حفروا لأنفسهم آباراً مشققة لا تضبط ماء (أي لا تحتفظ بالماء، وبالتالي لا تعطي أبداً ارتواء)». وهذه الطرق، أي إن كانت، علاوة على أنها تقود لمزيد من الألم (ألم الإدمان)، فهي أيضاً خطية في نظر الله، إذ أنها تبعدنا عن الله وتحل محله في محاولة لملء الفراغ الداخلي للإنسان. إذاً أي محاولة للإشباع عن طريق الإلهاء وتهنين الذات هي خطية وتزيد الأمر تعقيداً.
أيضاً دعونا نستمع إلى الاختبار التالي من أحد الشابات التي حضرت مؤتمر المشورة بمصر عام 1999 والذي تعطينا فيه الدليل الحي المعاصر لما نتحدث عنه هنا، إذ تقول:
«كنت دائماً أبحث عن الحب عند الناس مما عرضني للأذى في معظم أوقات حياتي. وقد كنت دائماً أخزى إذ لا أجد أبداً شبعاً لدى الناس. كانت لي صداقات كثيرة أحاول من خلالها أن أملئ فراغي الداخلي، ولكن لم يحدث أبداً أن امتلئ الفراغ بل على العكس ازداد جداً بداخلي وازداد انعزالي وتقوقعي بداخل نفسي. وازدادت أيضاً الهوة بيني وبين الرب إذ اعتبرته أيضاً مسؤولاً عن دمار حياتي… وشعرت أنني وحدي في عالم مظلم لا أرى فيه أية معالم!»
وفي اختبار آخر معاصر منقول عن كتاب “الشره المرضي”[5]، تقول كاتبته:
«تنتابني الرغبة في ملء الفراغ والتخلص من التعاسة الذين أشعر بهما في داخلي. عادة أتجه نحو الطعام، لكن في بعض الأحيان أنفق الأموال بغير حساب لشراء أشياء بدون قيمة أو فائدة كمساحيق التجميل وغيرها. قد يبلغ ثمن المشتريات أكثر مما أملك من النقود، ولكني لا أبالي لأن ذلك يشعرني بالراحة النفسية لفترة.»
هناك أسلوب آخر يتخذه الإنسان للتعامل مع آلامه الداخلية، أو قل إنه شكل آخر مختلف للهروب، وهو:
الكبت والإنكار[6]
قد يكبت الإنسان أيضاً آلامه وينكرها، وقد يقوم الشخص المسيحي بذلك في روحنة خادعة، مدعياً أو مؤمناً بأنه كمؤمن لا يتألم ولا يتعذب من نقص الحب أو الشعور بالرفض أو بالفشل أو الذنب، ويعتقد بعدم وجود هذه الآلام لأن المسيح قد غطى كل مشاكله فيخبئها في أعماق عقله الباطن، سواء عن وعي أو عن غير وعي، لكن ذلك لا يلغي وجودها.
ماذا يفعل الكبت والإنكار إذن؟!
1 – يستنزف طاقة الإنسان النفسية التي يحتاجها للحياة – في محاولات التغلب والسيطرة على الضغط العصبي (النفسي) الناتج من قمع هذه الآلام والسيطرة عليها والحيلولة دون صعودها إلى مستوى الشعور، كما لو كان إنسان يمسك بكل قوته بزمام يقيد به ثور هائج.
2 – غالباً ما يحدث تداعيات وانفلات لبعض هذه الآلام من قبضة صاحبها، وذلك على هيئة تصرفات اندفاعية Impulsive (انفعالية هوجاء؛ أي انفعال غير مناسب مع موقف معين) أو أوجاع وأمراض جسمانية.
3 – إن زاد الضغط العصبي (النفسي) عن قدرة الشخص عن التحمل فهو يصل إلى نقطة الكسر أو الانفجار (كما قد يحدث في وعاء الضغط إن لم يكن هناك تنفيس لضغط البخار المتزايد بالداخل) وينهار الشخص نفسياً وعصبياً.
ولكن بعد أن تحدثنا عن هذه الأساليب الخاطئة الشائعة في التعامل مع الألم، نأتي إلى السؤال «هل هناك أسلوب آخر للتعامل مع الألم؟» وهو ما سيكون موضوع الفصل التالي من هذا الكتاب.
نقاط هامة
ª الدافع عادة هو ما يجعل ما يقوم به الإنسان صائباً أو خاطئاً بغض النظر عما يكون عليه شكله من الخارج إيجابياً كان أم سلبياً، بناءً أم هادماً. فالعمل الشاق مثلاً أمر ممدوح في الحياة لكن إن لجأ إليه الشخص كي لا يتجنب التواجد ببيته الذي يؤرقه أصبح شيئاً ضاراً وأصبح إلهاءً، حتى لو كان هذا الإلهاء له شكلاً روحياً مثل المؤتمرات والقوافل طوال الصيف. فعملية الهروب مهما كان شكلها الخارجي هي لا قيمة إيجابية على الإطلاق. لا بد للإنسان إذن أن يمتلك القدرة على تمييز دوافعه، والتي غالباً ما تكون خفية وشائكة وليس من السهل تمييزها، علاوة على أن الإنسان قادر على أن يخدع نفسه «قلب الإنسان أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه».
ª التحدي الدائم الموضوع أمام الإنسان هو أن يجد علاجاً حقيقياً لآلامه عوضاً عن تعاطي المسكنات. في كل الأحوال، لا بد له في النهاية من مواجهة حاسمة قد يصعب عليه القيام بها متى اعتاد الإلهاء والتسكين. فالتسكين يقود الإنسان إلى مزيد من فقدان القدرة الحقيقية على المواجهة والتخدير وفقدان الإحساس بالألم على السطح، مع انتشار السرطان في الداخل. كما أن استمرار المسكنات يقود للإدمان وفي النهاية يفقد الشخص حياته التي أضاعها في الإلهاء.
وعلى العكس، فالمواجهة الحقيقية مع الألم تكسب الإنسان موارد ذاتية قوية تمكنه بمعونة الله أن يتحمل، في الغد، الألم الذي لم يكن ليتحمله اليوم. نعم، القدرة على مواجهة الألم تتطلب قوة من الإنسان، وهو مسؤول أن يجد ويبني هذه القوة في نفسه. وهروب الإنسان وتسكينه المؤقت للألم هو إضعاف لموارده الذاتية وإمكانية اكتسابه لهذه القوة الذاتية. وما قاله العالم النفسي ألبرت ايللس يتفق مع الإيمان المسيحي في أن الإنسان دائماً عنده قدرة لتحمل الأشياء التي كان يظن أنه لا طاقة له بها.
الله بالطبع يعطي قوة للإنسان وهو، أي الإنسان، عليه دور يقوم به ليعطيه الله هذه القوة، والأمر محير جداً، لاهوتياً، نظراً للتساؤل أيهما أسبق؛ قوة الله أم دور الإنسان.
ª طبيعة الإنسان بعد السقوط فرضت الحتمية بأن العودة إلى الله تكون من خلال الألم – كما قال تيلك – كالصلب والموت الذي هو قمة الألم بالنسبة للإنسان. فالله لم يعدنا بحذف هذه الأمور من حياتنا بل وعدنا بطريق ضيق.
ª من الوارد أن يخسر الإنسان بعض الجولات في حياته بسبب قرارات واختيارات خاطئة قام بها، لكن الصراع الدموي الذي فيه الإنسان طوال حياته، سواء مع نفسه أو مع الله أو مع الحقيقة، أشبه بجولات الملاكمة، ففقدانه وخسارته لجولة ما ليست النهاية، فمازال هناك جولات أخرى، ورصيده يأتي من المحصلة النهائية لما يؤول عليه في نهاية المطاف. لذا فالفشل والتقصير، والهزيمة أمور لا تخيف لأنها ليست نهاية المطاف كما يقول الجامعة «لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت» (جا 9: 4). فالنهاية لم تُكتب بعد طالما أنت حي.
ª الإنسان ليس مسؤولاً عن طبيعته الفطرية، التي ولد بها، ولا عن ظروف تنشئته المبكرة بالطبع. لكنه مسؤول أن يطور من قدراته الطبيعية وأن يستخدم كل موارده وألا يكون مقصراً في ذلك. كل إنسان لديه طبيعة فطرية مختلفة وبالتالي معادلته الحياتية، أي معطيات الحياة التي يسمح له بها الله، تكون مختلفة. ولكنك كإنسان في النهاية تملك القدرة، حتى وإن لم تمارسها، على حل معادلتك وتناول الحياة التي أعطيت لك تناولاً إيجابياً.
هذا ما يقوله أدلر وعلم النفس وما تقوله المسيحية أيضاً؛ أن الإنسان لم يعط تجربة ليست في استطاعته “بشرية” (1كو 10: 13). فكل إنسان أعطي معادلة أو مسألة تتناسب مع طبيعته الفطرية وقدراته وموارده الداخلية والخارجية، وعليه أن يقوم بكل ما في وسعه لاستثمار وزناته – التي قد تكون واحدة أو اثنتين أو خمس – بكل طاقته.
[1] تيليش، بول. “زعزعة الأساسات”. ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت 1995.
[2] ويلكوك، مايكل، تفسير “الكتاب المقدس يتحدث اليوم – إنجيل لوقا”. ترجمة د. عزت عطية دار النشر الأسقفية، القاهرة 2002.
[3] أرنولد جان كريستوف. “البحث عن السلام”. مكتبة المنار، القاهرة 2001.
[4] Nouwen, Henri, “Can you drink the cup?”, Ave, Maria Press ,Inc 1996.
[5] فرنش، باربرا. “الشره المرضي”. ترجمة ماريا معاد. منشورات دار الأفق الجديدة. بيروت 1997.
[6] الكبت Repression هو آلية دفاعية لا شعورية يقوم فيها عقل الإنسان، بطريقة لا شعورية، بدفع الأحداث المؤلمة ومكوناتها العاطفية (المشاعر المصاحبة) تحت ستار العقل الباطن فلا يشعر بها الإنسان أو يتألم من جراءها. أما الإنكار Deniel فهو آلية دفاعية أخرى فيها يقوم العقل بحيلة تجعل الإنسان يرى هذه الأحداث على أنها غير حقيقية، أو على أنها لم تحدث، لتفادي ألم لا يستطيع الشخص تحمله.
أجحية الألم – مشكلة الشر
انجيل توما الأبوكريفي لماذا لا نثق به؟ – ترجمة مريم سليمان
هل أخطأ الكتاب المقدس في ذِكر موت راحيل أم يوسف؟! علماء الإسلام يُجيبون أحمد سبيع ويكشفون جهله!
عندما يحتكم الباحث إلى الشيطان – الجزء الأول – ترتيب التجربة على الجبل ردًا على أبي عمر الباحث
عندما يحتكم الباحث إلى الشيطان – الجزء الثاني – ترتيب التجربة على الجبل ردًا على أبي عمر الباحث