مشكلة الشر والألم في قصة أيوب – كيف نؤمن بإله المحبة في عالم الألم؟ – ميلفين تيينكر
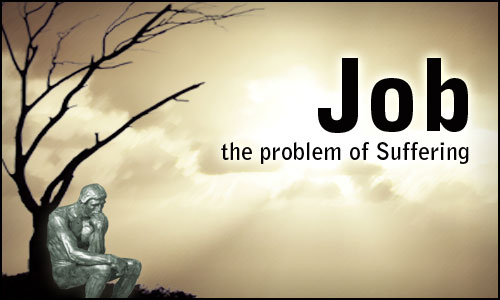
مشكلة الشر والألم في قصة أيوب – كيف نؤمن بإله المحبة في عالم الألم؟ – ميلفين تيينكر
ماذا يحدث؟
أيوب 1-3
في كتابه الذي يتغلغل عبر الكتاب المقدس، والمفيد رعوياً، [1]How Long o Lord?، يروي دي إيه كارسون القصة الحقيقية لمؤمنة اشتركت في عمل مسيحي شديد الصعوبة في أمريكا اللاتينية. وكانت هذه المرأة مملوءة بالحب للرب يسوع، وتدفعها غيرة شديدة نحوه. وفي عودتها إلى وطنها في الولايات المتحدة، كان مستقبلها يبدو مبشراً للغاية. وإذ تزوجت بأحد خريجي معهد الكتاب المقدس، وهو رجل عرفته على مدى عدة سنين، شرعت في العودة إلى حقل الإرسالية معه.
ولكنها بعد أن تزوجت منه بعدة ساعات، بدأت تساورها الشكوك في أنها قد تزوجت في الحقيقة من وحش. فقد ظهر سريعاً أنه شخص عنيف يفتقر إلى الشعور بالأمان، وبينما كان علنياً يتمتع بغطاء من الاحترام الديني، فإنه في البيت لم يكن يستطيع الحياة إلى مع نفسه بأن يقلل من أي شيء تقوله زوجته أو تفعله. وقد بدأ ذلك في أكثر أشكال الإرهاب نفسي خبثاً، ثم تطور بعد ذلك إلى وحشية جسدية، وقد عرف مجلس إدارة الإرسالية هذه الأمر سريعاً ورفض أن يرسلهما.
وبمرور السنين ساء الوضع أكثر، وحاولت المرأة التحدث مع أصدقاء ومشيرين، والذي جاء بعضهم ببساطة إلى جانب الزوج، وأخبروها أن تحاول أكثر. وفي النهاية اتجهت المرأة إلى الخمور، وبعد عامين أصبحت مدمنة للكحول، ووجدت نفسها تتعامل بوحشية مع طفليها، فكرت نفسها وكرهت زوجها وكرهت الله نفسه. وكانت صرختها «لماذا يا رب؟» فهي لم تفعل شيئاً لتستحق ذلك. كانت تعلم أنها غير كاملة، ولكنها كانت مسيحية مكرسة للرب. فماذا كان يمكن أن يكون السبب في إلقائها في هذا الجحيم الحي؟ إن هذا الأمر غير منطقي.
لا بد أن نعترف أن مثل هذا الألم ليس منطقياً. فيمكننا أن نرى ارتباطاً بين أشكال معينة من السلوك وبين الألم الذي ينتج عنها، مثلاً، العلاقة بين النجاسة الجنسية والأمراض التناسلية. لكن ما الرابطة الممكن تواجدها من ناحية الاستحقاق مثلاً، لتعليل الأعمال الوحشية المروعة التي وقعت على القوميات في حروب مختلفة؟ فعندما نتأمل في محرقة الهولوكوست بكل شرها البشع، هل يمكننا بأمانة أن نصدق أن كل هؤلاء الأطفال الذين عذبهم النازيون لم يكونوا حقيقة “متألمين أبرياء”؟ أو ما حدث للأرمن على يد الأتراك، ألم يكن هناك كثير من الأبرياء المتألمين والمصابين والضحايا.
هناك سفر واحد في الكتاب المقدس، الذي ربما أكثر من غيره يصارع مع مشكلة آلام البريء، وهذا السفر هو سفر أيوب. فعلى هذه الصفحات يثير الكاتب بصدق ملحوظ السؤال المحير الذي يتردد على ألسنة الكثيرين: لماذا يتألم الأتقياء؟
فلنكن مكان أيوب
إذا كنا نريد أن نسمح للناتج العاطفي الكامل لهذه القصيدة أن يؤثر فينا، فيجب أن نحاول أن نضع أنفسنا مكان أيوب، لكي نتعاطف بطريقة واقعية تماماً مع الصرخات القلبية التي تثيرها آلامه ومعاناته غير العادلة.
في أول أصحاحين من هذا السفر يتم تقديم شخصية أيوب. فنجد أنه يعيش في وقت كانت تقاس فيه ثروة الإنسان ليس بحجم ما يمتلكه في البنوك، بل بحجم قطعانه. وهذا يضعه في فترة الآباء العبرانيين، مثل إبراهيم واسحق ويعقوب. لكن أيوب لم يكن فقط مجرد رجل ثري، وربما كان أغنى إنسان عاش على الأرض بحسب عدد 3، ولكنه كان رجل تقي كذلك. فنقرأ أنه كان يخاف الله ويحيد عن الشر. وقد ظهرت تقواه الشخصية العميقة بعدة طرق، ليس أقلها اهتمامه القلبي العميق بالخير الروحي لأبنائه. ففي العددين 4-5 نقرأ أنه خوفاً من أن يكون أحد أبنائه قد تصرف بطريقة قد تغضب الله فتجلب عليهم دينونته، كان أيوب يقدم ذبائح خطية نيابة عنهم إلى الله. ولم تكن هذه مرة عابرة، ولكنها كان عادة لديه:
«وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه ويرسلون ويستدعون أخواتهم الثلاثة ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم. لأن أيوب قال ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام». (أيوب 1: 4-5).
يمكن أن يوصف أيوب في يومنا هذا بأنه مسيحي مكرس، وأنه شخص يتغلغل إيمانه في كل مناطق حياته.
ولكي نمنع أي شك قد يرد إلى أذهاننا من أن هذه الثروة قد كسبها بالتزوير أو الخداع، يوضح الكتاب منذ البداية أن أيوب كان «رجل كامل مستقيم» (1: 8)، بكلمات أخرى، كان شخصيته الأخلاقية بلا لوم. فلدينا هنا رجل متعبد ومخلص لله، أمين، ورجل أعمال مجتهد، كما أنه زوج محب وأب طيب القلب. ويبدو أن أيوب كان شديد الصلاح عن أن يكون شخصية حقيقية! لكننا كما سنرى، كان أيوب من الأشخاص نادري الوجود، من فئة خاصة، فقد كان رجلاً تقياً بالفعل. فأي شر يمكن أن يحدث له؟
لم يفعل أيوب شيئاً يتطلب تغييراً في أسلوب حياته. فعلاقته بالله لم يكن من الممكن أن تكون أفضل من ذلك. فلم تكن هناك دروس واضحة يحتاج أن يتعلمها أو خطايا تحتاج إلى تقويم، كما أنه من الصعب للغاية أن نرى كيف كان يمكن أن يتحسن. بل قد يقول البعض «بالتأكيد كون المرء أميناً لله يأتي معه ببركات ومزايا – مثل حياة طيبة آمنه، أليس كذلك؟»
خلف المشهد
في أيوب 1: 6، يتم رفع الستار الواقع المرئي للحظة لتوصيل للقارئ لمحة مما يحدث في العالم الروحي غير المرئي، حيث، خلف المشهد، يحدث رهان بين الله وإبليس، الشيطان، الذي يعني اسمه “المشتكي على شعب الله“. ومثل المحامي الحقود أو رجل الشرطة الفاسد الذي يتمتع باتهام البريء، كان إبليس يبحث عن شخص يجره أمام كرس قضاء الله لكي يدينه.
فعندما قال الله للشيطان: «من أين جئت؟» أجاب إبليس: «من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها». وعندما سأله الله: «هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض. رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر». أجابه الشيطان: «هل مجاناً يتقي أيوب الله، أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية…»، فالسبب الوحيد الذي يجعل أيوب يعيش بهذه التقوى أنه يعرف ما سيجنيه من خلف ذلك، فعلى أية حال، كل إنسان يعرف أن الدين ليس إلا اهتمام مستنير بالذات. آمن بالله، وكن صالحاً، وستذهب إلى السماء! أما إذا كنت شريراً فستذهب إلى الجحيم. والحقيقة أنك يمكن أن تضيع كل ظروفه الحسنة هذه التي وفرتها له. فأي إنسان يمكن أن يكون تقياً إذا توفرت له مثل هذه الظروف السهلة والغنية في الحياة، فالدين ليس سوى رفاهية بالنسبة للأثرياء الموسورين، من الطبقات العليا أو المتوسطة. لكن دع أيوب يذق طعم الحاجة والعوز، وستعرف سريعاً أين تكمن محبته. كان هذا هو تهكم وشكاية إبليس تجاه عدد لا حصر له من البشر عبر العصور.
وبالتالي، يتحدى ابليس الله: «ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك». (ع 11)، ورغم أن رد الفعل قد يثير الصدمة، إلا أن الله قبل التحدي، وسمح لإبليس فعلياً أن يفعل أسوأ ما يمكنه – على شرط واحد – ألا يؤذي أيوب نفسه: «فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك. وإنما إليه لا تمد يدك» (ع 12).
عالم ينهار
هذا بالضبط هو ما حدث. فقد وقع كل ما يمكن أن يعتبر كابوساً صارخاً، ودمرت حياة أيوب بالكامل. أولاً، فقد أيوب ثروته بفعل الغزاة الناهبين. فضاعت ثيرانه المطلوبة للزراعة، وفقد حميره وجماله التي كان يحتاجها للنقل، وكل عماله قتلوا (العددان 14-15). فتهدمت إمبراطورتيه المالية كلها. وبينما كان يعزي نفسه، إذ يفكر أنه رغم سوء الأمور، يمكنه أن ينجح في كسب عيشه مجدداً بقليل من الخراف التي بقيت، وصلته أخبار أخر بأن هذه أيضاً قد هلكت، ليس بفعل إنسان غاز هذه المرة، بل بفعل إلهي: «نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم» (ع16). ربما كان هذا نتيجة ثورة بركان! أو عاصفة من السماء، وبينما كان لا يزال يفيق من صدمة أمواج الكوارث الاقتصادية، جاءت إلى مسامعه أخبار أبشع في صورة مأساة شخصية أعظم – فقد جاءت عاصفة وحصدت أرواح أبناءه الأحباء كلهم (العددان 18-19).
كيف كان يمكننا أن نستجيب لكل هذه الكوارث؟
لكن هكذا كانت استجابة أيوب:
«فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً».
ثم نقرأ بعد ذلك: «في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة».
ألا يكفي ذلك؟
قد تعتقد أن هذا يكفي أن يحتمله أي إنسان. لكن يبدو أن الله كان يفكر بطريقة مختلفة. إذ عندما يرفع الستار مرة أخرى في الأصحاح الثاني، نجد أنفسنا في الساحة السماوية مرة أخرى، لكي نكتشف أن الرهان أخذ خطوة أخرى أعمق. فالشيطان، إذ كان لا يزال غير مقتنع أنه لا يوجد أساس أو دافع لإيمان أيوب، يستمر في تحديه في العددين 4 -5: «جلد بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه. ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك». بكلمات أخرى: «ادخل إلى ما تحت جلده، ودعه يشعر بنوع من الألم الجسدي، ودعه يعتقد أن حياته هو نفسه مهددة. ثم راقبه وهو يكشف عن وجهه الحقيقي».
وهكذا أصيب أيوب بقروج رديئة وآلام مبرحة، حتى أن زوجته إذ وجدت انه من غير المحتمل أن تراه، حثت أيوب على أن يقتل نفسه عن عمد وأن يلعن الله (ع9). وحتى أيوب نفسه تمنى لو لم يكن قد ولد، تلك الصرخة التي وصلت إلى الذروة في أيوب 3: 11:
«لِم لم أمت من الرحم. عندما خرجت من البطل لِم لم أسلم الروح. لماذا أعانتني الركب ولم الثدي حتى أرضع. لأني قد كنت الآن مضطجعاً ساكناً. حينئذ كنت نمت مستريحاً مع ملوك ومشيري الأرض الذي بنوا أهراماً لأنفسهم أو مع رؤساء لهم ذهب المالئين بيوتهم فضة».
لقد كان أيوب شديد التشوه والدمار، حتى أن أصدقاءه أليفاز وبلدد وصوفر عندما جاءوا لتعزيته. بالكاد تعرفوا عليه، وانفجروا في بكاء هستيري (2: 11-13). فها هو رجل يجتاز في آلام وعذاب لا يحتمل، والذي اشتد، ولم يحف، بإيمانه بالله. لأنه لو لم يكن يؤمن بالله لكان يعزيه بعض الشيء أن يعرف بأن كل هذا محض صدفة، دون أن يكون هناك شخص يلقي باللوم عليه. لكن أن يؤمن بالله، وبإله صالح وكلي القدرة في هذه الظروف، كان هذا الإيمان يبدو وكأنه يطير في وجه محنته الحالية. فكيف يمكن لمثل هذا الإله أن يسمح بحدوث ذلك؟
في هذه الأصحاحات الافتتاحية لسفر أيوب، توجد ثلاث دروس يصر الكاتب على أن نتعلمها إذا كنا نرغب في أن نتقدم وننمو في التكيف مع مشكلة الألم بالنسبة للبريء.
من المسؤول؟
الدرس الأول هو أن الله هو الذي له السيادة على الألم: أنه بصورة غامضة لا نستطيع أن نفهمها، يقع الألم داخل سلطان الله المطلق.
واحدة من الطرق التي يحاول بها بعض الناس أن يحلوا مشكلة الشر هي أن يصبحوا ما يطلق عليه “ثنائيين”. وهذه الفكرة تفترض أن هناك قوتان متساويتان ومتعارضتان تحاربان بعضهما البعض في هذا العالم – أي قوة الخير وقوة الشر، الله وإبليس. فكل الخير الذي يحدث يرجع إلى الله، وكل الشر الذي يحدث يرجع إلى الشيطان. والنتيجة هي أن الله لا يتحمل أية مسؤولية عن الألم لأنه ليس في الحقيقة خطأ يرجع إليه هو، بل يلقي اللوم على الشيطان. من الناحية الفلسفية، تمثل هذه النظرة الديانة القديمة التي كان يطلق عليها الزرادشتية، وشعبياً “حرب النجوم”. لكن بعض المسيحيين تبنوا هذا الفكر أيضاً.
منذ عدة سنوات مضت زرت مجموعة مسيحية شطح خيالها بهذا النوع من التفكير. فوقف أحد أعضائها وقال إنه فقد مفاتيح سيارته وأن هذه حرب من إبليس. ووقف آخر يقول إن لديه جيران مزعجون، وأن هذه أيضاً حرب من إبليس. ووقف ثالث وكان لديه قرحة، وهذا أيضاً قال إن هذه حرب من إبليس. هؤلاء الناس لم يكن من الممكن أن يصابوا بالبرد دون أن يحولوا الأمر إلى حرب روحية عظيمة!
يمكن أن تكون مثل هذه الفكرة مناسبة وبسيطة، ولكن تكلفتها اللاهوتية باهظة للغاية. فبهذه الفكرة يكون لدينا إله محدود، وإله معتمد بالكامل على تحركات خصمه الشيطان. بل ربما في يوم ما يتفوق عليه الشيطان، وعندها أين يمكن أن نكون؟ لكن الكتاب المقدس، وخاصة سفر أيوب، لا يسمح لنا بأن نؤمن بمثل هذه الترهات.
بل بدلاً من ذلك، يقدم لنا الكتاب المقدس إلهاُ كل السيادة والسلطان، وكل الأمور تحت سيطرته الكاملة. على الرغم من وجود إبليس، فإنه لا يتم تصويره كإله ثان، بل كمخلوق لديه قوى لا يستهان بها، ولديه القدرة على استخدام هذه القوى، لكن فقط بسماح من الله. بالطبع يمكن أن نُرجع مصائب أيوب إلى عمل إبليس، إلا أنها يمكن أيضاً أن ترجع إلى عمل الغزاة والفيروسات. يطلق على هذا السبب المزدوج أو الفهم المتزامن. إلا أن كل هذه الأمور ما كان يمكن أن تحدث لو لم يسمح الله بحدوثها. ففي أيوب 1: 11، تحدى الشيطان الله بأن يمد يده إلى أيوب، لكن الله هو الذي وضع القوة في يدي الشيطان! كما أن أيوب أيضاً كان يدرك سلطان وسيادة الله، مثلاً في 2: 10، عندما قال لزوجته: «أالخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل؟»
من وجهة نظر واحدة، معرفة هذا الأمر يجعل الأمور أسوأ، لأنه يدفعنا للسؤال «لماذا؟»، لماذا يجب على إله صالح أن يقر أو يسمح بهذه الأمور إذا كانت لديه القدرة على منعها؟ لكن من ناحية أخرى، يقدم لنا هذا الفهم رجاءً. لأنه إذا كان الله صالحاً (وهو كذلك بالفعل)، فيمكننا أن نؤمن أن هناك سبب ما للخير وراء ما يحدث، رغم أنه قد لا يكون معروف لنا في ذلك الوقت. والأكثر من ذلك، إذا كان الله كلي القدرة (وهو كذلك بالتأكيد)، فهناك رجاء في أن لديه القدرة على أن يخفف من آلامنا، أو على الأقل أن يمدنا بالنعمة لكي نتحملها ونتكيف معها. إن الرسالة التي تأتي إلينا بقوة ووضوح هي أن الله، وليس إبليس، هو الذي يحكم ويسود.
تكلم وأفصح عن مشاعرك
الدرس الثاني الذي نحتاج أن نتعلمه من هذا الاستعراض، هو أن الله لا يلومنا إذا عبرنا عن مشاعرنا له في آلامنا، وإذا صرخنا إليه، بل حتى إذا صرخنا في وجهه عند الضرورة، وبذلك نفضي أليه بحمل مشاعرنا وآلامنا. وهذا هو ما فعله أيوب في الاًصحاح الثالث.
فبعد رد الفعل السلبي نسبياً لأخبار موت أبنائه – وهو الأمر الغالب في حالة الحزن على فقد الأحباء، إذ يشعر الفرد بالصدمة وعدم التصديق، وهو جزء من الآلية الجسدية الطبيعية للتكيف – يتبع ذلك الانفجار العاطفي العميق. فرغم أن أيوب لم يخطئ بأن يلعن الله، إلا أنه لم يتردد في أن يلعن ويسب اليوم الذي ولد فيه. لقد كان شديد الحزن حتى أنه شعر أنه لا بد وأن يخبر أحداً، ومن يمكنه أن يخبر أفضل من الله؟ لذلك فمن الأمور المهمة ألا يقوم الأشخاص الذين يجتازون بآلام شديدة بكبت مشاعرهم، لأنهم إذا فعلوا ذلك، فإن كل هذه الطاقة سيتم دفعها وكبتها داخل العقل الباطن، لكي تُظهر نفسها بعد ذلك، سواء في صورة اكتئاب أو ضغط عصبي. فمن الأفضل كثيراً أن ندع الحزن يخرج ونعبر عنه. وهذا هو السبب في أنني أشدد على الشخص الذي يكون قد اجتاز مؤخراً في حالة فقد لأحد الأحباء، أنه في خدمة الدفن من السليم أن يظهر ويعبر عن كيفية شعوره – ومن المقبول أن نبكي. فلا توجد فضيلة في تصليب الشفتين والامتناع عن البكاء. كما أنه ليس من السليم أن نقول، «لم تذرف دمعة واحدة في الجنازة؟» لأنها لم تظهر أية عواطف. لكن هذا ليس تكيفاً، ولكنه إنكار، لكننا جميعاً نحتاج أن نعبر بحرية عن حزننا لكي نتمكن من التحرك للأمام تجاه الشفاء. والله يحترم ذلك، بل أنه يوافق عليه. فكما سنرى في الأصحاحات التالية، لم يوبخ الله أيوب لتعبيره عن شكوكه أو غضبه.
كثيرون يعرفون قصة الكتاب المسيحي سي إس لويس الذي تزوج من جوي ديفيدمان، كما تم تصوير ذلك في فيلم Shadowlands. وقد توفت جوي ديفيدمان متأثرة بالسرطان، تاركة وراءها ابنين صغيرين. وفي رواية صريح للغاية، دون لويس مشاعره بعد موت زوجته، والتي نقرأها في كتابه “A Grief Observed”[2]. ومثل أيوب، يواجه لويس حزنه ويجادل مع نفسه ومع الله حول كيفية شعوره، فيكتب:
«الليلة، كل جحيم بركان الحزن الحديث قد انفتح مرة أخرى؛ الكلمات الغاضبة، الاستياء المرير، انقباض المعدة، الوهم المرعب، التمرغ في البكاء. وفي هذه الأثناء أتساءل أين الله؟ إن هذه الأعراض والمشاعر شديدة الثورة. عندما تكون سعيداً… وترد له كلمات الامتنان والشكر، فإنك تشعر أنه يرحب بك – أو هكذا تشعر – بذراعين مفتوحتين. لكن اذهب إليه عندما تشعر بالاحتياج واليأس، عندما تبطل أية معونة أخرى، فماذا ستجد؟ باب مغلق في وجهك، وصوت مزلاج الباب وهو يوصد مرة ومرتين من الداخل، ثم بعد ذلك صمت رهيب».
كان هذا تعبير صادق للغاية عن تجربته. وربما نتذكر جيداً شخصاً آخر اجتاز اختباراً مشابهاً وهو على الصليب عندما صرخ: «إلهي إلهي لماذا تركتني». فيمكننا، بل يجب علينا أن نعبر عن حزننا.
حل اللغز
وأخيراً، لا نزال نحتاج أن ندرك أن هناك عنصر لا يمكن أن يحل من اللغز. فقد صرخ أيوب «لماذا؟»، «لماذا لم أهلك منذ الولادة؟ لماذا لم أمت عند ولادتي، ولماذا يرى البؤساء النور؟» لكن أيوب لم يحظ بأية إجابة، وبينما يُسمح لنا نحن كقراء أن نرى ما يحدث في السماء، فأيوب لم تكن لديه هذه الرؤية. فهو لم يدرك أبداً النقاش الذي دار بين الله وبين إبليس. وهذا أمر مهم، لأن واحداً من الدروس التي يعلمنا إياها هذا السفر الكتابي هي الحاجة إلى أن نثق في الله في المواقف التي لا نعرف فيها لماذا تحدث أمور معينة. لكن لنقل إن هذا الإيمان ليس إيماناً أعمى، فقد عرف أيوب عن الله، وكانت لديه أسباب لكي يؤمن أن الله كلي القدرة وكلي الصلاح، ويتم تذكيره بهذه الأمور فيما بعد عندما يلتقي بالله، كما يوصف ذلك في الأصحاحات 38-42. ولذلك، على الرغم من أن أيوب لم يعرف لماذا كانت هذه الأمور تحدث معه، فإنه كان يعرف الله بما يكفي لكي يثق في الإله الذي يعرف السبب. إن حقيقة أن أيوب لم يحصل على إجابة لم توقفه عن السؤال، كما لا يجب أن توقفنا نحن كذلك.
إن ما كان أيوب يختبره هو لغز غامض، ومع ذلك فقد استمر في الثقة في الله.
ولا بد أن نعترف أننا إذا استطعنا أن نرى أن هناك نتيجة جيدة للألم، فسوف يساعدنا ذلك على تحمله بصورة أفضل – مثل المرأة التي تمر بأوجاع الولادة مثلاً. ولكن في الحياة المسيحية، لا يسمح لنا دائماً أن نعرف السبب في آلامنا. ولكننا لا نزال مدعوين أن نثق في الله الذي يعرف السبب. دعوني أقدم لكم مثال فعلي.
في بلدة صغيرة في استراليا، كان هناك امرأة مسيحية مشلولة بسبب التهاب المفاصل، وكان جسدها يئن باستمرار تحت وطأة الألم. إحدى جيرانها التي كانت تعيش على بعد عدة منازل في نهاية شارعها، علمت بهذا الأمر، وقد أذهلتها الطريقة الجميلة التي تكيفت بها مع هذا الألم، فلم تكن تشكو، وكانت دائماً إيجابية. وقد بهرها هذا الأمر للغاية حتى أنها قررت أن تذهب إلى الكنيسة التي ترتادها تلك المرأة لكي تكشف المزيد عن الإيمان الذي استطاع أن يصنع هذا الفارق في حياتها. وأخيراً صارت مسيحية، ثم بدأت بعد ذلك تأخذ ابنها الصغير إلى الكنيسة، وهو كذلك أصبح مسيحياً. واليوم أصبح هذا الابن واحداً من أفضل علماء العهد الجديد في العالم ونموذج للرجل المسيح الحقيقي. إنني واثق أننا إذا كنا قد تمكنا من قول ذلك لتلك المرأة «استمري، وتحملي آلامك لأنها ستكون شهادة حية حتى أن شاباً استطاع أن يتغير ويتجدد من خلالها، وسوف يستخدمه الله بقوة للتأثير على آلاف من الخدام في كل أنحاء العالم»، فإن هذا الكلام كان سيجعل آلامها بلا شك أيسر في الاحتمال. ولكنها لم تعرف أياً من ذلك. كل ما استطاعت أن تفعله هو أن تثق في الله.
إن كل ما استطاع أيوب أن يفعله، وربما كل ما يمكننا نحن أيضاً أن نفعله، وفي وجه الأسئلة التي لا إجابة عليها، وهو أن نثق في الله الذي نعرف أنه ذاق قلب الألم في شخص ابنه الحبيب، يسوع المسيح.
[1] دي إيه كارسون، How Long o Lord? (IVP، 1990).
[2] سي إس لويس A Grief Observed (Fount، 1962).
