الاختزال الاختزال الاختزال – جون ليونكس
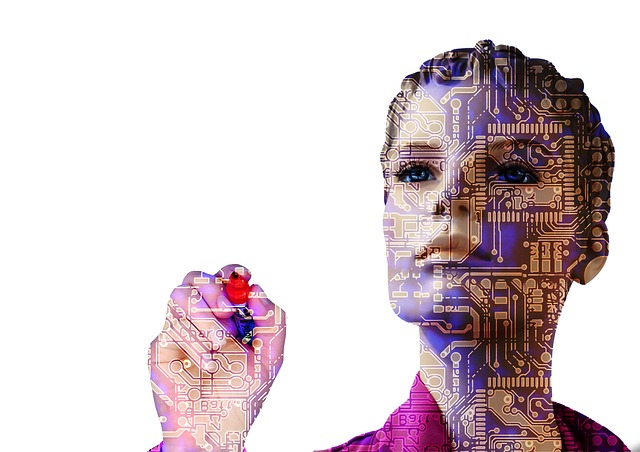
العلم ووجود الله – الاختزال الاختزال الاختزال – جون ليونكس
«لو كان للبقر والخيول أو الأسود أياد تمكنها من الرسم،
لرسمت الخيول أشكال الآلهة كالخيول، ولرسم البقر آلهة كالبقر،
لها أجسام تشبه أجسامنا.»
زنوفانيز (500 ق.م)
«لا أفترض “إلهاً للفجوات”، إلهاً لمجرد تفسير الأشياء
التي لم يفسرها العلم حتى الآن. ولكني أفترض إلهاً يفسر سر قدرة
العلم على التفسير. فأنا لا أنكر أن العلم يفسر، ولكني أفترض
وجود إله يفسر لنا سر قدرة العلم على التفسير.»
“ريتشارد سوينبرن” Richard Swinburne
إقرأ أيضا:
العلم ووجود الله – نطاق العلم وحدوده – جون ليونكس
العلم ووجود الله – صراع بين منظورين فلسفيين – جون ليونكس
إله الفجوات:
تنشأ قضية أخرى مهمة من قصة “لابلاس”، ألا وهي قضية “إله الفجوات” التي لا بد أن تطرح في أي مناقشة عن العلم والدين إن عاجلاً أم آجلاً. وهي فكرة مفادها أن إدخال إله أو إدخال الله في النقاش العلمي لهو دليل على الكسل الفكري، أي أننا عندما نعجز عن تقديم تفسير علمي لشيء ما ندخل “الله” لنغطي على جهلنا. وسوف نناقش هذه الفكرة لاحقاً بمزيد من التفصيل، ولكن من المهم الآن أن نبين أن مستر “فورد” لا يوجد في فجوات معرفتنا بكيفية علم آلات الاحتراق الداخلي.
وهو بمعنى أدق لا يوجد في أي تفسير تقدم أسباباً فيما يختص بآليات العمل. وذلك، لأن “هنري فورد” ليس آلية، ولكنه الفاعل المسؤول عن وجود الآلية أصلاً حتى إن الآلية بأكملها تحمل بصمات عمل يديه، بما في ذلك ما نفهمه وما لا نفهمه.
وهو ما ينطبق على الله. فعلى المستوى المجرد المتعلق بقدرة العلم التفسيرية نفسها، يقول الفيلسوف “ريتشارد سوينبرن” Richard Swinburne في كتابه “هل من إله؟” Is There a God?: «لاحظ أني لا أفترض “إلهاً للفجوات”، إلهاً لمجرد تفسير الأشياء التي لم يفسرها العلم حتى الآن. ولكني أفترض وجود إله يفسر لنا سر قدرة العلم على التفسير. فنجاح العلم نفسه في أن يبين لنا مدى ما يتسم به العالم الطبيعي من نظام عميق يقدم أساساً قوياً للاعتقاد بوجود مسبب أعمق لذلك النظام.»
ويستخدم “سوينبرن” الاستدلال القائم على أفضل التفسيرات Inference to the best explanation ويقول إن الله هو أفضل تفسير لقدرة العلم التفسيرية Explanatory power of science.
والنقطة التي لا بد أن ندركها هنا هي أنه بما أن الله ليس بديلاً للعلم باعتباره أداة تفسيرية، فلا يصح فهمه على أنه إله الفجوات فحسب. ولكنه على العكس، أساس التفسير كله: إن وجوده هو ما يسمح بإمكانية التفسير، سواءً أكان تفسيراً علمياً أو غيره. ومن الأهمية بمكان تأكيد هذه الفكرة لأن بعض الكتاب المؤثرين مثل “ريتشارد دوكينز” يصرون على أن يفهموا الله باعتباره مفسراً بديلاً للعلم، وهي فكرة لا نعثر عليها مطلقاً في أي فكر لاهوتي محترم. ولذلك، فإن “دوكينز” يهاجم عدواً وهمياً، لأنه يرفض مفهوماً لله لا يؤمن به أصلاً أي مفكر جاد. وهو ما يعد علامة على عمق الفكر.
نزع الألوهة عن الكون: العلماء الأوائل:
إلا أنه علينا أن نفحص الادعاء الذي يطرحه الكثير من العلماء بمزيد من الدقة، ألا وهو أن الإلحاد هو افتراض سابق لا غنى عنه للعلم الحقيقي. وهم يعتقدون أن أي محاولة للارتكان إلى الله باعتباره تفسيراً للكون على أي مستوى معناها نهاية العلم.
لا شك أننا لا بد أن ننزع الألوهة عن قوى الطبيعية حتى نتمكن من دراسة الطبيعة بحرية، وهي خطوة ثورية في عالم الفكر اتخذها فلاسفة الإغريق الطبيعيون الأوائل طاليس، وأناكسيماندر، وأناكسيمانس الميليتسي منذ أكثر من 2500 سنة. فهم لم يقنعوا بالتفسيرات الأسطورية كالتي كتبها هوميروس وهسيود حوالي سنة 700 ق.م. واجتهدوا في إيجاد تفسيرات للعمليات الطبيعية وحققوا إنجازات علمية عظمية.
فالفضل يرجع إلى طاليس في تحديد عدد أيام السنة بأنها 365 يوماً، وقد تنبأ بدقة بحدوث كسوف شمسي سنة 585 ق.م. وينسب إليه استخدام طرق هندسية في حساب ارتفاعات الأهرام بناء على ظلالها، وفي تقدير حجم الأرض والقمر. أما أناكسيماندر فقد اخترع الساعة الشمسية وساعة تتحمل الأجواء الصعبة ووضع أول خريطة للعالم وأول خريطة للنجوم. وهكذا كان الفلاسفة الميليتسيون Milesians من ضمن العلماء الأوائل.
ويعتبر زنوفانيز (حوالي 570-478 ق.م) الذي من كولوفون (بالقرب من أزمير في تركيا الحالية) ذا أهمية خاصة في موضوعنا. وهو بالرغم من أنه معروف بمحاولاته لفهم دلالات حفريات المخلوقات البحرية التي وجدت في مالطة، فهو معروف أكثر بشجبه الحاد للمنظور الأسطوري للحياة. وقد أشار إلى أن السلوك الذي يعتبره البشر في غاية الخزي نسب للآلهة: فالآلهة كانوا بلا مبدأ، ولصوصاً، وزناة.
ورأى أن هذه الآلهة صنعت على صورة الشعوب التي آمنت بها: فآلهة الإثيوبيين سوداء وأنوفها مسطحة. وشعب تراقيا Thracians صوروا آلهتهم بعيون زرقاء وشعر أحمر. وقد أضاف ساخراً: «لو كان للبقر والخيول أو الأسود أياد تمكنها من الرسم، لرسمت الخيول أشكال الآلهة كالخيول، ولرسم البقر آلهة كالبقر، لها أجسام تشبه أجسامها.» ومن ثم، فقد رأى زنوفانيز أن هذه الآلهة ليس سوى خيالات طفولية صريحة نتجت عن الخيال الخصب لمان آمنوا بها.
وأبيقور الفيلسوف اليوناني الذري[1] Atomist المؤثر (المولود سنة 341 ق.م. عقب موت أفلاطون مباشرة) الذي تنسب له الفلسفة الأبيقورية تمنى إلغاء الأساطير من التفسير بغية تطوير الفهم: «يمكن أن تنتج الصواعق بعدة طرق مختلفة، المهم إبعاد الأساطير عنها! ويمكن إبعاد الأساطير إن تتبعنا ما نراه من الصواعق تتبعاً صحيحاً واعتبرناه علامات تشير إلى ما نراه.»
وهذا الشجب للآلهة والإصرار على بحث العمليات الطبيعية التي كانت حتى ذلك الحين غالباً ما لا تفهم إلا باعتبارها عمل تلك الآلهة، أدى حتماً إلى تراجع التفسيرات الأسطورية للكون وإلى تقدم العلم.
إلا أن زنوفانيز لم يكن الوحيد بين المفكرين القدامى الذي انتقد فلسفة تعدد الآلهة. بل الأهم أنه لم يكن أول من فعل ذلك. فهو لم يعلم (ربما لم تتوفر معلومات كافية عن هذا الموضوع للأسف) أن موسى سبقه بقرون وحذر من عبادة آلهة أخرى والسجود لها «أو للشمس أو للقمر أو لكل ما جند السماء.» والنبي العبراني إرميا مثلاً الذي كتب حوالي سنة 600 ق.م. رفض أيضاً عبثية تأليه الطبيعة وعبادة الشمس والقمر والنجوم.
وهنا يمكن أن نسقط بسهولة في شرك القفز إلى الاستنتاج بأن التخلص من الآلهة يستلزم أو يعادل التخلص من الله. ولكن ما أبعد الفارق بين الاثنين. فموسى والأنبياء أدركوا حماقة السجود لأجزاء الكون المختلفة كالشمس والقمر والنجوم باعتبارها آلهة. ولكنهم رأوا أيضاً أن عدم الإيمان بالله الخالق الذي صنع الكون وإياهم، وعندم السجود له حماقة مماثلة. ولابد هنا أن نلاحظ أيضاً أنهم لم يقدموا فكرة جديدة غير مسبوقة. فهم لم يتحاجوا أن ينزعوا الألوهة عن الكون كما فعل الإغريق، لسبب بسيط أنهم لم يؤمنوا مطلقاً بالآلهة من الأصل.
وما أنقذهم من تلك الخرافة كان إيمانهم بالله الحقيقي الواحد خالق السماء والأرض. أي أن الكون الوثني متعدد الآلهة الذي وصفه كل من هوميروس وهسيود لم يكن صورة العالم الأصلية التي رآها البشر، وهو انطباع منبعه أن معظم الكتب العلمية والفلسفية تبدأ بالإغريق وتؤكد أهمية نوع الألوهة عن الكون، فتفشل فشلاً ذريعاً في الإشارة إلى أن العبرانيين سبقوا الإغريق بمئات السنين في نبذ التفسيرات الوثنية للكون.
وهو ما يشوش على حقيقة أن تعدد الآلهة ينطوي فعلياً على تشويه الإيمان الأصلي بالله الواحد الخالق. وهذا التشويه هو ما كان ينبغي تصحيحه. وهذا التصحيح لا يتم بالتخلي عن الإيمان بالخالق بل باستعادته. هو ما أوضح “ملفين كالفين” كما سبقت الإشارة.
ومن ثم، فالفرق شاسع بين المنظور الإغريقي للكون والمنظور العبراني، وهو ما يجب إبرازه بمزيد من الوضوح. فمثلاً “ورنر يجر” Werner Jaeger يكتب في تعليقه على قصيدة هسيود “نسب الآلهة” “Theogony” (بدايات الآلهة) قائلاً: «إن قارنا أساس خلق العالم عند الإغريق وهو الحب الجنسي أو الإيروس Eros بالكلمة أو اللوجوس Logos الذي يمثل أساس خلق العالم في رواية الخلق العبرية، سنلاحظ هوة شاسعة بني منظور الشعبين.
فاللوجوس تجسد لملكة أو قدرة فكرية عند الله الخالق الذي يقع خارج العالم ويوجد ذلك العالم بأمره الشخصي الخاص. أما الآلهة الإغريقية تقع داخل العالم، فسلالتها تنحدر من السماء والأرض… وقد تولدت بقوة تأثير الإيروس الذي ينتمي بدوره للعالم باعتباره قوة بدائية تنشئ كل شيء. ومن ثم، فهي أصلاً خاضعة لما نطلق عليه القانون الطبيعي. فعندما يفكر هسيود تفكيراً فلسفياً حقيقياً، ينتهي إلى البحث عن الله داخل العالم، لا خارجه، كما هو في اللاهوت المسيحي اليهودي الذي يكشف عنه سفر التكوين.»
فمن اللافت للنظر أن زنوفانيز بالرغم من أنه غارق في ثقافة تؤمن بتعدد الآلهة، لم يقع في خطأ الخلط بين الله والآلهة. ومن ثم، رفض الاثنين. ولكنه آمن بإله واحد يحكم الكون. وقد كتب: «يوجد إله واحد… يختلف عن المخلوقات الفانية شكلاً وفكراً… وهو بعيد ويحكم كل الموجودات دون مجهود.»
وإسهامات توما الأكويني في القرن الثالث عشر تتصل أيضاً بموضوعنا هذا. فقد اعتبر الله العلة الأولى First Cause، المسبب الأعلى لكل الأشياء. فالله تسبب مباشرة في وجود الكون. ومن ثم، فالكون معتمد عليه. وهذا هو ما يمكن نسميه العلية المباشرة Direct causation. ولكن توما الأكويني أوضح بعدئذ مستوى ثانياً من العلية (يسمى أحياناً العلية الثانوية Secondary Caustion) يعمل في الكون.
وهذا ما يكون شبكة المسبب والأثر Cause-effect التي تتألف خيوطها من منظومة الكون المتشابكة المعتمدة على بعضها البعض. ولذلك، فإن كانت تفسيرات العليّة الثانوية يمكن أن تقدم على هيئة قوانين وآليات، فهذا لا يعني عدم وجود الخالق الذي يعتمد عليه وجود شبكة المسبب والأثر عينه.
وفكرة أن الإيمان بإله خالق خلق الكون ويحفظه يقضي على العلم هي فعلياُ فكرة مغلوطة. بل إنها فكرة غريبة على ضوء الدور الذي لعبه هذا الإيمان في نشأة العلم، لأنها لو كانت صحيحة، فالأرجح أن العلم ما كان سينشأ أصلاً. فالاعتقاد بأن محرك السيارة هو من تصميم مستر “فورد” لن يمنع أي شخص من دراسة كيفية عمل المحرك علمياً، بل إنه قد يشجع على ذلك.
ولكن إن اعتنق المرء عقيدة خرافية مفادها أن مستر “فورد” هو المحرك فهذا ما يقضي على محاولاته العلمية نهائياً. وهذه الفكرة خطيرة، فهذا هو مربط الفرس: إن الفرق كبير بين الله والآلهة، وبين إله خالق، وإله هو الكون نفسه، وهو ما أدركه “جيمز كلرك ماكسويل” James Clerk Maxwell جيداً عندما حفر على باب “معمل كافينديش للفيزياء” Cavendish Physics Laboratory الشهير بجامعة كامبريج هذه الكلمات: «عظيمة هي أعمال الرب. مطلوبة لكل المسرورين بها.»
وعندما نمد بصرنا عبر تاريخ العلم نجد من الأسباب ما يكفي للشعور بالامتنان للمفكرين اللامعين الذين خطوا هذه الخطوة الجريئة وشككوا في النظرة الأسطورية للطبيعة التي أسبغت قوى إلهية على أجزاء الكون المختلفة التي لا تملك هذه القوى أصلاً.
وقد رأينا أن بعضهم فعل ذلك، دون أن يرفض مفهوم الخالق، بل باسم ذلك الخالق نفسه. ولكن الخطورة الخفية اليوم أن بعض العلماء والفلاسفة، انطلاقاً من رغبتهم في القضاء على مفهوم الخالق نهائياً، يميلون إلى إعادة تأليه الكون بمنح المادة والطاق قدرات خلقية لا يمكن إثبات أنهما تملكانها فعلاً، وهو ميل ساذج. فمحوهم للإله الواحد الخالق سينتهي إلى ما يسمى النتيجة النهائية لتعدد الآلهة، ألا وهي أن كل جزء في الكون يتمتع بقدرات إلهية.
عندما ناقشنا حدود العلم سابقاً، أوضحنا أن بعض الأسئلة خارجة عن نطاق العلم، وخاصة أسئلة “لماذا” التي تتعلق بالغرض باعتباره متمايزاً عن الوظيفة. ولكن علينا الآن أن نرجع لكيفية تناول العلم للأسئلة التي تقع ضمن مجال اختصاصه.
الاختزالية:
الهدف من “تفسير” شيء هو تقديم وصف مفهوم واضح لطبيعته ووظيفته. ومن الأساليب المتبعة للوصول لهذا التفسير تقسيم المشكلة إلى أجزاء أو أوجه منفصلة، ومن ثم “اختزالها” إلى مكونات يسهل بحث كل منها على حدة. وهذا الإجراء الذي عادة ما يطلق عليه الاختزالية المنهجية Methodological Reductionism يمثل جزءًا أساسياً من عملة العلم الطبيعية (ومن الكثير من الأنشطة الأخرى) وقد أثبت كفاءة مبهرة.
وتستخدم اللغة الرياضية لتبسيط وصف الظواهر المعقدة جداً أو اختصاره والتعبير عنه بمعادلات رياضية قصيرة وبسيطة. خذ مثلاً الإنجاز العظيم الذي حققه كبلر عندما أخذ الكثير من الملاحظات التي رصدها تيكو براهي Tycho Brahe لحركة النجوم واختصرها في جملة واحدة تقول بأن الكواكب تتحرك في مدارات بيضاوي الشكل وتقع الشمس في أحد مركزي المدار البيضاوي. ثم جاء نيوتن وضغط ما توصل إليه كبلر أو بسطه على هيئة قانون الجاذبية الذي صاغه.
وهكذا تصنف معادلات كل من ماكسويل وإينشتاين وأيضاً “شرودينجر” Schrodinger وكذلك “ديراك” Dirac ضمن أشهر الأمثلة النموذجية على انتصار مبدأ الاختزال الرياضي. والسعي المستمر لما يطلق عليه نظرية كل شيء TOE (Theory of Everything) مدفوع برغبة في التوصل إلى صورة رياضية مختصرة إلى أقصى درجة بدمج قوى الطبيعة الأساسية الأربع معاً.
وقد تأثر عالم الرياضيات العظيم “دافيد هيلبرت” David Hilbert بإنجازات الاختصار الرياضي المبهرة، فرأى أن برنامج تبسيط الرياضيات يمكن استخدامه إلى أقصى درجة حتى نتمكن في النهاية من اختصار كل الرياضيات في مجموعة من الأطروحات الشكلية Formal Statements على هيئة مجموعة منتهية Finite Set من الرموز ومجموعة منتهية من المسلمات وقواعد الاستدلال.
وكم كانت فكرة مغرية تعد بتقديم أعقد الظواهر في تفسيرات «تبدأ من التفاصيل الدقيقة وتنتهي بالمفاهيم العامة» «Bottom-up» ونجاح برنامج “هيلبرت” يعني تبسيط الرياضيات إلى مجموعة من العلامات المكتوبة التي يمكن تطويعها وفقاً لقواعد محددة دون أي اكتراث بالتطبيقات التي تضفي “دلالات” على تلك العلامات. وتتحدد صحة أو خطأ أي سلسلة من الرموز بعملية خوارزمية[2] Algorithmic عامة. وقد جرى البحث دؤوباً لحل المسألة المعروفة باسم مشكلة القرار[3] Entscheidungsproblem عن طريق العثور على ذلك الإجراء المختص بقرار عام.
وقد رجحت الخبرة لكل من “هيلبرت” وغيره أن مسألة القرار يمكن حلها إيجابياً. ولكن حدسهم لم يكن في محله. ففي سنة 1931 نشر عالم الرياضيات النمساوي “كريت جودل” Godel Kurt بحثاً بعنوان “في افتراضات الأسس الرياضية والنظم ذات الصلة التي لا يمكن إثبات صحتها أو خطئها شكلياً” On Formally Undecidable Propositions of“ Principia Mathematica and Related Systems” ورغم أنه بحث قصير من خمس وعشرين صفحة، فقد أحدث زلزالاً رياضياً مازلنا نشعر بتوابعه حتى الآن.
وذلك، لأن “جودل” أثبت فعلياً أن برنامج “هيلبرت” يستحيل تحقيقه. فقد بين “جودل” في هذا العمل الرياضي الذي يعد إنجازاً فكرياً متقناُ من الطراز الأول أن علم الحساب المألوف لجميعنا غير مكتمل، أي أنه أي منظومة ذات مجموعة منتهية من المسلمات وقواعد الاستدلال تكفي لاحتواء علم الحساب العادي، دائماً ما تحتوي على مقولات Statements صحيحة لا يمكن إثباتها على أساس تلك المجموعة من المسلمات وقواعد الاستدلال. وتعرف هذه النتيجة باسم نظرية “جودل” الأولى في عدم الاكتمال Godel’s First Incompleteness Theorem.
وقد كان برنامج “هيلبرت” يهدف أيضاً إلى إثبات الاتساق الأساسي في صياغته للرياضيات باعتبارها منظومة شكلية. إلا أن “جودل” بدد ذلك الأمر أيضاً في نظريته الثانية في عدم الاكتمال Second Incompleteness Theorem. فقد أثبت أنه من الجمل التقريرية التي لا يمكن البرهنة عليها بمنظومة شكلية قوية وافية هي تلك المختصة باتساق المنظومة نفسها.
أي أنه إن كان علم الحساب متسقاً، فتلك الحقيقة هي واحدة من الأمور التي لا يمكن البرهنة عليها في المنظومة. ولكنها أمر لا يمكننا إلا أن نؤمن به على أساس الأدلة، أو الاحتكام إلى مسلمات أعلى. وهو ما تم إيجازه بالقول: إن كانت أساسات دين ما تقوم على الإيمان، فالرياضيات هي الدين الوحيد الذي يستطيع أن يبرهن أنه دين!
وقد عبر “فريمن دايسون” Freeman Dyson عالم الفيزياء والرياضيات الأمريكي المولود في بربطانيا عن هذا المعنى بأسلوب بسيط عندما قال: «إن “جودل” أثبت أن الكل في الرياضيات دائماً أكبر من مجموع أجزائه.» وعليه، فالاختزالية[4] لها حدودها. ولذلك، فعبارة “بيتر أتكينز” الواردة آنفاً التي يقول فهيا إن «المبرر الوحيد للاعتقاد بفشل الاختزالية هو تشاؤم العلماء وخوف المتدينين» عبارة يجانبها الصواب.
وتاريخ العلم يؤكد محدودية الاختزالية العلمية، وهو يعلمنا ضرورة موازنة حماستنا للاختزال – رغم أنها حماسة في محلها – بأن نأخذ في حسابنا أن الكل قد يكون (بل هو عادة) أكثر من حاصل جمع كل ما تعلمناه من أجزائه. فدراسة أجزاء الساعة، كل على حدة لن يمكنك بالضرورة من استيعاب كيفية عمل الساعة الكاملة باعتبارها كلاً متكاملاً. والماء هو أكثر من مجرد ما نراه بسهولة من دراسة مكونيه الهيدروجين والأكسجين كل على حدة. وهناك الكثير من الأنظمة المركبة التي يستحيل فهم أجزائها منفردة دون فهم النظام ككل، ومن أمثلتها الخلية الحية.
وإضافة للاختزالية المنهجية، يوحد نوعان آخران مهمان من الاختزالية: الإبستيمولوجية أو المعرفية Epistemological[5] والأنطولوجية أو الوجودية [6]Ontological. والاختزال الإبستيمولوجي هو الموقف الذي يرى أن الظواهر عالية المستوى يمكن تفسيرها بعمليات من مستوى أدنى. والأطروحة القوية التي يقدمها الاختزال الإبستيمولوجي تتلخص في أن هذه التفسيرات التي «تبدأ من التفاصلي الدقيقة وتنتهي بالمفاهيم العامة» يمكن دائماً التوصل إليها دون باق[7].
أي أنه في نهاية المطاف يمكن تفسر الكيمياء بالفيزياء وتفسير الكيمياء الحيوية بالكيمياء، والأحياء بالكيمياء الحيوية، وعلم النفس بالأحياء، وعلم الاجتماع بعلوم المخ Brain Science، واللاهوت بعلم الاجتماع. وقد عبر عن ذلك “فرانسيس كريك” Francis Crick عالم الأحياء الجزيئية الحائز على جائزة نوبل بقوله: «الهدف النهائي من التطور الحديث لعلم الأحياء هو في الواقع تفسير علم الأحياء كله بالفيزياء والكيمياء.»
ويتفق “ريتشارد دوكينز” مع هذه النظرة إذ يقول: «مهمتي أن أفسر الأفيال وعالم الأشياء المعقدة بالأشياء البسيطة التي يفهمها الفيزيائيون أو ما زالوا يحاولون فهمها.» ولو نحينا مؤقتاً هذا الادعاء الذي يشوبه كثير من الشك عن بساطة الفيزياء (خذ مثلاً ميكانيكا الكم، أو الكهروديناميكا الكمية، أو نظرية الأوتار)، ولكننا سنعود إليه لاحقاً، لاكتشفنا أن الهدف النهائي من هذا الاختزال هو في الواقع اختزال السلوك البشري كله (ما نحب وما نكره، وخريطة حياتنا العقلية بأكملها) إلى فيزياء.
وعادة ما يسمى هذا الموقف “النزعة الفيزيائية” “Physicalism“، وهو من أقوى أشكال الفلسفة المادية Materialism. إلا أن هذه النظرة لا تحظى بتأييد شامل، وذلك لأسباب وجيهة جداً، كما أشار “كارل بوبر” Karl Popper: «في كل الأحوال تقريباُ يتبقى جزء معلق لا يمكن تبسيطه حتى في أنجح محاولات الاختزال.»
ويشرح لنا العالم والفيلسوف “مايكل بولاني” Michael Polanyi لماذا يستحيل منطقياً على الاختزال المعرفي أن ينجح في كل الحالات. فهو يطلب منا أن نفكر في مختلف مستويات عملية بناء مبنى إداري بالطوب. أول خطوة هي استخلاص المواد الخام التي يصنع منها الطوب. ثم تأتي المستويات الأعلى المتتالية من صنع الطوب، لأنه لا يصنع نفسه، يلي ذلك رص الطوب، لأن قوالب الطوب لا “تجمع نفسها”، وعملية تصميم المبنى، لأنه لا يصمم نفسه، وتخطيط المدينة التي يبنى فيها، لأنها لا تنظلم نفسها. ولكن مستوى قواعده الخاصة.
فقوانين الفيزياء والكيمياء تحكم المادة الخام التي يصنع منها الطوب، أما التكنولوجيا تزودنا بفن صنع الطوب، والعمال المسؤولون عن رص الطوب يرصونه حسب إرشادات المهندس المقاول، والهندسة المعمارية تعلم المهندس، والمهندس المعمار محكوم بعمل المتخصصين في تخطيط المدن. أي أن كل مستوى محكوم بالمستوى الأعلى منه. ولكن العكس ليس صحيحاً. فقوانين المستوى الأعلى لا يمكن أن تشتق من قوانين مستوى أدنى، وإن كان ما يتم عمله على مستوى أعلى يعتمد طبعاً على المستويات الأدنى. فمثلاً لو لم تكن قوالب الطوب قوية، سيحد ذلك من ارتفاع المبنى الذي يتحمله الطوب.
أو خذ مثالاً آخر بين يديك الآن. فكر في الصفحة التي تقرأها في هذه اللحظة. إنها تتكون من ورق مطبوع بالحبر (أو قد تكون سلسلة من النقاط على شاشة كمبيوتر أمامك). من الواضح طبعاً أن فيزياء وكيماء الحبر والورق (أو نقاط الصورة pixels على شاشة الكمبيوتر) يستحيل، ولو من حيث المبدأ، أن تخبرك بأي شيء عن دلالات أشكال الحروف المرسومة على الصفحة، وليس السبب إطلاقاً أن علوم الفيزياء والكيمياء لم تبلغ من التقدم ما يتيح لها التعامل مع هذه المسألة.
فحتى لو تركنا لهذه العلوم 1000 سنة أخرى للنمو لن يغير ذلك من الأمر شيئاً، لأن أشكال هذه الحروف تتطلب تفسيراً جديداً من مستوى أعلى يختلف تماماً عن التفسيرات التي يمكن للفيزياء والكيمياء تقديمها. وذلك لأن التفسير الكامل لا يمكن التوصل إليه إلا بمفاهيم ذات مستوى أعلى تختص باللغة والكتابة وتوصيل الشخص لرسالته. أما الحبر والورق ليست سوى موصلات للرسالة، ولكن المؤكد أن الرسالة لا تنشأ منها تلقائياً. وعندما نأتي للغة نفسها نجد أيضاً سلسلة من المستويات، وحيث لا يمكنك اشتقاق المفردات من علم الصوتيات، أو اشتقاق قواعد اللغة من مفرداتها، وهكذا.
وكما نعرف جيداً، المادة الوراثية DNA تحمل المعلومات. وسنشرح ذلك لاحقاً بشيء من التفصيل. ولكن الفكرة الرئيسية أن هذه المادة الوراثية يمكن أن نتخيلها شريطاً طويلاً عليه سلسلة من الحروف المكتوبة بلغة كيميائية تتكون من أربعة حروف. وتحتوي سلسلة الحروف على تعليمات (معلومات) مشفرة تستخدمها الخلية لصنع البروتينات. ولكن ترتيب السلسلة لا ينتج من كيمياء الحروف الأولية.
وهكذا نرى أنه في كل من الحالات سالفة الذكر توجد سلسلة من المستويات، كل منها أعلى من سابقة. وما يحدث على مستوى أعلى لا يشتق كلية مما يحدث على المستوى الأدنى منه. وفي هذه الحالة يقال أحياناً إن ظواهر المستوى الأعلى “تنبثق” “Emerge” من المستوى الأدنى.
ولكن للأسف كلمة “تنبثق” يساء فهمها بسهولة، بل يساء استخدامها على نحو مضلل بحيث تعني أن خصائص المستوى الأعلى تنشأ تلقائياً من خصائص المستوى الأدنى دون أي مدخلات إضافية من المعلومات أو التنظيم، تماماً كما تنشأ خصائص المستوى الأعلى من الماء من خلط الأكسجين والهيدروجين. إلا أن هذا الفكر خاطئ عموماً كما أوضحنا فيما سبق بمثالي عملية البناء والكتابة على الورق. فالمبنى لا ينبثق من قوالب الطوب ولا تنبثق الكتابة من الورق والحبر دون ضخ كمية من الطاقة والذكاء.
وتنطبق الحجة نفسها على تشبيه الانبثاق الذي اقترحه “دوكينز” في محاضرة عامة ألقاها في جامعة أكسفورد (20 كانون الثاني/ يناير 1999) عندما قال إن إمكانية معالجة الكلمات بالكمبيوتر هي خاصية “منبثة” من الكمبيوتر. وهذا صحيح، ولكن هذه الخاصية لا تكون ممكنة إلا بإدخال كميات ضخمة من المعلومات المتضمنة في حزمة برامج مصممة بذكاء، مثل Microsoft Word.
وقد كتب “آرثر بيكوك” Arthur Peacocke اللاهوتي والعالم البريطاني: «يستحيل التعبير عن مفهوم “المعلومات”، مفهوم نقل الرسائل، بمفاهيم الفيزياء والكيمياء، حتى وإن كانت الأخيرة تفسر الكيفية التي تعمل بها الآلة الجزيئية (Molecular Machinery DNA، وRNA، والبروتين) لحمل المعلومات….»
إلا أنه رغم الكتابة على الورق، وبرامج الكمبيوتر، والـ DNA تشترك في أنها تشفر “رسالة” فأولئك العلماء المتمسكون بالفلسفة المادية يصرون على أن الخصائص الحاملة للمعلومات في الـ DNA لا بد أنها انبثقت أخيراً بشكل تلقائي من المادة بعملية غير موجهة عديمة العقل. ودافعهم نحو هذا الإصرار واضح.
فإن كان لا يوجد شيء سوى المادة والطاقة قدرة كامنة تمكنهما من تنظيم نفسها بما يؤدي لانبثاق كافة الجزيئات المعقدة اللازمة للحياة بما فيها الـ DNA وبناء على هذه الفرضيات المادية، تنتفي أي احتمالات أخرى. أما السؤال عما إذا كان هناك دليل على أن المادة والطاقة تتمتعان فعلياً بهذه القدرة “الانبثاقية” فهو موضوع مختلف تماماً سنناقشه بالتفصيل لاحقاً.
والآن نأتي إلى النوع الثالث من الاختزالية، ألا وهو الاختزالية الأنطولوجية التي تعد وثيقة الصلة بالاختزالية الإبستيمولوجية. ويقدم “ريتشارد دوكينز” مثالاً كلاسيكياً على هذا النوع من الاختزال: «الكون ليس إلا مجموعة من الذرات المتحركة، والبشر ليسوا سوى ماكينات لإنتاج الـ DNA، وإنتاج الـ DNA عملية ذاتية الاستدامة. وهو السبب الوحيد في حياة كل شيء حي.»
إن تعبيرات “ليس إلا”، أو “الوحيد” أو “ليسوا سوى” هي العلامة المميزة لفكر الاختزال الأنطولوجي. فإن حذفنا هذه الكلمات عادة ما تتبقى عندنا عبارة لا اعتراض عليها. فلا شك أن الكون مجموعة من الذرات، والبشر بالفعل ينتجون الـ DNA. وهما جملتان علميتان. ولكن ما أن نضيف عبارات مثل “ليس إلا” حتى تتجاوز العبارات حدود العلم وتصبح تعبيرات عن معتقد مادية أو طبيعي.
والسؤال: هل تبقى العبارات صحيحة قد إضافة تلك الكلمات الكاشفة؟ هل هذا هو كل الكون والحياة فعلاً؟ هل سنقول مع “فرانسيس كريك”: «أنت، بأفراحك وأحزانك، وذكرياتك وطموحاتك، وشعورك بالهوية الشخصية والإرادة الحرة، لست في الواقع أكثر من سلوك مجموعة ضخمة من الخلايا العصبية وجزيئاتها»؟
كيف سنرى إذن المشاعر البشرية من الحب والخوف؟ هل هي أنماط سلوكية عصبية بلا معنى؟ وماذا نفعل بمفاهيم الجمال أو الحق؟ هل لوحة للفنان “رمبرانت” Rembrandt ما هي إلا جزيئات من الألوان مبعثرة على القماش؟ يبدو أن “كريك” يراها هكذا.
وهذا ما يدعونا للتساؤل عن الوسيلة التي تمكنا من إدراكها. فإن كان مفهوم الحق نفسه ينتج عن مجرد “سلوك مجموعة ضخمة من الخلايا العصبية»، فكيف نعرف منطقياً أن مخ الإنسان مكون من خلايا عصبية؟ كما أشار “فرزر واتس” Fraser Watts قائلاً إن “كريك” نفسه يبدو أنه يدرك ضرورة وجود مستوى أعمق لأنه أدخل تعديلاً جذرياً على فرضيته “المدهشة” وعمد إلى تخفيفها بعبارة لا تثير أي جدل عندما قال «أنت في معظمك عبارة عن سلوك عدد ضخم من الخلايا العصبية.»
إلا أن هذه الفرضية المعدلة لم تعد مدهشة. فكر فيها. بل حتى لو كانت الفرضية المدهشة حقيقية، فكيف لها أن تدهشنا؟ لأنه كيف يمكننا أن نعرفها أو نفهمها؟ وعندئذ نسأل ما معنى “الدهشة”؟ فالفكرة تنطوي على تناقض داخلي.
وتعد هذه الحجج امتدادات لما عرف باسم “شك داروين” Darwin’s Doubt: «الشك المقيت الذي يراودني دائماً هو ما إذا كان العقل البشري الذي تطور من عقل حيوانات أدنى يمكن لقناعاته أن تحمل أي قيمة أو مصداقية.»
ويعتبر أقوى نقد للاختزالية الأنطولوجية هو أنها تدمر نفسها مثل المذهب العلمي. حتى إن “جون بولكينجهورن” John Polkinghorne يصف مجمل الأفكار التي تشكلها بأنها «انتحارية في نهاية الأمر. فإن كانت أطروحة “كريك” صحيحة، إذن يستحيل أن نعرفها. وذلك لأنها تحط من قدر خبرتنا بالجمال والواجب الأخلاقي واللقاءات الروحية وتعتبرها منتجاً ثانوياً بلا قيمة. ولا تكتفي بذلك، بل إنها تدمر العقلانية لأنها تستبدل الفكر بأحداث عصبية كهروكيميائية.
وهما حدثان لا يمكن أن يواجها بعضهما البعض في حديث عقلاني. فهما ليسا صحيحين ولا خاطئين. ولكنهما يحدثان فحسب… ومزاعم الاختزالي نفسه تصبح مجرد إشارات في الشبكة العصبية لمخه. وعالم الحديث العقلاني يتلاشى إلى ثرثرة عبثية من عمل التشابكات العصبية التي تنطلق عندما تتلقى مثيراً ما. والحقيقة أن هذا الكلام يستحيل أن يكون صحيحاً وليس منا من يعتقد فيه.»
وللدقة نقول إن كل المحاولات تناقض ذاتها مناقضة صريحة، مهما بدت أنيقة، من حيث أنها تشتق العقلانية من اللاعقلانية. وعندما نعريها تماماً تبدو محاولات عقيمة عجيبة كمن يحاول أن يرفع نفسه برباط حذائه. أو يصنع ماكينة تدور بلا توقف. فرغم كل ما يدعون، استخدام العقل البشري هو نفسه الذي ساهم على تبني الاختزالية الأنطولوجية التي تحمل معها الاستنتاج القائل بأنه لا مبرر للثقة فيما تقوله عقولنا، إلا إذا كانت تقول لنا إن الاختزالية صحيحة.
[1] يعرف “قاموس أكسفورد” “الذرية” atomism بأنها منهج نظري يرى أنه يمكن تفسير الشيء بتحليله إلى مكونات ابتدائية متمايزة ومنفصلة ومستقلة. وهي عكس الشمولية holism. (المترجم)
[2] يعرف “قاموس أكسفورد” “الخوارزمية” Algorithm بأنها مجموعة من الخطوات أو القواعد التي تتبع في الحسابات أو غيرها من عمليات حل المشكلات، ويستخدمها الكمبيوتر بوجه خاص. (المترجم).
[3] هذه هي الكلمة الألمانية لمصطلح Decision Problem وهي تطرح هذا السؤال: هل توجد خوارزمية Algorithm تقرر ما إذا كان طرح رياضي Mathematical Assertion محدد له برهان أم لا؟ (http://mathworld.wolfram.com/DecesionProblem.html)، تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/1/ 2016 (المترجم)
[4] المقصود بالاختزالية هنا تحويل المعارف والمعلومات التفصيلية الدقيقة إلى قانون عام يفسر كل شيء، وهو نفس ما سعى إليه “ستيفن هوكنج” في محاولته للوصول إلى نظرية واحدة تفسر كل شيء. (المحرر)
[5] يعرف قاموس ويسهر Webster’s Dictionary الإبستيمولوجي Epistemology بأنه أحد مباحث الفلسفة الذي يدرس طبيعة المعرفة البشرية وأساليبها وحدودها وصحتها دراسة نقدية. (المترجم)
[6] الأنطولوجي Ontology (علم الوجود) هو المبحث الفلسفي الذي يدرس الوجود بذاته، الوجود بما هو موجود مستقلاً عن أشكاله الخاصة، ويعنى بالأمور العامة التي لا تخص بقصم من أقسام الوجود ) تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/6/2015 (المترجم)
[7] كما في عمليات القسمة الحسابية التي يكون فيها الناتج دون باق. (المترجم)


