نطاق العلم وحدوده – جون ليونكس
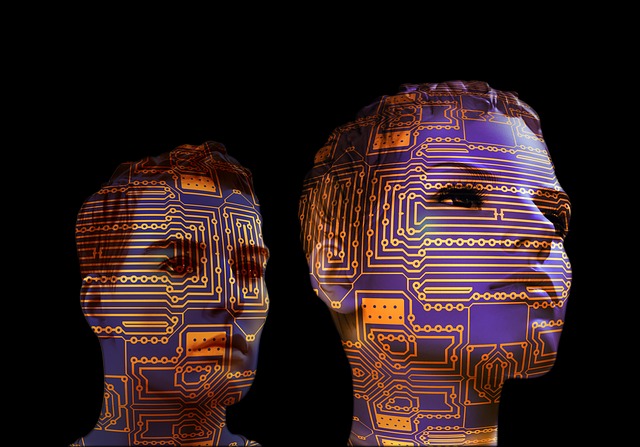
العلم ووجود الله – نطاق العلم وحدوده – جون ليونكس
«كل ما يمكن التوصل إليه من معرفة
لا بد أن نتوصل إليه بطرق علمية،
وما لا يمكن للعلم اكتشافه
لا يمكن للبشرية أن تعرفه.»
“برتراند رسل” Bertrand Russell
«إلا أن محدودية العلم تتضح في عجزه عن إجابة الأسئلة
البدائية الطفولية التي تتعلق بالأشياء الأولى والأخيرة،
مثل: “كيف بدأ كل شيء؟”
“ما غرض وجودنا؟”
ما مغزى الحياة؟”.»
السير “بيتر مداوار” Peter Medawar
إقرأ أيضًا:
العلم ووجود الله – صراع بين منظورين فلسفيين – جون ليونكس
العلم ووجود الله – الاختزال الاختزال الاختزال – جون ليونكس
الصبغة العالمية للعلم:
أياً كان ما يميز العلم، فالمؤكد أنه عالمي. وما يميز الكثير من العلماء، بمن فيهم مؤلف هذا الكتاب، أننا ننتمي لمجتمع عالمي بحق يتجاوز الحدود بكافة أنواعها: الجنس، والمنظومة الفكرية، والدين، والقناعات السياسية، والعديد من العوامل الأخرى التي تفرق الناس عن بعضهم. فكل هذه الاعتبارات تنسى عندما نحاول معاً أن ندرك أسرار الرياضيات، أو نفهم ميكانيكا الكم، أو نحارب مرضاً فتاكاً، أو نستكشف خواص المواد الغريبة، أو نصيغ نظريات عن تركيب النجوم الداخلي، أو نتوصل لأساليب جديدة لتوليد الطاقة، أو ندرس علم البروتينات Proteomics المعقد.
ونظراً لحرص العلماء على الاحتفاظ بعالمية مجتمعهم الذي يتمتع بحرية العمل العلمي دون تدخلات خارجية قد تفرق بين أعضائه، فهم يشعرون بالقلق عندما تطل الميتافيزيقا[1] برأسها مهددة بالتدخل في عملهم، وهو قلق مفهوم. بل إن الأسوأ عندما تظهر قضية الله. ولا شك أنه إن كان هناك مجال يمكن (ويجب) أن يظل محايداً من الناحية الدينية واللاهوتية، فهذا المجال هو العلم. وهو كذلك في الأغلب.
والواقع أن مساحات شاسعة في العلوم الطبيعية، بل ربما العناصر الرئيسية فيها تتمتع بهذا الحياد. ففي كل الأحوال، طبيعة العناصر، والجدول الدوري، وقيم الثوابت الأساسية في الطبيعة، وبنية الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين المعروف باسم DNA، ودورة كريز Kerbs Cycle وقوانين نيوتن، ومعادلة أينشتين، وغير ذلك لا علاقة له بالميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة. ألا ينطبق ذلك على العلم كله؟
تعريف العلم:
وهذا يأتي بنا ثانية إلى سؤالنا: ما هو العلم؟ على عكس الانطباع الشائع، ليس هناك منهج علمي واحد متفق عليه، إلا أن بعض العناصر دائماً ما تظهر فجأة في محاولة لوصف ما يشتمل عليه النشاط “العلمي”: فرضية، تجربة، بيانات، أدلة، فرضية معدلة، نظرية، تنبؤ، تفسير، وهكذا. ولكن وضع تعريف دقيق هو عملية بعيدة المنال. ويمكن أن نأخذ محاولة “مايكل روس” Michael Ruse مثالاً على ذلك. يرى “روس” أن العلم «بطبيعته لا يتعامل إلا مع الطبيعي، القابل للتكرار، المحكوم بقانون.»
ومن الناحية الإيجابية يتيح لنا هذا التعريف بكل تأكيد أن نميز بين علم الفلك والتنجيم. إلا أن نقطة الضعف الأكثر وضوحاً في هذا التعريف أنه يستبعد معظم علم الكونيات المعاصر من نطاق العلم. فالنموذج المعروف لنشأة الكون يصف أحداثاً فريدة من نوعها لأن نشأة الكون لا يمكن تكرارها (بسهولة) ويحق لعلماء الكونيات أن يتضايقوا عندما يسمعون أن عملهم لا يرقى إلى مستوى العلم.
علاوة على ذلك هناك طريقة أخرى لفحص الأشياء وتمثل جزءًا أساسياً في منهجية العلم المعاصر، ألا وهو طريقة «الاستدلال القائم على أفضل التفسيرات» Inference to the best explanation (أو الاستدلال الاحتمالي abduction كما يطلق عليه أحياناً). ففي حالة الأحداث المتكررة نحن نثق أن تفسيراتنا لها هي أفضل التفسيرات لأنها تحمل قدرة تنبؤية، ولكن في حالة الأحداث غير المتكررة، ما زال يمكننا أن نسأل: ما أفضل تفسير لهذا الحدث أو هذه الظاهرة؟ والفكرة من ورائها هي: إن وجدت (س)، إذن يحتمل أن توجد (ص). فنلاحظ (ص)، فتصبح (س) تفسيراً محتملاً للظاهرة (ص). أما تعريف “روس” يغفل عن هذه النقطة.
ومع ذلك، فهذا التعريف القاصر يؤدي غرضاً مفيداً من حيث إنه يذكرنا أن فروع العلم لا تتساوى في قوة مرجعيتها. فالنظرية العلمية التي تقوم على الملاحظة المتكررة والتجريب غالباً، بل يجب أن، تتمتع بمصداقية أكبر مما تتمتع به النظرية التي لا تنطبق عليها هذه المواصفات. وعدم إدراكنا لهذا الفارق يجعلنا نمنح الأخيرة نفس ما نمنحه للأولى من مصداقية مرجعية، وهو ما سوف نعود إليه لاحقاً.
ولكن علينا أن نلاحظ أن نموذج العالم كما يرسمه عصر التنوير[2] Enlightenment هو ذلك الرجل العقلاني الذي يلاحظ الظواهر بهدوء وسكينة، في استقلال تام، وتحرر من كل النظريات المسبقة، متجاوزاً الاعتبارات الفلسفية والأخلاقية والدينية، ويقوم باستكشافاته ثم يخرج بخلاصات موضوعية لا يشوبها أي تحيز تعبر عن الحق المطلق. ولكن ما يزيد الأمور تعقيداً، أن هذا النموذج يعتبره فلاسفة العلم الجادون (ومعظم العلماء حالياً) خرافة ساذجة. فالعلماء، مثل باقي البشر لديهم أفكار مسبقة، وفلسفات حياتية تؤثر في كل ما يواجهونه من مواقف. وهو ما يتضح في بعض العبارات التي ناقشناها فيما سبق. بل إن الملاحظات نفسها لا تملك إلا أن تكون «متأثرة بالنظريات»، فلا يمكننا مثلاً أن نقيس درجة الحرارة إلا إذا كانت هناك نظرية عن الحرارة.
وإن دخلنا إلى مستوى أعمق في مجال سلوك الجسيم الأولي Elementary particle، نجد أن علماء الفيزياء اكتشفوا أن عملية الملاحظة عينها تثير إشكاليات لا يمكن تجاهلها. فمثلاً “فرنر هايزنبوج” Werner Heisenberg الحائز على جائزة نوبل يستنتج أن «القوانين الطبيعية التي صيغت رياضياً في نظرية الكم لم تعد تتعامل مع الجسيمات الأولية نفسها بل مع معرفتنا عنها.»
هذا بالإضافة إلى المناقشات العنيفة التي تدور حالياً حول ما إذا كان العلم يقوم على الملاحظة والتنبؤ أم يقوم على تحديد المشكلة والتفسير. وعندما ننتهي إلى صياغة نظرياتنا، تأتي البيانات لتثير حولها تساؤلات جديدة: فمثلاً يمكن رسم عدد لا نهائي من الأقواس باستخدام عدد محدد من النقاط. لذلك فالعلم بطبيعته مبدئي ومتغير بنسبة ما.
إلا أننا هنا لا بد أن ننوه سريعاً أن هذا لا يعني مطلقاً أن العلم هو بنية اجتماعية اعتباطية ذاتية تتأثر بميول أصحابها، كما يرى بعض مفكري ما بعد الحداثة[3] Postmodern. ولكن من الإنصاف أن نقول إن الكثير من العلماء، إن لم يكن معظمهم، «واقعيون نقديون» يؤمنون بوجود عالم موضوعي يمكن دراسته ويؤمنون أنه حتى إن كانت نظرياتهم لا ترقى إلى مرتبة “الحق” بالمعنى النهائي أو المطلق، إلا أنها تزيد من قدرتهم على إدراك الواقع كما يتضح مثلاً في تطور فهمنا للكون من جاليليو إلى نيوتن إلى أينشتين.
ولكن لنرجع إلى “روس” وتعريفه للعلم لأن هناك المزيد مما يمكن أن يقال في هذا الصدد. ماذا يعني قوله إن العلم لا يتعامل إلى مع “الطبيعي”؟ لا بد أنه يعني على أقل تقدير أن الأشياء التي يدرسها العلم هي الأشياء التي توجد في الطبيعة. ولكنه قد يعنى أيضاً أن التفسيرات التي تعطى لهذه الأشياء لا يمكن اعتبارها علمية إلا إذا صيغت بمصطلحات الفيزياء والكيماء والعمليات الطبيعية. ولا شك أن هذه نظرة متفق عليها.
فمثلاً “ماسيمو بيجلوتشي” Massimo Pigliucci أستاذ علم البيئة والتطور يقول إن «فرضية العلم الأساسية هي أن العالم يمكن تفسيره كاملاً بمصطلحات فيزيائية دون اللجوء إلى أي كيانات فائقة.» ويكتب “كريستيان دو دوف» Christian de Duve الحائز على جائزة نوبل رأياً مشابهاً إذ يقول: «البحث العلمي يرتكز على فكرة مفادها أن كل ما نراه في الكون يمكن تفسيره بمصطلحات طبيعية، دون أي تدخل خارق للطبيعة. وهذه الفكرة ليست موقفاً فلسفياً بديهياً ولا اعتراف بعقيدة.
ولكنها افتراض Postulate، أي فرضية مبدئية ليست نهائية أن تامة Working Hypothesis يجب أن نكون مستعدين للتخلي عنها لو واجهتها حقائق تتحدى كل محاولات التفسير المنطقي. إلا أن الكثير من العلماء لا يشغلون أنفسهم بهذا الفارق، فيتعاملون ضمناً مع الفرضية على أنها حقيقة مؤكدة. وهم سعداء جداً بما يقدمه العلم من تفسيرات. وهم في ذلك مثل “لابلاس” Laplace لا يحتاجون إلى “فرضية الله” ويعتبرون الموقف العلمي موقفاً لا أدرياً، إن لم يكن موقفاً إلحادياً صريحاً.»
وهذا اعتراف صريح أن العلم عند الكثيرين لا ينفصل فعلياً عن موقف ميتافيزيقي لا أدري أو إلحادي يصر أصحابه على التمسك به. وقد لاحظنا أن ينطوي على فكرة خفية مفادها أن «أي تدخل فائق للطبيعة» يعني «تحدي كل محاولات التفسير المنطقي.» أي أن “فوق طبيعي” مرادف لما هو “غير منطقي”.
ومن تعمق منا في دراسة الفكر اللاهوتي الجاد يرى أن هذه الفكرة خاطئة وأن الاعتقاد بوجود إله خالق فكرة منطقية. أما اعتبار “التفسير المنطقي” مرادف “التفسير الطبيعي” فهو موقف يعبر في أحسن حالاته عن تحيز مسبق، وفي أسوأ الحالات يعكس خطأ تصنيفياً[4] Category Mistake.
والكثير من العلماء يتفقون مع “دو دوف” في رأيه. وهو ما عبر عنه القاضي “جونز” Jones في الدعوى التي رفعها “كيتسميلر” وآخرون على منطقة “دوفر” التعليمية Kitzmiller et al. vs. Dover Area School District سنة 2005 عندما قرر أن «التصميم الذكي» موقف ديني وليس موقاً علمياً، وقد قال صراحة: «شهادة الخبراء تكشف أنه منذ الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أصبح العلم مقتصراً على البحث عن الأسباب الطبيعية لشرح الظواهر الطبيعية…
ورغم أن التفسيرات الفائقة للطبيعة لها أهميتها وقيمتها، فهي لا تمثل جزءًا من العلم… وهذا العرف الذي يفرضه العلم على نفسه الذي يحصر البحث في التفسيرات الطبيعية للعالم الطبيعي التي يمكن إخضاعها للاختبار يشير إليه الفلاسفة باسم «المذهب الطبيعي المنهجي» “Methodological naturalism” ويعرف أحياناً باسم المنهج العملي Scientific method… والمذهب الطبيعي المنهجي هو “قاعدة أساسية” في العلم اليوم تتطلب من العلماء أن يبحثوا عن تفسيرات في العالم المحيط بنا تقوم على ما يمكننا ملاحظته، واختباره، وتكراراه، والتحقق منه.»
والفيلسوف “بول كرتس” Paul Kurtz يعبر عن رأي مشابه إذ يقول إن «العنصر المشترك بين كافة أشكال الفلسفة الطبيعية هو التزامها بالعلم. وبذلك، يمكن تعريف الفلسفة الطبيعية بمعناها الأشمل على أنها التعميمات الفلسفية لما تستخدمه العلوم من منهجيات وتتوصل إليه من استنتاجات.»
والآن يمكننا أن ندرك سر جاذبية هذا الأسلوب. فهو أولاً يميز تمييزاً واضحاً بين العلم الأصيل والخرافة، أي بين علم الفلك والتنجيم مثلاً، أو علم الكيمياء والسيمياء. وهو يمنعنا أيضاً من الارتكان إلى فكرة «إله الفجوات» «God of the gaps» التي تقول «إن كنت لا أفهم هذا الشيء، إذن هو من صنع الله أو الآلهة.»
إلا أن هذا الرأي يشوبه على الأقل عيب واحد خطير، ألا وهو أن هذا الارتباط الوثيق بين العلم والفلسفة الطبيعية من شأنه أن يؤدي إلى الاستخفاف بأي بيانات أو ظواهر أو تفسيرات لا تلائم قالب الفلسفة الطبيعية، بل قد يؤدي إلى مقاومتها مقاومة مستميتة. وبالطبع يعتبر هذا عيباً إن اعتبرنا الفلسفة الطبيعية خاطئة. ولكنها إن كانت صحيحة، فلن يكون لهذه المشكلة وجود أبداً حتى لو كان التفسير الطبيعي لظاهرة ما يستغرق سنين طويلة حتى يتم اكتشافه.
أيهما أسبق، العلم أم الفلسفة؟
يعرف “كرتس” المذهب الطبيعي بأنه فلسفة تنشأ من العلوم الطبيعية. أي أن العالم يدرس الكون أولاً، ويضع نظرياته، وبعدئذ يرى أنها تتطلب فلسفة طبيعية أو مادية.
إلا أنه كما أشرنا آنفاً، صورة «الصفحة البيضاء» العلمية التي تعكس عقلاً منفتحاً عن آخره ومجرداً من أي معتقدات فلسفية مسبقة في دراسته للعالم الطبيعي هي صورة مضللة جداً. لأن ما يحدث فعلياً قد يكون على النقيض مما يراه “كرتس”؛ فمثلاً عالم المناعة “جورج كلاين” George Klein يصرح بوضوح أن إلحاده لا يقوم على العلم، ولكنه التزام إيماني يقوم على فرضية بديهية.
وقد كتب في تعليق على خطاب من صديق له وصفه فيه بأنه لاأدري: «أنا لست لاأدرياً. أنا ملحد. وموقفي لا يقوم على العلم، بل على الإيمان…. فغياب الخالق وعدم وجود الله هو إيمان طفولتي وعقيدة رشدي، وهو موقف راسخ مقدس.»
ونلمح هنا إلى أن الفكرة التي يؤمن بها “كلاين”، ويشاركه فيها “دوكينز”، تتلخص في أن الإيمان والعلم متضادان، وهي فكرة نعترض عليها بشدة.
ويتبنى هذه الفكرة أيضاً “ريتشارد ليونتن” Richard Lewontin عالم الوراثة في “جامعة هارفارد” Harvard University إذ يقول صراحة في تعليقه على آخر كتب “كارل ساجان” إن قناعاته المادية تقوم على فرضية بديهية. وهو يعترف أن فلسفته المادية لا تنبثق من العلم، بل على العكس، فماديته هي التي تحدد طبيعة فهمه للعلم، وهو واع بهذه العملية: «استعدادنا لقبول المزاعم العلمية التي تخالف الحس السليم هو مفتاح فهم الصراع الحقيقي بين العلم وما هو فائق للطبيعي.
إننا نأخذ صف العلم رغم ما يشوب بعض أفكاره من عبث بيّن… رغم تسامح المجتمع العلمي مع القصص التي تقبل كما هي دون دليل لأننا ملتزمون مسبقاً… بالفلسفة المادية. فمناهج العلم ومؤسساته لا تجبرنا على قبول تفسير مادي للعالم الظاهر، بل بالعكس، التزامنا البديهي بالقضايا المادية يجبرنا على خلق أداة للبحث ومجموعة من المفاهيم تنتج تفسيرات مادية، مهما كانت مناقضة للحدس، ومهما بدت غامضة لضعيف المعرفة.»
ورغم ما تثيره هذه العبارة من دهشة، فهي في منتهى الصدق. وهي عكس موقف “كرتس.”
فبهذا التصريح يقول “ليونتن” بوجود صراع بين «العلم وما هو فوق طبيعي»، ولكنه يناقض نفسه فيعترف أن العلم لا يحمل أي إجبار في ذاته يفرض علينا الفلسفة المادية. وهو ما يؤيد قناعتنا بأن المعركة الحقيقية ليس فعلياً بين العلم والإيمان بالله، بل بين منظور فلسفي مادي (أو بشكل أشمل منظور فلسفي طبيعي) ومنظور فلسفي فائق للطبيعي يرتكز على الإيمان بالله الخالق.
فعلى أي حال إيمان “ليونتن” بالمادية لا يتأسس على العلم الذي يشتغل به، كما اعترف هو شخصياً، بل على شيء مختلف تماماً، كما يتضح فيما يقوله بعدئذ: «أضف إلى ما سبق قولنا بأن تلك المادية التي أومن بها لها صفة “المطلق”، ومن ثم لا نستطيع السماح بمطلق آخر – كالإله مثلاً – أن يدخل من الباب ليزاحمها أو يتجاور معها.»
ولست أدري إن كان “دوكينز” متحمساً لهدم هذا النوع من «الإيمان الأعمى» بالمادية قدر حماسه لهدم الإيمان بالله، رغم أن مبدأ الاتساق يحتم عليه ذلك. وما الذي يجعلنا «لا نستطيع أن نسمح بدخول السماح بمطلق آخر – كالإله مثلاً – أن يدخل من الباب»؟ فإن كان العلم كما يقول “ليونتن” لا يجبرنا على الإيمان بالمادية، فتعبير «لا نستطيع» لا يشير طبعاً إلى العلم باعتباره عاجزاً عن التدليل على أي تدخل إلهي.
ولكنه لا بد أن يعنى «أننا نحن الماديين لا نستطيع أن نسمح لأي عنصر إلهي بالدخول من الباب.» ولكننا لسنا في حاجة إلى أن نقول إن «الماديين لا يستطيعون أن يسمحوا لأي عنصر إلهي بالدخول من الباب.» وذلك، لأن المادية ترفض التدخل الإلهي، وترفض الباب نفسه. فالمادي لا يؤمن بأي شيء خارج الكون أصلاً، أي أنه «لا يوحد ولم يوجد ولن يوجد أي شيء سوى الكون.»
ولكن ذلك الموقف الرافض لا ينطوي في ذاته على أي أبعاد تشرح لنا وجود أو عدم وجود مثل هذا التدخل أو هذا الباب أكثر مما صرح به “ليونتن” بأنه لا يؤمن شخصياً بأي منهما، وهو تصريح بلا دليل. فلو صمم طبيب عن عمد جهازاً يكشف الإشعاع في المدى المنظور فقط، فمهما كانت فائدة هذا الجهاز، فمن العبث أن يستخدمه ليُنْكر وجود الأشعة السينية مثلاً التي لا يمكن لهذا الجهاز أن يكتشفها بسبب طبيعة تركيبه.
وهكذا من الخطأ أن ننكر أن العلماء الماديين أو الطبيعيين يمكنهم أن ينتجوا علماً جيداً، ومن الخطأ أيضاً أن ننكر أن المؤمنين بالله يمكنهم أن ينتجوا علماً جيداً. والأكثر من ذلك، حتى لا نفقد قدرتنا على رؤية الأشياء في حجمها الطبيعي، علينا أن نأخذ في اعتبارنا عموماً أن العلم الذي يتم بناء على افتراضات مسبقة إلحادية يسفر عن نفس النتائج التي يسفر عنها العلم الذي يتم بناء على افتراضات مسبقة تقوم على الإيمان بالله.
فمثلاً عندما يحاول أحد العلماء عملياً اكتشاف كيفية قيام كائن ما بوظائفه، لا يهم ما إذا كان العالم يفترض أن هذا الكائن يقوم بوظائفه وفقاً لتصميم حقيقي، أم أنه مجرد مظهر لتصميم، دون تصميم فعلي. ففي هذه الحالة، سواء استندنا إلى فرضية «المذهب الطبيعي المنهجي» (يطلق عليها أحياناً «الإلحاد المنهجي») أو إلى ما قد نطلق عليه اصطلاح «الإيمان المنهجي بالله الخالق» «Methodological theism»، كلاهما سيؤدي إلى النتائج نفسها. وذلك لأن الكائن يعامل منهجياً في الحالتين باعتباره يخضع لتصميم.
وخطورة بعض المصطلحات مثل «الإلحاد المنهجي» أو «المذهب الطبيعي المنهجي» تكمن في كونها تبدو وكأنها تؤيد المنظور الإلحادي، وتنقل انطباعاً بأن الألحاد له علاقة بنجاح العلم، وهو ما قد يخالف الواقع تماماً. وحتى تتضح هذه الفكرة في ذهنك، تخيل ما قد يحدث لو استخدم مصطلح «الإيمان المنهجي بالله الخالق» في المؤلفات بدلاً من مصطلح «الإلحاد المنهجي.» ستتعالى الأصوات ضده على الفور من كل حدب وصوب بحجة أنه يترك انطباعاً بأن الإيمان بالله هو ما ساهم في نجاح العلم.
ومع ذلك نجد بعض العلماء المؤمنين بالله يصرون على تعريف العلم بمصطلحات طبيعية صريحة، وهو موقف متناقض. فمثلاً “إرنن ماكمولين” Ernan McMullin يكتب قائلاً: «… المذهب الطبيعي المنهجي لا يقيد دراستنا للطبيعة، ولكنه يحدد نوعية الدراسة التي ترقى إلى مرتبة العلم.
إلا أنه إن أراد أحد أن يتبع منهجاً آخر في دراسة الطبيعة، والمناهج كثيرة، لا يحق لمن يتبع المنهج الطبيعي أن يعترض عليه. ولكن على العلماء أن يسيروا في هذا الاتجاه، فمنهجية العلم لا علاقة لها بالادعاء القائل بأن حدثاً بعينه أو نوعاً معيناً من الأحداث يجب تفسيره مباشرة بناء على فعل الله الخلقي.»
إلا أنه هناك فارقاً بين كلام “ليونتن” وكلام “ماكمولين.” وهو أن “ليونتن” لن يسمح بأي تدخل إلهي، وانتهى الأمر. أما “ماكمولين” يقبل التدخل الإلهي ولكن العلم ليس لديه ما يقوله عنه. فهو يرى أن هناك طرائق أخرى لدراسة الطيبعة، ولكن لا يمكن اعتبارها مناهج علمية، وهكذا يمكن التعامل معها على أنها أقل من حيث قوتها المرجعية. وهنا نقترح أنه لا تعبير “المذهب الطبيعي المنهجي” ولا تعبير “الإيمان المنهجي بالله الخالق” له أي فائدة خاصة، ويفضل تجنب كليها.
إلا أن الامتناع عن استخدام مصطلحات معينة عديمة النفع قصة أخرى تختلف عن القناعات الفلسفية. فما لا يستطيع أي عالم أن يتجنبه هو ما يؤمن به شخصياً من قناعات فلسفية. وتلك القناعات، كما ذكرنا تواً، لا تلعب دوراً كبيراً، أو لا تلعب أي دور يذكر، عندما ندرس الكيفية التي تعمل بها الأشياء، ولكنها قد تلعب دوراً أساسياً عندما ندرس كيف أتت الأشياء إلى الوجود أصلاً، أو عندما ندرس الأشياء التي لها علاقة بفهمنا لأنفسنا باعتبارنا بشراً.
هل دائماً ما نقبل ما يشر إليه الدليل؟
حتى لا نصادر على المطلوب[5] ونعرف العلم بأنه أساساً فلسفة طبيعية تطبيقية، ومن ثم فرضية بديهية من الناحية الميتافيزيقية، فلنفترض أننا نفهمه باعتباره عملية استكشاف للنظام الطبيعي ووضع نظريات تشرحه بحيث نميز روح العلم الحقيقي ونقدرها. وروح العلم هي الرغبة في اتباع الدليل التجريبي حيثما يؤدي. والسؤال المحوري هنا: ماذا يحدث لو أن العمليات الاستكشافية في هذه المجالات بدأت تنتج أدلة تتعارض مع منظورنا الفلسفية، إن كان هذا الأمر وارد الحدوث أصلاً؟
وقد أجرى “كون” Kuhn دراسة شهيرة في هذا الصدد خلص منها إلى أن الصراعات تنشأ عندما يتعارض الدليل التجريبي مع الإطار العلمي المقبول، أو “النموذج” “Paradigm” العلمي المقبول كما أطلق عليه “كون” الذي يعمل وفقاً له معظم العلماء في مجال بعينه. ويعتبر رفض بعض رجال الكنيسة النظر في تلسكوب جاليليو مثالاً كلاسيكياً على ذلك النوع من الصراع.
فلم تكن لديهم الشجاعة الكافية لمواجهة ما ينطوي عليه الدليل المادي من أبعاد، لأنهم لم يحتملوا أن يكون النموذج الأرسطي المفضل لديهم نموذجاً خاطئاً. ولكن لا يمكن اتهام رجال الكنيسة وحدهم بمعاداة العلم. ففي بداية القرن العشرين مثلاً، تعرض علماء الوراثة أتباع نظرية “مندل” Mendel لاضطهاد الماركسيين الذي اعتبروا الأفكار المندلية بخصوص الوراثة لا تتماشى مع الفلسفة الماركسية، مما جعلهم يرفضون السماح لأتباع النظرية المندلية أن يسيروا حيثما يقودهم الدليل.
وهو ما حدث في الإطاحة بالنموذج الأرسطي، فالمعتقدات المترسخة قد تستلزم وقتاُ طويلاً حتى تتراكم الأدلة التي تؤيد نموذجاً جديداً يحل محل النموذج القائم. وذلك لأن أي نموذج علمي لا ينهار بالضرورة لحظة اكتشاف دليل مضاد له، وإن كان لا بد أن نشير هنا إلى أن تاريخ العلم يكشف النقاب عن بعض الأمثلة الجديرة بالذكر. فعندما اكتشف “رذرفورد” Rutherford نواة الذرة، رفض على الفور أحد مبادئ الفيزياء الكلاسيكية، مما خلق فوراً تحولاً في النموذج المعرفي Paradigm Shift. وفي مثال آخر، حل الـ DNA محل البروتين باعتباره المادة الجينية الأولية بين ليلة وضحاها، إن جاز التعبير.
إلا أنه في هذه الحالات لم تنطو هذه الاكتشافات على قضايا فلسفية عميقة غير مريحة. وفي هذا الصدد يقول “توماس ناجل” تعليقاً في محله: «لا شك أن الإرادة تسيطر على العقيدة، بل أحياناً ما تقهرها. وأوضح الأمثلة على ذلك نراها في مجالي السياسة والدين. ولكن العقل المقيد يبقى متخفياً تحت أقنعة فكرية بحتة، ومن أقوى دوافعه نحو قبول هذا القيد الخفي هو تعطشه للعقيدة في ذاتها.
ومن يعانون من هذه الحالة لا يحتملون أن يرجئوا تكوين رأي في موضوع يهمهم. وهم لا يغيرون آراءهم بسهولة إلا إذا وجودا بديلاً يمكنهم تبنيه بارتياح دون أن يسبب لهم توتراً، ولكنهم يكرهون أن يضطروا لتعليق رأيهم فترة من الزمن.»
إلا أنه لا يمكن دائماً تبني البدائل دون شعور بشيء من التوتر وخاصة في المسائل التي تتعرض فيها الفلسفات الحياتية للتهديد من جانب الأدلة المغايرة، حيث تحدث مقاومة شديدة قد تصل إلى حد العداء لأي شخص يريد أن يتبع الدليل حيثما يؤدي ويتطلب الأمر شخصاً قوياً يسبح ضد التيار ويتحمل ما قد يتعرض له من نقد لاذع من أقرانه. ومع ذلك، فبعض القامات الفكرية الشامخة تفعل ذلك بالضبط.
فقد كتب “أنتوني فلو” Anthony Flew: «لقد سارت حياتي كلها وفقاً لمبدأ سقراط معلم أفلاطون» عقب تحوله من الإلحاد إلى الإيمان بالله الخالق. وهو يقول أيضاً: «اتبع الدليل حيثما يقودك.» ولكن ماذا لو كان الناس لا يحبون ذلك؟ وهو يجيب عن ذلك قائلاً: «يا له من أمر محزن.»
ملخص ما نوقش حتى الآن:
يبدو إذن أن هناك طرفي نقيض علينا تجنبهما. الأول هو النظر إلى العلاقة بين العلم والدين باعتبارها مجرد صراع. والثاني هو النظر إلى العلم كله باعتباره محايداً من الناحية الفلسفية أو اللاهوتية. وكلمة “كله” مهمة في هذا السياق لأنه من السهل ألا نضع الأشياء في حجمها الطبيعي ونرى العلم كله تحت رحمة الفلسفة. ولكن أؤكد أن مساحات شاسعة من العلم ما زالت كما هي دون أن تتأثر بالاعتبارات الفلسفية. ولكن ليس كل المجالات العلمية هكذا، وهنا تكمن المشكلة.
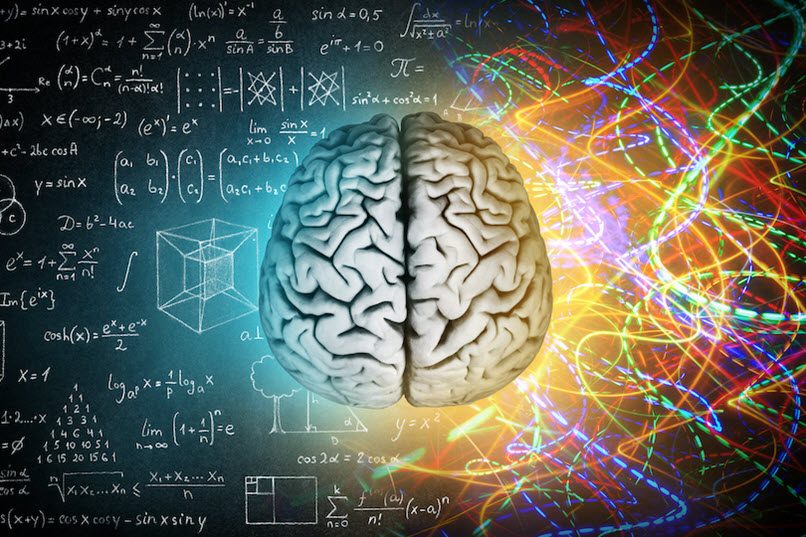
حدود التفسير العلمي:
العلم يفسر. يرى الكثيرون أن هذه الجملة تلخص قدرة العلم وإبهاره. إن العلم يمكننا من فهم ما لم نفهمه من قبل، وهو يساعدنا في السيطرة على الطبيعة بفضل ما يزودنا به من فهم لها. ولكن ما مقدار ما يفسره العلم؟ هل هناك حدود لقدرة العلم على التفسير؟
البعض لا يظن ذلك، ومن الماديين من يظنون أن العلم هو الطريق الوحيد للحق، وهو قادر على تفسير كل شيء. وذلك من حيث المبدأ على الأقل. ويطلق على هذا الموقف “المذهب العلمي” “Scientism“[6]. ويعبر “بيتر أتكينز” عن هذا الموقف تعبيراً كلاسيكياً بالقول: «ليس ما يدعونا للافتراض بأن العلم لا يمكنه التعامل مع كل جانب من جوانب الوجود.» وهذا هو جوهر المذهب العلمي بإيجاز.
وأمثال “أتكينز” الذين يتبنون هذا الموقف يعتبرون أن كل الحديث عن الله والدين والخبرة الدينية يقع خارج نطاق العلم، مما يجعله غير صحيح موضوعياً. ولكنهم يعترفون طبعاً أن الكثيرين يفكرون في الله، ويدركون أن التفكير في الله يمكن أن يأتي بآثار نفسية، أو حتى جسدية قد يكون بعضها مفيداً. ولكنهم يرون أن التفكير في الله يشبه التفكير في بابا نويل، أو التنانين، أو الغيلان، أو الجن والجنيات الموجودة في آخر الحديقة.
ويشير “ريتشارد دوكينز” إلى هذه النقطة في إهدائه لكتابه “وهم الإله” لذكرة “دوجلاس آدامز” Douglas Adams باقتباسه لأحد أقواله: «ألا يكفينا أن نرى جمال الحديقة دون أن نعتقد أن هناك جنيات في نهايتها؟»
إن التفكير في الجنيات والافتتان بها أو الخوف منها لا يعني أنها موجودة بالفعل. ولذلك، فالعلماء الذي نتحدث عنهم (غالباً ولكن ليس دائماً كما رأينا) يسعدون بأن يتركوا الناس يستمرون في التفكير في الله والدين إن أرادوا، طالما أنهم لا يزعمون أن الله له أي وجود موضوعي، أو أن الاعتقاد الديني يمثل نوعاً من المعرفة. أي أن العلم والدين يمكن أن يتعايشا سلمياً طالما أن الدين لا يغزو مملكة العلم. وذلك لأن العلم فقط هو ما يمكنه أن يخبرنا بما هو صحيح موضوعياً، أي أن العلم وحده هو الذي يزودنا بالمعرفة. فالعلم يتعامل مع الواقع والدين لا يفعل ذلك.
إلا أن بعض عناصر هذه الفرضيات والمزاعم في منتهى الغرابة حتى أنها تتطلب التعليق عليها فوراً. ولنأخذ قول “دوجلاس آدامز” الذي يقتبسه “دوكينز” أعلاه، فهو يكشف السر عن غير قصد لأنه يبين أن “دوكينز” متهم بارتكاب خطأ طرح بدائل خاطئة إذ يرجح أنه إما توجد جنيات أو لا يوجد شيء. فالجنيات في نهاية الحديقة قد تكون وهماً بالفعل، ولكن ماذا عن البستاني، ناهيك عن المالك؟ لا يمكن رفض احتمالية وجودهما بهذه البساطة، فالواقع أن كليهما موجود في معظم الحدائق.
خذ أيضاً الادعاء بأن العلم وحده هو القادر على توصيل الحق، لو كان هذا الادعاء صحيحاً، لقضى دفعة واحدة على الكثير من المواد التي تدرس في المدارس والجامعات. وذلك لأن تقييم الفلسفة والأدب والفن والموسيقا يقع خارج نطاق العلم بهذا المفهوم الضيق. فكيف يمكن للعلم أن يخبرنا ما إذا كانت قصيدة ما سيئة أو رائعة؟ لا أظن أنه يمكنه ذلك بقياس أطوال الكلمات أو ترددات الحروف المكونة لها.
وكيف يمكن للعلم أن يخبرنا بما إذا كانت إحدى اللوحات تمثل تحفة فنية أم أنها مجرد خليط ألوان بلا معنى؟ بالتأكيد لا يستطيع أن يفعل ذلك بتحليل الرسم واللوحة كيميائياً. وهكذا، يقع تعليم الأخلاق خارق نطاق العلم. فالعلم يمكنه أن يخبرك بأنك لو وضعت سماً في مشروب شخص، سيموت. ولكنه لا يقدر أن يخبرك عن مدى صحة ما تفعله من الناحية الأخلاقية عندما تضع سماً في شاي جدتك حتى تستولي على ممتلكاتها.
وفي كل الأحوال، الادعاء القائل بأن العلم وحده هو الذي يزودنا بالمعرفة يعتبر واحداً من الادعاءات التي تدحض نفسها بنفسها التي يحلو لبعض المناطقة أمثال “برتراند رسل” Bertrand Russel الإشارة إليها. ولكن المدهش أن «رسل” نفسه انضم لهذا الموقف عندما كتب يقول: “كل ما يمكن التوصل إليه من معرفة، لا بد أن نتوصل إليه بطرق علمية، وما يمكن لا للعلم اكتشافه، لا يمكن للبشرية أن تعرفه.»
ولكي نكتشف التناقض في هذه العبارة، ليس علينا سوى أن نسأل: كيف عرف “رسل” ذلك؟ وذلك لأن عبارته نفسها ليس عبارة علمية، فإن كانت صحيحة (بناء على العبارة نفسها)، إذن لا سبيل إلى معرفتها، ومع ذلك فهو يؤمن أنها صحيحة.
كعكعة الخالة ماتيلدا:
لعل مثالاً بسيطاً يساعدنا أن نقتنع بمحدودية العلم. فلنتخيل أن خالتي ماتيلدا خبزت كعكة جميلة وأننا أخذناها لمجموعة من أعظم علماء العالم لتحليلها. وباعتباري مغرماً باتباع الإجراءات والقواعد، طلب منهم شرحاً للكعكة، فانصرفوا جميعاً إلى العمل. علماء التغذية سيخبروننا بعدد السعرات الحرارية التي تحتويها الكعكة وأثرها الغذائي. وعلماء الكيمياء الحيوية سيخبروننا بتركيب البروتينات، والدهون، وغيرهما من العناصر التي تحتوي عليها الكعكة.
والكيميائيون سيتحدثون عن العناصر المكونة للكعكة وروابطها الكيميائية، والفيزيائيون سيتمكنون من تحليل الجسيمات الأولية للكعكة، وعلماء الرياضيات سيقدمون لنا طبعاً مجموعة من المعادلات العبقرية التي تصف سلوك تلك الجسيمات.
والآن بعد أن قدم لنا هؤلاء الخبراء وصفاً شاملاً للكعكة، كل حسب تخصصه العلمي، هل يمكننا أن نقول إنه أصبح لدينا شرح كامل للكعكة؟ المؤكد أننا حصلنا على وصف كيفية صمع الكعكة وكيفية اتصال عناصرها المتنوعة بعضها ببعض، ولكن هب أني سألت هذه المجموعة من الخبراء سؤالاً أخيراً: لماذا صنعت الكعكة؟ ستكشف الابتسامة العريضة على وجه الخالة ماتيلدا أنها تعرف الإجابة لأنها هي من صنعت الكعكة، وقد صنعتها لغرض.
ولكن كل علماء العالم في التغذية، والكيماء الحيوية، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات لن يتمكنوا من إجابة السؤال، والاعتراف بعجزهم عن الإجابة لا يقلل من شأن علومهم. فتخصصاتهم التي يمكنها التعامل مع الأسئلة المتعلقة بطبيعة الكعكة وتركيبها، أي التي تجيب عن أسئلة “كيف”، لا يمكننا أن تجيب عن أسئلة “لماذا” التي تتناول غرض صنع الكعكة. والحقيقة أن السبيل الوحيد للحصول على إجابة هو الخالة ماتيلدا نفسها. ولكنها إن لم تفصح عن الإجابة، فالحقيقة الأكيدة أنه لا يمكن لأي قدر من التحليل العلمي أن ينير لنا هذه المساحة.
ولكن أن نقول مثل “برتراند رسل” إنه ما دام العلم لا يستطيع أن يخبرنا بالسبب الذي دعا الخالة ماتيلدا إلى صنع الكعكة، فلا يمكننا أن نعرف لماذا صنعتها هن خطأ بين؟ لأن كل ما علينا أن نسألها. فالزعم القائل بأن العلم هو الطريق الوحيد للحق زعم ليس جديراً بالعلم نفسه.
ويشير السير “بيتر مداوار” Peter Medawar الحائز على جائزة نوبل إلى هذه الفكرة في كتابه الرائع “نصائح لعالم شاب” Advice to a Young Scientist: «أسرع وسيلة يسيء بها العالم إلى سمعته ومهنته أن يصرح بكل جرأة، وخاصة عندما لا يكون هناك ما يتطلب هذا التصريح، أن العلم يعرف أو سيعرف قريباً إجابات كل الأسئلة التي تستحق أن تسأل، وأن الأسئلة التي لا تعترف بالإجابة العلمية إما ليست أسئلة أو “أسئلة زائفة” لا يطرحها سوى السذج ولا يحاول الإجابة عنها سوى البلهاء.»
ويستطرد “مداوار” قائلاً: «إلا أن محدودية العلم تتضح في عجزه عن إجابة الأسئلة البدائية الطفولية التي تتعلق بالأشياء الأولى والأخيرة، مثل «كيف بدأ كل شيء؟»، «ما غرض وجودنا؟»، «ما مغزى الحياة؟» ويضيف قائلاً إننا إذا أردنا إجابات عن مثل هذه الأسئلة، علينا أن نلجأ للأدب الخيالي وللدين. ويؤكد هذه الفكرة “فرانسيس كولينز” مدير مشروع الجينوم بقوله: «العلم عاجز عن إجابة بعض الأسئلة مثل: “لماذا أتى الكون إلى الوجود؟” “ما معنى الوجود البشري؟” “ماذا يحدث بعد الموت؟”»
ومن هنا يتضح أنه لا تناقض في أن يكون المرء عالماً على أعلى مستوى، ملتزماً بعلمه وشغوفاً به ويدرك في الوقت نفسه أن العلم لا يستطيع الإجابة عن كل أنواع الأسئلة، بما فيها بعض من أعمق الأسئلة التي يمكن للبشر أن يسألوها.
ولكن من الإنصاف أن نقول أيضاً إن “رسل” رغم أنه كتب تلك العبارة المذكورة آنفاً التي تبدو علمية للغاية، أشار في موضع آخر أنه لم ينضم لمعسكر المذهب العلمي بكامل خصائصه. إلا أنه يعتقد أن كل المعرفة المؤكدة تنتمي للعلم، وهو موقف يبدو طبعاً أنه يعكس بوادر المذهب العلمي، ولكنه سرعان ما يستطرد قائلاً إن معظم الأسئلة المهمة تقع خارج اختصاص العلم: «هل العالم ينقسم إلى عقل ومادة، وإن كان كذلك، فما هو العقل، وما هي المادة؟
وهل العقل خاضع للمادة، أم أنه يتمتع بقوى مستقلة؟ هل في الكون أي وحدة أو غرض؟ هل يتجه نحو غاية ما؟ هل هناك بالفعل قوانين للطبيعة، أم أننا نؤمن بوجود قوانين نظراً لميلنا الفطري للنظام؟ هل الإنسان هو ما يبدو لعالم الفلك، كتلة صغيرة من الكربون غير النقي والماء يزحف ضعيفاً على كوكب صغير ضئيل القيمة؟ أم أنه كما يراه هاملت؟ هل هناك أسلوب حياة نبيل وآخر دنيء أم أن كل أساليب الحياة باطلة؟ …. هذه الأسئلة ليس لها إجابات في المعمل.»
إن ما نقوله الآن معروف منذ زمن أرسطو الذي اشتهر بتمييزه بين ما أطلق عليه العلل الأربع: العلة المادية Material Cause (المادة التي صنعت منها الكعكة)، والعلة الصورية Formal Cause (الصورة التي تتخذها المواد)، والعلة الفاعلة Efficient Cause (عمل الخالة ماتيلدا للكعكة)، والعلة الغائية Final Cause (غرض صنع الكعكة، وليكن عيد ميلاد شخص ما). والعلة الرابعة في علل أرسطو، ألا وهي الغائية هي التي تتجاوز نطاق العلم.
ويكتب “أوستن فارر” Austin Farrar قائلاً: «كل علم يتخير جانباً واحداً في العالم ويشرحه. وكل ما يقع خارج هذا المجال يقع خارج نطاق العلم. وبما أن الله ليس جزءًا من العالم، وبالتالي ليس أحد جوانبه، فكل ما يقال عنه، مهما كانت صحته، يستحيل أن ينتمي لأي علم.»
وفي ضوء ذلك يتضح أن عبارة “بتير أتكينز”: «ليس ما يدعونا للافتراض بأن العلم لا يمكنه التعامل مع كل جانب من جوانب الوجود» (مقتبسة عاليه) وعبارته «ليس هناك ما لا يمكننا فهمه» لا أساس لهما من الصحة على الإطلاق.
ولذلك لا عجب أنه يدفع ثمناً غالياً لما ينسبه للعلم من كفاءة مطلقة: «العلم لا يحتاج لغرض… فكل ما في العالم من ثراء أخاذ رائع يمكن تفسيره بأنه نما من وسط كومة روث من الفساد المترابط الذي لا غرض له.» وهو ما يدعوني للتساؤل عما يفيد الخالة ماتيلدا في هذا الكلام بوصفه التفسير النهائي لصنع الكعكة التي أعدتها لعيد ميلاد ابن أختها جيمي، بل باعتبارها التفسير النهائي لوجودها ووجود كل من جيمي وكعكة عيد الميلاد. ولو أتيحت لها فرصة الاختيار، أظن أنها ستفضل «الحساء الأساسي»[7] Primeval Soup»» على «كومة روث من الفساد.»
إلا أن القول بعجز العلم عن إجابة الأسئلة التي تتناول الغرض النهائي يختلف عن رفض الغرض نفسه باعتباره وهماً لأن العلم لا يستطيع التعامل معه. ولكن “آتكينز” يصل بماديته إلى خلاصتها المنطقية، أو ربما ليس كذلك بالضبط. ففي كل الأحوال، وجود كومة روث يفترض مسبقاً وجود كائنات قادرة على إنتاج الروث! وإلا فمن الغريب أن نتخيل روثاً يخلق المخلوقات. وإن كانت “كومة روث من الفساد” (تمشياً مع القانون الثاني في الديناميكا الحرارية)، فلنا أن نتساءل كيف يمكن أن يسير الفساد في اتجاه عكسي؟ يا لها من مسألة محيرة!
ولكن ما يدمر المذهب العلمي تماماً هو ما يعيبه من تناقض مميت. فلسنا بحاجة لحجة خارجية تفند المذهب العلمي لأنه يدمر نفسه بنفسه، ويلاقي المصير الذي لقيه فيما سبق مبدأ التحقق Verification Principle الذي شكل صميم فلسفة الوضعية المنطقية Logical Positivism. وذلك لأن عبارة أن العلم وحده هو الذي يقود للحق لم تستنتج من العلم. فهذه العبارة نفسها ليس تصريحاً علمياً ولكنها تصريح «عن العلم» Metascientific.
ومن ثم، إن كان المبدأ الأساسي في المذهب العلمي صحيحاً، فلا بد أن يكون التصريح الذي يعبر عن المذهب العلمي خاطئاً. فالمذهب العلمي يفند نفسه، مما يجعله متناقضاً مع نفسه. ولذلك، فما يراه “مداوار” من محدودية العلم ليس إهانة للعلم. بل على العكس تماماً، لأن أولئك العلماء الذين يطلقون ادعاءات مبالغة دفاعاً عن العلم هم الذين يظهرونه في مظهر مخجل. فقد ابتعدوا دون قصد، وربما دون وعي، عن الاشتغال بالعلم إلى الاشتغال بالأساطير، والأساطير المتناقضة.
ولكن قبل أن نترك الخالة ماتيلدا لا بد أن نلاحظ أن قصتها البسيطة تساعدنا في استجلاء شيء آخر يسبب نوعاً من التشوش. لقد رأينا أن التفكير العلمي وحده لا يمكنه اكتشاف سبب صنعها للكعكة، وأنها لا بد أن تكشف لنا السبب بنفسها. ولكن ذلك لا يعني أنه من هذ النقطة فصاعداً يصبح العقل غير ذي صلة بالموضوع ولا يعني أنه يتعطل عن العلم. بل العكس هو الصحيح، لأن فهم ما تقوله عندما تخبرنا عمن صنعت له الكعكة يتطلب منا استخدام العقل.
هذا بالإضافة إلى أننا نحتاج للعقل لتقيم مصداقية تفسيرها. فإن قالت إنها صنعت الكعكة لابن شقيقتها جيمي ونحن نعلم أن شقيقتها ليس لها ابن بهذا الاسم، سنشك في شرحها. ولكن إن كنا نعلم أن ابن شقيقتها اسمه جيمي، عندئذ يكون تفسيرها معقولاً. أي أن العقل ليس ضد الإعلان، ولكن إعلانها لغرض صنع الكعكة يزود العقل بمعلومات لا يمكن للعقل وحده التوصل إليها. ولكن لا غنى عن العقل لمعالجة تلك المعلومات. فالفكرة أنه حيثما لا يكون العلم هو المصدر الذي نستقي منه معلوماتنا، لا يمكننا أن نفترض تلقائياً أن العقل توقف عن العمل وأن الدليل لم يعد له مكان.
ومن ثم، عندما يزعم المؤمنون بالله أنه يوجد شخص علاقته بالكون مثل علاقة الخالة ماتيلدا بالكعكة، وأن ذلك الشخص أعلن سبب خلق الكون، فهم لا يهجرون العقل والمنطق والدليل على الإطلاق. ولكنهم يقولون إن بعض الأسئلة لا يمكن للعلم وحده أن يجيب عنها وإن الإجابة عنها تتطلب مصدراً آخر للمعلومات، وهو في هذه الحالة إعلان من الله الذي يستلزم العقل لفهمه وتقييمه. وهذه هي الروح التي تحدث بها “فرانسيس بيكون” عن الكتابين اللذين أعطانا الله إياهما: كتاب الطبيعة، والكتاب المقدس. والعقل والمنطق والدليل تنطبق جميعاً على كليهما.
الله: هل هو فرضية لا لزوم لها؟
لقد حقق العلم نجاحاً مذهلاً في سبر أغوار طبيعة الكون المادي وتفسير الآليات التي يعمل الكون وفقاً لها. وقد أسفر البحث العلمي أيضاً عن القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة، وبعث الأمل في القضاء على المزيد منها. وكان للبحث العلمي أثر آخر في اتجاه مختلف تماماً، فقد حرر الكثيرين من البشر من المخاوف الخرافية. فلم يعد الناس مثلاً مضطرين للاعتقاد بأن خسوف القمر يسببه روح شرير مرعب عليهم استرضاؤه. ولا بد أن نكون في غاية الامتنان على كل هذه الإسهامات وغيرها الكثير.
ولكن في بعض المجالات أدى نجاح العلم عينه أيضاً إلى فكرة مفادها أننا ما دمنا نفهم آليات الكون دون إدخال الله، يمكننا أن نستنتج بثقة أنه لم يكن هناك أصلاً إله صمم الكون وخلقه. إلا أن هذا التفكير ينطوي على مغالطة منطقية شائعة يمكننا توضيحها بالمثل التالي.
تخيل مثلاً سيارة ماركة فورد. مفهوم أن شخصاً من بقعة نائية في العالم يراها لأول مرة ولا يعلم شيئاً عن الهندسة الحديثة قد يتخيل أن إلهاً ما (مستر “فورد”) داخل هذه الآلة هو الذي يسيرها. وقد يتخيل أيضاً أنه عندما تسير العربة بهدوء فهذا يعني أن مستر “فورد” راض عنه، ولكنها عندما ترفض السير فهذا يعني أن مستر “فورد” غير راض عنه. ولكنه طبعاً إذا درس الهندسة بعد ذلك وفكك المحرك سيكتشف أن مستر “فورد” لا يقبع داخله.
ولن يحتاج ذكاءً خارقاً حتى يفهم أنه لم يكن بحاجة لإقحام مستر “فورد” لفهم كيفية عمل السيارة. فإدراكه للقوانين اللاشخصانية التي لا علاقة لها بشخص وتحكم عملية الاحتراق الداخلي كاف تماماً لتفسير عمل السيارة. حتى الآن كل شيء على ما يرام. ولكنه إذا قرر بعدئذ أن فهمه للقوانين التي تشرح كيفية عمل المحرك تلغي اعتقاده في وجود مستر “فورد” الذي صمم المحرك أصلاً. يكون قد ارتكب خطأ بيناً، يطلق عليه بلغة الفلسفة خطأ تصنيفي Category Mistake فلو لم يوجد مطلقاً مستر “فورد” ولم يصمم آليات المحرك، لما وجد صاحبنا هذا أي آليات ليفهمها.
وهكذا فإن الافتراض القائل بأن فهمنا للقوانين اللاشخصانية التي يعمل الكون وفقاً لها تجعل الإيمان بوجود خالق شخصاني صمم الكون وصنعه ويحفظه لا لزوم له أو مستحيلاً، هو افتراض يمثل خطأ تصنيفياً. أي أننا يجب ألا نخلص بين الآليات التي يعمل الكون وفقاً لها مع مسببه وحافظه.
والقضية الأساسية هنا أن من يظهرون وكأنهم يفكرون تفكيراً علمياً مثل “آتكينز” أو “دوكينز” يعجزون عن التمييز بين الآلية التي تعمل من خلالها الطبيعية والفاعلية وراء هذه الآلية Agency التي تحكم عمل الطبيعة. فهم بلغة الفلسفة يرتكبون خطأ تصنيفياً بدائياً جداً عندما يقولون إننا ما دمنا نفهم الآلية التي تفسر ظاهرة بعينها، فليس من فاعل Agent صمم الآلية.
وعندما اكتشف السير إسحق نيوتن قانون الجاذبية الكوني، لم يقل: «لقد اكتشفت آلية تشرح حركة الكواكب. لذا، فليس هناك إله فاعل صممها.» بل على العكس، فهمه لكيفية عملها زاده إعجاباً بالله الذي صممها على هذا النحو.
ويعبر “مايكل بول” Michael Poole عن هذه الفكرة في مناظرته المنشورة مع “ريتشارد دوكينز” بقوله: «…. لا تضارب منطقي بين التفسيرات التي تقدم أسباباً فيما يتعلق بالآليات، والتفسيرات التي تقدم أسباباً فيما يتعلق بخطط فاعل ومقاصده، سواء أكان بشرياً أم إلهياً. وهي نقطة منطقية لا علاقة لها بالإيمان بالله أو عدم الإيمان به.»
ولكن عالم الرياضيات الفرنسي “لابلاس” يتجاهل هذه الفكرة المنطقية كلية في تصريح شهير له دائماً ما يساء استخدامه لدعم الإلحاد. فعندما سأله نابليون عن موضع الله في عمله الرياضي، أجاب “لابلاس”: «سيدي، لست بحاجة لهذه الفرضية.» وقد كان محقاً. فالله طبعاً لم يظهر فيما قدمه “لابلاس” من وصف رياضي للكيفية التي تعمل بها الأشياء، تماماً كما لم يظهر مستر “فورد” في الوصف العلمي لقوانين الاحتراق الداخلي.
ولكن علام يبرهن ذلك؟ أنه لا يوجد شخص اسمه “هنري فورد”؟ بالطبع لا. وهكذا هذه العبارة لا تثبت عدم وجود الله. ويعلق “أوستن فارر” على واقعة “لابلاس” قائلاً: «بما أن الله ليس قاعدة في حركة القوى، ولا هو إحدى القوى، فأي جملة عن الله لا يمكن أن تلعب أي دور في الفيزياء أو الفلك… ويمكننا أن نسامح “لابلاس”، فقد كان يجيب شخصاً عديم الخبرة حسب جهله، ولا أريد أن أقول جاهلاً حسب حماقته.
إلا أنه عندما أخذ البعض إجابته باعتبارها ملاحظة ذات ثقل، فقد سببت لهم قدراً كبيراً من التضليل. ولكن “لابلاس” وزملاؤه لم يستغنوا عن اللاهوت، بل تعلموا ألا يتدخلوا فيه ويلتزموا بحدود علمهم.» ولكن هب أن نابليون طرح سؤالاً مختلفاً على “لابلاس”: «لماذا يوجد كون أصلاً وتوجد فيه مادة وجاذبية، وأجسام تتكون من المادة وتتحرك وفقاً للجاذبية وتصف المدارات التي تعبر عنها في معادلاتك الرياضية؟» سيكون من الصعب أن يقول إن وجد الله لا علاقة له بذلك السؤال. ولكن “لابلاس” لم يُسأل ذلك السؤال، ومن ثم، لم يجب عنه.
[1] يعرف “قاموس أكسفورد” “الميتافيزيقا” Metaphysics بأنها المبحث الفلسفي الذي يتناول المبادئ الأولى للأشياء، بما فيها المفاهيم المجردة كالكينونة، والمعرفة، والجوهر، والعلة، والهوية، والمكان، والزمان. أي أنه يتناول ما هو خارج المادة، مقابل العلم الذي يتناول ما هو مادي. (المترجم)
[2] حركة فكرية نشأت في أوربا في أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر تؤكد قيمة العقل والفردية في مقابل التقليد. (المترجم)
[3] اتجاه فكري معاصر يرفض الاعتراف بالمطلقات. (المترجم)
[4] خطأ فلسفي يعني تقديم أشياء تنتمي لفئة معينة وكأنها تنتمي لفئة أخرى مغايرة. وقد يعني أيضاً نسب صفة أو فعل لشيء معين لا تنطبق عليه هذه الصفة ولكنها تنطبق على فئة أخرى من الأشياء، مثل التعامل مع المفاهيم المجردة وكأن لها موقعاً مادياً. (المترجم).
[5] المصادرة على المطلوب begging the question إحدى المغالطات المنطقية التي فيها تفترض صحة المسألة المطلوب البرهنة عليها من البداية بهدف البرهنة عليها. (المترجم)
[6] المقطع ism في اللغة الإنجليزية يستخدم في نهايات العديد من الكلمات ويشير ضمن معانيه إلى منظومة أو مذهب أو قناعة أو حركة فكرية، أي أنه لا يمت بصلة لمبدأ علمي ثبتت صحته بالدليل أو بالتجريب. وعادة ما يترجم في العربية إلى كلمة “مذهب” (المترجم).
[7] نظرية ترجح أن الحياة بدأت في بركة أو محيط نتيجة لخليط من المواد الكيميائية من الغلاف الجوي وشكل من أشكال الطاقة لتكوين الحماض الأمينية (http://leiwenwu-tripod.com/primordials.htm) تم الاطلاع عليه بتاريخ 17/12/2015 (المترجم)


