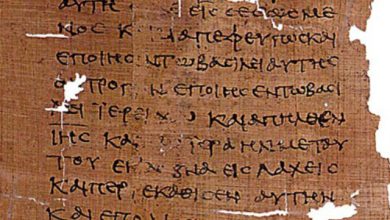لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟ ولماذا يوجد الكون بالأخص؟
لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟ ولماذا يوجد الكون بالأخص؟
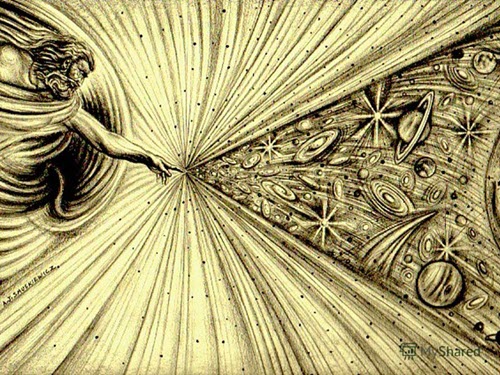
ما معنى كل هذا؟ ريتشارد فاينمن
لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟ ولماذا يوجد الكون بالأخص؟ من أين أتى، وإن كان يسير نحو وجهة معينة، فإلى أين؟ وهل الكون في ذاته يمثل الحقيقة النهائية التي لا يوجد أي شيء بعدها أم أن هناك شيئاً ما “أبعد” من الكون؟ أيمكننا أن نسأل “ريتشارد فاينمن” Richard Feynman: «ما معنى كل هذا؟» أم أن “برتراند رسل” Bertrand Russell كان محقاً عندما قال إن «الكون موجود، وهذا هو كل ما في الأمر»؟
إن هذه الأسئلة لم تفقد شيئاً من قدرتها على استنفار الخيال البشري. ونظراً لما يدفع العلماء من رغبة محمومة في تسلق أعلى قمم المعرفة، فقد كشفوا لنا أسرارً مدهشة تسبر أغوار الكون الذي نسكنه؛ فعلى مستوى الأجسام شديدة الضخامة، لدنا تلسكوب “هبل” Hubble telescope الذي ينقل صوراً مذهلة للسماء من مداره الذي يعلو عن الغلاف الجوي.
وعلى مستوى الأجسام متناهية الصغر، نحد الميكروسكوب النفقي الماسح Scanning tunneling microscope يظهر حقائق بالغة التعقيد في عالم الأحياء الجزيئية Molecular biology وما يعج به من الجزيئات الكبيرة Macromolecules الغنية بالمعلومات وما تحويه من مصانع بروتين شديدة الصغر تتميز بقدر من التعقيد والدقة يجعل أرقى التقنيات البشرية تبدو أمامها كل شيء.
هل نحن والكون، وما يزخر به من جمال مجراته وتعقيده البيولوجي الدقيق، لسنا سوى نتاج قوى اعتباطية تؤثر عشوائياً في مادة وطاقة لا عقل لهما، كما يزعم أولئك المعروفون باسم “الملحدين الجدد” New Atheists بقيادة “ريتشارد دوكينز” Richard Dawkins؟ وهل الحياة البشرية هي في النهاية مجرد تجمع لعدد من الذرات ضمن العديد من التجمعات المشابهة التي حدثت بالصدفة، وإن كان ذلك أمراً مستحيلاً؟ وعلى أي حال، ما الذي يميزنا بعد أن عرفنا أننا نسكن كوكباً صغيراً يدور في فلك واحدة من مليارات الشموس التي تقع في مكان ما في ذراع مجرة حلزونية، ضمن مليارات المجرات المنتشرة في الفضاء الفسيح؟
بل إن البعض يقولون إنه ما دامت بعض الخصائص الأساسية للكون، مثل قدرة القوى الأساسية للطبيعة، وعدد ما يمكن ملاحظته من أبعاد المكان والزمان، هي نتاج مؤثرات عشوائية عملت على نشأة الكون، فمن المؤكد وجود أكوان أخرى ذات بنى مختلفة تماماً. أليس من المحتمل أن هذا الكون ليس إلا واحداً ضمن مجموعة ضخمة من الأكوان المتوازية التي تنفصل بعضها عن بعض إلى ما لا نهاية؟ أليس من العبث أن ندعي أن البشر يتميزون بأي قيمة عليا؟ إن حجمهم وسط الأكوان المتعددة Multiverse يمكن أن يكون صفراً.
ومن ثم، فإنه عبث فكري أن نعود للعصور الغابرة عندما كان العلم الحديث يخطو خطواته الأولى حينما كان العلماء أمثال بيكون Bacon، وجاليليو Galileo، كبلر Kepler، ونيوتن Newton، وكلرك ماكسويل Clerk Maxwell يؤمنون بوجود إله خالق ذكي تمخض عقله عن الكون. وأصحاب هذا الفكر يحاولون إقناعنا بأن العلم تجاوز هذه التفكير البدائي، ووضع الله في مزنق، وقتله ودفنه بما قدمه من تفسيرات شاملة. وأصبحت أهمية الله للكون لا تتجاوز أهمية قصص الأطفال الخيالية المسلية.
بل إن الله لا يصل إلى مستوى شيخ خرافي ميت وحي في الوقت نفسه، مثل قط “شرودينجر” Schrodinger’s cat[1]، ولكنه ميت دون شك. وعملية تلاشيه برمتها تبين أن أي محاولة لإعادة تقديمه للعالم غالباً ما ستعيق تقدم العلم. وهكذا يمكننا أن نرى بوضوح لم يسبق له مثيل أن الفلسفة الطبيعية Naturalism (الاتجاه القائل بأنه ليس هناك شيء سوى الطبيعة، ولا يوجد أي شيء أبعد منها أو متجاوز لها Transcendence) هي المتربعة على العرش حالياً.
حتى إن “بيتر أتكينز” Peter Atkins أستاذ الكيمياء بجامعة أكسفورد (رغم أنه يتعرف بوجود عنصر ديني في تاريخ تكوين العلم) يدافع عن هذه النظرة باستماتة منقطعة النظير: «إن العلم، أي النظام العقائدي القائم على المعرفة المتفق عليها من الجميع والتي يمكن إعادة إنتاجها، قد نشأ من الدين. ولكن العلم بعد أن تخلص من شرنقته ليتحول إلى فراشة كما نراه اليوم، أتى على العشب كله.
فليس ما يدعونا للافتراض بأن العلم لا يمكنه التعامل مع كل جانب من جوانب الوجود. إن المتدينين فقط هم من يتمنون وجود ركن مظلم في الكون المادي أو في عالم الخبرة لا يمكن للعلم إنارته ولا يمكنه حتى أن يحلم بذلك، وإني أضع مع هؤلاء المتدينين كل من يتبنون أفكاراً مسبقة متحيزة وكذلك أصحاب المعلومات الضحلة. ولكن الحقيقة أن العلم لم تعرقله يوما أي حواجز، والمبرر الوحيد للاعتقاد بفشل الاختزالية[2] Reductionism هو تشاؤم العلماء وخوف المتدينين».
وقد نوقش موضوع بعنوان “أعمق من الاعتقاد: العلم والدين العقل والبقاء” “Beyond Belief: science, religion, reason and survival” في أحد المؤتمرات المنعقدة في “معهد سولك للدارسات البيولوجية” Salk Institute for Biological Studies بمدينة “لاهويا” في ولاية كاليفورنيا سنة 2006 حيث قال “ستيفن واينبرج” Steven Weinberg الحائز على جائزة نوبل إنه: «على العلم أن يستفيق من كابوس الدين الطويل… وعلينا نحن العلماء ألا ندخر وسعاً في أن نفعل كل ما من شأنه أن يضعف قبضة الدين، وربما يكون ذلك أعظم ما نسهم به في الحضارة.» ولا عجب أن “ريتشارد دوكينز” مضى خطوة أبعد قائلاً: «لقد سئمت كل السأم من الاحترام الذي أسبغناه على الدين بسبب ما تعرضنا له من غسيل مخ».
ولكن هل هذا صحيح؟ هل يجب وصم كل المتدينين بأنهم يتبنون أفكاراً مسبقة متحيزة ومعلوماتهم ضحلة؟ على أي حال، البعض منهم علماء حائزون على جائزة نوبل. هل صحيح أنه يعلقون آمالهم على العثور على ركن مظلم في الكون يستحيل على العلم أن يأمل في أن ينيره؟ من المؤكد أن هذا الوصف ليس دقيقاً ومجحف لمعظم العلماء الأوائل مثل كبلر الذين قالوا إن قناعتهم بوجود خالق كانت مصدر الإلهام الذي دفع علومهم لقمم أعلى. وكانت أركان الكون المظلمة التي نجح العلم في إنارتها هي ما وفر العديد من الأدلة على حقيقة وجود إله خالق ذكي.
وماذا عن الغلاف الحيوي؟ هل تعقيده الدقيق يبدو ظاهرياً كما لو كان قد صنع وفقاً لتصميم معين، ولكنه ليس كذلك، كما يؤمن “ريتشارد دوكينز” حليف “بيتر أتكينز” العنيد؟ هل يمكن حقاً أن ينشأ المعقول من عمليات طبيعية غير موجهة تؤثر على مواد الكون الأساسية وفقاً لقيود قوانين الطبيعة بشكل عشوائي؟ هل حل إشكالية العلاقة بين العقل والمادة Mind-body Problem هو أن عقلاً منطقياً “نشأ” من جسم مادي بلا عقل بفعل عمليات غير عاقلة وغير موجهة؟
إن الأسئلة المتعلقة بهذه الفلسفة الطبيعية لا تتلاشى بسهولة، كما يتضح من مستوى الاهتمام الجماهيري. فهل العلم يحتاج فعلاً للمذهب الطبيعي؟ أم أنه مفهوم أن الفلسفة الطبيعية أُقحمت على العلم وأنها ليست شيئاً يحتويه العلم أصلاً؟ بل هل يمكننا حتى أن نقول إن هذه الفلسفة قد تكون صورة من صور الإيمان، يشبه الإيمان الديني؟ وأرجو أن يغفروا لنا جرأتنا في الاعتقاد بذلك بسبب ما نراه من كيفية التعامل أحياناً مع من يجرؤون على طرح هذه الأسئلة. فقد يواجهون نوعاً من الاستشهاد بتجريدهم من كافة الامتيازات كما يحدث مع هراطقة الدين في العصور الغابرة.
فالمعروف عن أرسطو قوله إننا إن أردنا النجاح لا بد أن نسأل الأسئلة الصحيحة. إلا أن بعض الأسئلة خطيرة، ومحاولة الإجابة عنها أخطر. ولكن قبول هذا النوع من المخاطرة يمثل جزءًا أصيلاً من روح العلم واهتماماته. وإن نظرنا لهذه النقطة من زاوية تاريخية لن نجد عليها اختلافاً؛ ففي العصور الوسطى مثلاً، كان على العلم أن يحرر نفسه من بعض جوانب الفلسفة الأرسطية حتى ينطلق للأمام.
فقد علم أرسطو أنه بدءًا من القمر وما بعده لا يوجد سوى الكمال، ولما كانت الحركة الكاملة عنده هي الحركة الدائرية، فقد رأى أن الكواكب والنجوم تتحرك في دوائر تامة. ولكن الحركة تحت القمر خطية حيث تسود حالة من عدم الكمال. وقد سادت هذه النظرة على الفكرة لمدة قرون حتى نظر جاليليو في تلسكوبه ورأى حواف بارزة من الفوهات القمرية. لقد تحدث الكون وتبدد استنتاج أرسطو الذي بناه على ما اعتبر مفهوماً بديهياً للكمال.
ومع ذلك ظلت دوائر أرسطو مستحوذة على جاليليو: «حفاظاً على النظام التام فيما بين أجزاء الكون، لا بد أن نسلم بأن الأجسام المتحركة لا يمكنها إلا أن تتحرك في حركة دائرية.» ولكن فكرة الدوائر لم يحالفها الحظ عندما أخذ كبلر على عاتقه أن يخطو خطوته الجريئة ويقول إن الملاحظات الفلكية تعتبر دليلاً أقوى من الحسابات التي تقوم على نظرية مبنية على مجرد مفهوم بديهي يقول بدائرية حركة الكواكب.
وقد اقترح كبلر ذلك على أساس تحليله للملاحظات المباشرة والدقيقة لمدار المريخ التي قام بها سلفه تيكو براهي Tycho Brahe عالم الرياضيات التجريبي في مدينة براخ. أما الباقي فهو تاريخ كما يقولون. فقد قدم اقتراحه المذهل بأن الكواكب تتحرك في مدارات على شكل قطع ناقص “تام” الاستواء حول الشمس التي تقع في إحدى بؤرتيه، وهو استنتاج كشف غوامضه فيما بعد نيوتن عندما وضع نظريته في الجاذبية المبنية على قانون التربيع العكسي Inverse-square التي لخصت كل هذه التطورات في صيغة واحدة بسيطة مختصرة جداً. لقد غير كبلر العلم للأبد بتحريره إياه من فلسفة قاصرة قيدته على مدى قرون. لذا، قد يكون ضرباً من الغرور أن نفترض أن هذه الخطوة المحررة لن تتكرر أبداً.
وهنا يعترض العلماء أمثال “آتكينز” وكذلك “دوكينز” أنه منذ عصر جاليليو وكبلر ونيوتن قفز العلم قفزات واسعة وليس هناك ما يدل على أن الفلسفة الطبيعية التي يرتبط بها العلم حالياً ارتباطاً وثيقاً (على الأقل في أذهان الكثيرين) هي فلسفة قاصرة. وهم يرون طبعاً أن الفلسفة الطبيعية تعلم على تقدم العلم الذي أصبح الآن قادراً على المضي قدماً بعد أن تحرر من حمل حقيبة الأساطير الثقيلة التي كثيراً ما أعاقت سيره في الماضي. وهم يزعمون أيضاً أن أفضل ما يميز الفلسفة الطبيعية هو استحالة إعاقتها للعلم لأنها تؤمن بتفوق المنهج العلمي، فهي الفلسفة الوحيدة التي تتميز بالتوافق التام مع العلم انطلاقاً من صميم طبيعتها.
ولكن هل الأمر كذلك حقاً؟ فلا شك أن جاليليو وجد أن الفلسفة الأرسطية تعيق العلم بافتراضها البديهي عما يجب أن يكون عليه الكون. ولكن لا جاليليو ولا نيوتن ولا حتى معظم العلماء العظماء الذين ساهموا فيما أحرزه العلم من تقدم مبهر آنذاك رأى أن الاعتقاد بإله خالق يعيق العلم كما هو الحال مع الفلسفة الأرسطية. بل على العكس، فقد رأوا أن هذا الاعتقاد يزودهم بحافز قوي، وكان يمثل للكثيرين منهم الدافع الأساسي نحو البحث العلمي
وإن كان الأمر كذلك، فإن الألحاد العنيد الذي يميز بعض الكتاب المعاصرين يدفع المرء لطرح هذا السؤال: ما الذي يجعلهم مقتنعين تماماً أن الإلحاد هو الموقف الوحيد الصلب والمتماسك فكرياً؟ هل صحيح أن كل ما في العلم يشير إلى الإلحاد؟ هل العلم والإلحاد بطبعتهما صنوان لا يفترقان؟ إن الفيلسوف البريطاني “أنتوني فلو” Anthony Flew الذي كان أحد رواد الإلحاد على مدى سنوات طويلة لا يتفق مع هذه النظرة. فقد أعلن في حوار على قناة BBC أن التفسير الوحيد الوجيه لنشأة الحياة والتعقيد الذي تتميز به الطبيعة هو وجود ذكاء فائق وراء كل ذلك.
مناقشة التصميم الذكي
لقد أضاف مثل هذا التصريح لمفكر بحجم “فلو” بعداً جديداً للمناقشات الحادة، بل الغاضبة أحياناً، حول “التصميم الذكي”. ومما يزيد هذه المناقشات اشتعالاً أن مصطلح “التصميم الذكي” يبدو للكثيرين أنه توجه حديث نسبياً يخفي وراءه نزعة مؤيدة لنظرية الخلق ومناهضة للعلم هدفها الأساسي مهاجمة نظرية التطور. وهذا يعني أن مصطلح “التصميم الذكي” غير معناه على نحو خفي مما ينذر بخطورة مناقشة قضية بهذه الأهمية دون أن نتفق على ما نعنيه بها.
والآن يرى البعض مصطلح “التصميم الذكي” تعبيراً غريباً لأننا عادة ما نعتبر أن أي تصميم ينتج عن ذكاء، وهو ما يجعل الصفة “ذكي” زائدة ويمكن الاستغناء عنها. فإن اكتفينا بمصطلح “تصميم” أو استخدمنا تعبير “مسبب ذكي” “Intelligent causation“، فنحن نتحدث عن فكرة تحظى باحترام كبير في تاريخ الفكر، لأن فكرة وجود مسبب ذكي وراء الكون ليست حديثة على الإطلاق بل قديمة قدم الفلسفة والدين.
ثم إننا قبل أن نتناول السؤال ما إذا كان التصميم الذكي يخفي وراءه عقيدة الخلق أم لا، علينا أن نفحص معنى مصطلح “عقيدة الخلق” Creationism نفسه حتى لا نقع في سوء فهم آخر.
لأن هذا المصطلح أيضاً معناه تغير. فقد استخدم مصطلح “عقيدة الخلق” للإشارة إلى الاعتقاد بوجود خالق. ولكنه لم يعد يقتصر على مجرد الاعتقاد في وجود خالق ولكنه صار يشتمل كذلك على العديد من المعتقدات الأخرى، وأهمها تفسير معين لسفر التكوين يعتبر أن عمر الأرض لا تجاوز بضعة آلاف من السنين. وهذا التغيير الذي طرأ على معنى “عقيدة الخلق” أو “المؤمن بعقيدة الخلق” نتج عنه ثلاثة آثار سلبية:
أولها أنه يستقطب المناقشة ويقدم هدفاً سهلاً لمن يصرون على رفض أي فكرة تتعلق بوجود مسبب ذكي في الكون. والثاني أنه يتجاهل الاختلاف الكبير في تفسير رواية التكوين في هذا الأمر. أما الأثر الثالث، إن هذا التغيير يضعف الغرض (الأصلي) من استخدام مصطلح “التصميم الذكي”، ألا وهو التمييز بين الاعتراف بوجود تصميم، وتحديد المصمم؛ وهما أمران لا بد من التفريق بينهما.
هذه الآثار الثلاثة هي ثلاث قضايا مختلفة. والقضية الثانية لاهوتية في جوهرها وقد اتفق الأغلبية على أن تظل خارج نطاق العلم. والهدف من رسم الخط الفاصل بين القضايا هو تمهيد الطريق لاستكشاف وسيلة يمكن للعلم استخدامها للإجابة عن القضية الأولى. ولذلك، فمن المؤسف أن هذا التمييز بين قضيتين بينهما اختلاف جذري، دائماً ما يتلاشى بسبب الاتهام الموجه لفكرة “التصميم الذكي” باعتباره ملخصاً لفكر “عقيدة الخلق متخفية”.
وإن كنا نفهم مصطلح “التصميم الذكي” بمعناه الأصلي، يصبح السؤال الشائع عما إذا كان التصميم الذكي علماً سؤالاً مضللاً. فهب أننا نريد أن نسأل هذين السؤالين المتوازيين: هل الإيمان بالله الخالق الحافظ Theism علم؟ هل الإلحاد علم؟ معظم الناس سيجيبون بالنفي. ولكن إن قلنا إن ما نقصده هو ما إذا كان هناك أدلة علمية تؤيد الإيمان بالله الخالق الحافظ (أو الإلحاد)، فغالباً ما سيكون رد الطرف الآخر: فلماذا لم تقل هذا صراحة من البداية؟
وحتى نفهم معنى هذا السؤال يمكننا أن نصيغه هكذا: هل من أدلة علمية تشير إلى وجود تصميم؟ فإن كان هذا هو المعنى الذي يجب أن نفهمه من السؤال، فيجب التعبير عنه طبقاً لهذا المعنى حتى نتجنب سوء الفهم الذي ظهر في العبارة التي قيلت في “محاكمة دوفر”[3] Dover trial وهي أن «التصميم الذكي قضية لاهوتية مهمة، ولكنه ليس علماً.» وفي فيلم ” مطرود” Expelled (أبريل 2008) يبدو أن “ريتشارد دوكينز” نفسه يعترف أنه يمكن استخدام البحث العلمي لتحديد ما إذا كان أصل الحياة يعكس عمليات طبيعية أم أنه نتيجة لتدخل مصدر خارجي ذكي.
وكذلك “توماس ناجل” Thomas Nagel، وهو من أساتذة الفلسفة الملحدين البارزين في نيويورك، كتب في مقال مذهل بعنوان “التعليم الحكومي والتصميم الذكي” Public Education and Intelligent Design: «إن مقاصد الله ونياته، وطبيعة إرادته، إن كان يوجد إله، يستحيل أن تكون موضوعاً لنظرية علمية أو تفسير علمي. ولكن هذا لا يعني استحالة وجود أدلة علمية تؤيد أو تدحض تدخل مسبب غير محكوم بقانون في النظام الطبيعي.»
وهو يقول إن التصميم الذكي «لا يعتمد على تشويهات ضخمة للأدلة ولا على تنافرات جسيمة في تفسيره» وذلك بناء على قراءته لبعض الأعمال مثل كتاب “حدود التطور” Edge of Evolution لمؤلفه “مايكل بيهي” Michael Behe (كان “بيهي” أحد الشهود في “محاكمة دوفر”) أي أنه يرى أن التصميم الذكي لا يقوم على أساس الافتراض بأنه “يتمتع بحصانة ضد الأدلة التجريبية” كما يؤمن من يعتقدون بحرفية الكتاب المقدس بأنه محصن بحيث يستحيل تفنيده بأي أدلة كانت، وهو ينتهي إلى هذه الخلاصة: «التصميم الذكي مختلف تماماً عن علم الخلق.»
ويقول البروفسور “ناجل” أيضاً إنه «ظل فترة طويلة يشك أن مزاعم نظرية التطور التقليدية هي القصة الكاملة لتاريخ الحياة.» ويقول أيضاً إنه «يصعب أن نجد سنداً في المؤلفات المتاحة» يؤيد هذه المزاعم. وهو يرى أن «الأدلة المتاحة حالياً» تعجز عن تأكيد «كفاية الآليات المعيارية التي تتضمنها نظرية التطور لتقديم تفسير لنشأة الحياة بكاملها.»
والمعروف الآن أن بعض الكتاب أمثال “بيتر آتكينز”، و”ريتشارد دوكينز” و”دانيل دني” Daniel Dennett يزعمون وجود أدلة علمية قوية على الإلحاد. مما يتيح لهم الفرصة ليقدموا دفاعاً علمياً عن موقف ميتافيزيقي. ولذلك، فهم من دون الناس جميعاً، لا يحق لهم أن يعترضوا على الآخرين إن استخدموا الدليل العلمي لتأييد الموقف الميتافيزيقي المضاد، ألا وهو التصميم الذي يؤكد فكرة الخلق. وأنا طبعاً واع تماماً أن الرد الذي سيأتي به البعض على الفور أنه ليس هناك قضية بديلة يمكن طرحها. إلا أن هذا الحكم قد يكون سابقاً لأوانه.
ويمكن صياغة السؤال ما إذا التصميم الذكي علماً صياغة أخرى. وذلك بأن نسأل ما إذا كانت فرضية التصميم يمكنها أن تؤدي إلى فرضيات يمكن إخضاعها للاختبار العلمي. وسوف نرى لاحقاً قضيتين رئيسيتين أسفرت فيهما فرضية التصميم الذكي عن النتائج. وهاتان القضيتان هما: إمكانية فهم الكون بشكل عقلاني Rational intelligibility، بداية الكون.
إلا أن مصطلح “التصميم الذكي” يشكل صعوبة أخرى تتمثل في استخدام كلمة “تصميم” التي ترتبط في أذهان البعض ارتباطاً وثيقاً بالفكرة التي طرحها نيوتن عن الكون، إذ شبهه بالساعة التي تسير بانتظام دقيق معروف تحكمه القوانين الفيزيائية، ولكن أينشتاين سار بالعلم خطوات أبعد من هذه الفكرة.
بل إن الكلمة أيضاً تعيد إلى الذهن ذكريات الفيلسوف المسيحي “بيلي” Paley وما قدمه في القرن التاسع عشر من حجج مؤيدة لفكرة التصميم التي يعتقد الكثيرون أن “دافيد هيوم” David Hume قضى عليها. وحتى لا نصدر حكماً متعجلاً بخصوص هذه القضية الأخيرة، قد يكون من الحكمة أن نتحدث عن مسبب ذلك أو عن أصل ذكي، بدلاً من الحديث عن تصميم ذكي.
والحجج المعروضة في هذا الكتاب قدمتها في محاضرات وحلقات نقاشية وحوارات في العديد من بلدان العالم. ورغم شعوري أن الكثير لم ينجز بعد، ولكن استجابة لإلحاح الكثيرين ممن حضروا هذه الفعاليات، فقد قمت بهذه المحاولة من صياغة الحجج في شكل مدون في كتاب قصدت أن يكون قصيراً بناء على ما رآه البعض من أن المطلوب هو مقدمة موجزة ومركزة للقضايا الأساسية التي من شأنها أن تشكل أساساً لمزيد من المناقشة والاستكشاف لتفاصيل أكثر.
وأود أن أعبر عن امتناني لما تلقيته من الكثير من الأسئلة والتعليقات والنقد، مما ساعدني في مهمتي. أما أوجه القصور، فأنا فقط المسؤول عنها. أما عن الأسلوب المتبع في الكتاب، فسوف أحاول أن أتناول الموضوع في إطار الجدل الحالي حسب فهمي له. وسأقتبس كثيراً من أقوال العلماء والمفكرين البارزين لتقديم صورة واضحة لما يقوله من يتصدرون الحوار الدائر حول القضية. إلا أنني أدرك أن نزع الاقتباس من السياق الذي ورد فيه قد لا يكون منصفاً لقائل هذا الاقتباس، وقد يشوه الحق. ولذا، أتمنى أن أكون قد نجحت في تفادي هذه الخطوة بالذات.
ولكني إذا استخدمت كلمة الحق أخشى أن بعض المؤمنين بفكر ما بعد الحداثة Postmodernist قد يتوقفون عن القراءة، إلا أذا كان فضولهم يدفعهم لقراءة (وربما لهدم) نص كتبه شخص يؤمن فعلياً بالحق. وأنا أراه أمراً في غاية الغرابة أن من لا يعترفون بوجود شيء يسمى الحق يحاولون إقناعي بأن ما يقولونه حق! ربما أنا أسيء فهمهم، ولكن يبدو لي أنهم عندما يتحدثون إليّ أو يكتبون كتبهم، يستثنون أنفسهم من هذا المعيار العام الذي يقضى بعدم وجود حق. أي أنهم في نهاية الأمر يؤمنون بالحق.
وعلى أي حال، فالعلماء يهتمون بالحق، وإلا لماذا يتكبدون عناء العمل بالعلم؟ وبما أني أومن بالحق فقد حاولت أن أقتصر في اقتباساتي على ما يعبر نوعاً ما عن الموقف العام لكاتبها، وابتعدت عن اقتباس عبارات صدرت عن قائلها حينما لم يكن في أفضل حالاته، لأننا جميعاً معرضون للوقوع في ذلك.
ولكن ماذا عن التحيز؟ ليس هناك من يمكنه الهروب، لا الكاتب ولا القارئ. فكلنا منحازون من حيث إن كلاً منا له رؤية للعالم Worldview أو منظور خاص يرى به العالم من حوله، وهو يتكون من إجاباته الكاملة أو الجزئية عن الأسئلة التي يطرحها عليه الكون والحياة. وغالباً ما لا نكون هذه الفلسفة الحياتية أو المنظور بشكل دقيق قاطع، بل ربما تتكون حتى دون وعي منا، إلا أنها موجودة. وهذا المنظور يتشكل طبعاً بالخبرات وبالتفكير المتعمق فيها. وهو قابل للتغيير، بل إنه يتغير، بل إنه يتغير بالفعل إن وجد أدلة مقنعة، وهذا ما نرجوه.
والسؤال المحوري في هذا الكتاب هو سؤال يتعلق في جوهره بالفلسفة الحياتية أو المنظور: ما المنظور الأكثر توافقاً مع العلم: الإيمان بالله الخالق الحافظ أم الإلحاد؟ هل دفن العلم الله؟ فلنر إلى أي سيقودنا الدليل.
[1] تجربة يوضع فيها قط وسط ظروف تجعله حياً وميتاً في آن، مما يتطلب مزيداً من الملاحظة الدقيقة لتحديد حالته. (المترجم).
[2] يعرف “قاموس أكسفورد” Oxford Dictionary “الاختزالية” Reductionism بأنها تحليل ظاهرة معقدة ووصفها وفقاً لمكوناتها البسيطة أو الأساسية، وخاصة إذا كان الغرض تقديم تفسير واف. (المترجم).
[3] محاكمة جرت في مدينة دوفر الأمريكية حيث رفع بعض أولياء الأمور دعوى ضد منطقة دوفر التعليمية لأنها أقرت تدريس التصميم الذكي في المدارس التابعة لها. (المترجم)