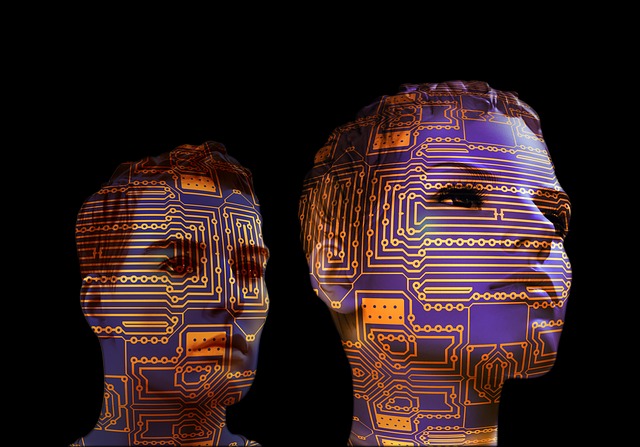كيف عرفنا يسوع – هل الأناجيل صادقة؟
كيف عرفنا يسوع – هل الأناجيل صادقة؟

كيف عرفنا يسوع – هل الأناجيل صادقة؟
في دراستنا لحياة يسوع وتعليمه، أخذناه أمراً مسلماً به أنه بمقدورنا أن نتعلم بالفعل شيئاً عنه من الأناجيل العهد الجديد. وقد عرفنا أن الأناجيل ليست سيراً ذاتيه ليسوع. وقد عرفنا أن الأناجيل ليست سيراً ذاتية ليسوع، بقدر ما هي مختارات منتقاة من أقواله وأعماله، جمعت معاً بسبب نفعها في خدمة الكرازة التي قامت بها الكنائس الأولى، ولكننا لم نأخذ هذه الحقيقة كسبب للتشكيك في مصداقيتها العامة بالنسبة ما روته عن حياة يسوع وتعليمه.
وفي غالبية النقاط شعرنا بأنه لدينا ما يبرر قبولنا لهذه السجلات كصورة عما كان عليه يسوع بالفعل، لا أن نعتبرها دراسات للحالة النفسية التي كان عليها المسيحيون الذين كانوا أول من كتبوا عنه.
ومع ذلك، يجب الاعتراف صراحة أن هذا الافتراض كان عرضة للشك من قبل عدد من الاتجاهات المختلفة. ولسنا في حاجة أن نتقبل بجدية أولئك الكتبة الذين يدعون بين آونة وأخرى أنه لم يكن ليسوع وجود على الإطلاق، ذلك أن لدينا دليلاً واضحاً على عكس ذلك من عدد من المصادر اليهودية واللاتينية والإسلامية. إلا أنه حين يدعي أناس درسوا العهد الجديد فترة طويلة أن الأناجيل لا تكشف شيئاً له أهميته عن يسوع، هنا علينا أن نواجه حججهم بك جدية.
ولعل أكثر التعبيرات تطرفاً في جيلنا بالنسبة لهذا الرأي ترتبط باسم رودولف بولتمان. ذلك أنه في كتاب صدر لأول مرة سنة 1934، ذكر قولته اللافتة للنظر: “أعتقد أننا نكاد لا نستطيع أن نعرف الآن شيئاً عن حياة يسوع وشخصيته”. وما يقصده بولتمان على وجه الدقة من قوله هذا يجب أن نقرره على ضوء بعض كتاباته الأخرى، حيث يوضح أنه يؤمن بالفعل بعناصر معينة من تعليم يسوع التي نجد في الأناجيل أن يسوع هو الذي قالها بنفسه. إلا أن بولتمان وحتى آخر يوم في حياته ظل متشككاً من ناحية احتمالية وقيمة المعرفة عن “يسوع التاريخي”.
وليس كل أتباع بولتمان كانوا متشككين مثله تماماً. وبمقدورنا أن نلمس هذا بوضوح كاف من كتاب جونثر بورنكام Gunther Bornkamm “يسوع الناصري” حيث يبين هذا حتى من وجهة النظر المتطرف التي يقول بها نقاد الصيغ. إلا أنه يتبقى مع ذلك الكثير مما يمكن معرفته بثقة عن يسوع. ولكنه، برغم كل هذا، فإن هؤلاء الباحثين الذين كانوا هم أكثر تأثراً ببولتمان وتناوله لنقد صيغة الأناجيل، فإنهم أخذوه أمراً مسلماً به بصفة عامة أن الأناجيل هي بصفة أساسية تعتبر سجلاً لمعتقدات الكنيسة الأولى عن يسوع، أكثر من كونها نوعاً من الروايات عن يسوع بالشكل الذي كان عليه حقيقة.
ومن الواضح أن معرفتنا بيسوع ليست هي نفس معرفتنا ونستون تشرشل Winston Churchill أو مارتن لوثر Martin Luther أو حتى بولس الرسول مثلاً. لأنه بمقدورنا أن نعرف هؤلاء الناس من خلال كتاباتهم وأقوالهم المسجلة. والواقع أنه بالنسبة لحالة لوثر وبولس، فإن المصدر الرئيسي لمعلوماتنا عنهما هي الكتب التي كتباها بنفسيهما. غير أن يسوع لم يكتب كتاباً. فقط أمضى حياته القصيرة كمعلم متجول، يعمل في أنحاء قاصية تقريباً من الإمبراطورية اليونانية، وبين أناس ربما لم يكن لهم أية اهتمامات بالموضوعات الأدبية.
ومن غير المحتمل إطلاقاً أن تكون أقوال يسوع وأعماله قد كتبت سواء بنفسه أو بواسطة أي شخص من معاصريه. وفضلاً عن ذلك نعرف أن يسوع كان يعيش في مجتمع لغته الأساسية هي اللغة الآرامية، ومع ذلك فإن معرفتنا بتعليمه جاءت من مصادر مكتوبة باليونانية. ومن المحتمل أن اللغة اليونانية كانت معروفة لشخص نشأ في الجليل. إلا أنه من المؤكد أن معظم تعاليم يسوع لم تعط أساساً بهذه اللغة، ولذلك فإن الأناجيل كانت ترجمة لأقوال يسوع باللغة التي كانت سائدة في الإمبراطورية الرومانية.
وعلاوة على ذلك، فإنه من نتائج تناقل أقوال يسوع باللغة اليونانية، أنه لدينا الآن في أناجيلنا قصص متباينة مما هو واضح أنه نفس التقليد الأساسي. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا الصلاة الربانية، سنجد أن إنجيلي متى ولوقا يحتفظان بترجمات مختلفة[1]. والتشابهات وثيقة جداً حتى إنه لا يوجد أي شك في أننا نتعامل مع نفس التقليد الأساسي. لكن الاختلافات بارزة ولا يمكن تفسيرها على أنها مجرد أشكال مختلفة من الترجمات. ونفس الملاحظات يمكن أن تقال بالنسبة لنقاط كثيرة أخرى في الأناجيل، وهي الحقائق الجوهرية التي يهتم بها نقاد الصيغ والتنقيح والمصدر.
ولا ينبغي علينا أن نضخم المشاكل. فهناك أجيال كثيرة من قراء الإنجيل ممن لا يعرفون شيئاً عما توصل إليه مفكرو العصر الحديث، لم يجدوا صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه الأمور. فعلى الرغم من وضوح القصص المختلفة عن يسوع، أو التقارير الخاصة بتعليمه، فمن الواضح أنه يوجد ترابط منطقي داخلي في الأناجيل ككل. وليس من الصعوبة بمكان أن نجمع معاً قصة مما قدمته لنا الأناجيل مجتمعة من “تعليم يسوع”، ثم إن العناصر الأساسية لهذا التعليم هي نفسها التي نجدها في كل الأناجيل الأربعة.
التعرف على أقوال يسوع الصحيحة
ولكن كيف لنا أن نتأكد من أن الأناجيل تحتوي على تعليم يسوع نفسه، وليس انطباعات الكنيسة الأولى عن يسوع؟ كان هذا السؤال موضوع مناقشة بين باحثي العهد الجديد طوال العقد الماضي أو ما يقرب من ذلك، ولا زال النقاش مستمراً. وكإجابة محتملة صممت بعض الاختبارات والتي اعتبرت وسائل يمكن الاعتماد عليها للتعرف على التعليم الحقيقي ليسوع في الأناجيل.
ولقد طبقت هذه الاختبارات بشكل شامل على الأناجيل المتشابهة بواسطة البروفسور نورمان بيرين Prof. Norman Perrin. وقد حدد ثلاثة اختبارات أو معايير منفصلة، تباحث على أساسها بأن هناك على الأقل ثلاثة مجالات في الإنجيل يمكن بيان مصداقيتها، وهي: الأمثال، التعليم الخاص بملكوت الله، والموضوعات المذكورة في الصلاة الربانية.
اختبار التمييز The test of distinctiveness
اختبار التمييز، سبق أن استعمله بولتمان نفسه في كتابه: “تاريخ تقليد الأناجيل المتشابهة”. وهو يقوم على افتراض أن أي شيء في تعليم يسوع يمكن أن يكون له نظير في التعليم اليهودي، أو في الفكر اللاهوتي للكنيسة الأولى يكون عرضة للشك في مصداقيته، لأنه يكون قد جاء وليد هذين المصدرين وليس من ذكريات حقيقية ليسوع.
وذلك حيث يكون تعليم يسوع فريداً تماماً ومميزاً فهنا نكون على ثقة أننا في اتصال مباشر بيسوع نفسه. ويمكننا أن نقدم أمثلة على ذلك باستعمال يسوع لكلمة “أبا” (أي أب) في مناجاته لله، وأسلوبه المميز في استهلال أقواله الهامة بعبارة الحق…). وعلى قدر علمنا فإن معلمي اليهود أو الكنيسة الأولى لم يستعملا هاتين الوسيلتين.
وهناك مفكرون كثيرون قد يتفقون مع بروفسور بيرن Perrin حين يدعي أن المعلومات التي تستخلص من الأناجيل بهذه الوسيلة تمثل حداً أدنى من المعرفة التاريخية عن يسوع لا يمكن انتقاصه.
لكننا إذا فحصناه بمزيد من العناية، فإنه من المشكوك فيه أنه حتى هذا الادعاء المتواضع يمكن تبريره تماماً على أساس هذه الوسيلة بعينها. لأن استخدامها بنجاح يعتمد بشكل كلي على الافتراض الآخر بأن معرفتنا الحاضرة باليهودية والكنيسة الأولى هي على وجه التقريب معرفة كاملة. ومع ذلك، فالحقيقة هي أننا لا نعرف سوى القليل جداً عن شكل اليهودية أيام يسوع.
فالمعلومات الجديدة تكتشف وتقيم بصفة مستمرة، ومن المؤكد أنه ستظهر معها نظائر جديدة لتعليم يسوع. وعلى ذلك فإن معيار التمييز كوسيلة يعد مشورة يائسة. والأمر لن يحتاج إلا إلى فترة من الوقت حتى يتم التوصل إلى النتيجة المنطقية، وهي أنه لا يمكن أن يعرف شيء مؤكد عن يسوع. إلى جانب ضعف هذه الوسيلة، توجد مشكلتان كبيرتان تتعلقان بهذا المنهج بالذات.
وحتى هذه الصورة المحدودة عن يسوع والتي جاءت وليدة هذه الوسيلة لا بد أن تكون غير واقعية وغير صحيحة في واقع الحياة، لأنها تفترض أن يسوع كان معزولاً تماماً عن الظروف المحيطة به. والقول المأثور: النص بلا قرينة هو نص مزعوم “A text without a content is a pretext” ينطبق هنا، كما هو الحال كثيراً بالنسبة للعظات الحديثة. فلا بد وأن يكون للمسيح سياق أو قرينة. ومن المؤكد أن قرينته كانت يهودية.
ومن المؤكد أيضاً أنه لا بد وأنه كان هناك قدراً من الاستمرارية بين يسوع والكنيسة الأولى. ويسوع الفريد بمعنى أن تعليمه لا علاقة له باليهودية أو بالكنيسة الأولى ليس من المحتمل أن يكون يسوع الحقيقي. وإذا لم يستطع هذا الاختبار الكشف عنه فلا بد وأن يحكم عليه بالفشل.
هناك مساحات كبيرة وهامة في الأناجيل لا تصلح فيها هذه الطريقة إطلاقاً. لنأخذ موضوع تعليم يسوع عن نفسه. فبالنسبة لهذا الموضوع يؤدي اختبار التمييز إلى نتائج سلبية تماماً بالنسبة لكل الألقاب الكبرى التي تمت نسبتها ليسوع. فألقاب (المسيا)، (ابن الله)، (ابن الإنسان)، استعملها كثيرون في الكنيسة الأولى، ومن ثم فإن تطبيق هذا الاختبار سيؤدي إلى استنتاج أن يسوع لم يعط أي تعليم عن مصيره وشخصه.
ونفس الشيء يحدث بالنسبة لموضوعاته الأخروية، لأن هذه يمكن أن يوجد لها مثيل في اليهودية وفي مصادر الكنيسة الأولى. بل أن التعليم المميز الخاص بالموعظة على الجبل سوف يستبعد للسبب نفسه، ذلك أن بولس يظهر أنه على معرفة واضحة بذلك (انظر رو 12-14). وعلى ذلك فإنه توجد غلطة جوهرية في مفهوم هذه العملية كلها. لأنه لا مفر من أن هذا سيؤدي – سواء من الناحية النظرية أو العملية – إلى الادعاء بأنه لا يمكن أن نعرف شيئاً مفيداً عن يسوع من الأناجيل.
اختبار الترابط المنطقي The test of coherence
الذين يستخدمون هذه الاختبارات لا يجهلون المشاكل المرتبطة باختبار التمييز. ولذلك يقدم بيرين Perrin اختباراً آخر يمكن استخدامه معها. وهذا هو ما يعرف باسم “اختبار الترابط المنطقي”. وهي يقوم على افتراض أن أية مادة في الأناجيل تتناغم مع التعليم الذي ينجح في اجتياز اختبار التمييز يمكن اعتبارها تصريحاً حقيقياً لما قاله أو علمه يسوع.
ومن الناحية الظاهرية، يبدو هذا الاختبار الآخر واعداً. ولكن هذا بالطبع يعتمد وبشكل كبير جداً على التطبيق الصحيح للاختبار الأول. وسبق لنا أن عرفنا الصعاب التي تحيط به، فإذا لم يؤد إلى نتائج أكيدة، فهنا يكون هذا الاختبار بلا فائدة أيضاً.
وعلى أية حال فإنه من الصعب جداً الحكم على ما هو مترابط منطقياً، وما هو ليس كذلك. وحتى لو افترضنا أنه يمكننا أن نصدر حكمنا في هذا الشأن، فليس من ضمان في أن ما بدا لنا مترابطاً سيبدو كذلك بالنسبة للكنيسة الأولى. وهكذا نواجه مرة ثانية مصاعب عملية بالغة في تطبيق هذا الاختبار على تقاليد الإنجيل.
اختبار أكثر من مصدر The test of more than one source
هناك محك ثالث كثيراً ما استخدم لتقييم التقاليد التي تتحدث عن يسوع، وهو لا يعتمد بصفة مباشرة على المحكمين الآخرين. وكثيراً ما كان يستخدمه مانسون T. W. Manson الذي لم يكن لديه وقت لمنهج نقاد الصيغ.
واستناداً لهذا الاختبار، فالتعليم المذكور في الأناجيل يكون من تعاليم يسوع حقاً إذا لم يوجد في أكثر من مصدر واحد من مصادر الإنجيل. وهذا الاختبار نافع في هذا النطاق، لأنه إذا ما تولد فينا نفس الانطباع من إنجيل مرقص ومن المصدر Q عن مضمون تعاليم يسوع، فإنه من المعقول والحال هذه أن نعتقد أن هذا الانطباع أصيل. ولكن اختبار المصداقية هذا اكتنفته أيضاً عدة مصاعب، ولو أنها ليس كبيرة كتلك التي كانت تواجه تطبيق الاختبارين الآخرين.
ç لا يمكن – بواسطة هذه الوسيلة – أن نقرر شيئاً بالنسبة لأقوال محددة نسبت إلى يسوع، لأنه توجد قصص أو أقوال قليلة جداً متضمنة في أكثر من مصدر واحد من مصادر الإنجيل. والواقع أن هذه الحقيقة تعد من الأسس التي يقوم عليها منهج نقل مصادر الإنجيل بجملته. فإذا كان نفس التعليم مقدماً في كل مكان، لما كان في وسع “ستريتر” أن يصيغ نظريته عن مصادر الإنجيل. وهذا مفاده أن أقصى ما تستطيع أن تكتشفه هذه الطريقة هو اللهجة العامة لتعليم يسوع وليس تقريراً مفصلاً عنه.
ç ثم إن هناك قيد آخر يشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاختبار، لأنه قد يرفض تلك الأجزاء من تعليم يسوع التي توجد في مصدر واحد فقط من مصادر الإنجيل باعتبار أنها غير حقيقة. ومع ذلك، فهذه هي الحالة بالنسبة لبعض من أكثر أجزاء تعاليم يسوع المميزة. باستخدام هذا الاختبار، سينتج عنه رفض قصص مثل السامري الصالح (لوقا 10: 25-37)، أو الابن الضال (لوقا 15: 11-32) بصفة قاطعة من قصة حياة يسوع وتعليمه، وذلك لأنها لم توجد سوى في إنجيل لوقا فقط.
ç حين طبق مانسون وآخرون هذا الاختبار على الأناجيل استطاعوا أن يفترضوا فرقاً شديداً حقاً بين مصادر الإنجيل المختلفة، لأنه في ذلك الحين كان الباحثون البريطانيون يتبنون نظرية “ستريتر” وعلى نطاق واسع في صيغتها الأصلية تقريباً. إلا أن دراسة أكثر حداثة بينت أن موضوع العلاقات بين الأناجيل ومصادرها أكثر تعقيداً وبدرجة تفوق إلى حد كبير ما كان يعتقده “ستريتر”. فلم يعد بوسعنا الآن أن نفترض أن التقسم البسيط إلى أربعة مصادر مستقلة هي: مرقص والمصادر Q، M، L، على أنه تقسيم طبيعي.
عيب أساسي
من الواضح أنه توجد مشاكل عويصة كثيرة تتعلق باستخدام هذه الاختبارات للتعرف على الأقوال الحقيقية التي فاه بها يسوع، والتي تضمنتها الأناجيل. ولذلك فلربما لا يكون الأمر مدعاة للدهشة أن يكون بعض الباحثين قد توصلوا بالأحرى إلى نتائج سالبة. ومن الصعوبة أن نفهم كيف أنه كان بإمكانهم أن يفعلوا خلاف ذلك.
والواقع أنهي يوجد عيب أساسي في كل النهج الذي تمثله هذه الاختبارات. فكلها تبدأ من الافتراض الجوهري بأن الأناجيل في معظمها تحتوي على معتقدات الكنيسة الأولى، ولا تضم سوى القليل جداً، إن لم يكن لا شيء على الإطلاق مما جاء مباشرة من يسوع نفسه. ويعرض البروفسور بيرين سببين رئيسيين ليبرر بهما هذا التشاؤم.
ç فقد كتب يقول: “إن الكنيسة الأولى لم تبذل أية محاولة للتمييز بين الأقوال التي قالها يسوع كإنسان، وتلك التي قالها الرب المقام بواسطة نبي في المجتمع، أو بين تعليم يسوع الأساسي والفهم الجديد وإعادة الصياغة بالنسبة لذلك التعليم الذي تم التوصل إليه في الكنيسة تحت إرشاد رب الكنيسة.
ونقطة البداية لهذه الحجة تتمثل في حقيقة أن المسيحيين الأولين اعتقدوا بكل وضوح أن يسوع المقام كان حاضراً وعاملاً بين أتباعه في الكنيسة. وهو بالطبع لم يعد بعد حاضراً بالجسد، ومن ثم لا يمكن توصيل كلمته للمسيحيين إلا بطريقة غير مباشرة.
هناك مثال عن كيفية إمكان حدوث ذلك، يقال إنه وجد في الأصحاحات الثلاثة الأولى من سفر الرؤية. حيث نجد أن النبي المسيحي يوحنا يقوم بتسليم رسائل من المسيح السمائي إلى سبع كنائس في أسيا الصغرى، كذلك يذكر بولس أنبياء يعملون في الكنيسة (1كو 12: 27-31)، وكثيراً ما قيل إن عمله الرئيسي كان إصدار “أقوال ليسوع” لمواجهة حاجة معينة في حياة الكنيسة.
وعلى الرغم من أن هذه الحجة لاقت قبولاً على نطاق واسع لدى باحثي العهد الجديد، إلا أنها مشكوك فيها إلى حد كبير. ويمكن أن تقدم ضدها عدد من الاعتراضات الخطيرة.
أولاً: قامت على دليل مشكوك فيه. وعلى الرغم من أنه كثيراً ما كان يقال بثقة إن دور النبي المسيحي هو أن يخترع أقوالاً عن يسوع، إلا أنه لا يتوافر لدينا في الحقيقة دليل حقيقي لكي نبين ما الذي كان الأنبياء يعملونه في الكنيسة الأولى. فالرسائل إلى الكنائس السبع في سفر الرؤيا كانت خارج الموضوع تماماً، لأنه تم عمل فرق واضح هناك بين اختبار وأقوال كاتب السفر ورسالة المسيح المقام.
وعلى أية حال فقد ادعى أنه تلقاها في رؤية، وليس بمقدورنا القول بأنه اختلقها إلا إذا طرحنا الافتراض الآخر المشكوك فيه وهو أن الرؤى لا يمكن أن تحدث. والدليل الصريح الوحيد في العهد الجديد عن عمل هؤلاء الأنبياء نجده في (أعمال 13: 1-3) حيث يصدرون تعليمات بخصوص العمل المرسلي لبولس وبرنابا. وحتى التعليمات لم تعط باسم يسوع، بل بسلطان الروح القدس. والدليل من هذه النوعية يعد دليلاً ضعيفاً حتى إنه لا يعطينا سوى إشارة واهية إلى عمل الأنبياء على نحو من الدقة في حياة الكنيسة.
ثانياً: القول بأن الأنبياء لهم الحرية في اختلاق “أقوال ليسوع” يفترض أيضاً أن المسيحيين الأوائل لم يفرقوا بشكل واضح بين تعليم يسوع وتعليمهم. ولكن هذا أمر بعيد تماماً عن الصحة. ومما يبدو متناقضاً، أن دليلنا على هذا واضح للغاية في كتابات بولس، ولهذا السبب كان ملفتاً للنظر بشكل متزايد. لأنه، من بين كل كتبة العهد الجديد نجد بولس بالذات هو الذي كثيراً ما يتهم بأنه يتساهل في تعاليم يسوع.
ثم إنه ادعى أيضاً وأكثر من مرة أنه يتمتع بمواهب الله الخاصة بدرجة أعظم من كل معاصرين (1كو 14: 18-19؛ 2كو 12: 1-10) وهاتان الحقيقتان وحدهما تجعلانه مرشحاً مثالياً لأن يكون مورداً لأقوال يسوع. ولنا أن نتوقع أن تكون رسائله عامرة بمثل هذه الأقوال التي صنعها بنفسه بإلهام من الروح القدس من أجل تقديم النصح لقرائه. غير أننا في واقع الأمر نجد النقيض من ذلك. فعلى سبيل المثال، في (1كو 7) يخرج من نهجه ليميز بين آرائه وبين تعاليم يسوع.
ثالثاً: توجد مشكلة أخرى بالنسبة لافتراض أن الكنيسة الأولى كانت تختلق كثيراً من أقوال يسوع، وهي أن هذا افتراض يفتقر إلى المنطق. و”الدليل” الوحيد على أن الأنبياء كانوا يصيغون مثل هذه الأقوال يتمثل في فكرة أن تقاليد الإنجيل كان لها أصلها في الكنيسة الأولى وليس في خدمة يسوع.
وهناك إطار حياة مفترض تم تخيله بالنسبة للأناجيل، تم تفسير الأناجيل على ضوئه. وهذه عمليه مشكوك فيها للغاية، وليس إلى حلقة مفرغة دون أن يكون لها أي دليل خارجي. وليس ما يدعو للدهشة أنه حتى على هذا الأساس يمكن القول إن الأناجيل ما هي إلا نتاج تخيل تقي للكنيسة الأولى، وضع فيها الدليل بعد بداية البحث.
ç أما السبب الثاني لشكوك البروفسور بيرين فله أساس أقوى. فهو يؤكد – وعن صواب تام – أن القصد الأساسي من الأناجيل لم يكن تقديم معلومات تاريخية أو سيرة ذاتية ليسوع، بل بنيان قرائها. وكل شيء في الأناجيل يخدم غرضاً معيناً في حياة الكنيسة. ولكنه يستطرد قائلاً إن هذه الحقيقة في حد ذاتها تستبعد احتمال أن الأناجيل تضم ذكريات تاريخية ليسوع، على هذا النحو الذي كان عليه حقاً. وهذه حجة أخرى كثيراً ما يراد تأكيدها، إلا أنه نادراً ما تلقى التأييد.
ومع ذلك، لا يوجد على الإطلاق سبب منطقي، فما الداعي أن قصة أو جزءًا من تعليم يبلغ رسالة عملية أو لاهوتية أن يوصف بالزيف من الناحية التاريخية. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما ألقيت عظات على قول بولس إنه في المسيح “ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر. ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعاً واحد….” (غلا 3: 28).
ولا شك أن عظات كثيرة ألقيت حول هذا الموضوع، حيث نسبناها إلى مشاكلنا المعاصرة المتعلقة بالظلم وعدم المساواة. ومن المؤكد أنها مناسبة تماماً لهذا الموضوعات. إلا أن حقيقة أنني ألقي عظة تقوم على هذا النص، وأنسبها إلى مشاكل القرن العشرين لن تؤدي عادة بالناس إلى القول إنني وضعت الأقوال بنفسي، وإن بولس الرسول لم يكتب إطلاقاً الرسالة إلى أهل غلاطية، أو إنه حتى لم يكن له وجود على الإطلاق.
ذلك سيكون أمراً سخيفاً. ومع ذلك فإن هذا هو بالضبط من نوعية المبررات التي يطلقها بعض الباحثين على الأناجيل حين يحاجون بالقول إنه بالنظر إلى أن محتوياتها تناسب الحياة في منتصف القرن الأول، فقد لا يكون لها أي سياق تاريخي في حياة يسوع نفسه. إنها ببساطة تأكيد ليس له أي معنى.
مدخل لفهم الأناجيل
كثيرون من الباحثين يرون أن شكوك بولتمان وأتباعه غير مقبولة على الإطلاق. وهم عوضاً عن هذه الشكوك ينادون بأنه يوجد عدد من الأسباب القوية للبدء من الافتراض القائل بأن الأناجيل يعول عليها، وليس العكس، من ناحية اعتبارها سجلات تصف يسوع بالشكل الذي كان عليه فعلاً. وهناك عدد من الحجج الهامة تشير إلى هذا الاتجاه.
إذ نبدأ على المستوى العام، يتعين علينا ألا ننسى أن الكتبة القدامى لم يكونوا على وجه الإجمال حمقى أو مخادعين. فكثيرون من لاهوتي العصر الحديث (ولو أنهم ليسوا مؤرخين) يتحدثون باستخفاف عن مؤرخي العالم الروماني حتى إنه كثيراً ما يتولد لدينا الانطباع بأن مفهوم كتابة التاريخ على نحو صحيح لم يكون معروفاً لهم على الإطلاق. وإنها الحقيقة بالطبع أن المؤرخ في العصر القديم لم يكون تتوافر له كل الوسائل المساعدة الحديثة التي تتوافر لنا في أيامنا هذه.
ولكن هذا ليس معناه القول ببساطة إنه اختلق قصصه. فكل من المؤرخين اللاتين واليونان كانت لديهم معايير عالية، وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا دائماً يلتزمون بها، إلا أنه من المؤكد أن ذلك لم يكن سببه الافتقار إلى المحاولة. والمبادئ التي حددها أناس مثل لوسيان وثوسيديدس Lucian and Thucydides توضح لنا تماماً أنهم كانوا يعملون في إطار خطوط إرشادية لا يزال معمولاً بها حتى يومنا هذا.
وأي شيء آخر قد يقال عن الناس الذين كتبوا الأناجيل، فمن الواضح أنهم كانوا يعتقدون أنهم كانوا يعملون في إطار هذه النوعية من التقليد التاريخي. ولوقا يقول بوضوح إنه تخير كل مصادر معلوماته، وإنه كتب بحرص قصته على هذا الأساس. وبالنظر إلى أن كتبه الأناجيل المتشابهة الآخرين استعملوا أسلوباً مماثلاً تقريباً في التعامل مع مصادرهم، فإنه من الطبيعي افتراض أنهم عملوا أيضاً على نفس هذه الأسس.
ومن المؤكد أنهم جميعاً كانوا يعتقدون أنهم يقدمون معلومات حقيقية عن شخص كان يعيش بالفعل وبالطريقة التي وصفوها. ولم يكونوا يدرون أنهم يكتبون عن أقوال صدرت عن معاصريهم ونسبوها ليسوع. لقد اعتقدوا أن ربهم المقام كان بالفعل معلماً يهودياً من الجليل، وأنه كمعلم متجول فقد عاش وتكلم كما صوروه.
وهذه الحجة ليست بالطبع قوية جداً في حد ذاتها، لأن الإنجيليين ربما كانوا قد أخطأوا أو غرر بهم، ولكنها تكتسب قوة مضافة كبيرة حين نكتشف أن تفاصيل قصصهم تعطي بالفعل صورة صادقة للحياة في فلسطين في الوقت الذي قالوا إنهم كتبوا فيه. وحين نتذكر أنهم جميعاً كتبوا باللغة اليونانية لقراء من غير اليهود تقريباً، وأن اثنين منهم على الأقل لم يكونوا عائشين في فلسطين حين كتبا، فإن هذا يبدو أمراً رائعاً.
وفي نقطة تلو أخرى نكتشف أن خلفية الإنجيل صادقة وحقيقية. وفضلاً عن ذلك، ففي المواضع التي ساد الاعتقاد ذات مرة، أن ما سجلوه فيها جانبه الصواب (كما في حالة إنجيل يوحنا)، فإن الاكتشافات التالية لمعلومات جديدة كثيراً ما بينت أن الأناجيل تحتفظ بكتابات يعول عليها لعدد من التفاصيل الجغرافية والاجتماعية الهامة.
أرجعت أصول الأناجيل إلى سياق وقرينة يهودية بعمل اثنين من المفكرين الاسكندنافيين هما: هيرالد ريزنفلد Herold Riesenfeld وتلميذه بريجر جيرهاردسون Birger Gerhardsson. فقد عرض جيرهاردسون الرأي القائل إن تعليم يسوع كان مماثلاً جداً في الشكل لتعليم معلمي اليهود، وفي تحليل مطول لوسائل تعليمهم بين كيف أنهم يبذلون كل جهد للتأكد من أنه قد تم حفظها جيداً أو أنها انتقلت شفاهة إلى أتباعهم.
ويقول جيرهاردسون Gerhardsson إن يسوع تبنى نفس هذه الطرق، وإنه صاغ تعليمه على أساس أن يحفظها تلاميذه عن ظهر قلب حتى يستطيعوا أن يسلموها لأتباعهم بنفس صيغة الاستظهار السهلة هذه. وقيل إن تعليم يسوع سلم بهذه الطريقة “ككلمة مقدسة” في الكنيسة الأولى، وأن الأناجيل ما هي إلا كتابة التقاليد التي تعود إلى يسوع نفسه.
ومع ذلك، لا يتوافر لدينا دليل على أن المسيحيين الأوائل اعتبروا أنفسهم ناقلي التقليد. فقد كانوا كارزي الأخبار السارة، شارحين كيف أن حياة يسوع ورسالته تناسب احتياجات جيلهم. ولدينا الشهادة التي أجمعت عليها الأناجيل، بأن يسوع كان مختلفاً تماماً عن معلمي اليهود. وكان يعلم “كمن له سلطان”[2]، ولم يقم ببساطة بتسليم أقوال محفوظة عن ظهر قلب من مجموعة من التلاميذ إلى مجموعة أخرى.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن ما ادعاه ريزيفلد وجيرهارسون قد يكون مبالغاُ فيه، إلا أنهما قاما بتذكيرنا أن تعليم يسوع أعطي في سياق وقرينة يهودية، وفي ظل هذا فإنه تعليم قائد صاحب سلطان كان يعامل باحترام عظيم. وحتى لو لم يكن التلاميذ الأوائل قد تعلموا تعاليم يسوع بحفظها عن ظهر قلب، فمن المؤكد أنهم كانوا يقدرونها حق قدرها.
وهناك أيضاً دليل كاف على حفظ القصص شفاهة، وبطرق يعتمد عليها على نطاق العالم الهليني كله. لنأخذ مثلاً: حياة أبولونيوس التياني Apollonuis of Tyana، والتي سبق أن ذكرناها في فصل سابق. كان أبولونيوس هذا من معاصري يسوع، مع أنه عمر طويلاً ومات قرب نهاية القرن الأول. ومع ذلك، فإن قصة حياته لم تتم كتابتها حتى بداية القرن الثالث.
ومع أن الكاتب جمع قصص حياته من عدد من المصادر المختلفة، ومع أنه لم يكن كاتب سيرة غير متحيز، فإن عدداً قليلاً جداً من المؤرخين القدامى هم الذين ستتولد لديهم شكوك خطيرة عن الخطوط الرئيسية لقصته. وبالنسبة للأناجيل، فنحن نتعامل مع مصادر كتبت بعد الأحداث التي تتناولها بفترة قصيرة. وبالنسبة لمعظم الناس العاديين سيبدو أمراً سخيفاً أن يفترض أن أحداثاً كهذه لا فائدة منها من ناحية معرفة شيء ما عن يسوع نفسه.
وطبقاً لما يقوله المفكر الألماني يواقيم جرمياس فإن الأناجيل تجعلنا حقاً على اتصال وثيق بيسوع بالشكل الذي كان عليه بالفعل. وقد فحص جيرمياس النواحي اللغوية وقواعدها بحسب ما وردت في الإنجيل، ويقول بأننا نستطيع أن نسمع صوت يسوع الحقيقي فيها.
وبين آونة وآخرى نصادف كلمات آرامية حقيقية، حتى في النص اليوناني للأناجيل. وفي حالات أخرى كثيرة توجد فقرات نجد أن تراكيب لغوية آرامية قد استعملت في كتابة الأناجيل باللغة اليونانية. كما يحدد جيرمياس أيضاً عدداً من طرق الكلام يقول إن يسوع بصفة خاصة كان يستعملها. وكثير من تعليمه تم كتابته في صيغة الشعر الآرامي، ويمكن التعرف على ذلك حتى في الترجمة الإنجليزية.
وفي نقاط أخرى، كما سبق لنا القول، توضح أنه حين تترجم الأقوال المنسوبة إلى يسوع ثانية إلى اللغة الآرامية، فإنها غالباً ما تأخذ صيغة سامية نمطية، بل وتبين أساليب الجناس والسجع، والتي لا يمكن أن تكون لها معنى إلا في اللغة الآرامية فقط، ثم إن هناك الأمثال، والتي تختلف تماماً عن تعليم معلمي اليهود، واستخدام يسوع الخاص لكلمات مثل أبا (في عبارة أبا الآب) وآمين.
ومثل هذه السمات لا تثبت في حد ذاتها أن تقاليد الإنجيل ترجع إلى يسوع. وإذا حددنا كلامنا بدقة نقول إن أقصى ما تستطيع أن تظهره هو أنها ترجع إلى صيغة أمكن بواسطتها أن تحفظ بواسطة المسيحيين الذي كانوا يتكلمون اللغة الآرامية، إلا أننا حين نعود إلى ذلك السياق، فإننا نعود أيضاً إلى فترة تأتي بعد أحداث حياة يسوع، وموته وقيامته بوقت قصير. وفي ذلك الحين لا بد وأنه كان كثيرون من شهود العيان ما يزالون على قيد الحياة لكي يدحضوا أية أقوال تكون قد جاءت من محض الخيال.
وعلى هذا، فإن هذه الأحداث تؤيد صحة روايات الإنجيل عن تعليم يسوع، وجيرمياس على سبيل المثال لم يكن يساوره شك في أنها تضع عبء الإثبات على عاتق هؤلاء الذين يشككون في صحتها. في التقليد الخاص بالأناجيل المتشابهة، يكون المطلوب هو إثبات عدم صحة أقوال يسوع وليس صحتها.
وثمة اعتبار آخر يعطينا ثقة في قبول الأناجيل على أنها بصفة عامة سجلات صحيحة عن حياة يسوع وتعليمه، يتمثل في حقيقة أنها مختلفة عما نعرفه عن حياة واهتمامات الكنائس الأولى غير اليهودية. ومن الخطأ تصور أنه بالنظر إلى أن الأناجيل قد كتبت لخدمة احتياجات الكنائس، فهي لا تزيد عن كونها مرآة تعكس حياة الكنيسة الأولى. فبقية العهد الجديد تبين أنه كانت للكنيسة احتياجات لم تظهر – ولو من بعيد – في الأناجيل.
فمثلاً، لا يوجد تعليم حقيقي عن الكنيسة نفسها في الأناجيل. فهناك ثغرة واضحة للغاية حتى إننا نجد لزاماً علينا أن نسأل في أصحاح من الأصحاحات الأولى ما إذا كان يسوع مهتماً على الإطلاق بتأسيس الكنيسة. ولقد قيل في هذا الخصوص إن ظهور الكنيسة لم يكن بأي حال متعارضاً مع تعليم يسوع، غير أننا لا زلنا في حاجة إلى الاعتراف أنه لا يوجد في الواقع أي إرشاد محدد بالنسبة لهذا الموضوع في الأناجيل.
وحتى المعمودية، والتي سرعان ما أصبحت طقساً لدخول الشركة المسيحية، لم يذكرها يسوع مطلقاً باستثناء حالة واحة بعينها[3]. ويسوع نفسه لم يعمد أحداً، بل ولم يتخذ من المعمودية جزءًا رئيسياً من تعليمه. ومع ذلك فإن هذا كان موضوعاً له أهميته البالغة بالنسبة للكنيسة الأولى. وإذا كانوا حقاً قد دأبوا على اختلاق أقوال ليسوع لمواجهة احتياجاتهم، فمن المؤكد أنهم فقدوا هنا فرصة هامة.
ونجد نفس الافتقار إلى توجيه صريح بالنسبة لموضوعات هامة أخرى. فعلى سبيل المثال، نجد أن موضوع اليهود وغير اليهود لم تتعرض له الأناجيل في واقع الأمر، على الرغم من معرفتنا من بقية العهد الجديد الذي سرعان ما أصبح أحد الموضوعات الهامة على الإطلاق.
وفي مواضيع أخرى، نجد أن الأناجيل تشدد على أمر يختلف تماماً عما يشدد عليه بقية العهد الجديد. فمصطلح “ابن الإنسان” على سبيل المثال، أكثر الأسماء المستعلمة بالنسبة ليسوع في الأناجيل، لكنه بالكاد يظهر في أي موضع آخر. وهكذا أيضاً مصطلح “ملكوت الله” الذي كان يشكل جوهر تعليم يسوع، بالكاد نجد له ذكراً في بقية العهد الجديد.
والحقيقة هي أنه إذا حاولنا أن نعيد تركيب وضع حياة الكنيسة في الأناجيل، فلن نصل إطلاقاً إلى نوعية الصورة التي نعرف أنها حقيقية من رسائل العهد الجديد. لأنه توجد سمات عديدة جداً في قصص الإنجيل عن يسوع تختلف اختلافاً بيناً عن حياة واهتمامات الكنيسة الأولى.
وعلى هدى حقائق كهذه، يبدو من المعقول أن نستنتج أن هناك أسباباً قوية لافتراض أن الأناجيل تحتفظ بذكريات صادقة عن يسوع بالشكل الذي كان عليه فعلاً. وبالطابع كله الذي تقدمه صورتهم ليسوع جاء على نحو نحتاج معه إلى حجج قوية ومنطقية لنبين أنهم كانوا مخطئين بصفة جوهرية.
وهذا الافتراض لا يعني بالطبع أنه يمكننا أن نتبنى موقفاً ساذجاً لا يتفق مع قواعد النقد النزيه. ولم يكن الإنجيليون مجرد مسجلين للتقليد، بل كانوا مفسرين للحقائق التي سلمت لهم، ونحن في حاجة إلى أن نفحص عملهم بحرص لنتفهم الطبيعة الصحيحة لما كانوا يعملونه.
إلا أنه مما يعطينا ثقة بالفعل هو اعتقادنا أن التقليد الذي فسروه لقرائهم الأوائل كان تقليداً أصيلاً، وأنهم بصفة عامة حفظوا لنا قصة عن حياة يسوع وتعليمه. أما من ناحية ما إذا كانوا قد فعلوا هذا في أمثلة معينة، فهذا ما يجب بالطبع تحديده عن طريق فحص أجزاء معينة من عملهم من الناحيتين الأدبية والتاريخية.
الإعلان الإلهي والتاريخ
على ضوء كثير من الأسباب التي حملتنا على افتراض أصالة الأناجيل كسجلات لتعليم يسوع، فقد تأخذنا الدهشة تماماً أن مفكرين كثيرين جداً قد اتخذوا موقفاً سلبياً تجاهها, وثمة سبب جوهري لهذا من المؤكد أن نجده ليس في تناولهم للأناجيل ذاتها من الناحيتين التاريخية والأدبية، بقدر ما نجده في فهمهم الكلي لموضوع الإعلان الإلهي بجملته ومعرفة الله.
وحتى نفهم هذا، نحن في حاجة للرجوع إلى ما كتبه فريدريك شيلرميكر Friedrich Shleiemacher (1768-1834) والذي يطلق عليه “أبو الفكر اللاهوتي الحديث”. وفي محاولته مواجهة حركة التنوير الأوروبية، قال شيلرميكر إنه إذا كان للاعتقاد الديني أن يحتفظ بأية مصداقية بالنسبة للشعوب الغربية في العصر الحديث، فلسوف يتطلب الأمر أن يبعد تماماً عن نطاق البحث العقلاني. لأن العلم التاريخي في أيامنا هذه متشكك تماماً في كل ما يتعلق بفكرة أن الله يستطيع أن يجعل نفسه معروفاً في التاريخ من خلال نوعية الأحداث التي سجلها الكتاب المقدس.
ولذلك استهدف شيلرميكر إنقاذ المعتقد الديني مما شعر بأنه سيكون سبب خنقه لا محالة في جو التشكك هذا. وقد نادى بأن جوهر الإيمان مختلف بالكلية عن جوهر النواحي الأخلاقية التي توجه الجانب العملي في الحياة، أو العلم الذي يهتم بعمليات التفكير العقلاني، وقال إن الإيمان هو شعور خالص، وهذا معناه أن الاعتقاد الديني الذي يمكن أن يكون صحيحاً يجب أن يكون بمعزل عن أي شيء يمكن تفسيره علمياً.
وقام مفكرون في وقت لاحق بتحدي هذه الفكرة وتعديلها في نقاط كثيرة إلا أن تمييز شيلرميكر بوجه عام بين الديانة والأدلة العقلية كان أمراً حاسماً للتطور اللاحق في الفكر اللاهوتي في كثير من أنحاء العالم الغربي. وفي دراسة الأناجيل تم التعبير عن ذلك بقبول مبدأين أساسيين يسيطران على تفكير الكثيرين من المفكرين.
ç إعلان الله والتاريخ: يوجد لاهوتيون كثيرون وخاصة أولئك الذين هم على شاكلة بولتمان، ممن يتبنون التقليد اللوثري، يعتقدون أن الكون هو نظام مغلق، يعمل على أساس “نواميس طبيعية” صارمة لا يمكن كسرها. وهذا الاعتقاد إذا وصل إلى نتيجته المنطقية، فمعناه أنه من المستحيل أن توفق أي نوع من الأحداث المعجزية أو الفريدة في مفهومنا عن التاريخ. وإذا كانت أعمال العلم يمكن التنبؤ بها كلها، فهنا وبالتحديد، لا يمكن وقوع ما لا يمكن التنبؤ به.
ولذا فإنه بناء على هذا الرأي فلا مفر أن ينظر إلى الأناجيل على أنها شيء غير التاريخ، لأنها تتضمن بالفعل قصصاً عن عدد من الأحداث الفريدة التي يبدو أنها انتهكت “نواميس الطبيعة” كما هي معروفة لدينا.
وهناك حجج عديدة يمكن طرحها ضد مثل هذه النوعية من الآراء المتعلقة بالعالم وأحداثه، ويمكن القول إن هذا أمر عفا عليه الزمن. ومن المثير أن نلاحظ أنه عند هذه النقطة، نجد أن افتراضات بعض الفلاسفة واللاهوتيين أقل مرونة من آراء كثيرين من علماء العصر الحاضر. وعلى سبيل المثال فإن الاكتشافات التي توصل إليها علماء الطبيعيات في القرن العشرين، أوضحت في نقاط كثيرة مدى غموض المفهوم الذي ينظر إلى الكون على أنه نظام مغلق، وهناك علماء كثيرون يدركون الآن أن أعماله تتضمن أكثر من مجرد عملية آلية لقوانين العلة والمعلول.
ثم أنه، من وجهة نظر أخرى، فالاعتقاد بأن الكون نظام مفلق يمكن بسهولة أن يصبح وسيلة لتفادي الحاجة إلى اتخاذ الدليل الفعلي المستمد من التاريخ بمأخذ الجد. فإذا سمحنا لأنفسنا أن نتأمل المضامين الكاملة لروايات الإنجيل، أو في الواقع، في التاريخ ككل، علينا من حيث المبدأ أن نكون مستعدين أن نعمل في ظل تحديد أرحب للتاريخ والحقيقة أكثر مما يسمح به كثيرون من لاهوتي العصر الحديث. فالقول بأن الأحداث الاستثنائية لا يمكن أن تقع، أو أنه لا يوجد ما هو خارق للطبيعة، لا يعد إجابة من أي نوع للأسئلة التي طرحها التاريخ. فهذا معناه الاحتياج لأسئلة أكبر وأكثر أهمية.
ç الحقائق والإيمان: وهناك افتراض آخر كثيراً ما يطرحه اللاهوتيون وهو أنه ليس ثمة ارتباط بين الحقائق والإيمان، وأن العقيدة الدينية لا يمكن أن تقوم على حقائق التاريخ. وثمة مشكلة تواجه المسيحية عند هذه النقطة… لأنه أياً كان ما نقوله عن الإيمان المسيحي، فإنه بشكل ما مرتبط بيسوع الذي عاش ومات في القرن الأول في فلسطين. ولذلك، فإنه من جانب، لا بد أن يكون إيماناً “تاريخياً” ولكن ما الذي نعنيه حين نقول هذا؟
حين نتحدث عن “التاريخ” أو “الأحداث التاريخية”، فمن الممكن أن نعني أمرين: فمن ناحية، “التاريخ” يمكن أن يعني “الماضي”. فهو ما وقع في مناسبة معينة. وهو ما يمكن أن نكون قد رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا لو كنا نحن هناك. وهذه هي نوعية “التاريخ” الذي كان العقلانيون في القرن التاسع عشر يحاولون اكتشافه في بحثهم عن يسوع التاريخي، إلا أنه بوسعنا أيضاً أن نستخدم كلمة “تاريخ” لنعني بها الإشارة إلى الماضي، ما يمكن أن يطلق عليه “تاريخ – كقصة” وليس “تاريخاً – كحقيقة”.
ففي إحدى الحالتين نحن نتعامل مع الأمور الفعلية التي حدثت، وليس شيئاً آخر. وفي الحالة الأخرى، نتأمل الأحداث في نطاقها الصحيح وفي ضوء مغزاها الأساسي بالنسبة لوجودنا.
تمسك عدد من اللاهوتيين الألمان بهذا الفرق التقني، كوسيلة للفصل بين يسوع الذي هو موضوع الإيمان المسيحي (الرب المقام) عن يسوع التاريخي. وقد استعملوا كلمتين ألمانيتين مختلفتين لوصف نوعيتي التاريخ. فاستخدموا كلمة “Historie” للإشارة إلى “التاريخ كحقيقة” وكلمة “Geschichte” للإشارة إلى “التاريخ كقصة”. ويقولون إن النوع الثاني هو الذي يهم الإيمان المسيحي حقاً. إن مغزى التاريخ من ناحية تأثيره فينا هو الذي يهم، وليس التاريخ نفسه. وهذا معناه أن معرفة يسوع نفسه كشخص تاريخي لا علاقة له بالإيمان.
وهذه النوعية من التأكيد لا تكفي إطلاقاً، سواء كقول عن الفكر اللاهوتي بصفة عامة، أو كتصريح عن قصص الإنجيل التي تتناول حياة يسوع وتعليمه. والفرق الحاج الذي اصطنع بين التاريخ كحقيقة، والتاريخ كقصة، قام على أساس سوء فهم للطبيعة الأصلية للتاريخ كحقيقة، والتاريخ كقصة. لأن الناحيتين مرتبطان بعضهما ببعض برباط وثيق للغاية، ومن المستحيل أن نفكر في أحدهما دون أن نفترض الآخر أيضاً.
وما من أحد يكتب إطلاقاً التاريخ كقصة ما لم يكن مقتنعاً بأن شيئاً ما قد حدث فعلاً وله من الأهمية ما يكفي لأن يستحق الكتابة عنه. وعلى مثال ذلك، بمقدورنا الوصول إلى “ما حدث فعلاً” من خلال القصص والسجلات التي تتحدث عن ذلك في سياقها وفي مغزاها الشامل دون الحاجة إلى أي شيء آخر.
ولذلك فإنه من الناحية المنطقية فإنه لا مفر من أنه حين نتحدث عن “التاريخ”، سواء بصفة عامة أو في علاقته بالعهد الجديد، فإنه يتعين علينا أن نضمن شيئاً من كلا المعنيين. ثم إنه من المرغوب تماماً أن نفعل ذلك أيضاً. وإذا حصرنا انتباهنا في معنى التاريخ فلسوف نكون في موقف مشكوك فيه تماماً، لأنه إذا لم يقع حدث ما فعلاً، فأي تفسير نقيمه على أساسه لا بد وأن يكون بعيداً تماماً عن أي معنى.
وعلى سبيل المثال، سيكون من الحماقة أن أقنع نفسي أن يسوع مات من أجل خطيئتي، إذا لم يكن – كحقيقة تاريخية – قد مات على الإطلاق. وإذا ما قلت إن الإيمان مهم، والحقائق ليست هامة فلسوف تكون ساذجاً. فذلك يقودك بعيداً عن الموضوعية، ويشكل عقيدة دينية وهمية غير منطقية.
وكتبة العهد الجديد لم يكونوا يجهلون هذه الأسئلة، وقد قدموا إجاباتهم عليها. وفي قصة بولس الهامة عن قيامة يسوع ومغزاها، أكد وبقوة على أهمية الحقائق كعنصر لا غنى عنه في إيمانه المسيحي. وعلى الرغم من أنه هو نفسه أصبح مسيحياً نتيجة لقاء مباشر بالمسيح المقام، إلا أنه يضع فكره اللاهوتي بثبات وقوة في سياق حدث تاريخي اعتقد أنه يمكن إثباته بالطريقة العادية بواسطة تقارير الشهود. ولم يتردد إطلاقاً في القول إنه إذا كان الشهود على خطأ، وأنه “إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم….”[4].
والقصص المختلفة للكرازة المسيحية الأولى تؤكد أيضاً أن التاريخ مهم، والكثير من الكرازة “Kerygma” كما وصفها “دود Dodd” ما هي إلا سرد لحقائق عن يسوع. فالمسيح الذي يقابلنا في العهد الجديد، وكشخص سام في الأناجيل، ليس شبحاً أو خيالاً ليس له أهمية إلا في مغزاه. فهو شخص حقيقي يمكن أن يناسب عالمنا لأنه عاش بالفعل فيه.
لكن الأخبار السارة لا تتطلب منا أن نصبح مؤرخين قدامى لكي نكون مسيحيين. والحقائق تتطلب منا أن نعمل، وأن نمارس الإيمان. وإذ كان يسوع قد قام من الأموات، فعلينا أن نواجه المضامين المترتبة على ذلك، الحاجة إلى الخضوع إلى الرب المقام ومتطلباته بالنسبة لحياتنا. ولكن هذا يؤكد لنا أيضاً أن كلاً من متطلباته ومواعيده معقولة وعادلة وحقيقية لأنه يمكن تبريرها من أحداث التاريخ.
وأخيراً نقول، إن يسوع التاريخي لا يمكن إلا أن يكون يسوع الذي آمنت به الكنيسة، لأنه في أحداث حياة وموت وقيامة هذا الشخص، كان الله يعمل، ويكشف لنا عن طبيعته، مصالحاً العالم لنفسه.
أقوال ليسوع خارج العهد الجديد
وفي مواضع مختلفة من هذا الكتاب أشرنا إلى تقاليد عن حياة يسوع وتعليمه مما لا توجد في العهد الجديد. وثمة عدد من “الأناجيل” التي كتبت في القرن الثاني تزعم أنها تتحدث عن طفولة يسوع المبكرة. ثم ذكرنا أيضاً مجموعات من أقوال يسوع، مثل “إنجيل توما”. وهناك عدد كبير من هذه التقاليد التي تتحدث عن حياة يسوع معروفة لنا.
هذه المصادر ليست الوحيدة التي تحتوي على معلومات عن يسوع لا نجدها في أناجيل العهد الجديد. وبعض آباء الكنيسة يحتفظون بعدد قليل من القصاصات عن تعليم يقولون إن أول ما أعطاه هو الرب يسوع، وبالطبع نجد أحياناً في أجزاء أخرى من العهد الجديد نفسه إشارات إلى أقوال ليسوع لا توجد في الأناجيل. فعلى سبيل المثال، نجد أن بولس في ختام رسالته إلى شيوخ كنيسة أفسس يلخص ما قاله على أنه كلمات يسوع الذي قال “مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ”[5]. ومع ذلك لا توجد أقوال ليسوع كهذه مسجلة في أي موضع آخر في الأناجيل.
والمادة المحفوظة في مصادر القرن الثاني هي من طابع مختلف بشكل ملحوظ. والكثير منها، ولا سيما في قصص الطفولة، من الواضح أنها من الأساطير. وقد كتبت لتسد الثغرة التي تركتها أناجيل العهد الجديد، لأنها لم تذكر لنا شيئاً على الإطلاق عن طفولة يسوع. وكثير من قصص أناجيل الطفولة الأبوكريفية بعيدة عن الحقيقة، ولا هدف لها، ولا يحتاج الأمر إلا إلى قراءتها حتى ندرك أنها من طابع مختلفة تماماً عن قصص العهد الجديد التي يرويها عن يسوع.
ومع ذلك ثارت أسئلة أخرى حول مجموعات أقوال يسوع التي وجدت في مصادر مثل إنجيلي فيلبس وتوما، أو البرديات العديدة التي اكتشفت في البهنسا في صعيد مصر. ومعظم هذه المستندات كتبت لأغراض دينوية، وكثير منها جاء من المجموعات الغنوصية المختلفة التي كانت منتشرة في القرن الثاني، وبعده.
و”إنجيل توما” في صيغته الحالية تم وضعه لدعم حياة المجموعات السرية في الكنيسة. والعلماء غير متأكدين ما إذا كانت هذه جماعة غنوصية، أو نوعية أخرى من الجماعات المرتبطة بالمسيحية اليهودية، ولكنهم متفقون من ناحية اعتباره مصدراً أنتج لتأييد معتقدات شيعة معينة. وكثيراً من أقواله أخذت من العهد الجديد والبعض الآخر ربما أخذت مباشرة من مصدر غنوصي آخر.
إلا إنه إلى جانب هذا توجد أيضاً أقوال أخرى يبدو أنها من مصدر مستقل. فعلى سبيل المثال، القول 82 من إنجيل توما جاء به “قال يسوع: ذاك الذي بالقرب مني هو قريب من الإلهام، ذاك الذي هو بعيد عني هو بعيد عن الملكوت”. وهذا القول بالذات كان معروفاً لأب الكنيسة أوريجانوس (185-245م)، وربما تكون هناك إشارات إليه في كتابات بعض المسيحيين الأوائل الآخرين. ومن المؤكد أنه من سمات نوعية أقوال يسوع المسجلة في العهد الجديد، وعلاوة على ذلك، فإنه يتسم بصيغة الشعر الآرامي، والتي هي أيضاً سمة منتظمة من سمات تعليم يسوع في الأناجيل الأربعة.
ويوجد عدد من أقوال كهذه نجدها في كتابات الكنيسة الأولى. فهي لا تتضمن أي تعليم لعقيدة طائفية، وحين تتفق بشكل عام مع تعاليم يسوع الواردة في العهد الجديد، فلا يبدو أنه لا يوجد سبب للشك في أنها تعود إلى تقاليد صحيحة عن يسوع. أما إذا كانت على نفس المثال الذي أوردناه، تحمل صيغة الشعر السامي، فإن هذا يعد دلالة أخرى على طابعها البدائي. وفي كتابه “أقوال غير معروفة ليسوع” عزل البروفسور جيرمياس عدداً من هذه القصص التي تحوي تعليماً، وعدداً قليلاً من القصص التي قيلت عن يسوع، والتي يعتقد أنها قد تكون ذكريات حقيقية عن حياة يسوع نفسه.
ولا شك أن البعض منها يحمل علامات صحته. وحقيقة أن هذه المعلومات حفظت خارج العهد الجديد لا يجب أن تدهشنا. فكاتب إنجيل يوحنا يشير إلى قصص كثيرة عن حياة يسوع وتعاليمه كانت معروفة له، ولكنه لم يستخدمها في إنجيله. ولكن بوسعنا أن نكون على ثقة من أنها لن تكون معروفة على الإطلاق بالنسبة للكنيسة. ولا شك أنه تم تذكرها، وتم تكرارها، وربما انتهى الأمر ببعض منها إلى أن سجل في السجلات المختلفة السابق ذكرها هنا.
إلا أنه من الأهمية أن نلاحظ أنه بالمقارنة مع العدد الكبير من التقاليد الأبوكريفية عن يسوع، فإن نسبة ضئيلة فقط، هي التي يمكن وعن حياء الادعاء بصحتها. أما الأغلبية الساحقة من المادة لا قيمة لها على الإطلاق كمصدر تاريخي للمعرفة عن يسوع. وليس من شك أن البروفسور جيرمياس كان محقاً حين يعلق قائلاً: القيمة الحقيقية للتقليد الموجود خارج الأناجيل تتمثل في أنه يلقى الضوء على القيمة الحقيقية للأناجيل القانونية نفسها.
وإذا كنا نود أن نتعلم عن حياة يسوع ورسالته، فإننا “لن” نجد ما نبتغيه إلا في الأناجيل الأربعة القانونية. أما الأقوال الربانية المفقودة، فقد تدعم معرفتنا المشتتة هنا وهناك في بعض الأمور الهامة، ولكنها لا تستطيع أكثر من ذلك.
[1] متى 6: 9-13؛ لوقا 11: 2-4.
[2] مرقص 1: 22.
[3] متى 28: 19.
[4] 1كورنثوس 15: 17.
[5] أعمال 20: 35.