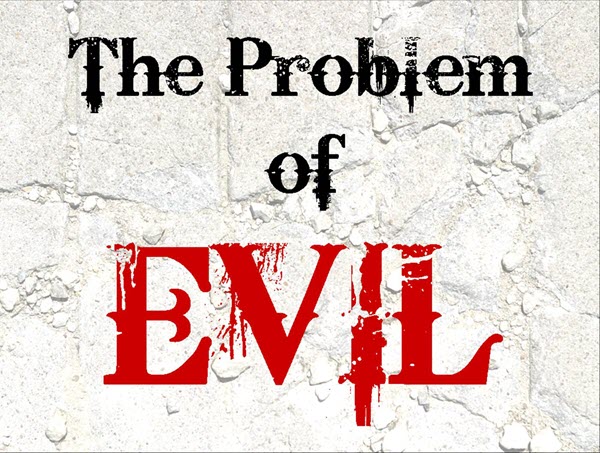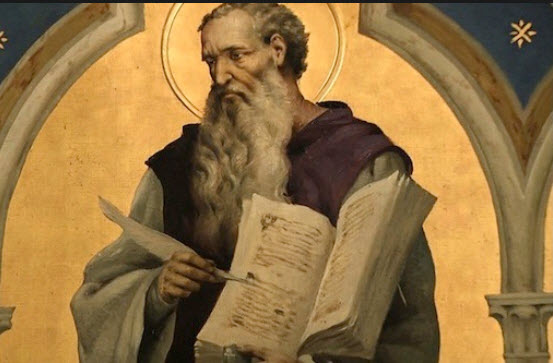لاهوت الكتاب المقدس (الوحي – العصمة) – فادى أليكساندر
لاهوت الكتاب المقدس (الوحي – العصمة) – فادى أليكساندر
لا يُوجد شيء إسمه لاهوت الكتاب المقدس. لا يُوجد فرع من فروع اللاهوت المسيحي يُسمى بذلك الإسم. ولم يعرف آباء الكنيسة شيء إسمه لاهوت الكتاب المقدس. حينما أقول “لاهوت الكتاب المقدس”، فأعنى بذلك الاعتقاد في الكتاب المقدس. لم يكن هذا اللاهوت له وجود قبل عصر الإصلاح، حيث كانت إحدى المبادىء الرئيسية للفكر الإصلاحى هي “الكتاب المقدس فقط” Sola Scriptura. منذ ذلك العصر، أصبح للكتاب المقدس عقيدة ولاهوت حوله هو لذاته.
للأسف، ما قصده لوثر بحصر السلطة الإيمانية في الكتاب المقدس فقط، لم يكن هو المفهوم الذي استمر في التقليد الإنجيلي لمدة خمس قرون. حتى كالفن مؤسس الفكر المشيخي، وهو الفكر الإنجيلي الرئيسي في العالم ومصر، لم يُنادى بسلطة روحية للكتاب في حد ذاته، بل أكد أن السلطة تكمن في الروح والمجتمع الروحي. ومنذ الربع الأخير من القرن العشرين، بدأ اللاهوتيين الإنجيليين في العودة لفهم أصول هذا الفكر اللاهوتي بالتحديد من هذا الحصر.
حينما أقول إن الآباء لم يسلمونا لاهوت واضح للكتاب المقدس، فأعنى بذلك أنهم لم يسلمونا عقيدة واضحة في الكتاب المقدس. لاهوت الكتاب المقدس الذي تطور عبر مائتي عام، هو ثلاثة فروع: الوحي، العصمة، والسلطة. الكتاب المقدس علمنا أنه وحي من الله، والآباء علمونا أنه وحي من الله. لكن الآباء لم يقدموا لاهوتاً واضحاً لهذا الوحي، ولم يشرحوه، ولم يتعرضوا له إلا قليلاً.
أما عقيدة العصمة عند الآباء فلم يكن لها معالم واضحة، ولا نراها بوضوح عند أحد منهم، بل ولا تظهر عند الكثيرين من الآباء. وحتى هؤلاء الآباء الذين تكلموا عن العصمة، لم يذكروها اصطلاحاً وإنما بحسب مضمونها. وبشكل أو بآخر، لا نرى إجماعاً آبائياً على العصمة، ولا على محتواها، ولا مفهومها، ولا على دلالاتها ابداً. أول مناقشة صريحة تظهر عند الآباء حول العصمة بشكل مُفصل، نراها عند بيتر ابيلارد الذي عاش في نهايات القرن الحادي عشر وبدايات القرن الثاني عشر، وقد مارسها بلاهوت سكولاستى بحت. لكن كان كل تركيز الآباء على سلطة الكتاب المقدس، من الناحية العقيدية والروحية والأخلاقية.
هذا يعنى بوضوح: أن هناك من الآباء من اعتقد بان الكتاب المقدس لا يوجد به خطأ، وهناك من الآباء من اعتقد بأن الكتاب المقدس فيه خطأ، ولكن الإجماع العام للآباء هو انعدام وجود لاهوت الكتاب المقدس بشكل عام، أي عدم وجود اعتقاد معين في الكتاب المقدس.
فى هذه الدراسة، سأتناول بشكل منهجى، تطور نظريات الوحي والعصمة، ولن أتعرض لمفهوم السلطة، لأنه مفهوم روحي لا علاقة له بهذه الدراسة النظرية. ولأن مجتمعنا الشرقى كان بعيداً تمام البعد عن هذا اللاهوت، لاهوت الكتاب المقدس، الذي تطور في الغرب، فأغلب هذه الدراسة سيتمركز حول دراسات العلماء الإنجيليين في الغرب. إن أي نقد أوجهه للفكر الإنجيلي لا يعنى ابداً أننى أنطلق من خلفية مسبقة معادية للفكر الإنجيلى.
لقد نشأت في بيت إنجيلى وعشت طفولتى في الكنيسة الإنجيلية، وحتى اليوم مازلت مندمجاً مع الإنجيليين. أنا أقر منذ زمن بعيد، أن العلماء الإنجيليين هم الذين حموا الإيمان المسيحي في الغرب. أمس تصدوا للحداثة، واليوم يواجهون ما بعد الحداثة. في الوقت نفسه الذي لا تعرف فيه الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية شيئاً بالمرة عن هذا الصراع، وتقاعسوا غير عالمين بالأمر. بكل محبة، كما انتقدت الفكر الأرثوذكسى سابقاً، أقدم نقداً أميناً لذلك اللاهوت الإنجيلي الذي حمى إيماننا المسيحى. لذلك أنا ألتمس عفوك عن ضعفى، فسامحنى على جرأتى.
التيارات اللاهوتية
نستطيع تقسيم التيارات اللاهوتية في اللاهوت المسيحي بشكل عام، وحول الكتاب المقدس بشكل خاص اليوم إلى ثلاث أقسام: الأصولية Fundamentalism، المحافظة Conservatism، والليبرالية Liberalism. فالأصولية هي التشدد والتعصب لفرضيات إيمانية سابقة على البحث العلمى، وتفرض نتائج الإيمان على البحث. أما الليبرالية فهى التشدد والتعصب لفرضيات إيمانية سابقة على البحث العلمي أيضًا، ولكن في ناحية مُضادة للإيمان. العامل المشترك بين الأصولية والليبرالية هو أن كلاهما يُوجه البحث. توجيه البحث هو البداية في الدراسة العلمية من حيث يريد الباحث أن ينتهى.
كمثال مُتعلق بموضوع هذه الدراسة: يبدأ الباحث الذي يُوجه بحثه من فرضية إيمانية معينة (الأصولية: نص الكتاب محفوظ لكل حرف فيه – الليبرالية: نص الكتاب مفقود لكل حرف فيه) ويبنى البحث الخاص به على هذه الفرضية، فيوجه مسار البحث ناحية هذه الفرضية. بذلك ينتهى الباحث من حيث أراد أن ينتهى حينما بدأ.
بين هذا وذاك، تقع المحافظة. المحافظة هي تبنى الدليل العلمي بمنتهى الحيادية، وإتباع البرهان إلى حيثما يذهب بالباحث. ما يميز المحافظة عن الأصولية والليبرالية، أمرين هامين: انعدام الفرضية، وتحدى النزعة. أما انعدام الفرضية، فهو أن الباحث يضع العلم فوق اللاهوت، فلا يضع فرضية لاهوتية ثم يُوجه البحث تجاهها. أما النزعة فهى ما يميل له الباحث تلقائياً (وليس عمداً) وعفوياً والتى تتكون من خلال الوسط العلمي للباحث. وتحدى النزعة هو سمة المحافظة دون سواها، لأنه يعنى أن الباحث يختبر نتائج بحثه العلمي في ضوء نزعات أخرى غير نزعته الشخصية.
كمثال: عن طريق البحث العلمي توصل الباحث إلى أن التاريخ يؤكد موت المسيح على الصليب. لكي يتأكد الباحث أن نزعته لم تفرض رؤيتها على منهجية البحث وبالتالي نتائج البحث، عليه أن يختبر هذه المنهجية (وبالتالى النتائج)، في ضوء نزعات أخرى، أي في نتائج قطاعات كبيرة أخرى من الباحثين. إذا تثبتت النتائج في ضوء النزعات المختلفة الأخرى، تأكد للباحث أنه استطاع تحدى نزعته الخاصة، وأن نتائج بحثه هي نتائج علمية لم يتم توجيهها بأى فرضية، ولم تؤثر عليها أي نزعة خاصة.
هذه التيارات اللاهوتية ظهر تطبيقها قبل اسمها، شأنهم شأن أي ظاهرة أخرى. غير أن المحافظة لم ترفض الليبرالية لمعاداتها للإيمان، وإلا فلما رفضت الأصولية التي تحامى عن الإيمان؟ إنما الرفض جاء من المنهجية المتبعة، واتخاذ الفرضية السابقة على البحث، وتغزية النزعة بدلاً من تحديها. أسباب الرفض هذه ذاتها، هي نفس أسباب رفض الأصولية أيضًا.
أساس الإيمان
فى اللاهوت التاريخي بأكمله، لا نجد سوى أساس واحد فقط للإيمان. هذا الأساس هو الاختبار الروحي، وليس سواه. إن كل طريق آخر للإيمان، هو طريق متعرج وغير صالح للوصول الآمن إلى ملكوت الله. لذلك لا يصح القول بأن الإيمان يُبنى على الكتاب المقدس، ولا على أي وسيلة أخرى. هذا يعنى أن الإيمان في المسيح، وليس في النص. كل إيمان يُبنى على النص، ويُبنى على الفكر، هو إيمان نظرى لا يُفيد إنساناً.
لكن المقابلة الروحية مع المسيح، الإله الذي كان ميتاً لكنه حى منذ الأزل وإلى الأبد، هي الإيمان ذاته. الاختبار الروحي ليس عاطفة، ولا هو مشاعر سيكولوجية تسيطر على الإنسان في حالة هياج وجداني. لكن هذا الاختبار حقيقة، وواقع، يستطيع الإنسان أن يلمسه بمجرد أن يتخذ القرار.
مناهج الإيمان إثنين: المنهج النظري، والمنهج الواقعي. الأول هو الإيمان بسبب دوافع عقلية ومنطقية ونظرية بحتة، والثاني هو الإيمان بسبب دوافع حقيقية وواقعية وملموسة. لا يُوجد مانع من البداية بالمنهج النظري، ولكن إن لم يكمله المنهج الواقعي، فهو إيمان ميت لا حياة فيه. كمثال، المنهج النظري هو الإيمان أن يسوع قام من الأموات لأن التاريخ يؤكد فعلاً أنه قام، بينما المنهج العملي هو الإيمان أن يسوع قام من الأموات لأن الفرد تقابل معه ولمسه حياً في حياته، وذلك في اختباره الروحي.
لكن ليس معنى أن الاكتفاء بالمنهج النظري يُنتج إيماناً ميتاً، هو أن هذا المنهج لا نفع منه. منافع هذا المنهج كثيرة جداً، حتى أنها في غالبية الحالات تتوج هذا المنهج النظري بالبداية في المنهج العملي. هناك شعور دفين في أعماق الإنسان، يعرفه كل من فحص التاريخ وتأكد من بياناته، أن لحظة التأكد من النظريات، تنتج حالة من الرهبة والخوف. الخوف من الواقع، لأن الواقع يتطلب مسئولية.
الاختبار الروحي، أساس الإيمان، هو مسئولية كبيرة وشاقة، وليس بهذه السهولة. في هذا الاختبار يقرر الباحث أن يدخل من الباب الضيق، وكل باحث قبل أن يدخل يعرف جيداً كم أن هذا الطريق شاقاً وصعباً. بكلمات أخرى، الحياة مع المسيح مسئولية، وليست هينة. هذه المسئولية هي الدافع الأول لرفض عمل الله في التاريخ البشرى، لأن الإنسان بغريزته الطبيعية يرفض الله ويرفض التبرير والقداسة في المسيح.
لكن الله كان واضحاً مع الإنسان، أنه بدون القداسة لن يرى أحد الآب (عب 12: 14). هذا الحمل الثقيل، يرهبه ويخافه كل باحث جداً لحظة أن يتأكد من مصداقية التاريخ.
للأسف، دائماً ما يحاول الإنسان أن يغلف رفضه الروحي بعوامل وأسباب عقلية. تعدى البرهان وكسره، ليستطيع التملص من المسئولية التي عليه أن يتحملها إذا ما أتخذ القرار. لأن الأخلاقيات التي تفرضها العلاقة مع الله، يتخيلها كل باحث في البداية شبه مستحيلة، تصبح هي العائق الرئيسي بينه وبين تحدى النزعة، خاصةً في الاتجاه الليبرالي. لكن على مستوى العامة، يكون الوضع أصعب بكثير. إحدى المرات قالت لي صديقة أنها تعاني من مشكلة ضخمة مع خطيبها، إذ أنه ترك الإيمان وألحد.
تكلمت مع هذا الشاب لأعرف لما ألحد، فحاول بكل الطرق أن يُوحى لي بأنها أسباب عقلية هي التي دفعته للتخلي عن الإيمان. لكن للأسف، لم يكن يعرف شيئاً عن البحث العلمي في المسيحية، وكل أسبابه ظهرت أمامي كمن يريد حجة ويبحث عن سبب ليتخلى عن الله. فسألتها عن شكل حياته، وأدركت أنها المشكلة الأخلاقية. كم كنت حزيناً أن أرى إنساناً يرفض الله لأجل متع دنيوية زائفة، ولا يهتم لدموع إنسانة أحبته بكل كيانها!
النتيجة واحدة، سواء على مستوى الباحث أو على مستوى الإنسان العادي. فكلاهما يضع الفرضية ويغذى النزعة، فيصل إلى معانقة المشكلة الأخلاقية ويبتعد عن الله، مُغلفاً هذا الابتعاد بالأسباب العقلية التي يوهم نفسه بها.
كان هذا عن الليبرالية، ولكن نفس الأمر يحدث مع الأصوليين، ولكن مع تغييرات بسيطة. فالله يصبح كالشرطي، بحسب الأصوليين، يبحث عن ثغرات وسقطات في حياة الإنسان لكي ينزل به أشد أنواع العقاب وينكل به. هذه الصورة المرعبة تساهم بشكل رئيسي في تولد الخوف والرعب لدى الباحث، وينطلق منها مُوجِهاً بحثه، في محاولة لتلاشى هذا الإله المرعب. هذا التشويه يمتد لكل أساسيات اللاهوت المسيحي، ولكن أشهر مثال هو صورة الله بحسب الأصولية.
من ضمن التشويهات الرئيسية الأخرى التي قام بها الأصوليين، هو تشويش أساس الإيمان. مارتن لوثر لم يكن يهدف بحصر السلطة في الكتاب المقدس فقط أن يعزل الكتاب عن الوسط الذي نما فيه هذا الكتاب، وإنما عن السلطة البابوية في روما، وإخراج الكتاب للشعب المسيحي في الغرب.
ولكن الأصولية شوهت هذا المفهوم لزمن طويل، حتى بدأ اللاهوتيين مع بداية القرن العشرين – خاصةً علماء معهد برينستون بنجامين وارفيلد وتشارلز هودجز – في مراجعة المفاهيم الأصولية عن سلطة الكتاب المقدس. ومنذ السبعينات، عكف اللاهوتيين الإنجيليين، وخاصةً في كندا، على مراجعة لاهوت لوثر، ومقارنته بلاهوت الأصولية.
تأثير الأصولية على أساس الإيمان، لا يقل خطراً عن تأثير الليبرالية. ففي الأصولية تحول أساس الإيمان من المسيح إلى الكتاب المقدس. في الشرق، يظهر هذا التأثير في قمة قوته، بينما لا نرى أثراً لليبرالية إلا نادراً. يظهر هذا بوضوح مع مراجعة تاريخ الإرساليات الأميركية إلى الشرق العربي في القرن التاسع عشر بشكل خاص.
هذا العامل، والذي شعرت الكنائس التقليدية بخطره بشكل مباشر لم يتكرر مرة أخرى، بالإضافة إلى تأثير الثقافة الإسلامية المحيطة حول عقيدة المسلمين في تنزيل نص القرآن، ساهما بشكل متضخم جداً في ترسيخ المبادئ الأصولية وتشوش أساس الإيمان، بل وفي تشوش المفاهيم اللاهوتية التي نستطيع استقراءها من الكتاب المقدس، حول ماهية وحيه.
واليوم، نرى ثمار نمو هذا الفكر المُشوش، بإحلال مسيحيي الشرق للكتاب المقدس بدلاً من الاختبار الروحي والمقابلة مع المسيح القائم من الموت، كأساس للإيمان. نتج عن هذا تحولات كبيرة وكثيرة في الفكر اللاهوتي بشكل عام في الكنائس الشرقية.
إعادة بناء اللاهوت
إن أشد ما نحتاج إليه الآن في هذا الزمان، هو أن نعيد النظر فيما توارثناه من تقاليد خاصة، ومفاهيم غريبة، وتفاسير شخصية لنص الكتاب المقدس. ما تحتاج إليه الكنائس الشرقية، وخاصةً كنائسنا في مصر، هو مراجعة لاهوتها في ضوء الفكر الأصولي، وتنقيته من كل الشوائب التي لحقت به. حتى الكنيسة الإنجيلية في مصر، عليها أن تواكب الفكر الإنجيلي العالمي. للأسف، نحن المسيحيين في الشرق بحاجة إلى بناء لاهوتنا متكاملاً، وليس فيما يخص الكتاب المقدس فقط.
عقيدتنا في الثالوث، تاهت وأصبحت مشوشة، وأصبحنا لا نعرف عن الثالوث سوى شمس وضوء وحرارة! وعقيدتنا في فداء المسيح لنا، محت الهوية الأرثوذكسية وأحلت بدلاً منها النظرية الإنجيلية في الفداء القانوني. فلتؤمن كل كنيسة بعقيدتها التاريخية، وليكن الاختلاف قائماً ولكن لتلتزم كل كنيسة بهويتها. ما يملأنى حزناً وكآبة على الكنائس الشرقية كافةً، أنها نسيت قيامة الرب يسوع من الموت. نسينا قيامة الرب كشفاء البشرية، ونسينا قيامة الرب كتحرير للبشرية من الناموس، وبالأكثر نسينا قيامة الرب يسوع كتأكيد واضح ومباشر على حقيقة تصريحاته كابن الله.
لقد ظهر في هذا الجيل رجالاً من الله، أعادوا بناء اللاهوت بشكل مستقيم بما يتناسب مع الهوية المسيحية، وأظهروا التعليم الآبائي المستقيم. لم يكن ذلك في الكنائس التقليدية فقط، بل أرسل الله للكنيسة الإنجيلية رجالاً علماء أشداء. وللأسف الشديد، رفضنا هؤلاء الرجال القديسين، ورفضنا علمهم، ورفضنا لاهوتهم وتكبرنا عليهم. لقد نطق المسيح حقاً حينما قال: “لَيْسَ نَبِيٌّ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ” (مت 13: 57؛ مر 6: 4).
لست أدعى أننى أحد هؤلاء الأبرار المعاصرين، بل أعرف في داخل نفسي كم أن قلبي قاسى ورفض الرب وعمله كثيراً، وموقن أننى لست سوى خاطئ تمرر في الخطية كثيراً ورفض نعمة الرب زمان هذا قدره. لست أدعى أننى مصلح لاهوتي، ولست أدعى أننى عالم في أي مجال مسيحي. ولكن كل دراساتي بما فيهم هذه الدراسة، هي مجرد محاولات واجتهادات أشرح فيها بعض الأفكار التي أتوصل لها.
لست أدعى أن ما أقوله هو حق مطلق، لكننى مقتنع بكل حرف أكتبه. هذه رؤيتي، وهذا ما تعلمته من علماء المسيحية، وأنت لك عقل تستطيع به أن تميز. أنا لا أفرض رؤيتي عليك، ولا أقول لك أنك يجب أن تقبل ما كتبته وما سأكتبه. هذا مجرد طرح أؤمن به، وأنشره فقط، ولكن لا أقصد به سوى أنه رؤيتي التي تعلمتها من العلماء وكتاباتهم.
فليعيننا الله أن نستنير بإنجيل المسيح.
الوحي
بعد هذه المقدمة الطويلة، أعود وأكرر أن آباء الكنيسة لم يعرفوا عقيدة محددة في الكتاب المقدس، سوى أنه كلمة الله. هذه البساطة في الإيمان بالكتاب المقدس ككلمة الله، لم تحتاج إلى تعقيد بالغ ينتج عنه بناء لاهوت متكامل حول الكتاب المقدس. ولكننا أصبحنا في عصر يستلزم فيه أن نوضح ونفصل حول ماهية إيماننا وعقيدتنا في الكتاب المقدس. لكن هذا التفصيل لا يبدأ من الكتاب المقدس نفسه، بل يبدأ من المفهوم البدائي: الوحي.
مفهوم “الوحي” له دلالات كثيرة وأشكال كثيرة، ولكن رغم هذه الأشكال والصور الكثيرة، فجوهر معناه واحد: أن الوحي في المفهوم الديني، هو اتصال الله بالإنسان. هناك ثلاث مصطلحات تُترجم بالعربية إلى “الوحي”، لكن لها ثلاثة أشكال مختلفة:
- المصطلح الأول: Revelation. هذا المصطلح يُشير إلى إظهار الله لنفسه وإعلانه عن نفسه للإنسان. قد يكون ذلك الإعلان في الرؤيا، في الحلم، أو عبر أي طريق آخر.
- المصطلح الثاني: Inspiration. وهذا النوع هو وحي الكتاب المقدس، والذي نقصد به أن الكتاب المقدس هو كلمة الله التي أوحى بها لبعض الرجال القديسين، فدونوها في الكتاب المقدس، أي كانت الطريقة وبأى وسيلة وبأي شكل.
- المصطلح الثالث: Illumination. وهو عمل الروح القدس بداخل كل إنسان، ليرشده ويقوده أثناء قراءة الكتاب المقدس، للوصول إلى المعنى الصحيح للنص.
هذه التصنيفات تختلف في أشكالها ووسائلها، ولكنهم جميعاً وحي من الله للإنسان. فالإعلان الإلهي (وهو يختلف عن الظهور الإلهي أو الثيؤفانيا ولا يجب الخلط بينهم)، هو اتصال بين الله والإنسان، وهو وحي، ولكنه يختلف عن الكتاب المقدس ككلمة الله، وهو وحي أيضًا، والإثنين يختلفان عن إرشاد الروح القدس، وهو وحي أيضًا. الثلاث أشكال يتفقون في جوهرهم على أنهم اتصال مباشر وحقيقي بين الله والإنسان، وهذا الاتصال في حد ذاته هو الوحي. ولكن الثلاثة يختلفون في طبيعتهم ووسائلهم. ما سأتحدث عنه هنا هو وحي الكتاب المقدس.
الإيمان المسيحي الراسخ في اللاهوت التاريخي، والثابت من جذوره، حول الوحي، هو أن الله تعامل مع الإنسان، وجعله شريكاً في عملية الوحي. نحن لا نعرف بالضبط كيف تمت عملية الوحي، لهذا فالوحي لا يُسمى “عقيدة كتابية”، لأن الكتاب لم يعلم عنه سوى وجوده، لكننا نستطيع استقراء بعض الملابسات والمعلومات من الكتاب المقدس حول ماهية الوحي، لهذا الوحي يُسمى “عقيدة لاهوتية”.
لقد شرحت سابقاً نصوص الوحي في العهد الجديد، فلا أريد أن أتعرض لها ثانيةً الآن. لكن سوف أقوم بالتركيز على كيفية فهم وحي الكتاب المقدس، والنظريات التي نشأت حوله. وحينما أتكلم عن النظريات هنا، فلا أتكلم عن نظريات الوحي العامة، بل على طرق وحي الكتاب المقدس. في الحقيقة، أسلوب وحي الكتاب المقدس ليس واحداً في كل أجزاؤه، وهناك نظريتين رئيسيتين عن شكل الوحي المُقدم في الكتاب المقدس.
نظريات الوحي الخاص
النظرية الأولى “الخبرة النبوية”: وهذه النظرية تعنى أن الكتاب المقدس يحتوي خبرات الأنبياء أثناء حديثهم مع الله سواء في رؤية، حلم، أو عبر ملاك، أو عن طريق الحديث المباشر مع الله. فبعدما اختبر الأنبياء الله، قاموا بتسجيل هذا الاختبار ودونوه في سجلاتهم، التي أصبحت كتباً مقدسة فيما بعد، لأنها تحوي مذكرات هؤلاء الأنبياء عن هذه الأحداث الفريدة التي تمت.
يصاحب هذه الخبرة دائماً، أقوال وتعليمات مباشرة من الله، وهي تلك الأقوال التي يكررها الأنبياء مرة أخرى على المستمعين، ومن ثم تتم كتابها ليتم تداولها ونشرها بشكل أوسع. نستطيع أن نرى بالمقارنة، أن الأنبياء لم يلتزموا دائماً بالرسالة التي تلقوها حرفياً، بل بعض الأحيان عبروا بأسلوبهم الخاص، فأضافوا أو حذفوا قليلاً، بحسب الحاجة.
وفي هذه النظرية يجب وضع عدة اعتبارات: أن هذه النظرية خاصة ببعض النصوص القليلة فقط، وغالباً ما تكون في العهد القديم والتي تحتوي على بعض التعبيرات مثل: “وقال الرب” أو “وكانت كلمة الرب” ومثل هذه التعبيرات فقط، وأن هذه النظرية قد يكون بها نوع من الإملاء ولكن لا يُوجد ضرورة للالتزام بالحرفية المطلقة، وأنها نادرة جداً في العهد الجديد خارج سفر الرؤيا.
النظرية الثانية “قيادة الروح”: وهذه النظرية تعنى أن في كافة نصوص الكتاب المقدس، كان عمل الروح القدس شاهداً، وموجوداً، ومتداخلاً مع الكاتب. هذا العمل يتمثل بالكامل في أسفار الكتاب المقدس كلها، وبكافة أنواعها. لكن بتغير النوع الأدبي Genre لكل سفر، يتغير شكل عمل الروح القدس.
فالأسفار التاريخية التي تسرد تاريخاً، يختلف عمل الروح فيها عن الأسفار الشعرية، وكذلك عن بقية الأنواع الأدبية الموجودة في الكتاب المقدس. قيادة وعمل الروح كعامل رئيسي في الوحي، امر يختلف عن التلقي المباشر من الله.
لأننا بذلك نعنى أن عملية التدوين (البحث في المصادر الشفوية والمصادر المكتوبة، عمليات التسجيل والتوثيق، إجراءات التنقيح في مراحل ما قبل النشر…إلخ) قد تمت بقيادة الروح القدس. هذا يعنى أن العامل الإنساني لم يكن عملاً حراً بحسب إرادة الإنسان، وإنما بحسب إرادة الروح وقيادته للكاتب.
هاتين النظريتين عامتين بشكل كبير وواضح، ونحتاج فيهما إلى بعض التفصيل، خاصةً النظرية الثانية. لكي يكون كلامي واضحاً ومفهوماً، سأضع تصور للنظريتين بحسب الواقع الكتابي، للأولى من العهد القديم، وللثانية من العهد الجديد:
· التصور الأول:
أن يختار الله أحد الرجال القديسين، والذي يُرفِعه الله لمنزلة النبوة. ثم يعطى رسالة مباشرة لهذا النبي، عن طريق عدة وسائل: الظهور، الرؤيا، الحلم، الملاك…إلخ. يكون النبي في حالة وعى تام وهو في عملية الوحي، لأنه يقوم بعد ذلك بنقل هذه الرسالة، مما يؤكد أنه يكون واعياً لما يراه ويسمعه. يبدأ النبي مهمته بنقل هذه الرسالة للشعب، وغالباً هو يقوم بتكرارها، أي بإعادتها مرة أخرى، مما يعنى وجود نسبة عالية من الحرفية مرة لدى النبي، لأن نقل الرسالة غالباً ما يكون بمجرد تلقيها.
في أثناء نقل الرسالة قد يستخدم النبي أسلوبه الخاص، فيُضيف أو يحذف بحسب ما يحتاج إليه الأمر، لتصل الرسالة بشكل واضح، ويفهمها جميع الشعب. ثم بعد ذلك يتم كتابة هذه الرسالة التي ألقاها النبي على المستمعين، ثم تُسجل في وثائق، ويتم نشرها بشكل أوسع وأشمل، فيحصل عليها كل أفراد الشعب.
· التصور الثاني:
من الصعب تحديد كيفية عمل الروح بالضبط، ولكن يُمكننا تصوره على أنه إرشاد وجداني داخلي، أو متابعة عقلية مستمرة طيلة أداء العنصر البشرى لدوره. فيقوم البشير بمحاولة جمع كافة المصادر التي يصل لها عن طريق جهده الذاتي، وبالبحث والتقصي حول المعلومات التي تصله، فيتيقن صحتها، ويتثبت من مصداقيتها، ثم يبدأ في عملية مراجعة هذه المصادر، وتنقيحها من أي شوائب إن وُجِدت.
بعد ذلك تأتى مرحلة التدوين والتسجيل، وفي هذه المرحلة يكون هناك عدة مستويات من التأليف والتنقيح والمراجعة. وأخيراً ينتهي الكاتب من صياغة الإنجيل الذي يكتبه. في كل هذه المراحل يُمكننا أن نلمس دور مستمر للروح القدس في المتابعة والمباشرة والإرشاد، فرغم أننا نلاحظ الدور البشرى بوضوح في الوحي، إلا أننا نؤمن يقيناً أن الروح كان مُظللاً لهذه العملية طيلة فترتها.
هذا لا يعنى أننا لا نجد تدخلاً مباشراً بين الروح والكاتب، بل نجد ذلك واضحاً في نصوص كثيرة، مثل أن يقوم الروح بإعلام الكاتب بما حدث خلف الأبواب دون أن يكون موجوداً.
أحد المشكلات الرئيسية للوحى هي أننا لا نعرف كيف تم بالضبط. كل ما قام به العلماء هو اجتهادات لتفسير ما يمكن أن نعلمه عن الوحي من خلال الكتاب الذي بين أيدينا. وبالتالي لا نستطيع أن نقول على وجه الدقة كيف تمت عملية الوحي. لكن هذا لا يعنى أننا لا نستطيع أن نقول شيئاً على الإطلاق؛ بل هناك بعض الأساسيات التي لا يمكن الشك فيها. أثناء عملية الاستقراء، يتبين لنا بعض الحقائق الثابتة في كافة النصوص المُختبرة في الوحي.
من هذا الاستقراء نستنبط التالي، حول عملية الوحي:
- الوحي كان عملية مشاركة متبادلة بين الله والإنسان، تمت في مجموعة من الحدود والإطارات، دون طغيان الله على الإنسان ولا طغيان الإنسان على الله.
- الوحي لم يكن عملية إملائية، وإنما كان إحلالاً لجوهر فكر الله في كلمات الإنسان. هذه الكلمات أصاغها الإنسان بأسلوبه، وبحسب ثقافته، وبحسب مصطلحات المجتمع الذي يعيش فيه.
- الوحي لم يلغى البحث التاريخي، بل شجعه، وحفز الكتبة على البحث والتقصي حول المعلومات المُسجلة والتيقن منها.
- الوحي كان صريحاً ومباشراً في بعض العبارات، مثل أن يقول نبي “وقال لي الرب…”، وقد يكون غير صريحاً كما في بقية الكتاب المقدس.
- وحي الكتاب المقدس يهتم بالجوهر لا بالظاهر، وتم ذلك بعدة أشكال. كلمات يسوع في الأناجيل ليست هي كما نطقها يسوع بالحرف، وإنما هي جوهر ما قاله يسوع.
- الوحي هو وحدة واحدة وغير قابل للتجزئة على نصوص كل كتاب من كتب الكتاب المقدس، فلا يُمكن أن يُضاف للوحى ولا يُمكن أن يُحذف من الوحي لأنه ليس نصياً.
هذه بعض الاستنباطات التي نصل لها عن طريق دراستنا لنصوص الكتاب المقدس، بهدف تعيين ماهية الوحي الإلهي. لكن هذه النتائج يترتب عليها بعض الأمور:
- أن الكتاب المقدس فيه عنصرين: عنصر إلهي وعنصر بشرى.
- أن الكتاب المقدس يضم بين دفتيه كلمة الله والحقائق التي أعلنها لنا من خلاله، عن نفسه وعن تاريخ تعامله مع البشر.
- أن الكتاب المقدس هو إعلان الله بشكل طبيعي، دون إعجاز ودون أي أمر خارق للطبيعة، عدا في الرؤى.
نظريات الوحي العام
هذه النتائج وهذه العناصر التي نصل لها، لم يتم تفسيرها بشكل مُوحد من قبل العلماء المسيحيين في كل الأزمنة. هذا البحث المسيحي في وحي الكتاب المقدس، والذي يستمر مداه لأكثر من مائة وثلاثين عاماً، أوجد لدينا ثراءً من المواد، سواء العلمية أو التطبيقية. أدت طرق الوحي هذه إلى عدة نظريات أخرى في تشكيل عقيدة عامة للوحى الإلهي للكتاب المقدس. سأتناول فيما يلي أشهر أربع نظريات، ومن ثم تقديم المنافسة بين النظريتين الأكثر انتشاراً غير أولئك الأربعة.
الوحي التاريخي:
أي أن الله قد أوحى بالأحداث التاريخية للكاتب، وقام بإرشاده لها، ويدخل في ذلك عنصر الإملاء إلى حد ما. ذلك لأن الكاتب لم يكن معاصراً للأحداث التاريخية التي لم يسجلها. أما النص فهو من الكاتب، وليس من الله ولم يكن مُوحى به. من اللاهوتيين الكلاسيكيين الذين اعتقدوا في هذه النظرية: جون بالى، ديفيد كيسلى، وجيمس بار.
مشكلة هذه النظرية متعددة الأطراف؛ فهي تحصر الوحي فقط في التاريخ وليس في النص، بينما غالبية كتب الكتاب المقدس لا علاقة لها بالتاريخ، ومع ذلك هي وحي. من ناحية أخرى، هذه النظرية تقوم بإلغاء أحد الحقائق الثابتة عن الوحي الإلهي، وهو أن الإنسان عنصر فيه.
الوحي الداخلي:
هذه النظرية ترى وحي الكتاب المقدس على أنه مجرد خبرات ونظرات ثاقبة لرجال ذو ثقافة دينية عالية، ولديهم المقدرة على التعبير عن مشاعرهم والحقائق التي يرونها في أسلوب شعري أو أسلوب بلاغي فقط. هذه النظرية لا تقول فقط أن الكتاب مُوحَى به من الله، ولكن الكتاب أيضًا مُوِحى لبقية البشر. فكان ختام النظرية أنه لابد من الربط بين الوحي والإيحاء. هذه النظرية لها عدة مشكلات رئيسية.
بكل الأشكال، الكتب الشعرية والأسفار البلاغية هي جزء قليل من الكتاب المقدس، فما هو وضع بقية الكتب بالضبط؟ مشكلة أخرى، أننا نستطيع لمس حقيقة الوحي الإلهي في الكتب التي لا تُوحِى بشيء على الإطلاق. هذه النظرية عبر عنها الألماني المعروف شيلماخر.
الوحي العقيدي:
أي أن العقيدة فقط، وخاصةً النصوص العقيدية، هي التي أوحى بها الروح القدس فقط، وبقية النصوص من عمل العنصر البشرى. المشكلة مع هذه النظرية ضخمة جداً، لأنها لا تنطلق من أساس فلسفي، بل أساس إيماني بحت.
فكيف يُمكن فصل النص العقيدي عن سياقه؟ وكيف يُمكن أن نعتبر الكتاب المقدس كتاب عقيدي فقط، في الوقت الذي يظهر فيه الكتاب المقدس في المقام الأول كوثيقة تاريخية، تشتمل في أغلب أجزائها على تاريخ علاقة الله بالبشر! بل حتى أن هذه النظرية تلغى دور العنصر البشرى في عملية الوحي ذاتها، حتى وإن كانت لا تلغيه في عملية تسجيل وتوثيق هذا الوحي.
الوحي الجدلى:
هذه النظرية تقول بأن وحي الكتاب المقدس لا يكمن في داخله، وإنما في فاعليته أثناء عمل الروح القدس بداخل الإنسان. بمعنى أن الكتاب مُوحى به بالفعل في كافة أجزاؤه، لكن في حالة وضع الكتاب المقدس في اعتباره بجانب عمل الروح القدس، يظهر هذا الوحى. أما إذا قرأ الفرد الكتاب المقدس لأى هدف آخر غير المعرفة الوحية، يفقد وحيه بشكل فعلى وليس قيمى فقط.
المشكلة مع هذه النظرية واحدة ولكن رئيسية، وهى أنها تقول بأن الإنسان إذا أقترب من الكتاب المقدس بشكل غير روحي، فإن الكتاب لا يعود وحياً ثانية. هذا غير حقيقى، لأن الإنسان وحالته ليست هي المعيار، وانعدام الحالة الروحية لا يُوقِف الكتاب كونه وحياً من الله. هذه النظرية أيدها كارل بارث، أكبر لاهوتى في القرن العشرين.
هذه النظريات الأربعة، كلها نظريات ناقصة. لو دققنا أكثر، سنجد أن المؤيدين لتلك النظريات، أوجدوا فكرهم من خلال مجال تخصصهم في الكتاب المقدس. كل نظرية من هذه النظريات وحدها ناقصة، ولكن إذا وضعناهم معاً سنجد نطاق أكبر مقبول لما يمكن أن نستشفه عن وحي الكتاب المقدس. ومع ذلك، فترتيب هذه النظريات معاً احتاج إلى تنسيقهم في شكل أوسع ليشمل كل النواحى. مع ترتيب هذه النظريات معاً، خرج لدينا نظريتين رئيسيتين، هما اللتين نجدهما اليوم.
الوحي اللفظى التام
الوحي اللفظى التام Verbal Plenary Inspiration هي أشهر عقائد الوحى. بقولنا “اللفظى” نعنى أن كل كلمة في الكتاب المقدس، قد كتبها كتبة الأسفار بإرادتهم، ولكن الله هو الذي حددها وأختارها. في نفس الوقت، لا نقول أن الله أملى الكتبة هذه الكلمات. أي أن الله اختار هذه الكلمات، لكنه لم يمليها على الكتبة، بل تركهم هم يصلون لها ويكتبونها بإراداتهم الحرة. وبقولنا “التام”، نقصد أن كل الكتاب المقدس بهذا الشكل، شاملاً كل جزء فيه وكل كلمة فيه.
بهذا الشكل، يُمكننا أن نعيد تكوين عملية الوحي كالتالى: أن الله اختار رجال قديسين، جعلهم مؤتمنين على كتابة كلمته التي يريد إيصالها للبشر. في لحظة معينة لا نعرف تفاصيلها ولا دقائقها، أوحى الله بكلمته في جوهرها وموضوعها ومغزاها وهدفها، إلى الإنسان. ثم حدد الله الكلمات التي سيستخدمها الكاتب بحسب خلفيته وثقافته، وتركه يكتب بطريقته الخاصة. هنا يجب أن ننتبه إلى ملاحظة هامة وخطيرة جداً: أن الله لم يوحى بهذا الحرف ابداً، ولم يمليه على الكتبة، ولم يتدخل في شخصيات الكتبة، وإنما اختار الكلمات وترك الكتبة يصلون لها.
المشكلة التي يسقط فيها الكثيرين، حتى من الإنجيليين المؤمنين في الغرب، هو تخيل أن اختيار الله للكلمات يعنى أنه قام بتحديد ما الذي سيكتبه الكاتب. في نفس الوقت، لا يمكن تخيل وجود وحي لفظى دون اللجوء إلى نظرية الإملاء. هذا ليس ما لاحظته أنا فقط، بل ما لاحظه علماء كثيرين. رغم هذا، فهناك رفض قوى ومُستغرب لقضية الإملاء من قِبل المؤمنين بالوحي اللفظى التام. هناك قطاع كبير لا يرى فرق بين الوحي اللفظى والوحي الإملائى، ولكن بحسب دراستى، أستطيع أن أرى عدة فروق في العملية نفسها.
دعنى أعطيك مثالاً: أشهر تطبيقات نظرية الوحي اللفظى التام، هو أن إرادة الإنسان لم تخالف إرادة الله في اختيار الكلمات. في هذا النموذج سنجد إرادتين، وسنجد رغبتين للإرادتين، ولكن النتيجة واحدة، لأن الرغبتين في الحقيقة رغبة واحدة فقط. هكذا، لا يكون هناك تعارض بين انعدام الإملاء ووحى الكلمات ذاتها. لكن المشكلة الحقيقة تكمن في شكل المُنتج النهائى. لو نظرنا لهذه النظرية ببعض التأمل، سنجد أنه لا فرق بينها وبين الإملاء في النتائج.
المُنتج النهائى في نظرية الوحي اللفظى التام هو أن الكتاب المقدس مُوحى به حتى أدنى كلماته، والمُنتج النهائى في نظرية الوحي الإملائى هو أن الكتاب المقدس مُوحى به حتى أدنى كلماته.
المؤمنين بنظرية الوحي اللفظى التام، يُصِرون على أنه حتى لو كان لا فارق في النتيجة بينها وبين الإملاء، فإن العملية نفسها لم تكن إملائية. كيف هذا؟ لا نعرف بالضبط. كما سأشرح في نهاية هذه الدراسة تفصيلياً، فإن عملية الوحي نفسها تخرج عن حدود فهم العقل البشرى. كما أن يسوع المسيح هو إله وإنسان في نفس الوقت، كذلك الكتاب المقدس إلهى وبشرى في نفس الوقت.
نحن لا نستطيع أن نفهم كيف أن يسوع المسيح إله وإنسان معاً، رغم أننا نقر بهذه الحقيقة؛ كذلك الكتاب المقدس، لا يُمكننا فهم كيف أنه إلهى وبشرى في نفس الوقت، رغم أننا نقر بهذه الحقيقة.
الأسباب التي يُصِر لأجلها المؤمنين بهذه النظرية عليها، لا يُمكن ربطها بالإعلان الإلهى، لأننا أصبحنا نتحدث في مرحلة تتعدى البرهان الكتابى الصريح، وحتى البرهان الاستقراءى. لكن الأسباب الرئيسية للتمسك بوحى اللفظ، هما سببين: سبب لاهوتى وسبب فلسفى.
السبب اللاهوتى هو الخطية. وضعت الخطية حائلاً وحاجزاً بين الله والإنسان، لذلك كان لآثار الخطية رؤية معينة في المجتمع الإنجيلي في الغرب في العنصر الإنسانى في الكتاب المقدس. فبسبب أن للخطية تأثير جزرى على علاقة الإنسان بالله، وأدت إلى كسر هذه العلاقة، فقد استحال على الإنسان الوصول مرة أخرى لله بمجهوده الذاتى. لذلك كانت المبادرة من الله، لأنه هو القادر، وكان على الإنسان الاستلام والتلقى.
ولأن الكتاب المقدس هو رسالة الله لخلاص البشرية، ولأن خلاص البشرية بحسب خطة الله هو عمل يقينى، فلم يكن بمقدور الإنسان الساقط أن يُساهم فيه، وكان على الله أن يقوم باختيار الرسالة واللفظ معاً بدقة، حتى يكون هناك ضمان ليقين خلاص الإنسان.
السبب الفلسفى هو الخوف من مذهب الذاتية الفلسفى. بدون تعقيد، هذا المذهب ينادى باستقلالية الطاقة الإنسانية، وهو ما يتعارض مع المفهوم الأنثروبولجى المعروض في السبب الأول. فلأن استقلالية العنصر البشرى يُبعِد الخلاص الإلهى عن المركز، بالإضافة إلى إبعاده مفهوم اليقين في الخلاص عن مركزية خطة الله. هذه الأنثروبولجية تؤكد على أن الإنسان لا يد له في الخلاص، وبالتالي فهو لا يستطيع أن يقدم شيئاً لخلاص نفسه.
لا أريد أن أقدم نقداً لهذه النظرية، حتى وإن كنت لا أؤمن بها. لكن أريد أن أقدم نقداً للأسباب التي تقف وراء الإصرار على وحي اللفظ:
- اولاً: الخطأ الرئيسى في هذه النظرية، هو اعتماد الكتاب المقدس، كهيئة خلاص الله المُقدم للبشرية. هذا الخطأ الشائع، كما أشرت في البداية، يجعل الخلاص في معرفة الخلاص، وليس في الخلاص في ذاته. التعليم بأن معرفة الخلاص (معرفة المسيح) هي التي تُخلِص، وليس الخلاص نفسه (المسيح)، يتناقض مع تعليم الكتاب المقدس، بل وحتى مع التعليم الأنثروبولجى الإنجيلى. بهذا نحن نجعل الإنسان هو سيد قرار الخلاص، بحسب معرفته، وليس في عمل المسيح الشامل. مثال على هذا الاحتجاج هو كل فرد عاش قبل إتمام عمل المسيح. كل فرد عاش على رجاء المسيح لم يعرف بخلاص المسيح، وإنما مات على الرجاء. وبالتالي فخلاصه في العمل وليس في معرفته الشخصية بهذا العمل.
- ثانياً: هناك خلط بين الحقيقة ويقين الإنسان من الحقيقة. الكلمات التالية تُعبر عن واقع نظرى ولا علاقة لها بالواقع الروحي العملى. الكتاب المقدس يُعلم بأن الحقيقة مُطلقة، ولكن لا يُعلم بأن الحقيقة المُطلقة في متناول البشر. وبالتالي لا يُوجد شيء اسمه حقيقة مُطلقة فيما يتعدى الحواس الخمس، يُمكن أن يكون في متناول الإنسان. الأمر نفسه بالنسبة لخلاص الإنسان، والدور الذي يلعبه الكتاب المقدس في إتمام هذا الخلاص. لا يُمكن أن يكون هناك ثقة مطلقة حول معنى النص، لأن النص تأويلى وليس مُطلقاً. بدلاً من ذلك، فالمنهج العلمي يُحتم وضع كافة الاحتمالات معاً، ومن ثم عمل تقييم لهذه الاحتمالات، واختيار أفضل هذه الاحتمالات تفسيراً للمعطيات المتوفرة.
- ثالثاً: يجب التفريق بين العنصر الإنسانى الحر والعنصر الإنسانى في يد الله. الخوف من الاستقلالية ليس له ما يبرره، لأن إعطاء دور أكبر للعنصر البشرى في عملية الوحي، لا يعنى استقلاله عن العنصر الإلهى. ولو أن هناك نظريات أخرى تسمح بحرية للعنصر البشرى، فهذا لا يعنى أن هذه الحرية خرجت عن رعاية وعناية الله.
- رابعاً: الإقرار بأن تدخل النقص البشرى في الكتاب المقدس، يعنى وجود نقص في الكتاب المقدس، مما يؤدى إلى انعدام صفة الكمال الأساسية، يطعن في أحد أساسيات اللاهوت المسيحى، وهو مفهوم “الاستعادة” Restoration. هذا المفهوم ثابت في الكتاب نفسه، وهو يعنى ببساطة: أن الله قادر على استخدام الضعف، والفساد، والنقص، في إنتاج القوة والمجد والكمال. سأناقش هذا المفهوم لاحقاً في الحديث عن العصمة تفصيلاً.
- خامساً: في عصور متفرقة، لم يكن لدى المسيحيين نفس الكلمات التي أوحى الله بها في نصوص معينة في الكتاب المقدس. لم يكن هذا تراثاً في الماضى، بل حتى الآن وفي كل زمان، هناك نسبة ستظل غير مُدركة وغير معروفة للإنسان بالضبط، حول نص الكتاب المقدس. أنا لا أقول أن عقيدة الوحي اللفظى تُحتِم عقيدة الحفظ، بل سأتناول هذا تفصيلاً لاحقاً، ولكن هل نستطيع أن نقول بأن كلمة الله “الدقيقة” لم تصل البشر في عصور كثيرة مختلفة، فقط لأن اللفظ لم يكن ثابتاً؟ بالتأكيد لا.
رغم ذلك، فأغلب الإنجيليين يعتنقون هذا الفكر، بعد التراث اللاهوتى الضخم الذي خلفه وارفيلد وهودجز. الوحي اللفظى التام ليست نظرية بها عيوب، بل نظرية تتكامل تماماً مع النقد الكتابى، ذلك العلم الذي أصبح معياراً (و ليس دافعاً) للتفتيش على مدى تكامل الإعلان الإلهى مع البحث الإنسانى الحديث. لكن الصراع المرير يظهر في حقيقته مع عقائد العصمة بكافة أشكالها، وهو ما سأتناوله في الشق الثانى من هذه الدراسة.
تتضمن نظرية الوحي اللفظى التام، معنيين يُقصد بهما لفظ “التام”:
- المعنى الأول: أن كل أجزاء الكتاب المقدس هي وحي من الله؛ بمعنى أن الفرد إذا فتح أي جزء في الكتاب المقدس، سيقرأ كلمة الله وليس كلمات الإنسان فقط.
- المعنى الثانى: أن الكتاب المقدس هو الوحي التام، فلا يوجد أي نصوص مُوحى بها خارج الكتاب المقدس، سواء في كتب دينية أخرى، أو في كتابات إلهامية.
من خلال الاستقراء الذي قدمناه بدايةً، يتأكد لنا صحة المعنى الأول. فوحى الكتاب المقدس وحدة واحدة، غير قابل للتجزئة على نصوص وأعداد. لكن المعنى الثانى يتناقض مع البرهان الذي يقدمه اللاهوت التاريخى، خاصةً اللاهوت الآبائى!
آمن آباء الكنيسة الأولى، بوجود وحي خارج الكتاب المقدس. ولدينا في كتابات الآباء، حوالى تسعين نص آبائى، يُشير إلى نصوص من خارج الكتاب المقدس، على أنها وحى. في غالبية هذه النصوص، الكلمة اليونانية المُستخدمة، هي نفسها المُستخدمة في 2 تى 3: 16. غالبية هذه النصوص تُشير إلى كتابات الآباء نفسهم، على أنها وحى. فمثلاً، نجد القديس غريغوريوس النزينزى، يصف تفسير القديس باسيليوس لأيام الخليقة، على أنه وحي تام، ولا يقل عن الوحي الذي تلقاه موسى نفسه. تغطى هذه النصوص فترة كبيرة جداً في عصور الآباء، فتبدأ من عصر الآباء الرسوليين وتصل إلى العصر المتأخر (ق. 7 – 8).
لذلك توصل العلماء إلى أنه هناك فرق بين القانون والوحي، وأصبحت قاعدة علمية اليوم: أن الوحي ليس هو معيار قانون الكتاب المقدس، وأن القانون لم يكن قصده تحديد الوحي، وإنما تحديد التعليم الرسولى.
و منذ الربع الأخير من القرن العشرين، دعا العلماء الإنجيليين إلى ضرورة وضع الكتاب المقدس في الوسط الذي نما فيه. فالكتاب المقدس هو كتاب الكنيسة، والكنيسة هي مجتمع الروح الذي نشأ فيه هذا الكتاب واستقر. منذ ذلك الوقت، بدأ الإنجيليين في مراجعة لاهوت لوثر، وشددوا على التفريق الدقيق في مصطلحات الكنيسة التي استخدمها لوثر. كانت هذه هي الشرارة التي دعت العلماء الإنجيليين والكاثوليك، ليعملوا معاً في مراجعة لاهوت لوثر بالكامل في كل الفروع، وليس في الكتاب المقدس فقط.
غير أنه من الأمانة أن أؤكد أن المعنى الأول هو المميز في نظرية الوحي الفعلى التام، والمعنى الثانى هو معنى ثانوى لا يشدد عليه الكثير من الإنجيليين.
على الجانب الآخر، هناك رؤية عامة أخرى للوحى، لكننا لا نستطيع أن نسميها نظرية، لأن تفاصيلها تختلف من شخص إلى آخر. هذه الرؤية يُمكن تسميتها بالرؤية الموضوعية، أو الرؤية التفاعلية. ذلك لأنها ترفع الشركة بين الله والإنسان في كتابة الكتاب المقدس إلى القمة، دون أن يطغى الله على الإنسان ولا أن يطغى الإنسان على الله.
الرؤية الديناميكية الموضوعية
هى تعبير عن التفاعل الحقيقى بين الله والإنسان، وكل تركيز هذه النظرية هو عن وجود معاملة ديناميكية أو معاملة فعالة بين الله والإنسان. في هذه الرؤية لا نرى الله مجرد مُلقِن والإنسان مجرد قلم يدون ما يقوله الله. بل نرى أن الله له دور والإنسان له دور أيضًا، ليس في عملية الكتابة فقط، بل حتى في عملية تكوين المادة التي سيتم وضعها في الكتاب أيضًا. لكن لأن هذه الرؤية بهذا الشكل مجالها واسع، لا يمكننا وضعها في شكل قالب نظرى ومن ثم تطبيقه. لذا سأضع الأساس العام للرؤية، ومن ثم وضع بعض الأمثلة على كيفية تطبيقها.
الأساس العام لهذه الرؤية هو أن الله أوحى بالمحتوى الفكرى فقط، وترك مهمة الصياغة بشكل كامل للإنسان. لكن يجب الانتباه إلى أن هذه رؤية عامة، مما يعنى أن تفسير هذه القاعدة العامة، ينتج عنه تفاسير مختلفة، ترى القاعدة من عدة زوايا. كى يكون الكلام واضحاً بأقصى ما يُمكن، سأضع بعض الأسئلة التي ستساعدنا على فهم حدود هذه القاعدة:
- إلى أي مدى يُمكن أن نحدد الفكر الذي أوحى به الله؟
- القاعدة العامة تحدد أن الصياغة هي مهمة بشرية بالكامل، ولكن هل يُمكن أن يستخدم الله الإنسان في عملية تجميع الفكر نفسه، بجانب مهمة الصياغة؟
- إذا كان الإنسان قد أشترك في مهمة وضع الفكر، فما هي الدوافع والضوابط التي تشكل هذه العملية؟
- ما هي حدود الطاقة البشرية، أو الإدراك البشرى وتأثيره على كون الكتاب المقدس وحى، بهذا المنطق؟
- ما هي الآليات التي أستخدمها الله في إيصال الفكر، ليس للكاتب فقط، وإنما للبشر كافةً أيضًا، لضمان وصول الفكر بشكل سليم؟
- ما هي الرسالة؟ وما هو الفرق بين الفكر والرسالة؟
- هل يُمكن للإنسان أن يكون له دور في الرسالة؟
لا أريد أن أدخلك في متاهات كثيرة الآن، ولكن سأعرض بعض التفاسير الرئيسية. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التفاسير ليست شاملة، وحتى بداخل كل تفسير يُوجد خلافات كثيرة بين نظرة كل فرد وآخر.
التفسير الرئيسى لهذه القاعدة العامة، في ضوء الأسئلة المعروضة أعلاه، كالتالى: أن الله أوحى للكاتب أن يقوم بالكتابة في موضوع معين، بهدف إيصال رسالة معينة. هذا الموضوع له فكر رئيسى معين، ومن خلال هذا الفكر، يستطيع القارىء أن يصل لرسالة النص. وهنا يلزم التفريق بين فكر النص ورسالة النص، لأن الفكر هو المحتوى الجوهرى للنص، بينما رسالة النص هي النتيجة التي يخرج بها القارىء.
فكر النص ورسالة النص، ليسا معنى النص كما يفهم الكثيرين في الشرق. في أثناء تجهيز هذا الفكر، يشترك الإنسان مع الله في تجهيز مادته أيضًا، بالإضافة إلى دوره الطبيعى في صياغة النص. أما رسالة النص فهى الهدف الذي حدده الله من البداية، وهى النتيجة التي يصل لها القارىء في النهاية. هذه الرسالة لا دخل للإنسان في تكوينها، ولا يُمكن له بأى حال أن يساهم فيها.
ما هي حدود تدخل الإنسان في بناء الفكر الجوهرى للنص؟ هذا أمر مُختلف عليه، وعليك أن تحدد ما تراه بنفسك. بشكل عام، تنقسم الرؤى حول تدخل الإنسان في بناء الفكر إلى عدة اتجاهات:
أولاً: تدخل الإنسان في الفكر قد يمتد إلى إدخال نموذج من التراث البشرى، مع بعض التعديلات، لإيصال الرسالة من خلاله. كمثال، هناك تيار واسع يعتقد أن في أسفار العهد القديم عنصر أسطورى، مأخوذ من عدة كتابات من التراث البشرى، مع بعض التعديلات. لكن العلماء المؤمنين بهذا الاعتقاد في الغرب، واللاهوتيين المؤمنين به في الشرق، أكدوا كثيراً أن بعضاً من هذه التعديلات، لا يبدو وكأنه مجرد تغيير عابر، بل أنه هادف وله مغزى.
بهذا الشكل، يكون قد اشترك الله والإنسان معاً في تجهيز الفكر الجوهرى للنص، والذي عن طريقه تصل الرسالة التي عينها الله منذ البداية للقارىء. فاستخدم الله القطعة التراثية من خلال الإنسان، وفي نفس الوقت تمت بعض التغييرات لتصل الرسالة بوضوح.
ثانياً: دور العنصر البشرى في تجهيز الفكر، قد يحدث فيه خطأ. هذا الخطأ يكون في إعداد المادة التاريخية أو العلمية للفكر الجوهرى للنص، لكنه ليس في رسالة النص. هذا الفكر يرتكز بشكل مباشر ورئيسى على مبدأ الاستعادة اللاهوتى؛ أن الله قادراً على استخدام الضعف لينتج كمالاً. فلو أننا وجدنا خطأ تاريخي في الكتاب، فهذا لا يعنى أن هذا الكتاب ليس من الله، بل هناك احتمال آخر، وهو أن هناك دافع معين في أعماق الله وراء السماح بورود هذا الخطأ.
ثالثاً: من الممكن أن يستخدم الكاتب مواد غير حقيقية، لبناء فكر واضح، تصل الرسالة بأوضح شكل من خلاله. كمثال، خرج أحد العلماء (جندرى) الإنجيليين، على المجتمع الإنجيلي في بداية الثمانينات، بتفسير لإنجيل متى، آثار زوبعة شهيرة جداً في الجمعية الإنجيلية اللاهوتية. كان الشكل العام لتفسير هذا العالم، أن متى استخدم بعض المواد الغير حقيقية، بهدف إيصال رسالة معينة من وراءها.
مثال على ذلك، قصة ظهور النجم للمجوس، لم تكن حقيقية، لكن متى استخدمها كى يجعل القارىء ينتبه لرسالة معينة. جندرى له احتجاجاته الكثيرة والخاصة بطرحه هذا، متعلقة في أغلبها بالأدب الرابيني اليهودى. لكن منبع الفكر نفسه هو مفهوم الوحى.
هذه بعض التصورات الرئيسية لمدى تدخل العنصر البشرى في تجهيز مادة الفكر نفسه. لكن في كل التصورات وفي كل الأحوال، يؤكد اللاهوتيين على أن الرسالة الخاصة بالفكر، هي رسالة إلهية خالصة، خرجت بحسب حكمة وإرادة الله.
نقد الرؤية الديناميكية
نقد الرؤية الديناميكية هو نقد واسع، ويُمكن لأى فرد تخيل المخاطر التي قد تنتج عنها، ورغم أنها نظرية إنجيلية واقعية، غير أن تناولها يجب أن يكون في أشد الحذر، والإيمان بها يجب أن يكون عن قناعة تامة بعد دراسة علمية طويلة جداً. ومن أكثر المخاطر التي تنتج عن هذه النظرية، هو عدم القدرة على التمييز وتحديد دور العنصر البشرى بشكل عام. هذا وإن كان ميزة في تأكيد أن الوحي وحدة واحدة، فقد يفتح باباً كبيراً أمام الباحث حول المادة البشرية في الكتاب المقدس.
سر الوحى
تبدأ المشكلة من الإنسان لا من الله. أرى كثيرين يفرضون معايير معينة على الوحي، ثم يقومون بتطبيقها على الكتب التي تدعى أنها وحي من الله. المشكلة في هذا المنهج أنه يفرض على الله ما الذي يجب أن يقوم به، بدلاً من البحث عما هو حقيقى فعلاً. هناك منهج عام أراه في الشرق كثيراً، يختبىء وراء غلاف فلسفى، كالتالى: أن الله هو إله كامل لا يشوبه نقص، وبالتالي لابد أن يكون الكتاب المقدس كامل لا يشوبه نقص.
نعم هذا صحيح، ولكن كيف يُفهم النقص، وكيف يُفهم الأمر الناقص، هذا هو مكمن المشكلة. لو أن هناك خطأ تاريخي في الكتاب المقدس، فهل هذا يعنى أن الكتاب لا يحتوى على وحي الله؟ من الوارد أن يكون الله قد قصد استخدام هذا الخطأ لغرض ما، فهل في هذا الحال يكون استخدام هذا الخطأ أو وروده نقصاً؟ لكن المشكلة تقع في رفضنا السعى وراء الحقيقة، وراء حقيقة ما أعلنه الله.
الإنسان بطبيعته يميل للمادة، والظاهر، والملموس، لأن هذا هو ما يستطيع أن يعقله فيصدقه. لكن التفاعل مع الله يستلزم من الإنسان أن ينزع عنه كل فكر معين عن الله، وأن يزيد فرصته من التوقع أكثر، لأنه يتعامل مع عقلية تفوق حدود وإدراك العقلية البشرية.
خاصةً في الإيمان المسيحى، حيث تحتل العلاقة بين الله والإنسان الجوهر والمركز. ورغم أن الله أعلن الكثير عن نفسه للإنسان، إلا أن ماهية الوحي بالضبط وعلى وجه التحديد، يبقى سراً خفى عن الإنسان. العلماء دائماً ما يشبهون وحي الكتاب المقدس بطبيعة الرب يسوع. أننا نستطيع السجود أمام إعلان الكتاب المقدس عن طبيعة المسيح: الإله والإنسان في نفس الوقت، ولكننا لا نستطيع فهم كيف هذا.
حاول رجال الله في عصور كثيرة أن يتصارعوا مع هذا الفكر لكي يفهموه، ولكن مهما كانت اجتهادات الإنسان، فلا يمكن أن يصل للحقيقة الكاملة، أو فهم كامل، حول طبيعتى المسيح. كذلك الأمر بالنسبة للكتاب المقدس، في طبيعة وحيه. الكتاب المقدس يعلن أنه وحي الله، ولكننا لا نستطيع تحديد ماهية هذا الوحي بالضبط، ولا يمكننا أن نفهمه بشكل كامل.
حاول رجال الله كثيراً في عصور كثيرة، خاصةً في القرنين السابقين، أن يفهموا ماهية الوحي، وكيف يمكن أن يكون إلهى وبشرى في نفس الوقت، لكن لا يمكن ابداً للإنسان أن يفحص عقل الله. لكن كما أن عدم فهمنا لم يمنعنا من قبول إعلان المسيح أنه إله وإنسان، كذلك عدم فهمنا لا يجب أن يمنعنا عن قبول إعلان الكتاب المقدس أنه إلهى وبشرى.
ووجود العنصر البشرى في الكتاب المقدس، يعنى أن هناك صراع مستمر ودائم مع الله. بوجود هذا العنصر، أصبح لدينا مساحة معينة من البحث العلمى، الذي يجب أن يُوظَف لبحث طبيعة وماهية ما قدمه العنصر البشرى للكتاب المقدس.
الآن وقبل أن ننتقل لمناقشة العصمة، يجب أن ندرك أن نظريات الوحي كافةً تشتمل على ثلاثة عناصر نشيطة وليس واحداً فيهم صامتاً: العنصر المُلقى، العنصر المُتلقى، والوسيط بينهما. العنصر المُلقى هو الله، العنصر المتلقى هو الإنسان، والوسيط بينهما هو الروح القدس. هذه الثلاثة عناصر جميعهم فعالين ونشطين، ولا يوجد فيهم من هو مُصمَت. أما الاختلاف بين النظريات، فيكمن في دور وحدود كل عنصر فيهم.
العصمة
إذا كان التعليم بوحى الكتاب المقدس راسخ في الكتاب المقدس واللاهوت التاريخى، فإن مصطلح “العصمة” هو مصطلح لا وجود له قبل عصر التنوير. هذا الاصطلاح لا وجود له في الكتاب المقدس، ولم يعلم الكتاب المقدس بأنه معصوم. آباء الكنيسة لم يعرفوا شيئاً اسمه عصمة الكتاب المقدس. فما هي قصة العصمة إذن؟
قبل أن نفصل الحديث عن العصمة من منظور تاريخي والنظريات التي نشأت حولها، يجب أن نعرف أن هناك ثلاث مصطلحات تُترجم في العربية إلى “العصمة”، وهى:
- المُصطلح الأول Inerrancy: ويعنى حرفياً “عدم الخطأ”. هذا المصطلح يُشير إلى أن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ التاريخى، الخطأ العلمى، والخطأ في أي معلومة دنيوية بشكل عام.
- المصطلح الثانى Infallibility: ويعنى حرفياً “عدم السقوط”. ويُقصد بهذا المصطلح أن الكتاب المقدس معصوم فيما يقدمه من تعليم، فكل تعليم فيه حقيقى، مثل التعليم عن حقيقة الأرواح النجسة.
- المصطلح الثالث Preservation: ويعنى حرفياً “الحفظ”. والمقصود من هذا المصطلح، أن نص الكتاب المقدس معصوم من الضياع، التغيير، التبديل…إلخ، وأن العناية الإلهية قد حفظت النص في كل العصور والأزمنة.
هذه الثلاث مصطلحات تُترجم في العربية إلى العصمة، لكن كل منهم عقيدة مختلفة عن الأخرى. ما يجب أن ننتبه له بشدة، أن ولا واحدة منهم مرتبطة بالأخرى، أو أن احدهم متعلقة بالأخرى أو تُبنى عليها. رغم أن الكتاب المقدس لم يعلم بعصمة محتواه ابداً ولا في أي نص، فإن العصمة باتت اليوم أحد ثوابت لاهوت الكتاب المقدس. السبب في ذلك هو أنها عقيدة تترتب على عقيدة الوحي اللفظى التام. سنأخذ الآن كل عقيدة منهم على حدة ونناقشها بنوع من التفصيل.
العصمة التاريخية Inerrancy
هذه العقيدة هي الأكثر جدالاً في الغرب، خاصةً بين المجتمع الإنجيلي والمجتمع الليبرالى. لكن هذا لا يعنى أن العصمة التاريخية شرط ضرورى لإنجيلية الفرد، بل هي شرط ثانوى يُمكن التنازل عنه. الفكرة الرئيسية تكمن في المنطق التالى: إذا كان لدينا نص ما في العهد الجديد أو القديم، وبحسب ظاهره يحتوى على خطأ واضح، ولكن بحسب باطنه قد لا يكون خطأ، فقد أصبح أمامنا احتمالين: خطأ النص، أو صحة النص. على أي أساس سنختار؟
لنأخذ مثال: حينما يقول يسوع أن حبة الخردل هي أصغر جميع البذور التي على الأرض (مر 4: 31)، فهذا النص بحسب ظاهره خطأ، لأن حبة الخردل ليست أصغر جميع البذور. ولكن هناك احتمال آخر أن النص يقصد أصغر البذور الموجودة على أرض اليهودية فقط. إذن فهذا النص بحسب باطنه صحيحاً. المشكلة حول العصمة التاريخية تكمن في أي تفسير هو الصحيح؟ هل التفسير الصحيح للنص أنه خطأ، أم أن التفسير الصحيح للنص أنه صحيح؟ الاحتمالين واردين، ولكن أيهما هو الحقيقى؟
هنا يكمن الصراع، بين علماء التفسير Exegesis، والعلماء الليبراليين. على أي أساس يمكن تحديد ما الذي كان يفكر فيه المؤلف؟ هذا هو السؤال الرئيسى في منهجيات التفسير، وهو علم كبير جداً من الصعب أن أقوم بعمل ولو مسح بسيط له هنا، فعلم التفسير يحتل الجزء الأكبر من علوم النقد الكتابى على الإطلاق. لكن هناك بعض الآليات التي تتحكم في علم التفسير، من بينها عقيدة العصمة التاريخية التي تترتب على الوحي اللفظى التام.
الوحي اللفظى التام يعنى أن المُنتج النهائى هو كلمة الله حتى أصغر ألفاظه، وسواء كان هذا بشكل إملائى أو لا، فالمنتج النهائى واحد. ولأن الله كامل، فلا يُمكن أن يصدر خطأ عنه، وبالتالي لا يُمكن أن يكون هناك خطأ في الكتاب المقدس من أي نوع. لهذا السبب، يختار المؤمن بوحى الكتاب المقدس لفظياً وتاماً، الخيار الذي ينفى الخطأ عن الكاتب، لأن عقيدة الوحي اللفظى التام يترتب عليها عقيدة العصمة عن الخطأ التاريخى.
هناك بعض الملاحظات التي يجب أن ندركها:
- أن السبيل الوحيد لمعرفة قصد الكاتب الحقيقى هو إعلان الروح القدس للقارىء، أثناء قراءته للنص. غير هذا فإن علم التفسير لا يُقدم ضماناً مُطلقاً حول معنى النص، لأن كافة الاحتمالات واردة.
- يجب تطبيق المنهج العلمي أثناء تفسير النصوص، وذلك بوضع كافة الاحتمالات الممكنة والتفاسير التي تحتمل الصحة، ومن ثم عمل تقييم شامل لها، ثم اختيار أفضل تفسير ممكن للنص. وفي هذا فإن منهجيات علم التفسير مفيدة جداً للقارىء.
- الشرط العلمي الأول في التقييم بين الاحتمالات الممكنة، هو مراعاة البيئة التي خرج منها هذا النص. لذلك يشدد علماء التفسير، على أن النص يجب أن يُنظر له بمعايير عصره، لا بمعايير عصر آخر.
- لا يجب النظر إلى ظاهر النص على أنه الاحتمال الأقوى إذا ما وُجِدت عدة احتمالات، لأن ظاهر النص لا يعنى أنه المقصود، خاصةً في كتاب مثل الكتاب المقدس، قدس أقداسه هو الرمزية والمثلية والتشبيه.
- يجب النظر بإعتبار إلى مدى كون الخطأ خطأ حقاً. فماذا لو أن النص كان يقصد بالفعل أن حبة الخردل هي أصغر البذور تماماً؟ إذا كان هذا القول تم عن قصد، فلابد أن له دافع معين علينا البحث عنه، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نعتبره خطأ، لأن التعمد في ذكره يعنى معرفة الكاتب بخطأه.
الملاحظة الأخيرة لا تستقيم مع نظرية الوحي اللفظى التام، إذ أن العصمة الناتجة عنها، لا تحتمل وجود أي خطأ بأى شكل وبأى هدف. ولكن الأمر مختلف تماماً مع الرؤية الموضوعية أو الرؤية الديناميكية. كما كان الوحي بحسب الرؤية الديناميكية مجاله واسع، فكذلك عصمة الكتاب المقدس بحسب هذه الرؤية، واسعة المجال. لكن الطرح الرئيسى للعصمة بحسب الرؤية الديناميكية، هو الملاحظة الأخيرة. من الممكن أن “يسمح” الله بورود الضعف البشرى في الكتاب المقدس، لهدف منه، علينا نحن أن نتصارع معه لنعرفه.
مثال شهير على ذلك الأمر، وهو ترتيب الأحداث بحسب الأناجيل. لو تكلمنا عن حدث واحد، مُكون من عدة أحداث، فلا يُمكننا أن نقول بأن هذه الأحداث حدثت في أكثر من تسلسل واحد. لابد أن يكون هناك تسلسل واحد للأحداث، وأى تغيير فيه لن يكون حقيقياً. لكن التغيير في تسلسل الأحداث هو سمة عامة في الأناجيل الأربعة، وخاصةً الأناجيل الإزائية. هناك تسلسل أحداث واحد فقط، وذلك يعنى أن أحد الأناجيل قد نقله صحيحاً، وإنجيل آخر قد غيَّر في تسلسل هذه الأحداث.
على أساس يُمكننا أن نقول أن التغيير في هذا التسلسل هو “خطأ” رغم أنه غير حقيقى بالفعل؟ كونه غير حقيقى لا يعنى أنه خطأ، لأننا أمام احتمالين: أن البشير يكون قد غيره عن حقيقته دون إدراك، وهو في هذه الحالة خطأ، ولكن من الممكن أيضًا أن يكون البشير قد غيره عن حقيقته عن قصد.
في هذه الحالة لا يُمكننا أن نقول أن البشير “أخطأ” لأن انعدام العفوية ينفى الخطأ، وبروز معالم التعمد في تغيير حقيقة التسلسل، تؤكد معرفة الكاتب أن ما يكتبه هو تسلسل غير حقيقى، وبذلك تنتفى صفة الخطأ ما كتبه الكاتب. بذلك يبقى على الإنسان أن يوظف البحث العلمى، متمثلاً في علم التفسير في هذه الحالة، ليعرف السبب في ذلك.
وفي هذا نلاحظ أن انعدام التسلسل الحقيقى هو خطأ في حد ذاته بمعايير عصرنا، ولكن حينما نوظف المنهج العلمى، يتبين لنا أن انعدام التسلسل الحقيقى ليس خطأ في حد ذاته بمعايير ذلك العصر. هناك نموذج رئيسى لهذا الطرح في توقيت لعن المسيح للتينة وتطهيره للهيكل، يمكن دراسته بشكل أوسع لفهم هذا المفهوم.
بشكل عام، العصمة التاريخية تكمن في مدى كون الخطأ خطأ حقاً.
على الجانب الآخر، هناك أحد الجوانب اللاهوتية الهامة التي تتمركز في أي مناقشة للعصمة: مبدأ الاستعادة Restoration. هذا مبدأ كتابى هام، ولعل المسيحية بأكملها تقوم على هذا المبدأ، في سقوط الإنسان الأول، وكيف استعاد الله شركته مع الإنسان من جديد. الأساس الذي يقوم عليه هذا المبدأ، هو أن الله يستطيع أن يخرج من الناقص كمالاً، ومن الفاسد صلاحاً. فمن الآكل يُمكِن أن يخرج أكلاً، ومن الجافى يُمكن أن تخرج حلاوة…و من الناصرة يُمكن أن يخرج شيئاً صالحاً.
نفس هذا المبدأ اللاهوتى يُمكن أن يُستخدم في قضية العصمة. من الممكن أن يستخدم الله النقص البشرى، في أن ينتج كمالاً. ومن الممكن أن يستخدم الفساد البشرى، في أن ينتج صلاحاً. هذا يعنى أن الله يُمكن أن يستخدم ورود خطأ حقيقى يُدخله الكاتب لنص الكتاب المقدس، في أن يُنتج كمالاً وصلاحاً منه. رغم أننى لا أعتقد بحدوث الخطأ الحقيقى في الكتاب، إلا أننى أؤمن بتفعيل هذا المبدأ في طبيعة انتقال النص الكتابى. كما سأناقش تفصيلاً في عقيدة الحفظ، فإننى أؤمن أن الله سمح بدخول نصوص ليست من الكتاب المقدس إليه، كى ينتج صلاحاً وكمالاً، من هذا النقص والفساد.
و عن العصمة التاريخية، اجتمع في نهاية السبعينات، حوالى 300 عالم في مؤتمر دُعى “المؤتمر العالمى للعصمة الكتابية”، في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة. خرج عن هذا المؤتمر بيان يشرح عصمة الكتاب المقدس عن الخطأ التاريخي والعلمى، سُمِى “بيان شيكاغو عن العصمة الكتابية”.
نُشِر هذا البيان لأول مرة في مجلة الجمعية الإنجيلية اللاهوتية، ثم نُشِر كتاب حرره نورمان جايزلر بعنوان “العصمة”، ضم مقالات العلماء الذين شاركوا في كلمات المؤتمر، وفي نهايته ملحق ببيان شيكاغو. هذا البيان في شكله العام، يوضح ماهية العصمة التاريخية، واليوم هو النص المعيارى للمجتمع الإنجيلي حول عقيدة العصمة.
غير أن هذا البيان ليس قانوناً للإيمان، وهناك علماء إنجيليين كثيرين لا يؤمنون ببنوده. وفي رؤيتى الشخصية، يُعتبر هذا البيان هو أفضل تحديد للعصمة الكتابية خرج في اللاهوت التاريخي بأكمله، وأستطاع بمهارة توضيح الفروقات الدقيقة.
العصمة التعليمية Infallibility
الغالبية العظمى من المسيحيين في كل مكان يؤمنون بالعصمة التعليمية، أي أن الكتاب المقدس معصوم فيما يعلم به من تعاليم تطبيقية وروحية. لذا لن يكون حديثى طويل في هذه النقطة، ولكن سأتناول نقطتين رئيسيتين: تأثير انعدام العصمة التاريخية على العصمة التعليمية، ونقطة الأرواح الشريرة في اللاهوت الإنجيلى.
اولاً، أنا لا أقول أن العصمة التاريخية غير موجودة في الكتاب المقدس، بل أؤمن بها بحسب الرؤية الديناميكية. ولكن ما أريد أن أعالجه هو كيف يُمكن للفرد أن يثق في التعليم التطبيقى، إذا كان لا يؤمن بالعصمة التاريخية. هذه النقطة في غاية الخطورة، لأنها تخلط بين النص وجوهر فكر النص ورسالة النص. لقد أكدت طوال هذه الدراسة أن رسالة النص إلهية خالصة، وهى هدف الله من البداية لكي يُوجد كتاب مقدس.
هذه الرسالة هي نفس الرسالة التي تصل للقارىء سواء كان فكر النص يحمل ما يُمكن أن يتصوره القارىء على أنه خطأ، حقيقةً كان أو غير حقيقةً، وهى نفس الرسالة التي تصل للقارىء إذا كان لا يعتقد أن هناك خطأ في النص. لنأخذ مثال تطبيقى على هذه النقطة، وهو نفس النص محل النزاع الذي تناولته، حول حبة الخردل.
يقول الرب يسوع:”وَقَالَ: «بِمَاذَا نُشَبِّهُ مَلَكُوتَ اللَّهِ أو بِأَيِّ مَثَلٍ نُمَثِّلُهُ؟ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مَتَى زُرِعَتْ فِي الأَرْضِ فَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ الْبُزُورِ الَّتِي عَلَى الأَرْضِ. وَلَكِنْ مَتَى زُرِعَتْ تَطْلُعُ وَتَصِيرُ أَكْبَرَ جَمِيعِ الْبُقُولِ وَتَصْنَعُ أَغْصَاناً كَبِيرَةً حَتَّى تَسْتَطِيعَ طُيُورُ السَّمَاءِ أَنْ تَتَآوَى تَحْتَ ظِلِّهَا»” (مر 4: 30 – 32).
فلنفترض أن هذا النص يحوى خطأ علمى، وهو أن حبة الخردل ليست هي أصغر البذور. لكن الحديث الخاص بالمثل، هو جوهر فكر النص، أما رسالة النص فهى طبيعة ملكوت الله. ملكوت الله الذي قد يكون مجرد شرارة بسيطة جداً تلتهب في قلب إنسان واحد، ولكن لأنها حركة إلهية منبعثة من الله، تستطيع احتواء الكل، حتى الأمم.
سواء كان النص يقصد أن البذرة أصغر بذور الأرض فعلاً (و هو الأمر الغير حقيقى علمياً)، أو كان للنص معنى آخر مثل أن الحبة تبدو متناهية الصغر في يدى الفلاح البسيط (و هو الأمر الحقيقى عملياً)، فإن كل هذه الأمور متعلقة بفكر النص، ولكن رسالة النص هي هى، سواء كان فكر النص يضم خطأ علمى أو لا يضم.
الفرع الثانى لهذه المشكلة، هو ضمان ما إذا كان الكتاب المقدس يضم رسالة إلهية حقاً أم لا. هذا الإعتراض له شكل أوسع، وهو ما إذا كان الكتاب المقدس هو وحي الله أم لا، وسأناقشه في نهاية هذه الدراسة، لكن في إيجاز أقول: مدى كون وحي الكتاب المقدس حقيقى أم لا، فهذه حقيقة غير خاضعة للاختبار البشرى. إذا ما جاء إلى شخص يسألنى ما هو دليلك على أن الكتاب المقدس هو وحي من الله حقاً، لا أقول له سوى كلمة واحدة: اقرأه. أما عن الأدلة النظرية على وحي الكتاب المقدس، فأنا لا أملكها.
سواء كان هناك تناقضات في الكتاب المقدس أم لا، وسواء كان هناك أخطاء تاريخية وعلمية في الكتاب المقدس أم لا، فهذا لا علاقة له بخطة الله لخلاص الإنسان. الرسالة الإلهية التي أرسلها الله للبشر واحدة، سواء قرأنا الكتاب المقدس على أنه معصوم عن الخطأ التاريخي والعلمى، أو كان به أخطاء تاريخية وعلمية. وفي ذلك، فرسالة النص لم تُمَس.
هنا يجب أن ننتبه إلى أن العصمة عن الخطأ التعليمى لا تمتد إلى العقيدة، ولكن التعليم. بمعنى أن العقيدة هي حقيقة، غير قابلة لتطبيق العصمة عليها أو لا. ولكن ما يُقصد بالتعليم هو الصوم، الصلاة، المواهب…إلخ، أي التعليم التطبيقى فقط، وليس العقيدة.
النقطة الثانية التي أريد مناقشتها هي مفهوم الأرواح النجسة في ضوء العصمة التعليمية. هناك قطاع كبير بين الإنجيليين اليوم، يرفض فكرة أن الأرواح النجسة التي يتكلم عنها الكتاب المقدس، هي في حقيقتها أرواح نجسة أو شياطين حقاً، وإنما يمكن تفسيرها على أنها ظاهرة طبية، أستطاع الطب الحديث تحديدها، وهو مرض الصرع. هذه النقطة ليست في الغرب فقط، بل إمتدت للكنيسة الإنجيلية في الشرق، وأصبحت قاعدة معروفة في الكنيسة الإنجيلية في مصر. منذ وقت قريب كنت في أحد الكنائس الإنجيلية وكنت في نقاش مع القس الراعى لها، ووجدته مؤمناً بنفس الفكرة.
لست بصدد تفنيد هذا الفكر، ولكن بيان أن حتى عدم إيمان الفرد بالعصمة عن الخطأ التعليمى، لا يعنى سقوط وحي الكتاب المقدس. دعونى أفترض أنها لم تكن أرواح نجسة حقاً، فيكون لدينا احتمالين: أن كتبة الأسفار لم يدركوا هذا ومع ذلك كتبوا، أو أن كتبة الأسفار أدركوا هذا ومع ذلك كتبوا. عادةً لا يُفهم هذا على أنه سقوط للعصمة التاريخية أو العصمة التعليمية، لأن المنادين بهذا الرأى، يؤكدون أن الله استخدم هذا الخطأ لينتج صلاحاً، مشددين على أن علامات التعمد بارزة، مما ينفى عن الكتبة خطأهم العفوى، فتنتفى صفة الخطأ.
الحفظ Preservation
تحدثت كثيراً سابقاً عن عقيدة الحفظ في كتابات كثيرة، لذا فسيكون كلامى هنا مُختصراً وحول نقاط بسيطة جديدة فقط. هذه العقيدة لا يؤمن بها إلا الأصوليين فقط، وحتى الإنجيليين المؤمنين بعقيدة الوحي اللفظى التام، لا يعتقدون بوجوب ترتب عقيدة الحفظ عليها. عقيدة الحفظ بشكل عام، هي الاعتقاد بضرورة وجود النص كما هو محفوظاً للمسيحيين في كل العصور. وهذه العقيدة لها تأثير سلبى جداً، خاصةً إذا كانت الفرضية التي ينطلق منها الباحث في النقد النصى.
لم يعلم الكتاب المقدس بضرورة حفظ نصه ابداً، ولكن هذه العقيدة تخرج من رؤية لاهوتية لا من رؤية كتابية. هذه الرؤية اللاهوتية تقول بأنه إذا كان الله قد قام بوحى هذا الكتاب، وأن المنتج النهائى يُعَد وحياً حتى أصغر كلماته، فلابد على الله أن يحفظ هذا الوحي لكل المسيحيين في كل العصور، وإلا فلما قام بالوحي من البداية؟ المشكلة الرئيسية هي أن هذه الرؤية لا تحاول البحث عما أعلنه الله، بل تفرض على الله ما يجب عليه. وهنا يجب التفريق بين ضرورة العصمة التاريخية، وضرورة الحفظ.
بحسب نظرية الوحي النظري التام، فإن كل كلمة في الكتاب المقدس هي وحي من الله، حتى وإن كان هذا بشكل يختلف عن الإملاء، ولأن الله كامل فلا يُمكن أن يخرج منه نقص. لذلك يستحيل علينا أن نجد في الكتاب المقدس خطأ تاريخي أو علمى، ولهذا فعقيدة العصمة التاريخية والعلمية واجبة الترتب على نظرية الوحي اللفظى التام. لكن على العكس من ذلك، فنظرية الحفظ لا علاقة لها بكمال الله، لأن عدم حفظ النص لا يؤثر في كمال الله ولا يؤدى إلى الاعتقاد بنقص فيه.
فإذا انعدم السبب النقلى للعقيدة، وانعدم السبب العقلى للعقيدة، لا يعود هناك أي سبب للاعتقاد بضرورة حفظ نص الكتاب المقدس. بالإضافة إلى ذلك، فالدليل يُشير إلى أن هذه العقيدة لا وجود تاريخي حقيقى لها. يوجد آلاف الاختلافات بين مخطوطات الكتاب المقدس، مما يعنى أن عقيدة الحفظ لها وجود عملى لها، مما ينفى وجودها النظري أيضًا. حتى الآباء الذين آمنوا بعدم احتواء الكتاب المقدس على أية أخطاء، لا نرى في كتاباتهم أي أثر لوجود شيء اسمه عقيدة حفظ نص الكتاب المقدس.
فى الحقيقة، أحد التفاسير الخاصة بالرؤية الديناميكية، تؤكد أن النصوص التي دخلت للكتاب المقدس عبر تاريخ انتقاله، سمح الله بها لأجل هدف معين. الأساس لهذا التفسير، هو أن كل حدث يتم بسماح من الله، وهذا السماح يكون لهدف معين. لذلك يشدد هذا التفسير على أن هذه النصوص التي دخلت للكتاب المقدس وهى ليست منه في أصله، استخدمها الله لينتج براً وكمالاً وصلاحاً. هذا الفساد النصى، استخدمه الله ليكون سبباً في معرفة الإنسان له. أنا أؤمن بهذه الحقيقة تماماً، ولمستها بيدى ورأيتها بعينى.
إجمالاً، الكتاب المقدس لا يقول أن هناك شيء اسمه عقيدة الحفظ، والمنطق لا يُجبر الفرد على الإيمان بعقيدة الحفظ كنتيجة للوحى الفعلى التام، وبالطبع لا حاجة لها مُطلقاً في الرؤية الديناميكية، وايضاً الدليل يُشير إلى أن هذه العقيدة ليست حقيقية واقعياً. لهذه الأسباب لا يؤمن أحد بعقيدة الحفظ إلا الأصوليين فقط.
العقيدة
إن العقيدة المسيحية هي الحقيقة في حياة المؤمن المسيحى، وليست قابلة إطلاقاً أن تكون محل نقاش حول عصمتها من عدمها، لأنها حقيقة فعلية. هذا يعنى أننا لا نستطيع أن نقول أن لاهوت المسيح عقيدة معصومة. هذه جملة ليس لها معنى، لأن العقيدة هي أساس الإيمان، ولا مجال للتشكيك بها، وإلا فلو ثبت بطلانها فهذا يعنى لا وجود للإيمان.
أنا لا أقول أننا لا يجب أن نفحص الدليل الكتابى حول كل عقيدة، ولكن أتحدث بشكل نظرى حول إمكانية عصمة العقيدة أم لا. لذلك لا يوجد أي نظرية تُعلِم بأن العقيدة نفسها معصومة عن الخطأ، لأنه لا مجال للاختلاف على حقيقة العقيدة.
إيمانى الشخصى في الكتاب المقدس
هذه الدراسة كانت في أغلبها عرض لما توصل له العلماء الإنجيليين في الغرب عن ماهية الوحي الكتابى وعصمته، ولم أتطرق إلى إيمانى الشخصى فيها إلا نادراً، بهدف تحديد النظريات كاملة لك، حتى تستطيع تكوين رؤيتك الشخصية عن الوحي الكتابى. أما إيمانى الشخصى في الكتاب المقدس، فهو كالتالى:
أنا أؤمن أن الكتاب المقدس هو وحي الله للإنسان، ودونه رجال الله القديسين، وأصبح يُعرف بالكتاب المقدس. هذا الوحي وحدة واحدة متكاملة، غير قابلة للتجزئة على نصوص الكتاب المقدس، سواء أسفاره أو إصحاحاته أو أعداده، بل هو شحنة واحدة تسير وتجرى في كافة نصوص الكتاب المقدس. أؤمن بالرؤية الديناميكية بشكل عام، حول كيفية إتمام الوحي، لأنى أراها الأكثر تجاوباً مع نتائج الاستقراء، لكن هذا لا يعنى قبول كل النظريات والتفسيرات التي تقدمها هذه الرؤية.
وأؤمن أن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ التاريخي والعلمى، ومعصوم عن الخطأ التعليمى. لا أؤمن أن نص الكتاب المقدس معصوم من ناحية حفظه، رغم أن النص محفوظ بالفعل في الشواهد المتوفرة، وذلك في العهد الجديد مجال اختصاصى. أؤمن أن الكتاب المقدس هو السلطة الأولى في حياة المؤمن المسيحى، رغم أننى أؤمن بسلطة التقليد الرسولى الذي يجرى في الكنيسة.
خاتمة: البرهان والإيمان
إيمانى الشخصى نابع من دراسة البرهان الكتابى، والبرهان المنطقى، والبرهان التاريخى. قضية الكتاب المقدس في نظر أي مؤمن حقيقى، يجب أن تكون قضية ثانوية، ولا علاقة لها بالإيمان. كما شرحت في بداية هذه الدراسة، أساس الإيمان هو الاختبار الروحي. إذا كنت لم أعرف شيئاً عن المسيح بعد، ولم أختبره، ولم أتقابل معه، ولم يصير بعد شخص حقيقى موجود في حياتى مثل كل فرد حقيقى في حياتى، فلا داعى لأن أهتم بوحى الكتاب وعصمة الكتاب والنقد الكتابى والعقيدة وكل هذه الأمور.
لا فرق بينى وبين المسلم واليهودى والملحد والبوذى وعابد الوثن في نظر الله. لأن وحي الكتاب المقدس وعصمته ليس هو ما سيخلص الإنسان. إذا أردت أن أضمن مكانى في ملكوت السماوات، فالطريق الوحيد هو الإيمان الحى، ليس الإيمان النظرى.
الشفاء الحقيقى لداء البشرية في قيامة الرب يسوع المسيح من الموت، لأن هذه القيامة هي بداية خلاصنا وحريتنا. لن ينفعنى وحي ولا عصمة ولا نص، وكل هذه الأمور النظرية لا قيمة لها ابداً، إن لم أنل الميلاد الثانى الحقيقى. في لحظة بدأت بحثى العلمي في الكتاب المقدس، وبعد سنوات إنتهى بحثى. كنت أبحث عن المسيح في هذه النظريات كثيراً، وفي لحظة أخرى وثقت أن إيمانى في المسيح صحيح.
سألت نفسى: وماذا بعد؟ لم أشعر بأن كل هذا البحث له أي قيمة! كان صوت والدى يرن في أذنى دائماً: لن تجد المسيح هنا. بعد صراع روحي مرير مع الله، قبلته في حياتى في رأس السنة منذ ثمانية شهور. أدركت في ذلك الوقت أن العلم لن يخلص الإنسان. لو أننى تيقنت مئة في المئة أن الكتاب المقدس هو كتاب الله، ولم أتخذ أي خطوة إيجابية من جانبى، فهذا كله لن يفيد ابداً.
سأكون أمام الله مثل أي شخص غير مسيحى، لأن المسيحي هو المؤمن الحى، وليس المؤمن النظرى. هذه سمة المسيحية بين كل العقائد والأنظمة الدينية: الحياة لا النظرية. لأن النظرية هي الموت، والإيمان هو الحياة. الإنسان المسيحي ليس مُطالب أن يكون لديه رؤية تفصيلية للوحى لكي يؤمن، ولا أن يفهمه بأكمله لكي يؤمن. الإيمان هو خطوة إيجابية نحو المسيح، وهو حرية من كل قيود الموت.
لست تحتاج إلى أن تتيقن من أن هذا الكتاب ليس به خطأ حتى تؤمن، وحتى لو كان به خطأ، فهذا ليس عائقاً أمام الإيمان. رسالة الله للإنسان واضحة جداً، مهما كانت النظريات ومهما كانت الفرضيات ومهما كان شكل الاعتقاد في الكتاب المقدس. حتى لو كنت تؤمن أن هذا الكتاب على حاله الآن محرف، ستجد نفس الرسالة التي يقدمها الله، مهما أدعيت كافة أشكال وأنواع التحريف. سواء كان خطأ نسخى، خطأ تاريخى، خطأ علمى، أو لا خطأ إطلاقاً، ستجد نفس الرسالة التي يقدمها فكر النص واحدة.
هذه الدراسة كانت ملخص دراساتى وابحاثى في عقيدتى الوحي والعصمة، بحث استمر لأكثر من ثلاث سنوات. عقيدتى في الوحي والعصمة جاءت نتيجة دراسة متفحصة شاملة لأغلب الأدب الإنجيلي في هذا المجال. عليك أنت أيضًا أن تبحث وتجتهد قبل أن تتخذ قراراً بشأن اعتقادك في الكتاب المقدس، وعليك أن تتعب كى تنال. هذه هي ضريبة الحقيقة التي عليك أن تدفعها لتنالها.
لندع البرهان هو الذي يشكل عقائدنا. لنترك البرهان الكتابى يتحدث عن نفسه، ومن ثم نتصارع مع الله حتى ننتصر عليه. الله هو الذي يدعونا أن ننتصر عليه في هذا الصراع، ونقول له كما قال يعقوب أب الآباء:”لا اطْلِقُكَ انْ لَمْ تُبَارِكْنِي” (تك 32: 26). وبالفعل، باركه الله، وغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل:”لا يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ اسْرَائِيلَ لانَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَدِرْتَ” (ع 28). لقد “قدر” يعقوب، ونحن أيضًا مدعوون لأن نقدر.
الإيمان المسيحي لا يسير عكس البرهان، والشك ليس خطيئة. حينما شك توما أن يسوع قد ظهر للتلاميذ، ظهر له مرة أخرى وأعطاه يديه ليتحسس مكان المسامير، وجنبه لينظر طعنة الحربة. لم ينتهره يسوع ولم يغضب، بل دعاه بكل رفق أن يأتى وينظر البرهان بنفسه، ويفحصه، وإلا يكون غير مؤمناً..بل مؤمناً.
لا داعى أن نكون متعصبين لما نعتنقه ونجهض الآخر حقه. في نهاية عام 1983، تم فصل العالم ستانلى جوندرى من الجمعية الإنجيلية اللاهوتية، بعد أن قام أعضاء الجمعية بالتصويت حول ما إذا كان جندرى يستحق أن يكون عضواً في الجمعية. واليوم، ستانلى جوندرى هو من أكبر علماء العهد الجديد الإنجيليين المؤمنين بعصمة الكتاب المقدس. لا أتمنى أن يكون بيننا جندرى آخر، بل أصلى للرب أن يحفظ الكنيسة ويرعاها ويفتح أعيننا وعقولنا لنستوعب الآخر.
المراجع الرئيسية
Ben Witherington III, The Living Word of God: Rethinking The Theology of The Bible, Baylor University Press 2007
Craig D. Allert, A High View of Scripture? The Authority of The Bible & The Formation of The new Testament Canon, Baker Academic: Baker Publishing Co. 2007
Donald Guthrie, New Testament Theology, Chapter ten ‘Scripture’, InterVarsity Press 1981, Pp. 953 – 982
Donald G. Bloesch, Essentials of Evangelical Theology, Vol. one (God, Authority & Salvation), Cahpter four ‘The Primacy of Scripture’, Fitzhenry & Whiteside: Canada 1978, Pp. 51 – 87
K. Beale, The Erosion of Inerrancy In Evangelicalism: Responding To New Challenges To Biblical Authority, CrossWay Books 2008
Harriet A. Harris, Fundamentalism and Evangelicals, Oxford University Press 2008
Howard Marshall, Biblical Inspiration, Hodder and Stoughton 1982
Kern Robert Trembath, Evangelical Theories of Biblical Inspiration: A Review & Proposal, Oxford University Press 1987
Norman L. Geisler (ed.), Biblical Errancy: An Analysis of Its Philosophical Roots, Zondervan Publishing House 1981
Normal L. Geisler (ed.), Inerrancy, Zondervan Publishing House 1980
Trevor A. Hart (ed.), The Dictionary of Historical Theology, Eerdmans: USA 2000.