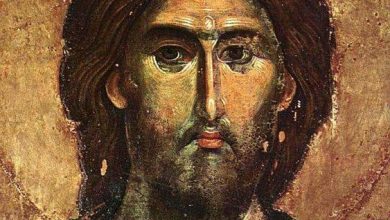أدلة أن الكتاب المقدس هو كلمة الله
أدلة أن الكتاب المقدس هو كلمة الله

الدلائل على كون الكتاب المقدس هو كلمة الله
بوسعنا قول المزيد، بل حقاً أكثر بكثير، مما رأيناه قبلاً في الفصل الثاني عن رأي يسوع في أصل الكتاب المقدس وطبيعته. لذا، فإن أول ما سنقدم عليه في هذا الفصل هو تناول، من زاوية تفسيرية، المزيد من الدلائل عما يقوله الكتاب المقدس عن نفسه، ذلك لأننا لا نبغي بكل تأكيد ادعاء عن الكتاب المقدس أي شيء لا يدعيه هو عن نفسه. سنتناول على التوالي 1كورنثوس 2: 6-14؛ 2بطرس 3: 15، 16؛ 2تيموثاوس 3: 16، 17؛ 1بطرس 1: 10-12؛ 2بطرس 1: 20، 21. بعد هذا سنستعرض حجة عن وحي الكتاب المقدس قدمها “غوردن هـ كلارك”. من ثم سنبحث في شهادة الروح لمصداقية الكتاب المقدس في قلوب مختاري الله. أخيراً، سنختم ببحث لقانونية العهد الجديد.
1كورنثوس 2: 6-14
في هذا النص الذي يصفه “تشارلس هودج” بأنه “أكثر نص تعليمي رسمياً في الكتاب المقدس كله” حول عقائد الإعلان والوحي[1]، أكد بولس عن نفسه كونه رسول المسيح[2]: “التي نتكلم بها أيضاً [الأفكار المعطاة لنا من الله بصراحة]، ليس بكلمات تعلمها الحكمة البشرية، بل بما تعلمه [كلمات] الروح، مع [كلمات] الروح شارحة أفكار الروح” (1كورنثوس 2: 13)[3].
في المقطع الذي سبق، كان بولس قد أكد أنه بإعلانه المسيح المصلوب (أي الإنجيل)، كان يتكلم “بحكمة الله في سر”، الحكمة التي لم يعرفها أحد من “عظماء” هذا الدهر (هؤلاء يشملون الناس الحكماء، والدارسين، والفلاسفة؛ راجع 1: 20). هو يصف هذه الرسالة على أنها حكمة “في سر”(2:7)، ذلك لأن ما كان يعلنه، كما يصرح، “لم تره عين [بشرية]، ولم تسمع به أذن [بشرية]، ولم يخطر على بال [بشري]” (2: 9). وفي معرض الرد على السؤال المطروح مسبقاً: “إن لم تكن رسالتك في متناول الناس، كما تقول (2: 9)، فكيف حصلت عليها أنت؟” يصرح بولس: “أعلنها لنا الله بروحه” (2: 10أ). أما السبب وراء قدرة الروح على إعلان فكر الله للناس، فهذا مرده، كما يذكر بولس، إلى كون الروح يعرف أفكار الله بما أنه الله نفسه (2: 11ب).
ثم يضيف بولس أن ما يجعله كرسول يتكلم بما يعرفه روح الله، هو كونه قد أخذ روح الله (2: 12) الذي لم يعلمه أفكار الله وحسب، بل أيضاً الكلمات عينها لصياغتها. وهو يصرح: “الأشياء الموهوبة لنا من الله [بالروح]“ (2: 12ب)، “نتكلم بها أيضاً، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس [بكلماته]، قارنين الروحيات بالروحيات [مع كلمات الروح مفسرة “أفكار” الروح]” (2: 13). فحتى الكلمات نفسها التي اعتمدها بولس للتعبير عن أفكار الله المعلنة، كانت من الروح، ومصدرها الروح. أمامنا هنا الوحي الحرفي حقاً، الوحي الحرفي بالكامل. لأنه بوسعنا التأكد من أن الروح لم يوح بأية كلمة بشكل عرضي. فكل كلمة أوحى به، قصد أن يختارها وهي هناك لهدف محدد. من هنا، علينا ألا نتمنى أبداً لو أن الروح لم يوح لأحد كتاب الكتاب المقدس بما صرح به، أو كان عليه أن يوحي للكاتب أن يقول ما قاله بشكل مختلف بواسطة كلمات أخرى.
أخيراً، يكتب بولس أن على أحدنا أن يقبل روح الله لفهم “الأمور التي يعلمها الروح”، ذلك لأن “الإنسان الطبيعي [الإنسان من دون الروح، أو الإنسان الساقط من أظلمت الخطيئة قدرته على استيعاب الأمور الروحية] لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحياً [بمعنى أن الروح هو الذي يمكننا من تمييزها]” (2: 14).
باختصار، يؤكد بولس أنه وبصفته رسولاً، فإن كلاً من الأفكار التي أعلنها [راجع الفعل باليوناني (لالومن)، ومعناه الحرفي “نتكلم به”] كما الكلمات التي اعتمدها في معرض التعبير عن أفكاره، لم تكن في نهاية المطاف أفكاره أو كلماته هو، بل كانت في الأصل أفكار الروح وكلماته. يظهر تصريح بولس هنا أنه ليس من المناسب فحسب، بل من الضروري التحدث عن “وحي حرفي” إن أراد أحدنا أن يكون كتابياً. ومن جديد، بمقدور أحدنا أن يستخلص من هذا عن حق أنه إن كان بولس قد دون هذه الأفكار بشكل خطي، بعد صياغتها بالكلمات التي علمها الروح، فإن ما كتبه في الكتاب المقدس، إنما يساوي أفكار الروح وكلماته.
2بطرس 3: 15، 16
هل يقع نظرنا في مكان ما من العهد الجديد على تصريح مفاده أن ما كتبه بولس كرسول، كان كلمة الله؟ أجل، نجد هذا في النص الذي يعتبره “جورج أ. لاد” “أبكر إشارة إلى حقيقة كون الكنيسة الرسولية كانت تنظر إلى رسائل بولس – أو إلى بعض منها على الأقل – كأسفار مقدسة”[4]. ففي 2بطرس 3: 15، 16، يعلن بطرس: “واحسبوا أناة ربنا خلاصاً، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضاً، متكلماً فيها عن هذه الأمور، التي فيها أشياء عسرة الفهم، يحرفها غير العلماء وغير الثابتين، كباقي الكتب أيضاً (باليونانية، كاي تاس لويباس غرافاس)، لهلاك أنفسهم”. بإمكاننا ملاحظة أربعة أمور عن هذا التصريح.
أولاً، يعلن بطرس أن ما كتبه بولس، ليس فقط ما وجهه إلى قرائه (قراء بطرس)، بل أيضاً في كل رسائله، كتب بحسب الحكمة المعطاة له. هنا يؤكد بطرس بالوحي الإلهي أن رسائل بولس تحوي حكمة إلهية بما أن الله هو الذي كان قد أعطاه الحكمة التي كتب بها. ثانياً، هنا بطرس ومن خلال قوله “كباقي الكتب أيضاً”، إنما يجعل رسائل بولس من ضمن مجموعة الأسفار المقدسة الموحى به إلهياً، كما أنه يسويها بها. ثالثاً، ترى سلطتها الإلهية في تصريح بطرس بشأن غير العلماء وغير الثابتين الذين يمعنون في تحريف رسائل بولس، وذلك لهلاك أنفسهم. أخيراً، يذكر بطرس هذه الأمور عن رسائل بولس، هذا مع كونه قد حصل في إحداها على توبيخ صارم بسبب ممارساته المتقلبة في أنطاكية (غلاطية 2: 11). إنه يُظهر بذلك استعداده لجعل نفسه تحت سلطة الكلمة الرسولية الصادرة عن بولس.
إذاً، يجزم بطرس كلاً من الأصل الإلهي الذي يدخل في جوهر رسائل بولس إلى جانب سلطتها أيضاً. وهذا بالتحديد ما يتوقعه أحدنا في ضوء التصريحات التي يدلي بها بولس نفسه عن الأصل “الخارجي” (أب إكسترا) لرسالته (غلاطية 1: 11، 12).
2تيموثاوس 3: 16
ماذا عن عبارة بطرس، “باقي الكتب”؟ وهل نفترض نحن عنها شيئاً لا يحق لنا افتراضه، أي أصلها الإلهي و”طابعها الإعلاني”، متى قلنا ما صرحنا به أعلاه؟ كلا، إن كنا نصدق بولس. فبولس يعلن في 2تيموثاوس 3: 16 أن “كل الكتاب هو موحى به من الله” (باسا غرافي ثيوبنستس)[5]. لكي نستوعب معنى هذا الكلام بالتمام، يلزمنا أن نفهم أولاً ماذا قصد بالعبارة “كل الكتاب” وبعد هذا، بالعبارة “موحى به من الله”.
على أقل تقدير، قصد بولس من خلال “كل الكتاب” أسفار العهد القديم المقدسة. وهذا واضح من تصريحه لتيموثاوس في العدد السابق مباشرة: “وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة [[تا] هييرا غراماتا]” قاصداً من خلال هذه العبارة العهد القديم نفسه الذي في حوزتنا اليوم.
هذا الأمر لا جدل حوله. لكن ثمة أسباب وجيهة لاعتقاد أن بولس كان على استعداد ليشمل، بل شمل بكل تأكيد تقريباً، من ضمن فئة “كل الكتاب” وثائق العهد الجديد أيضاً، بما في ذلك كتاباته هو أيضاً. ذلك لأنه عندما كتب بولس ما كتبه في 1كورنثوس 7، أكد بشيء من السخرية لأولئك الذين كانوا يدعون نيلهم موافقة الروح على تصرفهم بشكل مغاير لتوجيهاته: “وأظن أني أنا أيضاً عند روح الله” (7: 40). هنا يعبر بولس عن إدراكه أن ما كتبه كرسول، فقد كتبه تحت إشراف الروح القدس.
ومجدداً عن إدراكه هذا لتأثير إشراف الروح عليه لدى كتابته في 1كورنثوس 14: 37: “إن كان أحد يحسب نفسه نبياً أو روحياً، فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب”. ثم في 1تيموثاوس 5: 18 يكتب بولس: “لأن الكتاب [هي غرافي] يقول” ثم يقدم على اقتباس كل من تثنية 25: 4 ولوقا 10: 7. هذا قد يعني فقط أن إنجيل لوقا كان من قبل في حوزة بولس وأن بولس اعتبره كواحد من الأسفار المقدسة على قدم المساواة مع التثنية.
يتضح لنا من هذه المعلومات أن بولس كان ليشمل من ضمن تعبيره، “كل الكتاب”، أي وكل وثيقة مكتوبة مصدرها الله، وبالتالي من طبيعة “الكتابات المقدسة”. هذا يعني أنه شمل من ضمن هذه العبارة ليس العهد القديم فحسب، بل أيضاً تلك الأجزاء من العهد الجديد المكتوبة من قبل وأية أجزاء من العهد الجديد التي كانت ستكتب. باختصار، بالنسبة إلى بولس كل ما كان يحمل طابع “الكتب” بموجب استخدامه المنتظم لهذه اللفظة، كان على استعداد للتأكيد بشأن تلك الكتابة أنها موحى بها من الله. حقاً، وكما سنحاجج الآن، بما أنها “موحى به من الله” بالتحديد، فهي إذاً من “الأسفار المقدسة”.
ترى، ماذا قصد بولس بالتحديد عندما صرح بأن كل الكتاب هو “موحى به من الله” (ثيوبنستس)؟ وردت اللفظة اليونانية هنا فقط، لكن “أ. ت. روبرتسن” يعتبرها بمثابة صفة فعلية بناء على صيغة قديمة لاسم المفعول في المجهول[6]. لعل أقرب لفظة مشابهة لها في العهد الجديد (ثيو – في المقدمة وأوس في النهاية) هي اللفظة (ثيوديداكتوس) والتي تعني “متعلمون من الله” (لاحظ فكرة صيغة المجهول) في 1تسالونيكي 4: 9.
هذا المعنى يدعم عمل صيغة المجهول في (ثيوبنستس)، من هنا ترجمتنا “موحى به من الله”. أو بحسب الترجمة الإنجليزية “الله تنفسها”. لكن ما معنى هذا؟ هل هذا يعني أن الله نفخ شيئاً في الأسفار المقدسة، أو كون الأسفار المقدسة “خرجت من” نفس الله؟ بعد بحث مستفيض، خرج “بنجامن ب. وارفيلد” بخلاصة أن المعنى الأخير هو المقصود هنا، أي أن الله “تنفس” الكتاب المقدس وأخرجه من كيانه، وخلاصته هذه حظيت على وجه العموم بموافقة الدارسين. بعد تصريحه أن العبارة “موحى به” هي “ترجمة مغلوطة بل تضيع”، فهو يعرض السبب وراء خلاصته هذه كما يلي:
… اللفظة اليونانية في هذا النص – # (ثيوبنستس) – لا تعني بكل وضوح “موحى به من الله” فهذه العبارة هي بالحري الترجمة اللاتينية (ديفيناتس إنسبيراتا). بعد استعادتها من الصيغة “وكلف” (أل سكربتور أف عد إنسبيريد إز…”) ومن الصيغة “ريميش” (All Scripture inspired of God is…) للغولغاتة. لا تعني العبارة اليونانية حتى كما تترجمها الصيغة الإنجليزية AV، “معطاة بوحي من الله”.
هذه الترجمة هي موروثة من “تندال”: “كل الكتاب الموحى به من الله هو…” وأقل ما يقال فيها أنها خرقاء وغير ملائمة ربما، من دون أن تكون مضللة، وهي إعادة صياغة للعبارة اليونانية باللغة اللاهوتية المعتمدة في تلك الأيام. إلا أن اللفظة اليونانية لا تذك شيئاً عن inspiring أو inspiration لكنها تتحدث فقط عن “spiring” و”spiration”.
ما تقوله عن الكتاب ليس أن “الله نفخ فيه” أو كونه نتاج “تنفس” الله داخل كُتابه الأرضيين، بل بالحري كونها خرجت من نفس الله، أي أنها نتاج نفس الله الخلاق. بكلام آخر، ما يعلنه هذا النص الجوهري ببساطة هو أن الأسفار المقدسة هي نتاج إلهي من دون أية إشارة إلى الطريقة التي اعتمدها الله في معرض إنتاجها[7].
إذاً، بولس بإعلانه أن الله “تنفس [إلى خارج]” الأسفار المقدسة، كان يؤكد بذلك “بكل ما أوتي من طاقة أن الكتاب هو نتاج عمل إلهي محدد”[8]. بكلام آخر، كان بذلك يؤكد الأصل الإلهي للأسفار المقدسة بجملتها، بالكامل وبأجزائها، بشكل جازم لو أنه كتب (باسا غرافي إك ثيو) (“كل الكتاب هو من الله”).
وبصيغة مختلفة، كان يؤكد أن الكتاب المقدس هو إعلان إلهي. لا يبالغ “جايمس س ستيوارت” قط من خلال تأكيده أن بولي كفريسي ومن ثم لاحقاً كمسيحي، كان يؤمن أن كل كلمة من الكتاب “الخارج من نفس الله” كانت “صوت الله الحقيقي”[9].
إلى ذلك، عندما وصف الأسفار المقدسة على أنها (ثيوبنستك)، بمعنى أنها من الطبيعة نفسها “لنفس الله الخارج منه”، كان بذلك يؤكد شيئاً عن طبيعتها. فكما أن “نفس” الله (أي كلمته) خلق كل جند السماء (المزمور 33: 6)، وكما أن “نفسه” منح حياة جسدية لآدم وللبشرية جمعاء (تكوين 2: 7؛ أيوب 33: 4)، وكما أن “نفسه” منح أيضاً حياة روحية لإسرائيل، “بقعة العظام اليابسة” (حزقيال 37: 1-14)، هكذا أيضاً فإن “نسمة فيه” المقتدرة تحت شكل كلام، هي “حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته” (عبرانيين 4: 12).
كما أنها لا تفنى وثابتة (1بطرس 1: 23)، وروح الله العامل من خلالها ومعها في النفس، يمنح النفس المحتاجة إلى ولادة جديدة حياة جديدة. وكما يكتب بطرس في 1بطرس 1: 23-25: “مولودين ثانية، لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لأن: كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها”.
اختتم بولس وصفه “لكل الكتاب” بقوله إنه “نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان لله كاملاً، متأهباً لكل عمل صالح” (2تيموثاوس 3: 16، 17)[10]. هنا يؤكد بولس كلاً من نهائية الأسفار المقدسة وكفايتها فيما يخص حاجة الإنسان التقي إلى كلمة إعلان من السماء.
1بطرس 1: 10-12
“الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الذين تنبأوا [بروفتويسانتس] عن النعمة التي لأجلكم [يعلن بطرس]، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد [برومرترومينون] بالآلام التي للمسيح، والأمجاد التي بعدها. الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم، بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أُخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشكروكم في الروح القدس المرسل من السماء”.
لدينا هنا تأكيد، لا يرقى إليه أي شك، على أن الأنبياء المذكور عنهم أنهم تلقوا الإعلان الإلهي، كان روح المسيح الذي فيهم هو الذي يتنبأ من خلالهم، عندما تنبؤوا عن أمور مستقبلية.
يبني “التصريح العقيدي لكلمة اللاهوت – دالاس” على هذا المقطع تصريحهم عن قديسي العهد القديم أنهم “لم يفهموا الأهمية الفدائية للنبوات والرموز المختصة بآلام المسيح”. لكن بطرس لا يعلم هذه الفكرة في هذه الأعداد. فهو يقول عنهم أنهم كانوا يبحثون بشكل هادف وبكل اهتمام عن الوقت والظروف، وليس عن “الذي”[11] (تينا أي بويأن كايرن؛ حرفياً، “أي وقت أو ما الوقت”)، المتعلق بآلام المسيا، وليس آلامه بحد ذاتها والأمجاد التي بعدها.
أكرر أن بطرس لا يذكر عن أنبياء العهد القديم انهم كانوا يجهلون آلام المسيا بحد ذاتها. هذه الحقيقة يأتي ليثبتها وصف بطرس للإعلان الإلهي الذي جاء نتيجة بحث الأنبياء الجاد حول هذا الإعلان الذي كان عندهم قبلاً. أعلن الله لهم ليس عن هوية الشخص الذي كانوا يتكلمون عن آلامه – هذا الأمر الذي كانوا على علم به من قبل – بل متى ستحصل هذه الآلام.
آلامه هذه، كما أعلمهم الله بذلك، كانت لتحصل ليس في زمانهم، أي ليس في عصر الأنبياء، بل في العصر التالي لعصر الأنبياء، بل في عصر تتميم كل شيء، أي في عصرنا الحاضر، حين سيكرز الناس بالإنجيل من خلال الروح القدس المرسل من السماء.
بكل تأكيد، وفي ضوء كل هذه التأكيدات العظمى التي تناولناها، علينا استخلاص أن الكتاب المقدس يتحدث عن الله الذي أعلن ذاته تحت شكل حقائق مطلقة بواسطة أوان مختارة. كما أن الكتاب المقدس يصور نفسه ككلام الله أو رسالته للناس المحتاجين.
2 بطرس 1: 20، 21
كيف أعطى الله إعلانه بالكلام؟ وهل يُجيب الكتاب المقدس عن هذا السؤال؟ طبعاً، نعم. يكتب بطرس في هذا السياق: “لك نبوة الكتاب ليست من تفسير [للنبي] خاص. لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس” (2بطرس 1: 20، 21).
علينا أولاً تناول القرينة وراء هذه التصريحات في 2بطرس، بما أن شلة من المعلمين الكذبة، ولعلهم كانوا من المتحمسين “لما قبل” الغنوسطية، في معرض ترويجهم للاهوت (الغنوسي) عندهم، في كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية، راحوا يدعون حصولهم على كلمة جديدة من الله تلت الكلمة صاحبة السلطة لكل من أنبياء العهد القديم، ورسل العهد الجديد. شعر بطرس بضرورة الرد على ادعائهم هذا قبل أن يتسنى لهم إفساد قطيعه.
وصف أولاً “معرفتهم” بأنها “خرافات مصنعة” (2بطرس 1: 16) و”أقوال مصنعة” (2: 3). ثم حاجج في أن اختباره كشاهد عيان وشاهد لما سمع خلال تجلي يسوع في عظمته – هذه الحادثة التي تعد تتميماً لأسفار العهد القديم – “جاءت لتثبت الكلمة النبوية” (1: 19أ)[12]، هذه الكلمة التي نصح بها قراءه بالقول: “التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار، ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم” (1: 19ب). من ثم، ختم بطرس رده بتصريحه التالي حول الوحي: “… عالمين هذا أولاً: أن كل نبوة الكتاب ليس من تفسير خاص. لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس” (2بطرس 1: 20، 21).
بطرس، ومن خلال هذا التصريح الرائع، يؤكد أولاً أمرين سلبيين بشأن نبوة الأسفار المقدسة، أي النبوة المعلنة من الله في صيغتها المكتوبة:
† ما من نبوة في الكتاب جاءت في الأصل (“نشأت، خرجت من” غينتاي) من تقديرات النبي للحالة السياسية السائدة في أيامه أو من تخميناته الشخصية حول المستقبل. بكلام آخر، ما من نبوة في الكتاب المقدس نشأت من مفهومه الخاص للأمور. فهو لم يكن ببساطة عبقرياً في مجال السياسة ولا كان ملماً بشكل غير عادية في شؤون زمانه المدنية والعالمية.
† ما من نبوة في الكتاب المقدس حصلت بدافع من الإرادة البشرية، أي ما من نبوة كتابية جاءت بمجرد حافز بشري.
بطرس، ومن خلال هذين الأمرين السلبيين، ينفي بالتمام أن يكون قد تسبب العنصر البشري بأي معنى نهائي في إنشاء الأسفار المقدسة. هذا الأمر مدهش إلى أقصى حد.
من ثم يؤكد بطرس أمرين إيجابيين بشأن نبوة الكتاب، مع الحرص على جعلهما مقابل الأمرين السلبيين السابقين بواسطة حرف العطف الذي يفيد معنى المفارقة بقوة (ألا) (“لكن” أو “على نقيض ذلك”). وهذان الأمران الإيجابيان لا يحيراننا بدرجة أقل من الأمرين السلبيين الآخرين.
† تكلم الأنبياء من عند الله. هذا يعني، على أقل تقدير، أن ما قالوه لم يبدأ فيهم (راجع أيضاً 1: 20) لكن الله هو الذي أعطاهم إياه. يعني هذا التأكيد الإيجابي أيضاً في نظر بطرس أن ما “نطق” به الأنبياء شمل أيضاً ما “كتبوه” (لنتذكر كيف أن بطرس يصف هنا “نبوة الكتب”)، فإن الكتابات النبوية نفسها جاءتهم من الله.
وكدليل آخر على أن بطرس شمل ضمن فئة “كلامهم” ما تكلم به الأنبياء مع كتاباتهم أيضاً، بإمكاننا ملاحظة ما دونه في 2بطرس 3: 15، 16: “كما كتب [إغرابسن] إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل [إبستولايس] كلها أيضاً، متكلماً [لالن] فيها عن هذه الأمور”.
† السبب الذي مكن الأنبياء من التكلم من عند الله كما فعلوا، هو أنهم كانوا باستمرار مسوقين أي محمولين (فيرومنوي، اسم مفعول للحاضر في صيغة المجهول) بالروح القدس عندما تكلموا أو كتبوا. أي أنهم كانوا تحت تأثير إشراف الروح المباشر طوال الفترة التي تكلموا خلالها أو كتبوا كأنبياء. نجد إيضاحاً رائعاً لفكرة بطرس هنا، في أعمال 27: 15 حيث نقرأ “فلما خطفت السفينة [من جراء الريح العاتية] ولم يمكنها أن تقابل الريح، سلمنا، فصرنا نحمل [إيفيروميثا]”.
وكما أن السفينة لم تكن تحركها أية إرادة شخصية، بل تسير بموجب “إرادة” الريح، هكذا هي حال الأنبياء، يصرح بطرس. فهم لم يكونوا ليعرفوا أية إرادة ذاتية بأي معنى نهائي في سياق إنتاج الكتب النبوية، بل كانوا “محمولين” (جذر الفعل نفسه) بإرادة الروح القدس. وعلى قدر ما ساقهم، أي أشرف عليهم، تكلموا من عند الله. يعلق “وارفيلد” على هذا ما يلي:
ما يشدد عليه كلام بطرس هنا – وما يجري التركيز عليه في الرواية الكاملة التي يعطيها الأنبياء عن وعيهم الشخصي – وهي صفة الجمود التي تحلى بها الأنبياء فيما يتعلق بالإعلان المعطى من خلالهم. هنا تكمن أهمية العبارة: “تكلم الرجال من الله وكأن الروح القدس يحملهم ويسوقهم.” أن “يُساق” (فراين) أحدنا لا يفيد المعنى نفسه للفعل يُقاد (أغاين)، وبأقل تقدير أنه يصار إلى توجيهه أو إرشاده (هوديغاين)؛ فالذي يُساق لا يُساهم بشيء في الحركة الحاصلة، إنما يكون هو موضوع التحريك. غير أن اللفظة “جمود” قد يُساء فهمها ومن الضروري الحرص على عدم جعلها تعني ما لا يُقصد منها.
فلا يُقصد منها التنكر لذكاء الأنبياء ولنشاطهم في معرض تقبلهم لرسالتهم، بل حصلوا عليها بواسطة ذكائهم الناشط، شكل ذكاؤهم الأداة للإعلان. إنما المقصود بها هو إنكار فقط أن يكون ذكاؤهم ناشطاً في إنتاج رسالتهم: أي أنه لم ينشط بشكل خلاق، وذلك مقابل كونه نشط في معرض تقبله للرسالة. ذلك لأن التقبل نفسه هو شكل من أشكال النشاط. ما يريد الأنبياء لقرائهم أن يفهموه أنهم لم يكونوا شركاء الله في تأليف رسائلهم، فلقد أعطيت لهم، وبأكملها، وبالتحديد كما يسلمونها بدورهم. الله هو المتكلم من خلالهم، لم يكونوا مجرد مرسليه، بل بالحري “فمه”[13].
هل هذا يعني أن النبي كان مجرد إنسان آلي وسكرتير تكلم من خلاله الوحي الإلهي؟ ثمة اعتراض مفاده أنه “لمصلحة شخصيات [الأنبياء]، مطلوب منا عدم تصوير الله على أنه يتعامل معهم بشكل آلي، إذ يسكب إعلاناتهم داخل نفوسهم لكي يقبلوها ببساطة كما في العديد من الأوعية، أو وصفهم على أنهم في صراع مرير مع أذهانهم للتخلص من أفعالهم الشخصية حتى يتسنى لله جعل فكره الخص فيهم. “يصر هذا الاعتراض على ضرورة أن تحصل كل الإعلانات من خلال “وساطة نفسية” حتى تصبح أولاً “من الناحية النفسية ملكاً لمستلميها” فيمسي الأنبياء بالمعنى الصحيح هم المؤلفين الحقيقيين والنهائيين.
في هذا السياق، يُذكر “وارفيلد” قارئه بأمرين: أولاً، يتناقض أسلوب توصيل الرسائل النبوية التي يفضلها الاعتراض، بشكل مباشر مع وصف الأنبياء لعلاقتهم بالروح المعلن: “ففي نظر الأنبياء، كانوا مجرد أدوات أعطى الله من خلالها إعلانات، نطقوا بها لا كأنها من نتاجهم الخاص، بل ككلمة يهوه النقية”[14]. دعونا نقف على ما قاله “وارفيلد” حرفياً في هذا المجال:
… [يجب ألا] تعمينا منطقية هكذا تساؤلات، عما تنطوي عليه من خداع. إنهم يستغلون اعتبارات ثانوية ليست بغير صحيحة ضمن موقعها وحدودها، وكأنها الاعتبارات الأساسية وحتى الوحيدة في القضية، وذلك على حساب إهمالهم للاعتبارات الهامة الحقيقية. فالله هو نفسه صانع الأدوات التي يعتمدها لتوصيل رسائله إلى الناس. وهو شكلهم ليكونوا الأدوات التي أرادها لتوصيل رسالته بكل دقة.
ثمة مسوغ في محله لتوقع إقدامه على استخدام كل أدواته بحسب طبيعتهم: الكائنات الذكية ككائنات ذكية، والعناصر الأدبية كعناصر أدبية. لكن ما من مسوغ صحيح لتأكيد كون الله عاجزاً عن استخدام الكائنات الذكية التي صنعها هو وشكلها بحسب إرادته، وأن يعلن رسائله من خلالهم بكل نقاوة كما سلمها إليهم. هؤلاء عندهم أيضاً مفاهيم منطقية لا بد لهم من تكوينها. كما أنه ما من مسوغ لتخيل أن الله غير قادر على صياغة رسالته بلغة الناطق الرسمي بإعلانه من دون جعله يكف عن الوجود من جراء ذلك.
فهم يعبرون بشكل طبيعي بالنسبة إليهم، حتى ينطقون برسالة الله النقية. بوسع أحدنا افتراض في صلب هذه المسألة أنه متى أعطى الله أي إعلان للناس، فهو سيعطيه بلغة الناس؛ أو لأفراد بأكثر تحديد، وذلك بلغة الرجل الذي يستخدمه ليكون الناطق الرسمي بإعلانه. ومن الطبيعي أن يكون المقصود هنا ليس بلغة أمته أو دائرته، بل بلغته هو الخاصة، مع ما يشمل ذلك كل ما يُضفي فرادة على تعبيره الشخصي. قد نتحدث عن هذا، إن شئنا، على أنه “تكيف الله الذي يعطي الإعلانات مع فرادة الشخصيات النبوية المتنوعة”.
لكن، علينا تجنب التفكير في [هذا التكيف] كمسألة خارجية وبالتالي آلية. وكأن الروح المعلن صاغ بشكل اصطناعي الرسالة التي يعطيها من خلال كل نبي باللغة المناسبة لفرادة كل واحد منهم، بشكل يوهم بأن الرسالة قد خرجت من قلب النبي نفسه، لكن الأنبياء يؤكدون بالتحديد أن رسائلهم لا تنبع من قلوبهم ولا تمثل أعمال نفوسهم… إنه لمن الباطل الزعم أن الرسالة التي يجري توصيلها بواسطة اللسان (البشري) تتأثر، على الأقل في شكلها، باللسان الذي نطق بها، إن لم نقل يختصرها حقاً أو يحدها، بل حتى يقرر اللسان مضمونها بنسبة معينة.
لم يصنع الله اللسان وحسب، وبالتحديد مع كل خصائصه، بل أخذ أيضاً في الاعتبار الرسالة التي سينقلها بواسطته. سيطرته عليه هي بالكامل وبالكلية. لذا من السخافة زعم أنه لا يمكنه النطق برسالته من خلاله بنقاوة، من دون تعرض هذه الرسالة للتغيير بفعل نبرته الخاصة به وأساليب الإلقاء. وكأننا نتحدث عن عدم إمكانية إعلان أي حق جديد في أية لغة بما أن عناصر الكلام التي من خلالها جمعها معاً يتم الإعلان عن الحق المطروح، هذه العناصر موجودة من قبل مع ما تحمله من معان ثابته. بكلام آخر، سمات الفرادات المتعددة الداخلة في صلب رسائل الأنبياء، تعد فقط جزءًا من الحقيقة العامة ومفادها أن هذه الرسائل قد جرى التعبير عنها بلغة بشرية. الأمر الذي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في نقاوتها كرسائل من عند الله[15].
لماذا كان على الله “أن يسوقهم” خلال تكلمهم؟ يسهب “وارفيلد” في حديثه عن إعداد الناطقين الرسميين لأداء مهمتهم النبوية، والمشار إليهم في التعليقات أعلاه. فهو يكتب:
أحياناً يجري تصوير الله عندما يرغب في إصدار كتب مقدسة تجسم إرادته – سلسلة من الرسائل كتلك التي كتبها بولس مثلاً – كأنه مضطر إلى النزول إلى الأرض ومعاناة الأمرين في تفحصه الدقيق للرجال الذي عثر عليهم هناك. باحثاً بشيء من القلق عن الشخص الذي على وجه العموم يبدو واعداً أكثر من سواه في تتميم قصده الإلهي. ثم يظهرونه وهو يدخل غنوة وبشكل عنيف بواسطته المادة التي يرغب أن يصاب إلى التعبير عنها، وذلك ضد ميله الطبيعي، وبأقل خسارة ممكنة لخصائص التمرد عنده. بالطبع، لم يحصل أي شيء من هذا القبيل.
فإن كان الله يرغب في إعطاء شعبه سلسلة من الرسائل كرسائل بولس، كان يعده لكتابتها، كما أن بولس الذي أحضره لتتميم المهمة، سيكتب هذه الرسائل بشكل عفوي وتلقائي.
إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار، سنعرف مدى قيمة التصور المألوف، والذي مفاده أن الخائص البشرية للكُتاب يجب أن تؤثر في الكتابات الصادرة عنهم وتحددها. إذاً، بالإمكان استخلاص من كل هذا أنه يتعذر الحصول بواسطة إنسان على كلمة نقية من الله. وكما أن النور الذي يجتاز عبر الزجاج الملون لنافذة الكاتدرائية، يقال لنا، هو نور من السماء إلا أنه يصطبغ بألوان الزجاج الذي يعبر من خلاله، هكذا فإن أية كلمة من الله تمر عبر ذهن أحد الرجال وعبر نفسه، لا بد أن تخرج بألوان أخرى من الشخصية التي أعطيت بواسطتها، حتى أنها تكف بهذه الدرجة عن أن تكون كلمة الله النقية.
لكن، ماذا لو أن هذه الشخصية كان الله قد شكلها لتكون بالتحديد ما هي عليه، وذلك بقصد توصيل الكلمة المعطاة لها من خلال الألوان المنبعثة منها فقط؟ وماذا لو كانت ألوان النافذة الملونة قد صممها المهندس لهدف محدد بحيث تضفي على النور الذي يغمر الكاتدرائية تلك الصفات والخصائص المحددة التي تحصل عليها منه؟ وماذا لو كانت كلمة الله التي تصل إلى شعبه قد عمل الله على تشكيلها لتكون كلمة الله، وذلك بالتحديد بواسطة مزايا الرجال الذين كان الله قد كونهم لهذا الغرض، لكي يوصل كلمته بواسطتهم؟
عندما [نأخذ بعين الاعتبار العملية الطويلة الأمد التي تقوم بها العناية الإلهية لإعداد الرجال الذين أنتجوا الأسفار المقدسة]، لا يعود بإمكاننا استغراب كيف أن ما نتج من من ذلك من أسفار مقدسة، تعتبر باستمرار بمثابة كلمة الله النقية.
لكن حري بنا في هذه الحال استغراب القول بضرورة قيام الله بعملية إضافية – ما يعرف عندنا بالتحديد “بالوحي” بمعناه التقني – عندما نولي العناية الإلهية على صعيد الكون أهميتها التي تليق بها في أفكارنا، وكذلك أيضاً عملها في أصغر الأمور وأدقها، كما ايضاً بشكل كامل على أوسع النطاقات، مع فعاليتها التي لا تعرف التغيير، قد نميل عندئذ إلى التساؤل عما تدعو إليه الحاجة فوق هذه العناية السائدة لضمان إنتاج أسفار مقدسة من اللازم أن تكون منسجمة في المطلق في كل التفاصيل مع الإرادة الإلهية.
الجواب هو أنه لا تدعو الحاجة إلى أي شيء فوق مجرد العناية الإلهية للحصول على أسفار كهذه، شريطة فقط ألا يدخل في صلب القصد الإلهي أن تحوي هذه الأسفار خصائص تعلو وتسمو فوق قدرات البشر لإنتاجها [من صنف الإلمام بالقصد الإلهي، والعصمة]، حتى تحت أعظم وأكمل شكل من الإرشاد الإلهي. ذلك لأن العناية هي الإرشاد، والإرشاد لا يمكنه أن ينقل أحدهم إلى أبعد مما بوسع قوته الشخصية أن تأخذه.
إن كانت هنا أعال ترتفع وتسمو فوق قدرة الأنسان على بلوغها، فعندئذ، تدعو الحاجة إلى ما هو أكثر من الإرشاد، مهما بلغت فعاليته. هذا يحتم في نهاية العملية الطويلة لإنتاج الأسفار المقدسة، إضافة العمل الإلهي الذي نطلق عليه تقنياً التسمية “الوحي”. من خلاله، ينسكب روح الله للعمل جنباً إلى جنب مع العناية الإلهية، ومع الرجال في عزمهم للعمل، بحيث يصبح بإمكانهم إنتاج تحت التوجيهات الإلهية الكتابات المعينة لهم.
الأمر الذي يضفي على النتاج صفة إلهية لا يمكن بلوغها بواسطة القوى البشرية وحدها. وهكذا لا تعود هذه الكتب مجرد كلام أناس أتقياء، بل بالحري الكلمة المباشرة من عند الله نفسه، لكي تُخاطب بشكل مباشر ذهن كل قارئ وقلبه.
…. يطالعنا أيضاً في سياق تلميح العهد الجديد إلى الموضوع، كيف أن كتابه فهموا كيف أن إعداد الرجال ليصبحوا قنوات وأدوات لنقل الرسالة الإلهية إلى الإنسان، أمر لا يحصل بين ليلة وضحاها، لكنه كان قد بدأ معهم منذ بداية وجودهم.
فالدعوة مثلاً، التي على أساسها جُعل بولس رسولاً ليسوع المسيح، حصلت فجأة وحسب الظاهر من دون أن يسبقها أي شيء آخر. لكن بولس نفسه يحسب أن دعوته لم تكن سوى خطوة واحدة ضمن عملية طويلة، كانت قد بدأت حتى قبل وجوده: “ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي، ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ” (غلاطية 1: 15، 16؛ راجع إرميا 1: 5؛ إشعياء 49: 1، 5)[16].
هنا يكمن الجواب عن السؤال، لماذا “ساق أو حمل” روح الله الأنبياء خلال كتابتهم؟ قام بالإشراف عليهم خلال كتابتهم بشكل محدد ودقيق لضمان إضفاء على الأسفار المكتوبة تحت إشرافه طابعها الإعلاني، أي لمنحهم القدرة على إعلان تلك الأمور من صنف القصد الإلهي الذي هو فوق طاقتهم (راجع “تكلموا من عند الله، بينما كانوا محمولين”). وليس هذا وحسب، بل للتأكيد على أن كتاباتهم تحمل الصفة الإلهية بالكامل، وبالتالي عصمتها وموثوقيتها.
هل يشير الإشراف من قبل الروح القدس ضمناً إلى عصمة الأسفار المقدسة؟ العديد من اللاهوتيين (مثلاً: “إميل برونر”، “كارل بارث”، “أرنست كازمان”، لا يدعون فقط بأن الكتاب المقدس هو أي شيء ما عدا خلوة من التناقضات في تعاليمه – فهو بحسب زعمهم مملوء بالأخطاء والتناقضات – بل كون الله أيضاً “الذي يسر بأن يفاجئنا” والذي، كما يزعمون أيضاً، بوسعه “رسم خط مستقيم بواسطة عصا ملتوية”، يكلمنا حتى من خلال تناقضاته.
من هنا فإن المسألة التي تطرح نفسها بشكل طبيعي هي: هل المسيحي الإنجيلي في إصراره على عصمة الأسفار المقدسة فرض عليها مستلزماً في غير محله من خلال مطالبته بأن يشهد تماسكاً عقيدياً لا تستلزمه الأسفار المقدسة نفسها؟ تظهر ملاحظة “هنري بلوشر” في هذا السياق، في محلها:
في كل مراحل التاريخ الكتابي، يحظى التماسك بأكبر قدر من القيمة والأهمية، وهو ينسب إلى أي تعليم يعتقد أنه صادر عن الله. فالحق… هو مرادف للأبدية، وللاستمرارية التي لا تتغير (المزمور 119: 160). ناموس الرب نقي، أي أنه يشهد تناغماً كاملاً، وهو منقى من الزغل أكثر من الفضة والذهب المصفى؛ كل فرائضه تتجانس وتتماشى كأنها واحدة في استقامتها (المزمور 19: 9). ما من معجزة تستطيع إضفاء سلطة على النبوات غير المستقيمة (تثنية 13: 1 والأعداد التالية).
إن كان الله ينعم بملء الحرية بأن يُظهر أموراً جديدة في التاريخ، يبقى أن كل إخفاق على صعيد تناغم هذه مع الأسلوب السائد للإعلانات السابقة، يثير الشكوك حول مصداقية الرسالة (إرميا 28: 7) والأعداد التالية). يناشد بولس قراءه أن يكونوا في فكر واحد (فيلبي 2: 2، إلخ)؛ وأن عليهم أن ينموا في وحدانية الإيمان (أفسس 3: 13)، بما أنه هناك فقط تحت سلطة الرب والواحد، إيمان واحد ومعمودية واحدة (العدد 5).
ليس تعليمه “نعم” و”لا” (2كورنثوس 1: 18)، الأمر الذي يشكل صدى لكلمات يسوع المأثورة… يصر بولس على كون رسالته شبيهة برسالة سائر الرسل (1كورنثوس 15: 11). وفي وجه إساءة التفسير، 2بطرس 3: 16 يعود ويؤكد هذا الأمر المتفق عليه. يوحنا يسلط الأضواء على التوافق القائم بين الشهود الثلاثة (1يوحنا 5: 8)، كما أن الإنجيل الرابع يعرض عملية “تكرار”، ليس على غرار الببغاء بالطبع، بل من قبيل الاهتمام بأن يكون هناك تشابه في المضمون (يوحنا 8: 26، 28؛ 16: 13).
عدم الانسجام والاختلاف، هو علامة أن الأمر ليس حقاً، كما كان أمر شهود الزور في محاكمة يسوع (مرقص 14: 56، 59). يجب دحض المناهضين وإسكاتهم (رومية 16: 17؛ تيطس 1: 9)؛ هذا الأمر لا يمكن أبدأ الإقدام عليه لو كان المعيار نفسه يضم العديد من التعاليم اللاهوتية المتناقضة. في الواقع، كل منطق استشهاد ربنا بالأسفار المقدسة في حججه، (وكذلك الأمر مع رسله) من شأنه أن ينهار فوراً في حال سقوط الافتراض المسبق بتماسك الأسفار المقدسة.
وحتى في معرض مواجهته مع المجرب، يعتمد يسوع على التماسك الداخلي لكلمة أبيه، مقتبساً الأسفار المقدسة للرد على استخدام الكتاب المقدس بشكل منحرف وملتو. العبارة “مكتوب”، لن تعود تفي بالغرض على صعيد حسم أمر ما، لو سلمنا بوجود عدة آراء متناقضة تتنافس معاً على صفحات الكتاب المقدس. في هذه الحال، لا تعود سلطة كلمة الله تعمل عملها كما تفعل الآن في الأسفار المقدسة… رجالات الله الذين كان لهم دور في كتابة الكتاب المقدس، ثمنوا التماسك نسبوه بشكل بديهي إلى الإعلان الإلهي، والذي توسع من خلال خدمتهم[17].
لذا، أحتاج أن أكرر أن اللاهوتي الذي يصرح من جهة أنه يؤمن بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها، ثم يعتبر من جهة أخرى أنها تحوي أخطاء في نسختها الأصلية، فإنه يترتب عليه تفسير مشكلة رئيسية تواجهه، من زاويتي المعرفة واللاهوت. ثم لدينا الصنفان من نصوص العهد الجديد المثيران جداً للاهتمام بحيث إن كل منهما،
…. متى أخذ بالانفصال عن الآخر، يسلط الضوء بأقصى وضوح ممكن على ما كان [كُتاب العهد الجديد] يقومون به من خلال اقتباسهم العهد القديم على اعتبار أن الله هو المتكلم بنفسه، بينما يتركان معاً انطباعاً لا يقاوم بشأن التعاطف في المطلق القائم بين كتاب الأسفار المقدسة المتوافرة لديهم والله وصوته الحي.
ففي صنف من هذه النصوص، يصار إلى التحدث عن الأسفار المقدسة وكأنها الله، وفي الآخر يصار إلى التحدث عن الله وكأنه هو الأسفار المقدسة. ومتى أخذناهما معاً، يظهر التعاطف الكامل القائم ما بين الله والأسفار المقدسة، الأمر الذي يبين أنه لا مجال للتفرقة بينهما فيما يخص سلطتهما الصريحة[18].
على القارئ أن يتأمل بكل إمعان وتركيز في التفسير التالي كما يعرضه “وارفيلد”:
الأمثلة على الصنف الأول من النصوص هي كالتالي: غلاطية 3: 8 “والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن “فيك تتبارك جميع الأمم”” (تكوين 12: 1-3)؛ رومية 9: 17، “لأنه يقول الكتاب لفرعون: “إني لهاذا بعينه أقمتك”” (خروج 9: 16). لكن، لم يكن الكتاب (الذي لم يكن بعد موجوداً في ذلك الوقت) الذي بعد أن رأى مقاصد النعمة الإلهية للمستقبل، نطق بهذه الكلمات الثمينة لإبراهيم، لكن الله نفسه بشخصه. ولم يكن الكتاب الذي لم يكن له أي وجود بعد، هو الذي أعطى فرغون هذا الإعلان، بل بالحري الله نفسه على فم نبيه موسى. هذه الأفعال كان بالإمكان نسبها إلى “الكتاب” نتيجة للتماثل الذي بات مألوفاً في ذهن الكتاب على اعتبار أن الله هو الذي يتكلم في الكتاب. وهكذا أصبح من الطبيعي استخدام العبارة “يقول الكتاب”، عندما كان المقصود بذلك فعلاً: “الله، كما هو مدون في الأسفار المقدسة، قال.”
أمثلة على الصنف الآخر من النصوص هي كالتالي: متى 19: 4، 5: “فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسداً واحداً”. (تكوين 2: 4)؛ عبرانيين 3: “لذلك كما يقول الروح القدس: “اليوم إن سمعتم صوته” إلخ.
(المزمور 95: 7)؛ أعمال 4: 24، 25: “أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل”؛ أعمال 13: 34، 35: “إنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضاً إلى فساد، فهكذا قال: “إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة” (إشعياء 55: 3)؛ “ولذلك قال أيضاً في مزمور آخر: “لن تدع قدوسك يرى فساداً” (المزمور 16: 10)؛ عبرانيين 1: 6: “وأيضاً متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله” (تثنية 32: 43)؛ وعن الملائكة يقول: “الصانع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار” (المزمور 104: 4)؛ “وأما عن الابن، قال “كرسيك يا الله إلى دهر الدهور”، إلخ.
(المزمور 45: 7): “وأنت يا رب في البدء” إلخ. (المزمور 102: 26). لكن، لم يكن الله هو الذي نطق بهذه الأقوال التي جعلت في فمه في نص العهد القديم، إنها كلمات آخرين مدونة في نص الأسفار المقدسة على أنها قيلت لله، أو نطق هو بها. كان بالإمكان نسبها إلى الله فقط من جراء هكذا تماثل ما بين نص الكتاب وأقوال الله. والذي بات مألوفاً في أذهان الكتاب، حتى أنه أصبح من الطبيعي استخدام العبارة “قال الله” عندما كان المقصود فعلاً: “يقول الكتاب، كلمة الله”. إذاً هاتان المجموعتان من النصوص تظهران معاً وجود تماثل في المطلق في أذهان هؤلاء الكتاب بين “الكتاب” والله المتكلم[19].
إذاً، وفوق كل جدل، يدعي الكتاب المقدس لنفسه بأنه كلمة الله. هذه الحقيقة، الذي يؤكدها علم التفسير، من الضروري أخذها بعين الاعتبار وعدم تجنبها أبداً عندما تواجهنا مسألة لماذا نؤمن بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله. نحن نؤمن بذلك، لأنه هذا ما يدعيه عن نفسه. أنا مديون لـ “أ. كالفن بايسنر” لأنه لفت نظري إلى الحجة المشابهة التي طورها “غردن هـ كلارك” للإيمان بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله. حجته في غاية البساطة، وبرأي لها قيمتها، مع أن “كلارك” سيكون الأول لتأكيد أنه لا يمكنها بحد ذاتها، ولن تتمكن من هداية أي كان.
[1] Charles Hodge, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, n.d.), I 165.
[2] علينا ألا ننسى أن بولس كتب كالناطق الموحى إليه بلسان المسيح الموحي. يتبين من الدليل الكتابي أن بولس كان يعتبر نفسه كرسول للمسيح. كما أن أصدقاء يسوع الحميمين اعتبروه كذلك، وأنه صاحب وفرة من مصادر المعلومات عن يسوع، وكونه شاطر يسوع النظرة عينها إلى ملكوت الله بحيث “حضر ولم يحضر بعد”، والعقيدة نفسها عن أبوة الله، والعقائد عينها المختصة بالخلاص على أساس النعمة المجانية، وبالدينونة الأخيرة، وبأدب المحبة كالتتميم للناموس، والأهم من هذا كله ديانة الفداء عينها في موت يسوع وقيامته ومن خلالهما. كذلك، كان قد حصل من يسوع على وعد بتعليمه ما يقوله بصفته رسوله (أعمال 9: 15، 16؛ 13: 2؛ 13: 46، 47؛ 18: 9؛ 22: 14، 15؛ 26: 16-18). إننا نقصد من خلال هذا أن الإيمان ببولس هو الإيمان بيسوع، كما أن عدم الاتفاق مع بولس يعني عدم الاتفاق مع المسيح من كان بولس رسوله الذي كان الرب قد أوحى إليه.
[3] يترجم هودج الجملة الأخيرة في كتابه: Hodge, Systematic Theology, 1, 162 “كاسين حقائق الروح بكلمات الروح.
[4] George E. Ladd, A Theology of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 605.
[5] صيغة الكتاب المقدس الإنجليزية المعروفة باسم Revised Version 1901 أوردت تصريح بولس على الشكل التالي: “كل كتاب موحى به من الله هو أيضاً نافع…” هذه الصيغة تفرض علينا الإدلاء بتعليقين:
أولاً: أنها تجعل فرقاً قليلاً بين الإقدام على ترجمة (باسا غرافي) إلى كل كتاب [نص] أو “كل كتاب” بمعنى “الأسفار المقدسة كلها [بأكملها].” النتيجة هي عينها في نظري.
Nigel Turner (A Grammar of New Testament Greek, edited by James H. Moulton [Edinburgh: T. & T. Clark, 1963], III, 199)
يعتبر أن (باسا) متى وردت قبل اسم غير معرف، فهي تعني “كل” بمعنى “أي”: “ليس كل فرد… بل أي واحد من فضلك”. وعليه يترجم (باسا غرافي) إلى “أي كان السفر المقدس”. ثم يضيف أن “(باسا) قبل اسم غير معرف تعني أيضاً كل، كامل الشيء، تماماً كعملها مع أل التعريف”. لذا، كان من السهل على “ترنر” أن يترجم (باسا غرافي) إلى “كل الكتاب”، بمعنى “الكتاب بجملته”. حقاً، وفي ضوء القرينة التي تحبذ مفهوم كون بولس يفكر بالعهد القديم بجملته، أسلم بأن هذا هو المعنى المقصود، على الأرجح. بولس يعلن هذا بشكل مبدئي في رومية 15: 4 عندما يصرح بالقول: “لأن كل ما سبق فكبت [هوسا بروايغرافي] كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب [غرافون] يكون لنا رجاء (هوسس، بحسب BADG، الفقرة 2، 586، متى استخدمت في المطلق، كما هي الحال هنا، تعني “كل شيء”).
C.F. D. Moule (An Idiom Book of New Testament Greek [Cambridge: University Press, 1953], 95)
يوافقه الرأي. فهو يؤكد أن (باسا غرافي) “من غير المرجح أبداً” أن تعني “كل كتاب موحى به”، ومن المحتمل أكثر بكثير أنها تعني “كل الكتاب”.
ثانياً: فيما يتعلق بالترجمة بحسب:
Revised Version (RV), Merrill F. Unger Introductory Guide to the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1956), 25, 26
أصاب في رؤيته أنها (1) ركيكة من الزاوية التفسيرية، بما أنه ليس من الضروري أن يقال لأحدنا أن كل كتاب موحى به من الله هو أيضاً نافع؛ (2) عليها اعتراضات من الزاوية النحوية بما أن RV تجعل التركيبة نفسها (الفاعل الذي يليه صفتان أصليتان يربط بينهما حرف الجر (كاي) في 1كورنثوس 11: 30؛ 2كورنثوس 10: 10؛ 1تيموثاوس 4: 4؛ وعبرانيين 4: 12، 13، إنها تجعل هذه التركيبة بمثابة صفتين أصليتين متساويتين؛ (3) غير ثابت على أساس متين من الزاوية النقدية، بما أن هذه الترجمة حظيت بموافقة قلة قليلة فقط من الدارسين؛ و(4) خطرة من الزاوية العقدية، بما أنها توحي بأن بعض الكتب قد لا تكون من نتاج النفس الإلهي، راجع أيضاً تعليقات مشابهة لهذه مصدرها “ج. ن. د. كلي” في كتابه
A Commentary on the Pastoral Letters (New York: Harper & Row, 1964), 203
كذلك، فإن “روبرت واتس” علق على هذه المسألة في أواخر القرن التاسع عشر في كتابه
The Rule of Faith and the Doctrine of Inspiration [London: Hodder and Stoughton, 1885], 142
وذلك بقوله: من غير الممكن تخيل، ولو للحظة واحدة، أن يقدم الرسول بعد توجيه كل هذا المديح إلى الأسفار المقدسة والتي كانت محط إكبار واحترام عند كل من تيموثاوس، وأمه، وجدته، أن يعود ويغرس في الأذهان نظرية مبهمة عن الوحي، والتي نظراً لغموضها، لا تصلح سوى لإرباك أولئك الذين يحاولون تطبيقها، ومن الضروري أن يسفر عنها في النهاية آراء مشككة في ادعاءات التدوين المقدس ككل.
[6] A. T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (Nashville, Broadman, 1934), 1095-97.
راجع أيضاً الدراسة المطولة لصيغة “ثيوبنستس) في مقاله
“God-Inspired Scripture” in The Inspiration and Authority of the Bible, 245-96.
إنه يستخلص أيضاً أن هذه العبارة وردت في صيغة المجهول.
[7] Benjamin B. Warfield, “The Biblical Idea of Inspiration” in The Inspiration and Authority of the Bible, 132-33; see also 154.
[8] Warfield “The Biblical Idea of Inspiration” in The Inspiration and Authority of the Bible, 133.
[9] James S. Stewart, A Man in Christ (London: Hodder and Stoughton, 1935), 39.
[10] أنا أقترح أن العبارة “كل عمل صالح” تشمل عمل المدافع وتعتبر أن عملية الدفاع هذه، متى تمت بشكلها الصحيح، عليها افتراض مسبقاً وجود الحق المعلن داخل الأسفار المقدسة، كما أنها ستؤسس حججها على تعاليم الكتاب المقدس كدليل لا يقبل الجدل على مصداقية الإيمان المسيحي بالله الواحد في الكل وفي الجزء.
[11] صيغتا الترجمة الإنجليزيتان المعروفتان باسم NADB و ETV تعرضان هنا ترجمة مضللة للغاية من خلال عبارتهما “أي شخص أو وقت”. هنا “أو” التي يستخدمها بطرس لا تفصل كما لو أن الإشارة هي إلى سؤالين متفارقين، لكنها بالحري عاطفة بمعنى أن المسألة الوحيدة التي كانت تهمهم هي المتعلقة بالوقت، والتي يمكن طرحها، كما في ترجمتنا العربية: “أي وقت أو ما الوقت” لحصور آلام المسيح. وفي كلتا الحالتين، كانوا معنيين بزمن حصول آلام المسيا، وليس إن كان سيتألم. هذا كانوا يعرفونه من قبل.
[12] ترجمت صيغة الترجمة AV (ببايأوتيرون) بالعبارة “أكثر تأكيداً – عندنا أيضاً كلمة نبوية “أكثر تأكيداً” – مولدة بذلك الإنطباع عند العديد من القراء المسيحيين، بأن الكلمة المكتوبة هي أضمن من “الصوت من المجد الأسنى” أو من اختبار بطرس كشاهد عيان أو شاهد للصوت الإلهي الذي سمعه. هذا الأمر مؤسف، ذلك لأنه الصوت نفسه الذي يتكلم والسلطة نفسها في كلتا الحالتين. صحيح أن (ببايأوتيرون) هي صفة للمقارنة، لكن أمامنا هنا حالة عندما تعمل الصفة للمقارنة عمل صيغة التفضيل. هذا يحصل بشكل مألوف في اللغة اليونانية. وبالتالي، الترجمة الصحيحة تكون “الأكيدة إلى أقصى حد”. الفكرة المقصودة هنا هي أن الكلمة النبوية المكتوبة التي تحدثت عن مجد المسيا قد “تأكدت إلى أقصى حد” بمعنى قد “تثبتت” من خلال التجلي.
[13] Warfield, “The Biblical Idea of Revelation” in The Inspiration and Authority of the Bible, 91.
[14] Warfield, “The Biblical Idea of Revelation” in The Inspiration and Authority of the Bible, 92.
[15] Warfield, “The Biblical Idea of Revelation” in The Inspiration and Authority of the Bible, 92-94.
[16] Warfield, “The Biblical Idea of Revelation” in The Inspiration and Authority of the Bible, 155-58, 159.
[17]Henri Blocher, “The ‘Analogy of Faith’ in the Study of Scripture” in The Challenge of Evangelical Theology (Edinburgh: Rutherford House, 1987, 29-31.
[18] “God Says” in The Inspiration and Authority of the Bible, 299. Benjamin B. Warfield, “It Says: Scripture Says”
[19] “God Says” in The Inspiration and Authority of the Bible, 299-N 300. Warfield, “It Says: Scripture Says”