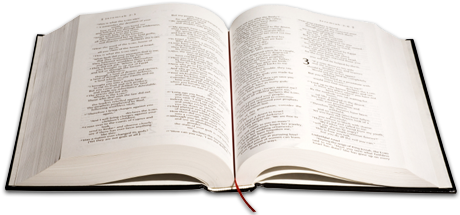تعليل الإلحاد السارتري – إلحاد سارتر – كوستي بندلي
تعليل الإلحاد السارتري – إلحاد سارتر – كوستي بندلي

تعليل الإلحاد السارتري – إلحاد سارتر – كوستي بندلي
الاكتفائية وأصنام الله
وقد نتساءل: إذا كان هذا هو إله الاعلان الكتابي، فما الذي دفع سارتر – وقد عاش في وسط مسيحي – أن يعطينا عنه هذه الصورة المشوهة؟
إنني أعتقد شخصاً أن لذلك سببين: أولاً الاكتفائية الكامنة في صميم فكر سارتر، والثاني “أصنام” الله التي حالت بينه وبين إله الإعلان الكتابي.
1 – الاكتفائية السارترية
فمن جهة أولى قبول الله يفترض أن أقبل بأن وجودي عطية من آخر ولو كان لي سلطان بأن أستخدم هذه العطية كما أشاء وأن أحولها، إذا أردت، ضد معطيها. قبولي لله يعني اعترافي بأن لي مقياساً ومرجعاً، ولو أعطيت سلطاناً بأن اضرب بهذا المقياس وبهذا المرجع عرض الحائط. قبولي لله يعني إنني لست مالكاً لذاتي ولو أعطيت سلطة التصرف بذاتي كما أشاء. قبول لله لا ينفي حريتي ولكنه يعني أن هذه الحرية ليس غاية بحد ذاتها. مجمل الكلام أن “كوني مخلوقاً، كما كتب جان دانيالو، لا يعني أن الوجود ينزع مني كما يقول سارتر، إنما ينوع مني امتلاك هذا الوجود.
ما ينزع مني هو إرادتي بالاكتفاء الذاتي”. قبولي لله طعن في الصميم لاكتفائيتي، لإرادتي بأن أكون المقياس والمرجع الوحيد لذاتي. إيماني بالله صليب لهذه “النرجسية الروحية” على حد تعبير أوليفية كليمان، لتلك الشهوة في الإنسان بأن يملك نفسه ويتمتع بأناه المنغلق، المكتفي. صعب على الإنسان أن يقبل بأن وجوده كله نعمة. وهذا صعب بنوع خاص على الإنسان الحديث الذي بدأ منذ عصر النهضة يعتبر نفسه تدريجياً مركز كل شيء ومقياس كل شيء. وبصورة أخص هذا صعب بالنسبة للاتجاه الفردي الكامن في صميم فلسفة سارتر، وأن كان تطوره الفكري قاده إلى أن يخفف نوعاً ما من حدة هذه الفردية. فبالنسية لسارتر وجود الآخر كآخر تهديد لوجودي. لأن وجودي ينزع إلى اتخاذ نفسه محوراً لذاته وللكون كله، بينما يأتي وجود الآخرين ليزعزع هذه المحورية.
نظر الآخر إليّ، بالنسبة لسارتر، خطر عليّ واعتداء على حريتي لأنه يجعلني تحت تصرف الآخر يحكم عليّ ويقيمني كما يشاء فيجمدني ويحصرني في هذه الفكرة التي يكونها عني. الحب نفسه فخ لأن كلاً من المحبين يستخدم الآخر في سبيل تأكيد ذاته. لذلك “فجوهر العلاقات بين الوجدانات، حسب تعبير سارتر، هو الصراع، ومن هنا كلمته الشهيرة في مسرحية Huis-Clos “الجحيم هو الآخرون”. لم يدرك سارتر أن العلاقة بين البشر، وإن كانت في كثير من الأحيان صراعاً كما صورها، يمكنها أن تكون أيضاً شركة وأن “الفردوس هو الآخرون”، على حد تعبير غبريال مارسيل، لأنني بهم، وبهم فقط، أخرج من عزلتي وأنجو من اكتفائيتي القتالة، فأحقق هكذا ملء وجودي.
لم يدرك أن وجود الآخر إلى جانبي فرصة لأجد ذاتي بخروجي من ذاتي في اتجاهه وبانفتاحي لاقتباله ولقائه. إن من اختبر صداقة أو حباً أصيلين، من عاش الأبوة أو الأمومة في أعماقهما، يعرف كم تلك العلاقات بالآخر تغني الإنسان بفيض من الحياة غزير؛ كذلك اعجابنا بمن رأيناه متفوقاً في ميدان ما يفجر فينا طاقات كامنة ويرفعنا، بصورة ما، إلى مستوى من نحن معجبون به. وحتى إذا أقلقنا الآخر بمعارضته وانتقاده، حتى إذا كان حكمه علينا قاسياً ولربما ظالماً، فإن اقلاقه هذا مثمر إذا عرفنا أن نتقبله، فإنه يدفعنا إلى أعادة للنظر خلاقة فيما نحن عليه، إلى تجاوز حدودنا وعيوبنا، إنه ينتزعنا من الاستكانة المخدرة ويدفعنا إلى الأمام في حركة لا تتوقف. لذا كتب مونييه في كتابه “مدخل إلى المذاهب الوجودية”: “لقد لمنا سارتر لكونه لم ير في النظرة سوى النظرة التي تجمد. ولكن النظرة الأعمق هي، بالعكس، نظرة تزعزع.
إذا تقبلت حضور الآخر كشيء ليس تحت تصرفي، فنظرته إليّ لا تجمدني، ولكنها بالعكس تزعجني، تقلقني، تعيد النظر فيّ. نعم إنها تجردني، ولكنها تجردني من نفسي كعدو لنفسي، من مركزية أناي اللاشفافة، … من هذا الحاجز الذي أقيمه بيني وبين نفسي في العزلة. الاختبار يعلمنا كل يوم قيمة الكشف التي لرأي الآخرين بنا عندما يقبلون بأن يفضلوا به إلينا أو لذلك الوعي الذي يوقظونه فينا بمجرد عبء نظرتهم الصامتة. في الوحدة لا نعرف أنفسنا كما يجب ولا نحسن الحكم على أنفسنا. الاغتياب في معظم الأحيان محق أكثر من التأمل الباطني. إذاً لا يحيينا النظر الكريم الصادر من الآخر وحسب، إنما أيضاً نظر العداء أو الحسد أو اللامبالاة، إذا كنت، أنا الذي أتقبله، في حالة انفتاح له. هذا الاختبار يتحقق في الجماعات كما في الأفراد… إن نظرة الالحاد الى الدين، نظرة المعارضة إلى الحكومة، نظرة التلامذة إلى المعلم، هي الباعث الأساسي لحيوية هؤلاء”. أما بالنسبة لسارتر، فعلاقة الإنسان بالآخر هي، في الصميم، علاقة استعباد متبادل (وإن قبل سارتر في تطوره الفكري بإمكانية تعاون خارجي بين البشر من أجل بناء عالم أفضل). هذا المفهوم لعلاقة الإنسان بالآخر مبني، كما بين مونييه في كتابه المذكور أعلاه، على كون تفكير سارتر – إننا نحكم هنا على تفكيره وليس على شخصه، ففي شخصه الكثير من الالتزام الشريف لشؤون الناس تجلى في جهاده من أجل تحرير البشر من الظلم وفي تصريحه لجريدة Le Monde في 18 نيسان 1964: “أمام طفل يموت، لم يعد للغثيان من وزن” – قلنا على كون تفكيره يدور في عالم التملك أو عالم عدم الانفتاح على حد تعبير غبريال مارسيل. وقد حدد مارسيل هذا الموقف بقوله: “عدم الانفتاح هو أن يكون المرء منشغلاً بذاته”. إذا كنت أريد أن أكون مالكاً لذاتي فوجود الآخرين يهدد هذا التملك لأن عليّ أن أحسب حساباً لوجودهم ولما ينتظرونه مني ولوجهة نظرهم فيّ. إذا أغلقت على ذاتي ضمن مركزية أناي، فلا بد أن أرى الآخرين على شاكلتي وأن أرى فيهم بالتالي كائنات منغلقة، منشغلة بذاتها، تتطاحن مع كياني وتهدده بالاستعباد. إذا كنت منشغلاً بذاتي، فلا مكان حقيقي في وجودي للآخر، وبالأحرى لا مكان فيّ لهذا الآخر المطلق الذي هو الله، لأن إن قبلت به تجردت تماماً عن ملكية ذاتي وضربت في الصميم اكتفائي. ولا بد عند ذاك أن أتصور الله، كما أتصور الآخرين، من خلال مركزية أناي، فأراه أنانية هائلة تحاول استعبادي. ولا بد أن يكون رفضي له أعمق بكثير من رفضي للآخرين، لأنني إذا تصورت أن الآخرين يحاولون استعبادي أستطيع أن أرد عليهم بمحاولتي استعبادهم، أما الله، وهو تحديداً من لا أستطيع استعباده، فلا سبيل لي إلا إنكاره للمحافظة على اكتفائيتي. إذا كانت نقطة الانطلاق هي مركزية الأنا، فلا بد أن تبدو لي صورتها منعكسة على الآخرين، فأحس أنهم معتدلون ومستعبدون، ولا بد أن تنعكس صورتها مضخمة على الله، فأراه الطاغية الأكبر الذي يمتص كياني امتصاصاً ويلغي وجودي. لقد كتب إتيان بورن عارضاً وجهة النظر السارترية: “إن حضور الآخر يأتيني ببرهان إضافي على مدى أذى الله، لو كان موجوداً. لأن من هو الله سوى آخر مطلقة حرب بأن يرفع العلاقة الجدلية بين سيد وعبد (التي تربطني بالآخر) إلى أعلى درجة من الحدة عوض أن يحلها؟ لأنه إذا كان الآخر بغيضاً، فالله يكون، والحالة هذه، بغيضاً بصورة مطلقة”. عند ذاك وفي هذا المنظار الذي يصبح فيه حسب تعبير هيغل “كل وجدان يسعى إلى الموت الآخر”، أصبح “موت الله”، على حد تعبير نيتشه وسارتر من بعده، شرطاً لا بد منه لأوجد أنا. أما إذا تحررت من مركزية الأنا وأصبحت “منفتحاً” تحولت علاقتي بالآخر من صراع بين “أنا” و”هو” إلى “مناجاة” بين “الأنا” المنفتح والأنت حسب تعليم غبريال مارسيل. أي أن الآخر يصبح ليس ذلك الغريب “هو” الذي يحد وجودي ويهدده بل ذلك المخاطب، ذلك “الأنت”، شريكي الذي به أكتمل. عندئذ أستطيع أن أرى الله كطاغية غريب ينتزع مني الوجود بل كشريك وحبيب، ذلك، “الأنت المطلق” كما يقول غبريال مارسيل، الذي يوقظني باستمرار إلى وجود أوفر وأغنى.
2 – أصنام الله
أما السبب الثاني الذي حدا سارتر بنظري إلى تبني هذه الصورة المشوهة عن الله، فهو “الأصنام” التي حالت بينه وبين الإله الحقيقي. “الأصنام” هي تلك التصورات التي نكونها عن الله في ضوء ميولنا ورغباتنا فنتعبد لها معتقدين أننا نتعبد لله فيما لا نعبد بالحقيقة سوى أنفسنا. “ليست أفكاري كأفكاركم يقول الله، في نبؤة أشعيا، ولا طرقي كطرقكم لكن كبعد السماء عن الأرض تبعد أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم” (أشعيا 55: 8، 9)، ومع ذلك فإننا عوض أن نرتقي نحن إلى الله كثيراً ما ننحدر بالله إلى مستوى أفكارنا ورغباتنا. عندما انطلق سارتر من محورية الأنا تصور الله طاغية يمتص وجود الإنسان، كما رأينا، فأوجد هكذا صنماً سماه “الله”. ولكن سارتر عندما فعل ذلك، كان إلى حد بعيد يرجع صدى ما يتصوره الكثيرون من المسيحيين عن الله.
قاله المسيحيين، والحق يقال، ليس دائماً الإله المسيحي، الإله الذي أعلن لنا في يسوع المسيح. إن إله الكثيرين من المسيحيين إله يتصورونه على شاكلتهم، إله هو صورة مضخمة عن نقص المحبة الكامن فيهم. يقول لويس افلي في كتابه المذكور أعلاه: “… إن معظم المسيحيين لا يتمنون أن يكونوا ذلك الإله الذي يتصورونه. لأنهم أفضل منه. لقد قال فولتير كلمة رهيبة: “الله خلق الإنسان على صورته، ولكن الإنسان رد له المثل”. الإنسان صنمي بطبيعته. إنه دون انقطاع يكوّن إلهاً على صورته. كل واحد منا مجرب بأن يتصور إلهاً بعيداً…. مستاء، غير مكترث، لاهياً، حقوداً، متذمراً. لأننا لا نحبه كثيراً، نتصور أنه لا يمكن أن يحبنا كثيراً”. ولكن إله الاعلان الكتابي “أعظم” بما لا يقاس “من قلوبنا” الضيقة (1يوحنا 3: 29). لذا يتابع لويس افلي قائلاً: “الإعلان الإلهي يقول لنا… إن الله ليس مثلنا، وأنه لا ينبغي لنا، إذا شئنا أن نعرف مشاعره نحونا، أن نستند إلى مشاعرنا نحوه… إن الله أحبنا دون أن نحبه، إنه أحبنا أولاً”.
الإله الذي يتصوره المسيحيون كثيراً ما يكون صورة عن أسلوبهم في الحياة، مع أن هذا الأسلوب دائماً ناقص وقد يكون منحرفاً. من قرأ كتاب سارتر الأخير Les Mots (وفيه يروى طفولته)، أو الكاتب المماثل لتلميذه سيمون دي بوفوار، يرى أن كلاهما نشأ في بيئة عائلية أو اجتماعية كان الله يتميز فيها عن الوطن والنظام والأسلوب البورجوازي في العيش وسلطة التقاليد الاجتماعية. تلك التقاليد التي قتلت “زازا” الفتاة المؤمنة والمنتمية إلى عائلة مؤمنة، صديقة سيمون دي بوفوار، لأن تربيتها جعلتها تخضع، ضوعها لله، لإرادة والدة كانت ترفض تزويجها من الرجل الذي أحبته لأن العرف يقضي بان لا تختار الفتاة زوجاً بل يختاره لها والدها.
المسيح رفض تجربة السلطة، رفض أن يكون ملكاً على الأرض، (يوحنا6: 15، 18: 36)، وبذلك أظهر لنا أن سلطة الله تختلف بما لا يقاس عن مفاهيم البشر في السلطة. ومع ذلك فكثيراً ما يتخذ المسيحيون الله مبرراً للنظام الاجتماعي الراهن ولو كان هذا النظام جائراً. لقد تحققت في فولتير مثلاً كلمة المذكورة أعلاه، إذ أنه نادى بفكرة “إله دركي” يكون ضمانة لنظام اجتماعي مبني على تفاوت الثروات، وكان هكذا، وهو ثري، يتخذ الله حجة لضمان احتفاظه بثروته.
ولكن الكثيرين من المسيحيين يجارون في هذا الموقف فولتير الذي لم يكن مسيحياً، فتراهم ينسـبون إلى الله تفاوت الثروات ويتخذونـه وسيلة لتكريس اسـتغلال فئة لفئة أخرى. إن أ. لامبرت، في مقال له، بعد أن بين أن الله لا يمارس في العالم سلطة شبيهة بسلطة الناس، أظهر كيف أن المسيحيين سخّروا ولا يزالون يسخّرون الله لتثبيت تسلط المتسلطين، وأضاف قائلاً: “يتمتع الإنسان بهذا الامتياز الرهيب بأنه يستطيع أن يحمّل إلهاً مسؤولية المركز الذي يشغله والقانون الذي يضعه… هذا هو أحد العوامل الرئيسية لاستبعاد البشر وهذا ما يظهر بأنه بإمكان المرء أن يدوس الصليب لا عن طريق اضطهاده بل عن طريق تملكه”.
إنها بالحقيقة محاولة كفرية يستخدم بها الإنسان الله عوض أن يضع نفسه في خدمته ويحدره إلى مستوى مطامعه عوض أن يرتفع إليه، إنه يصور الله بأخلاقه عوض أن يتصور بأخلاق الله، وهكذا يبرر سلوكه ويتأصل به ويطفئ فيه الإمكانات الخيرة ويصبح تماماً على صورة ذلك الإله الذي تصوره. يقول جوبيتر “الذباب” لايجيست: “لقد قلت لك أنك مصنوع على صورتي. كلانا يعمل ليسود النظام، أنت في أرغوس وأنا في العالم” (الفصل 2 – المنظر 2 – المشهد 5) والصحيح أن “جوبيتر” و”أصنام الله” الشبيهة به صنعت على شيه الطاغية ايجيست وأمثاله. الحق يقال إن المسحيين كثيراً ما تصورا ويتصورون الله على صورة الملوك والحكام وما سمي “بنظامهم” الذي قد يكون تكريساً من الملوك والحكام التخلق بأخلاق الله.
هذا ما أدى إلى التلازم المؤسف، المرير، بين “المذبح” والعرش”، هذا ما قاد الكنيسة الرسمية في كثير من الأحيان إلى الخلط بين قضية الله وقضية الطبقة الحاكمة، هذا ما يفسر، إلى حد ما، إن الحركات التحريرية منذ الثورة الفرنسية كثيراً ما انحرفت في نضالها ضد الاستبداد إلى رفض الله نفسه، لأن الإله الذي وجدته أمامها كان قد صنع على صورة المستبدين.
ولأن المسيحيين تصورا الله على صورة السلطات الأرضية، فقد ناقضوا الإنجيل بشكل رهيب إذ كثيراً ما استخدموا الاكراه في أمور الدين. فقد كتب بردياييف: “في مجرى التاريخ، كثيراً ما اتخذت المسيحية طريق الاكراه وسقطت في التجربة وتخلت عن حرية المسيح. إن الرئاسة الروحية، سواء الكاثوليكية أو الارثوذكسية، كثيراً ما استبدلت الحرية بالإكراه، وسقطت في تجربة المفتش الأكبر”.
هذا الإله الذي كثيراً ما نلصق به صورة المتسلط في المجتمع، قد نراه أيضاً من خلال علاقتنا الطفيلية بوالدينا. إن أول صورة يتحسس المرء من خلالها سر الله هي صورة والديه، إلا أن نموه الإنساني والروحي يجب أن يقوده إلى تجاوز هذه الصورة. ولكن قد تحجب هذه الصورة الطفيلية عن الإنسان رؤية الإله الحقيقي. هذا ما قد يحدث مثلاً إذا كان الوالدان شديدي التسلط أو إذا كانا يخلطان بين سلطة الله وسلطتهما الخاصة ويبنيان تربيتهما الدينية والخلقية على الخوف من الإله الذي “يخنق الأطفال”.
هكذا قد تبقى عالقة في نفس المرء طيلة حياته صورة إله يضخم شراسة الوالدين وتسلطهما، صورة له لا سبيل للوقوف أمامه إلا في موقف الطفل العاجز أمام عملاق يسحقه، صورة إله بعبع لا مجال أمامه إلا للشعور الدائم بالإثم والخوف. تلك صورة “الإله الأب الرهيب” التي وجدها فرويد في بعض التصورات الدينية فلم يعرف أن يميز بينها وبين الإله الحقيقي. إن المشتغلين بعلم النفس كثيراً ما يرون هذه الصورة عن الله، التي يجتمع فيها كل عجز الطفل وذعره، تبرز من كوامن العقل الباطن وتطغي على المعلومات الدينية التي تلقنها الشخص – خاصة إذا كانت سطحية، ناقصة – وتصبغ حياته كلها، فإما تستعبده وتشل فيه كل حيوية وتعذبه دون هوادة بالوساوس والشعور المرضي بالإثم وإما تشعل فيه ثورة تبدو وكأنها موجهة ضد الله فيما هي بالحقيقة محاولة مستميتة للتخلص من صنم استعيض به عن الإله الحقيقي.
تلك العلاقة بين الصورة التي يكونها الطفل عن والديه (والتي ليست هي بالضرورة مطابقة تماماً لشخصها الحقيقي) وبين تصوره، في طفولته وما بعدها، لله، تبدو لنا إذا عدنا إلى طفولة سارتر كما يرويها لنا في مذكراته المذكورة آنفاً وكما رجع لنا تلميذه جانسون صداها في دراسته عن سارتر التي سبق أيضاً ذكرها. أن عبارة في مذكرات سارتر لا بد لها أن تلفت النظر، ألا وهي: “لقد فهم القارئ أنني أكره طفولتي وكل ما بقي منها….”. فما هو الداعي يا ترى لتلك الكراهية؟ لقد توفي والد سارتر فيما كان يبلغ من العمر سنتين، فعاشت أرملته عند والديها مع الطفل مدة عشر سنوات تزوجت بعدها من جديد. هكذا قام جد سارتر بدور الوالد بالنسبة لليتيم. وقد أحاطه بالعناية والاهتمام، فلم ينقصه شيء في الظاهر، إلا أن الطفل كان يحس بأن تلك العناية كلها لم تكن نابعة حقيقة من القلب، إنما كان فيها تكلف وتمثيل.
لم يحس بأن ذلك المنزل كان منزله حقيقة، فقد كانت والدته توشوش في أذنه إذا ضج: “احذر، لسنا في بيتنا”. أحس هذا الطفل المدلل بأنه لم يكن محبوباً من أجل نفسه، إنما كان عليه أن يشترك في تمثيلية، فيتقبل تظاهر جده بالاهتمام به ويجيب على ذلك بأن يلعب دوره، دور الولد المرضي، المهذب، المطيع، الذكي، دون أن يجد الحب لقلبه سبيلا: “لم أكن أحب شيئاً أو أحداً”. كان يشعر بأنه ليس مقبولاً حقيقة وأن لا مبرر لوجوده سوى أرادة جده، تلك الإرادة التي كان عليه ان يستميلها بلعبه، تجاه ذلك الجد المتسلط، دور الكلب الأليف. من الطبيعي، والحالة هذه، أن يكوّن الطفل سارتر صورة عن الأبوة نابعة من علاقته بجده. فقد كانت تلك العلاقة مجردة من الحب: كان الطفل يشعر أن جده لا بحبه حقيقة (“كان مصيري معلقاً به كلياً، فكان يعشق فيّ كرمه”) وإن عطفه عبء عليه لأنه كان مضطراً أن يستجديه بتلبس شخصية زائفة، ذليلة. لذا تصور الأبوة طاغية، ساحقة، وهنأ نفسه لوفاة والده لأنها جعلته حراً: “ليس من أب صالح، تلك هي القاعدة. ولا يعود اللوم في ذلك للبشر بل لرباط الأبوة الذي هو مهترئ. حسن أن يصنع الإنسان أولاداً، ولكن أن يكون له أولاد، يا للظلم.
لو كان عاش أبي، لكان تمدد عليّ بطوله وسحقني. لحس حظي مات عندما كنت صغيراً….”، “لقد كان موت جان باتيست (والده) قضية حياتي الكبرى، فقد…. أعاد لي الحرية”. هكذا نرى أن سارتر بتأثير خبرة طفولته لم يتصور الأبوة إلا بشكل ملكية واستبعاد ساحق. وإذا كانت صورة الأبوة كما يكونها الإنسان في طفولته تطبع إلى حد ما تصوره لله، كما أظهر التحليل النفسي، فلا عجب أن يكون سارتر قد كوّن منذ طفولته عن الله صورة مشوهة، صورة مراقب مخيف تجلت للطفل سارتر في لحظة يرويها لنا من حياته، فرفضها نهائياً: “مرة واحدة، شعرت بأنه موجود. كنت قد لعبت بعيدان كبريت وأحرقت سجادة صغيرة، وفيما كنت أخفي جرمي، أبصرني الله فجأة، شعرت بنظرة داخل رأسي وعلى يديّ؛ قدرت في الحمام وأنا أحس أنني مرئي بشكل فظيع، هدف حي للرماية.
ولكن الاستنكار أنقذني: فقد اغتظت لفضول مبتذل لهذا الحد وجدفت… فلم ينظر إليّ أبداً فيما بعد”. تلك الصورة الرهيبة التي كونها سارتر منذ طفولته عن الله لم يكن ما يقومها، لا في بيئته العائلية، فجده وجدته كانا لا مباليين، وأمه كانت ذات إيمان منطو، ولا في بيئته الاجتماعية التي كانت تدين بدين شكلي لا حياة فيه ولا التزام. فلا عجب أن يكون قد تسلح ضدها بتلك المكابرة التي اتخذها منذ طفولته سلاحاً ضد بيئة عائلية أحس أنها تسلبه وجوده الأصيل، لا عجب أن يكون قد رفضها رفضه لتلك الأبوة التي تبرأ منها مفضلاً عليها عزلة لا جذور لها (“ابن لا أحد، أصبحت علة ذاتي، هذا غاية الكبرياء وغاية الشقاء”، “أصبحت راشداً وحيداً، لا أب لي ولا أم، لا مقر لي، وأكاد أكون بلا اسم”)، تلك الأبوة التي لم يشأ هو أن يمارسها. هكذا كانت طفولة سارتر أحد المصادر الرئيسية لتلك الصورة الصنمية عن الله التر رفضها بشدة غير مميز إياها عن الإله الحي.
هذا ما يظهر ما لنوعية سلوك الوالد من أهمية في تنشئة الموقف الديني عند أولاده. فالوالد صورة عن الله ولكنه صورة ليس إلا. لذا يجب أن يمحي تدريجياً أمام الأصل، كما أمحى المعمدان أمام السيد قائلاً: “ينبغي أن ينمو هو وأن أنقص أنا” (يوحنا 3: 27-30)، يجب أن يكون سلوكه قدر الإمكان صورة لمعطائية الله الذي يغدق من ذاته ولا يستولي. أما إذا شاء الوالد أن يخلط بين سلطته وسلطة الله، وبعبارة أخرى أن يؤله ذاته، إذا كانت أبوته طغياناً وحبه لنفسه وسيلة للاستعباد، فإنه يدفع بأولاده إلى الكفر لا به وحسب بل بالله الذي هو صورته في نفوسهم. هذا صحيح خاصة في أيامنا حيث يقود التمرد على السلطة الوالدية في كل مظاهرها، من عائلية واجتماعية، إلى رفض الأب السماوي. وقد كتب جان لاكروا بهذا الصدد: “إن رفض سلطوية الوالد، بأقوى معانيه، هو أحد دوافع زمننا الرئيسية، والسبب الجوهري لرفض الله”. بالطبع كثيراً ما يتخذ ذلك الرفض للسلطوية الوالدية في أيامنا أشكالاً هوجاء، تتسم بطابع المراهقة، فيخلط بين السلطوية والأبوة ليرفضهما كليهما، ولكن ينبغي أن نرى في أصل ذلك الالتباس تلك الصورة المشوهة التي طالما سادت في العائلة والمجتمع، صورة أبوة مستعبدة، ساحقة، عوض أن تكون محيية، معطاء، صورة ألصقت بالله نفسه واتخذته تكريساً لها وضماناً، فأوجدت صنماً من أبشع أصنام الله.
“أصنام الله، هذه، على حد تعبير القديس غريغوريوس النيصصي، يجب أن يكفر بها. لقد كان الوثنيون يسمون المسيحيين الأولين “ملحدين” لأنهم كانوا يكفرون بتلك الأصنام التي كان يعتقدها عبادها آلهة. ولكن في كل منا لا تزال الوثنية كامنة، وأصنامها المصنوعة على شاكلة تصورات البشر. لذا ينبغي لنا أن نكفر باستمرار بهذه الأصنام التي قد تحجب عنا رؤية الإله الحق. هنا يظهر لنا الدور الإيجابي الذي يمكن لإلحاد سارتر وللإلحاد المعاصر عامة أن يلعبه بالنسبة لإيماننا. لقد كتب الفيلسوف لانيو: “إن الإلحاد هو الملح الذي يمنع الإيمان بالله من الفساد”. المسيحي يعلم أن وجد الآخر إلى جانبه، وإن كان يهدده في طمأنينته الأنانية، إنما هو بالحقيقة دعوه له إلى وجود أوفر وأغنى، لذا يمكن أن نعتبر الإلحاد السارتري مدعاة إلى تطهير إيماننا وتأصيله وتعميقه. إذا عنى أحد بالله ذلك الإله الذي يصوره سارتر فنحن مع سارتر كافرون بهذا الإله – الصنم، باسم الإله الحقيقي، حسب تعبير الراهب المتصوف الألماني الشهير المعلم أكارت (الذي عاش في القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر): “إنني أسأل الله أن ينجيني من الله”، أين إنني أسأل الإله الحقيقي الحي أن ينجيني من الإله الصنم الذي يراود خيالي. الإيمان الحقيقي عملية شاقة مستمرة يلازمها كفر دائم بأصنام الله، حسب وصية الرسول يوحنا: “يا أولادي احفظوا أنفسك من الأصنام” (1يوحنا 5: 21). خطأ سارتر أنه توقف عند الناحية السلبية ولم يتجاوزها. أما نحن فسبيلنا أن نتذكر دائماً بأن الله، حسب تعليم الكتاب المقدس وحسب النهج الذي سار عليه بنوع خاص الآباء الشرقيون في لاهوتهم وحسب اختبار كبار المتصوفين المسيحيين، منزه عن كل تصور بشري، وأنه ينبغي لنا، والحالة هذه، أن ننبذ كل تصوراتنا البشرية عن العظمة والسلطة إذا شئنا أن نعرف عظمته وسلطته. يقول القديس غريغوريوس بالاماس منزهاً الله عن كل ما في الوجود من صفات: “إذا كان الله طبيعة، فكل ما تبقى ليس بطبيعة وإذا كان ما ليس الله طبيعة فالله ليس بطبيعة. وإذا كانت الكائنات الأخرى موجودة فهو ليس بموجود” أي أن وجوده يختلف بما لا يقاس عن وجود الكائنات الأخرى، حتى أننا إذا أطلقنا صفة الوجود عليها، لا يمكننا أن نطلق الصفة نفسها عليه. وهكذا إذا سمينا البشر آباء وحكاماً فالله ليس بأب ولا بحاكم. إما إذا سمينا الله أباً وحاكماً فالبشر ليس بآباء ولا بحكام حسب قول السيد: “لا تدعوا أحداً على الأرض أباً، فإن أباكم واحد وهو الذي في السماوات، ولا يدعكم أحد مدبرين، لأن مدبركم واحد، وهو المسيح” (متى 23: 9، 10).