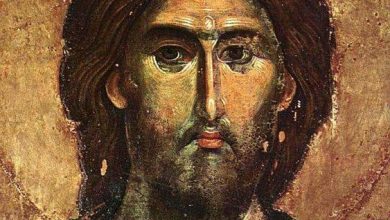السماء – سي إس لويس
السماء – سي إس لويس

السماء – سي إس لويس
“إنها مطلوبة. إنك توقظ إيمانك بالفعل. ثم بعد ذلك كل شيء يقف ساكناً؛ معلقاً؛ أولئك الذين يظنون أنه عمل غير مشروع هذا الذي سأقوم به، دعهم يرحلون.”
شكسبير SHAKESPEARE, Winter’s Tale
“وأنا مغمور في عمق رحمتك دعني أموت الموت الذي تشتهيه كل نفس حية.”
كوبر COWPER out of Madame Guion
“فإني أحسب”، يقول القديس بولس، “أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.” إن كان الأمر كذلك، فإن كتاباً عن الألم والمعاناة لا يقول أي شيء عن السماء، يترك تقريباً جانباً كاملاً من جانبي الرواية. في المعتاد يضع الكتاب المقدس والتقليد أفراح السماء في جانب مقابل للآلام الأرضية، ولا يوجد حل لمعضلة الألم لا يقوم بذلك يمكن أن نطلق عليه حلاً مسيحياً.
إلا أننا نشعر بالخجل الشديد في هذه الأيام حتى من مجرد ذكر السماء؛ فنحن نخشى من التهكم حول السعادة في السماء، وأن يقال لنا أننا نحاول “الهروب” من واجبنا في أن نصنع عالماً سعيداً هنا والآن عن طريق أحلام بعالم سعيد في مكان آخر. فإما أن تكون هناك سعادة في السماء أو لا تكون. لكن لو لم تكن هناك سعادة في السماء، إذاً المسيحية باطلة وزائفة، لأن هذه العقيدة منسوجة داخل نسيجها بأكمله. وإذا كانت هناك هذه السعادة، فإن هذه الحقيقة، مثلها مثل أية حقيقة أخرى، لا بد أن تتم مواجهتها، سواء كان هذا مفيداً في الاجتماعات السياسية أم لا.
مرة أخرى، إننا نخشى أن تكون السماء رشوة، وأننا إذا جعلناها هدفاً لنا فإننا لن نصبح نزيهين. لكن الأمر ليس بهذه الصورة. فلا تقدم السماء أي شيء يمكن للنفس المنتفعة أن ترغب فيه. فمن الآمن أن تخبر ذوي القلوب النقية أنهم سوف يرون الله، لأن أنقياء القلب وحدهم هم الذين يريدون ذلك. هناك مكافآت لا تلوث الدوافع. فمحبة رجل لامرأة ليس نفعية لأنه يريد أن يتزوجها، ولا تعتبر كذلك محبته للشعر نفعية لأنه يريد أن يقرأه، ولا محبته للتدريبات الرياضية أقل نزاهة لأنه يريد أن يجري ويقفز ويمشي. فالحب بحسب تعريفه، يسعى للاستمتاع بما أو بمن يحبه.
ربما تعتقد أن هناك سبباً آخر لصمتنا بشأن السماء، بمعنى، أننا لا نرغب فيها حقاً. لكن قد يكون هذا وهماً. إن ما سأقوله الآن هو مجرد رأي خاص بي بدون أدنى سلطة، لذلك فإني أخضعه لحكم مسيحيين أفضل ودارسين أفضل مني. في بعض الأحيان أفكر أننا لا نرغب في السماء؛ لكن في مرات أكثر أجد نفسي أتساءل ما إذا كنا، في أعماق قلبنا، قد رغبنا في أي شيء آخر على الإطلاق. ربما تكون قد لاحظت أن الكتب التي تحبها حقاً مرتبطة معاً بخيط خفي.
إنك تعرف جيداً ما هي السمة المشتركة التي تجعلك تحبها. رغم أنك لا تستطيع أن تصيغ ذلك في كلمات؛ لكن معظم أصدقائك لا يرون تلك السمة على الإطلاق، وكثيراً ما يتساءلون لماذا، إذ تحب هذا، يكون عليك أيضاً أن تحب ذلك. مرة أخرى، أنت تقف أمام بعض المناظر الطبيعية، التي تبدو وكأنها تجسد ما تبحث عنه طوال حياتك؛ ثم بعد ذلك نظرت إلى التصديق الذي يجلس إلى جانبك الذي يظهر أنه يرى ما رأيته انت، لكن عند الكلمات الأولى تجد هوة كبيرة تفصل بينكما، فتدرك أن هذا المنظر الطبيعي يعني شيئاً مختلفاً تماماً بالنسبة له، إنه يسعى إلى رؤية مغايرة ولا يهتم بالإيحاء الذي يفوق الوصف الذي أثارك.
حتى في هواياتك، ألم يكن هناك دائماً نوعاً من الجاذبية الخفية يجهلها الآخرون بصورة غريبة، شيئاً، لا يمكن تعريفك به، ولكنه يكون دائماً على وشك الظهور. في رائحة الخشب المقطوع في الورشة أو قرقعة المياه على جانب القارب؟
أليست كل الصداقات التي تستمر طوال الحياة تولد في اللحظة التي تلتقي فيها أخيراً بإنسان آخر يكون لديه نوع من المعرفة المحدودة (لكنها تكون ضعيفة وغير أكيدة حتى في أفضل صورها) لذلك الشيء الذي ولدت وأنت ترغب فيه، والذي يكون قابعاً تحت التغير المستمر للرغبات الأخرى، وفي كل أوقات الصمت اللحظي بين العواطف الأعلى صوتاً، ليلاً ونهاراً، وسنة بعد سنة، منذ الطفولية وحتى الشيخوخة، تبحث عنه، وتراقبه، وتصغير إليه؟ إنك لم تحصل عليه أبداً.
كل الأمور التي امتلكت نفسك بعمق من قبل كانت مجرد لمحات منه، ومضات مثيرة، وعود لم تتحقق تماماً، وأصداء تلاشت بمجرد أن لامست أذنيك. لكنه لو أصبح ظاهراً بالفعل، لو جاء صدى في أي وقت مضى ولم يتلاشى بل تضخم داخل الصوت نفسه فإنك ستعرفه. بلا أي احتمال للشك سوف تقول، “ها هو أخيراً الشيء الذي صنعت لأجله”. إننا لا نستطيع أن نخبر به بعضنا البعض.
إذ إنه السمة السرية المميزة لكل نفس، الرغبة التي لا يمكن التعبير عنها والتي لا يمكن إشباعها، الشيء الذي رغبنا فيه قبل أن نلتقي بزوجاتنا أو نكّون صداقاتنا أو نختار عملنا، والذي سنظل نرغب فيه على أسِرّة موتنا، عندما لا يعد العقل يعرف الزوجة او الصديق او العمل. فأثناء وجودنا يوجد هذا الشيء. وإذا فقدناه، نفقد كل شيء.
تلك السمة أو العلامة المميزة في كل نفس قد تكون نتيجة الوراثة والبيئة، لكن هذا يعني فقط أن الوراثة والبيئة هما من بين الأدوات التي بواسطتها يخلق الله النفس. إنني أتساءل ليس عن الكيفية، بل عن السبب الذي لأجله يصنع الله كل نفس مميزة ومتفردة. فإذا لم يكن له أي استخدام لكل هذه الاختلافات، فأنا لا أرى سبباً يجعله يخلق أكثر من نفس واحدة. لكن تأكيد أن مداخل ومخارج فرديتك لا تعد غامضة بالنسبة له؛ وفي يوم من الأيام لن تكون سراً غامضاً بالنسبة لك.
فالقالب الذي يصنع منه المفتاح سيكون شيئاً غريباً، لو أنك لم ترى مفتاحاً من قبل؛ والمفتاح نفسه سيكون غريباً بالنسبة لك لو لم تكن قد رأيت قفلاً. إن لنفسك شكلاً رائعاً ومختاراً بعناية لأنها تجويف صُنع لك يلائم بروزاً معنياً في المعالم اللامحدودة للجوهر الإلهي، أو مفتاحاً لفتح واحد من الأبواب في منزل به العديد من الشقق. لأنه ليست الإنسانية بصورة مجردة هي التي ستخلص، بل أنت، أنت القارئ كفرد، سواء كنت جون ستوبس أو جانيت سميث. أيها المخلوق المبارك السعيد.
إن عينيك أنت هي التي سوف تراه (الله) وليس عيناً آخر. كل ما أنت عليه، بدون خطية، من المقدر لك أن تحظى بالشبع المطلق، إذا تركت الله يأخذ طريقه الصالح في حياتك. نظرت ساحرة بروكين The Brocken specter “إلى كل رجل كأنه هو حبها الأول”، لأنها كان خدعة، لكن الله سوف ينظر إلى كل نفس وكأنها هي حبه الأول لأنه هو حبها الأول. سيبدو مكانك في السماء وكأنه صنع لأجلك، ولأجلك أنت وحدك، لأنك أنت صُنعت له، صُنعت له غرزة تلو الأخرى مثلما يصنع القفاز لليد.
من وجهة النظر هذه يمكننا أن نفهم الجحيم في جانبه الخاص بالحرمان. طوال حياتك كانت هناك نشوة غير قابلة للتحقيق تحلق أبعد من قبضة وعيك. لكن سيأتي اليوم الذي ستستيقظ فيه لتجد، فيما يتجاوز كل رجاء، إما أنك قد حصلت عليها، أو أنها كانت في متناول يدك لكنك قد فقدتها إلى الأبد.
قد تبدو هذه فكرة خاصة وذاتية خطيرة عن اللؤلؤة كثيرة الثمن، ولكنها ليس كذلك. فالشيء الذي أتكلم عنه ليس اختباراً. فقد اختبرت فقط الاحتياج إليه، لكن الشيء نفسه لم يتجسد فعلياً أبداً في أية فكرة، أو صورة، أو عاطفة. فقد يستدعيك دائماً خارج نفسك. وإذا لم تخرج خارج نفسك لكي تتبعه. إذا جلست لكي تتأمل في الرغبة وأنت تحاول أن تتعلق بها في ذهنك، فإن الرغبة نفسها سوف تهرب منك. “فالباب الذي يوصل إلى الحياة يفتح عامة خلفنا” و “الحكمة الوحيدة” لإنسان “يلازمه عبير الورود غير المرئية، هي العمل”[1].
هذه النار الخفية تخرج عند استخدام الخوار؛ قم بتغطيتها بما يبدو أنه الوقود البغيض للعقيدة والأخلاقيات (لكي تضمن استمرار اشتعالها ببطء)، أدر ظهرك لها، وباشر واجباتك، وعندها سوف تتقد وتتوهج. يشبه العالم صورة ذات خلفية ذهبية، ونحن الشخصيات الموجودة في تلك الصورة؛ فإلى أن تخطو خارج مسطح الصورة إلى الأبعاد الواسعة للموت، لا تستطيع أن ترى الذهب. لكن لدينا أشياء تذكرنا به. لك نغير استعارتنا التشبيهية، نقول إن التعتيم ليس كاملاً تماماً. فهناك شقوق يظهر منها النور. لكن في بعض الأحيان يبدو المشهد اليومي كبيراً لغموضه.
هذه هو رأيي؛ وقد يكون خاطئاً. ربما تكون هذه الرغبة الخفية أيضاً جزء من الإنسان القديم ولا بد من صلبها قبل النهاية. لكن هذا الرأي له خدعة غريبة لتجنب إنكار الذات. فهذه الرغبة – بل الأكثر كثيراً الرضا والشبع – يرفض دائماً أن يكون متواجداً بالكامل في أية خبرة. فمهما حاولت تحديدها والتعرف عليها، يتضح أنها ليست هي بل شيء آخر؛ بحيث أنه بالكاد يمكن لأية درجة من الصلب أو التغيير أن تذهب إلى أبعد مما تقودنا الرغبة نفسها أن نتوقعه. مرة أخرى، لو كان هذا الرأي غير صحيح، فإن شيئاً أفضل يكون صحيحاً. لكن “شيئاً أفضل” – ليس هذه الخبرة أو تلك، بل أبعد منها – هو في الأغلب تعريف الشيء الذي أحاول أن أصفه.
الشيء الذي تتوق إليه يستدعيك بعيداً عن الذات. بل حتى الرغبة في الشيء تحيا فقط إذا تركتها وتجاهلتها. هذا هو القانون المطلق – البذرة تموت لكي تحيا، والخبز لا بد أن يُلقى على وجه المياه، والشخص الذي يضيّع نفسه يخلصها. لكن حياة البذرة، والعثور على الخبز، واسترداد النفس، هي أمور حقيقية مثل التضحية الأولى. لذلك يقال حقاً عن السماء أنه، “لا توجد ملكية في السماء، فإذا تجرأ أي إنسان بأن يدعو شيئاً ما أنه ملكه، فإنه سوف يُطرح مباشرة إلى الجحيم ويصبح روحاً شريرة”[2].
لكنه يقال كذلك، “من يغلب فسأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ” (رؤيا 2: 17). ماذا يمكن أن يكون ملكاً للإنسان أكثر من اسمه الجديد الذي حتى في الأبدية يظل سراً خاصاً بينه وبين الله؟ وماذا يا ترى تعني هذه “الخصوصية”؟ بالتأكيد. إن كلاً من النفوس المفدية سوف تعرف وتمجد إلى الأبد خاصية ما معينة في الجمال الإلهي أفضل مما يمكن أن يقوم به أي كائن آخر، فلماذا غير ذلك إذاً تم خلق كل الأفراد، إلا لأن الله، حيث أنه يحب كل منهم إلى ما لا نهاية، يحب كل منهم بطريقة مختلفة؟ وهذا الاختلاف، أبعد كثيراً من أن يعوق، يفيض بالمعاني في حب كل الكائنات المباركة لبعضها البعض.
في شركة القديسين. فلو كان الجميع قد اختبروا الله بنفس الطريقة وقدموا لله عبادة متماثلة، لما كان لترنيمة الكنيسة المنتصرة أي تناغم، لكانت كما لو أن فرقة موسيقية تقوم فيها كل الآلات بعزف نفس النغمة الواحدة. يخبرنا أرسطو أن المدينة هي “وحدة المختلفين”، ويخبرنا القديس بولس أن الجسد هو وحدة بين أعضاء مختلفة والسماء مدينة، وجسد، لأن المباركين يظلون إلى الأبد مختلفين؛ يظلون مجتمعاً، لأن كل منهم لديه شيء يقوله للآخرين كلهم – فسيجد كل منهم في الله أخباراً جديدة ومتجددة دائماً عن “إلهي”، والذي سوف يسبحه الجميع باعتباره “إلهنا”.
لأنه بلا شك أن المحاولة الناجحة المتواصلة، لكن غير المكتملة على الإطلاق، التي تقوم بها كل نفس بتوصيل رؤيتها المتفردة لجميع الآخرين (وهذا بطرق يُعتبر الفن الأرضي والفلسفة مجرد محاكاة غير متقنة لها) هي أيضاً من بين الغايات التي خلق الفرد لأجلها (لمدح مجد نعمته).
هذا لأن الوحدة تتواجد فقط بين المختلفين؛ وربما من هذا الرأي، تلقي نظرة لحظية على معنى كل الأشياء. مبدأ وحدة الوجود Pantheism هو عقيدة ليست كاذبة تماماً بقدر ماهي وراء الزمن بصورة ميؤوس منها. ففي القدين، من قبل الخليقة، كان سيصبح صحيحاً أن نقول إن كل شيء كان هو الله. لكن الله خلق؛ وهكذا قد سبب وجود أشياء أخرى غير نفسه. ولكونها مختلفة، فيمكنها أن تتعلم أن تحبه. وأن تحقق الوحدة بدلاً من مجرد التماثل. وهكذا ألقى الله أيضاً خبزه على وجه المياه.
وحتى داخل الخليقة يمكننا أن نقول ان المادة غير الحية، التي ليست لديها إرادة، هي واحد مع الله بالمعنى الذي لا يكون فهي البشر كذلك. لكنه قصد الله أننا يجب أن نعود إلى تلك الهوية القديمة (كما قد يريدنا بعض الصوفيين الوثنيين أن نفعل) بل إننا يجب أن نواصل إلى الحد الأقصى للاختلاف هناك، لكي نتحد مرة أخرى معه بطريقة أسمى. حتى داخل الإله الواحد الأقدس نفسه، لا يكفي أن يكون الكلمة هو الله، بل لا بد أيضاً أن يكون الكلمة “عند” أو “مع” الله. فالآب يلد الابن أزلياً والروح القدس ينبثق؛ هذا الإله يقدم لنا الاختلاف والتمييز داخل ذاته نفسها حتى أن وحدة المحبة التبادلية تتسامى على مجرد الوحدة الحسابية أو الهوية الذاتية.
لكن التمييز والاختلاف لكل نفس – السر الذي يشكل الوحدة بين كل نفس والله، الجنس البشري في حد ذاته لن يلغي أبداً القانون الذي يمنع الملكية في السماء. أما بالنسبة إلى رفاقها من المخلوقات، فإننا نفترض أن كل نفس، سوف تشترك أبدياً في تقديم كل ما تتلقاه إلى الباقين كلهم. اما بالنسبة لله، لابد أن نتذكر أن النفس ما هي إلا تجويف يملأه الله. فوحدتها مع الله، تقريباً بحكم التعريف، هي إخلاء وتخل مستمر عن الذات – فتح، وكشف وتسليم للذات.
فالروح المباركة هي قالب مجوف ينتظر في أي وقت بصبر أكثر فأكثر أن ينسكب فيه المعدن المشع، جسد يتكشف دائماً بالكامل أكثر فأكثر لوهج شمس النهار الروحية. لا يجب أن نفترض أن ضرورة شيء مواز لإخضاع الذات سوف تنهي على الإطلاق، أو أن الحياة الأبدية لن تكون أيضاً إماتة أبدية (للذات). بهذا المعنى، كما أنه قد تكون هناك متع في الجحيم (ليقنا الله منها)، قد يكون هناك شيء ليس على العكس تماماً من الآلام في السماء (ليمنحنا الله سريعاً أن نتذوقها).
لأنه في إعطاء الذات، إذا كان في إي مكان آخر، نلمس إيقاعاً ليس فقط لكل الخليقة بل لكل الكيان. هذا لأن الكلمة الأزلي Eternal Word قدم نفسه أيضاً كذبيحة؛ وتلك لم تكن فقط على الجلجثة. لأنه عند صلب “فإنه فعل في الطقس العاصف لعوالمه النائية، ذلك الذي كان قد فعله قبلاً في بيته في المجد والسرور”[3]. فمن قبل تأسيس العالم يعود الإله المولود ويخضع للإله الوالد بالطاعة.
وكما أن الابن إنساناً عادياً، أعتقد أنه قيل بصدق أن، “الله يحب ليس نفسه كنفسه بل باعتبارها الصلاح او الخير؛ وإذا كان هناك شيء أفضل من الله، لكان قد أحبه ولم يحب نفسه”[4]. لذلك من الأسمى (الإله) إلى الأدنى (المخلوق)، تتواجد الذات ليك تُخلى، وبواسطة هذه الإخلاء، تصبح نفساً بأكثر صدق، وعندها تصبح أكثر اخلاء، وهكذا إلى الأبد. ليس هذه قانوناً سماوياً يمكننا أن نهرب منه بأن نظل أرضيين، ولا هو قانون أرضي يمكننا أن نهرب منه بأن نَخلص: لكن ما هو خارج نظام إعطاء وإخلاء الذات ليس أرضاً، ولا طبيعة، ولا “حياة عادية”.
بل هو فقط وببساطة الجحيم. ومع ذلك فحتى الجحيم يَشق من هذا القانون مثل هذا الواقع حيث أنه عنده. فهذا السجن القاسي في الذات هو مجرد وجه العملة الآخر لإعطاء الذات الذي هو واقع مطلق؛ إنه الشكل السلبي الذي تأخذه الظلمة الخارجية بواسطة توضيح وتعريف شكل الواقع؛ أو الذي يفرضه الواقع على الظلمة بأن يكون له شكل وطبيعة إيجابية خاصه به.
إن التفاحة الذهبية للطبيعة الذاتية، إذ ألقيت بين الآلهة الباطلة، أصبحت تفاحة الخلاف الشقاق لأنهم تزاحموا وتدافعوا عليها. إنهم لم يعرفوا القانون الأول للعبة المقدسة، وهي أن كل لاعب لابد بكل وسيلة ممكنة أن يلمس الكرة ثم يمررها بعد ذلك في الحال. فإذا وُجدت والكرة في يدك يكون هذا خطأ؛ وإذا تشبثت بها، هذا هو الموت. ولكنها عندما تطير للأمام وللخلف بين اللاعبين بسرعة شديدة بحيث لا يمكن للعين أن تتبعها، والمدرب العظيم نفسه هو الذي يقود اللعب، معطياً نفسه أزلياً لخليقته في الخلق، ثم راداً إياها لنفسه مرة أخرى بتضحية الذبيحة في الكلمة، عندها حقاً تجعل الرقصة الأبدية Eternal Dance “السماء تنعس مع التناغم”.
كل الآلام والمسرات التي نعرفها على الأرض هي تلقينات مبكرة لحركات تلك الرقصة؛ لكن الرقصة نفسها لا يمكن مضاهاتها على الإطلاق بآلام هذا الزمان الحالي. فإننا إذ نقترب من إيقاعها الأزلي، يغوص الألم والمتعة حتى يختفيا عن الأنظار تقريباً. هناك يتواجد الفرح في الرقصة، ولكن الرقصة لا تتواجد لأجل خاطر الفرح. بل أنها حتى لا تتواجد لأجل خاطر الخير، أو الحب، بل إنها هي الحب نفسه Love Himself، والخير نفسه Good Himself، وبالتالي فهي فرحة. إنها لا توجد لأجلنا، بل نحن الذين نوجد لأجلها.
إن حجم وفراغ الكون الذي أخافنا في بداية هذا الكتاب، لا يزال يجب أن يخيفنا، لأنه رغم أنها ليسا أكثر من منتج ثانوي ذاتي لخيالنا ثلاثي الأبعاد، إلا أنهما يرمزان إلى حق عظيم. فكما هي أرضنا بالنسبة لجميع النجوم، هكذا بلا شك نحن أيضاً البشر واهتماماتنا بالنسبة لكل الخليقة؛ وكما هي كل النجوم بالنسبة للفضاء نفسه، هكذا أيضاً كل المخلوقات، وكل العروش والقوى وأقدر الآلهة المخلوقة، بالنسبة إلى لانهائية ولامحدودية الكائن ذاتي الوجود Self Existing Being (الله)، الذي هي بالنسبة لنا آب وفادي ومعزي ساكن فينا.
إنه هو الكائن الذي لا يستطيع أي أنسان أو أي ملاك أن يقول أو يدرك ما هو في نفسه، أو ما هو العمل الذي يعمله “من البداية إلى النهاية”. لأن هؤلاء جميعهم مستمدون وغير جوهريين، لذلك فإن رؤيتهم تخذلهم وهم يغطون أعينهم من النور المفرط للحقيقة المطلقة، الذي كان والكائن والذي يأتي، الذي لم يكن من الممكن أبداً أن يكون غير ذلك، والذي ليس له ضد أو نقيض.
بعض الأحيان، تنتج تصميماً على إخفاء المعاناة، أما النساء اللواتي يعانين من التهاب المفاصل الروماتويدي Rheumatoid Arthritis فيظهرن مرحاً وهو الأمر المميز للغاية. حتى أنه يمكن مقارنته بأمل مرض السل Spes Phthisica؛ وربما يرجع هذا إلى تسمم طفيف للمريض من العدوى أكثر منه إلى زيادة في قوة الشخصية. بعض ضحايا الألم المزمن تتدهور حالتهم، فيصبحون خصاميين ولوامين ويستغلون مركزهم المميز كمرضى لممارسة الاستبداد المنزلي.
لكن الأمر الغريب هو أن الفاشلين يكونون قليلين للغاية والأبطال كثيرين جداً؛ يوجد تحدي في الألم البدني يمكن لمعظم الناس أن يدركوه ويستجيبوا له. من ناحية أخرى، فإن المرض الطويل، حتى دون ألم، يستنزف العقل كما يستنزف الجسد. فيتخلى المريض المزمن عن الصراع وينجرف بعجز وبوضوح إلى يأس الشفقة على الذات. حتى في هذه الحالة، بعض المرضى في حالات جسدية مماثلة، يحتفظون بهدوئهم وإيثارهم إلى النهاية. أن ترى ذلك، فتلك خبرة نادرة ولكنها مؤثرة.
أما الألم النفسي فأقل درامية من الألم الجسدي، ولكنه أكثر شيوعاً وأيضاً أكثر صعوبة في تحمله. المحاولات المتكررة لإخفاء الألم النفسي تزيد من العبء؛ فمن السهل أن تقول “أسناني تؤلمني” عن أن تقول “إن قلبي مكسور”. لكن إذا تم قبول السبب ومواجهته، فإن الصراع يقوي وينقي الشخصية وفي الوقت المناسب سوف يعبر الألم في المعتاد.
إلا أنه في بعض الأحيان، يستمر ويكون أثره مدمراً؛ فإذا لم يتم مواجهة السبب أو الاعتراف به. فإنه ينتج الحالة المحزنة للعصابية المزمنة. لكن البعض ببطولية يقومون بالتغلب حتى على الألم النفسي المزمن، وفي كثير من الأحيان ينتجون عملاً بارعاً، ويقوون، ويشددون ويشحذون شخصياتهم إلى أن يصبحوا مثل الصلب المقسى.
أما في الجنون الفعلي فتكون الصورة أعتم. في العالم الطبي بأكمله لا يوجد شيء أكثر شناعة يمكن أن نفكر فيه مثل إنسان يعاني من الكآبة او السوداوية المزمنة Chronic MeLancholia. لكن معظم مختلي العقل لا يكونون غير سعداء، او بالفعل، لا يكونون واعين بحالتهم. في كلتا الحالتين، إذا شفوا من هذا المرض، فإن ما يثير الدهشة هو أنهم لا يتغيرون إلا قليلاً. ففي معظم الأحيان، لا يتذكرون شيئاً عن مرضهم.
يقدم الألم فرصة للبطولة؛ وهذه الفرصة يتم اغتنامها بتكرار
مثير للدهشة.
[1] George Macdonald جورج ماكدونالد
[2] Theologica Germanica
[3] “Unspoken Sermons”, George Macdonald جورج ماكدونالد
[4] Theologica Germanica