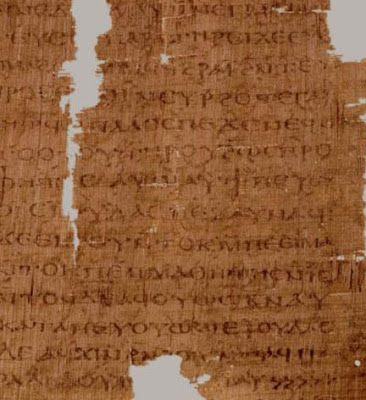الإنسان الجديد – سي إس لويس

الإنسان الجديد
شبّهت في الفصل السابق عمل المسيح في خلق أناس جُدد بعملية تحويل حصان إلى كائن مُجنح. وقد استخدمت هذا الإيضاح الذي فيه شيء من التطرف بُغية التشديد على كون الأمر ليس مجرد تحسين بل تغييراً جذرياً. فأقرب موازٍ له في عالم الطبيعة نجده في التحويلات الرائعة التي يمكننا إحداثها في الحشرات بتسليط أشعة معينة عليها. ويعتقد بعضُهم أن التطور حصل بهذه الطريقة. فتحولات الكائنات التي يتعلق كله بها ربما نتجت من جراء أشعة ترامت عليها من الفضاء الخارجي. (وطبعاً، ما إن تنوجد التحولات، حتى يسري فيها عمل ما يسمونه “الانتقاء الطبيعي”، أي أن التحولات النافعة تدوم وتزول الأخرى).
ولربما كان في وسع الإنسان العصري أن يفهم الفكرة المسيحية فهماً أفضل إذا نظر إليها في إطار التطور المفترض. والجميع الآن يعرفون عن التطور (مع أن بعض المثقفين طبعاً لا يؤمنون به)، إذ يُقال للجميع إن الإنسان تطور من أنواع حياة أدنى. وعليه، فغالباً ما يتساءل قوم: “ماهي الخطوة التالية؟ متى سيظهر الكائن الأرقى من الإنسان؟” ويحاول كتاب واسعو المخيلة أحياناً أن يتصوروا هذه الخطوة التالية (“السوبرمان” أو الإنسان المتفوق كما يسمونه)؛ غير انهم عادة لا ينجحون إلا في تصور كائن أبغض إلى حدّ بعيد من الإنسان كما نعرفه، ثم يحاولون التعويض عن ذلك بأن يُضيفوا إليه مزيداً من الأرجل أو الأذرع.
ولكن ماذا لو أن الخطوة التالية ستكون شيئاً أكثر اختلافاً بعد عن المراحل الأولى مما حلموا به يوماً؟ أو ليس من الأرجح أن يحصل ذلك؟ فقبل آلاف القرون، تطورت مخلوقات ضخمة مدّرعة على نحو ثقيل للغاية.
ولو كان امرؤ آنذاك يراقب مجرى التطور لربما توقع على الأرجح أن يستمر قُدماً إلى تدريع أثقل فأثقل. ولكن لو توقع ذلك، لثبت أنه على خطأ. فقد كان المستقبل يُخفي أمراً ما كان أي شيء آنذاك ليدل المُراقب عليه. إذ كان عتيداً أن يُطلع له “حيوانات” صغيرة عارية غير مدرعة ذات أدمغة أفضل، وبهذه الأدمغة كانوا عتيدين أن يسيطروا على الكوكب بكامله.
ولم يكونوا فقط عتيدين أن يحوزوا قدرة تفوق تلك التي كانت لأولئك المسوخ الذين ظهروا قبل التاريخ، وبل كانوا مُزمعين أن يحوزوا قدرة من نوع جديد. فلم تكن الخطوة التالية عتيدة أن تكون مختلفة فحسب، بل مختلفة بنوع جديد من الاختلاف. إذ لم يكن مجرى التطور مزمعاً أن يظل يتدفق في الاتجاه الذي رآه المُراقب جارياً فيه، بل كان في الواقع عتيداً أن ينعطف انعطافاً حاداً.
والآن، يبدو لي أن معظم التحزرات الشائعة بشأن الخطوة التالية تقع في مثل هذه الغلطة بعينها. إذ يرى قومٌ (أو على الأقل يحسبون أنهم يرون) بشراً تتطور لديهم أدمغة عظيمة ويكتسبون سيطرة على الطبيعة أعظم. ولأنهم يحسبون أن المجرى يتدفق في ذلك الاتجاه، يتصورون أنه سيظل يتدفق فيه تماماً. ولكن لا يسعني إلا أن أفكر بأن الخطوة التالية ستكون جديدة بالحقيقة؛ إنها ستنطلق في اتجاه ما كان يمكنك أن تحلم به. ولا تكاد تستحق أن تُدعى خطوة جديدة إلا إذا فعلت ذلك. فينبغي لي أن أتوقع لا مجرد اختلاف، بل اختلافاً جديد النوع.
وينبغي لي أن أتوقع لا مجرد تغيير، بل أسلوباً جديداً لإحداث التغيير. أو بتعبير طريف: ينبغي أن أتوقع أن التطور نفسه من حيث كونه اسلوباً لإحداث التغيير سيُبطل. وأخيراً، لا ينبغي أن أفاجاً إذا كانت قلة قليلة من الناس، عند حدوث التغيير، لاحظت أنه كان يحدث.
والآن، إذا راقك التحدث بمصطلحات من هذا القبيل، فالرأي المسيحي هو على وجه الدقة أن الخطوة التالية قد ظهرت فعلاً. وهي بالحقيقة جديدة. فهي ليست تغييراً من إنسان ذكي إلى إنسان أذكى، يل هي تغيير يجري كلياً في اتجاه مختلف تماماً: تغيير من كون الإنسان خليقة من خلائق الله إلى كونه ابناً من أبناء الله. وقد وقعت “الحادثة الأولى” في فلسطين منذ ألفي سنة. وبمعنى ما، ليس التغيير “تطوراً” على الإطلاق، لأنه ليس شيئاً ناجماً عن تتالي الأحداث الطبيعي، بل هو شيء دخل الطبيعة من الخارج. ولكن هذا هو ما كان ينبغي أن أتوقعه.
وقد توصل بعضهم إلى الفكرة القائلة “بالتطور” من دراسة الماضي. فإذا كانت مستحدثات فعلية طي المستقبل. فإن هذه الفكرة بالطبع، هي مؤسسة على الماضي، لن تشمل تلك المستحدثات حقاً. وبالحقيقة أن هذه الخطوة الجديدة تختلف عن جميع سابقاتها، ليس فقط في إتيانها من الخارج، بل أيضاً من بضعة أوجه أخرى.
(1) إنها لم تحصل بالتناسل الطبيعي. وهل من داع لأن يُفاجئنا هذا؟ فقد كان زمان، قبل ظهور الجنس، فيه كان التكاثر يحصل بأساليب مختلفة. وعليه، كان ممكنناً أن نتوقع أنه سيأتي زمن يتلاشى فيه الجنس، وإلا (الأمر الحاصل فعلاً) فزمنٌ فيه يكف الجنس، رغم استمرار وجوده، عن أن يكون سبيل النمو الرئيسي.
(2) في المراحل الأبكر، كان للكائنات العضوية الحية إما لا خيار البتة وإما خيار ضئيل جداً بشأن الخضوع للخطوة التالية. وقد كان الارتقاء، بصورة رئيسية، شيئاً حدث لها، لا شيئاً فعلته هي. غير أن الخطوة الجديدة، خطوة الانتقال من كون الناس خلائق إلى كونهم أبناء، هي طوعية، أو على الأقل طوعية بمعنىً معين. فهي ليست طوعية بمعنى أننا، من ذواتنا، كان يمكن أن نختار القيام بها، أو كان يمكننا حتى تصورها تصوراً؛ بل هي طوعية بمعنى أنه عندما تُقدَّم لنا يمكننا أن نرفضها. ففي وسعنا، إن شئنا، أن ننكمش ونتراجع؛ وفي وسعنا أن نغرز أقدامنا في الأرض وندع البشرية الجديدة تمضي في سبيلها من دوننا.
(3) لقد أشرت إلى تجسد المسيح بوصفه “الحادثة الأولى” في بروز الإنسان الجديد. ولكنه بالطبع أمرُ أكثر من ذلك بكثير. فليس المسيح إنساناً جديداً فحسب، أي عينة من النوع، بل هو الإنسان الجديد بالذات. إنه أصل جميع الناس الجدد ومركزهم وحياتهم. لقد جاء إلى العالم المخلوق، بمحض إرادته، آتياً بالحياة الجديدة، “الزويي”. (أعني أنها جديدة بالنسبة إلينا طبعاً، فمن حيث طبيعتها هي موجودة أزلاً). هو ينقلها لا بالوراثة، بل بما دعوته “العدوى الصالحة”. فكل من يحصل عليها ينالها من طريق الاحتكاك الشخصي بالمسيح. إذ إن الناس الآخرين يصيرون “جدداً” بكونهم به.
(4) تتم هذا الخطوة بسرعة تختلف عن سابقاتها. فمقارنة بنمو الإنسان على هذا الكوكب، يبدو أن انتشار المسيحية على الجنس البشري يحصل بمثل ومضة برق: لأن ألفي سنة لا تكاد تُساوي شيئاً في تاريخ الكون. (لا تنسى أبداً أننا ما نزال “المسيحيين الأولين”. فالانقسامات المقيتة والمهلكة بيننا. كما نرجو، ليست سوى مرض من أمراض الطفولة، إذ أننا ما نزال في مرحلة ظهور الأسنان.
ولا ريب أن العالم الخارجي يحسب عكس هذا تماماً: فهو يحسب أننا نموت من الشيخوخة. ولكنه ما أكثر ما حسب ذلك من قبل. فقد حسب مراراً وتكرارً أن المسيحية مائتة…. مائتة بفعل الاضطهادات من الخارج وضروب الفساد من الداخل، بفعل قيام كثير من الحركات الكبرى المناهضة لها، بما فيها نشوء العلوم الطبيعية والحركات الأخرى المضادة. ولكن فأل العالم خاب كل مرة. وقد حصلت أول خيبة بشأن الصلب. فإن الإنسان بُعث حياً من جديد.
وبمعنى ما، ما زال الانبعاث جارياً منذئذٍ، وأنا أدرك تماماً إلى أي مدى لابد أن يبدو ذلك ظلماً في نظر المُناهضين! فإن هؤلاء يدأبون في قتل ما قد انطلق، وفي كل مرّة، بينما هم يمهدون التربة فوق قبره، يسمعون فجأة أنه ما يزال على قيد الحياة، بل أيضاً قد برز إلى الوجود في مكان جديد. فلا عجب إن كانوا يكرهوننا).
(5) إنما الآمال أسمى فعلاً. فبالتعثر في الخطوات الأبكر، فقدَ المخلوق، في أسوأ الأحوال، سني حياته القليلة على هذه الأرض: وما أكثر ما لم يفقد حتى هذه! ولكننا بالتعثر في هذه الخطوة نخسر جائزة هي (بالمعنى الأضيق للكلمة) لا نهائية. ذلك أن اللحظة الحاسمة قد حلت الآن. فقرنا بعد قرن، اقتاد الله الطبيعة إلى نقطة إنتاج خلائق في وسعهم (إذا شاءوا) أن يؤخذوا رأساً إلى خارج الطبيعة، بصيرورتهم “آلهة”. أفيسمحون لأنفسهم بأن يؤخذوا؟ وهذا شبيه، من ناحية، بأزمة الولادة. فإلى أن نقوم ونتبع المسيح.
نظر أجزاء من الطبيعة، إذ ما نزال في رحم أمنا العظيمة. ولقد كان حملها طويلاً وأليماً ومحفوفاً بالترقب والقلق، إلا أنه قد بلغ ذُروته. فها قد حلت اللحظة الحاسمة، وكل شيء جاهز، وطبيب التوليد قد جاء. فهل تتم الولادة بخير؟ غير أنها بالطبع تختلف عن الولادة العادية في جانب مهم جداً. ففي الولادة العادية لا يكون للطفل خيار كثير: أما هنا فلديه. وإني لأتساءل ماذا يفعل الطفل العادي لو كان له الخيار. فقد يؤثر البقاء في ظلمة الرحم ودفئها وأمانها. ومن شأن ذلك أن يكون موضع خطأه الأخرى: لأنه إذا بقي هناك يموت.
فبناء على هذه النظرة، حدث الأمر فعلاً؛ إذ إن الخطوة الجديدة قد تمت وتتم. فالناس الجدد فعلاً منتشرون هنا وهناك على وجه الأرض كلها. والمرء يقابلهم بين حين وآخر. حتى أصواتهم ووجوههم مختلفة عن أصواتنا ووجوهنا: فهي أقوى وأهدأ وأسعد وأبهى. وهم يبتدئون حيث نتوقف نحن. وأعتقد أن تمييزهم ممكن؛ إنا ينبغي لك أن تعرف عما تبحث.
فإنهم لن يكونوا تماماً على صورة “المتدينين” التي كونتها من قراءاتك معهم، في حين يكونون هم بالحقيقة لطفاء معك. وهم يحبونك أكثر مما يحبك سائر الناس، غير أنهم يحتاجون إليك أقل. (علينا أن نتغلب على الرغبة في أن نكون مطلوبين: فهذه هي التجربة الأصعب مقاومتها بين جميع التجارب لدى بعض مُتكلفي الصلاح، ولا سيما من النساء).
وسيبدو دائماً أن لديهم متسعاً من الوقت، حتى لتعجب من أين يأتيهم. وعندما تُميّز واحداً منهم، فسيكون تمييز التالي أسهل عليك بكثير. وأغلب الظن عندي (إنما كيف لي أن أتيقن؟) أنهم يميزون بعضهم بعضاً في الحال وبلا التباس، عبر كل حاجز من لون أو جنس أو فئة أو عمر، بل عبر قوانين الإيمان أيضاً. على هذا المنوال، تكون صيرورة المرء قديساً أشبه بالانضمام إلى جمعية سرية. وبتعبير يقتصر على الحج الأدنى، لا بد أن ينطوي ذلك على متعة عظيمة.
ولكن لا ينبغي أن تتصور ان الناس الجُدد، بمعنى الكلمة المألوفة، متشابهون كلهم. ولربما جملك مقدار كبير مما دأبت في قوله في صفحات الباب الأخير هذا على الظن بأن الواقع لا بد أن يكون على تلك الحال. فأن نصير أناساً جُدداً يعنى أن نفقد ما ندعوه الآن “ذواتنا”. إذ ينبغي لنا أن نخرج إلى خارج أنفسنا كي ندخل المسيح. ينبغي أن تصير إرادته إرادتنا، وأن نفكر أفكاره: “أن يكون لنا فكر المسيح”، كما يقول الكتاب المقدس. وما دام المسيح واحداً، وينبغي هكذا أن يكون “فينا” جميعاً، أفلا نكون متشابهين تماماً؟ يقيناً أن الأمر يبدو على هذه الصورة، ولكنه ليس كذلك في الواقع.
من الصعب هنا أن أقدم إيضاحاً وافياً: لأنه بالطبع لا يرتبط شيئان آخران أحدهما بالآخر تماماً كما يرتبط الخالق بواحد من خلائقه. غير أنني سأجرب إيضاحين غير كاملين للغاية لكنّهما قد يلقيان ضوءً على الحق. تصور مجموعة من الناس عاشوا دائماً في الظلام. ثم تأتي وتحاول أن تصف لهم حقيقة النور. فقد تقول لهم إنه إذا أقبلوا إلى النور فإن ذلك النور عينه سيسقط عليهم جميعاً، وأنهم جميعاً سيعكسونه، وبذلك يصيرون مرئيين كما نقول.
أفليس من الممكن تماماً أن يتصوروا أنهم ما داموا كلهم يتلقون النور ذاته وكلهم يستجيبون له بالطريقة نفسها (أي يعكسونه) فسيكونون متشابهين كلهم؟ في حين أننا، أنا وأنت، نعلم أن النور بالحقيقة سوف يُبرز، أو يُظهر، إلى أي مدى هم مُتباينون. أو أيضاً هب شخصاً لا يعرف عن الملح شيئاً. فإنك تُعطيه مقدارً ضئيلاً من الملح حتى يتذوقه، فيحسُّ طعماً قوياً حاداً معيّناً.
ثم تقول له إن الناس في بلدك يستخدمون الملح في جميع مآكلهم. أفلا يمكن أن يُجيب: “في هذه الحالة أعتقد أن جميع مأكولاتكم لها الطعم نفسه تماماً: لأن طعم هذه المادة التي أعطيتني إيّاها للتو قوي جداً بحيث يقتل طعم أي شيء آخر”؟ غير أن ما أعلمه وتعلمه هو أن تأثير الملح الحقيقي عكس ذلك تماماً.
فأبعد بكثير عن قتل الملح لطعم البيض أو المحشو أو الملفوف، نعلم أنه بالفعل يُبرز طعم هذه المأكولات. ذلك أن هذه المآكل لا تُبدي طعمها الحقيقي إلا متى أضفت إليها الملح. (كما سبق أن نبهتك طبعاً، ليس هذا إيضاحاً وافياً جداً، لأنك في نهاية المطاف قد تقتل الطعوم الأخرى بإضافة كثير من الملح، في حين لا يمكنك أن تقتل طعم الشخصية البشرية بإضافة مقدار زائد من المسيح… غير أني بذلت قصارى جهدي!)
إن حالنا مع المسيح تُشبه شيئاً من هذا القبيل. فكلما أزحنا من الطريق ما ندعوه الآن “ذواتنا” وسمحنا للمسيح بأن يتولى أمرنا، نصير “أنفسنا” حقاً على نحو أوفى. وثمة مقدار كبير جداً من المسيح سيكون ملايين الملايين من “المسحاء الصغار” أقل جداً من أن يعبّروا عنه أكمل تعبير وبعضهم مختلفون عن بعض. وهو قد صنعهم أجمعين. فهو اخترع، كما يخترع الروائي أشخاص روايته، جميع الناس المختلفين الذي قُصد لنا، أنتم وأنا، أن نكونهم. وبهذا المعنى، فإن ذواتنا الحقيقية كلها تنتظرنا فيه. فلا خير في سعيي إلى “أن أكون ذاتي” بمعزل عنه. وكلما قاومته وحاولت أن أعيش حياتي الخاصة، سيطرت عليّ وراثتي ونشأتي وبيئتي ورغباتي الطبيعية.
وبالحقيقة أن ما أدعوه “نفسي” بكل فخر يصير مجرد مُلتقى سلاسل من الأحداث التي لم أطلقها قط والتي لا يمكنني وقفها. وما أدعوه “رغباتي” يصير مجرد الميول التي يلقيها عليّ كياني العضوي الطبيعي، أو تضخًّها في داخلي أفكار الناس الآخرين، أو توسوس لي بها الشياطين أيضاً. فإن أكل البيض وشرب الكحول وقضاء ليلة هانئة ستكون الأصول الحقيقية لما أطري نفس بحسبانه تصميمي الشخصي جداً والمدروس بحكمة على إقامة وصال جنسي مع الشابة الجالسة مقابلي في عربة القطار.
وسيكون الترويج الدعائي هو الأصل الحقيقي لما أعده أفكاري السياسية الشخصية. فأنا، في حالتي الطبيعية، لست تقريباً ذلك الشخص الذي أود أن أحسب نفسي إياه: فمعظم ما أدعوه “أنا” يمكن تعليله بكل سهولة. وعندما ألتفت راجعاً إلى المسيح، عندما أُسلم نفسي لشخصيته، عندئذ أبدأ أحوز الشخصية الحقيقية الخاصة بي.
قلت في البداية إن في الله شخصيات، أو أقانيم. وسأتقدم قليلاً الآن، فأقول إنه لا توجد أية شخصيات حقيقة في أي مكان آخر. فما لم تُسلم ذاتك لله، لا تكن لك ذات حقيقية. إن التماثل يتواجد أكثر الكل بين الناس الذين يتصفون أكثر من سواهم بأنهم “طبيعيون” وليس بين أولئك الذين يخضعون للمسيح. فكم كان جميع الطغاة والغزاة العظام متماثلين على نحو رتيب، وكم كان جميع القديسين متمايزين على نحو مجيد!
إنما ينبغي أن يحصل تخل حقيقي عن الذات. فيجب أن تطوحها بعيداً “على العمياني”، إن جاز التعبير. وسيُعطيك المسيح بالحقيقة شخصية حقيقية، إنما لا ينبغي أن تذهب إليه طلباً لهذا الأمر بعينه. فما دامت شخصيتك الخاصة هي ما يعنيك ويقلقك، فإنك لن تذهب إليه أبداً. وأول خطوة بالذات هي أن تحاول نسيان أمر ذاتك كلياً. فإن ذاتك الحقيقية، أي الجديدة (التي هي للمسيح ولك أيضاً، وهي لك تماماً لأنها للمسيح)، لن تأتيك ما دمت تطلبها. إنها ستأتيك فيما تطلب المسيح نفسه.
أيبدو هذا غريباً؟ إن المبدأ عينه يصح، كما تعلم، بالنسبة إلى كثير من الشؤون اليومية. حتى أنك، في الحياة الاجتماعية، لن تُخلف لدى سواك من الناس أي انطباع حسن قبل أن تكف عن التفكير في أي نوع من الانطباع انت محدثه. وفي الآداب والفنون أيضاً، لن يكون أصيلاً البتة أي شخص تعنيه الأصالة وتقلقه: في حين أنك إذا حاولت قول الحق فحسب (بغير أن يهمك بتاتاً كم مرة سبق أن قيل) فلا بد أن تصير أصيلاً، دون أن تلاحظ ذلك أبداً، تسع مرات من كل عشر. فهذا المبدأ يتخلل الحياة كلها من القمة إلى الحضيض: تخل عن ذاتك، فتجد ذاتك الحقيقية؛ اخسر حياتك، فتُنقذها.
اخضع للموت، موت مطامحك ورغباتك كل يوم موت جسدك بكامله في النهاية، اخضع له بكل عرق وعصب في كيانك، فتجد حياة أبدية، لا تتمسك بأي شيء. فلا شيء مما لم تتخل عنه سيكون لك حقاً.
ولا شيء فيك مما لم يمت سيُقام من الموت. ابحث عن ذاتك، فلن تجد في نهاية المطاف إلا البغض والوحشة واليأس والسخط والخراب والفساد. ولكن ابحث عن المسيح، فتجده حتماً، وتجد معه كل شيء آخر علاوة عليه.